

الفصل الأوّل: اللّسانيّات: التّعريف والجذور | 14
*المهاد التاريخي للسانيات: | 17
الفصل الثّاني: المناهج والأقسام | 24
*اليونانيون والدرس اللساني: | 26
المنهج التّقابليّ Contrastive linguistics: | 36
المنهج الوصفيّ Descriptive linguistics: | 36
الفصل الثّالث: التّيارات والمدارس ومستويات التّحليل | 44
النّحو التّوليديّ التّحويليّ: | 57
اللّسانيّات الوظيفيّة العربيّة | 65
ثانيًا: المستوى الصّرفيّ: | 87
ثالثًا: المستوى التركيبيُّ (Syntax): | 92
رابعًا: المستوى الدلاليّ: | 99
الفصل الرّابع: أهم الأعلام والمنظريّن | 104
مقدمة المركز7
المقدمة9
الفصل الأوّل: اللّسانيّات: التّعريف والجذور14
*تعريف اللسانيات:14
*خصائص اللسانيات:15
*قسمة اللسانيات:16
*المهاد التاريخي للسانيات:17
الفصل الثّاني: المناهج والأقسام24
*عين على التاريخ:24
*خصائص النحو الهندي:25
*اليونانيون والدرس اللساني:26
*العرب والدرس اللساني:29
اللّسانيّات التاريخية34
المنهج التّقابليّ Contrastive linguistics:36
المنهج الوصفيّ Descriptive linguistics:36
الفصل الثّالث: التّيارات والمدارس ومستويات التّحليل44
النّحو التّوليديّ التّحويليّ:57
اللّسانيّات الوظيفيّة العربيّة65
أولًا: المستوى الصّوتي:76
ثانيًا: المستوى الصّرفيّ:87
ثالثًا: المستوى التركيبيُّ (Syntax):92
رابعًا: المستوى الدلاليّ:99
الفصل الرّابع: أهم الأعلام والمنظريّن104
آ- فرديناند دو سوسور104
ب - نيقولاي سيرجيفتش تروبتسكوي124
ج. إدوارد سابير126
د. ليونارد بلومفيلد131
هـ. لويس هيلمسليف133
و. رومان جاكوبسون136
ز. زليج سابيتي هاريس139
ح. أندريه مارتينيه143
ط. نوم تشومسكي147
الخاتمة154
المراجع157
تدخل هذه السلسلة التي يصدرها المركز الإسلامي للدراسات الإستراتيجية في سياق منظومة معرفية يعكف المركز على تظهيرها، وتهدف إلى درس وتأصيل ونقد مفاهيم شكلت ولما تزل مرتكزات أساسية في فضاء التفكير المعاصر.
وسعياً إلى هذا الهدف وضعت الهيئة المشرفة خارطة برامجية شاملة للعناية بالمصطلحات والمفاهيم الأكثر حضوراً وتداولاً وتأثيراً في العلوم الإنسانية، ولا سيما في حقول الفلسفة، وعلم الإجتماع، والفكر السياسي، وفلسفة الدين والاقتصاد وتاريخ الحضارات.
أما الغاية من هذا المشروع المعرفي فيمكن إجمالها على النحوالتالي:
أولاً: الوعي بالمفاهيم وأهميتها المركزية في تشكيل وتنمية المعارف والعلوم الإنسانية وإدراك مبانيها وغاياتها، وبالتالي التعامل معها كضرورة للتواصل مع عالم الأفكار، والتعرف على النظريات والمناهج التي تتشكل منها الأنظمة الفكرية المختلفة.
ثانياً: إزالة الغموض حول الكثير من المصطلحات والمفاهيم التي غالباً ما تستعمل في غير موضعها أويجري تفسيرها على خلاف المراد منها. لا سيما وأن كثيراً من الإشكاليات المعرفية ناتجة من اضطراب الفهم في تحديد المفاهيم والوقوف على مقاصدها الحقيقية.
ثالثاً: بيان حقيقة ما يؤديه توظيف المفاهيم في ميادين الاحتدام الحضاري بين الشرق والغرب، وما يترتب على هذا التوظيف من آثار
(7)سلبية بفعل العولمة الثقافية والقيمية التي تتعرض لها المجتمعات العربية والإسلامية وخصوصاً في الحقبة المعاصرة.
رابعاً: رفد المعاهد الجامعية ومراكز الأبحاث والمنتديات الفكرية بعمل موسوعي جديد يحيط بنشأة المفهوم ومعناه ودلالاته الإصطلاحية، ومجال استخداماته العلمية، فضلاً عن صِلاته وارتباطه بالعلوم والمعارف الأخرى. وانطلاقاً من البعد العلمي والمنهجي والتحكيمي لهذا المشروع فقد حرص لامركز على أن يشارك في إنجازه نخبة من كبار الأكاديميين والباحثين والمفكرين من العالمين العربي والإسلامي.
***
هذه الدراسة التي تندرج ضمن مشروعنا "سلسلة مصطلحات معاصرة" تبحث في الألسنية كمفهوم ومصطلح وتيار نشأ وتتطور في أزمنة الحداثة المتعاقبة. كما تبحث في الجذر التاريخي والمعرفي لنشوء المفهوم ودراسة مذاهبه ومدارسه والرواد الأوائل المؤسسين.
يتناول الباحث هذا المعطى العلمي والمعرفي من وجهة نظر ابستمولوجية وتاريخية فضلاً عن متاخمته بالتفكيك النقدي انطلاقًا من المنهجية الأصلية لمشروعنا في درس المفاهيم الحديثة.
والله ولي التوفيق
(8)اللّغة إحدى أهمّ الظّواهر الإنسانيّة الّتي لفتت أنظار الإنسان نفسه منذ أن كانت أصواتًا يتواصل بها مع أبناء جنسه إلى أن غدت بنيةً متكاملة. ثمّ كانت محطّ اهتمام الفلاسفة واللّغويين يجهدون في تفسير نشأتها، ودراسة بنيتها ووظيفتها، وإماطة اللّثام عن كيفيّة عملها في الدماغ البشريّ.
وهذا البحث لا يعدو أن يكون محاولةً صادقةً للتعريف بالعلم الّذي أصبح متكأً لدراسة (الظّاهرة اللّغويّة)، والوقوف على أبعادها، فيما أصبح يعرف بـ (اللّسانيّات).
كُسِرَ هذا البحث على أربعة فصول أُريد بها أن تقف عند معالم هذا الفرع من الدّراسات الإنسانيّة، فوقف أوّل فصوله عند اللّسانيّات ومفهومها وأقسامها، فرأى أنّها علمٌ يدرس اللّغة الإنسانيّة دراسة علمية عمادها الوصف والمعاينة، وينأى بنفسه عن النّزعات التّعليميّة والأحكام المعياريّة.
وجعل الفصل الثاني وجهته المناهج اللّسانيّة، فرأى أنّها قسمان رئيسيان هما: قسمٌ يعود إلى ما قبل القرن التّاسع عشر، والقسم الآخر من مطلع القرن التّاسع عشر حتى زمان النّاس هذا. فكانت المناهج الّتي توسَّلت بها اللّسانيّات متعددة، نحو: اللّسانيّات المقارنة، واللّسانيّات التّاريخيّة، والمنهج التقابليّ، والمنهج الوصفيّ.
ثم أردف ذلك بدراسة التيارات والمدارس اللسانية، بادئًا
(9)بالبنيويّة التي وضع حجر أساسها (سوسور) الّذي يُعدّ أبًا حقيقيًّا لهذا الاتجاه، وعرض لِمَن تأثر بهذا الاتجاه من اللّسانيّين، أمثال: فرانز بواز، وإدوارد سابير، وبلومفيلد. ومرّ كذلك على الوظيفيّة الّتي كانت جهود (أندريه مارتينيه) نقطة انطلاقها، ثمّ حطّ رحاله عند اتجاه (النّحو التوليديّ التّحويليّ)، وصاحبه (تشومسكي)، والآثار الّتي تمظهرت فيها معالم نظريّته، ومساعيه الخبيثة لتطوير نظريّته على مرّ الأيام.
وفي إطار ذلك تلبّث الفصل عند مستويات الدّرس اللّسانيّ فوقف عند الدّرس الصّوتيّ، وهو أسّ الدرس اللّسانيّ، فالدّرس الصّرفيّ، فالتّركيبيّ، فالدّلاليّ، وهو آخر المستويات وذروة سنامها، ففيه شحنات الدّلالة والمقاصد التي يتغيَّاها متكلم أيّة لغة.
ولم يغفل البحث دراسة تمظهرات هذه الاتجاهات والمناهج في اللّسانيّين على امتداد السّاحة العربيّة، فوقف وقفةً متأنيةً عند الدّراسات اللّسانيّة لتمّام حسان، وميشال زكريا، وأحمد المتوكل إذ كان كلّ منهم يمثل اتجاهًا يحاول توظيفه في دراساته اللّسانيّة.
ثم انتجع البحث الفصل الرّابع فكان خاصًا بالتّعريف والترجمة لأهمّ الأعلام في ميدان الدّرس اللّسانيّ، فوقف عند مراحل نشأتههم وحياتهم في الميدان العلميّ، وكشف أهمّ المؤثرات الّتي كانت وراء تسلّمهم هذه المكانة على صعيد الدرس اللّسانيِّ.
وليس لهذا البحث أن يدّعي أنّه أحاط بجوانب الدّرس اللّسانيّ كلّها، أو أنّه أوّل حارثٍ لهذه الأرض، أو أنّه استطاع أن يأتي بما عجزت الأوائل عن الإتيان به. فحسبه أنّه كان صادق المحاولة
(10)في رسم ملامح هذا العلم القديم الجديد ومعالمه، وهو غير مُنكرٍ لفضل السّابقين عليه، وقد كانت سطور آثارهم موردًا له خلال عامٍ تصرَّم في إعداد صَفحاته، ولكنّه لا يدفعه التّواضع إلى الضَّعَة فينكر على نفسه أنّه ناقش، وفسَّر، وأخذ وردَّ، وأعجب وأنكر، فنثر رأيًا هنا، ومقولةً يؤمن بها هناك، مكتفيًا بالارتشاف دون العبِّ، وبالتلميح دون التّصريح، وبالإشارة إذا أغنت عن العبارة.
والله من وراء القصد.
الإثنين التّاسع عشر من شوّال، 1439هـ، الموافق الثاني من تموز، 2018م.
وليد محمد السّراقبيّ
تُعرَّف (اللِّسانيّات) بأنّها علمٌ يدرس «اللّغة الإنسانيةً دراسةً علمية تقوم على الوصف ومعاينة الواقع بعيدًا عن النزعات التعليمية والأحكام المعياريَّة» فهي دراسةٌ تأخذ من العلم سلَّمًا لها، وتعرض للغات البشرية كافة من خلال الألسنة الخاصة بكلّ قوم، وتدرس اللّغة بعيدًا عن مؤثرات الزمن والتاريخ والعِرْق.
والمقصد من هذه الدراسة بيان جوهر كلّ لغة من هذه اللّغات، واستراتيجيَّة عمل كلٍّ منها والنّظر إليها على «أنّها منظومةٌ كليّةٌ تتألف من مستويات متراتبةٍ يستند الأعلى منها إلى الأدنى».
فإذا كان (فقه اللّغة) لا يلتفت إلّا إلى اللّغة المعيارية الّتي تفترش المعجمات، وتنطق بها كتب الأدب والمجاميع الشعريّة، فلاحظ للعامية في أن تمتدَّ إليها يدها بالدراسة، فإنّ اتجاه اللسانيات يدفعه إلى «دراسة اللغات في واقعها المعيش إلى جانب دراستها في ماضيها
المنقول إلينا» ـ فإنَّ (اللسانيات) لا تتأبّى على تناول اللّغة ـ أية لغة إنسانية، حيَّة كانت أم ميتة، أو آيلة إلى الاندثار، عامية أم فصيحة بالدراسة العلميَّة، يحدوها البحث المجرَّد عن أيّة معاييرٍ قديمة.
فموضوع اللسانيات «كلّ النشاط اللّغويّ للإنسان في الماضي والحاضر، ويستوي في هذه الإنسان البدائي والمتحضر، واللغات الحية والميتة، والقديمة والحديثة، دون اعتبارٍ لصحَّةٍ أو لحن، وجودةٍ أو رداءة».
إنَّ ما اشتملت عليه جملةُ التعريفات السابقة، والخصائص الّتي فرشت ـ في السّطور السّابقة- تجعل من اللسانيات علمًا له تخصُّصه وله ما يميّزه، إذا ما قورن بعلوم اللّغة الأُخرى مثل (النّحو) و(الصّرف)، ومن ذلك:
1. استقلاليّتها عن بقية العلوم، كالنّحو الّذي كان وشيج الصّلة بالمنطق.
2. توجهها إلى اللّغة المنطوقة قبل المكتوبة.
3. الاعتناء بدراسة اللّهجات، إذ هذه اللّهجات «لا تقلُّ أهميةً عن سواها من مستويات الاستخدام اللّغويّ».
4. طموحها إلى بناء نظريّة لسانيّة عامّة تدرس بموجبها اللّغات البشريّة كافة.
5. إهمال الفوارق بين بدائيِّ اللّغات ومتحضِّرها.
6. النّظر إلى اللّغة كلًا موحَّدًا، وتسير في الدّراسة من الصّوت لتنتهي بالدّلالة مرورًا بالبنى الصّرفية فالنّحوية.
7. دراسة اللّغة دراسةً حسيَّةً استقرائيةً وصفيةً وفق الواقع اللّغويّ المعيش.
8. الاعتماد على التقانات من آلاتٍ وأجهزةٍ حديثةٍ في الدّرس الصّوتيّ أحد ميادينها.
9. استنباط القوانين الناظمة للظواهر اللّغويّة أو للغات بالاتكاء على الملاحظة الإحصائية.
فاللّسانيّات علمٌ «يدرس اللّغة أو اللهجة دراسةً موضوعيةً، غرضها الكشف عن خصائصها، وعن القوانين اللّغويّة الّتي تسير عليها ظواهرها الصّوتيّة والصّرفيّة والنّحويّة والدّلاليّة والاشتقاقيّة والكشف عن العلاقات الّتي تربط هذه الظّواهر بعضها ببعض، وتربطها بالظّواهـر النّفسيّة، وبالمجتمـع والبيئة الجغرافيّة».
وتنقسم اللِّسانيّات ـ بالنظر إلى كونها علمـًا يدرس اللّسان البشريَّ ـ قسمين: أوّلهما قسمٌ يتناول بالدّرس والتّدقيق اللّسان
البشريَّ عامّة، أساسه وحدة اللّسان البشريّ لا تمييز بين لسانٍ قوميٍّ وآخر، فهو يعرض للكليات اللّغويّة الّتي تشترك فيها اللغات البشرية، كدراسة ظاهرة التأنيث مثلًا في اللغات، أو ظاهرة الاسم، أو ظاهرة التذكير، أو ظاهرة الجمع، ... وكذلك يدرس عناصر المنظومة اللّغويّة، وما تمتاز به من خواصٍّ تفرزها من غيرها أوّلًا، وما يربط بين هذه العناصر ومستويات استعمالها ومظاهره، فهو إذًا يدرس «البنى العميقة في اللّسان البشري، وهي تجمع بين ظواهر خاصة، أي: بين اللغات القوميّة».
وثانيهما: دراسة الظواهر الخاصة في اللّسان البشري، أي يدرس اللغات القومية، فيخصُّ لغة ما بدراسة وصفية عمدتها المعاينة والموضوعية، رغبة في الكشف عن خصوصياتها ومزاياها الّتي توحِّد بينها في كلٍّ هو (اللّغة القومية) وهذا يعني أنه ينطلق ـ على النقيض من القسم الأول ـ من الخاصّ إلى العامّ.
وإذا أردنا البحث عن العمق التاريخيّ لهذا العلم كان في استطاعتنا أن نتلبّث عند القرن التاسع عشر، ذلك القرن الّذي شهد بداية علم اللسانيات، إذ اكتشف (وليام جونز William Jones) سنة 1796م اللّغة السنسكريتية، وكشف عن منزلة اكتشاف هذه اللّغة وما تقدِّمه للدرس اللّغويّ في أوربا، فكان ينظر إلى أنّ هذه اللّغة، على الرّغم من إمعانها في القدم ذات بنية رائعة تفوق اللّغة اليونانيّة
واللّاتينيّة كمالًا وغنىً وثقافة ولكن لا تعدم الصّلة الوثقى بهاتين اللّغتين «سواء من ناحية جذور هذه الأفعال، أم من ناحية الصّيغ النّحوية ... ولا يسع أي لغيٍّ بعد تفحُّصه هذه اللّغات الثّلاث إلّا أن يعترف بأنّها تتفرع من أصلٍ مشتركٍ زال من الوجود».
لقد كان اكتشاف هذه اللّغة ـ أعني اللّغة السّنسكريتيّة- منطلقًا للدرس اللّسانيّ الخاصّ بهذه اللّغة من جهة، وموئلًا لعلم اللّغة المقارن من جهةٍ أخرى. فقد وضع (كارل شليجل Karl Schlegel) سنة 1808كتابًا سماه (حول لغة الهنود وحكمتهم)، وقد بسط فيه ما طرحه سابقه (وليام جونز)، وكتب (بارتلمي) كتابًا بـعنوان (قواعد اللّغة السّنسكريتيّة) وآخر بعنوان (في قدم اللّغات الفارسيّة والسّنسكريتيّة الجرمانيّة والتجانس بينهما).
ووضع (فرانز بوب Franz Bopp) سنة 1916 كتابه (منظومة تصريف الأفعال السّنسكريتيّة)، وكشف فيه عن الرّوابط الرَّحميّة بين اللّغة السّنسكريتيّة واللّغات الأوربيّة، كاللاتينية، والألمانية، وسميت آنئذٍ بـ (اللغات الهندوأوربية).
وقد أشار (بوب) إلى بداية بحوثٍ فعليةٍ دقيقةٍ عمدتها عقد مقارنات فيما بين النصوص القديمة لِما بين اللغات من تطابقات في الأصوات، أو البنى الصّرفيّة، أو غيرها.
وترمي هـذه الأبحاث إلى تلمُّس الأصول الّتي توارثتها هذه
اللغات، وتبيان الأصل الحقيقيّ لهذه اللّغات، بعيدًا عن شطحات الخيال، وبذلك يكون هذا الكتاب قد فتح الباب أمام أفقٍ لسانيٍّ جديد.
فإذا كانت الدّراسات اللّسانيّة المقارنة قد ولَّت وجهها شطر العلوم الطبيعية تتكئ على منهجها، وتأخذ منها كثيرًا من المصطلحات، على ما مرَّ معنا = فقد اتجه الدّرس اللّسانيّ وجهةً تاريخية، وهيمن علم التاريخ على الفكر عامة، ثم غدا محْرق الدرس اللّغويّ فغدا أشبه بعلمٍ تاريخيٍّ بعد أن كان يُنظر إلى اللّغة إلى أنها أشبه بالجسم البشري.
فالانتقال بين الدرس اللساني المقارن والدرس التاريخي حصل بين الأعوام (1876–1886م) مع المدرسة اللّغويّة الّتي كانت تسمى بـ (النّحاة الجدد) أو (النّحاة المحدثين)
Neo – grammarian)) فقد كان لهذا الأسلوب في الدّرس اللّسانيّ أثره في هؤلاء النحاة، لما كان لعلم التاريخ من ريادة علمية في القرن التاسع عشر .
منطلق النحاة الجدد في الدرس اللساني:
كانت نقطة انطلاق (النحاة المحدثين) ما وقّر في أذهانهم حول اللغات وطبيعتها من تصوّرات وصفية وآلية، وأكدوا أنّ أيَّ تغيّرٍ صوتي في اللغات يمكن أن يُفسَّر بقوانينٍ لا استثناء فيها، ذلك أنَّ
هذه التغيّرات الّتي تلاحظ في وثائق الدرس الألسني التاريخي إنما مصدرها قوانين ثابتة لا تتغير إلّا بالتوافق مع غيرها من القوانين.
فهذه المدرسة تنظر إلى اللسانيات على أنّها علمٌ تاريخي، وترى أن الدرس التاريخي هو المسلك الوحيد في الدرس اللّغويّ الّذي لا يسلك سبل هذا المنهج يُتَّهمُ بقصور الرؤيا، ونقص المصادر، وكلّ ذلك عائد إلى سيطرة علم التاريخ وهيمنته في هذه الحقبة، على ما أشرنا إليه من قبل.
وكان من نتائج الاعتماد على البعد التاريخي في الدّرس اللّسانيّ تشتُّت الدّراسات اللّسانيّة وبعثرتها، ورفضها أيّ تأصيلٍ لغويّ يقوم على التخيُّل، أو أيّ تفسيرٍ منطلقه ذات اللّغة ولكنّها ـ على الرّغم مما تقدّم ـ جعلت اللسانيات تشقُّ طريقها علمٍ مستقل .
وأفسحت مدرسة (النحاة المحدثين) السبيل إلى علم النفس ليكون عونًا لها في البحث اللّساني، ذلك أنّ في مقدوره تحليل روابط اللّغة بالفكر، وشرَعَ اللّسانيون المحدثون يقترضون من علم النفس ـ وقد بسط جناحيه في السّاحة العلميّة ـ مصطلحاته وآلياته وفرضياته ومنهجه، وأخذوا يُولون العامل النفسي لمتكلم اللّغة اهتمامًا فائقًا.
وتمخَّضت أواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين عن مسلكٍ جديدٍ في الدّرس اللّسانيّ كان من أعلامه (أنطوان ماييه Antoine Meillet)، (فرديناند دو سوسور Ferdinand de
Saussure)، وعمدته دراسة الظواهر اللّغويّة في مدّةٍ محدَّدةٍ دراسة وصف لا تُدخل في حسبانها أية أفكارٍ سابقة، ولا تحتكم إلى معايير الصواب والخطأ، وكان ظهور هذا المنهج بالوقوف على قيمـة المحاضرات الّتي ألقاها (سوسور) على طلابه، وقاموا من بعده بجمعها، وهو ما جعله الرّائد الحقيقيّ للدّراسات الألسنيّة الوصفية، وهو كذلك مؤسس اللسانيات المحدثة بلا منازع، فقد «وضح اختصاصها ومناهجها وحدودها، وأغنى الدراسات الإنسانية بالكثير من الأفكار اللّغويّة».
(23)
تقتضينا النَّصفة ألّا نهجم هجومًا مباشرًا على ما جدَّ من مناهج لسانيّة، ذلك أنَّ هذه المناهج المحدثة لم تُولد من فراغ، ولذا كان لزامًا على الدارس المنصف أن يعرِّج على مراحل سبقت، فيقف عندها، محلِّلًا، مدقّقًا، راصدًا امتداداتها أو انقطاعاتها في العصر الحديث، ولذا رغبنا في تقسيم دراسة تطوّر الدّرس اللّسانيّ ومناهجه قسمين:
1 – القسم الأول: ما قبل القرن التاسع عشر.
2 – القسم الثاني: مطلع القرن التاسع عشر إلى العصر الحالي.
أما القسم الأوَّل فيبدأ في الحضارة الهندية (2000 – 1000 ق.م)، وهي الّتي تُسمَّى (مرحلة الفيدا)، كتاب البوذيين المقدَّس، ذلك أنّ غاية هذه المرحلة المتقدِّمة من الدّرس اللّسانيّ المحافظة على النّصوص الطّقسيّة الدّينيّة من أنْ تمتدَّ إليها يد الزّمان واللّهجات بالإفساد.
وكانت جهود (بانيني Pāṇini) أهمّ ما قُدِّم للدرس اللّغويّ، فقد
أثرت دراسات الهنود اللّغويّة في الارتقاء بالمنهج العلمي لدراسة الصوت اللّغويّ، فدرسوا الأصوات المفردة، ووزَّعوا الصوت بين معتلٍّ، ونصف معتلٍّ، وساكن، وقسّموا العلل قسمين: عللًا بسيطة وعللًا مركبة، وصنَّفوا السواكن بحسب مخارجها، وعرَّفوا الأصوات الانفجارية، وعرضوا لصوت العلّة الناتج عن تقارب الوترين أو تباعدهما.
وتحدّثوا عن المقطع، ووضعوا قواعد النبر فجعلوه في ثلاث درجات، وأولوا الدّرس النّحويّ عنايةً كبيرة، حتَّى إن الهند حوَتْ اثنتي عشرة مدرسة نحويّة ووجد فيها 300 مؤلف نحويّ.
و(بانيني) يمثل فترة النّضج في الدّرس اللّسانيّ في الهند، ذلك أنّه واضع كتاب (الأقسام الثمانية) الّذي ضمَّ جملة الآراء المتناقضة.
ويمكن للدارس أن يستخلص جملةٌ من السمات الّتي عرفها النحو الهندي، فقد عمل على جمع المادة العلميّة وتصنيفها ليصير إلى استخلاص القواعد النحوية منها، وقسّم الكلام إلى (اسم، وفعل، وحرف، وإضافة، وأدوات)، وبذلك يسبق النحو اليوناني في ذلك، وعرّف النحو الهندي قسمة الفعل إلى (ماض، وحاضر، و مستقبل) متكئًا على الزمن في ذلك، وحلّل الكلام إلى عناصر أساسية، وعرّف أقسام الاسم من جهة العدد فكان فيه الإفراد، والتثنية، والجمع.
وصرف النحاة الهنود همتهم إلى صنع معجمٍ يضمّ قوائم المفردات الغريبة المعنى في كتابهم المقدّس (الفيدا)، وهذا ما غدا يعرف ـ فيما بعد ـ بمعجم المعاني.
أما اليونانيون، فقد كان تفكيرهم ومناحيه يقعان تحت تأثّير الفلسفة الّتي كان لها السلطان الأكبر، وكان للدرس اللّغويّ تأثره الواضح في ذلك ، لذا كان درسهم اللّغويّ يطغى عليه التنظير دون التطبيق، واشرأبت نفوسهم إلى كشف حقيقة النظام اللّغويّ الإنساني وجذوره، فأفضى ذلك إلى تمظهر مفاهيمٍ وتصورات جمّةً كان لها أثرها في الدّرس اللّسانيّ المعاصر، وكانت بحوث أفلاطون (428 ق.م – 348 ق.م) وأرسطو (328 ق.م – 322 ق.م)، والمدرسة الرّواقية ومؤسسها (Zeno) في (300 ق.م) وهي أهم المدارس اللّسانيّة ـ بالمفهوم العامّ ـ في الدّرس اللّسانيّ القديم.
وكان هاجس التوصّل إلى الوقوف على جذور اللّغة الإنسانية أكثر جوانب الدّرس اللّسانيّ لديهم بروزًا، ولذلك عند تلمُّس إرهاصات الآراء في ذلك نقف على رأي (هيراقليط Heraclitus) الّذي يرى أنّ اللّغة إلهامٌ إلهي، هبط على الإنسان هبوطًا، فكان بعد ذلك أن تعلَّم وضع الأسماء للمسميات الّتي تحفّ به. وقد شاع هذا الرأي بين الأوربيين، وكان لهم في هذا المذهب ما أخبر به (سفر
التكوين) عن وضع آدم، عليه الصّلاة والسّلام، أسماء الكائنات الّتي يراها وتعيش معه على سطح الأرض، من طير وغيره.
أمّا الرّأي الثّاني في ذلك فكان رأي (ديموقريط Democritus) الّذي كان يعتقد أن نشأة اللّغة تعود إلى ابتداع المتحدثين بها واصطلاحهم، وارتجالهم ما يريدون التعبيرية من ألفاظٍ تحقِّق لهم التوصل بين بني جنسهم.
ويمكننا بشيءٍ من العلميّة أن نعدَّ درس اليونانيّين للّغة درسًا رياديًا بحقّ، إذ لم تقتصر جهودهم على البحث عن أمور (ميتافيزيفيّة) فحسب، كبحثهم عـن (نشأة اللّغة) والتردُّد بين القول بتوقيفيتها أو عرفيتها، بل أمعنوا في الدّرس اللّسانيّ، فبحثوا العلاقة الرّابطة بين الاسم ومسمَّاه، وبحثوا في أصل المفردات المنطوقة، وكان لأفلاطون قصب تقسيم الكلمة إلى اسم، فعل، وحرف، هذه القسمة الثلاثية الّتي نجدها في نحونا العربي القديم، وحدَّد جنس اللّفظ، وقسّمه إلى بسيطٍ ومركَّبٍ، وقال بالإعراب، ويعدّ أول من فرّق بين الأسماء، والأفعال، وقد أطال أفلاطون في تلبّثه في عرض النحو اليوناني وبسط معالمه، وقسّم الأصوات إلى معتلَّة، وساكنة مهموسة، وساكنة مجهورة.
والتقى (أرسطو Aristotle) مع أستاذه (أفلاطون Plato) على تقسيم الكلمة إلى اسم وفعل، وحرف وزاد على قسمة أستاذه قسمًا رابعًا هو (الرّابطة).
وكان لليونانيّين سُهْمة بل ريادة في صنع المعجم اللّغويّ ؛ فكان معجم (أبقراط 180 ق.م) أهم المعجمات، وكانت القرون الميلاديّة الأولى عصرًا ذهبيًّا للـتأليف المعجميّ.
ولكن السّمة الّتي انطبعت بها جهود اليّونانيين في الدّرس اللّغويّ إنّما هي «التأمل والنظر والتفكير المجرَّد غير المشفوع بملاحظة مباشرة»، ذلك أنّهم كانوا «كمن يدرس جذور شجرة خفيت في الأرض، وهو لا يرى إلّا الغصون». ولعلّ هذا عائدٌ إلى أنّهم عرضوا لدرس اللّغة وكانت اللّغة قد اكتملت، وبسطوا القول في نشأة اللّغة وهم لم يعايشوا هذه النشأة، وكلّ ما يمكننا الإشارة إليه ـ على الرغم من قدم الدراسات اللّغويّة لديهم- أنّها نظراتٌ عُمدتها الظن والرجم بالغيب، وليست درسًا علميًا يحكمه منهجٌ علميٌّ قائمٌ على ملاحظةٍ منظمّةٍ لما يُراد درسه من ظواهر، ثم عزلها وانتقاؤها وتحكيم مبضع الدرس فيها دون غيرها من الوقائع. وهذا ما يجعلنا نقف مع الدكتور علي عبد الواحد وافي ومن وافقه بالنظر إلى تلك الجهود على أنها ليست إلّا تخمينًا خياليًّا، وفرضًا عقيمًا، يحمل في طياته آية بطلانه، وليس على أنّها معالمُ نظريّةٍ لسانيّةٍ محكومةٍ بقيود البحث العلميّ.
أما الرومان فلم يكونوا ورثةً شرعيين للدرس اللّغويّ اليوناني، ولكن يمكن القول إنّ لهم أثرهم في دفع الحركة العلمية في الدّرس اللّسانيّ إلى الأمام، وتمظهر ذلك في دراساتهم الدلاليّة والبلاغيّة.
وكان للعرب جهودهم الّتي لا تخفى ولا ينكرها إلّا جاحد؛ فقد مرَّت دراساتهم بمراحل عدَّة حتى استوت على سوقها دراسةٌ تستند إلى أصول، فكانت المرحلة الأولى لصوقة بحماية القرآن الكريم من التحريف والتصحيف، وبُدِئ فيها بضبط النّصّ القرآنيّ ضبط إعجام، ثم ضبط إعراب فكان من أعلام هذا الدّرس أبو الأسود الدّؤلي (ت69 هـ)، ونصر بن عاصم اللّيثيّ (ت 89 هـ)، والخليل بـن أحمد الفراهيديّ (ت 175 هـ) صاحب معجم (العين)، فسيبويه (ت 180 هـ) صاحب (الكتاب)، وكلا الكتابين يمثلان أرقى ما وصل إليه البحث اللّغويّ في تلك المرحلة.
وقد أكدّ أستاذنا الدكتور غازي طليمات أنّ منهجهم يقتفي خطوات المنهج الوصفيّ، فهو يقوم على تحديد الزّمان، وهو ما قبل (150 هـ)، وتحديد مكان المادة المدروسة، وهي هنا البقعة الّتي تُدْرسُ لغتها، والمراد بها قلب الجزيرة العربيّة، ثم تحديد المستوى؛ ذلك أنّ «الوصفيين حينما رسموا للظاهرة المدروسة إطارًا تاريخيًا وإطارًا جغرافيًا قصدوا حصر المستوى اللّغويّ للظّاهرة»، ولذا
رمى نحاتنا إلى «اختيار المستوى اللّغويّ الفصيح، وانتباذ ما عداه من اللّهجات المضعوفة والكلام الملحون» .
ولدى عقده المقارنة بين المنهج العربيّ الوصفيّ والمنهج اليونانيّ خلص إلى نتيجةٍ مؤدَّاها أنّ فرقًا كبيرًا بين المنهجين، فبينما عوَّل اليونانيون على دراسة نشأة اللّغة، وهي قضيةٌ غيبيةٌ لا يُرْكن إلى نتيجة فيها، آثر النحاة اللّغويّون العرب دراسة اللّغة الحية الّتي تنطق بها مجتمعاتهم، ويعبَّر بها عن حيواتهم.
والمنهجان مختلفان في الغاية أيضًا، فقد رمى اليونانيّون إلى إخضاع اللّغة للمنطق وربطها بالفلسفة، وامتدّ أثر ذلك إلى النّحو التقليديّ في أوربة، فكانت الطّريقة الّتي انتهجها النّحو اليونانيّ هي طريقة النحو التقليديّ، أي النّحو المتشبّع بآراء أرسطو وعلاقته باللّغة اليونانيّة، وبما أنتجه الرّومان أيضًا = في حين أن منهج الدرس العربيّ هو الّذي سُمِّي في علم اللّغة الحديث المنهج الوصفي الّذي أصبح الطريق اللاحق في الدرس اللّغويّ الحديث.
فالذين يقرنون «الدراسات اللّغويّة العربيّة القديمة بالمنهج اليونانيّ يبخسون العرب حقّهم، ويحملون على ظهر المنهج العربيّ الوصفيّ أوزار المنهج التقليديّ الغربيّ». وليس أدلُّ على ما ذهب إليه أستاذنا ونؤيده فيه من قول علم من أعلام الدرس الوصفي العربي الحديث، وأعني به تمّام حسّان الّذي قال: «الاتصال المباشر
بالواقع اللّغويّ أصلٌ من أصول النحو الوصفي ... وقد كان أيضًا أصلًا من أصول النحو العربي نتيجةً لطبيعة الحياة العربيّة، ولطبيعة الحركة العلمية الّتي نشأت في مناخٍ عامٍ أساسه النقل والرواية. وقد أدَّى هذا الاتصال إلى أن يكون في النحو اتجاه وصفي في تناول كثير من ظواهر اللّغة».
وما إن أطلّ فجر القرن التاسع عشر على أوربا حتَّى بدأ علم اللّغة الحديث يشقُّ طريقه ويغدو القرن التاسع عشر المسرح الّذي تزدهر على خشبته الدراسات اللّغويّة وتتجه نحو النّضج، وكان ذلك كلّه بتأثير (وليام جونز William Jones) الّذي يعود إليه الفضل في اكتشاف اللّغة السنسكريتية، فشرع علم اللّغة يستقل من الحقل الأدبي بعد أن وجَّه السير (وليام جونز) كتابًا إلى الجمعية الآسيوية يخبرها فيه باكتشافه المشار إليه، فكان لهذا العلم ـ علم اللّغة ـ حقله المستقلّ وحدوده الخاصة به، فكان على «طلاب هذا العلم في القرون الّتي تلت أن يخلقوا لأنفسهم حدود مادته وطريقته».
لقد أدّى اكتشاف هذه اللّغة إلى وضع اليد على وشائج الصلة بينها وبين اليونانية واللاتينية، ودفع الدارسين إلى اصطناع مناهج في الدّرس اللّسانيّ، وهي مناهج تختلف في المنطلقات والتوجهات والغايات، وكانت على النحو الآتي:
اللّسانيّات المقارنة Comparative linguistics:
ويرمي هذا المنهج اللّسانيّ إلى وضع اليد على روابط الاتصال بين غير ما لغة مع شرط انتمائها إلى أسرة لغوية واحدة خلال عمر هذه اللغات.
إنّه منهجٌ عمدته «الموازنة بين الظواهر اللّغويّة في طائفة من اللغات لاستنباط خواصها المشتركة، وللوقوف على وجوه الاتفاق والخلاف في عواملها ونتائجها، وللوصول من وراء هذا كلّه إلى كشف القوانين الخاضعة لها في مختلف مظاهرها».
قسّم علماء اللّغة اللغات إلى فصيلتين رئيسيتين هي:
أ. الفصيلة السّامية الحاميّة.
ب. الفصيلة الهنديّة الأوربيّة.
أما الفصيلة الأولى فتشمل بلاد العرب وشمال إفريقيا، وبعض شرقي إفريقيا، أي في مساحة (20 مليون كم2)، وتشمل: الأكاديّة، والكنعانيّة، والعربيّة الجنوبيّة، والحبشيّة، والمصريّة، والكوشيّة، والبربرية. وأهم ما يميّز هذه المجموعة تماسك أجزاء منطقتها.
أما الفصيلة الثانية فتمتد رقعة الناطقين بها من الهند إلى أوربة، ولها من الفروع: الهندية، والإيرانية، والجرمانيّة، والرّومانيّة.
ويعمل هذا الفرع اللسانيّ على دراسة الأصوات، والبنى الصرفيّة، والمعجميّة، والتركيب النّحويّ.
وقد خلص العلماء الأوربيون من عقد المقارنة بين لغات
عدّةٍ تنحدر من هذه الفصيلة إلى اشتراكها في التراكيب الأساسية، والمفردات الأولية، والأصوات.
وإذا حاولنا أن نقف على جهود علمائنا العرب في ميدان المقارنة بين لغتهم العربيّة وغيرها من الساميات = وقفنا على إشارات واضحةٍ تُفصح عن إدراكهم حقيقة هذا الشبه ـ بل ربما يدفعنا ما نلمسه عندهم من رُؤى إلى القول بمعرفتهم أخوات العربيّة من الساميات، فأشار الخليل بن أحمد (ت 175 هـ) إلى أنّ الكنعانيين الذين ينتسبون إلى كنعان بن سام بن نوح، كانت اللّغة الّتي يتكلمونها تشابه العربيّة.
وصرَّح ابن حزم بأنَّ «مَنْ تدبَّر العربيّة والعبرانية والسريانية أيقن أنَّ اختلافها إنّما هو من تبديل ألفاظ الناس على طول الأزمان واختلاف البلدان، ومجاورة الأمم، وأنّها لغةٌ واحدةٌ في الأصل».
ولعمري! أيمكن أن يتفوَّه هذا الرجل بمثل ما تفوَّه به منذ ألف سنة إلّا إذا كان على وعي بأثر الزمن والبيئة والجوار في طبع اللغات بميسم التطوُّر والتحوُّل والانتقاء. ولعلّ ذلك يدفع إلى الإقرار بأنّ «المقارنة بين لغتين متحدّرتين من أصلٍ سامٍ أدلُّ على جدوى المنهج المقارن لقرب الأسرة السامية من أفهامنا».
وقد عرف الاستشراق أهميّة عقد المقارنة بين اللغات للوقوف على خصائصها الصوتية والتركيبيّة والدلاليّة، فولَّوا وجوههم شطر دراسة
الساميات، وسار الباحثون العرب على نهجهم وترسَّموا خطاهم، فوقفوا عن كثبٍ على أهم أوجه الشبه بين الساميات، أصواتًا، وجذورًا، وضمائر، وألفاظ عدد، واشتقاق أسماء .
يقوم منهجها على دراسة اللّغة في مظاهر تطوّرها التاريخي، مضافًا إليها الروافد الّتي تصبّ في مجراها التطوّري، من روافد اجتماعية، وأخرى ثقافية، وثالثة علمية، وهكذا دواليك.
ولمّا كان من وظائفه رصد حركة اللّغة وحياتها، أو حركة لغة ما بعينها وملامح تطوّرها وسم هذا المنهج بـ (علم اللّغة التاريخي Historical linguistics).
إنّه منهجٌ «يتتبع الظاهرة اللّغويّة في عصورٍ مختلفة، وأماكن متعدِّدة ليرى ما أصابها من التطوّر، محاولًا الوقوف على سرّ هذا التطوّر وقوانينه المختلفة».
وإذا كان المنهج الوصفيّ يدرس اللّغة في ثباتها زمنًا ومكانًا ومستوىً، فإن (اللّسانيّات التاريخية) تهتم بالدرس الطولاني للغة، وتدرس اللّغة في حركتها وحيويتها لا في ثباتها ـ ويكشف عن موضع اللّغة من الحياة وعناصرها الّتي تسم اللّغة بميسمها صوتًا ودلالة وتركيبًا، نحوًا وصرفًا، فصيحًا أو عامّيًّا. ولكنها
دراسةٌ لا تحتكم إلى قواعد معيارية، مع رصد العلاقة بين اللّغة والبيئة والمجتمع.
وتتعدّد ميادين دراسة (اللّسانيّات التاريخية)، ومن ذلك: الانتشار اللهجي، وتحوُّل لغة ما إلى العالمية، وتحوُّل لهجةٍ ما إلى لغةٍ رسمية، والتطوّر الصوتي للغة ما، وتطوّر الصيغ الصرفيّة لإحدى اللغات، والتحوّل الدلالي لألفاظ لغة، كأن يدرس التغييرات الدلالية لألفاظ جاهلية واكتسابها دلالات جديدة في ظل الإسلام .
ولعلَّ من أهم ما يعود به هذا المنهج من عائدةٍ على اللّغة أنه قد يصنع مَنْ يترسَّمون خطواته أطالس لغوية تبيِّن تطوّر الألفاظ لفظًا ودلالة، وتأثّرًا بما يمرّ بها من عوامل اجتماعيةٍ وغير ذلك، على نحو ما ألمحت من قبل إلى دراسة التطوّر الدلالي لبعض الألفاظ بين الجاهلية والإسلام.
واللّسانيّات التاريخية هي الّتي تعرض لبدايات وجود صيغةٍ لفظيةٍ وتحوُّلاتها بين الحقول الدلالية امتثالًا لعوامل البيئة الزمانية والمكانية، وكذلك يمكن للّسانيّات التاريخية دراسة الانحرافات الصوتية وتطوّرها سواء أكانت على صعيد الانعزال أم على صعيد التركيب. و «من واجب المنهج التاريخي يحدد هذه الانحرافات تحديدًا زمنيًا ومكانيًا) . «وأن يبحث كذلك عن أسبابها، ويعمل على كشف العوامل الّتي أدّت إليها».
عمدة هذا المنهج دراسة «لغتين أو لهجتين، أو مستويين من الكلام بالدرس العلمي للوصول إلى الفروق الموضوعية بين الطرفين اللذين تبنى عليهما الدراسة)) .
وليس من وُكد هذا المنهج أن يدرس لغتين تعودان إلى أرومة واحدة، فقد يدرس مثلًا لغة تنتمي إلى السامية وأخرى تنتمي إلى السلافية، كأن يدرس خصائص الإفراد والتثنية بينهما، أو كأن يدرس صيغة البناء للمجهول في العربيّة وهذه الصيغة في الفرنسية أو الإنكليزية، وتعود نشأة هذا المنهج إلى تذليل الصعوبات الّتي يواجهها متعلم اللّغة الثانية، كالإنكليزي الّذي يريد أن يدرس العربيّة، فيجري درسًا تقابليًّا بين الخصائص الصوتيّة، والصرفيّة، والتركيبيّة بينهما، ولذلك توضع النتائج الّتي يمكن أن تتمخَّض عن الدّراسة التّقابليّة في خدمة فرعٍ من فروع اللّسانيّات يدعى (اللّسانيّات التطبيقيَّة) لتيسير أمر تعلّم لغةٍ ثانيةٍ لغيرِ الناطقين بها.
يعدُّ هذا المنهج أكثر المناهج اللسانيّة شهرةً، وتعدُّد مدارس، وعدد دارسين، واتساعَ زمان، وتخصيص درس، وتحديد أصول، ذلك أنه منهج ضرب صفحًا عن مناهج الدراسات السابقة الّتي كان من وكدها الأصل الميتافيزيقي للغة أصلًا ونشأة، أما المقابلة بين لغتين أو لهجتين، أو المقارنة بينهما في مستويين أو أكثر، وجعل اللّسانيّون الوصفيّون جهودهم منصبّةً على توصيف اللّغة الّتي يتواصل بها القوم
لا أن ينكفئوا إلى الماضي ينقّبون في دهاليز التاريخ عن اللّغة ونشأتها، وكان أن أسسوا منهجهم على ثلاث ركائز هي:
1 – تحديد البيئة الاجتماعية.
2 – تحديد المجال الزمني للغة المدروسة.
3 – تحديد المجال المكاني.
ولا ينطلق هذا المنهج من أيِّ موقفٍ معياري؛ ذلك أنه «يفرِّق بين ما هو علمي وما هو تعليمي، فالدرس العلمي يتوسَّل بالمنهج الوصفي أساسًا، على حين أنّ الدرس التعليمي هو الّذي يحتكم دومًا إلى قواعد الخطأ والصواب».
ولعلّنا نستذكر ما قد سبق أن مررنا به من جهود اللّغويّين والنحاة العرب الذين حدّدوا زمان اللّغة الّتي يدرسونها، وهذا القيد «يقيد بداية المادة المدروسة ونهايتها بفترةٍ زمنيةٍ معينةٍ لسببٍ معروف، وهو أنّ الظواهر اللّغويّة دائمة التغيّر، فإذا لم يحدّد الزمان أدرك التغيُّر الظاهرة قبل أن تبلغ الدراسة غايتها».
وكذلك فعلوا بالنسبة إلى المكان؛ ذلك أنّ اللّغة لا تكون إلّا في مكانٍ يؤطّرها، فليست تعيش وتنمو في فراغ، فلا يجوز إطلاق الفسحة المكانية للغة المدروسة في الاتجاهات كافة، لأن ذلك يعيق الإمساك بأطراف الموضوع (اللّغة) المدروسة، ويدخل فيها اللهجة في اللهجة، والبيئة في البيئة، والمستوى بالمستوى.
فإذا كانت الدراسات اللّغويّة القديمة تنتهج سبيل الدرس القائم على ثنائية الصواب والخطأ، والرفض والقبول، فأساس الدرس الوصفي وصف اللّغة ودراسة عناصرها المختلفة المكوِّنة لها بدءًا من الصوت مرورًا بالبنية وانتهاءً بالتركيب، وهو يعتمد على «الاتصال الناجح بين عالم اللّسانيّات ومتكلِّم اللّغة» ، فهو يقتصر على تسجيل ما يسمعه ووصفه وصفًا دقيقًا من غير أن يخضعه لحكمٍ معياريٍّ من صوابٍ أو خطأ.
وهو لا يقتصر على دراسة اللّغة القوميّة بل أفسح للهجة مكانًا واسعًا، إذ ليس للهجة ما للغة القوميّة من الاتساع، ولعلَّ هذا ما دفع اللّسانيّ (أنطوان ماييه Antoine Meillet) إلى النّظر إلى المنهج الوصفيّ أنّه إنّما يختص بدراسة استعمال شخص ما اللّغة في مكان وزمان معينين.
وإذا كانت الصبغة الّتي سيطرت على الدّرس اللّسانيّ في القرن التاسع عشر هي السّمة التاريخيّة، ودرست اللّغة من ناحيةٍ تاريخيةٍ اللّغة ومراحل تطورها، والاهتمام بالمذهب الميكانيكي الفلسفي، وهذا ما جعل اللّغة علمًا مستقلًا = فإنَّ المنهج الوصفي هو الابن الشرعيّ للقرن العشرين، وفي ذلك يقول (فيرث Firth): «ويزداد استحقاق علم اللّغة الوصفي لمكانته باعتباره مجموعةً مستقلةً من المواد المترابطة كالأصوات، والتشكيل، والجراماطيقا، والمعجم، والدلالات، وما يمكن أن يسمَّى علم الاجتماع اللّغويّ»
ولكن المنهج الوصفيّ لم يبق على سمت واحد، ولم يركن إلى أصول ثابتة لا يحيد عنها، بل انشعب هو نفسه إلى مدارس واتجاهات لها أصولها، ولها أعلامها، وهي على الرغم من ذلك لم تخرج عن طريق الوصفية، ولم تخلع عنها عباءة المنهج الوصفي، فحسب كلّ مدرسة أن ترمي سابقتها بشيء من النقد، وتحوِّر بعض المفاهيم والمبادئ لتشكّل مدرسةً جديدة.
وقد وجدت الوصفيّة سبيلها إلى الدّرس اللّسانيّ العربي، وعمد الوصفيّون العرب إلى نقد الدّرس النّحويّ العربيّ كما فعل الوصفيّون الغربيّون بالنسبة إلى أنحائهم، فمن هذه النقدات اعتقادهم بتأثر النّحو العربيّ بالنّحو الأرسطيّ، وميله إلى التعليل والتأويل والتقدير، وبذلك يكون نَحونا العربيّ قد نأى عن الاستعمال الواقعي للّغة.
ومن ذلك أنَّه نحوٌ قعَّد لِلغةٍ نموذجيةٍ لا للغة الاستعمال، فلم «يوسّع درسه ليشمل اللغة التي يستعملها الناس في شؤون الحياة، وإنّما قصره على اللغة الأدبيّة ... مما أبعدهم عن الاستعمال الشائع في هذه اللغة»
يضاف إلى ذلك تحديد بيئةٍ زمانيةٍ للّغة المنتقاة، وعدم وضع حدودٍ معيّنة للتحليل اللّغويّ ومستوياته، فجاءت تلك التحليلات متعددة المستويات.
وهذه النقدات ـ على ما هو واضح ـ لا تخرج عن سمت ما نقد الوصفيون الغربيون به نحوهم التقليديّ، فأفضى بهم هذا إلى السعي
إلى الاستعاضة عن الأسس الدّرسيّة القديمة بأسسٍ جديدة تجلَّت في المنهج الوصفي، حتى إنهم ذهبوا إلى الاعتقاد بأنّ «أيَّ نهضةٍ منشودةٍ في مجال الدراسات اللغوية العربية، بحسب الوصفيين، تبقى رهينةً بتطبيق هذا المنهج على اللغة العربية».
*تجليات المنهج الوصفي عند اللسانيين العرب المحدثين:
وقد تمثَّل هذا الاتجاه الوصفيّ، في الدّرس اللّسانيّ العربيّ في عددٍ من الدّارسين المحدثين، نذكر منهم: (إبراهيم أنيس)، و(عبد الرحمن أيّوب)، و(تمّام حسّان)؛ وكان هذا الأخير أكثرهم إخلاصًا لهذا التوجه اللّسانيّ وتمثيلًا له من خلال أهم أثرين له، هما: (اللغة بين المعياريّة والوصفيّة)، و: (اللغة العربية: معناها ومبناها).
فقد كتب تمّام حسّان يقول: «إنّ الدّراسات اللغوية الحديثة تجعل اللّغة موضوعًا للوصف، وتستخدم الموضوعيّة التّامة لهذا الوصف».
وقد وجَّه تمّام حسّان -كما فعل سابقوه- نقده إلى الدّرس النّحوي العربيّ، ورأى أنّ ثمّة خللًا في تقسيم القدّماء للكَلِم، ودعا إلى تقسيم جديد، «يندرج ضمن مشروعٍ طَموحٍ لوصف ظواهر اللّغة العربيّة ومستوياتها».
ودعا (تمّام حسّان) إلى ضرورة «بناء الدّراسات اللّغويّة على
منهج له فلسفته وتجاربه، إرضاءً للرّوح العلميّة الخالصة من جهة، وتوفيرًا لجهود عشاق اللّغة من جهةٍ أخرى، فقارئ اللّغة العربية أمام أمشاج من الأفكار غير المتناسبة ... ومن هنا كانت الرغبة ملحّةً إلى تخليص منهج اللغة من هذه العدوى، حتى يسلم لقارئ اللّغة نصٌّ في اللّغة، واللّغة فحسب غير معتمدٍ على أسسٍ من خارجها».
وهذا القول صدًى لِمَا قال به (سوسور) بأنَّ اللّغة تُدْرَس لذاتها ومن أجل ذاتها، وليس من هدف للدّرس اللّغوي إلّا تبيان العناصر المؤلفة لّلغة المدروسة. وبذلك يعبّر اللّغويّون العرب ـ لا عن انتماء صريح إلى الدّرس اللّسانيّ الوصفيّ، وتبني دعوته الرّامية إلى استقلال الدّرس اللّغويّ عن غيره من الدراسات، «ومن ثَمَّ يكون ما وجهه هؤلاء الوصفيّون العرب إلى نحونا العربيّ من نقد وما ألقوا على منهجه من لوم» نابعًا من رغبتهم في الانتماء إلى علم اللّغة الوصفيّ بالدرجة الأولى.
(41)
(43)
أما أهم تيارات الدّرس اللّسانيّ الوصفيّ فهي:
1. البنيوية: واضع حجر أساسها (فرديناند دو سوسور Ferdinand de Saussure) اللّغويّ السويسري الّذي كان أهم مفاصل الدّرس اللّسانيّ في القرن العشرين، وجاءت بنيويّته ردّة فعلٍ على المنهج التاريخي الّذي بسط جناحيه على الدّرس اللّسانيّ في القرن التاسع عشر.
يعرِّف (Louis Hislmeslev) (ت1965م) البنيوية بأنّها «مجموعةٌ من البحوث الّتي تقوم على عللٍ فرضيةٍ يكون من المشروط علميًا طبقًا لها أن توصِّف اللّغة واعتبارها جوهرًا وكيانًا مستقلًا من العلاقات الداخلية».
وإذا كان أكثر الدارسين يجعلون مـن (سوسور) الأب الحقيقي للّسانيّات البنيويـة، فإن (جاكوبسون) أرجعها إلى (شارل بيرس Charles Sanders Peirce) (1839-1941 م) وإنّ (جون ليونز John Lyons) ذهب إلى «أنّ المذهب البنيوي كان الصيحة الّتي جمعت بين مدارس مختلفة في علم اللّغة في القرن العشرين، أي إنّ ما جدَّ من مدارس لسانيّةٍ حديثةٍ راجعةٌ إلى البنيوية بطريقة أو بأخرى؛ ذلك أنّها ترى اللّغة نظامًا من الأصوات تتركّب وفق طريقةٍ عرفيّةٍ لتغدو بنى صرفية تنتظم في خطٍّ نظميٍّ دالٍّ على معانٍ».
وقد تمظهر المنهج الوصفي في جهود (سوسور) اللسانية في مظاهر عدة، منها: تحديد مادة الدّرس اللّسانيّ، والانتقال من العموم إلى الخصوص، والفصل بين الكلام واللّسان، أي بين الكلام الفرديّ والمنطوق الفعليّ للمتكلم، وبين ما تواضع عليه المجتمع اللّغويّ من إشارات ومواصفات هي مطية أفراد هذا المجتمع في التواصل اللّغويّ. وقد سبق لنا أن وقفنا وقفات مطوّلة عند أهم مفاهيم الّتي طرحها (سوسور) وأصبحت مَعْلم تفكيره اللّسانيّ.
إنّ اللّغة عنده «نظامٌ من العناصر المترابطة، تشترك في بنائه الأصوات، والمفردات، والتراكيب... ولهذا فاللّغة عنده شكلٌ لا مادة، وهذا الشكل هو الجدير بالدراسة الوصفية، والدراسة الوصفية للأنظمة اللّغويّة الشكلية أساسية علم اللّغة عنده، وعند مَنْ بنى على نظريته البنيوية». ويتّجه التحليل البنيوي من المركب إلى البسيط، من الجملة إلى مفرداتها، «ومن الكلمات إلى العناصر الصوتية الّتي تتألف منها كلّ كلمة».
وليس من بأسٍ في أن نقتبس خطاطةٌ نحلِّل بها جملةً على المنهج البنيوي، إذ ينتقل التحليل ـ كما سنرى ـ من الجملة إلى عناصرها المكونة لها.
وقـد تبنّى عددٌ من اللّسانيّين مبادئ البنيوية وأهدافها، واقتفوا
آثار مؤسسها، ومن هؤلاء (فرانز بواز Franz Boas )، و(إدوارد سابير Edward Sapir )، وهو أحد تلاميذ (بواز)، ثم (بلومفيلد Leonard Bloomfield)، صاحب كتاب (اللّغة) الّذي نشر سنة 1923، فكانت له الهيمنة على ساحة الدّرس اللّسانيّ ثلاثة عقود، واشتهر بأنّ «عالم اللّغة عينٌ ترصد ما يجري، ولهذا فعليه أن يقصر عمله على مراقبة الظواهر اللّغويّة الخارجية الّتي تقبل القياس»، ثم إن ما يجب على العالم اللّغويّ أن يغلب اعتناءه بأصوات البنى اللّغويّة (المفردات) على احتفاله بدلالاتها، «ونحن، مهما تبلغ بنا محاباة البنيويين، لا نستطيع أن ننسى أن اللّغة وعاء الفكر، وأنّ تحليل المبنى لا يغني عن دراسة المعنى».
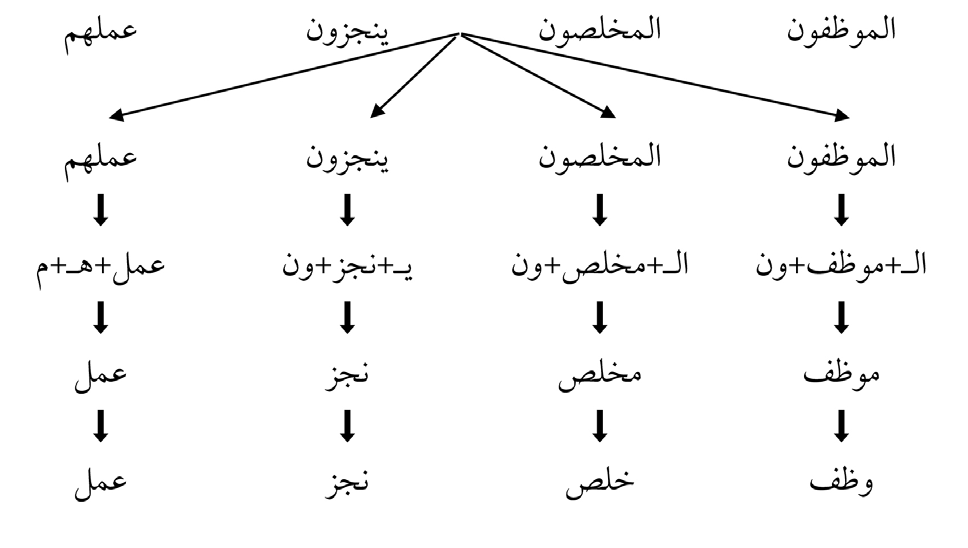
2. الوظيفية: هذا الاتجاه من الدّرس اللّسانيّ يجعل وكده في التواشج بين النظام اللّغويّ وسبل استخدامه وبين المقاصد المبتغاة
من وراء ذلك؛ أي إنَّ دراسة اللّغة عند أصحاب هذا الاتجاه هي دراسة الوظيفة التواصليَّة في الجماعة اللّغويّة.
لقد كانت نقطة انبثاق هذا الاتجاه اللّسانيّ على يد (أندريه مارتينيه André Martinet) هي الدراسات الّتي ركّزت على دراسة الظواهر الصوتية المنضوية تحت الدرس الفونولوجي وصاحبه (نيكولاي تروبتسكوي Nikolai Trubetzkoy) والمطوّر على يد كلٍّ من (رومان جاكوبسون Roman Jakobson) و(أندريه مارتينيه)، وحلقة (براغ) الّتي رأت النور اتجاهًا في الدّرس اللّسانيّ سنة (1928)، وجوهر هذه المدرسة أمران:
أ – المعنى.
ب – الوظيفة.
أمَّا أهم مبادئها فهو:
1. الكشف عن المقاطع الصّوتيّة ذات الوظيفة في بنية التركيب.
2. كشف الوحدات الصّوتيّة المفضية إلى تبدّلات دلالية.
3. اختيار المتكلم نظامًا لغويًّا مقصودًا يُوجِد سياقًا لغويًّا ذا وظائف محدّدة.
4. تعدّد الخيارات في بنى التركيب لا يعني ترادفها، فلكلّ بنية منها بؤرة تركيز ما.
5. ارتباط اللّغة بالمجتمع ارتباطًا يشمل تراثه، وتقاليده، وثقافته
وهذا يُخضع متكلم اللّغة لمسلكٍ معيّن، ذلك أنّ المنطوق اللّفظي تعبيرٌ عن بنية المجتمع الّذي يعيش (المتكلم) بين ظهرانيه.
6. لا تنتج وظيفة اللّغة عن عنصر لغويّ منعزل، بل على مجموع البُنى.
7. وجوب إحصاء الوحدات اللّغويّة المكونة للتركيب، ثم سَلْكها في ترتيب بحسب علاقات التشابه والاختلاف.
8. لكلّ عنصر مكوناته الصوتية الّتي تختلف صفةً ومخرجًا، ومن ثَمَّ تؤدي إلى اختلاف دلالي، مثال ذلك قولنا: (عاد) (ســاد) فكلّ من اللّفظين يشكّلان صيغةً مشابهةً للأخرى، ويتشابهان في مقطعين، ويتخالفان في المقطع الأوّل من كلّ منهما (ع / س)، ومن ثَمَّ لكلّ منهما معنى منفرد.
9. التقطيع المزدوج والتقطيع الأوَّلي والقطع الثانوي، وهذا ما أعطى هذا الاتجاه اللساني أهميةً، وهذا التقطيع هو الفيصل بين منظومة التواصل الإنساني من سبل التواصل غير المنطوقة (كالإشارات، ولغة الحيوان) ويعني التقطيع المزدوج أن تُحلَّل العناصر اللّغويّة في التركيب على مستويين:
1. مستوى التقطيع الأوّلي، يعتمد على تحليل الجملة إلى المورفيمات = الكلمات الأساسية المكونة لها، كما في قولنا:
أنشأ المهندس مبنى الجامعة.
أنشأ + الـ + مهندس + مبنى + الـ + جامعة.
2. مستوى التقطيع الثانوي: عمدته تحليل العناصر السابقة إلى أصغر بنى صوتيةٍ لها مجردة من المعنى. وهذا النوع من التحليل يعود بالفائدة على اللّغة إذ يعطيها قدرة تعبيرٍ غير متناهٍ عن الأفكار والمعاني المجرَّدة.
يمثل (أندريه مارتينيه André Martinet) أهم أقطاب هذه المدرسة، وصاحب الفضل الكبير في تطوّر الدّرس اللّسانيّ، وكان من أتباع هذه المدرسة بل من أعلامها: (إميل بنفنيست ةmile Benveniste)، و(جورج غوغينهايم Georges Gougenheim)، و(لوسيان تنيير Lucien Tesnière)، و(غوستاف غِيّوم Gustave Guillaume).
تحذو هذه المدرسة حذو (سوسور) وتترسَّم خطواته، فتجعل وكدها في الوظيفة التواصلية الّتي تؤديها اللّغة في المجتمع، وتتفحَّص ما تخلّفه التراكيب في متلقيها.
لقد صبَّ (مارتينيه) جهده على المحاور البحثية الثلاثة الآتية:
1 – الصّوتية العامّة والوصفيّة.
2 – الصّوتية التزامنيّة.
3 – اللّسانيّات العامّة.
من مؤلفاته الّتي تفصح عن جهوده في الدّرس اللّسانيّ كتابة «التصويتيّة من حيث كونها صوتيّة وظيفيّة»، ثم كتابة «دينامية اللّغة ووظيفتها».
وهو يجعل بؤرة التحليل اللّسانيّ دراسة الطابع الوظيفيّ، فالتصويتيّة هي الّتي تفسِّر الوقائع الصوتيّة الّتي يتألف منها الواقع اللّسانيّ الّذي يدرسه اللّسانيّون، وبالتركيز على التصويتية تتبيَّن الاختلافات الصوتية وإسهامها الوظيفي في تشكيل البنية وأداء الدّلالة.
وقد ظهر عند (مارتينيه) مصطلح «الصوتية التزامنيّة»، ومراده به عدم الاكتفاء أو الاقتصار على توصيف الصوت توصيفًا آليًا مجرَّدًا، ذلك أنّ الصوت مفتوحٌ ماديٌّ، ولا بدَّ من رصد التطورات الصوتيّة وتبيان ما ينجم عن ذلك من إجراء تبادليةٍ بين الأصوات، أو تنحية أحدها وإحلال آخر، وأثر ذلك كله في تفسير الوقائع الصوتيّة، وبيان أسبابها وآليتها، وبيان الأسباب الكامنة وراء ذلك، فـ (مارتينيه) يسعى إلى رصد السيرورة التطوّرية للغة بالاعتماد على العوامل اللّغويّة الراسخة، ومن هنا يرى وجوب «إقامة تواصل والمحافظة عليه، وتلبية حاجات تواصلٍ جديدةٍ هي أصلًا موجودة تزمنيًا وتزامنيًا».
كان مارتينيه صدى لآراء (تروبتسكوي) فقد كان تأثير هذا الأخير واضحًا فيه، ومع ذلك سعى (مارتينيه) إلى تجاوز أستاذه بتطوير بنية الإسناد في الجملة بالاتكاء على المبادئ والأصول الوظيفية لـ (تروبتسكوي)، وعمل كذلك على تطوير تصنيف (سابير) الّذي يفصل اللّغة إلى لوائح صوتيةٍ، ونماذج تنغيميةٍ، وبنى صرفيّةٍ، ونحويّةٍ، ومعجميّة.
إنّ (مارتينيه) يرى أنَّ المشـكلة الأسـاسية ليسـت فـي (البنيـة) أو (الشكل)، ولكنها في (الوظيفة)، وأنَّ التعقيدات اللّغويّة لا يصح أن تعاد إلى (مبدأ واحد)، من قبيل القول: هذه لغةٌ انعزالية، أو أخرى لاصقة، وثالثة إعرابية، وأنَّ أهم وظيفة يضطلع بها اللّغويّ أن يدرس اللّغة دراسةٌ وظيفيةٌ، ولا سيما في العملية التواصليّة، ولا يجوز الاقتصار على النظر إلى اللّغة على أنّها أشكالٌ فحسب.
ومن أتباع هذه المدرسة: (إميل بنفنيست ةmile Benveniste) (1902-1976م)، و(جورج غوغينهايم Georges Gougenheim) (1900-1972م)، و(لوسيان تنيير Lucien Tesnière) (1893-1954م)، و(غوستاف غِيّوم Gustave Guillaume) (1883-1960م).
إنَّ عمدة منهج (مارتينيه) ... فحوى الكلام الّذي يستحيل إيجازه، وقد دعا لذلك إلى ضرورة إيجاده بوساطة ما سمَّاه (أداة التحصيل)، وما عدا ذلك معدود عنده في الملحقات.
يُبين مارتينيه ذلك في قوله: «ويقودنا ذلك إلى أن أصغر قولٍ لا بدَّ أن يشتمل على عنصرين يشير أحدهما إلى مضمون الآخر أو حدث، ويشدّ الانتباه إليه ونسميه المسند، ويشد الآخر إلى مشارك إيجابي أو سلبيِّ ونسميه المسند إليه، ويكون تقويم دوره على هذا الأساس».
فهو يرى أنَّ أصغر وحدةٍ ذات دلالةٍ تامةٍ هي الجملة المكوّنة من عنصرٍ مركزيٍّ هو (المحمول = المسند)، وهو الّذي يشكّل بؤرة الدلالة، أما المسند إليه فهو الّذي يسمّيه (أداة التحصيل) ومراده بذلك (المسند إليه) ـ الفاعل، وموقعه صدر الجملة، ولا دلالة للجملة إلّا بالمسند إليه، لذلك يرى ضرورة وجوده ولا يجيز حذف، ولا يجيز حذفه المسند أيضًا. ويكون التمييز بين المسند إليه والملحقات عن طريق الموقعيّة للعنصر اللّغويّ.
ولنمثّل على ذلك بجملةٍ هي:
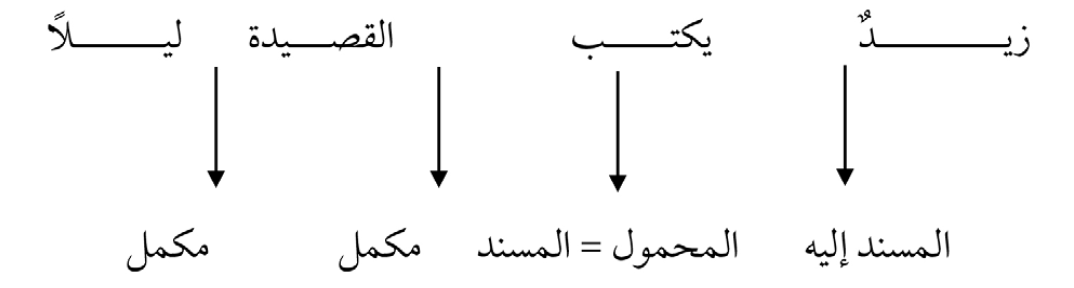
فلا وجود للجملة هذه بغير (الموضوع والمحمول = المسند إليه والمسند)؛ أي إنَّ بؤرة الاهتمام وهي (المسند = الخبر)؛ لأنَّه مدلولٌ يُراد إلصاقه بالمسند إليه (زيـد).
وخرج اللّسانيّ الوصفي (تنيير) على وظيفية (مارتينيه) بجعله (المسند = الفعل = الخبر) هو المحور في التركيب، أما (المسند إليه = الفاعل = المبتدأ) فيقعان في مستوى واحدٍ في التركيب، والمفعول به فهو (معمم، متمّم) وهو المحدِّد.
وشُهِر عن هذا اللّسانيّ الوصفيّ نمطه في تحليل الجملة ودُعي بـ (طوق تنيير)، فإذا كان لدينا جملة مثل:
(52)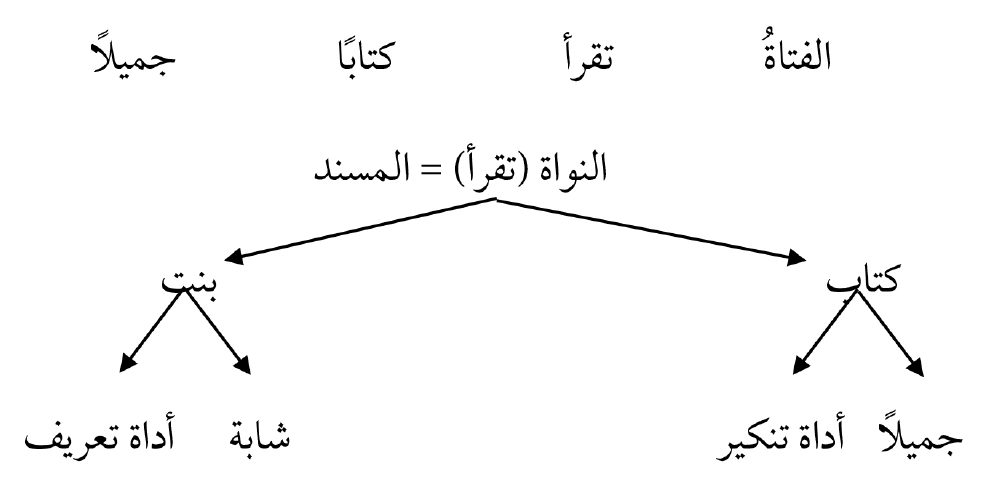
فالفعل = تقرأ هو النواة (المحدِّد)
بنت + كتابًا = نواتان من الدرجة الثانية
الصّفة + الأداة = تتبعان الاسم (بنت).
(شابّة + الـ)
الصّفة (جميل + تنكير = تتبعان الاسم (الكتاب).
وهذا يعني أنّ بنية التركيب عند (تنيير) تتراءى من خلال تسلسل متتالٍ اسم الحدث (الفعل)، وتغيير العلاقات بين العناصر اللّغويّة يسميه (تنيير) إدماجًا.
ووجد إلى جانب ما تقدّم اتجاهاتٌ وصفيةٌ أخرى متعدِّدة، وكان لها أعلامٌ أرسوا معالمها ووضعوا أصولها، ومن ذلك (اللّسانيّات السّياقيّة) ومؤسسها (جون فيرث John Rupert Firth) (1890-1960م)، وتقوم نظريته على «إعادة الاهتمام بالأحوال والمحيط الّذي يتضمَّن الأحداث الكلامية)؛ إذ إنَّ هذا الاتجاه اللّسانيّ
ينظر إلى أنّ اللّغة ليست أقوالًا فحسب، بل هي أفعالٌ تحتوي الحدث الكلامي، والقضايا الماديّة المحيطة بالنّصِّ المنطوق أو المكتوب».
ولا يمكن للدّارس اللّسانيّ ـ وفق مقولات (فيرث) ـ أنْ يعرف ما يرشح عن التعبير من دلالات من دون الوقوف على «الأنماط الحياتيّة للجماعة المتكلِّمة، وكذا الحياة الثقافية والعاطفية والعلاقات الّتي تؤلف بين الأفراد داخل المجتمع»، ولعلَّ هذا ترجمة حقيقية لِما يدُعى لدينا بـ (المقام)، فإنّ لكلّ مقامٍ مقالًا.
ومن ذلك أيضًا: اللّسانيّات التوزيعيّة، وأبرز أعلامها فرانز بواز (Franz Boas 1858-1942م)، وإدوارد سابير (Edward Sapir 1884-1939م)، وليونارد بلومفيلد (Leonard Bloomfield 1887-1949م)، ونشوء هذا الاتجاه في الدرس الأمريكيّ عائد إلى ارتباطه بـ (الأنثروبولوجيا)؛ «لأنّ المؤسسين الأوائل اعتمدوا في وصف لغات المجتمعات الّتي قاموا بدراستها وتحليل لغاتها على مناهج الأنثروبولوجيين».
ويضاف إلى ذلك تأثّر أقطاب هذا الاتجاه بالمذهب السّلوكيّ، ذلك أنّهم كانوا يعدّون اللّغة عادات سلوكية، لذلك كان محور تركيزهم هو (اللّغة المنطوقة)؛ أي لغة الحديث، ومن ثمَّ رأوا أن تَتعلَّم لغة الحديث، يليها تعلُّم لغة الكتابة. وكان كتاب (اللّغة = Language) لـ (بلومفيلد) أكثر أثرًا من غيره في بلْورة هذا الاتجاه من الدّرس اللّسانيّ في أمريكا.
والهدف النهائي للتحليل التوزيعي الكشف عن البناء المتسلسل للتركيب اللّغويّ؛ ذلك أن الوقوف على هذا البناء يفضي إلى إمكانيّة إجراء التعويض في المواضع السابقة الّتي احتلتها المفردات فيه من غير التعرّض للمكونات الأساسية المشكلة له، فلو ضربنا مثلًا الجملة الآتية:
الرّياضيون يلعبون كرة الطّائرة
فهذه الجملة مكوّنة من عنصر رئيسي هو (المسند إليه = الرّياضيون) و (الخبر = يلعبون) والمتممات (كرة الطّائرة). فـ (الرّياضيون) مكوّن رئيس و(يلعبون كرة الطّائرة) مكوّن رئيس.
ولدى تحليل العناصر تكون الصورة على النحو الآتي:
الأولاد = مكوّنٌ مباشر.
يلعبون = مكوّنٌ مباشر.
كرة الطائرة = مكوّنٌ مباشر.
ثم يجري تحليل هذه المكوِّنات إلى مكوناتها النهائية الّتي لا يمكن تحليلها، فتكون على النحو الآتي:
الرياضيون = الـ + رياضي + ون
يلعبون = يلعب + ون
كرة الطائرة = كرة
الطائرة = الـ + طائرة + ة
وقد تتلمذ على بلومفيلد (ت 1949 م) عددٌ من الباحثين الذين
أصبح لهم فيما بعد مكانتهم المرموقة في الدّرس اللّسانيّ، ومنهم:
1. برنارد بلوك (Bernard Bloch) (1906-1965م).
2. زيليغ هاريس (Zellig Harris) (1909-1992م)
3. شارل هوكيت (Charles F. Hockett) (1916-2000م).
4. أوجين نيدا (Eugene Nida) (1914-2011م).
وكانّ لـ (هاريس Harris) فضل تمثيل البنيويّة الأمريكيّة بمظاهرها كلها، فقد وضع كتابه (مناهج اللّسانيّات البنيوية Methods in Structural Linguistics) سنة 1951 م، وفيه وضع الأسس النظرية والإجرائية للدرس اللّسانيّ في أمريكا، ومن عباءته خرج الاتجاه التوليدي التحويلي على يد (تشومسكي) كما سنرى.
وكأن هاريس قد لحظ بعض النقائص في التحليل التّوزيعيّ (البلومفيلديّ) فسعى إلى وضع أسّس معالم منهجٍ بنيويٍّ عُمْدته وصف اللّغة في ظلّ العلاقات التوزيعيّة، فعمد إلى فكرة التّحويل
الّتي تبلورت أكثر فأكثر بعد عام 1952 في مقالٍ له بعنوان: (البنى الرياضية)، فغدا التوزيع لديه مرادًا به:
1 – جملة الأسيقة الّتي يرد فيها مكون لغوي ما.
2 – تبيُّن أثر هذه الأسيقة في المكون اللّغويّ.
3 – الاتكاء على الدلالة إلى جانب مقياس التوزيع في سبيل ضبط المكونات الصوتية والفونولوجيّة والتركيبيّة.
4 –التفريق بين معاني العناصر اللّغويّة هو السبيل إلى التفريق بين الفونيمات.
5 – قسمة التركيب (الجملة) إلى:
أ – الجملة النّواة.
ب – الجملة المحوَّلة.
فاللغات عامةً تتشابه في مستوى الجمل المحوَّلة، ولكن الخلاف إنّما يقع في الجمل النَّواة.
وقد كان لتطوير (هاريس) لمفهومي (الجملة النواة والجملة المحوَّلة) أثره البيِّن في انبثاق مدرسة (النحو التوليدي والتحويلي)، فقد تلقَّف تلميذه (نوم تشومسكي) هذين المفهومين وبنى عليهما نظريّته تلك، فغدا بذلك نقطة الفصل بين منهجي الدّرس اللّسانيّ الوصفيين في كلّ من أمريكا وأوربة.
ذكرنا من قبل أنّ (تشومسكي) المولود سنة (1928م) ومذهبه اللّسانيّ قد خرجا من عباءة (هاريس Harris)، إذ كان لهذا الأخير أثرٌ كبيرٌ فيه، ذلك أنَّ (تشومسكي) وجَّه نقدًا لكتاب (Burrhus Frederic Skinner) وعنوانه: (السّلوك اللّفظيّ Verbal Behavior) الصادر عام 1957م، وهو بهذا يحمل على المذهب السلوكي في الدرس اللّغويّ الّذي وضع أسسه (بلومفيلد).
لقد تراءى لـِ (تشومسكي) بعد محاولاته تطبيق المنهج التوزيعي في دراساته عدم جدوى هذا المنهج في دراسة الجمل
لعدم اهتمامها بالدلالة، ولعدم تطبيقها على أنواع الجمل كافة أو على الأجزاء الرئيسيّة منها، ذلك أنّها تعجز عن تفسير العلاقات بين الجمل ذات المعنى الواحد مع اختلاف تراكيبها ظاهريًا، أو ذات المعاني المختلفة ولكن بُنيتها الظاهرية واحدة.
إن «وضع قواعد شاملة تنتظم تركيب الجملة في جميع اللغات على أساس أنَّ هناك عوامل مشتركة من البشر»، وهذه العوامل المشتركة ليست إلّا مظاهر «الشبه الملحوظة بين لغات العالم»، وتدعى (المظاهر الكلية)، ذلك أنَّ «أنماط التفكر الّتي التزمها العقل البشريّ فرضت على اللّغات كافة».
كان كتابه (مظاهر النّظرية النّحوية) (Aspects of the Theory of Syntax) سنة 1957 أول كتاب نثر فيه (تشومسكي) أسس نظريته وتمثُّلاتها، واستمر في تطوير نظريته بوضعه كتابه (البنى النحوية) (Syntactic Structures) وكتابه (دراسات الدّلالة في القواعد التّوليديّة) (Studies on of Semantic Generative Grammar) وكتابه: (مقالات في الشكل والتفسير) (Essay on Form and Interpretation). ولعلّ الملحوظ أنّ هذا المنهج أو هذه المدرسة تقوم على أساسين هما: فكرة (التحويل) في البنى، وهي فكرة تعود إلى صاحبها (هاريس Harris) أستاذ (تشومسكي) وموجّهه، وفكرة التوليد، وهي الفكرة الّتي تمخضت عنها دراسات (تشومسكي) من
خلال كتبه السابقة، وقد جمع (تشومسكي) في نظريته بين قواعد التّوليد وقواعد التّحويل.
فهذه النّظرية النّحويّة تفارق المفهوم النّحويّ التّقليديّ مفاهيماً وأهدافًا، وليست تقصد إلى تقنين الاستعمال اللّغويّ استعمالًا صحيحًا بمعايير، وتؤمن هذه النظرية بأن النحو أصولٌ قواعديّةٌ يختزنها ذهن مستعمل اللّغة، وهي قواعدٌ يفيض عليه بها الواقع، وهي الّتي تجعل المتكلّم للغةٍ ما قادرًا على أن يكتسب ما يشاء من لغات وهو تبعًا لذلك وبناءً عليه، يمكن له أن «يولّد = ينتج)، جملًا لم يسمعها من بيئته الاجتماعية، وهو المراد بمصطلح (التوليد)، فإذا كانت الجملة الكلية تقوم على جملة نواة أخرى غير النواة، فإن الجمل غير النواة إنما تُشْتَقّ من الجمل النواة بوساطة قواعد تحويلية، فالنحو (التوليدي التحويلي)، منظومة قواعدٍ تقوم على وصف الجمل وصفًا واضحًا محدَّدًا.
ويلحظ من خلال مـا سبق المرور به أنَّ «قـدرة المتكلم على إنشاء جملٍ لم تطرق سمعه قبل»، أهم ما وجَّهت مدرسة النحو التوليدي التحويلي أنظارها إليه، وصبَّت جهدها عليه، إلى جانب سعيها الحثيث إلى «دراسة السلاسل اللّفظية للتمييز بين ما يشكِّل منها جملًا مفيدةً وما لا يشكل مثل هذه الجمل ... وأن توجّه دراستها إلى هدفٍ رسمته لنفسها، وهو الكشف عن القواعد الكامنة وراء بناء الجمل».
وقد استمرَّ (تشومسكي) في تطوير الدّرس اللّسانيّ التّوليديّ التّحويليّ، فلم يقف عند نقطة معينة، ذلك أنَّ النظرية الشكلية الّتي قدَّمها (تشومسكي) سنة (1957م)، متمثلة في كتابه: (البنى النّحويّة) فرضيّةٌ علميةٌ في إطار الألسنية التّوليديّة تبقى صحيحةً ما لم «تبرهن المعطيات اللّاحقة عدم صحتها»، ومن ثمَّ دأب (تشومسكي) على تطوير فرضيته، ووصل من جراء ذلك إلى أنّها فرضية ٌمؤسَّسةٌ على الشّكل الـمحضّ، وليس إلى اعتبارات الدّلالة إليها سبيل؛ ذلك أنّها كانت تدرس الجملة في إطار مستوى
تركيبي (Syntactic Level) قائمٌ على تعاقب جملة من العناصر اللّغويّة، وآخر (فونولوجي صوتي) (Phonological Level)، فكان أن استدرك (تشومسكي) على فرضيته السّابقة بنظرية فرشها في كتابه الّذي صدر بعد ثماني سنوات من كتابه الأوّل (البنى النحوية)، وأعني به كتابه (مظاهر النظرية النّحويّة)، (Aspects of the Theory of Syntax)، وفيه أفسح (تشومسكي) للدلالة اللّفظيّة مكانها في بناء مقولاته، وفرَّق بين البنية العميقة والبنية السّطحيّة، وبين الأداء اللّغويّ والكفاية اللّغويّة.
ولا يذهبَنَّ بنا الشّطط إلى النظر إلى أطاريح (تشومسكي) على أنّها الحقّ الّذي يعلو على غيره، أو أنّها النظرية المستعصية على الانتقاد؛ ذلك أنّها فرضيةٌ قابلةٌ للأخذ والرّد، وليست مسلَّمةً من المسلَّمات، فقد نكص (تشومسكي) نفسه عن كثير من المقولات، وتخلَّى عن كثير من المقولات، «فكلّ فرضية هي قابلة مبدئيًا أن
يعاد النظر فيها»، فنظرية (تشومسكي) نفسها سجِّل عليها ثمانية وعشرون مأخذًا، فلم يخلُ كتابٌ من الكتب المخصَّصة لدراسة هذه النظرية من أن يوجه سابقها نقده للاحقها، أو يسعى إلى تعديل مقولاته.
وكان كلّ من (كاتز Jerrold Katz) و(فودر Jerry Fodor) وراء الدّعوة إلى تطوير قواعد (تشومسكي) بإفساح مكان للدّلالة، بالبحث «عن معاني الكلمات بإرجاعها إلى المؤلفات الأساسية أو المكونات التجزيئية على أساس أن معنى الكلمة مؤلف من سمات معنوية».
فإذا أُرِيد في ـ ضوء التطور المقترح- تحليل كلمة (المرأة) يكون تحليلها على النسق الآتي:
[محسوس + معدود + حي + بشر + أنثى + بالغة].
ومردّ ذلك أنَّ ما اقترحه (تشومسكي) من نماذج يفسح المجال لتوليد جملٍ ليست ذات دلالةٍ مع اتساقها وانسجامها مع قواعد التركيب، كأن يقال: شربَ الحليب الطفل، فهي صحيحة تركيبيًا من جهة الإسناد وعلاقة التخصيص بالمفعول به، ولكنها غير متسقة دلاليًا،
ذلك أن تناقضًا بين (الحليب) وهو غير حيّ، وبين (الطفل) وهو متحرك حيّ، والفعل (شرب) لا يمكن أن ينفذه إلّا من كانت فيه سمة الحياة والحركة وتأسيسًا على اقتراح (كاتز) و(فودر) بإعطاء المعنى موقعيته في التحليل الألسنيّ يكون بناء الجملة على ما تمثِّله الخطاطة الآتية:
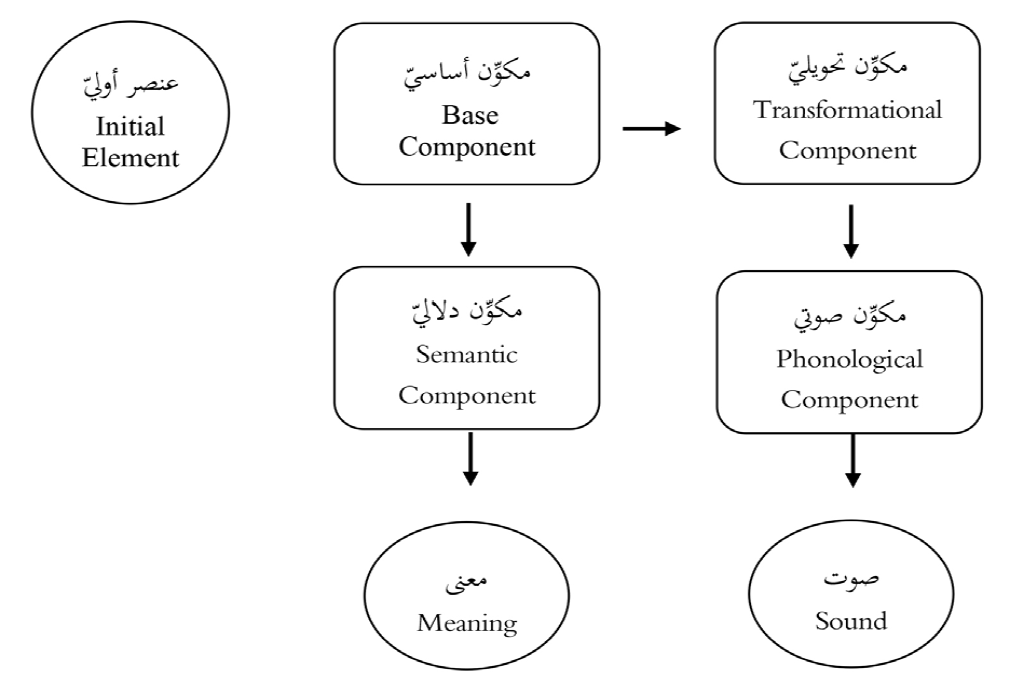
ولا بأس أن نقتبس مثالًا لتبيان مستوى تحليل الجملة وفق قواعد التركيب الشّكلية، ثمّ نتبعها بالتّمثيلات الدّلاليّة، ففي قولنا: (أكل الرّجلُ التّفاحةَ)
فاستنادًا إلى مقولات (تشومسكي) الأولى تحلَّل الجملة على النحو الآتي:
أكلَ الرّجلُ التّفاحةَ
الجملة (ج)⬅ركن إسناد (أكل الرجلُ) + ركن تكملة (التفاحة)
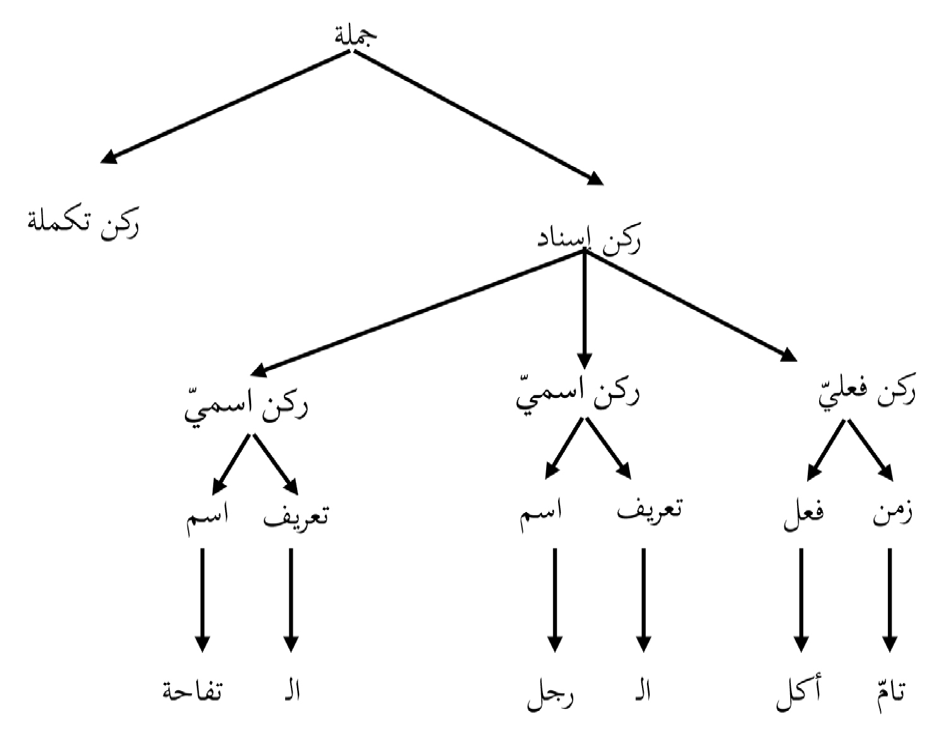
فإذا أضيفت إلى هذا التّمثيلِ الشّكليّ المحضّ التمثيلاتُ الدّلالية لكلّ عنصر، يكون التحليل على النحو الآتي():
1 – أكل: ⬅(+ فعل)، (- ركن اسمي)، (متحرك)، (نشاط)، (غذاء).
2 – الـ: ⬅ (+ تعريف)، (محدِّد)، (مفرد أو جمع)، (مذكر أو مؤنث).
3 – رجل: ⬅ (+ اسم)، (إنسان)، (ذكر)، (متحرك)، (حيّ)، (أكثر من عشرين سنة).
4 – تفاحة: ⬅ (+ اسم)، (مؤنث)، (شيء)، (نبات)، (مأكول)، (طبيعي).
فإذا ضمَّ المكون الدلالي إلى البنية التشجيرية يكون لدينا مزج المكونات الدلالية بالبنية التركيبية، وتمثّلها الخطاطة الآتية:
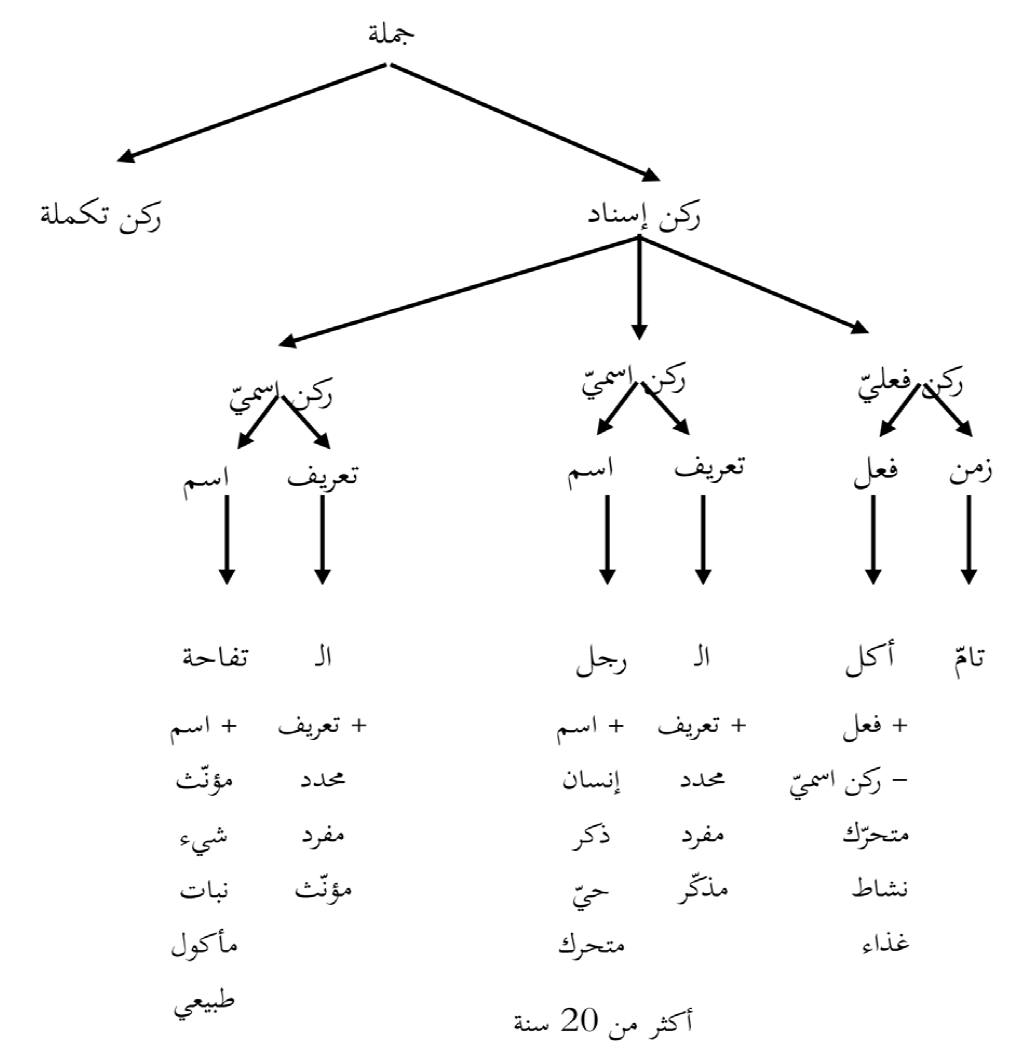
وقد لخَّص د. أحمد قدور منهج (تشومسكي) في العملية النّحوية لإنتاج الجملة في المراحل الآتية:
1 – يُولِّد المكون التركيبيّ ابتداءً من المستوى التوليديّ أو الأساسيّ البنية العميقة للجملة.
2 – يحوِّل هذا المكون بوساطة المستوى التحويلي البنية العميقة إلى بنية سطحية من خلال الإضافة، والحذف، والنقل والقلب.
3 – يقدِّم المكوِّن الدّلاليّ التّفسيرات الدّلالية للبنية العميقة بالجمع بين التمثيل الركنيّ للتركيب والتمثيل الدلاليّ للمفردة.
4 – يقدم المكون الصوتيّ تمثيل الجملة في بنيتها السّطحية من خلال القواعد الصّوتية المتفق عليها.
وإذا أردنا الوقوف على تمظهرات اللّسانيّات الوظيفية في ساح الدرس العربي تلقّانا اللّسانيّ (أحمد المتوكل) الّذي تبنّى النّحو الوظيفيّ أرضية نظرية يتهدّى بأصولها في تناول معطيات اللّغة العربيّة، ويمثّل ذلك كتابان له هما:
أ. (الوظائف التداولية في اللغة العربية) ، وقد درس فيه «خصائص المكونات المسندة إليها الوظائف التداولية»، وهذه المكونات هي: المبتدأ، والذّيل، والمحور، والبؤرة، والمنادى.
وقد قسم النّظريات اللّسانيّة المعاصرة من جهة تصوُّرها للغة ووظيفتها قسمين: أولهما: اللّسانيّات الصّوريّة. وثانيهما: اللّسانيّات
الوظيفية (التداولية)، وإلى المدرسة الثّانية (النظريّة الوظيفيّة Functionalism)، ولا سيما المدرسة النّسقيّة، ثمَّ النّحو الوظيفيّ الّذي قال به (سيمون ديك Simon C. Dik 1940-1995).
ويصرح (المتوكل) أنَّ «النّحو الوظيفيّ Functional Grammar الذي اقترحه (سيمون ديك) في السنوات الأخيرة في نظرنا، النظرية الوظيفية التداولية الأكثر استجابةً لشروط التنظير ولمقتضيات النّمذجة» ...، فالنّحو الوظيفيّ «محاولة لصهر بعضٍ من مقترحات لغوية (النحو العلاقيّ Relational Grammar)، و(نحو الأحوال Case grammar)، و(الوظيفيّة Functionalism)، ونظريات فلسفية (نظرية الأفعال اللغوية) خاصة أثبتت قيمتها» .
وقد لخّص في كتابه هذا الأصول المنهجيّة للنّحو الوظيفيّ فيما يأتي:
1. الوظيفة الأساسيّة للّغة هي التّواصل.
2. الدّرس اللّسانيّ وظيفته وصف القدرة التّواصلية للمتكلم والمخاطب.
3. النّحو الوظيفيّ نظريةٌ في التّركيب والدّلالة الرّاشحة عنه، ولكنها من وجهة نظرٍ تداوليّة.
4. يجب على الوصف اللّغويّ السّاعي إلى الكفاية أن يحقق أنواعًا ثلاثة منها هي: الكفاية النفسيّة، والكفاية التداوليّة، والكفاية النمطيّة.
وبناءً على ذلك يعمل النحو الوظيفيّ على إلغاء القواعد التحويلية لعدم واقعيتها النفسيّة.
ب. (المنحى الوظيفي في الفكر اللغوي العربي: الأصول والامتداد): وفيه يبين المتوكل عن هدف اللّسانيّن الوظيفين العرب، وحدَّدها في:
1. الانطلاق من تبعية البنية لوظيفة التواصل، من خلال الكشف عن نسق اللغة العربية في المستويات اللّسانيّة المختلفة، الصرفية والتركيب، مع التفريق بين النّسق الفصيح والنّسق الدّارج.
2. ربط الدّرس اللّسانيّ الوظيفيّ بالتنظير العربيّ التراثيّ في جوانبه المختلفة، نحوًا، وبلاغةً، وتفسيرًا، ...
فالمتوكل يتغيّا التأسيس لنحوٍ وظيفيٍّ في اللغة العربية، يستطيع من خلاله رصد ما يرتبط بهذه اللغة من قضايا. فقد صرّح عن هدفين اثنين يقصد إليهما من وراء مشروعه، هما:
1. إغناء لسانيات اللغة العربية بتقديم أوصافٍ وظيفيّةٍ لظواهر مركزية بالنسبة إلى قضايا تداولية، أو دلالية، وتركيبية في عربيتنا.
2. تطعيم النّحو الوظيفيّ بمفاهيم يفرضها الوصف الكامل لظاهرة ما.
3. وقد اتكأ في وصف قضايا اللّغة العربية بناءً على توجّهه النّحويّ الوظيفيّ على جملة تحليلات نجملها في:
. التّحليلات المعجميّة
. التّحليلات التركيبيّة
. التّحليلات التداوليّة
وسعى إلى إغناء النموذج الوظيفي، وقدَّم جملةً من المقترحات لمضمونات نموذج الوظيفيّ (سيمون ديك) سنة 1978، أو النّموذج العائد إلى عام 1989 م.
وإذا كنّا نؤيد اللّسانيّ (حافظ إسماعيلي علوي) فيما ذهب إليه أنَّ «تتبّع مسيرة البحث اللّسانيّ التوليديّ في الثقافة العربية ... لم يكن نتيجةً طبيعيةً لتراكمات في البحث اللّغويّ العربيّ، لكنّه كان ظهورًا طفريًّا»، فإنَّنا نميل معه أيضًا إلى القول: «إنّ الاتجاه الوظيفيّ كان ظهوره أيضًا طفريًّا»، وهو الاتجاه الّذي جاء بعد الاتجاه التوليديّ، ولذلك أسبابه.
ولكن لا مفرّ من الإقرار بانطلاق المتوكّل في تأسيس تصوُّره «من موقف إبستمولوجي مفاده أنَّ الخطاب العلميّ يتصف بتوحّده وكونيته، فهو خطابٌ يتجاوز السياق التاريخي ليدخل في علاقة تواصلٍ وتفاعلٍ مع الخطاب العلميّ الحديث».
. النحو التوليدي التحويلي عند اللسانيين العرب المحدثين:
بسط النَحو التّوليديّ التّحويليّ سلطانه على فكر بعض الدّارسين اللّسانيّين في السّاحِ العربية، ووجد صدى واسعًا في محاولاتهم، وهي محاولات يتّصف بعضها بالجزئيّة وبعضها الآخر بالشّموليّة.
وتمظهر هذا التبني لا التأثير فحسب في كتابات كلّ من (داود عبده) و(ميشال زكريا)، وكان الثاني منهما أكثر تمثيلًا لذلك.
وضع (داود عبده) مؤلفات عدّة، منها (أبحاث في اللغة العربية)، و: (دراسات في أصوات اللغة العربية)، و: (التقدير وظاهر اللفظ) و: (الترتيب في القواعد الصوتية في اللغة العربية)، و: (البنية الداخلية للجملة في اللغة العربية).
لقد كانت كتاباته موزعةً بين الدراسة الصوتيّة والدراسة التركيبيّة، وكان يهدف من ورائها إلى تخطي معايب الدرس الوصفي الذي وصم أصحابه بالتعصّب له، وبأنَّهم كادوا أن يجرّدوا الدّرس اللّسانيّ
مما يستحق أن يسمى من أجله علمًا. وتساءل قائلًا: «فإذا كانت غاية علم اللغة الوصف فقط، فلأيّ علم ننسب تفسير الظواهر اللغوية المختلفة». وانتهى إلى أنَّ السّاحة اللّغوية العربيّة الحديثة تحتاج إلى «عالم لغوي لكي يذكر أنّ الفعل الثّلاثيّ في العربية يأتي على أوزانٍ مختلفة ... ولكلّ من هذه الفئات تصريفٌ خاصٌّ قائمٌ بذاته ... ما تحتاج إليه هو تفسير عددٍ من الظّواهر اللّغوية المتعلقة بهذه الأفعال».
ولا يخفى أنَّ (داود عبده) في اعتماده التفسير منهجًا يسير عليه مستعيضًا به عن الوصف، يعني انخراطًا واضحًا في المنهج التوليدي، ويعني انتماءً صريحًا لا مواربة فيه إلى المدرسة التّوليديّة.
إنّ (داود عبده) كان من أوائل من أفادوا من معطيات الدرس التّوليديّ وطبقوه على اللغة العربيّة، فقد كتب يقول: «يتطلب التفسير الصّحيح لكثيرٍ من قضايا اللغة العربيّة أنْ ترد كثيرًا من الكلمات إلى أصلٍ أو بنيةٍ تحتيّة Under ling structure تختلف عن ظاهر اللفظ».
وقد انطلقت آراء (داودعبده) في تبنيه مبادئ (تشومسكي) من أربعة أنماطٍ تحويليّة هي: الحذف، والتعويض، والإضافة، والقلب.
وأشار في الفصل الرّابع من كتابه (دراسات في علم أصوات
اللغة العربيّة) إلى البنيتين: السّطحية والعميقة، وفسَّر من خلالهما، على نحو ما انتهى إليه أنَّ «الألف في الأفعال المزيدة واسم الفاعل والمثنى، ليست بدلًا من واو أو ياء بعامة هي في الأصل همزة. أي إنّ البنية التحتية لصيغة (فاعل) فاعل، ... وأن الهمزة سقطت من هذه الصيغ وأطيلت الفتحة السابقة لها ...».
وانتشرت في كتاباته مصطلحات توليدية، نحو: بنية داخلية، وبنية خارجية، وقواعد تحويلية، وقواعد اختيارية، ... «وكل هذا يشير إلى مدى نمثُّله للنظرية التوليدية ولمفاهيمها الموظفة».
وبسط (النحو التوليدي التحويلي) سلطانه على فكر بعض الدارسين اللّسانيّين في الساح العربية، ووجد صدى واسعًا في محاولاتهم، وهي محاولات يتصف بعضها بالجزئيّة وبعضها الآخر بالشّموليّة.
وتمظهر هذا التبني ـ لا التأثرـ فحسب في كتابات كل من (داود عبده)، و(ميشال زكريا)، وكان الثاني منهما أكثر تمثيلًا لذلك.
وضع (داود عبده) مؤلفات عدَّة، منها: أبحاث في اللغة العربية، ودراسات في أصوات اللغة العربية، والتقدير وظاهر اللفظ أو الترتيب في القواعد الصوتية في اللغة العربية، والبنية الداخلية للجملة في اللغة العربية.
لقد كانت كتاباته موزعة بين الدراسة الصوتية والدراسة التركيبية، وكان يهدف من ورائها إلى تخطي معايب الدرس الوصفي الذي وصم أصحابه بالتعصُّب له، وبأنهم كادوا أن يجردوا الدرس اللّسانيّ مما يستحق أن يسمى من أجله علمًا. وتساءل قائلًا: «فإذا كانت غاية علم اللغة الوصف فقط، فلأي علم ننسب تفسير الظواهر اللغوية المختلفة».
وانتهى إلى أنّ السّاحة اللّغويّة العربيّة الحديثة تحتاج إلى «عالم لغويّ لكي يذكر أن الفعل الثلاثي في العربية يأتي على أوزان مختلفة «... ولكل من هذه الفئات تصريف خاص قائم بذاته ... ما نحتاج إليه هو تفسير عدد من الظّواهر اللّغويّة المتعلقة بهذه الأفعال».
ولا يخفى أنَّ (داود عبده) في اعتماده التفسير منهجًا يسير عليه مستعيضًا به عن الوصف، يعني انخراطًا واضحًا في المنهج التوليديّ «ويعني انتماء صريحًا لا مواربة فيه إلى المدرسة التّوليديّة».
ولكن المنهج الوصفيّ لم يبق على سمتٍ واحد، ولم يركن إلى أصولٍ ثابتةٍ لا يحيد عنها، بل انشعب هو نفسه إلى مدارسٍ واتجاهات لها أصولها، ولها أعلامها، وهي على الرغم من ذلك لم تخرج على طريق الوصفيّة، ولم تخلع عنها عباءة المنهج الوصفيّ، فحسب كلّ مدرسة أن ترمي سابقتها بشيء من النقد، وتحوِّر بعض المفاهيم والمبادئ لتشكّل مدرسةً جديدة.
وقد وجدت الوصفية سبيلها إلى الدّرس اللّسانيّ العربي، وعمد الوصفيّون العرب إلى نقد الدّرس النّحويّ على العربيّ كما فعل الوصفيّون الغربيّون بالنسبة إلى أنحائهم، فمن هذه النقدات اعتقادهم بتأثر النّحو العربيّ بالنّحو الأرسطيّ، وميله إلى التعليل والتأويل والتقدير، وبذلك يكون نَحونا العربيّ قد نأى عن الاستعمال الواقعي للّغة.
ومن ذلك أنَّه نحوٌ قعَّد للغةٍ نموذجيةٍ لا للغة الاستعمال، فلم «يُوسّع درسه ليشمل اللّغة التي يستعملها الناس في شؤون الحياة، وإنّما قصره على اللّغة الأدبيّة ... مما أبعدهم عن الاستعمال الشائع في هذه اللغة».
يضاف إلى ذلك تحديد بيئةٍ زمانيّةٍ للّغة المنتقاة، وعدم وضع حدودٍ معيّنةٍ للتحليل اللّغويّ ومستوياته، فجاءت تلك التحليلات متعدّدة المستويات.
وهذه النقدات ـ على ما هو واضح ـ لا تخرج عن سمت ما نقد الوصفيون الغربيون به نحوهم التقليديّ، وهذاما أفضى بهم إلى السعي إلى الاستعاضة عن الأسس الدّرسيّة القديمة بأسس جديدة تجلَّت في المنهج الوصفي، حتى إنهم ذهبوا إلى الاعتقاد بأنّ «أيَّ نهضة منشودة في مجال الدراسات اللغوية العربية، بحسب الوصفيين، تبقى رهينةً بتطبيق هذا المنهج على اللغة العربية».
أما اللّسانيّ (ميشال زكريا) فتنم مؤلفاته عن تبنّيه نظريّة
(تشومسكي) وعرضها عرضًا مفصَّلًا ممثّلًا لها بنماذج من معطيات اللّغة العربيّة، فقد وضع كتبًا متعدِّدة في هذا الإطار، وهي:
ـ الألسنية (علم اللّغة الحديث) المبادئ والأعلام، المؤسسة الجامعية للدراسات، لبنان، 1987م.
ـ الألسنية التوليدية والتحويلية وقواعد اللغة العربية: النظرية الألسنية، المؤسسة الجامعية، لبنان، 1986 م.
ـ الألسنة التوليدية والتحويلية وقواعد اللغة العربية: الجملة البسيطة، المؤسسة الجامعية، لبنان، 1983 م.
ـ الملكة اللّسانيّة في مقدمة ابن خلدون، دراسة ألسنية، المؤسسة الجامعية، لبنان، 1983م.
وقد كان يقول بوجود بنيتين للجملة، أولاهما: البنية العميقة الّتي تتولّد منها بنية سطحيّة بفعل قواعدٍ توليديّةٍ وتحويليّة. وكان تحليله للجملة هو الأبرز، إذ «أشار إلى الأهمية التي تتخذها إعادة كتابتها ـ يعني الجملة ـ بالقواعد التوليديّة والتحويليّة من حيث إنّ للجملة بيئةٌ عميقةٌ تشتغل عليها قواعدٌ توليديّةٌ وتحويليّةٌ لاشتقاق بنيتها السّطحيّة».
وانتهى (زكريا) إلى أنَّ الجملتين الاسمية والفعلية هما جملةٌ واحدةٌ هي الجملة الفعلية، فالجملة هي أساس القواعد كلّها.
ومن الجدير ذكره ههنا أنّه حذا حذو ابن هشام في فهمه للجملة،
ذلك أنّه قد تبنّى تعريفه لها، فهي عنده كما هي عند ابن هشام «اللّفظ المفيد فائدة يحسن السّكوت عليها»، ورأى أنّ فهم (هاريس) في الفكر اللّسانيّ الغربي كبير شبه بفهم ابن هشام.
وعرّض كذلك لقضية الرّتبة تحت مسمَّى (ترتيب العناصر في البنية العميقة)، وارتأى أنَّ ترتيبها ليس حرًّا، بل محكومًا، وقدم حججًا بيّنة على ذلك.
ويتجلَّى تبنيه معطيات النظريّة التّوليديّة والتّحويليّة من خلال تحليله معطيات لغويّة عربيّة، ومن خلال التركيز الواضح على عناصر التّحويل، ودراسة البنية المكونيّة، ومعالجة القواعد الأساسيّة، ومنها قواعد إعادة الكتابة لتنظيم المعطيات التّركيبيّة.
وقد وقف (زكريا) موقف النّاقد للدّراسات النّحوية المطبَّقة على اللّغة العربيّة، فما قامت به الأجيال السّابقة، وما تبنّوه من مفاهيمٍ في الدّرس اللّغوي غير صالحةٍ ولو حصل لها بعض التّحسين الشّكليّ الّذي لا يمس الجوهر، فهي دراساتٌ لا نستطيع من خلالها فهم كثيرٍ من القضايا اللّغويّة، وليست وافية بالتّحليل، لذلك كانت النّظريّات الألسنيّة العلميّة الحديثة «هي التقنية التي يُتَسلَّح بها في سبر أغوار قضايا اللغة وتفسيرها وتوضيحها». ورفضه هذا يشي باعتقاده أنَّ الدّراسات اللّسانيّة الحديثة هي البديل الحقّ عن النّحو العربيّ، وهو موقفٌ يشاركه فيه (عبد القادر الفاسيّ الفهريّ) من المغاربة، وهذا
ما يجعلنا نتبنّى رأيًا مفاده أنّ المدرسة التّوليديّة العربيّة الحقّة هي مدرسة اللّسانيّين المغاربة، إذ هي أكثر ترسيخًا للاتجاه التّوليديّ، وتحمل في الوقت نفسه مقومّات العمل المتكامل، ومثالها دراسات (عبد القادر الفاسيّ الفهريّ) الذي عني بدراسة لغتنا وفق مستويات الدّرس اللّسانيّ الدّلاليّة، والتّركيبية، والمعجميّة.
ومع ما تقدّم كلّه يبقى البحث اللّسانيّ التّوليديّ العربيّ لَمّا يزل مفتقرًا إلى كثير من شروط التّكامل والتّساوق.
وتضطلع اللّسانيّات بدراسة اللّغة أيّة لغة من خلال مستويات أربعة، هي:
1. المستوى الصَّوتيّ: Phonological Level
2. المستوى الصرفيّ: Morphological Level
3. المستوى التركيبيّ: Level Syntactic
4. المستوى الدلاليّ: Semantic Level
وستكون لنا وقفةٌ خاصة عند كلّ مستوى من تلك المستويات المذكورة آنفًا، تحدِّد معالمه وآفاقه.
تشكل اللّغة منظومةً من الأصوات المنطوقة أو المكتوبة الّتي يُرْبَط بعضها إلى بعضٍ بوساطة قواعدٍ بنائيّةٍ معينةٍ سعيًا إلى تحقيق تواصلٍ فكريٍّ أو عاطفي بين متكلمي اللّغة.
واللّغة الإنسانية إنما بدأت شفاهيّةً منطوقةً قبل أن يتّجه متكلّمها إلى تسجيلها وكتابتها؛ ذلك أن «اختراع الكتابة لم يكن متأتيًا من معرفة الطبيعة الشفهيّة للغة ومحاولة تقييدها بالكتابة، بل كان محاولةً لتسجيل معنى الكلمة بتمامها عن طريق الصّور والرّسوم».
وهذا يعني أنّه لم يُعرف للأصوات المنعزلة دلالة حتى توصّله إلى اختراع (الأبجدية)، فكان له أن عرف الأصوات الّتي منها تتركب الكلمات، هذه الكلمات الّتي يؤلّف منها جمله الّتي هي وسيلة التواصل فأكثر اللغات كانت منطوقةً ثم جرت كتابتها .
فالأصوات اللّغويّة المفردة لا مؤدّى لها ولا وظيفة، ولا يكون الكلام مستحِقًا صفة الكلام إلّا إذا رُكِّبت هذه الأصوات وتآلفت. يقول (فندريس): «لا توجد في اللغات أصواتٌ لغويّةٌ منعزلة، وهذا لا يعني فقط أنَّ الأصوات اللّغويّة لا توجد مستقلَّة، وأنها لا تُحلَّل على انفرادٍ إلّا بنوعٍ من التّجريد».
وقد كان الفينيقيون أوّل الأقوام اختراعًا للأبجديّة، وبذلك كانوا هم الأسبق إلى الوقوف على البنية الصوتيّة للّغة، واندفعوا بذلك إلى توصيف الأصوات، وبيان ما تمتاز به من خصائص وسمات وأنّ في مُكْنة الدّارس تَجْزِيء اللّغة المدروسة إلى تقطيعات يرمز إليها بإشارات، وعرفوا الصوامت دون الصوائت،
فكان اختراع هؤلاء القوم للأبجدية أهم أحداث التاريخ على الإطلاق.
ولقي وصف الأصوات اهتمامٍ أقوام آخرين هم الهنود، وكانوا يتوقون من وراء ذلك إلى أن يكون نطقهم بلغتهم السنسكريتية صحيحًا، لأنها لغةٌ تتلى في المعابد، وهي عمدة الطقوس الدينية الّتي يمارسونها، ذلك لاعتقادهم أنها لغة الآلهة الّتي لا يجوز تحريفها، وكان (بانيني Pāṇini) رأسًا في ذلك، فقد اعتنى بوصف الأصوات وتبيان خصائصها، ومخارجها، وأعضاء نطقها. فقد كان وصف الهنود للأصوات في غاية الدقة مع أنّهم ضربوا صفحًا عن «أثر البنية الصوتية في نقل المعنى، ولم يعرف بحثهم الصوتي تقدّمه المشهود إلى أن ترجم كتاب (بانيني) سنة 1815-1840».
ثم كان أن أخذ الإغريق الأبجديّة الّتي اخترعها الفينيقيون، وأتموا اختراعهم الكتابة، وسجّلوا الصوائت، ولكنّهم في بحوثهم تلك لم يصلوا إلى ما وصل إليه الهنود، ولم يكن له كبير أثرٍ في الدّرس اللّسانيّ عند الغرب من بعد.
فلم تكن الصوائت تعتمد على الظّنّ والتّخمين عند الإغريق، فكان يجب امتزاج اللّفظ بالإشارة إليها حتى تكون اللّفظة مفهومة.
وليس بمقدور الدّارس أن يصل إلى الدّرس اللّسانيّ الحديث ما لم يمرَّ مرورًا هيِّنًا على جهد العرب في الدرس الصوتي. فعلى الرغم من اتكائهم على (المشافهة = الرواية) في تلقّي اللّغة، وانعدام وجود مدوَّنات لغوية = توافرت لهم العوامل الّتي دفعت ظهور الدرس الصوتي مبكِّرًا، نحو: القراءات القرآنية وخصائصها، والمصحف وكتابته وضبطه، وظهور الدرس المعجمي ابتداءً من تفسير غريب النص القرآني، ثم من بعد ظهور علم التركيب (النحو) على يد الخليل بن أحمد الفراهيدي الّذي يُعَدّ ـ بحقّ ـ ذروة سنام الدّرس الصّوتيّ العربيّ ممثَّلًا بمعجمه المبني أصلًا على أساسٍ صوتي، حتى إنْ استطاعتنا القول: «إنّ الدّرس الصّوتيّ عند الغرب فاق نسقه وعمقه وتعدُّد مجالاته وتطبيقه كلّ ما عرفه علم اللّغة حتى العصر الحديث». وهو درسٌ له استقلاليّته عن المؤثرات الأجنبية، فكان منطلقه لغويًّا فحسب، وكان الخليل وسيبويه رائدين من رواده.
ولا يذهب بنا الظّنّ إلى تفوُّق الدّرس الصّوتيّ في العرب -على حداثته ـ على الدّرس الصّوتيّ العربيّ، وذلك لِمَا توفّر له من تقانة، فلا يتجاوز ذلك غير الدّقة في تحديد الخصائص والسمات اعتمادًا على الأجهزة الحدثية، وهذا راجعٌ في حقيقة الأمر إلى المركزيّة
الأوربيّة، وضعف دراساتنا عن الدّفع بهذا العلم وتقديمه على أنّه جزءٌ من التّراث الإنسانيّ العامّ.
يفرِّق في الّدرس الصوتيّ بين معنيين هما: المعنى الفيزيائيّ للصوت، والمعنى اللّغويّ له، أما الأول فهو «ظاهرةٌ طبيعيةٌ تنشأ عن اهتزاز الأجسام، وندركه عن طريق حاسة السّمع».وأما الثاني فهو «أثرٌ سمعيٌّ نتيجة أعضاء النطق الإنساني إراديًّا في صورة ذبذبات، نتيجةً لأوضاعٍ وحركاتٍ معيّنة لهذه الأعضاء».
فعلم الفيزياء يدرس الصوت مادة، وهو يختلف عن علم الصوت اللّغويّ الّذي يدرس الصوت الإنساني، وما يرتبط به من مخرج، وصفة، وموقعية في نسج الكلمة، وتأثره وأثره في السابق واللاحق من الأصوات الّتي تجاوره.
وقد ظهر في ميدان الدّرس الصّوتيّ مصطلحان يدل كلّ واحدٍ منهما على فرعٍ من فروع الدّرس الصّوتيّ، وهما:
1 – Phonetics، ويدعى، (علم الأصوات العامّ).
2 – Phonology ويدعى، (علم الأصوات الخاصّ).
أما علم الأصوات العامّ (Phonetics) فينقسم أقسامًا أربعة، هي: علم الأصوات النطقيّ، وعلم الأصوات الفيزيولوجيّ، وعلم الأصوات السّمعيّ، وعلم الأصوات المخبريّ، ولكن الدارسين اللّسانيّين يقتصرون «على الجوانب النّطقيّة والسّمعيّة الّتي يحتاجها التّحليل اللّسانيّ».
وميدان هذا الفرع دراسة مخارج الأصوات (الحروف) والتفريق بين الأصوات الجوفيّة والحلقيّة، واللّهويّة، والشّفهيّة.
أما علم الأصوات الخاصّ (Phonology) = علم الأصوات التشكيلي فيعود ظهور هذا المصطلح (Phonology) إلى سنة (1850) على يد (William Dwight Whitney) المتوفى سنة (1894م)، الّذي كان يذهب إلى أنّ اللّغة تشبه الجسم البشريّ، وهي مكوّنةٌ من تلاصق أجزاءٍ متماثلة، بل إنّها جزئياتٌ تتواشج فيما بينها، ويعضد بعضها بعضها الآخر، ويرى كذلك أنّ «الصوت المنطوق ليس إلّا نتاجًا ماديًا، وأنّه لا يشكّل المادة الأولية للّغة ما لم يكن حاملًا للمعنى، والأصوات البسيطة للّغة ما ليست سديمًا، وإنّما هي نظامٌ من ألفاظٍ متّسقةٍ محكومة بعلاقات على الأصعدة كلّها».
ويُقسّم التحليل الفونولوجيّ الوحدة الصّوتيّة بدءًا من الجزء وانتهاءً إلى الكلّ، على النّحو الآتي:
الفونيم Phoneme: أصغر وحدة في التحليل، ويعرف بأنه أصغرُ وحدةٍ صوتيّةٍ تؤدي إلى التمييز بين معنى وآخر ، نحو: القاف، والعين، واللام في الألفاظ: قام، عام، لام. فكلّ منها (فونيم) يغير معنى (الكلمة) الّتي يدخل فيها.
المقطع Syllable: هو مجموعة أصوات مفردة، ويكون مؤلفًا من صائت وصامت، أو أكثر، نحو قولنا: نامتْ، فالكلمة مؤلفة من مقطع أول (نَ + ا) ومقطع ثان (مَ تْ)،
فالأوّل صامت والثّاني طويل (نا)، وفي عربيتنا خمسة مقاطع:
أ. مقطع قصير مفتوح = صامت + صائت قصير CV (بَ).
ب. مقطع متوسط مفتوح = صامت + صائت طويل CVV (با).
ج. مقطع متوسط مغلق = صامت + قصير + صامت CVVX (منْ).
هـ. مقطع طويل مغلق = صامت + صائت طويل + صامت CVVC.
و. مقطع طويل مضاعف الإغلاق = صامت + صائت قصير + صامت + صامت = دَرْبْ ويرمز له بـ (VCC).
فالمقاطع الثّلاثة الأولى هي الشّائعة في منظومة الكلام العربيّ، والمقطعان الأخيران قليلان فيها، وليس يوجدان إلّا عند الوقف على أواخر الألفاظ. وليست البنية المقطعيّة من ابتداع التشكيليين فحسب، فهم مسبوقون إليه بالأكاديين الذين كانت كتابتهم المسمارية على رمزٍ واحدٍ يرمزون به إلى أصوات المقطع كله، ثم تركوا ذلك بعد وصولهم إلى الأبجديّة، فقد بدأت كتابتهم المسمارية صورية، ثم نصف صورية، ثم مقطعية، فكان الرمز كلمةً أو مقطعًا.
ولعلمائنا الأقدمين فضل الوقوف على البنية المقطعيّة، ومنهم: أبو نصر الفارابي (ت 339 هـ)، وأبو الوليد بن رشد (ت 595 هـ)، وقد وضع هذا الأخير مصطلح (المقطع)، فكان أسبق ابتكارًا من المحدثين.
3. النبر Stress: هو ظاهرة لصيقة بالمقطع، ولا نشاط فجائيًا يعتري أعضاء النطق في أثناء التلفظ بمقطعٍ من مقاطع الكلمة ، وسبيلٌ إلى التفريق بين الدّلالات في لغات أخرى غير العربيّة، ولذلك يعدُّ (فونيمًا) مميِّزًا بين المعاني، إذ قد ينقل الكلمة من الاسمية إلى الفعلية، أو العكس.
ويُفسَّر بأنه وضوحٌ في الصوت في مقطعٍ إذا قيس بالمقاطع الأخرى، ويتطلب جهدًا أكبر منها، إذ إنَّ هذه الظاهرة تتضافر في إنجازها أجزاء الجهاز النطقي كلها، فيؤدي ذلك إلى علوٍّ في الصوت ووضوحٍ في السّمع.
وإذا كان الدّرس اللّسانيّ العربي لم يعرف للنبر دراسة مفصَّلة فلا يعني أنْ نقرَّ (هنري فلايش Henri Fleisch) الّذي أجحف بحق اللّغويّين العرب على افتئاته عليهم وجَعْله فكرة (النبر) ومصطلحه
نتاج الفكر الغربي وليس للنحاة أيُّ إسهامٍ فيه، وقد فاته أنّ مصطلح (النبر) ورد في خبرٍ عن النبيّ، صلى الله عليه وسلّم، حينما خاطبه أحدهم بقوله: (يا نبيء الله) بالهمزة في آخر الكلمة فأجابه: (لا تَنْبُرْ باسْمِي)، أَي لا تَهْمِزْ.
ثم إنَّ هذه الظاهرة أكثر ما تتجلَّى العناية بها في قراءة القرآن، وهو اهتمامٌ بالناحية الصوتية أكثر من النظر إليه (فونيمًا) يحمل تفريقًا بين الدّلالات، على غرار ما هو في اللّغات الأخرى. وذهب الدكتور تمام حسان في تأكيد وجود هذه الظاهرة إلى «أنّ النّبر في الكلمات العربيّة من وظيفة الصيغة الصرفية، فصيغة (فاعل) يقع النبر فيها على الفاء (فا)، وصيغة (مفعول)، يقع النّبر فيها على العين (عو) ... أما نبر الجمل والمجموعات الكلاميّة فليس له ارتباط بالصيغ الصرفية، لارتباطه بالوظائف النّحويّة.
4. التنغيم Intonation: والمراد به أن تُعطي الكلام تطريبًا معينًا نتيجة تغيُّر في درجات الصّوت، وتعدّد هزات وتري الحنجرة، ما يزيد الاهتزاز أو ينقصه وفق المؤثرات النفسية أو الفكرية، ولا يكون إلّا ضمن نسقٍ من الكلمات على مستوى الجملة، وهو غير (النغمة = Tone) الّتي تعني الأثر الّذي يُسببه ازدياد عدد الذّبذبات أو انخفاضها في مستوى الكلمة.
وعلى الرّغم من أنّ هذه الظاهرة لم تحظَ بالدّرس المستقرئ المتوسِّع، لكن لم يغفل عنها علماؤنا، ولا يخلو تراثنا من تجليات لها، ومن هنا كانت مثار خلاف بين قائل بعدم وجود هذا المستوى من الدرس، وأنه مازال ينتظر من يؤصله، ومن هؤلاء المرحوم محمد الأنطاكي، والدكتور عبد السلام المسدي، وبين واضع يده على نصّ يُبيّن فيه تأثير التنغيم في تغيير توجيه العبارة بين دلالةٍ وأخرى، كنقلها من التقرير إلى الاستفهام، أو التعجب إلى التوكيد.
يقول ابن جني في حديثه عن حذف الصّفة ودلالة الحال عليها، وذلك فيما حكاه سيبويه من قول العرب: (سيرَ عليه ليلٌ)، وهم يريدون: (ليلٌ طويلٌ): «وكأنَّ هذا إنّما حذفت فيه الصفة لـما دلَّ من الحال على موضعها، وذلك أنك تحس في كلام القائل لذلك من التطوع والتطريح والتفخيم والتعظيم ما يقوم مقام قوله: (طويل) أو نحو ذلك، وأنت تحس ذلك من نفسك إذا تأملته. وذلك أن تكون في مدح إنسان والثناء عليه فتقول: (كان والله رجلًا!) فتزيد في قوة اللّفظ بـ (الله) هذه الكلمة وتتمكن في تمطيط اللّام أو إطالة الصوت بها وعليها».
ولابن سينا إشارة واضحة إليه في الفصل التاسع في حديثه عن الخطابة وجعل التنغيم مسلكًا مائزًا بين دلالةٍ وأخرى، مع إقرارنا باختلاط مفهوم التنغيم بمفهوم النبر، وقد ميّز ابن سينا بين ثلاثة مكونات للتنغيم هي: الحدة، والثقل، والنبرات، فقال في ذلك: «إنّ من أحوال النغم: النبرات، وهي هيئات في النغم مدّية، غير حرفية،
يبتدئ بها تارة، وتتخلل الكلام تارة، وتعقب النهاية تارة، وربما تكثر في الكلام، وربما تقلّ، ويكون فيها إشارات نحو الأغراض، وربما كانت مطلقةً للإشباع، ولتعريف القطع، والإمهال السامع ليتصوَّر، ولتفخيم الكلام، وربما أعطيت هذه النبرات بالحدة والثقل هيئات تصير بها دالّةً على أحوالٍ أخرى من أحوال القائل إنه متحيزٌ أو غضبان، أو تصير مستدرجةً للمعقول معه بتهديدٍ أو تضرُّعٍ أو غير ذلك، وربما صارت المعاني مختلفةً باختلافها، مثل أن النبرة قد تجعل الخبر استفهامًا، والاستفهام تعجبًا، وغير ذلك».
وقد انتهى الدكتور تمّام حسّان ـ وهو أكثر المحدثين المجتهدين المحتفين بهذا الدّرس- إلى حصر مظاهر التنغيم في ستة هي:
1. إيجابي هابط: يتمظهر في تأكيد الاستفهام بكلّ من الهمزة و(هل)، وفي تأكيد الإثبات.
2. إيجابي صاعد: يؤكد به الاستفهام بالهمزة و(هل).
3. نسبي هابط: يثبت به غير المؤكد، مثل الكلام في التحية والنداء، وتفصيل المعدودات.
4. نسبي صاعد: يتجلّى في الاستفهام بغير أداة، أو بـ (هل)، أو الهمزة.
5. سلبي صاعد: يكون في التمنّي والعتاب مضافًا إلى ذلك نغمة ثابتة تعلو على ما قبلها.
سلبي هابط: يكون في الإثبات غير المؤكد، والاستفهام بغير (هل) والهمزة، وفي تعبيرات التسليم بالأمر، وعبارات الأسف والتحسر.
إذا كان الدّرس السّابق يُعْنى بالأصوات مفكَّكةً غير مؤتلفةٍ في عنصرٍ لغويٍّ يلمُّ شعثها، فإن هذا المستوى عمدته دراسة هذه الأصوات وقد انتظمت في عنصر لغوي يسمَّى الكلمة، و(Morpheme)، ولذلك يُدعى هذا المستوى بالدراسة المورفولوجيّة (Morphology)، وهو ما يقابله في تراثنا (علم الصّرف)، قسيم علم التركيب (النّحو).
وفي هذا المستوى تدرس الوحدة اللّغويّة الصغرى (Morpheme) الّتي لها دلالة مستقلَّة، وما يتصل بها من تصريف واشتقاق، وما يضاف إليها من سوابق (Prefix) أو في أوساطها ويسمَّى (أحشاء Infixes)، ومـا يلحق بآخرها، ويسـمى اللواحق = الأعجاز (Suffixes) فتغيَّر بنيتها ودلالتها، وفيما يأتي تحديد كلّ مصطلحٍ مما سبق:
1. المورفيم: يعرف بأنّه اللّفظ الّذي يَدلُّ على معان تربط بين الماهيات، ويُطلق عليه أيضًا اسم: (وحدة صرفية). وقد تعدَّدت المصطلحات الّتي أشير بها إليه، فقيل: (الصيغم)، و(المورفيمة)،
و(الصرفية)، و(صرفيم)، و(صرفيمة)، و(الوحدة الصرفية)، و(الوحدة الدّالة)، و(المونيم)، ...
والـ (مورفيم) عنصرٌ لغويٌّ ينتظم في وحدات تدعى (السّلسلة الكلاميّة)، وهو يدلّ على المقولات النّحوية والصّرفية، وليس له ارتباط بالمعجم، ولا دلالة عرفيّة أو صرفيّة له، وهو الأدنى في السّلسلة الكلاميّة، ومن هنا لا يمكن أن يجزَّأ إلى وحدات أصغـر لها دلالتها الصّرفيـّة أو النّحويّة. ومثالـه ياء المضارعة في (يكتب)، والألف في اسم الفاعل نحو (نادم)، واللّام في (لام)، ...
2. السَّوابق (Prefix): وهي المورفيمات الّتي تقع في بداية الألفاظ، ومن ذلك سـين الاستقبال في (سيكتب) مثلًا، وهمـزة التعديـة في قولنا: (أذهب)، و (أجاد). ومثالها في الإنكليزية. مورفيم (im) في كلمة (Possible) بمعنى (المستحيل)، فبالسـابقة (im) انتقل معنى اللّفظ إلى (الممـكن) ومثلها السابقة (inter) في (international) الّتي تقلب المعنى في (national) من (وطنيّ) إلى (عالميّ).
3. الدواخل infixes: وهي مورفيمات تأتي في وسط اللّفظ تُقلّب معناه أو تغيّره، نحو (الواو) في (بيوت) جمع (بيت)، نقل هذا المورفيم اللّفظ من (المفرد) على الجمع. ومثل الألف في (بلاد) الّتي تنقل المفرد (بلد) إلى جمع أيضًا. وربما كان زيادة على ما رأينا،
وربما كان إنقاصًا نحو قولنا في (آكل): (أَكِلٌ) على زنة (فَعِل)، ومن ذلك في الإنكليزية (Bite) بمعنى (يعض) و (Bit) بمعنى (عَضَّ).
4. اللواحق أو الأعجاز (Suffixes): وهي المورفيمات الّتي تأتي في آخر اللّفظ نحو:
كاتب ⬅ كاتبة = التاء نقلت اللّفظ من التّذكير إلى التّأنيث.
ونحو: حلبيَّ ⬅ (يَّ) (ياء النسبة) غيّرت الدّلالة من الفعليّة إلى الاسميّة.
ونحو: كتابان ⬅ (ان) = غيرت اللّفظ من الإفراد إلى التثنية.
وما مثّلنا به يظهر لنا أنّ هذه المورفيمات قد تكون صوتًا قصيرًا كما في (فَهِم) بدلًا من (فاهم)، أو طويلًا كما في (كاتب)، وقـد تكون ملاصقةً للّفظ كما في (المطر) فـ (الـ) في الكلمة مورفيم تعريف، وجاء سابقًا اللّفظ وملاصقًا له، وقد تكون مقطعًا كما في (لن) من قولنا: (لنْ يفوز المقصِّر)، وقد غيّر هذا المورفيم الفعل من الإثبات إلى النّفي.
وبالنظر إلى ما تؤديه المباني التصريفيّة من دلالة، وما تضطلع به من وظيفة في إطار النّظام الصّرفي يمكن تقسيم هذه المباني ثلاثة أقسام، هي:
1. مباني التّقسيم، أو ما يسمَّى (أقسام الكلام).
2. مباني التّصريف، وهي الدالة على الجنس، والعدد، والمؤنّث، والمذكّر، والشّخص أو التّعريف.
3. مباني القراء من السّياقية، مثل الإسناد، والرتبة، والنبر، والتنغيم.
1. أقسام الكلام: وهي بحسب التقسيم القديم ثلاثة أقسام:
الاسم، والفعل، والحرف. وهذا تقسيم لقي من المحدثين نقدًا لخروجه على الواقع اللّغويّ، ولاعتماده على المنطق، لذا كان تمام حسّان (ت 2011 م)، أحد أهم الذين اجتهدوا وخرجوا على التصنيف القديم واستفادوا من إشارات متناثرة في بعض آثار القدماء من اللّغويّين، وانتهى إلى جعل القسمة سباعية لا ثلاثية، وهي:
أ. الاسم وأنواعه: اسم ذات، اسم معنى (مصدر)، اسم جنس، اسم مبهم، أسماء مبدوءة بميم زائدة (اسم الآلة، اسم الزّمان، اسم المكان)، وللاسم قرائن تميزه ويعرف بها.
ب. الصّفة: ويعني بها ما دلَّ على موصوفٍ بالحدث، ويشمل: اسم الفاعل، اسم المفعول، الصفة المشبَّهة، مبالغة اسم الفاعل، اسم التفضيل وللصفة خصائص مميزة أيضًا.
ج. الفعل: وهو كلمةٌ دالةٌ على حدث وزمن، وأقسامه ثلاثة: ماض، حال، مستقبل.
د. الضمير: وهو كلمةٌ جامدةٌ تدلّ على حضور المتكلم، أو مخاطبته، أو غيبته. ويدخل فيه الأسماء الموصولة، وأسماء الإشارة، ولا يقصرها على ما عهد من تقسيمٍ إلى متّصلٍ ومنفصل.
هـ. الخالفة: وهي مبنى جامد يدلّ على تعجبٍ، أو مدحٍ وذمٍّ، وأسماء الأفعال، وليست مقصورةً على (أسماء الأفعال) كما أشار أحمد بن صابر الأندلسيّ (ق 6 هـ)، أو أبو حيان الأندلسي (ت 745 هـ) أو الكوفيّون.
و. الظّرف: مبنى جامد صرفي دالّ على زمانٍ أو مكانٍ مختصَّيْن، أمّا ما ليس مختصًا من الظروف فلا يدخل في هذا التقسيم، وذلك كالاسم الّذي يأتي ظرفًا وغير ظرف، مثل كلمة (يوم) أو (ساعة)، أو (شهر)؛ لأنّها متصرفة، والظّرف وفق التّقسيم الجديد لا يتصرف.
ز. الأداة: وهي كلمةٌ «فقدت معناها المعجميّ وخلصت لأداء الوظيفة النّحويّة، وهي الرّبط بين الماهيات».
2. مباني التّصريف: وتشمل العدد، والشخص، والجنس (النوع) والتعيين (التعريف والتنكير).
3. مباني القرائن السّياقيّة: ويُقْصَدُ بها ما سمَّاه تمام حسان معاني القرائن، وهي قسمان:
أ. قرائنٌ معنويةٌ وتشمل: الإسناد (بين الفعل والفاعل وما يقوم مقامهما، أو بين المبتدأ والخبر)، والتّخصيص، والنّسبة، والتّبعية، والمخالفة.
ب. قرائن لفظية وتشمل: الرّتبة (الموقعية = تقديم، تأخير)، النّبر، التّنغيم، ...
جاء إيثارنا ههنا مصطلح التركيب (Syntax) على مصطلح النّحو (Grammar) اتّساقًا مع ما يعوِّل عليه اللّسانيّ، وأعني به (الدرس الوصفي)، في حين أنّ مصطلح (Grammar) يرتبط في ذهننا بالمعياريّة الّتي توجِّه أنظارها إلى مستوى الصّواب والخطأ قراءة وكتابة، ويسعى إلى الحفاظ على اللّغة الّتي هي موضوع دراسته من اللّحن، والتّصحيف، والتّحريف، ويجعل مستوى اللّغة الفصيحة هو المستوى المثال الّذي على المتكلم احتذاءه.
ويعني (علم التركيب) أن تتكئ فروع العلوم اللّغويّة على بعضها، وتتواشج فيما بينها يشدُّ بعضها أزرَ بعض، فيُستعان على دراسة النحو وتراكيبه بكلّ من الصرف، والبلاغة، والعروض، وعلم الدلالة، وغير ذلك، وهذا المسلك مفضٍ إلى تشعُّب ميادين الدراسة اللّسانيّة، و«تفسَّر اللّغة باللّغة، ويؤازر كلّ علمٍ قسيمه على النحو الّذي كان علماؤنا الأقدمون يؤثرونه ويطبقونه»، وهو ما نجد مصداقه في كتاب (سيبويه) مثلًا، أو في (الكامل) للمبرِّد، أو في كتب أعاريب القرآن، إذ كانت العلوم اللّغويّة كلها تتضافر فيما بينها، فلا يتخلَّف علم منها على رفد أخيه من العلوم بما يحتاجه الآخر.
وإذا كان منطلق الدّرس اللّسانيّ ـ على نحو ما رأينا سابقًاـ هو الصوت مخرجًا، وصفةً، وكانت الأصوات إنما تتآلف على نحوٍ من الأنحاء لتغدو بنىً ذات صيغٍ متعددةٍ. فإن المستوى التركيبي لا يأبه بالمفردة مستقلّةً، ولا يعبأ بها إلّا في سياق تركيبٍ معيَّن، يراد منه إبلاغ دلالةٍ مقصودة، ولذلك كانت دراسة الجملة هي أس
هذا المستوى من التحليل اللّسانيّ، ذلك أن متكلم اللّغة لا يفكر بالأصوات ولا بالبنى المفردة، وإنّما يفكر بالجمل.
فالمفردة إذا لم تسلك في نظم ذي روابط بين عناصره لا يمكن بها نقل ما يراد من فكر، أو عواطف، وهذا النظم والترتيب للجمل إنَّما يحصل «وفق عادات تفرضها لغة المجتمع على الفرد»؛ ذلك أنّ «تفكير الإنسان وتعبيره مرتبطان بالعادات اللّغويّة».
والدّرس اللّسانيّ الحديث لا يقف في درسه الجمل «عند العلاقات الشّكلية الّتي اهتم بها الدرس المعياري، إنما يتعدّى ذلك إلى البحث عن المعاني الّتي تُعبّر عنها تلك التراكيب».
ويشير مصطلح الجملة إلى وجود علاقةٍ إسناديّةٍ بين اسمين، فتكون جملة اسمية، أو بين فعلٍ واسمٍ فتكون جملةً فعلية، ولكلّ منهما غاية، إذ الأولى تدلُّ على ثبوت المسند للمسند إليه من دون الدلالة على التجدّد أو الاستمرار، في حين أنّ الثانية تبيّن العلاقة الإسنادية بين الفعل والاسم مع الدلالة الزمنية الماضوية، أو الحاضرة، أو المستقبلية، مع إرادة التجدد، أو الاستمرار من غير تجدّد . ويكون نظم كلّ جملة منهما على النسق الآتي:
أ – الجملة الاسمية: المسند إليه (المبتدأ) + المسند (الخبر).
ب – الجملة الفعلية: المسند (الفعل) + المسند إليه (الاسم).
والجملة عند النحاة «تعبيرٌ صناعيٌّ، أو مصطلحٌ نحـويٌّ لعلاقةٍ إسناديّةٍ بين اسمين أو اسمٍ وفعلٍ سـواء أتمت الفائدة بها أم لم تتم، ولذلك فهي أعم من الكلام، والكلام أخصُّ منها».
وقد كثرت القضايا الّتي تناولها في ميدان دراسة الجملة، وليس في قدرتنا أن نغطيها كلَّها في هذه الدراسة الّتي تميل إلى الإيجاز لا الإطناب والتفصيل، وتقتصر إلى الإشارة دون الإطالة.
وفي عربيتنا نمطان جُمْليّان أساسيان كما أشرنا من قبل هما: النمط الاسمي والنمط الفعلي، والنمط الثاني هو الأشيع في عربيتنا. يضاف إلى ذلك أنّ في اعتماد أنماط الجمل في اللّغة العربيّة على قرينتي الإعراب والرتبة فسْحًا أمام متكلّم اللّغة أن يقدِّم وأن يؤخر، كأن يقدِّم المفعول به على الفاعل (المسند إليه) وأن يؤخّر المبتدأ ويقدّم الخبر، وهكذا ... وهذا على نقيض اللغات الأوربية الّتي تشيع فيها دلالة الموقعيّة فحسب على وظيفة العنصر اللّغويّ، فلا تقديم ولا تأخير إلّا في حدودٍ قليلةٍ جدًا لا تذكر بالقياس على اللّغة العربيّة، فإن حصل في اللغات الأوربية تغييرٌ في الموقعيّة رُميت بالخطأ، والنمط الشائع في هذه اللّغات هو النّمط الّذي يدعى (النمط التحليلي) أما ما يخصُّ عربيتنا فهو النمط الإعرابيّ.
أمّا ما اشتهر من اتجاهات في تحليل الجملة فهي:
1 – الاتجاه الوظيفيّ: ويوجّـه عنايته إلى بيان طريقة استخدام
اللّغة وتوظيفها كوسيلة تواصل، وهذا الجانب «الوظيفي ليس شيئًا منفصلًا عن النظام اللّغويّ نفسه...».
والجملة من الوجهة الوظيفية تقوم على عنصرين أساسيين هما: المسند والمسند إليه، و «يتحدَّد كلٌّ منهما استنادًا إلى ما تثيره كلّ كلمةٍ من كلمات الجملة من الانتباه»، ويعدُّ (أندريه مارتينيه) رأس الهرم في هذا الاتجاه، وقد وقفنا من قبل عند أصول هذا الاتجاه.
2 – الاتجاه التوزيعيّ: وعمدته الطريقة الشكليّة، في سبيل بلوغ المكونات النهائية والمباشرة للجملة، ويعدّ (بلومفيلد) (ت 1949) ممثل هذا الاتجاه في كتابه (اللّغة) فإذا اقتبسنا المثال الإنكليزيّ: (Poor John ran away)، وترجمته: (هرب جون الفقير)، كانت الجملة وفق هذا المنهج مكوّنةً من مكوِّنين مباشرين على النحو الآتي:
1 – المكوّن المباشر الأوّل: Poor John
2 – المكوّن المباشر الثّاني: Ran away
فكلُّ مكوِّنٍ يشكّل صيغةً معقّدةً، ولكن المكونات المباشرة لكلّ منهما هما:
أ. Poor + John = بالنسبة إلى المكوِّن الأول.
ب. Ran away = بالنسبة إلى المكوِّن الثاني.
ثم هناك مكونات نهائية لهما، هي المورفيمات (الوحدات الصرفية)، وأخيرًا تأتي المكونات النهائية، وهي:
1 – Ran = مورفيم مستقل.
2 – away = a مورفيم + way = مورفيم.
ولكن التّوزيعيين لم يكونوا على قلب رجل واحدٍ، فقد كان منهم من اتّبع التّوزيع الهرميّ، ومنهم من اعتمد البنية المشجَّرة، ومنهم من اتبع مبدأ «التقويس = حصر كلّ عنصر في قوس»، أي اعتمد على وضع «أقواسٍ متداخلةٍ لتمييز المقاطع الداخلة في التركيب».
3 – الاتجاه التوليدي التحويلي: ويعتمد على العودة بالجملة إلى مكوناتٍ مباشرةٍ سعيًا للوصول «إلى قواعد شاملة تنتظم تركيب الجملة في جميع اللغات» ، اتكاء على الاعتقاد بوجود عواملٍ مشتركةٍ بين البشر جميعهم، وهذه العوامل ليس إلّا ممثلة لأوجه الشبه الّتي يمكن أن يلحظها الدّارس بين لغات العالم، وهي الّتي سميت بالنّحو الكليّ.
وقد وقفنا مليًا -من قبل- عند أصول هذا الاتجاه اللّسانيّ وآرائه ونقتصر -ههنا- على الوقوف على أركان الجملة عند (تشومسكي)
ممثل هذا الاتجاه وباني صرحه، وهي:
1. الجملة ⬅ مركب اسمي + مركب فعلي ويرمز لهما بـ
1- (S➡NP +VP)
2. المركب الاسمي ⬅أداة تعريف + اسم
2- (NP➡ T + N)
3. المركب الفعلي⬅الفعل + المركب الاسمي
3- (VP ➡ V+NP)
4. أداة التعريف ⬅ ألـ
4- (T ➡ The)
5. الاسم ⬅ (رجل، كرة)
5- (N ➡ man، ball)
6. الفعل ⬅ (ضرب، أخذ)
6- (V ➡ hit، took)
فإذا أردنا تحليل الجملة الإنكليزية الآتية:
The Man Hit the Ball
(97)وأردنا تطبيق قواعد (تشومسكي) آنفة الذّكر، يمكننا أن نمثِّل التّحليل في الخطاطة التشجيرية الآتية:
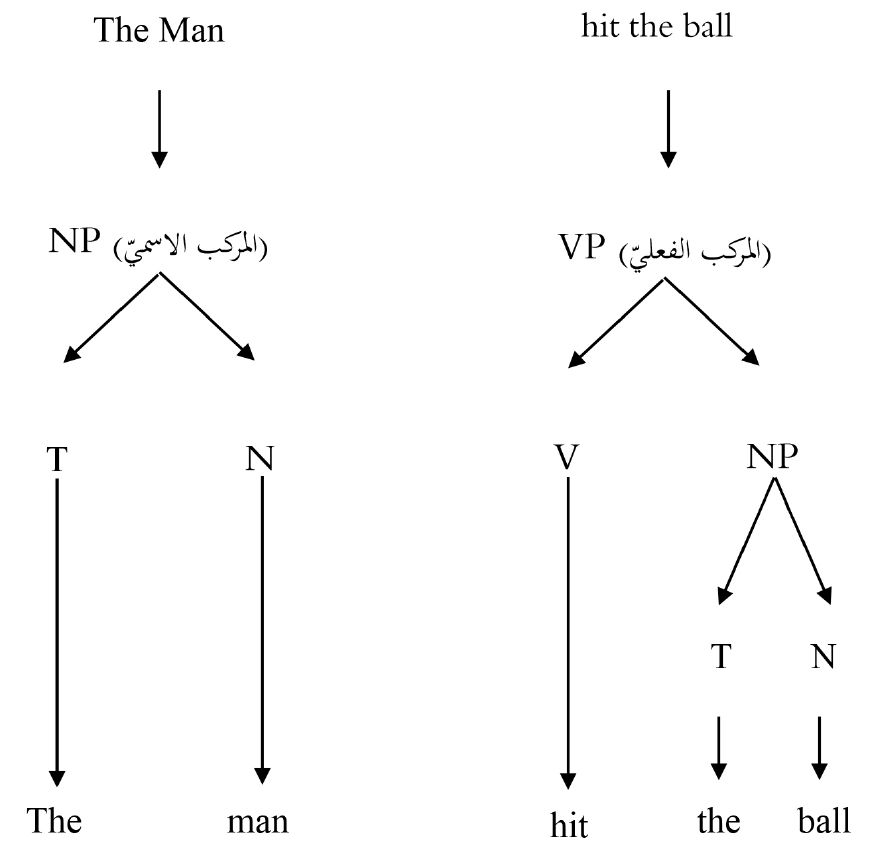
ويمتاز هذا الاتجاه بتوليد «جمل اللّغة كلّها من الجملة النواة (Kernal)، وهي الجملة الخبريّة البسيطة المبنيّة للمعلوم»، كما في الجملة المحلَّلة، إذ منها نُفرّع الجملة المبنيّة للمجهول، والجملة الاستفهامية... وقد تعدَّدت نماذج التحليل عند (تشومسكي) ومَنْ لفّ لفّه من تلاميذه ومريديه، فكان ثمة التحليل المشجَّر، والمربّع، والمفرَّع، والمدور، ...
وهو مآل الاتجاهات اللّسانيّة السابقة، وذروة سنام الدّرس اللّسانيّ؛ لأنّه به تتحقق عملية التواصل الصّوتيةّ، فاللّفظيّة، فالجمليّة، فإنّما تنتظم الأصوات في ألفاظ، وتُنْظم المفردات في جمل، وغاية هذه الجمل الدّلالة على ما يريده متكلم اللّغة وما يبتغيه.
ويُعَدّ علم الدلالة قمّة الدّرس اللّسانيّ، ذلك أنّ «الحياة الاجتماعية تُلجِئ كلّ متكلّمٍ إلى النظر في معنى هذه الكلمة أو تلك، وهذا التركيب أو ذاك»، فهو ليس أحد فروع الدّرس اللّسانيّ شأنه شأن الأصوات والتركيب كما يرى بالمر، بل هو ذروة سنامها.
ومدار هذا المستوى الكشف عن المعنى اللّغويّ للمفردة والتركيب، ذلك أنّ المعنى «في المآل والنتيجة هو القصد من إنتاج المتكلم للسلسلة الكلاميّة بدءًا من الأصوات وانتهاءً بالمعجم، ومرورًا بالبناء الصرفي وقواعد التركيب، وما يضاف إلى ذلك كلّه من معطيات المقام الاجتماعية والثقافية».
ولنا أن نفرِّق في نشأة (علم الدلالة) بين مرحلتين:
قديمة: وكان اللّغويّون في هذه المرحلة أكثر الشّرائح اشتغالًا بها؛ إذ إنَّ فهم التّراث أصلًا مرهونٌ بالوقوف الدّقيق على الدّلالة
الّتي تتحملها الألفاظ ودليلنا على ذلك أنّها لم تكن خاصة بميدانٍ دَرْسيٍّ واحد، فقد عَمَّت النّحو، واللّغة، والفقه وأصوله، وغير ذلك، ويعضد ذلك ما قام به اللّغويّون الأوائل الّذين وضعوا وسائلَ لغويّةٍ غدت نواة المعاجم الكبرى، سواء في ذلك معاجم الألفاظ أم معاجم المعاني، وكذلك اعتناء العلماء وبالاشتقاق، والتمييز بين الحقيقيّ والمجازيّ في الاستعمال اللّغويّ، واهتمام علماء أصول الفقه بالدّلالات الرّاشحة عن التّركيب؛ لأنّ نحوهم نحوٌ دلاليٌّ لا إعرابيّ.
حديثة: ويُعْزى فيها وضـع اللبنة الأولى فيمـا صرحه إلى الباحـث الفرنسي ميشيل بريال Michel Bréal الّذي نشر مقالةً سنة 1883، ووضع كتابًا أسس فيه لهذا العلم سنة 1897م. وجاء بعده (جيمس دارمستيتر James Darmesteter) الّذي ألّف كتابًا بعنوان (حياة الكلمات) الصادر سنة 1887م.
يُضاف إلى ذلك كتاب (معنى المعنى) لـ (Charles Kay Ogden)، و(I. A. Richards) وفيه أشارا إلى عقادة مسألة المعنى وطبيعته. واتسعت آفاق الدرس الدّلالي على يد (جون فيرث John Rupert Firth) و(ستيفين أولمان Stephen Ullmann) و(ليونز John Lyons) و(بالمير Frank R. Palmer) و(غريماس Algirdas Julien Greimas) و(بيير جيرو Pierre Guiraud)
وغيرهم، ولا يتسع المقام للتعمق التاريخي في أوليات هذا العلم وسيرورته التطوريّة.
ولم يسلمْ هذا العلم من مشكلات، فمن ذلك عدم محدوديّة المصطلح واقتصاره على ميدانٍ واحد، ومن ثمَّ استعماله في تخصُّصات متعدّدة، على جانب الخلاف في وحدة التحليل الدلالي: أهي الكلمة أم الجملة؟ فعلى حين يرى البنيويّون أن (الكلمة) هي اللّبنة الأولى للتحليل الدّلاليّ، يرى التّوليديّون أنّ الدّلالة الحقيقيّة هي دلالة (التركيب = الجملة)؛ إذ هي الحامل لمنظومة الألفاظ، والألفاظ جزءٌ من الجملة، وبهذا ينطلق هؤلاء من الجزء إلى الكلّ ولا يرون العكس صحيحًا. أما أصحاب الاتجاه الأوّل فحجّتهم أنّ البُنى اللّغويّة متعددة، وهذا يؤول إلى تعدّدٍ في الدّلالات. وهم يقدِّمون دراسة معنى البُنى اللّغويّة منفردة للوقوف من وراء ذلك على مدى اتّساق هذه الوحدات في البنية الكليّة، على حين يرى أصحاب التّركيز على تحليل الجملة الدلاليّة من دون أن يعبؤوا بتحليل اللّفظة مفردة إيمانهم بأنّ معنى التركيب أكبر قسمة من معنى الألفاظ الّتي تشكِّله.
وقد تعدَّدت المحاور الّتي اضطلعت بها الدراسات الدلالية في العصر الحديث وفق ما يأتي.
1. محور الدّلالة: ويدخل تحته دراسة المعنى، والحقل الدلالي، والسياق، وأنواع المعنى.
2. محور العلاقات الدلالية: كالترادف، والاشتراك، والتضاد، والاقتراض.
3. محور التطور الدلالي: يدرس الأسباب الداخلية والخارجية له، وكيفية حصول هذا التغيُّر، والمجاز، والاستعارة، ومظاهر مَجليات التغيٌّر الدلالي.
ولا أحسبنا نستطيع أن نترك للقلم جموحه وحميته في تفصيل كلّ محور من المحاور السابقة، إذ إن ذلك يحتاج إلى مثل ما سوّدناه من صفحات سابقات ذلك أنها محاورٌ متعددة الفروع، وأن كلّ فرع يحتاج إلى تفصيل لا يتسع له صدر دراسة تهدف إلى الإطلالة دون التملِّي، وإلى الإشارة دون العبارة، وإلى التلميح دون التصريح.
ولعلَّنا فيما سبق لنا أن قدّمناه على نحوٍ موجزٍ وفق ما يقتضيه المقام أن نؤكد أن الدّرس اللّسانيّ طريقٌ مَهْيع، مترامي الأطراف، معرِقٌ في التاريخ القديم، مستوعبٌ لما حَدَّ وحَدُث، متعدّد الفروع، مختلف المدارس، وافر الاتجاهات، متطاول البنيان.
لقد استحالت اللّسانيّات إلى «مولِّدٍ بشتّى المعارف، فهي كلَّما التجأت إلى حقلٍ من المعارف اقتحمته فغزت أسسه حتّى يصبح ذلك العلم نفسه ساعيًا إليها ... فقد كانت للّسانيّات فضلُ تأسيس جملةٍ من القواعد النّظريّة والتّطبيقيّة أصبحت الآن من فرضيات البحث ومسلَّمات الاستدلال ... وأبرز هذه القواعد فضلًا عن النّزعة العلمانيّة ... اثنتان: قاعدة تمازج الاختصاص، وقاعدة التفرُّد والشّمول ...».
(103)
يمكن القول بقليلٍ من المجاز إنَّ ما يمتاز به القرن العشرون أمران: أوّلهما بسط المنهج الوصفيّ سلطانه على الساحة الدرسيّة، وظهور شخصيّة (فرديناند دو سوسور Ferdinand de Saussure) الذي كان ما قدَّمه من جهدٍ في الدرس اللّسانيّ، وتركه من أثرٍ فيه أشبه ما يكون بالثورة الكوبرنيكية.
ولد (فرديناند دو سوسور Ferdinand de Saussure) في جنيف سنة 1857 م وتوفي سنة 1913م. تأثّر (سوسور) بالاتجاهات والقيادات الّتي كانت سائدةً آنئذٍ، ومن هؤلاء المؤثرين فيه (ميشيل بريال Michel Bréal) (1832-1915م)، و(دوركهايم ةmile Durkheim) زعيم المدرسة السّوسيولوجية، ورائد علم الاجتماع الّذي كان يبسط سلطته عصرئذٍ، و(تارد Gabriel Tarde) زعيم تيار علم النفس الجماعيّ، فكلّ أولئك كان لهم «مسارب في أعمال
سوسور الألسنيّة»، وتركوا فيه بصمات لا تُنكر، ولكنّه كان «هو الّذي جمع خيوط المسألة الألسنية».
كتب (سوسور) رسالةً في «ملاحظات حول النظام البدائي لصوتيات اللغات الهنديّة الأوربيّة» (1878 م) وأخرى في «حالة الجرّ المطلق في اللّغة السّنسكريتيّة (1881)».
ولكن شهرته لا تعود إلى ذينك المؤلفين الجامعيين المهمين السّابق ذكرهما، بل إلى المحاضرات الّتي ألقاها (سوسور) في جامعة جنيف في تشرين الثاني سنة 1891م، وكانت مفتتح تدريس تاريخ اللغات الهنديّة الأوربية وعقد المقارنات فيما بينها، وهذه المحاضرات شاهد «على الحالة الفكريّة لدى (سوسور) في تلك الفترة حول مسائلٍ أساسية، ولاسيما حول أهميّة وصف القوانين العامة للغة بالارتكاز إلى دراسة الألسنة أو إلى شروط التعديلات الّتي تطرأ عليها أو إلى المسألة الأساسية المتعلقة بماهية اللّسان عبر الزّمن».
فـ (فرديناند دو سوسور) لم يؤلّف كتابًا مستقلًا عنوانه (محاضرات في اللّسانيّات العامّة)، وإنّما ألقى محاضرات ثلاثًا قام تلميذان له هما (سيشيهاي Albert Sechehaye) و(شارل بالي Charles Bally ) بجمع الأمالي الّتي دوّناها عن أستاذهما (سوسور)
فقد حيل بينهما وبين سماع محاضراته في اللّسانيّات العامّة، فعقدا العزم على إعادة تنظيمها في كتابٍ أصدره سنة 1916م، وترسَّـخت من خلاله «مصطلحات مهمَّة جدًا في نظريّة (دو سوسور)، مثل: لسان، ولغة، وتعاقبية، وتزامنية، ودال، ومدلول».
لقد كان (دو سوسور) يسلك مسلك أستاذٍ حقيقيّ، ذلك أنّه كان يقوم بشرح الوقائع شرحًا واضحًا، ويتّكئ على نماذجٍ لغويّةٍ محدَّدة، ويقرِّب البيانات من فهم تلاميذه، ويتسع في بعض القضايا مع الحفاظ على ترابط تامّ».
ولم يصادف الكتاب إلّا بعد عام 1967 خاصة إذ شهد هذا العام «انتشارًا واسعًا لأفكار الدارسين» ، وبناءً على ذلك «عُدَّ سوسور الأب الحقيقيَّ للسانيات في القرن العشرين».
بُنِي كتاب (سوسور) على مقدمةٍ وخمسة أبوابٍ، أما المقدِّمة فعرض فيها قضايا لسانيّة عامة، نحو: تاريخ اللّسانيّات ومادتها، وأسس علم الأصوات، ومفهوم الفونيم (Phoneme) وعرض في الباب الأول مفاهيم كلٍّ من: العلامة، واللّسانيّات السّكونيّة، ثمّ اللّسانيّات التّعاقبيّة.
وناقش في جزئه الثّاني مفهوم الوصفيّة في اللّسانيّات أو ما سماه اللّسانيّات التّزامنية، والنّحو وما يتفرّع عنه.
وخصَّ الباب الثالث بدراسة اللّسانيّات التّاريخيّة، والتّأصيل، والتبدُّلات الصّوتيّة.
وتناول في الباب الرّابع اللّسانيّات الجغرافيّة، والتّعدد اللّغويّ، وأسباب التّنوع اللّغويّ، وانتشار الهجرات أو الموجات اللّغويّة.
وناقش في الباب الخامس مسائل مرتبطةٍ باللّسانيّات الاسترجاعيّة ويعني بها اللّسانيّات التّاريخيّة الـمتّجهة نحو الأقدم، والمسائل اللّغويّة الأكثر قدمًا، والعلاقة بين اللّغة والأنثربولوجيا.
ولعلَّ سردنا لأهم مصطلحات الكتاب وأفكاره يكون له أثّر في تبيان جملة الأفكار الّتي يتبنّاها (سوسور) ويبديها في كتابه؛ ولذلك لنا وقفتان: أوّلاهما: ترتبط بالمصطلحات الأساسيّة الّتي تناثرت في كتابه، وثانيتهما: الأطاريح الّتي فرشها (سوسور) في ثنايا كتابه، أو قُلْ: محاضراته، أما المصطلحات فهي:
أ. العلامة: وهذه العلامة تؤكّد الترابط بين (اللسانيات) و(السيميولوجيا)؛ ولذا يحسن التفريق بين ما هو في صلب المصطلح (السيميولوجيا)، كالرمز والأيقونة، وبين العلامة الّتي هي مصطلحٌ لسانيٌّ بحت، وأكثر تعقيدًا من الدليل، والرمز، والإشارة. فالرمز إشارةٌ اعتباطيّةٌ لا رابط بينها وبين ما يشير إليه، وقد يكون اصطلاحيًا (اتفاقيًا)، وهو يربط بين عنصرين. فالرمز يتصف بالثبات كما في الرمز بالميزان إلى العدالة.
أما الأيقونة فهي ترتبط بعلاقة مشابهةٍ مع الواقع الخارجي، وتكسب ما تومئ إليه خصائصها، فإذا رسمنا (كرسيًا) فهذا الرسم يشكّل (أيقونةٌ) للكرسي الواقعي الأصلي، وتتشابه مع الأصل من
جهة الهندسة الشكليّة والغاية الوظيفيّة، وهي كذلك شيءٌ معلَّل، وشكلها ليس نتاج محض المصادفة، نحو (بقعة الدم) الرامزة للون الأحمر، والبقعة السوداء الّتي تشير إلى اللّون الأسود.
إنّ (العلامة اللّسانيّة) تختلف عن كلٍّ من الإشارة والرّمز والأيقونة، وتبدو معقَّدةً منها، «وتتشكل لفعل سلطان الترابط بين صورةٍ سمعيّةٍ تدعى الدالَّ، وتصوّرٍ يُدعى المدلول».
ينظر (سوسور) إلى العلامة على أنّها كيانٌ لغويٌّ له وجهان:
الأول: هو الدالّ، وهو تتالٍ لأصواتٍ مركّبةٍ يشكّل واقعًا ماديًا.
والثاني: المدلول، وهو المفهوم، أو الفكرة، أو التصوُّر الّذي تستحضره الصّورة السّمعية (الدّالّ)، وليس المراد بالصّورة السّمعيّة الأثر الفيزيائيّ (الصّوت) فحسب، ولكن هي الانطباع النفسي للتّمثل الصّوتي الّذي تشهده حواسّنا.
فالعلامة اللّسانيّة «كيانٌ نفسيٌّ ذو وجهين قائمٌ على اتحادٍ لا ينفصل بين الدّالّ والمدلول، وهذه العلامات حقائقٌ واقعيّةٌ تتموضع في الدّماغ البشريّ تُحَسّ وتُلمَس، فضلًا عن قدرة الكتابة على تثبيتها ماديًا بصورٍ اصطلاحيّة اتفاقيّة».
وتتصف العلامة بثلاث خصائص هي:
أ. الاعتباطيّة: فارتباط الدّالّ بالمدلول لا ينتظمـه رابطٌ منطقيٌّ
أو قياسيّ، فالعلاقة بينهما علاقة كيفيّة، فلا صلة تربط بين الشّيء والتسمية. وأمر الاعتباطية جاء بصيغتين في المخطوطات الّتي سجّلها تلاميذ (سوسور) عنه، ولذلك طرح (لويك ديبكير Loïc Depecker) سؤالًا عن نسبيّة الاعتباطية أو كلّيتها، ذلك أنَّ أحد تلاميذ سوسور سجّل في دفتره أنَّ سوسور قال: إنها اعتباطيّة كليًا، ولكنّ تلميذًا آخر سجل: العلاقة الّتي تربطهما اعتباطية، في حين أن (ديغالييه) كتب: العلاقة الّتي تربطهما اعتباطية كليًا. وهنا لجأ (ديبكير) إلى نصّ محاضرات فوجد فيه: «إنّ العلاقة الّتي تربط بين الدّالّ والمدلول اعتباطيّةٌ، أو بالأحرى، وبما أنّنا نعني بمصطلح (إشارة) الكلَّ الناتج من ربط الدّالّ بالمدلول، يمكننا القول بشكلٍ أكثر بساطة: إنّ الإشارة اللّغويّة اعتباطية».
وهذه الاعتباطيّة تُفضي إلى أن تقف اللّغة عاجزةً مكتوفة الأيدي أمام الرّوابط الّتي قد توجدها عوامل ما بين الدّال ومدلوله، وتنأى باللّغة عن المفهومات الاجتماعية الثابتة، وتفرض الدلالة على الجماعة اللّغويّة فرضًا؛ إذ ليس في استطاعة أحدٍ متكلّمي لغة الجماعة أن يبدّل لغتها، وبهذا توجد علائقٌ غير متينةٍ بين طرفي الدّلالة (الدّال والمدلول)، ذلك أنّ اللّغة «تمتثل لقانون الوقت، أي قانون التبدّل والتّطور، فهي تتطور عبر الزمن وتخلق علامات جديدة أو تبدل العلاقة بين الدّالّ والمدلول».
ويضرب (سوسور) لذلك كلمة (أخت) فالمتوالية الصوتيّة لهذه
العلامة = الكلمة ليس بينها وبين مدلول الأخت (فكرة الأخوة) رابط داخلي معلَّل، فليس بينهما أي رابط طبيعيّ.
وكلمة (كلب) المؤلفة من متتاليةٍ صوتيّةٍ هي (الكاف، واللام، والباء) لا ترتبط برابطٍ طبيعيٍّ بالتصوَّر (الفكرة) الّتي يُشار بها إليها، والدليل على ذلك «أنّ اللغات تطلق تسميات متباينة على أشياءٍ متماثلة، ومن ذلك كلمة (Dog) في الإنكليزية و(Chien) في الفرنسية، و(كلب) في العربيّة، و (Hund) في الألمانية ...».
ولنا أن نستثني من مفهوم الاعتباطيّة الّتي نادى بها (سوسور) فنقول: إنّها ليست اعتباطيّةً كلية، وليست اعتباطيّةً مطلقة، ذلك أنّنا نجد أنّ العلاقة بين الاسم والمسمَّى في فكرنا العربي الإسلامي لا يمكن تفسيرها بمبدأ (الاعتباطية)، ففي قوله تعالى: ﴿تَبَارَكَ اسْمُ رَبِّكَ ذِي الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ﴾ [الرحمن: 78] يستحيل علينا أن نقول: إنّ (البركة) للمسمى الّذي هو (الله) لا للاسم الّذي هو الصّورة السّمعية، إذ لا اسم يتطابق مع المسمَّى إذا أطلق على مسمَّى فيه الوصف، فـ (البركة) للمسمى وللاسم معًا.
ومثل ذلك نجد بعض الألفاظ في العربيّة تحاكي صورتها (السّمعية) المفهوم (التصوُّر) المعبَّر بها عنه، نحو قولنا: (زلزلة)، (وشوشة)، (خرير)، (حفيف)، وهو ما أشار إليه ابن جني في حديثه عن نشأة اللّغة تقليدًا لأصوات الطّبيعة. ولقيت هذه النّظرية من العالم الألمانيّ (هردر Johann Gottfried Herder) اقتناعًا بها ومنافحةً
عنها، لكنّه نكص عنها فيما بعد لضعف الأساس الّذي أُسست عليه. وهذا يعني «أنّ الأمثلة القليلة الّتي تتصاقب فيها المعاني والألفاظ في العربيّة أو في الإنكليزيّة لا يرقى بهذا الرّأي الفطير من أفق التخمين والرّجم بالغيب إلى أفق اليقين والوصول إلى مرتبة العلم، والقوانين تُبنى على الكثير المطّرد لا على القليل النّادر».
ب. الخطية: وهي سمةٌ بديهيّةٌ في العلامة اللّغويّة، إذ للدال صورة سمعيّة متناهية في الزّمن، ولها امتداد زمني تكمن فيه التغييرات، وهو يمثّل اتساعًا، ويمكن قياسه في بعدٍ واحد.
فالخطية تعني تعاقب العلامات اللّسانيّة في السّلسلة الكلاميّة، ولكن يستحيل عليها أن تظهر في وقتٍ معًا في نقطةٍ واحدة، فلا يمكن أن نلفظ كلًا من (ب) و(ج) في وقتٍ واحدٍ معًا، فالصّورة السّمعية تتالي أصواتٍ تشكّل الكلمة، والجملة تتالي كلمات، والخطاب توالي جمل.
ت. القيمة أو التّمييز: والمراد بذلك أنّ وجود أيّةِ علامةٍ لغويّةٍ شرطه وجود علاماتٍ أخرى متمايزةٍ مختلفةٍ فيما بينها؛ ذلك أن ليس للغة إلّا وجود الاختلافات، وليس بين علاقةٍ وأخرى إلّا التقابل، «وكلّ آليةٍ لسانيّةٍ إنّما تقوم على تقابلاتٍ من هذا النّمط وعلى الفوارق الصّوتيّة والمتصوّرة الّتي تفترضها».
فأصوات اللّغة هي وحداتٌ مميّزةٌ ومتمايزة؛ ذلك أنّنا إذا قمنا بعمليةٍ استبداليّةٍ لحرفٍ مكان حرفٍ استدعى ذلك تصوُّرًا آخر غير التصوّر السّابق، فإذا افترضنا كلمتي (حاطب) و(خاطب)، فهما متشابهتان من جهة البنية الشكليّة الإيقاعيّة، ولكنهما متمايزتان لأنّ صوت الحاء في (حاطب) يتمايز من صوت (الخاء) في خاطب، فالتقابل بينهما، أعني صوتي الحاء والخاء متميزة، ومن ثم تكون الكلمتان متمايزتين دلالة.
وصفة التمييز هذه تعدّ شرطًا أساسيًا «لتقطيع السّلسلة الكلامية إلى وحداتٍ يمكن فصلها وعزلها عن بعضها البعض هو ما ساعد الألسنيّة على التأكيد على مبدأ الحضور أو الغياب، والتشابه أو الاختلاف بين هذه الوحدات».
إنّ محاضرات (سوسور) مجْلى لجملةٍ من الثّنائيات الّتي تركت بصماتها على الدّرس اللّسانيّ طوال سنواتٍ مديدة، إلى جانب طرحه أفكارًا عديدة، نحو: مفهوم اللّسان، وغاية الدّرس اللّسانيّ، وموقفه من وجود أصلٍ للغة، أو وجود اللّغة (اللّسان الأم).
أما الثّنائيّات التّقابليّة فيمكن أن نصنِّفها وفق ما أراد (سوسور) إلى:
وهذا تفريقٌ بين ما هو ظاهرة بشرية عامة مصدرها الملكة اللّغويّة، وبين ما هو تجلٍّ أو مظهر معيَّن من هذه الظّاهرة، كأنْ نقول: اللّغة، اللّسان العربي، أو الإنكليزيّ، وبين مصطلحٍ ثالثٍ هو
الكلام (parole) وهو تمظهرٌ ينتمي إلى اللّسان، والفرق بين هذه المصطلحات إنّما هو في الفرق بين ما هو اجتماعي، وبين ما هو فَرْديّ، فاللّغة ظاهرةٌ إنسانيّةٌ عامّة، واللّسان أضيق نطاقًا من اللّغة؛ ذلك أنّ عمدته العُرْفيّة والمجتمعيّة والاكتساب. أما الكلام فهو ذو طبيعة فرديّة، فاللّغة «كنزٌ يدَّخره الأفراد الّذين ينتمون إلى مجموعةٍ واحدةٍ عبر ممارسة الكلام، وهـي منظومة قواعدٍ موجودة ـ شاء الفرد أم أبى ـ في كلّ دماغ، ... ولا تتجلّى اللّغة إلّا بفعل تحقيقٍ فرديّ لها، نعني به الكلام».
فاللّسان ـ عند سوسورـ «مجموع المبادئ الخاصة الّتي تحدِّد اللّغة البشرية». ولَمَّا كان (اللّسان) ظاهرةً اجتماعيّةً وأداةً عُرْفيّةً يتفاهم بها أبناء مجموعة لسانيّةٍ كانت مهمة اللّسانيات دراسة اللّسان لا دراسة اللّغة الظّاهرة الإنسانيّة، ولا دراسة اللّسان ذي الخصيصة الفرديّة، إذِ اللّسانيّات لا تستطيع أن تقترب من هدفها (دراسة التكلم البشري) إلّا من خلال الألسنة، ذلك أنّ المبادئ الّتي ستعمل الدّراسات اللّسانيّة على استخراجها من ألسنة هي الّتي ستؤدي إلى بناء اللّسان.
فمفهوم اللسان يبدو للمدقق أحد المبادئ الّتي توجِّه فكر سوسور ذلك أن غاية الدّرس اللّسانيّ مرتبطةٌ بـ «اللسان كمجموع مبادئٍ تُستخرج من خلال تحليل الألسنة، وكتأمّلٍ مجرَّد، وكتجريد» .
وبهذا يلاحظ أنَّ (سوسور) يفصل بين ما هو فرديّ وبين ما هو اجتماعيّ، بين ما هو جوهري وما هو عَرَضي، بين ما هو منظومة عامّة وبين ما هو نسق فرديّ، بين ما هو شكل وبين ما هو تمظهر لهذا الشّكل.
ونتيجة ذلك فرَّق (سوسور) بين علم لسانيّات اللّغة، وعلم لسانيّات الكلام، وبين اللّغة على أنّها شكل، والكلام الّذي هو تمظهر فرديّ من خلال متتاليات صوتية يؤدَّى بها معنى.
وقد أعرض غير ما لسانيّ عن الأخذ بثنائية اللّغة والكلام الّتي كانت جوهر مقولة (سوسور)، وجعلوها ثلاثيةً بدلًا من ثنائية، فهيلمسليف لا يجعل اللّغة منظومةً بل خطَّة، والكلام هو الجانب الإجرائي لهذه الخطة، وفرّق (تشومسكي) بين ما سمَّاه (الكفاية اللّغويّة)، وهي تقابل مفهوم منظومةٍ لغويّةٍ عند (سوسور)، والأداء الكلامي، وهو مقابل الكلام عند (سوسور) وفرَّق غيره بين اللّغة، والكلام، والخطاب.
وما تقدَّم كلّه يشير إلى أنّ من اللسانيين مَنْ لم يأخذ ثنائية (سوسور) مسلَّمات أو قوانين صارمةٍ لا يمكن تجاوزها، فكثيرٌ من اللّسانيّين ضربوا بتمييزات (سوسور) عرض الحائط، فرأوا «أنّ اللّغة ظاهرةٌ عامّةٌ والكلام ظاهرةٌ عيانيّة ... اللّغة دائمةٌ والكلام ظاهرةٌ عابرةٌ، ...».
2. التزامنيّة / والتّعاقبيّة: والمراد بذلك أنَّ دراسة اللّغة في الإطار الزمني يمكن أن تدرس وفق منهجين اثنين:
أ. تخصيص الدّرس اللّسانيّ بزمنٍ معيّن، ودعاها (سوسور) synchronic)) كأنْ ندرس اللّغة في القرن الهجريّ الأوّل لنقف على التغيُّرات الصّوتيّة، والتّركيبيّة، والدّلاليّة الّتي أصابت اللّغة، وقد عُرِف هذا المنهج بالمنهج التزامنيّ.
ب. الدراسة التعاقبيّة للظاهرة اللّغويّة خلال مراحلٍ زمنيّةٍ متتالية، يأخذ بعضها برقاب بعض، واصطلح عليها بالدراسة التعاقبيّة أو التطوريّة، وعبّر عنها بـ (diachronic)، وهذا المنهج هو الّذي صبّ الدّرس العلميَّ بميسمه، وأصبح السّبيل العلميّ الوحيد لدراسة اللّغة.
والفرق بين المنهجين أو الطّريقتين في الدّرس اللّغويّ أنّ «اللّسانيّات التّزامنية تجعل وكدها في دراسة اللّغة في حالة ثباتٍ وديمومةٍ خلال زمنٍ معين، أما الأخرى فتوجّه الأنظار إلى التطوّرات اللّغويّة خلال الزمن».
3. ثنائية النظم والاستبدال: ونعني بـ (النظم) المحور السّياقي الّذي ترتبط فيه العناصر اللّغويّة، وهو ما أطلق عليه مصطلح
(Syntagmatic)، أي «المجموعات اللّغويّة الحاضرة في الجملة والتي تشكّل محورًا أفقيًا نظميًا».
فالمحور النَّظمي يعني العلاقات السياقيّة التركيبيّة بين وحدةٍ لغويّةٍ وأخرى، وهذا المحور الّذي يقع على عاتقه بنيات الخطاب، وتتشكَّل الأنساق، وتتمظهر العلاقات السياقيّة بوساطة أسسٍ قواعديّةٍ تجعل هذه العناصر متآلفة فيما بينها، نحو قولنا: [الكاتبُ المبدع يهتمُّ بإبداع الصور]. فيلاحظ أنّ كلمتي (الكاتب المبدع) ترتبطان بعلاقة النعتيّة، ومن الأصول المقرَّرة وجوب تطابق النعت مع منعوته، وأنّ كلمة الكاتب مؤلفةٌ من أداة التعريف (ال) + كلمة (كاتب)، فهذه الأداة (ال) غيَّرت بنية الكلمة من التنكير إلى التعريف، وهكذا لو تابعنا كشف العلاقات السياقية للتركيب لوقفنا على محورٍ نظميٍّ لو استبدل فيه عنصر بآخر لربما يؤدي ذلك إلى خللٍ دلالي.
أما المحور الاستبداليّ، وما يطلق عليه مصطلح (العلاقات الجدوليّة) فتعني علاقات التبادل بين الوحدات اللّغويّة الّتي تضطلع بأداء الوظيفة نفسها، فهذا المحور هو الّذي يجعل متعلم اللّغة حرًَّا في اختيار العنصر الّذي يتطابق مع الموقع من جهةٍ ومع الوظيفة من جهةٍ أخرى، وفق ما تسمح به منظومة قواعد اللّغة.
ويمكن توضيح هذين المحورين بالخطاطة الآتية:
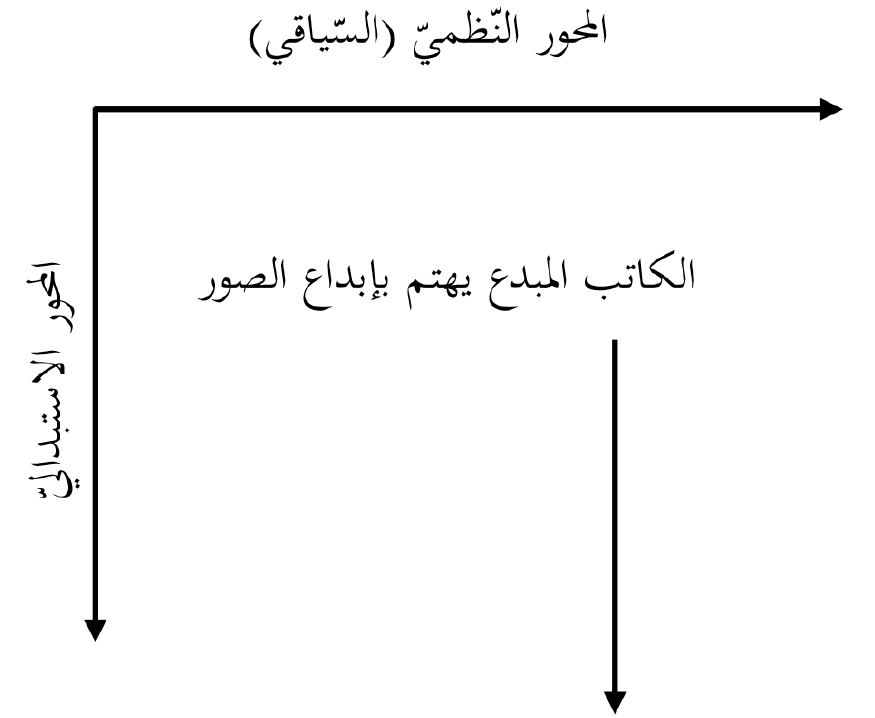
إذ يمكن استبدال عنصرٍ (الكاتب) مثلًا بعنصر آخر كأنْ نقول: الشّاعر، أو القاصّ، ... فإذا قلنا: (النّجار) مثلًا بدلًا من (الكاتب) لا يشكّل المحور النظمي آنئذٍ وحدات نظميّةً سياقيّةً ذات وظيفةٍ متناسقة، ذلك أنّ كلمة (النّجار) تستدعي صورةً ذهنيّةً لا علاقة لها بإبداع الصور، فالاستبدال لا يكون إلّا بين عناصر لغويّة تؤدي الوظيفة السّياقية ذاتها، وهي الّتي تسمح للمتكلم باختيار العنصر المنسجم مع الموقع والسياق معًا، ووفق حدود التركيب الّتي تسمح بها منظومة اللّغة الّتي ينتمي إليها الخطاب، وهذا يدفع بنا إلى القول: ليست العلاقات السياقيّة كلَّ شيء، بل لا بدَّ من تبادل الأثر بين محور النظم ومحور الاستبدال.
وليست هذه الثّنائيات وحدها هي الثّنائيات الّتي يفيض بها كتاب (سوسور)، فثمة ثنائيات أخرى، نحو: ثنائية الرمز اللّغويّ (Sign) والرّمز عمومًا، والسّيميا، واللّغة، والعَرَض والجوهر، فكان ذلك كلّه مطيَّة لوصف (سوسور) ولسانياته بالهوس في التّقسيم.
وينضح الكتاب (المحاضرات) بأفكارٍ كثيرةٍ منها:
1. لا أصل للّغة: فـ (سوسور) لا يقرُّ بوجود أصلٍ للّغة، ولا أصل للألسنة كذلك، إذ إنّنا يستحيل علينا وبالرجوع إلى أصل لسانٍ ما أن نعرف مبتدأه، ولذلك جعل الأصل الّذي تُعزى إليه الألسنة ضربًا من الخيال، ولا يمكن بحالٍ من الأحوال تناول أصل اللّغة نقطة ثابتة يمكن الوصول إليها وتحديدها، ولا يمكن ـ من ثَمَّ ـ توالد لسان من آخر.
فهو يعتقد بأن لا وجود لأيِّ لسانٍ أم، ولا وجود لأيِّ لسانٍ بنت، ولكن ما هو موجود هو اللسان الّذي انتشر عبر الزمن من غير تحديد بدايةٍ لوجود أو نهايةٍ له، إلّا إذا وقع على هذا اللسان حادثٌ وعنفٌ، أو لدى وجود سلطةٍ متجبرّةٍ سواءً أكانت داخليّةً أم خارجيّة، تعمل على سحقه وإماتته.
فإذا كان ليس ثمة أصلٌ للسان فليس ثمة موتٌ له، «إذ لم يتم أبدًا الإبلاغ عن ولادة لسانٍ جديد على سـطح الأرض... لا يمكن للسان أن يموت ميتة طبيعية، فاللسان لا يختفي إلّا باختفاء
الذين يتكلمونه: لا يمكنه أن يموت إلّا ميتةً عنيفةً بتأثير أحداثٍ خارجيّة ... الطريقة الوحيدة الّتي تجعله يتوقف عن الوجود هي أن يتمَّ إلغاؤه بالقوّة... أي من خلال الإبادة الكاملة للشعب الّذي يتكلمه، كما حصل في وقت وجيز مع ألسنة الهنود الحمر في أميركا الشمالية، أو من خلال فرضِ لسانٍ جديدٍ ينتمي إلى عرقٍ أقوى».
2. اللّسانيّات علم تاريخيّ: إنّ التعمُّق في فهم حقيقة طبيعة الوقائع اللّغويّة يفضي إلى نتيجة مفادها أنّ علمَ اللّسان هو علمٌ تاريخي، ولا شيء سوى ذلك، ولذلك لا بدّ من الارتكاز إلى حقائقٍ ووقائعٍ لا إلى أمورٍ متخيَّلة، ومن ثمَّ لا بدَّ من الاستناد إلى الألسنة للوصول إلى التحليل اللّغويّ، إذ إنّ كلّ شيءٍ في اللّسان هو تاريخ.
3. الثّبات والتغيُّر: فالعلامة اللّغويّة تتّسم بالثبات، فلا يمكن للعلامة أو العنصر اللّغويّ إلّا أن يكون هو نفسه، «فإذا تبدَّى الدالُّ عنصرًا حرَّ الانتقاء بالقياس إلى الفكرة الّتي يمثلها، فهو ـ حقيقة ـ على نقيض ذلك، إذ إنه ليس حرًّا... ذلك أنّه لا يمكن تبديل الدّال الّذي تنتقيه اللّغة بغيره ... إن العلاقة لا بدّ أن تكون نفسها ليس غيرها».
والمراد بذلك أنّ العلامة اللّغويّة علاقتها دائمة بالمرجع، لولا هذا الثبات لتعذّر التفاهم ونقل المعلومات.
وفي مقابل ذلك تحمل اللّغة في داخلها سرَّ تطوُّرها، فللزمن تأثيره في اللّغة، وهو الّذي يضمن انتقال اللّغة انتقال الإرث من جيلٍ إلى تاليه، وهكذا، ولكنّ هذا الزمن من جهةٍ أخرى يؤثر تأثيرًا مختلفًا في العلامة، إذ يعمل على تحوّل العلامة اللّغويّة سواءً واقعيًا أم في الانزياحات الدلالية، أو التبدُّلات الصوتية، «وفي معظم الأحيان، تمرُّ هذه التغيرات دون أن يشعر بها أحدٌ من أولئك الذين لا يُولون اهتمامهم المشاكل اللّغويّة، وهكذا، فحياة العلامات الألسنيّة ليست مستمرة نهائيًا».
4.العلاقة بين اللّغة والمكان: فالمبدآن اللّذان يهيمنان على اللسانيات هما: التواصل (الثبات) أو الوحدة عبر الزمن، والتبدُّل، وهما مبدآن يرتبطان بوشائجٍ متينة، وتصل بينهما عُرى وثيقة، فإذا تُجوهِل أحدهما فليس معنى ذلك أن يُتجاهل الآخر.
وإنّ عدم الإقرار بالتبدّل يفضي بنا إلى العجز عن تفسير التغيُّرات الحاصلة في الألسنة، ويدفعنا إلى تحكيم المفاجأة والمصادفة باللّغة.
وهذان المبدآن يشكّلان مبدأً مطلقًا مفاده الألسنة في تغيُّر، ولا ثبات مطلقًا مستقرًّا لأيِّ لسان، ذلك أن التغيُّر خلال اللّسان يتوافق والتغيُّر خلال المكان، حتى أنَّه ما تتمخض عنه الدراسة اللسانيّة ليس أصلًا مقترضًا، ولكنّه مجموعةٌ من التغيّرات.
5.أهمية القياس في الدّرس اللّسانيّ: يتبوّأ القياس في الدّرس
اللّسانيّ منزلةً مهمّةً عند سوسور، إذ إنَّ له منزلة في تفسـير استمراريّة الألسنة وتواصلها، وفي الوقوف على تطويرها، فتاريخ كلّ لسانٍ «ليس سوى عبارةٍ عن عددٍ كبيرٍ من الظواهر القياسيّة المتراكبة» ، فاللّسان عند سوسور شبيهٌ بالثوب، وعلى القياس أن يعمـل في الثوب، «واللسان ثوبٌ مصنوعٌ من ترقيعات» .
6. اللّغة منظومة: فقد نُظر إلى اللّغة على أنّها «منظومةٌ لا تُعْرف إلّا بترتيبها الخاص»، والمقصود بـ (المنظومة) أنّها جملةُ علاقاتٍ في مستوياتٍ صوتية، أو مورفيمية، أو تركيبية، فالعناصر اللّغويّة إنما تتحدَّد انطلاقًا من مفهوم المنظومة ، وعن هذا المفهوم يصدر مفهومان هما: التقابل والقيمة، ويُراد بالتقابل ارتباط علامةٍ بأخرى في المستوى الواحد (صوت، صرف)، فإذا قلنا: (عجوز) ففي مقابلـه: (هرم)، (مُسِـنٌّ)، (شيخ)، ... وقـد كانت نظرته إلى اللّغة إرهاصًا لنشأة مذهبٍ لسانيٍّ بسط سلطته ردحًا من الزمن هو (اللّسانيّات البنيويّة).
وكذلك الأمر على صعيد (المفهوم) لا قيمة للوحدة اللّغويّة (العلامة) إلّا إذا قُرنت بالوحدات الأخرى الّتي تنتمي إليها، فقيمة العلامة محدَّدة «علاقاتها مع عبارات المنظومة الأخرى» ، و«صفتها الأكثر دقّةً إنما هي في وجودها المغاير لوجود الأخرى» .
7. ليست اللّسانيّات علمًا طبيعيًّا: يرفض (سوسور) مقولة (هوفلاك) ومؤدَّاها أنَّ اللّسان يولد وينمو ويذوي، ويموت مثل كلّ كائن حيٍّ. فليس اللّسان جسمًا ولا نباتًا، ينمو مستقلًا عن متكلِّمه، ولا حياة خاصة للسان تصل به إلى ولادةٍ فموت، فاللسانيات ليست من العلوم الطبيعيّة كالفيزياء مثلًا، ونظرته هذه «تقدّم نظرةً خاطئةً عن الظواهر اللّغويّة وتمنع من تناول اللسانيات تناولًا علميًا».
إنّه -أي سوسور- ينتقد النظرة إلى اللّسانيّات على أنّها أجسامٌ حيّة، إذ يعدّ الألسنة «هي الشيء الملموس الموجود أمام اللّغويّين على سطح الأرض، اللّسان هو الاسم الّذي يمكن إطلاقه على ما استطاع اللّغويّ استخلاصه من مراقبته مجموع الألسنة عبر الزمان وعبر المكان» .
8. الارتباط بين اللّغة وعلم الإشارة (Semiology)، فللإشارة أنماط متعددة، كالإشارات العسكرية، وإشارات السلوك، وهذا أدّى إلى أن استشرف سوسور علم الإشارة (Semiology) الّذي يوجّه الأنظار إلى دراسة الإشارات اللّغويّة وغيرها.
9. ازدواجية العلاقة بين اللسان والعوامل الجغرافية، وهذا ما أفضى إلى دراسة الترابط بين المكان واللسان، بين اللّغة والجغرافية، وأدَّى ذلك ـ مِنْ ثَمَّ ـ إلى نشوء فرعٍ من فروع الدراسات الألسنيّة هو (اللسانيات الجغرافيّة)، أحد الفروع الّتي ستكون لنا وقفة معها.
تلك هي أهم المبادئ وقد كان لها ـ على قلتها ـ أن أثَّرت تأثيرًا
واضحًا في النظريات اللسانية الّتي توالدت وانتشرت بعد انتشار أفكاره المتضمَّنة في محاضراته، ما يجعل الدارس يحكم بالصّلة الّتي لا تنكر بينها وبين ما بثّه (سوسور) من أفكارٍ أصبح لها حضورٌ واضحٌ في كلّ جديدٍ في علم اللّسانيّات.
وما إطالتنا المكْث عند (سوسور) وأفكاره الّتي غدت مبادئً لكلِّ نشاطِ الدّرس اللّسانيّ فيما بعد إلّا تجلٍّ لأهميّة هذه الأفكار وأثرها في الدّرس اللّسانيّ الّذي تلا (سوسور) ومحاضراته.
أميرٌ وسليل أمراء، ولد سنة 1890م من أصلٍ روسيّ، ويعدّ قطب الرحى في تأسيس (حلقة براغ) اللّسانيّة، فقد اجتذب بذهنه الوقّاد مجموعةً من العلماء التشيك، ومنهم (رومان جاكوبسون Roman Jakobson)، و(ڤيلِم ماثيسيوس Vilém Mathesius) فشكّلوا حلقة براغ للدّرس اللّسانيّ.
كان حادَّ الذّكاء، متّقد الذّهن، فقد نشر أولى مقالاته وهو في سن الخامسة عشرة، ثّم نشر أّول مباحثه عن اللّغات الّتي تُنتشر بين فنلندا وهنغاريا، ولم يكن قد تجاوز السّابعة عشرة من عمره.
قام مع زملائه الّذين أحاطوا به إحاطة السّوار بالمعصم، بنشر أعمالٍ لغويّةٍ أطلق عليها (أعمال حلقة براغ اللّغويّة). وكان جلّ تركيزه على دراسة اللّغات السّيبريّة، والقوقازية، وقواعد اللّغات الهندأوربية، وكانت أطروحته الجامعية تصب في هذا الميدان سنة 1916م.
تنقّل بين كلٍّ من إستانبول وصوفيا إلى أن حطّ رحاله في فيينا أستاذًا ذا كرسيٍّ لفقه اللّغة السّلافية فيما بين 1932 - 1938م، ثم طُرِد على يد النازيين وصودرت كتاباته.
وكانت (حلقة براغ) وعلى رأسها (تروبتسكوي) تركّز في دراساتها اللّغويّة على النظرية الفونولوجيّة، وكان كتابه (مبادئ علم الأصوات Principles of phonology) أهم أثرٍ ارتبطت أواخر هذه الحلقة به.
فقد وصلت دراساته إلى (53) عنوانًا تتقاسمها لغات عدة، هي: الإنكليزيّة، والفرنسيّة، والروسيّة، والإيطاليّة، وغيرها.
كان لـ (تروبتسكوي) وحلقته إسهاماتٌ جليّةٌ في تطوير نظريّة الفونيم التي وضعها (سوسور)، فقد رأت هذه الحلقة أنَّ أصوات الكلام تنضوي تحت (مصطلح الكلام) لا (اللّغة)، وبهذا يكون (الفونيم) منتميًا إلى الكلام لا اللّغة، فهو «وحدة فونولوجيّة مركّبة تتحقق عن طريق أصوات الكلام، وعلاقة التحقّق بين الوحدات على مستوى معيّنٍ وبين الوحدات على مستوى آخر علاقة جوهريّة».
وللفونيم ـ بحسب هذه الحلقة ـ ملامح تمييزيّة تفصله عن غيره من الفونيمات، فيغدو بذلك كيانًا لغويًّا متفرّدًا، ومن ثَمَّ صُنّفت الأنظمة الفونولوجيّة طبقًا للملامح التمييزية للفونيمات. فمثلًا الفونيمات (D) و (ط) و(T) و(d)، و(K) و(g) فونيمات متمايزة في الجهر والهمس، ويتقابل الجهر والهمس بها في كلّ موقعٍ ينطق بها فيه.
يمثل كتاب (تروبتسكوي) (مبادئ التصويتيَّة Principles of phonology) ذروة سنام عبقريّته اللّسانيّة، ولهذا الكتاب صفات الموسوعيّة والشمول، إلى جانب تضمّنه وصفًا للمنظومات التصويتية، ويعدّ الممثل الرئيس لفكر (تروبتسكوي) في الدرس اللّسانيّ بنيةً ومضمونًا، وممثل المفهومات اللّسانيّة التي أجمعت (حلقة براغ) عليها، فجعلت منه مرتكز اللّسانيّات الوظيفيّة.
ونتيجة بحوث هذه المدرسة وأعمال أفرادها «أصبح الفونيم عنصرًا من العناصر الأساسيّة للنظريّة اللّغويّة ككلٍّ، ومن الوصف والتحليل العلميين للّغات». وإلى (تروبتسكوي) هذا يعود فضل إطلاق مصطلح (الأسلوبيّة الصّوتيّة) سنة 1938م.
ولد في لاونبورغ Lauenburg الألمانية سنة (1884م)، وانتقل إلى الولايات المتحدة وَلَمَّا يتجاوز الخامسة من عمره، وفيها أمضى مراحله الدراسيّة كلّها، وتخصص في (اللّغة الجرمانيّة)، وتابع دروس عالم الأجناس البشرية وعالم اللّغة (فرانز بواز Franz
Boas) مؤسس علم اللّغة الأمريكي الحديث (ت 1942م)، فأدَّى إلى تغييرٍ جذريّ في مساره العلميّ.
يمتاز (سابير) بسعة الأفق، والغنى المعرفي، وتعدُّد المواهب، فكان أديبًا، وموسيقيًا بالغ التذوق للموسيقا، وشاعرًا، و«اهتم بالتحليل اللّغويّ الّذي يمكن» أن يطبّق على الشّعر، واعتنى عنايةً واضحةً بـ «العلاقات بين اللّغة والأدب، واللغة والثقافة، .... وبوجهٍ عام العلاقات بين اللّغة وحامليها» فيما صار يعرف فيما بعد بـ (علم اللّغة العرقي).
وكتابه (اللغة Language) الّذي نشر أوّل مرّة سنة 1921م، وتُرْجِمَ إلى الفرنسيّة فقط سنة 1953م أحد المؤلفات المرموقة التي ولدت في القرن العشرين، هذا بالإضافة إلى مقاله المهم (الحقيقة السيكولوجية للفونيمات)، وقد ترجم إلى الفرنسيّة أيضًا.
يعدّ (سابير) هذا رائد مدرسة اللّسانيّات الذهنية وهي مدرسةٌ تستند في الدراسة اللّسانيّة إلى بعض الفروع التي تعضدها، مثل: علم النفس، وعلم الأجناس؛ ذلك أنَّ (سابير) عرفَ باتجاهه الذّهنيّ، إذ جلُّ اهتمامه الاعتماد على النّشاط
الذّهنيّ لتفسير الظّواهر النّفسيّة؛ولذلك دعيت باللسانيات الذهنيَّة.
يعزو إليه (تروبتسكوي) التّوصل إلى فكرة وجود الفونيم، وأنّه كان يسميّه في البداية (صوتًا نموذجيًا)، وأنّ هذا التوصّل كان بمنأى عن (بودوان دو كورتيني Jan I. Baudouin de Courteny) و(سوسور) نفسه، ولا يعني ذلك أنّ في مكنة الدّارس إهمال القول بتأثره بـ (كورتيني)، وهو «الذي وجد (سوسور) لديه الكثير من التشجيع فيما يخص هذه المسألة»، يعني فكرة (الفونيم). «ومهما يكن فإننا نجد لدى سابير، ومنذ عام 1921م كل العناصر التي تكوّن مفهوم الفونيم تقريبًا».
لقد كان (سابير) ذا قدرةٍ متميزةٍ على التنظير الفكري، فتجاوز بذلك حدود الفكر البنيوي السّوسوريّ، ففرَّق في اللّغة بين المنظومة الفيزيائيّة والمنظومة النموذجيّة، وهذه المنظومة مبدأٌ حقيقيّ بالغ الأهمية في حياة اللّغة.
كان يرى أنّ النموذج الصّوتيّ لأيّةِ لغة نموذجٌ ثابتٌ ولو عرض التغيير طول المحتوى الصوتيّ، فقد يكون للغتين نماذجٌ صوتيةٌ متعددة، إلّا أنّ الأصوات التي تصدر عنها تتشابه فيما بينها.
و(سابير) هو القائل مع (بنامين لي وورف Benjamin Lee Whorf ت1941م) بفرضيّةٍ دعواها (النسبيّة اللّسانيّة) التي يُراد بها أن اللّغة تحدِّد للمتكلمين رؤيتهم للعالم، وما يظهر من فروقٍ بين لغات العالم هو الذي يفضي إلى اختلاف نظرات أبناء لغةٍ ما إلى العالم، وإلى اختلاف طرائق تفكيرهم كذلك.
وفرضيّة (النسبية الألسنية) هذه تتكئ على فكرتين أساسيتين هما:
1. إنّ اللّغة هي الّتي تحدِّد الفكر، وهذا مؤدَّى الحتميّة اللّسانيّة.
2. إنّ اللّغة هي الّتي تحقّق رؤية معينة للعالم، وهو المراد بـ (النسبية اللّسانيّة).
وباختصار: لكلِّ لغةٍ أن تحدّد طريقةً ورؤيةً خاصّة للعالم.
ويمكن إجمال بنية الفرضيّة اللّسانيّة بما يأتي:
1. لكلّ لغة نموذج، فاللّغة مشكِّلة الفكر.
2. النموذجات اللّسانيّة ذات ارتباط بالنموذجات الاجتماعية والثقافية.
3. ثمَّة نوع من التناغم والتناسب بين البنية اللّغويّة والبنية الاجتماعية والثقافية.
ثمَّة توازٍ بين البُنى اللّغويّة والبُنى الاجتماعية والثقافية.
وفرضيّة النسبية اللّسانيّة التي قال بها (سابير) لم تكن فرضيّةً بريئةً من المآخذ، أو متفقة مع ما ساد أمريكا من اتجاه في البحث اللّسانيّ، ذلك أنَّها وُصفت «بأنَّها اتجاهٌ عقليٌّ، ويُحَطّ من شأنها، ويمكن بذلك أنْ تكون قد أدخلت مضامين الوعي في علم اللّغة».
ولعلّ فرضيتهما لم تتجاوز حدود الفرض؛ ذلك أنّ اللغة وحدها لا تصلح لصنع رؤيةٍ معيّنةٍ للعالم، فهي ليست منظاراً أو تلسكوباً، ولكنّها معينٌ في بيان هذه الرؤية لا في صنعها.
يضاف إلى ذلك أن هذه الفرضية تُهمل العوامل الأخرى المشكلِّة للرؤية، نحو التطور الفكري، والبيئة الاجتماعية،والثقافية، والاقتصادية، والعلمية فرؤية الفرد للعالم هي جماع هذا كلّه.
توفي (سابير) سنة 1939م، وانطوت بذلك حياة عالم لغويّ ذي أفقٍ واسعٍ، درس الأسر اللّغويّة كلّها تقريبًا، وترك أثره الواضح في جملةٍ من علماء اللّغة، مثل (كينيث بايك Kenneth Lee Pike)، و(هـاري هويجر Harry Hoijer).
ولد ليونارد بلومفيلد سنة 1887م في شيكاغو، وأمضى شطرًا من حياته الدّراسية بين أوربا، وهارفارد، وشيكاغو، ومن جامعة شيكاغو نال درجة الدكتوراه سنة 1909م ليصبح فيما بعد أستاذًا للّغة الألمانية، في غير ما جامعة.
كان مؤسِّسًا حقيقيًا لمدرسةٍ لغويَّة هي مدرسة (ييل: Yale)، تُدعى (مدرسة علماء اللّغة الوصفيّين)، التي ترمي إلى وصف اللغة، وتجعل هذا الوصف في بؤرة بحثها.
وهو صاحب اتجاهٍ لسانيٍّ مناقضٍ لاتجاه (إدوارد سابير Edward Sapir)، يُدعى اللسانيات السلوكية فإذا كان هذا الأخير يفسّر الظّواهر النّفسيّة انطلاقًا من دراسة النّشاط الذّهنيّ، فإنّ (بلومفيلد) يفسّر الظّواهر اللّغويّة بالاتكاء على تحليل السّلوك الّذي هو ردّة فعلٍ نحو موقفٍ ما، يُطلق عليه اسم (المثير)، وهذا يؤدي إلى استجابةٍ لهذا المثير، ومِن ثمَّ لا يعدّ التواصل اللّسانيّ أكثر من استجابةٍ ما لمثيرٍ ما؛ فهو يقف في طرفٍ مقابلٍ لاتجاه (سابير) الذهني، وإن كانا يُكمِل أحدهما الآخر في مقاربة الدرس اللّسانيّ.
وإذا كانت الوضعيَّة الصارمة لعلماء السلوك قد بسطت تأثيرها في الدرس اللّسانيّ في أمريكا في مرحلة التكوين، فإن (بلومفيلد) أكثر علماء اللّسانيّات تمثّلًا لهذا التأثر؛ فقد أصدر كتابه (Language) سنة 1933م ومداره الاتفاق مع النظريّة السّلوكيّة، «فاللّغة بفعل هذه النّظرية تصحّ بدورها حافزًا وجوابًا عليه في وقتٍ واحد». وكانت اللّسانيّات بالنسبة إليه فرعًا من علم النّفس اليقيني الّذي عُرف بالسّلوكيّة، فكانت نظرياته سلوكيّةً إلى أبعد مدى.
وبتأثيرٍ من الصرامة العلميّة التي يتمتّع بها (بلومفيلد) وتركيزه على التحليل اللّغويّ الشكلي رفض «التحليل الدّلالي بنفس الدّرجة من الصّرامة التي يطلبها الجانب الشّكليّ من اللّغة».
وكان لوجهة نظره الرّافضة تلك أثرها في تجاهل جيلٍ من اللّسانيّين الدراسة الدّلاليّة، واستبعادها أيضًا. وكان الإيحاء بهذا الرّفض للدّراسة الدّلالية على أيّ مستوى محلَّ استياء (بلومفيلد)؛ فقد أكّد (روبنز Robert Henry Robins) أنَّ هذا الأمر لم يكن من غاية (بلومفيلد) ووكْده، وأنَّ «ما طرحه هو أنَّ التّحليل الدّلاليّ لا يمكن أنْ يطمع إلى الوصول بأيّ حالٍ للدّقة العلميّة المتاحة للتحليل الشّكلي للمادة اللّغويّة... وأنَّ أيّ تحليلٍ للمعاني يتطلّب معرفةً واسعةً من
خارج علم اللّغة نفسه، وأنَّ المعاني الصّحيحة أو المفترضة لا يمكن أنْ تستعمل بشكلٍ صحيح»، على أنَّها معاييرٌ في التّحليل اللّغويّ، وصعوبة الوصول إلى الدّقة الدّلالية تؤدي إلى فشل التّحليل، وهذا من ثَمَّ يؤديّ إلى فشل المعايير الَّتي يستند إليها هذا التحليل.
إنَّ أهمية (بلومفيلد) في المدرسة اللّسانيّة الأمريكية تعود إلى أنَّه رسم إطارًا محدَّدًا للنشاط اللّغويّ، وترك لأتباعه مهمّة إنجاز التّوسيع المحدّد الخاص لمنهجه التّحليليّ، ولا سيما في كتاب (هاريس Zellig Harris) (علم اللّغة التركيبي) الذي يعدّ أكثر الكتب تمثيلًا للبنيويّة الأمريكيّة.
ويُضاف إلى ذلك «تأكيد اللّسانيّات كعلمٍ بأسلوبٍ فلسفيٍّ دقيق إذ بلغ نضوجه العلميّ في زمنٍ كان فيه الفلاسفة يخُصّون العلم بمكانةٍ رفيعةٍ بالمقارنة مع المنجزات الفكريّة الأخرى».
ولد لويس هيلمسليف في كوبنهاغن سنة 1899م لأبٍ يعمل أستاذًا للرّياضيات، وفي مسقط رأسه (كوبنهاغن) درس اللّسانيّات المقارنة على يد (هولغر بيدرسن Holger Pedersen)، فكان أحد علماء اللّغويّات المقارنة ومريدي مدرسة النّحاة المقارنين.
وقد حصل على منحةٍ لدراسة علم اللّغة في (براغ) فلم ترق له ثمة دراسة علم اللّغة الكلاسيكي، فانتقل إلى (باريس) ليدرس على يد (أنطوان ماييه Antoine Meillet) ويتلقّف علم اللّغة عنه، وهناك عرف محاضرات (سوسور)، فكان لها كبيرُ الأثر في تعمّق نظريّته.
رأَسَ (هيلمسليف) حلقة لغويي (كوبنهاغن) منذ تأسيسها سنة 1931م، واستمرّ في ذلك إلى وفاته سنة 1965م عن ستة وستين عامًا، وأصدر له سنة 1943م كتابه (مقدمة إلى نظرية لغويّة Prolegomena to a Theory of Language)، وهو كتابٌ مصوغٌ «بطريقةٍ عسيرةٍ على القارئ»، ويضم ثلاثة وعشرين بحثًا، تشكِّل أسس نظريته اللّغويّة التي ترتكز إلى:
أ. الكُمُون، ومعناه تحليل اللّغة اتكاءً على السمات الداخليّة، تلك السمات التي تجعل من اللّغة (بنية مغلقة)، وبذلك يكون درس اللّغة وفقًا لذلك درسًا لذات اللّغة، وليس بالنظر إلى أنّها وسيلةٌ تواصليّة، وهو درسٌ يضرب بالاعتبارات التاريخية والاجتماعية والنفسية عُرْض الحائط.
ب. الوقوف على الخصائص المشتركة للّغات عامة.
ج. دراسة اللّغة للّغة لأجل ذاتها، وهو الاتجاه الّذي عرف به (هيلمسليف) وأُطلق عليه مصطلح (الغلوسيماتيك Glossematic)، أي النظرية اللّغويّة الّتي هدفها دراسة اللّغة ذاتها.
د. الاعتماد في استنباط خصائص اللّغة على ثوابت في ذات اللّغة لا على ما هو خارج اللغة.
وبهذا تكون نظريته مخالفةً للنظريات اللّسانيّة السّابقة.
كان (هيلمسليف) ينطلق من معالجة (سوسور) للعلامة اللّغويّة بالنظر إليها على أنّها مركّبةٌ من (دالٍّ) و(مدلول)، ويعمل على تطوير مقولات (سوسور)، ولا سيما في نظرته إلى اللّغة باعتبارها فكرًا منظمًا يُصَبّ في مبنى صوتي، وباعتبار اللّغة شكلًا لا مادة، فعمل (هيلمسليف) على نقل هذين المفهومين إلى مفهومي (المضمون والشكل)، فالمضمون (وحدات بنية المعنى)، والشكل (مستوى التعبير للفونيمات). ولكلٍّ من مستويي (الدّال) و(المدلول) مادة وشكل، فالتعبير له مادته الصّوتيّة التي يتموضع عليها وينبثق عنها، وكذلك لـ (المضمون) مستويان (شكل ومادة).
إن (هيلمسليف) كان يعدُّ نفسه استمرارًا ونضجًا لِمَا قال به (سوسور)، وأنّه التلميذ الحقيقي له؛ فقد كان متّحدُ النظرة مع (سوسور) إلى اللّغة على أنّها شكلٌ لا جوهر، وأنَّ ليس للجوهر ـ أي الصوت والمعنى ـ أية قيمةٍ ذاتيّة، فربما كان الجوهر صوتيًّا أو كتابيًّا حركيًّا فيما يخصّ الدّال، ولكنّه فيما يخصّ المدلول تجاوز (سوسور) بتبنّيه فكرة أنَّ القيمَ المجردة للألفاظ هي وحدها الموجودة، ورفض المعنى الّذي لا شكل له.
لقد عُدُّ (هيلمسليف) أحد البنيويّين الّذين شرعوا في تأسيس علم
لدّلالة انطلاقًا من مقولة التشابه بين مستويي التعبير والمحتوى، وعُدَّ إلى جانب ذلك مطوِّرًا للمشروع السّوسوري المتعلق بهذا المنحى.
ترك (هيلمسليف) بصماته في كلٍّ من (جوليان غريماس Algirdas Julien Greimas) و(رولان بارت Roland Barthes) اللَّذَين سارا على خطاه، واقتفيا آثاره، وحذوا حَذْوه.
من الآثار العلمية التي خلّفها: (اللّسان)، و(محاولات لسانيّة)، وفيهما كان يصل في طرح آرائه حدَّ المغامرة التي تعمل على طرح تساؤلاتٍ كثيرةٍ في نفس مَنْ يجيل النّظر فيها
وقد عَدَّ التقابل الّذي يقوم عند (سوسور) بين الدّال والمدلول تقابلًا بين مستويي التعبير والمحتوى عند (هيلمسليف)، أمّا مقابلة اللّغة للكلام عند (سوسور)، فقد غدت تقابلًا بين النّظام والاستعمال.
هو أحد أعلام حلقة براغ. ولد سنة 1896م في موسكو لأسرةٍ من
الفنانين والعلماء، وتلقَّى تعليمه في معهد اللغات الشرقية في موسكو، وكان ذا جهدٍ وافرٍ في تأسيس حلقة موسكو اللّسانيّة التي أسست سنة 1914م. وعقدت أول اجتماعٍ لها سنة 1915م. وكان هدف هذه الحلقة (فن الشّعر وتحليل الشّعر)، أو ما يسمَّى (الشّعرية).
غادر جاكوبسون روسيا سنة 1920م وهو العام الذي غادرها فيه (تروبتسكوي) وحطَّ رحاله في (براغ)، ودرس في جامعتها، وتخرَّج فيها حاملًا شهادة الدكتوراه سنة 1930م، ودرَّس في جامعة (برنو Brno)، وكان صاحب إسهامٍ وافرٍ في تأسيس جماعةٍ لغويّيّ براغ، «فقد انضمّ مع لغويين روس وتشيك آخرين ... في جماعة لغويّيّ براغ».
وكان لظروف الاحتلال الألمانيّ لـ (تشيكوسلوفاكيا) إسهامٌ في هروبه إلى الدّول الإسكندنافّية في بادئ الأمر، فعمل أستاذًا زائرًا في (جامعة كوبنهاغن)، ثمَّ جعل قصده سنة 1941م الولايات المتحدة الأمريكية، ولما استتب له الأمر كان أحد مؤسسيّ (حلقة نيويورك اللّسانيّة Linguistic Circle of New York)، وكان له موقع الصّدارة في مجلتها التي تصدر عنها باسم (Word)، وهناك دَرَّسَ في عددٍ من الجامعات الأمريكيّة، منها جامعة هارفارد، ومعهد ماساشوستس للتكنولوجيا (Massachusetts Institute of Technology MIT)، وكان له كبير في فضلٍ «نقل المعرفة اللّغويّة الأوربيّة» لتصبَّ في
بحر علم اللّغة الأمريكيّ، بل إنَّ «كلّ موضوعاته الأثيرة» كانت نتاج الفترة الأمريكيّة.
كان (جاكوبسون) يتمتع بتعدّد مسارب اختصاصاته، وبغزارة علمه، فقد زاد نتاجه العلميّ على (470) عنوانًا موزعًا بين الكتب والأبحاث.
وكانت له يدٌ طُولى في تطوير النظريّة اللسانيّة من خلال اللّسانيّات البنيوية، وأسهم مع (تروبتسكوي) في وضع (الفونولوجيا = التّصويتيّة) وناقض زميله (تروبتسكوي) فمال إلى النظر إلى الفونيم على أنّه «مجموعةٌ من مجموع سماتٍ فارقةٍ موجودةٍ بشكل ٍمتزامن».
لقد كان (جاكوبسون) صاحب أوّل صياغةٍ حديثةٍ للصّوتيم، إذ إنه وضع تصنيفًا للتقابلات الصّوتيّة ضمّها (12) تقابلًا صوتيًا أساسيًا، وهي تقابلات يمكن جمعها في التقابلات الجهوريّة، والسمات النّغميّة، ذلك أنَّ «النظام الفونولوجي المعين لكلّ لغةٍ هو اختيارٌ من الثّنائيات المتقابلة»، وهذا ما جعل (جورج مونان Georges Mounin) يقول بـ (الثّنائية الجاكوبسونيّة) ويمثلها ميله الفلسفيّ إلى تفسير كل القضايا في ضوء التقابل بين كلمتين، وهو اتّجاهٌ لم يخلُ من ضعفٍ يتجلّى في «تقويم التعارض بين التراكيب
المعلَّمة والتراكيب غير المعلَّمة في الموروفولوجيا، والنّحو، وعلم المعاني».
زليج هاريس روسي المولد، فقد ولد سنة (1909م) في مدينة (بالتا Balta) الواقعة جنوب غرب أوكرانيا، ثمّ قصد مع أسرته الولايات المتحدة الأمريكيّة سنة (1913م) وله من العمر أربع سنوات. تخرَّج في جامعة بنسلفانيا سنة (1930م) يحمل درجة الإجازة، ثم حصل على درجتي الماجستير والدكتوراه بين أعوام (1930-1934م)، وغدا أستاذًا مساعدًا ابتداءً من عام (1938م)، ثم أستاذ علم اللّغة التحليليّ سنة 1947م.
عُرفت عنه كثرة النشر والكتابة المنتظمتان، ولكنَّ نتاجه العلميَّ كان ضعيف الصّدى لدى القُرَّاء؛ ذلك أنَّ نتاجه لم يحظَ «في أوروبا وأمريكا بتقاريرٍ كان أنْ تثير الرغبة في مطالعةٍ شاملةٍ لمذهبه العام».
وشُهِر (هاريس) أيضًا بجديّة التّفكير، والثّبات الواضح على الأفكار الّتي كان يؤمن بها، وبالرّزانة العلميّة كذلك.
يعدُّ (هاريس) مؤسس علم اللّغة الوصفيّ التقليديّ، ذلك أنّ كتابه (مناهجٌ في علم اللّغة البنيويّ Methods in Structural Linguistics) هو «الكتاب المقدَّس لهذه المدرسة»
ترك آثارًا عدة، منها: رسالته للماجستير بعنوان (نشأة الأبجدية Origin of the Alphabet)، وبحثه للدكتوراه الذي يحمل عنوان (نَحوُ اللّغة الفينيقيّة A Grammar of the Phoenician Language) وآخرها كتابه (نظرية اللّغة والمعلومات منهج رياضي A Theory of Language and Information: A mathematical approach).
إنّ وجهة نظر (هاريس) فيما يخصُّ (علم اللّغة الوصفيّ) ليست في إبداع نظريّةٍ لغويّة من فراغ، «بل على الأرجح في تطوير مناهج لوصف اللّغات»، ويكون ذلك إجرائيًّا على عينةٍ لغويّةٍ عشوائيّةٍ غير منتقاةٍ بشرطِ أن تجري ذلك بحسب خطواتٍ معينةٍ بدقةٍ بوصف هذا الإجراء اتجاهًا خوارزميًّا وأسلوبًا حسابيًّا ميدانه علم اللّغة والأصوات، وقصده بسط قضيّةٍ لغويّةٍ ما وفق نقاطٍ متسلسلةٍ على غرار الجداول الرياضية المستعملة في الحاسبات الالكترونيّة، وأخصّ ما يكون هذا في النّحو التّوليديّ، وهو ما عرف بـ (المعيار التوزيعيّ) الّذي يؤسس على استبعاد المعنى، والاقتصار على توزيع الوحدات اللّغويّة من مورفيمات، وفونيمات توزيعًا شكليًا فحسب.
لقد غدا (هاريس) الممثل الحقيقيّ للمنهج التوزيعيّفي الدرس اللّسانيّ، وقد سيطر على ساحة الدرس اللّسانيّ في الولايات المتحدة الأمريكية بدءًا من سنة (1930م) وكان لكتاب (بلومفيلد) (اللغة) الإلهام الأكبر في انتشاره. وهي نظريّةٌ «معروفةٌ جدًّا ويرتبط بها وحدها» اسم (هاريس)، وتتصف نظريّته اللّسانيّة هذه بالصلابة والانسجام، وكانت تهدف إلى إكمال المذهب (البلومفيلديّ) الوصفيّ وتصحيح مساره، ومن ثمَّ تخطّيه.
وأُسس هذه النّظرية لا تنأى عن الأفكار السّوسوريّة، فهي تقوم على جملةٍ من الأسس منها:
1. اللّغة هي الغرض الأوّل للدّراسة وهي تقابل الكلام.
2. اعتماد الاستبدال وتحليل المكوّنات، فالاستبدال يكشف فئات التوزيع، وبتحليل المكوّنات تحدَّد القواعد التي ترتبط وفقها عناصر الفئات الموزّعة ببعضها.
3. استبعاد العوامل الذّاتيّة.
4. الاستغناء عن معنى الوحدات اللّغويّة.
5. تقوم بنية اللّغة على وحداتٍ توزيعيّةٍ تمييزيّةٍ تظهر بفعل التّقطيع أو التّقسيم.
6. الاعتماد على التّوزيع يفضي إلى العلامة اللّسانيّة.
7. وحدة الكلام ليست الجملة المفردة، فالكلام نصٌّ متتابعٌ بدءًا من الجملة المكوّنة من كلمةٍ واحدةٍ حتى العمل المؤلف من عشرة مجلدات.
8. يتوصل بوساطة التحليل التوزيعي إلى جملة القوانين الخاصة بأنساق الوحدات المتعدّدة والمختلفة.
إنّ النظريّة اللّسانيّة التّوزيعية تتسم بالتّعقيد والصعوبة، و(هاريس) نفسه «ظل مدركًا للصعوبات الّتي يثيرها التّحليل التّوزيعي، وعلى الرّغم من إصراره على تأكيداته القطعيّة فهو لا يتجاهل الاعتراضات» ، ويُقرّ ضمنيًّا أو بشكلٍ واعٍ بعض مظاهر الضّعف المنهجي في نظريته التّوزيعيّة.
أحد أعلام مدرسة اللّسانيّات الوظيفية التي ولدت في فرنسا. ولد سنة 1908م في مقاطعة (Savoie)، في بلدة (Saint-Alban-des-Villards) لأبوين معلِّمين، وفي مدارس (باريس) شدا أوليات العلم، وكان لطفولته في مقاطعته تلك أثرٌ في مستواه اللّغويّ، فقد «احتكّ هناك بظواهر الثنائية اللّغويّة الحقيقية»، وفي دراسة لهجة منطقة (Hauteville) القريبة من بلدته.
ثم تابع تلقّي تعليمه على يد (فندريس Joseph Vendryes) في المدرسة المسلكية العليا، والسّوربون بين عامي (1928 و1929م)، وتدرّج في تعلُّمه حتى نال سنة 1937م شهادة الدكتوراه عن أطروحته «الازدواجية من أصلٍ تعبيريّ في اللغات الجرمانيّة»، وتسنّم سنة 1939م منصب أستاذ التّصويتيّة الأوّل في المدرسة نفسها، ثم أستاذ اللّسانيّات العامة في جامعة باريس.
ولما تعرَّض للأسر في أثناء الحرب العالميّة الثانية، أجرى بحوثًا
على عيّنات من السّجناء مدَارُها اللّغة الفرنسية المعاصرة، فنجم عن هذه الدّراسات وصفه للبنيّة الصّوتيّة الفرنسيّة وصفًا منهجيًّا دقيقًا.
توطّدت علاقاته بعد رحيله إلى أمريكا بقصد الإقامة فيما بين (1946- 1955م) مع أقطاب المدرسة البنيويّة (إدوارد سابير Edward Sapir)، و(ليونارد بلومفيلد Leonard Bloomfield)، وغدا مدير مدرسة اللّسانيّات في جامعة كولومبيا، وشارك في مجلة (Word) التي كانت تصدرها (حلقة نيويورك اللّسانيّة).
عاد أدراجه إلى فرنسة في 1955م وتسنّم الإدارة والتدريس في معهد السوربون للسانيات، وتولّى الإشراف على مجلة اللّسانيّات التي بدأت في الصّدور سنة 1965م، وهي المنبر الّذي ينافح عن اللّسانيّات البنيويّة.
ويعد (مارتينيه) أحد «أفضل أتباع تروبتسكوي في مجال الفونولوجيا وأكثرهم أمانة»؛فقد كان له الباع الأطول في تطوير «الخطوط الأساسيّة لتحليلٍ نحويٍّ عام متناسق، تمحور، شيئًا فشيئًا، حول المسألة الرئيسيّة المهملة بشكلٍ عام، ألا وهي: بنية الإخبار في الجملة ووظيفة الخاصتين جدًا ... وربط مفهوم تكوّن العمل الأدبيّ من خلال شكله تلك الفكرة الجاكوبسونية التي تعرف بدقّة علم الأسلوب بمفهوم الفحوى الّذي اعتبره أكثر أهميّةً على مستوى الاستعمال الشّعري والفنيّ»
ويعدّ مارتينيه «اللّغويّ الفرنسي الذي تلقَّى الإرث الحقيقي لسوسور الذي لم يقدَّر حقَّ قدره لفترة طويلة قبله».
يصبّ (مارتينيه) جلّ اهتمامه على الطابع الوظيفي للتحليل البنيوي، إذ يجب دراسة «الوظيفة الألسنيّة للفوارق الصّوتيّة، وعبر الطريقة التي يتمّ بها استخدام هذه الفوارق نفسها في المنظومة الألسنيّة، ونعني بها مردودها الوظيفيّ».
فهو لا يعوّل على الوصف الخالص بوساطة تسجيل التغييرات الصّوتيّة، ولكنه يتجاوز ذلك إلى تفسير هذه التغيرات الصّوتيّة وفق أسّسٍ عامة، فهو يرى أنَّه «لا يكفي أن نسرد الوقائع بل يجب أيضًا تفسيرها وردّها إلى أسبابها ...» إذ ليس «مهمًّا أن نضع على الظّواهر بطاقة محدَّدة، بل المهم أن نرصد ونفسّر بشكلٍ سليمٍ آليتها».
فـ (مارتينيه) يجعل وكده وديدنه سبر أغوار بواعث التغيرات في البنى الصّوتيّة، والكشف عن أسباب ذلك داخل المنظومة اللّغويّة، فلا يعتمد على التفسير من خارجها، ويسعى دائمًا إلى التحليل الوظيفيّ للتركيب النحويّ تحليلًا علميًّا دقيقًا.
ترك (مارتينيه) جملةً من الآثار، منها:
1. اللّغة والوظيفة Langue et fonction.
2. مبادئ في اللّسانيّات العامة ةléments de linguistique générale.
3. اقتصاد التغيرات الصّوتيّة Economie des changements phonétiques.
4. وظيفة الألسن وديناميتها Fonction et dynamique des langues.
وآثاره كلّها تشهد له بترسمه خطوات (تروبتسكوي) (ت 1938م)، فقد كان أدام السّعي إلى إتمام النظرة الوظيفية للظاهرة اللّغويّة وفق ما رسمته حلقة براغ. وأهم محاور الوظيفية التي يدرسها هو الوظيفيّة التّواصليّة، فقد أولاها من الاهتمام أضعاف إيلائه الشكل والبنية، ومع ذلك يمكن الاعتقاد بتكامل الرؤيتين البنيويّة والوظيفيّة لديه.
أسَّس (مارتينيه) الجمعيّة الدولية للسانيات الوظيفية Société Internationale de Linguistique Fonctionnelle SILF، وهي جمعيّة تضمّ زملاءَ له، ومريدين، وطلابًا، ممن اتسقت عقولهم، وتآلفت قلوبهم.
وكان يربط بين النظريّة والإجراء، فقد كان يتبع تعاليمه النظريّة بالإجراء العملي والوصف الفنولوجي. واستطاع أن يطوّر أصول نظريّته، ويضع آليات منظومات للدراسة الوصفيّة للسانيّات.
وكانت له وقفةٌ عند (فونولوجيا) اللّغة العربية، فأثارت مسائلها فضوله، فتملّاها، وجهد في سبر أغوار الديناميّة التي تعرّفها، فوقف عند فونيم (الجيم) في العربية فكان نتاج ذلك بحثه الموسوم بـ (التغوير العفوي للصامت g في العربيّة).
وكان من جملة جهوده التي بذلها في الدّرس اللّسانيّ سعيه إلى بلورة مبدأ (التزامنية الدّيناميّة Synchronie Dynamique)، هذا المبدأ الذي يُشرِّع الأبواب لدراسة ما يحصل من تغيرات للوحدات اللّسانيّة في زمنٍ ما، ذلك أنّ اللّسان عرضةٌ للتغير ما دام في حالة شغل.
قلنا من قبل: إنّ الدرس اللّسانيّ في القرن العشرين محوطٌ بثورتين علميتين، حمل لواء أولاهما اللّسانيّ السّويسريّ الذي ترجمنا له من قبل (فرديناند دو سوسور)، وحمل لواء الثانية اللّسانيّ (نوم تشومسكي)، الّذي سنحاول في الفقرات الآتية أن نُلمَّ بأهم محطّات سيرورته العلمية، إذْ يعدُّ صاحب (تحوُّل كوبرنيكيّ) في
علم اللغة، وقد عُرفت نظريته اللّسانيّة باسم (النحو التّوليديّ التّحويليّ)، وهو أحدث المذاهب اللّسانيّة من جهة، فضلًا عن امتيازه بتطوره الدّائب السّريع من جهة ثانية.
ولد أفرام نوم تشومسكي (Avram Noam Chomsky) عام 1928م لأبٍ يعمل معلمًا للّغة العبريّة. وحصل على درجة الماجستير من جامعة بنسلفانيا سنة 1951م عن أطروحته المعنونة (دراسة مورفولوجية للعبريّة الحديثة). ثم نال درجة الدكتوراه سنة 1955م عن أطروحةٍ تحمل عنوان (التحليل التحويليّ) بإشراف أستاذه (هاريس) صاحب النظرية التوزيعية التي أشرنا إلى بعض ملامحها في صفحة سابقة.
إنَّ هذا يعني أنَّ توليديّة (تشومسكي) تنبثق من البنيويّة الأمريكيّة، وأنَّ تحويليته هي نتاج تأثره الجمِّ بأستاذه (هاريس)، فقد بدأ هذا الأخير منذ عام 1951م إصدار كتاب (المناهج Method) يُؤسّس لمذهبٍ (وصفي) يتكئ على التّوزيعيّة اتكاءً مطلقًا، وتأثَّر (تشومسكي) بأفكار أستاذه (هاريس) حول القواعد التّحويليّة.
وتأثر كذلك بـ (جاكوبسون) الذي كان يدرس في (هارفاد)، وقد انتقل إليها (تشومسكي)، ووقف على (الفونولوجيا) التي كان يدرسها (جاكوبسون)، وهي على نقيض توزيعية (هاريس).
يضاف إلى ذلك تأثر (تشومسكي) بالتنوع الفكريّ الّذي يعمّ
معهد (ماسا شوسيتس Massachusetts Institute of Technology MIT، فقد كانت تتجاور فيه «أعلام في الرياضيات، والمنطق، وعلم النفس، .... ». فهذا المعهد يمثل «عملية النّضج النهائي لتشومسكي».
تبوَّأ (تشومسكي) مكانةً عاليةً في علم اللّغة في القرن العشرين؛ ذلك أنّ أبعاد طموحه وتجديده النّظري والصّدمة التي أراد أن يحدثها وأحدثها يجعل الباحث قليل الزّاد من المعرفة اللّغويّة يحار بين أن يعتبر «تشومسكي النّتاج الصّرف لسلسلة الخصومات هذه أو تلك، وإمّا أنْ نعتبره (سوسور) وربما كان في الوقت نفسه أرسطو وديكارت وهمبولد، وسابير، وتروبتزكوي وبانيني النصف الثاني من القرن العشرين».
إنَّ سنة (1957م) بالنسبة إلى الدّرس اللساني لديه هي نقطة التحوُّل الرّئيسة، فقد نشر (تشومسكي) كتابه (البُنى النّحوية Syntactic Structures)، وفيه بسط قواعد النّحو التّوليديّ ـ التحويلي، فغدا (تشومسكي) حامل لواء المعارضة والتّحدي للفكر البلومفيلديّ الّذي ساد عقودًا طويلة، فكان (تشومسكي) هو «الذي تحدَّى بصراحة ووضوح، معظم الأسس الفلسفيّة للبلومفيلديّة».
وغدا (تشومسكي) ورفاقه القواعديّون التّوليديّون هم مَنْ يمثلون
هذه المناقضة للفكر اللّغويّ البلومفيلديّ، وهم وحدهم ـ على الإطلاق ـ المعارضون الأكثر بروزًا وتعدّدًا.
وقد تغيّا (تشومسكي) من كتابه (البنى النحوية) سابق الذّكر «بناء نحو لتوليد الجمل، ووصف خواص الأنحاء، وأخيرًا تأسيس نظرية للبنية اللّغويّة دون صلة بلغات مفردة».
لقد كان (تشومسكي) ينظر إلى اللّغة على أنّها مفتاحٌ لفهم العقل الإنسانيّ فهمًا جزئيًّا، وأنّ علم اللّغة هو فرعٌ من علم يسمَّى (علم نفس المعرفة)؛ ذلك أنَّ العقل ـ عند تشومسكي ـ ليس صفيحة بيضاء تنتظر الانطباعات الّتي ستأتيه فتنطبع فيه، لكنّه مزودٌ ببرنامج واضح يستطيع به استقبال المعلومات وتفسيرها وتخزينها.
وينبني على ذلك أنَّ «تعلّم اللّغة الأولى هو العملية الّتي يقوم بها مخّ الطّفل نحو الّتجربة العشوائية للكلام»، ويحدث هذا بتأثير نظامٍ محدَّد يقوم بإدخال هذه المعلومات وتفسيرها، وبذلك يكون الاكتساب اللّغويّ للّغة الأولى نشاطًا يعتمد على مكوّنٍ موجود وراثةً في مخّ الطفل، وهو (جهاز اكتساب اللغة)
وقد مرَّت توليدية (تشومسكي)، بمرحلتين، طوّر في أولاهما
تصوّراته حول وظائف علم اللغة، وطوَّر في المرحلة الثانية نظريّة أكثر شمولًا أودعها كتابه (مظاهر النّظرية النحوية Aspects of the Theory of Syntax) الصادر سنة (1965م).
يفرِّق (تشومسكي) بين البنية السّطحيّة والبنية العميقة، فالأولى خاصة «بتنظيم الجملة كظاهرةٍ ماديّة»، في حين إن البنية العميقة هي «الأساس البنائيّ المجرّد الّذي يحدد المحتوى المعنويّ، وهو موجود في الذّهن حين ترسَل الجملة أو تتلقى»، والبنية العميقة تشتمل على عددٍ من الجمل الأساسية المنظمة وفق علاقاتٍ ما لغرضٍ معيّن، وهي قابلة إلى أن تتحوّل إلى بنيةٍ سطحيّةٍ من خلال عمليات شكلية يطلق عليها اسم (التحويلات القواعدية).
يسمّي (تشومسكي) التّملك الفطري للآليات العامّة الّتي تنقل البنى العميقة إلى بنى سطحيّة (الكفاءة اللّغويّة)، وهي قدرةٌ توليديّةٌ لا تفسيريّة، قدرة على الفهم، والإنتاج، والتمييز. وترتبط الكفاءة بقابليّة المتكلّم على نحوٍ عفويّ على توليد عددٍ كبيرٍ من الجمل وفهمهاوهي موجودةٌ لدى كلِّ متكلّمٍ أو سامع، فهي معرفةٌ حدسيّةٌ أو ضمنيّة للغة يمكن بها توليد جملٍ وفهمها معًا.
ومفهوم الكفاءة اللّغويّة هذا يعدّ «حدثًا هامًا من وجهة نظرٍ معرفيّة ... »، فهو يرتبط بعرى وثيقةٍ «بمفهوم المظهر الإبداعيّ للّغة أو
بإبداعيتها». ويقابل ذلك ما أسماه (الأداء اللّغويّ Performance) الذي يراد به التداول الإجرائي لِلُغةٍ ما في موقفٍ ما، أو هو الأداء الفعليّ للكفاءة اللّغويّة.
وقد رأى (تشومسكي) أنَّ ثمة فرقًا جوهريًّا بين منهجه وبين علوم اللّسانيّات السابقة عليه، ويتمثّل هذا الفرق في أنّه سعى إلى تقديم «نظريّةٍ لغويّةٍ وليس علمَ لغةٍ عامٍّ [كذا]، نظريةٍ دقيقةِ البناء على شكل نموذجٍ فرضي استنتاجيّ بالمعنى المنطقيّ والرّياضيّ لهذا التعبير».
إن نظرية (تشومسكي) التّحويليّة التّوليديّة لم تنجم من فراغ، بل كانت ولادتها بفعل الانتقادات الّتي وُجِّهت إلى البنيويّة، ما دفع إلى منهج لسانيّ متجاوزٍ وصفيةَ (سوسور)، فاتّجه البحث نحو الوصف والتفسير بعد أنْ كان مقصورًا على الوصف فحسب، ولا يكون التفسير إلّا من داخل اللّغة، والتّوليديّون إنّما يتغيّون صوغ قواعدٍ عامّة تشمل اللّغات كافة، وهذا يتطلب منهم وجود أصولٍ افتراضيّةٍ لنماذج لغويّة تستنبط استنباطًا منطقيًّا ورياضيًّا.
لقد أفاد (تشومسكي) من كلّ معطيات الدّرس اللّسانيّ الّذي بسط أجنحته على ساحِ الدّرس اللّسانيّ في القرن العشرين، ومن
ذلك (توزيعية) (هاريس) الّتي أراد بها مناقضة أستاذه (بلومفيلد)، إذ اعتمد في صوغ اللّغة على أسسٍ تحويليّة.
وقد كان لـ (تشومسكي) كبير الأثر في انتقال الدرس اللّسانيّ من المستوى التصنيفي إلى المستوى التنظيري؛ فقد كانت المدارس السابقة عليه تجعل وكدها في تصنيف الوقائع اللّسانيّة ووصفها، قاصدةً من وراء ذلك إلى وضع تنظيم يعمل الوقائع موضوع الدّرس.
نخلص مما تقدَّم في الصّفحات السّابقة إلى جملةٍ من النّتائج، لعلّ منها:
1. أنّ الدّرس اللّسانيّ نشأ متداخل التّخوم مع بعض العلوم اللّغويّة الأُخرى، من نحوٍ، وصرفٍ، ... لكنّه أخذ يشقّ طريقه مستقلًّا عن غيره من العلوم، وينظر إلى اللغة نظرةً كليّة، وطمح إلى بناء نظريّة خاصّة به.
2. أنَّ التّيارات اللّسانيّة تعدّدتْ، فكانت هناك البنيويّة، والذّهنيّة، والسّلوكيّة، والتّوزيعيّة، والوظيفيّة، والتّوليديّة، وكان لكلّ اتّجاه منها أصوله الفكريّة والفلسفيّة، ولكلّ منها توجّهاته الخاصّة في الدّراسة اللّسانيّة. ولكن يبدو أنّ منها ما كان محكومًا بغرضٍ معينٍ ومرتبطًا بفكرٍ خاصٍّ، كالذّهنيّة، والسّلوكيّة، واتّصف بعضها ـ كالتّوزيعية ـ بالصّعوبة والصّلابة مما جعل استمرارها مستحيلًا، فخرجت من عباءتها تحويليّة (تشومسكي) وتوليديته.
3. ابتعدت بعض التّيارات اللّسانيّة ابتعادًا كثيرًا عن واقع الدّرس اللّسانيّ، كما هي حال الذّهنيّة لـ (سابير)، والسّلوكيّة لـ (بلومفيلد)، فكان ذلك الابتعاد مؤذنًا بانتهائها، مؤكّدًا عدم جدواها في الدّراسة اللّغويّة.
4. لم يكنِ الدّرس اللّسانيّ سكونيًا، فلم يثبت على حال، وهذا دليل حيويّةٍ وامتدادٍ، فكانت النّظريات اللّسانية تَتْرَى، تحاول اللّاحقة منها تجاوز ما وُجِّه من نقدٍ إلى السّابقة.
5. تعدُّ جهود (فرديناند دو سوسور) ذروة سنام الدّرس الوصفيّ اللّسانيّ الّذي بسط سلطته على القرن العشرين عامّة، ذلك أنّ مقولاته وجدَتْ لها أثرًا ظاهرًا في الدّارسين الّذين تلوه.
6. أنّ المنهج اللّسانيّ الّذي تبناه (تشومسكي) هو المرحلة الثّانية المهمة في الدّراسات اللّسانيّة، وهو اتّجاهٌ خرجَ من عباءة التّوزيعيّة وأستاذها (زيليغ هاريس)، وما زال تأثيره منذ أن نشر كتاب (البنى النّحويّة) حتى هذه السّاعة، على الرغم مما وجه إليها من انتقاد.
ولعلّ هذا الاتجاه اللّسانيّ الأكثر نجاعةً في الوقوف على سبل الاكتساب اللّغويّة من جهة، وفي قدرة متكلم اللّغة على توليد عباراتٍ جديدةٍ قياسًا لما لم ترفده به البيئة اللغوية على مارفدته به.
وقد لَقيتْ هذه النظريات عامّة، والوظيفيّة والتّوليديّة خاصّة، تمظهرات في الدّرس اللّسانيّ في السّاح العربيّة، فكان لها ممثلوها وأقطابها الّذين سعوا إلى استثمار الأصول النّظريّة لهذه التّيارات وتوظيفها في دراسة اللّغة العربيّة، مع أنّنا لا نعدم في تراثنا بعض مثل هذه الأفكار عند بعض اللّغويين الّذين كانوا يمزجون الدّرس النّحويّ بالبلاغيّ، ويأتي على رأسهم عبد القاهر الجرجانيّ، الّذي تنطق آثاره بكثير من مقولات النّحو التّحويليّ التّوليديّ، وأبو الحسن الفارقيّ الّذي لا نعدم ذلك عنده، ولا سيما في كتابه (تفسير المسائل المشكلة في أوّل المقتضب)، إذ إِنَّ نماذجه وأمثلته لا تخرج عما كان يدعو إليه (تشومسكي).
ولكن هذا لا يحجب عن أعيننا الرّؤية، ولا يدفعنا إلى الادعاء بأنّنا ـ نحن العرب ـ السّباقون، وأنّ الغرب ليس له فضل الرّيادة، فإنّ الدّرس اللّسانيّ لدينا ـ على تعدّد اتجاهاته ـ لا يمتلك أصولَ نظريَّةٍ متكاملة، ولا يعدو أنْ يكون طفرة، وليس نتيجة تراكمات معرفية، مع إيماننا أنّ (تشومسكي) نفسه لم يبنِ نظريته إلّا بالاتّكاء على دراسته اللّغة العبريّة ونحوها، هذه اللّغة الّتي تتّفق والعربيّة في الأصل الواحد.
(156). ابن جني، عثمان: الخصائص، تحقيق محمد علي النجار، 1952م، نسخة مصورة، جامعة البعث.
. ابن سينا: الشفاء، تحقيق د. إبراهيم بركور، القاهرة، 1966م.
. ابن نعمان، أحمد، وآخرون: اللّغة العربيّة، أسئلة التطور الذاتي والمستقبل، مركز دراسات الوحدة، كتاب رقم (46)، 2005م.
. إسماعيلي علوي، د. حافظ: اللسانيات في الثقافة العربية المعاصرة، دار الكتاب الجديد المتحدة، ط1، بيروت، 2009م.
. إسماعيلي علوي، د. حافظ: من قضايا اللغة العربية في اللّسانيّات التوليديّة، مجلة عالم الفكر، مجلد 37، ع 1، الكويت، 2008م.
. الأنباري، أبو بكر: الزاهر في معاني كلمات الناس، تحقيق: د. حاتم صالح الضامن، مؤسسة الرسالة، بيروت، الطبعة الأولى، 1412هـ/1992م.
. الأندلسي، ابن حزم: الإحكام في أصول الأحكام، مطبعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية.
. الأنصاري، ابن هشام، المباحث المرضية المتعلقة بـ (مَنْ) الشرطية، حققه د. مازن المبارك، دمشق، 1987م.
. الأنطاكي، محمد: الوجيز في فقه اللّغة، دار الشروق، بيروت، 1969م.
. الفراهيدي، الخليل بن أحمد: العين، تحقيق: د. مهدي المخزومي، ود. إبراهيم السامرائي، دار ومكتبة الهلال، د. ت.
. أنيس، إبراهيم: الأصوات اللّغويّة، مكتبة الأنجلو أمريكية، القاهرة، ط4، 1971م.
. أونج، والتر ج: الشفاهية والكتابة، عالم المعرفة، شباط، 1994م.
. إيلوار، رونالد: مدخل إلى اللّسانيّات، ترجمة بدر الدين القاسم، وزارة التعليم العالي، دمشق، 1980م.
. بارتشت، بريجتيه: مناهج علم اللغة من هرمان باول حتى نعوم تشومسكي، ترجمة د. سعيد حسن بحيري، مؤسسة المختار للنشر والتوزيع، القاهرة، ط1، 2004.
. بالمر، ف. ر: علم الدلالة، ترجمة مجيد الماشطة، الجامعة المستنصرية، بغداد، 1985م.
. باي، ماريو: أسس علم اللّغة، ترجمة د. أحمد مختار عمر، عالم الكتب، القاهرة، 1983م.
. بشر، كمال: علم اللّغة الاجتماعي، دار غريب للطباعة والنشر، القاهرة، 1995م.
. بوبو، د. مسعود: أثر الدخيل على العربيّة في عصور الاحتجاج، وزارة الثقافة بدمشق، ط1، 1978م.
. بيشت، هربرت، وجينفر دراسكاو: مقدمة في المصطلحية، ترجمة د. محمد حلمي هليل، جامعة الكويت، 2000م.
. الترابي، د. دفع الله: تعريب الرموز، مجلة مجمع اللّغة العربيّة، مج71، ع1.
. التنغيم في إطار النظام النحوي: مجلة جامعة أم القرى، ع 14، السنة 10، 1417 – 1996.
. جرمان، كلود، ولوبلان، ريمون: علم الدلالة، ترجمة نور الهدى لوشن، دار الفاضل، دمشق، 1994م.
. حجازي، د. محمود فهمي، الأسس اللّغويّة لعلم المصطلح، ط1، دار غريب للطباعة، القاهرة، 1977م.
. حجازي، محمود فهمي: مدخل إلى علم اللّغة، القاهرة، 1989م.
. حسّان، تمّام: اللّغة العربيّة معناها ومبناها، الهيئة المصرية العامة للكتاب، 1979م.
. حسّان، تمّام: اللّغة بين المعيارية والوصفية، القاهرة، 1958م.
. حسّان، تمّام: مناهج البحث في اللّغة، دار الثقافة، الدار البيضاء، 1394هـ/1974م.
. حسين، محمد الخضر: دراسات في العربيّة وتاريخها، دمشق، المكتب الإسلامية، 1960م.
. الخولي، محمد علي: معجم علم اللّغة النظري، مكتبة لبنان-ناشرون.
. دوبيكير، لويك: فهم فرديناند دو سوسور وفقًا لمخطوطاته: مفاهيم فكرية في تطوّر اللّسانيّات، ترجمة: ريما بركة، المنظمة العربيّة للترجمة، مركز دراسات الوحدة، بيروت، ط1، 2015م.
. دو سوسور، فردنياند: محاضرات في الألسنية، ترجمة يوسف غازي ومجيد نصر، دار نعمان، بيروت، 1984م.
. دو سوسور، فرديناند: علم اللّغة العام، ترجمة يوئيل عزير، العراق.
. دو سوسور، فرديناند: فصول في علم اللّغة، ترجمة أحمد نعيم الكراعين، دار المعارف الجامعية، الإسكندرية، 1985م.
. ديكرو، أوزاولد: القاموس الموسوعي الجديد، ترجمة منذر عياشي، جامعة البحرين، 2003م.
. الرّاجحي، عبده: النحو العربي والدرس الحديث، دار النهضة، بيروت، ص: 1986م.
. روبنز، ر. هـ: موجز تاريخ علم اللّغة، ترجمة د. أحمد عوض، عالم المعرفة، الكويت، ع 227، 1997م.
. زكريا، فؤاد: التقليد العلمي، عالم المعرفة، الكويت 1978م.
. زكريا، ميشال: التطور الذاتي في الألسنية التوليدية والتحويلية، مجلة الفكر العربي المعاصر، ع 25، 1983.
. زكريا، ميشال: المكوِّن الدلالي في القواعد التوليدية والتحويلية، مجلة الفك العربي المعاصر، العددان (18/19).
. السامرائي، إبراهيم: التطوّر اللّغويّ التاريخي، دار الأندلس، بيروت، 1983م.
. سامسون، جفري: مدارس اللّسانيّات، التسابق والتطور، ترجمة زياد كبة، النّشر العلميّ والمطابع، جامعة الملك سعود، 1417هـ.
. السّراقبي، د. وليد: الأسلوبية الصوتية وتحليل الخطاب، دائرة الثقافة والإعلام، الشارقة، 2016م.
. السعران، محمود: علم اللّغة: مقدمة للقارئ العربي، دار النهضة، بيروت، بلا تاريخ.
. سفر التكوين.
. سليكي، خالد: من النقد المعياري إلى التحليل اللساني، مجلة عالم الفكر، الكويت، مج23، ع1و2، 1994م.
. السّيد، صبري: تشومسكي وفكره اللّغويّ وآراء التقادمية، دار المعرفة الجامعية، الإسكندرية، 1989م.
. شنوقة، السعيد: مدخل إلى المدارس اللّسانيّة، المكتبة الأزهرية، القاهرة، 2008م.
. طحان، ريمون: الألسنية العربيّة، دار الكتاب العربي، بيروت، 1972م.
. طليمات، د. غازي: في علم اللّغة، ط3، دار طلاس، دمشق، 2007م.
. عبد التواب، رمضان: المدخل إلى علم اللّغة ومناهج البحث اللّغويّ، مكتبة الخانجي، القاهرة، 1985م.
. عبد العزيز، محمد حسن: مدخل إلى علم اللّغة، القاهرة، 1983م.
. العلوي، شفيقة: محاضرات في المدارس اللّسانيّات المعاصرة، أبحاث للترجمة والنشر، بيروت، 2004م.
. عمر، أحمد مختار: الألسنية، عالم الفكر، مج 20، ع 3، 1989م.
. عمر، أحمد مختار: البحث اللّغويّ عند العرب، طرابلس، 1972م.
. عمر، أحمد مختار: دراسة الصوت اللّغويّ، عالم الكتب، القاهرة، 1976م.
. غازي، يوسف: مدخل إلى الألسنية، منشورات العالم العربي الجامعية، دمشق، ط1، 1985م.
. الفراهيدي، الخليل بن أحمد: العين: تحقيق: د. مهدي المخزومي، ود. إبراهيم السامرائي، دار ومكتبة الهلال.
. فلشر، هنري: العربيّة الفصحى، ترجمة د. عبد الصبور شاهين، دار المشرق، بيروت، ط2، 1983م.
. فندريس، ج: اللّغة، تعريب عبد الحميد الدواخلي ومحمد القصاص، مكتبة الأنجلو المصرية.
. الفهري، عبد القادر الفاسي: اللّسانيّات واللّغة العربيّة، دار الشؤون الثقافية، بغداد 1985.
. الفياض، محمد جابر: أهمية اللّغة في الحياة الإنسانية، مجلة اللّغة العربيّة والوعي القومي، 1984م، مركز دراسات الوحدة.
. الفيروزأبادي، القاموس المحيط (فقه).
. قدور، أحمد: اللّسانيّات وآفاق الدرس اللّغويّ، دار الفكر، دمشق، 2001م.
. قدور، أحمد: مبادئ اللسانيات العامّة، جامعة حلب، 2006م.
. قضماني، رضوان: مدخل إلى اللّسانيّات، مديرية الكتب والمطبوعات الجامعية، منشورات جامعة البعث، بلا تاريخ.
. كانتينو، جان: دروس في علم الأصوات العربيّة، ترجمة صالح القرماوي، تونس، 1966م.
. الكفوي، أبو البقاء: الكليات، أعده للنشر د. عدنان درويش، ومحمد المصري، وزارة الثقافة، دمشق، 1981-1982م.
. كمال، ربحي: دروس في اللّغة العبرية، مطبعة جامعة دمشق، 1960م.
. ليونز، جون: اللّغة واللّغويّات، ترجمة د. محمد العناني، دار جرير، عمّان، ط1، 2008م.
. ليونز، جون: تشومسكي، النادي الأدبي، ترجمة د. محمد زياد كبة، الرياض، ط1، 1987م.
. ليونز، جون: نظرية تشومسكي اللّغويّة، ترجمة حلمي خليل، دار المعرفة الجامعية، الإسكندرية، 1985م.
. مارتينيه، أندريه: مبادئ اللّسانيّات، ترجمة زهير الحمو، وزارة التعليم العالي، دمشق.
. مانيس، دانييل: علم اللّغة، ترجمة سهيل عثمان وعبد الرزاق الأصفر، الموقف الأدبي، ع 135- 136، 1982م.
. المبارك، محمد: فقه اللّغة، دار الفكر، دمشق، 1972م.
. المتوكل، أحمد: المنحى الوظيفي في الفكر اللّغويّ العربيّ، دار الأمان، الرباط، ط1، 2006م.
. المتوكل، أحمد: الوظائف التداولية في اللّغة العربيّة، دار الثقافة، الرباط، ط1، 1985م.
. المرسي، ابن سيده: المحكم والمحيط الأعظم، تحقيق: عبد الحميد هنداوي، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى، 1421هـ/2000م.
. مرعي، عيد: اللسان الأكادي، وزارة الثقافة، دمشق، 2012م.
. المزيني، د. حمزة: التحيّز اللّغويّ، سلسلة كتاب الرياض، ع 125، 2004م.
. المزيني، د. حمزة: مراجعات لسانية، سلسلة كتاب الرياض، ع 75، 1420هـ.
. المسدي، عبد السلام: التفكير اللّسانيّ في الحضارة العربيّة، تونس، 1981م.
. المسدي، عبد السلام: قاموس اللّسانيّات، الدار العربية للكتاب، بلا تاريخ.
. مطر، عبد العزيز: علم اللّغة وفقه اللّغة، تحديد وتوضيح، قطر، 1985م.
. مطر، عبد العزيز: علم اللّغة وفقه اللّغة، قطر، 1983م.
. المعجم اللّغويّ التاريخي، مجمع اللّغة العربيّة، القاهرة، 1976م.
. منصور، عبد الحميد: علم اللّغة النفسي، الرياض، 1403 هـ.
. مونان، جورج: تاريخ علم اللّغة حتى القرن العشرين، ترجمة بدر الدين القاسم، وزارة التعليم العالي، 1981م.
. مونان، جورج: تاريخ علم اللّغة حتى القرن العشرين، ترجمة نجيب غزاويّ، وزارة التعليم، مطابع مؤسسة الوحدة، 1972م.
. وافي، علي عبد الواحد، علم اللّغة، نهضة مصر للطبع، القاهرة، 1984م.
. الوعر، مازن: قضايا أساسية في علم اللّسانيّات الحديث، دار طلاس، ط1، 1988م.
. الوعر، مازن: نحو نظرية لسانية عربية حديثة، دار طلاس، دمشق، ط1، 1987م.
. هيشن، كلاوس: القضايا الأساسية في علم اللّغة، ترجمة سعيد بحيري، مؤسسة المختار، القاهرة، ط1، 2003م.
. Martinet، André: La description phonologique avec application au parler francoprovençal d’Hauteville (Savoie)، coll. Publication romanes et françaises، Genève، Librairie Droz، 1956.- Martinet، André: La synchronie dynamique، André Martinet. La Linguistique Vol. 26، Fasc. 2، Linguistique et “facteurs externes”? (1990)، pp. 13-23.
. Sapir، Edward: Language، BiblioBazaar، 2008، 228 pages.
. Sapir، Edward: La réalité psychologique des phonemes، Presses universitaires .deFrance، 1933، 265 pages.
(166)