

دراسة نقديّة لأركان نظرية لكسنبرغ
لكسنبرغ -السيرة العلميَّة- | 22
ثالثًا: نقد آراء لكسنبرغ المطروحة عن لغة القرآن والخطِّ العربيّ | 33
أولاً: رأي لكسنبرغ في القراءة والفهم الخاطئ للقرآن عند المسلمين | 83
1 - التعابير التي قُرئت قراءةً خاطئة | 83
2 - التعابير التي فُهمت وتُرجمت بنحو خاطئ | 85
ثانيًا: نقد آراء لكسنبرغ المطروحة في القراءة والفهم الخاطئ للقرآن عند المسلمين | 102
1 - نقد منهجيَّة لكسنبرغ | 103
2 - النقد على أساس المعاجم | 109
3 - النقد على أساس تراث الأدب الجاهليّ | 117
4 - النقد على أساس السياق القرآنيّ | 132
5 - النقد على أساس التراث الروائيّ | 135
أ- معاني مفردات الآية ٦٤ من سورة الإسراء | 137
6 - الانتقادات الموجَّهة إلى لكسنبرغ من قِبَل المستشرقين | 154
المصادر والمراجع العربيّة | 174
المصادر والمراجع الفارسيَّة | 192
مقدّمة المركز 11
مقدّمة المؤلِّف15
المدخل22
الفصل الأول
دراسة نقديّة لأركان نظرية لكسنبرغ
لكسنبرغ -السيرة العلميَّة-22
أولاً: لغة القرآن29
ثانيًا: الخطّ العربيّ31
ثالثًا: نقد آراء لكسنبرغ المطروحة عن لغة القرآن والخطِّ العربيّ33
1 - لغة أهل مكَّة33
أ. الآراميَّة القديمة35
ب. الآراميَّة الغربيَّة35
ج ـ الآراميَّة الشرقيَّة37
2 - المسيحيَّة في مكَّة42
3 - لغة القرآن49
4 - الخطّ العربيّ 54
أ- الرأي التقليديّ60
ب- رأي لكسنبرغ64
ج- الرأي الحديث66
5 - مسألة الإعجام74
الفصل الثاني
دراسة نقديّة لفهم لكسنبرغ
أولاً: رأي لكسنبرغ في القراءة والفهم الخاطئ للقرآن عند المسلمين83
1 - التعابير التي قُرئت قراءةً خاطئة83
2- التعابير التي فُهمت وتُرجمت بنحو خاطئ85
ثانيًا: نقد آراء لكسنبرغ المطروحة في القراءة والفهم الخاطئ للقرآن عند المسلمين102
1 - نقد منهجيَّة لكسنبرغ103
2 - النقد على أساس المعاجم109
3 - النقد على أساس تراث الأدب الجاهليّ117
4 - النقد على أساس السياق القرآنيّ132
5 - النقد على أساس التراث الروائيّ135
أ- معاني مفردات الآية ٦٤ من سورة الإسراء 137
ب - الحور العين139
6 - الانتقادات الموجَّهة إلى لكسنبرغ من قِبَل المستشرقين154
8 - نقد مصادر البحث159
خاتمة161
الملحقات164
المصادر والمراجع174
المصادر والمراجع العربيّة174
المصادر والمراجع الفارسيَّة192
المصادر والمراجع الإنكليزيَّة194
المصادر والمراجع الألمانيَّة204
إلى أهل بيت النبوَّة، وموضع الرسالة، ومختلف الملائكة، ومهبط الوحي، الحفظة لسرِّ الله، والخزنة لعلمه، والمستودع لحكمته، والتراجمة لوحيه، الأئمَّة الدعاة، والقادة الهداة، والسادة الولاة، الذين قرنهم الله بکتابه العزيز، الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، والذين جعلهم رسوله أحد الثقلين اللذين أودعهما في أمَّته، عليهم أفضل الصلاة والسلام.
(9)بسم الله الرحمن الرحيم
والحمد لله ربّ العالمين، وسلام على المبعوث رحمةً للعالمين سيّدنا ونبيّنا أبي القاسم محمّد بن عبد الله وعلى آله الأطهار الميامين...
قال الله -تعالى- في كتاب العزيز: (إِنَّا جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَّعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ) . تكشف هذه الآية عن أنّ الله -تعالى- هو الذي اختار اللغة العربيّة لتكون لغةً لكتابه الخاتم لرسالاته؛ لما لذلك من دخالةً في ضبط أسرار آياته وإيصال حقائقه ومعارفه من دون تحريف أو اضطراب أو التباس أو تشويه...؛ فقضى الله -تعالى- تنزيل حقائق كتابه الكريم ومعارفه العالية والسامية بقالب اللفظ العربيّ؛ لتقريبها إلى الأذهان والأفهام، ولتكون قابلةً للتعقّل والتأمّل، بأسلوب فاق حدود القدرة البشريّة في الفصاحة والبلاغة والبيان والتعبير... فالقرآن الكريم معجز كلّه باختلاف اللحاظات والجهات، وأبعاد إعجازه أعلى من أن تحصيها العقول، أو أن تدرك كنهها الأفهام. ومن أبعاد إعجاز القرآن فصاحته وبلاغته وبيانه، حيث تحدّى بها العرب الذين بلغوا مبلغاً لم يذكره التاريخ لواحدة من الأمم المتقدّمة عليهم أو المتأخّرة عنهم، ووطئوا موطئاً لم تطأه أقدام غيرهم في هذا المضمار، فتحدّاهم به، ثمّ تدرّج معهم في التحدّي إلى حدّ أن يأتوا بحديث من مثل القرآن الكريم! وبعد أن طال بهم الأمد، لم يجيبوه إلا بالعجز!
وقد جذبت لغة القرآن الكريم المستشرقين في فترة مبكِّرة من دراستهم للقرآن الكريم، فأبدى بعضهم الانبهار بها، وادّعى الأكثر تأثّرها بلغات الحضارات المحيطة بشبه الجزيرة العربيّة، وبالأدبيّات اللغويّة للكتب السماويّة السابقة على القرآن، وكذلك بأدبيّات أشعار الجاهليّة، وقد عاود المستشرقون المعاصرون تظهير هذه الادّعاءات بأساليب وأدوات عصريّة؛ فظهرت نظريّات معاصرة في مجال دراسة لغة القرآن الكريم تنطلق من البحث اللغويّ في فقه اللغة التاريخيّ وفقه اللغة المقارن بين اللغة العربيّة (لغة القرآن) وغيرها من اللغات السامية السائدة في الشرق (بلاد الشام والرافدين وشبه الجزيرة العربيّة) قبل نزول القرآن، ومن هذه النظريّات ما طرحه كريستوف لكسنبرغ من أنّ القرآن يحتوي على الكثير من المفردات الغامضة وغير القابلة للتفسير، حتّى أنّ العلماء المسلمين وجدوا صعوبةً بالغةً في توجيه بعض الفقرات لناحية إعراب معناها!!! مدّعيًا أنّ القرآن كُتِبَ بمزيج من العربيّة والسريانيّة (اللغة السوريّة الآراميّة القديمة المنطوقة والمكتوبة والسائدة في كلّ منطقة الشرق الأوسط إلى بداية القرن السابع الميلاديّ)؛ ولهذا أثره البالغ في تفسير القرآن!!! وقد لاقت نظريّة لكسنبرغ رواجاً وإعجابًا من قِبَل بعض الأكاديميّين، في حين وجد آخرون في تطبيقاته التفسيريّة انحيازًا وانتقائيّة للتفسير الذي يخدم طرحه! فأثار كتابه الذي ضمّنه نظريّته في لغة القرآن جدلًا عالميًّا في فقه اللغة التاريخيّ وفقه اللغة المقارن للغة العربيّة مع اللغات الساميّة السائدة قبل نزول القرآن في الشرق الأوسط، وقد لَقِي هذا الكتاب تغطية كبيرة في وسائل الإعلام الرئيسة وبشكل غير معتاد لكتاب في فقه اللغة التاريخيّ والمقارن (الفيلولوجيا)، وأُقيمت عن نظريّته مؤتمرات عالميّة عدّة؛ منها: ما أقامه الألماني فيسنشافتسكولغ (معهد الدراسات المتقدّمة) في برلين في سنة ٢٠٠٤م، ومؤتمر آخر أقيم سنة ٢٠٠٥م في جامعة نوتردام بعنوان (نحو قراءة جديدة للقرآن)؛ بحيث جمع عددًا من الذين أبدوا قبولًا بأسلوب لكسنبرغ، وآخرين قدّموا مقاربات نقديّة لنظريّته.
وأمام هذا الواقع، ومن منطلق الحرص على القرآن الكريم ولغته العربيّة التي
(12)ارتضاها الوحي لتكون مدخلًا لفهم صحيح وسليم للقرآن، كان من الضروري بذل الجهود العلميّة والبحثيّة لمناقشة هذه النظريّة ونقدها.
وهذا الكتاب الذي بين أيدينا من الجهود العلميّة المبذولة من قبل المركز الإسلامي للدراسات الاستراتيجية، ضمن مشروع القرآن في الدراسات الغربيّة؛ وهو جهد عملي بحثيّ مميّز أنجزه الباحث الإيرانيّ أميرحسين فراستي بإشراف الدكتور محمود كريمي الأستاذ المشارك في كليّة الإلهيات والدراسات الإسلامية في جامعة الإمام الصادق عليهالسلام في العاصمة الإيرانية طهران، تناول فيه بالدراسة والتحليل والنقد كتاب «القراءة السريانيَّة-الآراميَّة للقرآن» للمستشرق الألمانيّ كريستوف لكسنبرغ الذي بذل فيه مساعيه ـ كما يدَّعي كاتبه ـ في تقديم رؤيةٍ حديثةٍ في لغة القرآن الكريم وطريقة فهمها. ويتمحور الكتاب حول إثبات أنَّ لغة القرآن الكريم ليست عربيَّةً محضة، بل فيه مفردات من اللغة السريانيَّة تسبَّبت في صعوبة فهمه لدى المسلمين، إلى جانب الأخطاء التي ارتكبها الكتّاب، والتي أدَّت إلى عدم التماسك والاتِّساق في نصوصه الشريفة. ورأيه هذا ناجمٌ عن الاعتقاد بأصلٍ سريانيّ للقرآن، وهو رأيٌ لا يخلو من التعسُّف والتسرُّع، وفيه تغاضٍ عن حقائق جمَّة؛ فإنَّ بيانات علم الآثار وتصريحات علماء الساميَّات تعارضُ التاريخ الذي صنعه لكسنبرغ لمكَّة وأهلها، وكذلك التراث الروائيّ الإسلاميّ والشعر والأدب الجاهليّ زاخر بالشواهد المتعدِّدة التي ترفض دعاويه بشأن مفردات القرآن. هذا، مضافًا إلى استخدامه الخاطئ للمنهج الفيلولوجيّ الذي وظَّفه بشكلٍ منحاز في إثبات نظريَّته، فضلًا عن السياق القرآنيّ الذي لا يتناسب مع ما ادّعاه.
نرجو أن يقدِّم هذا الكتاب فائدة علميّة وبحثيّة مرجوّة للباحثين في نقد النظريّات الاستشراقيّة المعاصرة في لغة القرآن الكريم، ولا سيّما نقد نظريّة كريستوف لكسنبرغ في هذا المجال.
(13)
بسم الله الرحمن الرحيم
لقد شهد الاستشراق في سبعينيَّات القرن العشرين تحوُّلًا جذريًّا في مجال دراسات القرآن الكريم، على أثر انقسام المستشرقين إلى مدرستين ذواتَي اتِّجاهين مختلفين؛ سُمِّيَت المدرسة الأولى بـ«التقليديَّة»، والثانية بـ«التنقيحيَّة».
وما يميِّز المدرسة الثانية، والتي من روادها «وانسبرو» و«كرون» و«لولينغ» و«كوك»، هو أنَّها -خلافًا للأولى التي تقصر أبحاثها على المصادر الإسلاميَّة ـ تحلِّل التراث الإسلاميّ موظِّفةً منهجَ نقد المصادر، مضافًا إلى الاعتماد على مصادر غير عربيَّة، مثل: نتائج علم الآثار، وعلم الكتابات القديمة، وعلم المسكوكات. ويعمد هذا الاتِّجاه إلى إثارة الشكّ في صحَّة التاريخ الإسلاميّ، ويعتمد -بصورة صريحة أو ضمنيَّة- على فرضيَّات «جولدتسيهر»، الذي كان يرى
أنَّ الحديث [النبويّ] هو حصيلة التطوُّر الدينيّ والتاريخيّ والاجتماعيّ للإسلام في القرنين الأوَّلَيْن للهجرة، وعلى هذا الأساس فلا قيمة له في معرفة التاريخ الذي يدَّعيه، أيْ العصر النبويّ، بل للزمن الذي وُضع فيه، أيْ العصرَيْن الأمويّ والعبَّاسيّ. ويفضي هذا الاتِّجاه إلى القول بأنَّ القرآن ليس نتاجًا بشريًّا وحسب، بل اكتمل في فترة القرنين الأوَّلَيْن للهجرة، ومن هذا المنطلق يكترث بإعادة بناء نصِّ القرآن. لكن ما لبث أصحاب هذا الاتِّجاه أن تلقوا ردود فعلٍ قاسيةٍ وانتقاداتٍ لاذعةٍ من قبَل أغلبيَّة المستشرقين الذين رفضوا نظريَّاتهم؛ ما أدَّى إلى صمتهم لمدَّة سنوات.
ولعلَّ عودة هذا الاتِّجاه إلى الحياة من جديد مرهونةٌ بمؤسَّسة ألمانيَّة عنونت نفسها بـ«الإنارة» (Inârah)، تنويهًا بعصر التنوير الأوروبيّ الذي يمتاز برفض الطبيعة الإلهيَّة للكتاب المقدَّس، واستبدال القصص والخرافات والوحي بالعقلانيَّة، وهي تحاول تطبيق الاتِّجاه نفسه على الإسلام والقرآن. ومن أبرز الباحثين فيها: «كارل هاينتس أوليك» -مؤسِّسها ورئيس التحرير لعدد من منشوراتها- وكذلك «كريستوف لكسنبرغ»، مؤلِّف كتاب «القراءة السريانيَّة-الآراميَّة للقرآن: مساهمة في فكِّ شفرة لغة القرآن»، وهما كسائر المتعاونين مع تلك المؤسَّسة تتمحور مؤلَّفاتهم -نتيجةً لاعتقادهم بأنَّ الإسلام كان في البداية نوعًا من المسيحيَّة، وما زال
كذلك حتَّى نهاية القرن الأوَّل للهجرة- حول إثبات أصل مسيحيّ للإسلام.
تركِّز هذه الدراسة على كتاب لكسنبرغ المشار إليه آنفًا، والذي أثار ضجَّة بين المستشرقين والمسلمين لدى انتشاره للمرَّة الأولى باللغة الألمانيَّة عام ٢٠٠٠م. ثم نُقل إلى اللغة الإنكليزيَّة عام ٢٠٠٧م، مع إضافات من المؤلِّف نفسه، وهي النسخة التي اعتمدنا عليها هنا.
يشدِّد لكسنبرغ في كتابه هذا على مسألة الكلمات الدخيلة في القرآن الكريم، ويدَّعي تعديل فهمها على أساس منهجه الخاصّ، وذلك بعد إنكاره أهمِّيَّة المصادر الإسلاميَّة في فهم القرآن على الإطلاق. ويمتاز هذا الكتاب عن أمثاله في توظيف مؤلِّفه منهجًا فيلولوجيًّا في إثبات ما كان أسلافه -أمثال: «كارل فُلرز» و«ألفونس مينغانا»- بصدد إثباته.
وحريٌّ بالذكر أنَّ مسألة الكلمات الدخيلة في القرآن الكريم مسألةٌ قديمة قِدَمَ تاريخ القرآن، وقد اختلف فيها العلماء المسلمون بُعَيْد جمع القرآن. فبينما أنكر بعضهم وجود الكلمات المعرَّبة في القرآن الكريم؛ تمسُّكًا بقوله -تعالى-: (وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿١٩٢﴾ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ ﴿١٩٣﴾ عَلَىٰ قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ ﴿١٩٤﴾ بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُّبِينٍ)، أثبتها آخرون؛ مفسِّرين عبارة «بلسانٍ عربيٍّ» في قوله -تعالى- بـ«الواضح البيِّن» الذي جيء بوصف «مبين» لتوكيده؛ ولهذا عكف فريقٌ منهم على تدوين معاجم وتأليف كتب تضمٌّ هذه الألفاظ الدخيلة في العربيَّة.
ومن أقدم هذه الكتابات ما جُمع من أجوبةِ عبد الله بن عبَّاس على أسئلةٍ طرحها نافع الأزرق الخارجيّ، وما كتبه الجواليقي وسمَّاه «المعرب من الكلام الأعجميّ»، وتبعه كثيرون ممَّن لا تتَّسع هذه المقدّمة لذكر أسمائهم.
وليس المسلمون وحدهم من اهتمّ بهذه المسألة، بل كانت موضع اهتمام غيرهم -أيضًا-، حتَّى أقبل بعضهم على تأليف كتبٍ تحوي عددًا كبيرًا من هذه الألفاظ. ومن أشهر هذه الكتب ما ألَّفه القسِّيس المسيحيّ آرثر جفري، بعنوان: «الكلمات الدخيلة في القرآن»، والذي ضمَّنه أكثر من ثلاثمئة مفردة قرآنيَّة، رادًّا أصلها إلى خارج بيئة الإسلام. هذا، وعلى الرغم من اهتمام المسلمين وغيرهم بهذه المسألة، ولكن ثمَّة بونًا شاسعًا في رؤيتهما إلى هذه الكلمات، يكمن في استنتاج المستشرقين من التقارض اللغويّ أصولًا غير إلهيَّة للقرآن، مفترِضِين التوراة والإنجيل مصدَرَيْن له.
واستمرَّ هذا الاتِّجاه الاستشراقيّ فترة طويلة من الزمن حتَّى أكل عليه الدهر وشرب في ثلاثينيَّات القرن العشرين، إلى أنْ جاء المستشرق البلغاريّ «لولينغ» ليُحييَ بدعةً قد أُميتت، في كتابه: «القرآن الأصليّ» بحثًا عن جذورٍ مسيحيَّة للقرآن. ثمَّ ظهر بعده «لكسنبرغ» مطوِّرًا عناصر فرضيَّات «لولينغ»، ومؤكِّدا على نظريَّات علم اللسانيَّات، في كتابه الصادر سنة ٢٠٠٠م، والذي اختلفت الآراء -تأييدًا ومعارضةً- حول فكرته البديعة التي ادَّعاها فيه بشأن القرآن، والمتمثِّلة في أنَّ جزءًا كبيرًا منه هو باللغة السريانيَّة.
ومن أهمّ دعاوى هذا المستشرق، هو أنَّ بعض كلمات القرآن قُرئت أو فُهمت بنحو خاطئ؛ بسبب عدم تطوُّر الخطِّ العربيّ في زمن رسول الله صلىاللهعليهوآله، أو عدم كتابة
النقاط في رسم القرآن، وكذلك يعتبر الخطَّ السريانيّ أصلًا للخطِّ العربيّ، ولغةَ أهلِ مكَّة -أيْ مخاطبي القرآن- مزيجاً من العربيَّة والآراميَّة، قاصدًا السريانيَّة تحديدًا؛ وذلك للتواجد الحاشد للنصارى فيها. ومن هذا المنطلق بدأ بتعديل مفردات القرآن الكريم وتعابيره، وإيجاد الموافقة بينها وبين المعتقدات المسيحيَّة، مستدلًّا بأنَّها ليست بالعربيَّة، بل باللغة السريانيَّة.
أمَّا كتابه «القراءة السريانيَّة ـ الآراميَّة للقرآن»، فهو يتألَّف من ثمانية عشر فصلًا، بدءًا من المقدِّمة (الفصل الأوَّل) ووصولًا إلى الخلاصة (الفصل الثامن عشر)، وبعد أن يعرِّف مصادرَ بحثه في الفصل الثاني ومنهجيّته في الفصل الثالث، يعبِّر عن رأيه في الفصل الرابع في أصل الخطّ العربيّ ومشاكله التي أدَّت إلى أخطاء جمَّة ـ حسب دعواه ـ في قراءة القرآن وفهمه، ثمّ يشير في الفصل الخامس -وهو قصيرٌ جدًّا ـ إلى النقل الشفاهيّ أو الكتبيّ للقرآن منذ العصر النبويّ حتَّى عصر الخلفاء، وبينما يدَّعي عجز التراث الإسلاميّ عن تحديد زمن التعديل النهائيّ لقراءة القرآن، ويقدّر ذلك بفترة تربو على ثلاثمئة عام، تجده يُلفت الأنظار في الفصل السادس إلى الروايات الدالَّة على اختلاف الصحابة في قراءة القرآن، وفي الوقت ذاته تأكيد رسول الله صلىاللهعليهوآله على صحَّة جميع القراءات؛ تمهيدًا للفصل السابع، الذي ينوِّه فيه إلى مسألة القراءات السبعة للقرآن، وهنالك يربط بين هذه الأحرف السبعة والمصوِّتات السبعة في الخطّ السطرنجيلي (السريانيّ الشرقيّ)، وليناقشَ بعض الأحرف والمصوِّتات العربيَّة مثل «ي/ﱝ/ئ/ا/ة»، ويضرب أمثلةً من تعديلاتٍ أجراها على قراءة القرآن وفهمه، مشدِّدًا على خلط القرآن بين قواعد الكتابة العربيَّة والسريانيَّة كثيرًا، وعلى صمت النبيّ صلىاللهعليهوآله في الإجابة على السؤال عن تأويل القرآن، وفي الفصل الثامن يشير إلى الصعاب التي واجهها مترجمو القرآن إلى اللغات الأوروبيَّة، وتصريحهم بغموض جملة من المفردات والتعابير القرآنيَّة؛ ليخوض بعدها ـ تدريجيًّا ـ في نقد عربيَّة لغة القرآن، مفسِّرًا إعجازه -في الفصل التاسع- باستحالة فهم تفاصيله على الإنسان، ومنطلقًا في الفصل العاشر من مفردة «القرآن» نفسها، مدَّعيًا أنَّها مأخوذة من كلمة «ܩܪܝܢܐ» السريانيَّة التي تعني
(19)«كتاب قراءة النصوص المقدَّسة» (Lectionary)، متَّخذًا من ذلك دليلًا على إثبات تأثُّر القرآن بها، بل اقتباسه من الكتاب المقدَّس -أي العهدين القديم والجديد- وليس مستقلًّا عنهما. هذا، ويُعالج في الفصل الحادي عشر بعض الآيات التي تدلّ على نزول القرآن بلسانٍ عربيٍّ مبين، بينما يتشبَّث بأدلَّة -يسمِّيها بالفيلولوجيَّة- يسعى من خلالها إلى إثبات أنَّ لغة القرآن مختلفةٌ تمامًا عمَّا سُمِّي لاحقًا -أيْ بعد قرنين من الهجرة- بالعربيَّة الكلاسيكيَّة؛ إذ هي لغة الكتاب المقدَّس نفسها، ثمّ فُصِّلِت (يعني -كما يزعم لكسنبرغ تُرجمت) إلى العربيَّة. وبعد ذلك يتناول في الفصل الثاني عشر -بإسهابٍ- نماذج من المفردات والتعابير القرآنيَّة التي يزعم لها أصولًا سريانيَّة، وقد أدَّت قراءتها بوصفها ألفاظًا ذات أصول عربيَّة إلى عدم فهمها الصائب لدى المفسِّرين المسلمين، فيحاول تصحيح قراءتها، إلى جانب تقديم فهمٍ جديدٍ منها، مستدلًّا بتوظيف منهجه الفيلولوجيّ في لغة القرآن. كذلك يناقش في الفصل الثالث عشر اقتباس العربيَّة من النحو السريانيّ، ويشير إلى أمثلة في القرآن، ثمَّ يعالج في الفصل الرابع عشر آيتين من القرآن، يدَّعي قراءتهما الخاطئة في ما مضى من الزمان. ثمَّ يقدِّم في الفصل الخامس عشر دراسةً عن مدلول الحور العين، أثارت جدلًا واسعًا، حيث عبَّر فيها عن فهمه الغريب لهذا التعبير وهؤلاء الكائنات، معقِّبًا بالبحث عن الغِلمان (أو الولدان المخلَّدون)، مستنتجًا في الأخير أنَّ المفسِّرين المسلمين كانوا غافلين عن العناصر المسيحيَّة في الجنَّة التي يصوِّرها القرآن. ويختتم الكتاب بتفسيره الجديد لسورتَي الكوثر والعلق، فيبذل جهده في إيجاد الموافقة بين مضامينهما والمعتقدات المسيحيَّة التي اعتنقها السريان.
أمَّا هذا الكتاب الذي بين أيديكم، فيتناول أهمّ دعاوى لكسنبرغ في مجال لغة القرآن والخطّ العربيّ، ويعالج دعاويه الواردة في الفصلين الرابع عشر والخامس عشر من كتابه أنموذجًا؛ محاولًا الإجابة على الأسئلة الآتية:
1- ما هي أهمّ دعاوى لكسنبرغ وأدلَّته في إثبات نظريَّته عن القرآن؟
2- هل تتلائم نتائج الكتاب مع التراث الإسلاميّ؟
(20)3- هل هذه النتائج مدعومة بمنهج علم اللسانيَّات، وهل كان المؤلِّف مصيبًا في توظيف هذا المنهج أو لا؟
ويتألَّف الكتاب من فصلين رئيسين؛ هما:
- الفصل الأوَّل: تطرّق فيه الباحث إلى أركان نظريَّة لكسنبرغ، مع الاستفادة من معطيات علم الآثار ونتائجه وما قاله المستشرقون وعلماء الساميَّات عن تاريخ العرب قبل الإسلام؛ لتقويم مدى صحَّة ما ادَّعاه لكسنبرغ عن تاريخ مكَّة وأصل الخطّ العربيّ.
- الفصل الثاني: يدرس فيه الباحث أنموذجين من تعديلات لكسنبرغ على قراءة القرآن وفهمه، وسيأتي التوضيح لاختيارهما. وقد قُدِّمت في هذا الفصل أدلَّة من التراث الروائيّ الإسلاميّ، وكذلك من تفاسير العلماء المسلمين، إلى جانب أشعار العرب في الجاهليَّة، مضافًا إلى دراسة فيلولوجيَّة لبعض مفردات القرآن، فضلًا عن آراء المستشرقين في مزاعم لكسنبرغ والردّ عليها.
وفي الختام، أقدِّم جزيل الشكر والامتنان والتقدير والاحترام للمركز الإسلاميّ للدراسات الاستراتيجيَّة-فرع بيروت؛ لموافقتهم على نشر هذه الدراسة، ثمَّ خالص شكري لأستاذي الغالي الدكتور محمود كريمي الذي أشرف على هذه الدراسة، وأرشدني إلى النهج القويم في إنجازها، كما أشكر الأستاذ الدكتور نهاد حسن حجي الشمري، الذي زوَّدني بجملةٍ من الكتب النافعة عن أصل الخطِّ العربيّ وتاريخه. وأرجو من الله-سبحانه وتعالى- أن يتقبَّل هذه الدراسة المتواضعة، ويجعلها توعيةً للأمَّة الإسلاميَّة، وصيانةً لهم من تضليل المستشرقين وأعداء الدين.
«كريستوف لكسنبرغ» (Christoph Luxenberg) هو الاسم المستعار لمستشرقٍ ألمانيٍّ لا يزال اسمه الحقيقيّ مجهولًا. ويرى رضوان السيِّد أنَّه مسيحيٌّ لبنانيّ الأصل يتخفَّى تحت هذا الاسم المستعار؛ لأسبابٍ أمنيَّةٍ، وأنَّ بعض أصدقائه المسلمين نصحه بأن يستخدم اسمًا مستعارًا؛ كيلا تقتله جماعة متطرِّفة قبل أن يُحكم عليه بما حُكم على سلمان رشدي، ويخمِّن السيِّد أنَّ اسمه الحقيقيّ هو «أفرام ملكي»، من دون أن يقدِّم دليلًا على ذلك. أمَّا «استينبرك»، فيحتمل أنَّه من الهنود السريان، الذين يتقنون السريانيَّة، باعتبارها لغتهم العباديَّة.
هذا، وتستند دراسة لكسنبرغ -حسب ما وصل إليه «بڤرينغ»- إلى مؤلَّفات القسّ اللبنانيّ جوزيف قزِّي، مؤلِّف كتابَي «نبيّ الرحمة» و«قسّ ونبيّ»، وهو الذي يرى للقرآن أصلًا سريانيًّا، واصطنع له تاريخًا لا يعرفه غيره.
وتشير المعلومات المنشورة في الصحف إلى أنَّ لكسنبرغ هو أستاذٌ للُّغات الساميَّة في جامعة ألمانيَّة، لكنَّ البروفيسور «فرانسوا دوبلوا» يرى أنَّه رجل يتقن اللغة العربيَّة العاميَّة، ولديه فهم مقبول بالعربيَّة القديمة، وبجانبهما يستطيع قراءة
اللغة السريانيَّة؛ ليستخدمَ معاجمها، ولكنَّه يجهل منهجيَّة اللغويات الساميَّة المقارنة. ثمَّ إنَّ رسالة لكسنبرغ للدكتوراه تُعنى بمخطوطٍ سريانيٍّ يعود تاريخه إلى القرنين الثامن والتاسع للميلاد، وقد كشف هو نفسه عن أسراره بعد مقارنته باليونانيَّة الأصيلة، فكان الطريق الذي أوصله إلى المنهجيَّة التي وظَّفها في ما بعد لفهم ملابسات القرآن.
وقد برز الاهتمام بكتاب لكسنبرغ، تحديدًا بعد أحداث ١١ سبتمبر، حيث سلَّطت الصحف الضوء عليه كثيرًا؛ نظرًا إلى ربط الرأي العامّ بين فكرة لوكسنبرغ في كتابه عن الحور العين -التي وُعد الشهداء بها في الآخرة- وبين البيان الصادر عن مختطفي الطائرة في تلك الأحداث.
وللكسنبرغ ـ أيضًا ـ مقالات في مجال لغة القرآن، منها:
1- مقالة بعنوان: «عيد الميلاد (كريسماس) في القرآن»؛ نشرها في كتاب «أبحاث عن الإسلام تكريمًا لأنطوان موصلي»، عام ٢٠٠٤م.
2- مقالة بعنوان: «ترجمة جديدة لنقش قبَّة الصخرة في أورشليم»؛ نشرها في كتاب «الأصول المظلمة: بحث جديد عن أصل الإسلام وتاريخه المبكر»، عام ٢٠٠٥م. وتُعدّ هذه المقالة محاولة جديدة لقراءة نقش قبَّة الصخرة من منظارٍ لغويٍّ تاريخيٍّ، على أساس المنهج الذي أبدعه لأوَّل مرَّة في كتابه «القراءة السريانيَّة-الآراميَّة للقرآن». وما يميِّز هذه الترجمة هو أنَّ المؤلِّف يرى اسم «محمَّد صلىاللهعليهوآله » الوارد في هذا النقش صفةً تنعت عيسى بن مريم عليهالسلام ، خلافًا للرؤية التقليديَّة التي تراه اسمَ علَمٍ لرسول الإسلام صلىاللهعليهوآله .
3- مقالة بعنوان: «بقايا الحروف السريانيَّة الآراميَّة في المخطوطات القرآنيَّة المبكرة في الأسلوبين الحجازيّ والكوفيّ»، نشرها في كتاب «الإسلام المبكر: إعادة بناء تاريخيَّة نقديَّة مبنيَّة على مصادر تفسيريَّة»، عام ٢٠٠٧م. وفيه يردِّد المؤلِّف دعواه المذكورة في مقدِّمة كتابه «القراءة السريانيَّة-الآراميَّة للقرآن»، من أنَّ القرآن هو أوَّل كتابٍ عربيٍّ، لكنَّه لم يكن مكتوبًا بالخطِّ العربيّ الذي نعرفه، بل بالخطّ الكرشونيّ (كتابة العربيَّة بالخطّ السريانيّ). ويزيد عليه أنَّه: من المحتمل أنَّ مصحف حفصة الذي أحرقه عثمان بعد جمع القرآن كان مكتوبًا بالخطِّ الكرشونيّ. ومن ثم يَعِد بتقديم أدلَّة أكثر استيعابًا في مؤلَّفاته المقبلة.
4- مقالة بعنوان: «الطقس السريانيّ والحروف الملغّزة في القرآن: دراسة ليتورجيَّة مقارنة»، نشرها في كتاب «الإضاءة: القرنين الأوَّلين من الهجرة»، عام ٢٠٠٨م. يتناول فيها مسألة الحروف المقطَّعة، ويدَّعي أنَّه حلَّ اللغز الذي أرهق العلماء لعشرات القرون، مستعينًا بالتراث المسيحيّ السريانيّ؛ لأنَّ هذه الحروف آراميَّة الأصل، ما يؤكِّد -بحسب زعمه- ضرورة معرفة اللغة الآراميَّة في فهم القرآن، وإعادة بناء نصِّه الذي قُرئ وفُسِّر بشكلٍ خاطئ.
5- مقالة بعنوان: «لا غزوةَ بدر: عن الحروف السريانيَّة في المخطوطات القرآنيَّة المبكرة»؛ نشرها في كتاب «من القرآن إلى الإسلام: كتابات حول تاريخ الإسلام المبكر والقرآن» عام ٢٠٠٩م. يرى فيها أنَّ الآية (وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنتُمْ أَذِلَّةٌ ۖ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ) قُرِئت خاطئة، والصحيح هو «بعذر»، ويكون المعنى المعدَّل للآية: ولقد دعمكم الله بمساعدة سماويَّة وأنتم قليلون.
6- مقالة بعنوان: «سورة النجم: قراءة سريانيَّة آراميَّة جديدة عن الآيات الثماني عشرة الأولى»؛ نشرها في المجلَّد الثاني من كتاب «رؤى جديدة إلى القرآن: القرآن في محيطه التاريخيّ»عام ٢٠١١م. في هذه المقالة يعدِّل لوكسنبرغ
ترجمة الآيات المختارة، منطلقًا من أنَّ الموضوع المركزيّ للسورة هو ردع تهمة مسّ روحٍ شريرةٍ للرسول صلىاللهعليهوآله ، فليس هو متأثِّرًا بالسقوط (ترجمته لـ«الهوى» في الآية الثالثة)، الذي هو من آثار الجنون، عندما علَّمه الربُّ القدير ـ المتواجد في الأفق الأعلى ـ مقرِّبا نفسه إلى عبده، الذي أصبح مصعوقا للحظَتَيْن أو أقلّ.
7- مقالة بعنوان: «الإنارة في القرآن: كلمة فريدة متجاهَلة (أنارة/أثارة-سورة الأحقاف، الآية ٤)»؛ نشرها في المجلَّد الأوَّل من كتاب «تكوُّن ديانةٍ عالميَّةٍ: مدينة مكَّة المقدَّسة-قصَّة أدبيَّة»، عام ٢٠١٠م.
8- مقالة بعنوان: «لا تعدُّد زوجات ولا اتِّخاذ أخدان في القرآن (سورة النساء، الآية ٣)، القسم الأوَّل»؛ نشرها في المجلَّد الثاني من كتاب «تكوُّن ديانةٍ عالميَّةٍ»، عام ٢٠١٢م.
9- مقالة بعنوان: «القرآن والحجاب الإسلاميّ».
10- مقالة بعنوان: «عن الصرف والإتيمولوجيا لـ «ساطانا» السريانيَّة الآراميَّة و[لفظة] «الشيطان» «القرآنيَّة العربيَّة»؛ نشرها والمقالة السابقة في كتاب «نقاش حول القرآن -جدل لكسنبرغ: وجهات النظر والخلفيَّات»، عام ٢٠٠٤م.
هذا، مضافًا إلى مقالات أخرى، نشرها في مجلَّة «Imprimatur» الإلكترونيَّة.
يُشيِّد لكسنبرغ نظريَّته على مقولة أنَّ لغةَ القرآن آراميَّة سريانيَّة وليست عربيَّةً. ويقصد بالآراميَّة السريانيَّة فرعًا من اللغة الآراميَّة التي كانت منتشرة في الشرق الأدنى، والتي كان يتحدَّث بها أهلُ إديسا والمناطق الشماليَّة الغربيَّة المحيطة ببلاد ما بين النهرين، بوصفها لغتهم الأمّ، وخصوصًا لغة كتابة الأصول المسيحيَّة للقرآن. لقد كانت الآراميَّة لغة التواصل في الشرق الأوسط بكامله لأكثر من ألف سنة، حتَّى حلَّت محلَّها اللغةُ العربيَّة في القرن السابع للميلاد. والظاهر أنَّ أوَّل من سمَّى الآراميَّة بالسريانيَّة هم اليونان، وكانت هذه التسمية مستخدمة لدى المسيحيِّين الآراميِّين؛ تمييزًا لهم عن مواطنيهم الكفّار. وقد أطلقت العربُ هذه التسمية على المسيحيِّين الآراميين في كتاباتهم الأولى؛ مثل: الأدب الروائيّ، وهذا دليلٌ على أهمِّيَّة هذه اللغة في الفترة التي نشأت فيها الكتابة العربيَّة. ويشير لكسنبرغ إلى هذه الأهمِّيَّة، قائلًا: انتشرت السريانيَّة الآراميَّة بوصفها لغة كتابة -وبشكلٍ خاصّ في ترجمة الكتاب المقدَّس- من سوريا إلى بلاد الفُرس، وذروة هذا الأدب في ما بين القرن الرابع والسابع للميلاد.
وعندما يُفصح عن طموحه في تسليط الضوء على عدد من أوجه غموض لغة القرآن، يستطرد قائلًا: «هذه الحقيقة ـ أي أنَّ اللغة السريانيَّة الآراميَّة كانت أهمّ لغة الكتابة والحضارة في بيئة ظهر فيها القرآن، يعني فترة لم تكن بعدُ العربيَّةُ لغة كتابة، فكان العرب المتعلِّمون يستخدمون الآراميَّة لأجل الكتابة ـ تنمّ عن أنَّ مخترعي الكتابة العربيَّة كانوا قد أخذوا معارفهم ومهاراتهم من بيئةٍ سريانيَّةٍ آراميَّة. ثمَّ إنَّه بملاحظة أنَّ العرب في الغالب تنصَّروا، وشاركت نسبةٌ كبيرةٌ منهم في الطقوس المسيحيَّة السريانيَّة، يتَّضح بجلاء أنَّ هؤلاء العرب -قطعًا- قد أدخلوا عناصر معتقدهم السريانيّ الآراميّ ولغتهم الثقافيَّة في العربيَّة. إذًا، تعنى هذه
على النبيّ صلىاللهعليهوآله أن يُبَلِّغ القرآن إلى «أُمَّ الْقُرَى وَمَنْ حَوْلَهَا»، ومن هنا يذهب لكسنبرغ بخياله ويتصوَّر أنَّ أهل مكَّة هم الذين تمكَّنوا من فهم القرآن لأنَّه نزل إليهم، أمَّا العرب الذين جاؤوا في ما بعد (بعد قرنٍ ونصف مثلًا) فلم يتمكنُّوا من فهم القرآن؛ لأنَّهم لم يخاطَبوا به. ومن ثمَّ يُعرب عن أسفه للاستناد إلى الأشعار الجاهليَّة بدلًا من الكتاب المقدَّس في تفاسير القرآن.
يرى لكسنبرغ أنَّ الخطَّ السريانيَّ الآراميَّ كان أنموذجًا لاختراع الخطِّ العربيّ. فعندما يُعرِّف القرآنَ بأنَّه أوَّل كتاب كُتِبَ بالخطِّ العربيّ، بغضِّ النظر عن عددٍ ضئيلٍ من النقوش التي يعود تاريخها إلى فترة قبل الإسلام (أي ما بين القرنين الرابع والسابع الميلاديَّيْن) وتنتمي إلى شمالي الحجاز وسوريا، يستنتج من الشَبَه بين الشكل المبكر للحروف العربيَّة وطريقة اتِّصالها ببعض وبين الخطِّ السريانيّ المتَّصل، أنَّ الخطَّ السريانيَّ استُخدم أنموذجًا للخطِّ العربيّ. ومن ثَمَّ يشير إلى القواسم المشتركة بين الخطِّ العربيّ والخطِّ السريانيّ، قائلًا: كِلا الخطَّيْن يتَّفقان مع الآراميَّة في أمور، هي: الكتابة من اليمين إلى اليسار، والمقصود بالحروف في الأعمّ الأغلب الحروف الصامتة (consonants)، مع حرفين مصوّتين للمدّ (long vowel) ونصف المدّ (semi-long vowel)، هما: «و» و«ي»، وقد يُطلق عليهما بأمّ القراءة (mater lectionis). وتمَّت لاحقًا إضافة «ا» -التي كانت تُستخدم في الآراميَّة في حالات محدَّدة كـ«ا» الطويلة [المدّ] في أواخر المفردات غالبًا، و«ا» القصيرة أحيانًا- إلى العربيَّة؛ بوصفها ثالث حرفٍ من حروف أمّ القراءة للدلالة على «ا» الطويلة.
ثمّ يتناول لكسنبرغ تداعيات طريقة الكتابة هذه، قائلًا: بقدر ما تمَّ فرض هذا الإصلاح في كتابة القرآن ترتّبَت عليه آثار حتميَّة في قراءات خاصَّة، كما في التشكيل الابتدائيّ للمصوِّتات القصيرة (ـَ ـُ ـِ) بوضع نقاط، كما في أنظمة النطق
(vocalization systems) السريانيَّة الآراميَّة المتقدِّمة (يعني بوضع نقطةٍ فوق حرفٍ صامتٍ للدلالة على مصوِّت الفتحة، ونقطةٍ تحت حرفٍ صامتٍ للدلالة على الكسرة، ونقطةٍ متوسِّطةٍ [أي بين حرفين صامتين] للدلالة على الضمة)، حيث تمَّ إدخاله في العربيَّة مساعدةً على القراءة لأوَّل مرَّة في زمن عبد الملك بن مروان.
وبالتالي، يُعبِّر المؤلِّف عن رأيه في الخطّ العربيّ ومشاكله التي يراها فيه، ويكمن أهمُّها في الحروف الصامتة، إذ إنَّ هناك أحرفًا ستَّة يمكن تمييزها بسُهولة (أ/ل/ك/م/و/ه)، بينما هناك ٢٢ حرفًا آخر ـ بسبب تشابهاتها الظاهريَّة ـ يتعذَّر تمييزها إلَّا بواسطة السياق، وإن تمَّت إزالة هذا الخلل بشكلٍ تدريجيٍّ بإضافة نقاط الإعجام. ومن ثَمَّ يبدأ بعَدِّ المشاكل المترتِّبة على الحروف الصامتة، ويقول: إلى جانب [صعوبة التمييز بين] هذه الحروف الـ٢٢، قد يحدث خطأٌ بين الحروف المماثلة بصريًّا (د/ذ، ر/ز)، وكذلك بين هذه الحروف وحرف «الواو»، أو بين الحروف قريبةِ المخارج (ح/ه)، أو بين الحرفَيْن الحَلْقِيَّيْن (ع/ء)، أو بين «السين» و"الصاد"، أو بين «هاء» الضمير و«تاء» التأنيث المربوطة (ـه/ـة)، أو بين «النون» في نهاية الكلمة و«الياء» وحتَّى «الراء» في نهاية الكلمة (ـن/ـى/ـر)، أو بين ركزات السين وثلاثة أحرف معجمة أخرى (سـ/نبتـ). إذًا، هناك احتمال للخطأ بنسبة أكبر من 22/28. ومقارنةً بالأبجديَّتَيْن العبريَّة والسريانيَّة الآراميَّة الخاليتين من الغموض (ما عدا حرفَي «ܪ=ر» و«ܙ=ز» اللذَين يتميزان بنقطةٍ فوق أو تحت، وربما جرى استخدام هذه الطريقة نفسها للإعجام في الخطِّ العربيّ)، فإنَّ الخطَّ العربيَّ الأقدم كان نوعًا من الاختزال؛ بغية مساعدة الذاكرة. ويبدو أنَّه لم تكن الحاجة إليه ماسَّة في البدء؛ إذ كان القرَّاء قد أُمروا بحفظ القرآن عن ظهر القلب.
تقدَّم -في ما سبق- أهمّ دعاوى لكسنبرغ في لغة القرآن، ويمكن تلخيصها في اثنتين؛ هما:
ـ الدعوى الأولى: إنَّ لغة أهل مكَّة -أيْ مخاطَبِي القرآن- كانت مزيجًا من العربيَّة والآراميَّة؛ إذ كان معظمهم نصارى يشاركون في الطقوس المسيحيَّة
ـ الدعوى الثانية: إنَّ الخطَّ العربيَّ احتذى الخطَّ الآراميَّ السريانيَّ، وكان الخطُّ السريانيُّ أنموذجًا لاختراع الخطِّ العربيّ، وإنَّ التشابهات الظاهريَّة بين حروف الأبجديَّة العربيَّة أدَّت إلى أخطاء وغموض في قراءة القرآن وفهمه.
وفي ما يأتي تمحيص هذه الدعاوى ونقدها؛ بهدف بيان صحَّة الأسس التي بنى عليها لكسنبرغ باقي الآراء والنظريَّات في ما يلي من كتابه.
بنى لكسنبرغ نظريَّته على أركانٍ عدَّة، من أهمِّها: لغة أهل مكَّة التي يراها مزيجًا من العربيَّة والآراميَّة، ويعني بالآراميَّة لهجةً منها، وهي السريانيَّة. وقبل معالجة هذه الدعوى وتقويم مدى صحَّتها، لا بدَّ من تقديم خلاصة عن اللغة الآراميَّة وأهمِّ لهجاتها، ليتبيَّن ما إذا كان لكسنبرغ فعلًا محقًّا في ما ادَّعى، وإن كان محقًّا فإلى أيِّ مدى تؤيِّد ما قاله الرواياتُ التاريخيَّةُ؟
الآراميَّة هي إحدى اللغات الساميَّة الشماليَّة الغربيَّة التي ظهرت في النقوش منذ الألف الأوَّل قبل الميلاد. وقد أسَّس الآراميون خلال القرن الحادي عشر قبل الميلاد مملكةً قويَّةً في أعالي الفرات، ممتدَّةً على ضفَّتَيِ النهر، وسُمِّيْت بـ«بِيت أديني»، وتلتها إماراتٌ صغيرةٌ في أقصى الجنوب من العراق، يُسمَّى فرع منهم بالكلدانيِّين. وتوسَّعت مملكتهم في الجهة الغربيَّة إلى زنجيرلي، وسُمِّيَت بإمارة
«سمأل»، وفي سوريا إلى حلب وأرفد، وسُمِّيَت بـ«بيت أجوشي»، وفي الجهة الجنوبيَّة إلى حدود الممالك العبريَّة، حتَّى هزمهم النبيّ داوود عليهالسلام . لكن لم تكن للآراميِّين وحدةٌ سياسيَّةٌ؛ فلم يكوِّنوا سوى ممالك محلِّيَّة صغيرة. وفي نهاية القرن التاسع قبل الميلاد عندما نهضت آشور من جديد، وقمع الآشوريُّون الآراميِّين، ونفَوهم من أرض الرافدين، واستمرَّت حياة الآراميِّين الكلدانيِّين بعضَ الوقت في بابل، وقاموا بثوراتٍ ضدَّ آشور بين الفينة والأخرى، إلى أن انهارت دولتهم في نهاية القرن الثامن قبل الميلاد، ولم ينهضوا بعدُ أبدًا، ولكن بقي مجتمعهم واستمرَّت ثقافتهم إلى قرونٍ عدَّة.
على الرغم من الدور السياسيّ المحدود للآراميِّين؛ إذلم يتجاوز نشاطهم في دولة ذات كيان مستقلّ أربعة أو خمسة قرون، وكانوا يعيشون منقسمين إلى قبائل وعشائر بدويَّة لكلٍّ منها حكومة وإمارة، ولكنَّهم امتازوا بدورهم المهمّ في التطوُّر الحضاريّ واللغويّ لمنطقة الشرق الأوسط؛ فإنَّ لغتهم من أسهل اللغات الساميَّة وأكثرها مرونةً وملائمةً للحياة الحضاريَّة، ولم تتأثَّر لغتهم بالهزائم التي مُنِيَت بها دويلاتُهم، بل على العكس، فقد صار تشرُّدهم في أنحاء الشرق سببًا في انتشارها حيثما ذهبوا. وهكذا أصبحت اللغة الآراميَّة واسعة الانتشار في رقعةٍ شاسعة، من الهند شرقًا وإلى البحر الأبيض المتوسِّط غربًا، وأمسَت لغة الإدارة والدبلوماسيَّة للفرس الأخمينيِّين، وكذلك للآشوريِّين والبابليِّين، واستمرَّت في العصرَيْن الهلينيّ والرومانيّ، وحلَّت بشكلٍ تدريجيّ محلَّ العبريَّة والفينيقيَّة في منطقة الشرق القديم. وتجدر -هنا- الإشارة إلى أهمّ لهجات هذه اللغة، وهي:
وهي لغة النقوش القديمة التي يرجع أصلها إلى دمشق وآشور (أيْ الشام والعراق)، غضون القرنين العاشر والثامن قبل الميلاد، وتنقسم إلى ثلاثة أقسام، هي: آراميَّة النقوش، آراميَّة الدولة، وآراميَّة العهد القديم. وآراميَّة الدولة هي التي أصبحت لغة التواصل في الشرق الأدنى، وكانت مستخدمةً لدى الإمبراطوريَّات الآشوريَّة والبابليَّة والفارسيَّة. وما يميِّز هذه الفترة هو التطوُّر الأدبيّ في مجالَي اللغة والكتابة، حيث اعتمدت الآراميَّة في كتابة النصوص والوثائق الرسميَّة، لكنَّها لم تبقَ طويلًا بعد انتهاء الدولة الأخمينيَّة؛ لأنَّ الدولة الساسانيَّة منعت استخدامها في مجال الإدارة، لكن ظلَّت لغة التعامل اليوميّ في العراق والشام بلهجاتها الشتَّى.
ـ النبطيَّة: لهجة آراميَّة كتب بها الأنباط نقوشهم حتَّى القرن الثالث الميلاديّ. ومن الثابت أنَّهم كانوا عربًا يعيشون في مدينة سلع (البتراء) في بادية شرق الأردن، وكذلك في بُصرى جنوب الشام، وكان ازدهارهم في فترة ما بين القرن الأوَّل قبل الميلاد والقرن الثالث الميلاديّ. وبما أنَّهم لعبوا دورًا في تطوير الأبجديَّة الآراميَّة وتحويلها إلى العربيَّة، سيأتي الكلام عنهم في مبحث الخطِّ العربيِّ بتفاصيل أكثر.
ـ التدمريَّة: وهي تشبه اللهجة النبطيَّة، لكنَّها متأثِّرة باليونانيَّة واللاتينيَّة،
فدخل فيها كثيرٌ من مفرداتهما. وكان للتدمريِّين نشاطٌ تجاريٌّ ضخمٌ في شرق الشام، خلال الفترة نفسها التي ازدهر فيها الأنباط، وقد كان أمراؤهم في تلك الفترة عربًا أو مستعربين على الأقلّ، لكن خَلَتْ لغتهم من الكلمات العربيَّة؛ لضعف التغلغل العربيِّ فيها. وقد اتَّفق معظم الباحثين على أنَّ التدمريِّين طوَّروا الكتابة الآراميَّة، وانتقلت عنهم إلى السريان في «الرها».
ـ اليهوديَّة: وهي لغة أهل فلسطين في زمن النبيّ عيسى عليهالسلام طيلة القرن الأوَّل للميلاد. فعندما عاد اليهود من المنفى في القرن السادس قبل الميلاد كانت العبريَّة لا تزال ناضرة، لكنَّها بدأت بالتراجع والاضمحلال منذ القرن الرابع قبل الميلاد
ـ وقد ساعد على ذلك، تفشِّي عادة الزواج من غير اليهوديَّات اللاتي لا يتقنّ
العبريَّة ـ فدعت الحاجة إلى ترجمة العهد القديم إلى الآراميَّة التى أصبحت منتشرة على الألسنة. ويُمثِّل هذه اللهجة الآراميَّة الترجومُ والتلمود الأورشليميّ والمدراش، وهي ترجماتٌ شديدةُ التأثُّر بالعبريَّة.
ـ السامريَّة: وهي لغة الترجوم السامريّ، وعددٍ من الكتابات الدينيَّة الأخرى؛ فعندما نَسِيَ السامريُّون لغتهم، اضطروا إلى ترجمة التوراة السامريَّة إلى الآراميَّة، ولعلَّ ذلك في القرن الرابع الميلاديّ.
ـ الفلسطينيَّة المسيحيَّة: وهي لغة المسيحيِّين المَلَكانيِّين في فلسطين؛ فبعد انفصالهم عن الكنيسة السريانيَّة اليعقوبيَّة، والنسطوريَّة، قاموا بترجمة الكتاب
المقدَّس وجملة من الأدعية والصلوات إلى هذه اللهجة القريبة الشبه إلى اليهوديَّة.
هذا، وأخذت اللغة الآراميَّة الغربيَّة بالاندثار تدريجيًّا، وإن بقيت بعض لهجاتها تستخدم في قرى أطراف دمشق.
ـ التلمود البابليّ: وهو شرح آراميّ على «المشنا» بكامله، قريبٌ من اللهجة السريانيَّة، متأثِّرٌ بالعبريَّة التي دخلتها ألفاظ فارسيَّة. وكان اليهود البابليون يتكلمون بها طوال القرنين الرابع والسادس الميلاديّ.
ـ المندائيَّة: أو المندعيَّة، لهجة ترتبط بجماعة دينيَّة تسمَّى «الصابئة»، ويتواجد بعضهم اليوم في قرى عدَّة من جنوب العراق، كالبصرة وواسط، لكنَّهم نموا في أرض الرافدين، وذلك ما بين القرن الثالث إلى القرن الثامن للميلاد.
ـ السريانيَّة: وهي أهمّ اللهجات الآراميَّة التي ارتبطت بالديانة المسيحيَّة، وتتقارب كلَّ التقارُب مع آراميَّة التلمود البابلي والمندائيَّة. نشأت هذه اللهجة وترعرت في الإقليم الذي تقع فيه مدينة «إديسا» جنوب شرق تركيا قريبًا من الحدود السوريَّة. وتعود أهميَّتها إلى الفترة ما بين القرن الثاني قبل الميلاد والثالث بعده؛ إذ كانت واقعة على طريق التجارة البرِّيّ الموصل من الهند إلى البحر الأبيض
المتوسِّط، وهو ما كان سببًا في ازدهارها الاقتصاديّ. ودخلت المسيحيَّة هذه المدينةَ في القرن الأوَّل الميلاديّ، فسمّى الآراميُّون أنفسَهم بالسريان، تمييزًا لهم عن الآراميِّين الوثنيِّين أو اليهود؛ إذ صار الآراميّ عارًا يدلُّ على الكافر عندهم. ونما الأدب السريانيّ متزامنًا مع انتشار المسيحيَّة، واستمرَّ في الازدهار من القرن الثالث إلى القرن السابع للميلاد، وازداد التأليف بالسريانيَّة والترجمة إليها، ومن أهمِّها ترجمة الكتاب المقدَّس المعروفة بـ«فشيطو». وقد زعزعَ النزاعُ حول طبيعة المسيح اللاهوتيَّة والناسوتيَّة كيانَ المسيحيَّة في القرن الخامس للميلاد، وأدَّى إلى انقسام الكنيسة السريانيَّة إلى معسكرَيْن متعاديَيْن؛ القسم الغربيّ وهم أتباع الدولة الرومانيَّة الذين اعترفوا بتعاليم «يعقوب البردعيّ» القائلة بطبيعة المسيح الواحدة، والقسم الشرقيّ أتباع الدولة الفارسيَّة الذين اعترفوا بتعاليم «نسطوريوس» المضادَّة. واضطرَّ النسطوريون إلى مغادرة الرها بعد تكفيرهم من قبَل اليعاقبة، فأسَّسوا كنيستهم في مدينة نصيبين، الواقعة -اليوم- ضمن الحدود التركيَّة. ونتيجةً لهذا الانفصال اختلفت الطائفتان في الكتابة والضبط بالحركات؛ فسُمِّيَت الكتابة السريانيَّة الشرقيَّة بالخط النسطوريّ أو السريانيّ المربَّع، وسُمِّيَت الكتابة السريانيَّة الغربيَّة بالخطِّ اليعقوبيّ أو السرتو. ولم تتلاشَ السريانيَّة منذ الفتوحات الإسلاميَّة في القرن السابع للميلاد، بل واصلت حياتها في أوساط العلم والفكر إلى القرن العاشر، ثمَّ أخذت بالاضمحلال حتَّى القرن الرابع عشر الميلاديّ، فماتت آنذاك، وبقيت لغة العبادة في الكنيسة المارونيَّة وعند السريان الشرقيِّين (الكلدان) فقط. وقد يستخدم السريانُ اللغةَ العربيَّةَ، ويكتبونها بالخطِّ السريانيّ؛
كيلا يستطيع المسلمون قراءتها، وسُمي ذلك عندهم بالخطِّ الكرشونيّ. وتوجد اليوم بقايا من اللهجة السريانيَّة في قرى متفرِّقة على الحدود التركيَّة والسوريَّة والعراقيَّة، من أشهرها: معلولة، وجبعدين، وأرميا، وطور عابدين.
وبعد هذا العرض، يتبيَّن أنَّ لكسنبرغ كان صادقًا في جملة ما قاله عن اللغة الآراميَّة وأهمِّيَّتها. لكنَّه يدَّعي أنَّ السريانيَّة الآراميَّة كانت منتشرة إلى حدٍّ كبيرٍ في مكَّة، ولا يُناقش كيف أمكن لهذه اللغة أن تُهيمن على الحجاز -التي كانت بعيدةً عن «إديسا»- إلى درجةِ أنَّها صارت لغة الكتابات المقدَّسة لدى سكانها.كذلك لا يُناقش حول طبيعة اللغة العربيَّة وخطِّها، بل يكتفي بالقول إنَّ القرآن أوَّل كتاب تمَّت كتابته بالخطِّ العربيّ سوى نقوش قليلة كُتِبَتْ قبلَه، ولم تكن للعربيَّة لغة الأدب المعياريَّة عندما ظهر الإسلام. فبقيت دعواه مجرّد دعوى من غير برهنة عليها.
على الرغم من أنَّه ليس هناك تاريخ مدوَّن لمكَّة قبل الإسلام، لكن ثمَّة إشارات عابرة في التاريخ إلى سكَّان هذا البلد المقدَّس قبل الإسلام. فكان يسكنها في غابر
الزمان قبائل جُرهم وبقايا من الأمم البائدة، وتلتْهم قبيلة خزاعة اليمنيَّة حين نزح عددٌ من القبائل اليمنيَّة نحو الشمال، إلى أن جاء قُصَي بن كلاب في القرن الخامس للميلاد وأنزل أهله فيها. وعندما وُلد سيِّد الأنبياء صلىاللهعليهوآله كان قد مضى أكثر من قرنٍ منذ أصبحت هذه المدينة آهلةً بالسكَّان، وكانت قريش قد أقامت بها في فترة ما، تقرب إلى هذا الزمن، ولعلَّ قصيًّا هو من منح قريشَ بعض الأجزاء من مكَّة، فنزلت قريش البطاح -وهم هاشم وأميَّة ومخزوم وتيم وعَدي وجُمَح وزهرة ونوفل وأسد وسَهم- حول الكعبة، ومن ورائهم قريش الظواهر، ومعهم جماعة من صعاليك العرب والحلفاء والموالي والعبيد الذين كان أكثرهم من الأحباش. وقريش، اسمه النصر [أو النضر] بن كنانة بن خزيمة، تفرَّقت قبائله من بني فهر بن مالك، وهم من العرب.
ويبدو من تاريخ «هيرودوت» أنَّ اللغةَ العربيَّةَ القديمة كانت موجودة منذ القرن الخامس قبل الميلاد على أقلّ تقدير، لكنَّها لم تكن تُكتب إلا نادرًا حتَّى قرنٍ قبل الإسلام. وكان العرب الجاهليُّون يعيشون إلى حدٍّ كبيرٍ بعيدِين عن العالَم الخارجيّ، فقد كانت حياة العرب البدويَّة والبعيدة عن التأثير الأجنبيّ سببًا في الحفاظ على بنية لغتهم القديمة. علاوة على ذلك، توضح الكتابات التي عُثر عليها في أنحاء شبه الجزيرة العربيَّة أنَّ اللغة العربيَّة كان يُنطَق بها في نطاقٍ واسعٍ من
أرجاء هذه المنطقة، بل أصبحت اللغة التي يتكلَّم بها جميع سكَّان وسط شبه الجزيرة وشمالها، وربَّما جزءٌ كبيرٌ من جنوبها الغربيّ أيضًا، وذلك في غضون القرن الخامس بعد الميلاد. هذا، فضلًا عن أنَّه لا وجودَ لنقوشٍ سريانيَّة خارج منطقة «إدسا» أو شمالي سوريا إلَّا قليلًا، وهي من كتابات الحجَّاج أو النازحين، ولم يُعثر على مثلها في غرب شبه الجزيرة، خلافًا لِما يزعمه لكسنبرغ من أنَّ لغة الأدب في هذه المنطقة كانت السريانيَّة. إذًا، كانت العربيَّة هي اللغة المنطوقة على نطاقٍ واسعٍ من منطقة الشرق الأوسط خلال القرن السابع للميلاد، كذلك كانت العربيَّة اللغة المكتوبة بشكلٍ واسع النطاق فيها، لكنَّه لم يبقَ إلَّا القليل من تلك الكتابات، وكانت هذه اللغة تُستخدم للتعبير الأدبيّ والمقدَّس منذ أمد بعيد، كما تشهد بذلك النقوش العديدة التي عُثر عليها.
نتيجةً لما تقدَّم، لا يمكن تصديق ما ادَّعاه لكسنبرغ في لغة أهل مكَّة؛ إذ تُعارضُ هذه الدعوى المعلومات التاريخيَّة عن مكَّة وأهلها، بينما لم يقدِّم لكسنبرغ دليلًا يؤيِّد رأيه سوى تمسُّكه بدليلٍ إتيمولوجيّ لإثبات حقيقة تاريخيَّة، وهو أنَّ لفظة «مكَّة» هي مفردة آراميَّة. وبغضّ النظر عن صحَّة هذه الدعوى فهو دليلٌ مرفوضٌ؛ إذ إنَّ هناك ـ على سبيل المثال ـ كثيرًا من المدن اللبنانيَّة أصلها آراميَّة أو سريانيَّة، لكن أهاليها يتكلَّمون باللغة العربيَّة بلا شكّ. فإنَّ اسم المدينة كثيرًا ما لا ناقة له ولا جمل بلغة أهلها. والأغرب من ذلك، هو أن لكسنبرغ يشير إلى لفظة «مدينة» ويقول قد ثبت جذرها الآراميّ، في حين أنَّها تسميةٌ متأخِّرةٌ لـ«يثرب»،
والجذر الآراميّ لـ«مدينة» - سواء أصحيحًا كان أم خطأً- لا يُثبت أيَّ شيء! ولنسألْ لو كانت السريانيَّة منتشرةً في مكَّة إلى الدرجة التي يدَّعيها لكسنبرغ، فلمَ لا نجد لها أثرًا في العصر الراهن، كما بقيت آثارٌ من اللغات الآراميَّة في بعض القرى -كما أشرنا سابقًا- التي كانت مأهولة بالناطقين بها؟
إذًا، دعوى لكسنبرغ هذه، والتي بُنيت عليها دعاوى أخرى، لا تصحّ، بل يؤيَّد خلافُها بالمعلومات التاريخيَّة التي بين أيدينا. وقد يأتي هذا التساؤل، وهو أنَّه: إن لم تكن لغة القرآن مزيجةً من الآراميَّة والعربيَّة، فما هي لغته؟ وهو ما ستأتي الإجابة عنه في طيات الدراسة.
لم يقف لكسنبرغ عند زعمه بأنَّ الآراميَّة كانت منتشرة في مكَّة فحسب، بل ادَّعى أنَّ أهل هذا البلد المبارك في الأغلب كانوا من النصارى الذين كانوا يشاركون في الطقوس المسيحيَّة النصرانيَّة، ولذلك أدخلوا عناصر معقتدهم المسيحيَّة في العربيَّة. وسوف يتَّضح أنَّ هذه الدعوى -أيضًا- لا تخلو من المبالغة، بل تردّها الحقائق التاريخيَّة وأقوال المستشرقين عن هذه المدينة المكرَّمة.
كانت لدى العرب شتَّى الديانات والمعتقدات؛ فمنهم من يعبد الأصنام، ومنهم من يؤمن بالأرواح والجنّ، ومنهم مشرك، ومنهم موحِّد. لكنَّ المصادر تؤكِّد أنَّ الوثنيَّة أو عبادة الأصنام كانت الديانة الأكثر انتشارًا بين العرب قبل الإسلام. وتبيِّن دراسة النصوص (النقوش) الجاهليَّة أنَّ ديانتهم كانت قائمة على عبادة الكواكب، أيْ تأليهها والتقرُّب إليها بالصلوات والأدعية، وكانت الأصنام والأوثان رموزًا لتلك
الكواكب. وليس هذا دليلًا على إنكار التواجد المسيحيّ أو الديانات الأخرى التي كانت منتشرة في شبه الجزيرة. وقبل أن نبدأ بالمسيحيَّة في الحجاز نقدِّم خلاصةً عن المسيحيَّة في الأنحاء الأخرى من شبه الجزيرة العربيَّة:
أـ الجنوب: تُظهر غالبيَّة الدراسات الجديَّة أنَّ المسيحيَّة دخلت اليمن في القرن الرابع الميلاديّ، وهناك من يُرجع ذلك إلى القرن الخامس. وأيًّا كان، فاليمن أقدم مركز بدأ فيه التبشير، وأهل نجران هم أوَّل من رحَّبوا بالمسيحيَّة. مع ذلك، بقيت مقهورةً أمام اليهوديَّة، كما نجد أنموذج ذلك في المجزرة التي ارتكبها ذو نوّاس الملك اليهوديّ ضدَّ النصارى في اليمن في القرن السادس. لكنَّها انتعشت بعد مقتل ذي نوَّاس من جديد وتسارع انتشارها، فبُنيت كنيسةٌ كبيرةٌ في صنعاء سُمِّيَتْ بـ «القليس»، وعندما بدأت ولاية الفرس على اليمن في أواخر القرن السادس -على الرغم من التسامح الذي ساد بينهما- دخلت المسيحيَّة في الجمود والانكماش. فالمسيحيَّة لم تكن الديانة الأكثر انتشارًا عند ظهور الإسلام، سوى في بعض المواضع؛ كنجران وصنعاء وعدن.
ب ـ الشرق: تدلُّ أقدم المعلومات عن البحرين على انتشار المسيحيَّة فيها خلال النصف الثاني من القرن السادس للميلاد، لكنَّها لم تكن غالبة على سكَّان هذه المنطقة، بل تُذكر في التاريخ إلى جانب المجوسيَّة واليهوديَّة. أمَّا في عمان، فانتشرت فيها النسطوريَّة وغابت التعدُّديَّة المذهبيَّة.
ج ـ الوسط: أكَّد المؤرِّخ الفرنسيّ «دوشاسن» أنَّ المسيحيَّة دخلت نجد بعد
القرن السادس الميلاديّ. ومن أبرز القبائل التي تنصَّرت بنو آكل المرار الكِنْديِّين؛ حيث قاموا بدورٍ تبشيريٍّ في وسط شبه الجزيرة وشماله، وكذلك أحياءٌ من طيء، الذين يُحتمل أنَّهم كانوا مقيمين في الشام والحيرة. ولكن لا يوجد شاهد على نجاح هؤلاء في التبشير المسيحيّ، بل بقيت جهودهم منقوصة عند مجيء الإسلام؛ إذ لم يُلاحظ أيُّ تنظيمٍ كنسيٍّ بين عرب اليمامة ونجد.
دـ الشمال: يمكن الإشارة إلى المراكز التابعة للرومان والفرس، أي الغساسنة والمناذرة (اللخميِّين)، فكان الغساسنة على مذهب اليعقوبيَّة، واللخميُّون على مذهب النسطوريَّة، لكنَّ إيمانهما بالمسيحيَّة كان ظاهريًّا وسطحيًّا. ومن أهم المدن التي اعتنق أهلها المسيحيَّة: الرها (إديسا) والنصيبين، وقد سبق ذكرهما.
هـ ـ الغرب: يقرّ «دوشاسن» حول المسيحيَّة في الحجاز، بأنَّ الحملات التبشيريَّة لم تصلها أبدًا. ويقول المستشرق الفرنسيّ «لامنس»: إنَّ المسيحيِّين في مكَّة لم يكونوا سوى الأجانب، وأمَّا المسيحيُّون من أهلها فهم حالات نادرة جدًّا. وكان الحضور المسيحيّ في الحجاز قليلًا جدًّا، إلى درجةٍ حدت بالمستشرقين إلى أن يعلِّلوا هذه القلَّة؛ إذ صرَّح بعضهم بأنَّ المسيحيِّين لم يكن لهم جماعة مستقرَّة في مكَّة، ووصفهم «لامنس» بعددٍ من الفقراء والعبيد والجنود، الذين كانوا يعيشون في ضواحي مكَّة. وقد أثبتت أحدث الدراسات الأكثر إقناعًا أنَّه إنْ كان للمسيحيِّين من تواجد في مكَّة، فمن المرجَّح أنَّهم كانوا عبيدًا من سائر قبائل العرب النصارى، الذين بِيعوا إلى ساداتهم في مكَّة، وما كانوا جماعة مستقرَّة.
أمَّا أسباب ضعف الحضور المسيحيّ في مكَّة، فمنها التوغُّل اليهوديّ في كثير من المدن والقرى كالطائف، وخيبر، وتيماء، وفدك، وكذلك في يثرب؛ إذلم يُشِرْ أصحاب السِّيَر إلى تصدِّي نصارى يثرب أمام الإسلام فيها، مثلما فعلت اليهود. فلم يكن للمسيحيَّة ثمثيلٌ يعتدُّ به في الحجاز، لا من حيث العدد ولا من حيث التنظيم. والحاجز الذي عرقل التبشير المسيحيّ في هذه المنطقة هو القبائل اليهوديَّة التي كانت تتميَّز بالاستقرار والانغلاق والثروة والاعتزاز بالدين اليهوديّ، بحيث لم يستطع الإسلام ـ الذي انطلق من صلب العرب ـ اختراقها، فضلًا عن المسيحية القادمة من الخارج. وهكذا، بقيت الوثنية هي المعتقد الغالب على سكَّان شبه الجزيرة العربيَّة؛ فنادرًا ما اعتقنت قبيلة بكاملها المسيحيَّة، بل لم يتجاوز الأمر بطنًا أو بطونًا قليلة منها؛ وربَّما كان السببُ في ذلك القوميَّةَ التي ترسَّخت بين العرب آنذاك، تلك القوميَّة التي كانت من أهمّ ميِّزات الحياة الجاهليَّة، والتي صدَّت بقوَّة كلَّ معتقد أجنبيّ، وإليها يلوّح «ترمنجهام» عندما يبرِّر عدم التأثير المسيحيّ على أهل مكَّة قائلًا: هذه المدينة التي وقعت في وادٍ قاحل، لم تكن لها أهمِّيَّة قبل أن تسكنها قريش في القرن السادس الميلاديّ، وهذا ما يتَّضح من قلَّة الإشارة إليها في النصوص اليونانيَّة والنقوش العربيَّة الجنوبيَّة. فأنشأت قريش العلاقات مع قبيلة كنانة البدويَّة التي كانت مسيطرة على هذه المنطقة، وقد حوّلتها إلى مركز عقديّ تجاريّ، وتتمثَّل علاقاتها مع اليمن والشام والعراق والحبشة في معارضَ مثل سوق عكاظ. هذه الأسباب -أي عدم وجود خلفيَّة تاريخيَّة لهذه المدينة، وإقامة قبيلة بدويَّة في مكان ممتاز للديانة والتجارة، مع حفاظهم على معظم ميِّزات النظام الاجتماعيّ البدويّ ـ تكفي لتبيّن عدم النفوذ المسيحيّ لدى سكَّانها. وعندما يعالج المسيحيَّة في يثرب يقول: إشارات السور المدنيَّة [إلى النصارى] تنمُّ
عن أنَّ المسيحيِّين كانوا متواجدين في يثرب، لكن الأغلبيَّة الساحقة منهم كانت من المتنقِّلين، ولا يُشار إلى نظامٍ مسيحيٍّ فيها. ويَظهر الحضور المسيحيّ في مكَّة بشكل أقوى، لكنَّ جلَّهم كانوا من غير أهلها. ويستنتج قائلًا: لم تلمس المسيحيَّة سوى السطح من حياة العرب؛ فيثبت هذا عجزَها عن التوغُّل في حياتهم وتغييرها من الداخل، ولا سيَّما بالنسبة إلى عرب البادية، الذين كانوا يصمدون أمام أيِّ تغيير جذريّ، ويواصلون حياتهم بشكل بدويّ.
وهناك من يوضح ضعف التواجد المسيحيّ في مكَّة المكرَّمة والمدينة المنوَّرة بشكل آخر، ويقول: لم تتكوَّن في مكَّة والمدينة جماعة مسيحيَّة يُعبأ بها؛ لأسبابٍ ثلاثة رئيسة:
ـ كانت المسيحيَّة ديانةً حديثةً في المدن، فكلُّ من يُسمع عن تنصُّره كان من الجيل الأوَّل الذي اعتنق المسيحيَّة.
ـ ظلَّ المسيحيُّون بحكم طبيعتهم منعزلين عن البعض؛ فمنهم من التحق بالرومان، ومنهم من سكن مكَّة أو المدينة، فلم تربطهم صلة خاصَّة.
ـ تأثَّر العرب بفرَقٍ شتَّى من المسيحيَّة، مثل: النسطوريَّة، والمونوفيزيَّة الخلقيدونيَّة. وكانت بين هذه الفرق نزاعاتٌ وتناحرات.
ومن أهمّ الأدلَّة التي تشبَّث بها بعض الباحثين لإثبات انتشار المسيحيَّة في مكَّة مجموعة أخبار أوردها الأزرقي في كتابه «تاريخ مكَّة»، خلاصتها أنَّه: عندما أعادت قريش إعمار الكعبة، جعلوا في دعائمها صور الأنبياء والشجر والملائكة، ومن صورها صورة إبراهيم خليل الرحمن عليهالسلام وهو شيخٌ يستقسم بالأزلام،
وصورة عيسى بن مريم وأمّه عليهاالسلام ، وصورة الملائكة أجمعين، فلمَّا كان يوم الفتح أمر
رسول الله صلىاللهعليهوآله بطمس تلك الصور، ما عدا صورة عيسى بن مريم وأمّه عليهالسلام . وكذلك ما قاله عطاء بن أبي الرباح أنَّه أدرك هذه الصورة، وكانت موضوعة في العمود الذي يلي الباب، وهلكت في الحريق في عصر ابن زبير. وأنَّ امرأة من الغساسنة حجَّت في حجّ العرب، فلمّا رأت صورة مريم عليهاالسلام قالت إنَّها عربيَّة، فأمر رسول الله صلىاللهعليهوآله بمحو الصور.
هذه الأخبار -على فرض صحَّتها- لا تثبت انتشار المسيحيَّة في مكَّة، بل أقصى ما تدلّ عليه هو الحضور المسيحيّ فيها. ولسنا بصدد إنكار المسيحيَّة في مكَّة أصلًا، بل لا نوافق لكسنبرغ في دعواه سيطرة المسيحيِّين عليها وتفشّيهم فيها؛ ففي الكتاب نفسه الذي وردت فيه تلك الأخبار هناك أخبار جمَّة أخرى تشير إلى كثرة الأصنام التي وُضعت قرب الكعبة، فعن عبد الله بن مسعود: «دخل رسول الله مكَّة يوم الفتح وحول الكعبة ثلاثمئة وستون صنمًا»، وقال جبير بن مطعم: «وما من رجلٍ من قريش إلَّا وفي بيته صنم، إذا دخل يمسحه وإذا خرج يمسحه تبرُّكًا به». وأمَّا الأخبار التي تدلُّ على وضع صورة عيسى بن مريم وأمّه عليهاالسلام في الكعبة -لو ثبتت صحَّتها- فيمكن القول فيها إنَّ الوثنيِّين الذين رسموا صورة النبيّ إبراهيم عليهالسلام -صورةَ شيخ يستقسم بالأزلام- وغيره من الأنبياء، رسموا هذه الصورة أيضًا، ولم يبالوا بأنَّها صورة عيسى عليهالسلام أو غيره، فكانوا يعبدون هذه الصور والتماثيل، فنهى رسول الله صلىاللهعليهوآله عن رسم الصور. وإنْ افتُرض أنَّ المسيحيِّين وضعوا هذه الصور في
الكعبة، فهذا لا يدلُّ على انتشار المسيحيَّة في مكَّة، فمن الممكن أنَّهم كانوا جاليةً قليلةَ العدد، وضعوا صورة عيسى عليهالسلام إلى جانب صور الأنبياء، ولم يقدروا على تنظيف الكعبة من الأصنام والأوثان، التي كانت رمزًا للوثنيَّة السائدة فيها. ثمَّ إنَّ في قصَّة أبرهة -الحاكم الحبشيّ لليمن- شاهدًا يؤيِّد عدم انتشار المسيحيَّة في مكَّة؛ إذ بعد تشييده كنيسةً كبيرةً في صنعاء اعتزم على هدم الكعبة بغية صرف أنظار العرب عنها إلى كنيسته، وتسهيل انتشار المسيحيَّة في شبه الجزيرة، إذ كانت مكَّة معقلًا للوثنيَّة ومقرًّا للأصنام.
واستدلال بعضهم بجملة من أشعار العرب التي تُشعر بمسيحيَّة شاعرها، يردُّه أنَّ الإعلان عن المسيحيَّةلم يؤثِّر على حياة العرب أو أشعارهم إلَّا في الظاهر، فلا تُثبت هذه الأشعار التسرُّب المسيحيّ إلى الشعور الروحيّ والاجتماعيّ لدى العرب. كذلك، لا يصحُّ الاستدلال بالأسماء المسيحيَّة التي تداولت بين أهل مكَّة؛ فإنَّهم -عبيدًا كانوا أم أحرارًا- لم يقصروا أنفسهم على الأسماء التقليديَّة العربيَّة، فليس هذا دليلًا على مسيحيَّتهم. والحجَّة الأقوى التي يستدلّ بها بعض الباحثين هي قضيَّة الحنفاء، الذين -من المعتقد- أنَّهم كانوا نصارى، بينما لم يكن هؤلاء يهودًا أو نصارى، بل كانوا يعبدون إله إبراهيم، ويعيشون عيش الرهبان، فإذا التحقوا ببلاد النصارى اعتنقوا المسيحيَّة.
والنتيجة هي أنَّ المسيحيَّة بقيت ديانةً هامشيَّةً في مكَّة، ولم يُدخل العرب
عناصرَ السريانيَّة المسيحيَّة في العربيَّة؛ بل كانت الوثنيَّة -وفقًا للمعلومات التي بين أيدينا- هي الديانة الغالبة على العرب آنذاك. ولا توجد وثيقة تؤيِّد ما ادَّعاه لكسنبرغ بشأن المسيحيَّة في مكَّة، وهو -أيضًا- لم يقدِّم دليلًا على صحَّة دعواه، وألقى الكلام جزافًا على عواهنه، تمامًا مثلما نسب القول بالفارق الجوهريّ بين العربيَّة الكلاسيكيَّة والعربيَّة القديمة إلى اللغويِّين العرب، ولم يسمِ أحدًا منهم، ثمَّ استنتج من هذه الدعوى ما شاء وهوى.
تقدَّم الكلام عن دعوى لكسنبرغ في لغة أهل مكَّة وتأثُّرهم بالمسيحيَّة السريانيَّة، وثبت بطلان تلك الدعوى. ويجدر -هنا- البحث عن القول الأصحّ -والله أعلم- في لغة القرآن. والسؤال المطروح هو: ما هي لغة الأدب العربيّ في العصر النبويّ، والتي نزل بها القرآن الكريم؟
نظرًا إلى أنَّ لغة النصوص الدينيَّة يجب ألَّا تقترب من لغة التعامل اليوميّ إلى درجةٍ يَشعر مخاطبوها أنَّها غير سماويَّة، أو كأنَّها لا تختلف عن محادثاتهم اليوميَّة، كذلك لا تبتعد عنها إلى درجةٍ لا يفهمها أحدٌ منهم؛ لذا كانت هذه اللغة -أيْ اللغة التي نزل بها القرآن- أسمى وأرقى من اللغات العامِّيَّة التي كانت دارجة بين العرب الجاهليِّين، وكذلك كانت مفهومة لدى جميعهم، وهذه هي خاصيَّتها التي تمتاز بها عن خصائص سائر اللهجات؛ فقد كان العرب الجاهليُّون يتحدَّثون بمختلف اللهجات، ولكلِّ لهجة خصائصها، مثل: الكشكشة عند أسد وبكر وتميم، والكسكسة عند هوازن وربيعة ومضر، والشنشنة عند اليمنيِّين، والعنعنة عند قيس وطيء، والفحفحة عند هذيل وبني ثقيف، والاستنطاء عند الأزد، والعجعجة عند قضاعة، والوكم والوهم عند بني كلب. ولم تصلنا من هذا الأدب الشعبيّ
-أيْ الذي تتجسَّد فيه الصفات اللهجيَّة- إلَّا أعمال غير متكاملة تضمَّنتها كتب اللغة والنحو، لكن هناك مجموعات زاخرة بالأدب الجاهليّ -تُمثِّلها الأشعار والخطب والأمثال والحكم- لغتها موحَّدة منسجمة، لا تكاد تشتمل على الخصائص اللهجيَّة، وهي التي تسمَّى بـ«اللغة المشتركة»، التي اتَّخذها الشاعر للتعبير عمَّا يجول في باله، واستخدمها الخطيب للتأثير في مستمعيه، سواء أكان الشاعر أو الخطيب من قريش أم من غيرها من القبائل.
لم تكن هذه اللغة المشتركة مصطنعة، بل من المرجَّح أنَّها شاعت بين الشعراء والخطباء على أساس إحدى اللهجات الأكثر تكاملًا بشكلٍ تلقائيّ، ومن أجل قيمتها اللغويَّة أو الظروف التجاريَّة تفوَّقت على اللهجات الأخرى، وساعدت أطيب العناصر من تلك اللهجات على إثرائها. وربَّما كان الداعي إلى هذه اللغة المشتركة لأمَّةٍ تتعدَّد فيها اللهجات هو إيجاد صورةٍ جديدةٍ من الاستعمال تتجاوز اختلاف اللهجات. ويُحتمل أنّ هذه اللغة المشتركة ظهرت منذ أواخر القرن الخامس أو أوائل القرن السادس للميلاد. وللمستشرقين آراءٌ مختلفة في كيفيَّة تكوين هذه اللغة ومكوِّناتها؛ فمنهم من يراها مزيجًا من مختلف اللهجات، ومنهم من ينسبها إلى أعراب نجد أو معد أو اليمامة أو غيرها، ومنهم من يزعمها عملًا جماعيًّا لجملةٍ من الشعراء، بعيدًا كلَّ البعد عن لغة عامَّة الناس، بينما يُجمع العلماء القدامى على أنَّها لهجة قريش، لأنَّهم كانوا أفصح العرب ألسنةً وأصفاهم لغةً.
بينما يستحيل إنكار إسهام لهجة قريش في تكوين هذه اللغة المشتركة، يصعب -في الوقت نفسه- قبول القول بالمساواة بينهما؛ فمن أشهر الفوارق بين لهجة قريش وهذه اللغة المشتركة -أو لغة الأدب التي أنزل الله بها القرآن الكريم- هو تحقيق الهمزة؛ إذ لم تكن قريش تَهمِز، خلافًا لما في قراءات القرآن. كذلك لا يمكن التسوية بين هذه اللغة المشتركة وأيِّ لهجةٍ؛ إذ لا أثر في اللغة المشتركة لأيٍّ من نماذج الخصائص اللهجيَّة التي تقدَّمت الإشارة إليها، والتي كانت شائعة بين تلك اللهجات. وعليه، يبقى السؤال عن كيف وأين نشأت هذه اللغة المشتركة؟
نشأت هذه اللغة المشتركة -أو لغة الأدب- في مكَّة المكرَّمة وازدهرت قبل مجيء الإسلام؛ وذلك لأسبابٍ دينيَّةٍ وسياسيَّةٍ واقتصاديَّة. أمَّا السبب الدينيّ، فهو مكانة الكعبة عند العرب قبل الإسلام؛ إذ كانت مكَّة منذ عهودٍ سحيقة مدينةً مقدَّسةً للعرب، تحجّ إليها من كلِّ حدبٍ وصوب، وهذا ما أدى -طبعًا- إلى الاختلاط بين العرب من مختلف القبائل وأهل مكَّة، اختلاط نتجت عنه هذه اللغة المشتركة. واختيار إحدى اللهجات -كلهجة قريش مثلًا- لتكون هي اللغة المشتركة ليس أمرًا اصطلاحيًّا أو شعوريًّا، بل هو أمر لا شعوريّ أبدًا، تمامًا مثلما يتأثَّر الشخص الذي يسكن في غير موطنه بلهجة أهل ذلك البلد بشكلٍ غير شعوريّ. ومكَّةلم تكن مدينةً مقدَّسةً فحسب، بل مدينة تشهد أسواقًا متعدِّدة، تحضرُها العرب للبيع والشراء، وللندوات الأدبيَّة التي كانت تُعقَد في هذه الأسواق، ومن أشهرها سوق عكاظ؛ وهذا ما كان سببًا لاختلاط أهل مكَّة بوفود قبائل العرب، وظهور البذرة الأولى للُّغة المشتركة التي نمت وازدهرت بينهم، وعندما عادت هذه الوفود إلى مواطنها حملت إليها تلك اللغة المشتركة، وهكذا انتشرت هذه اللغة في أنحاء شبه الجزيرة، لكنَّها لم تنتشر -على الأرجح- إلَّا بين الخاصَّة منهم، أيْ الشعراء والخطباء. وأمَّا السبب الاقتصاديّ فيعود إلى النشاط الاقتصاديّ الضخم الذي حَظِيَ به أهلُ
مكَّة؛ إذ كانوا تُجَّارًا يرتحلون بتجارتهم إلى اليمن في الشتاء، وإلى الشام في الصيف، بحيث أتاحت لهم هذه التجارة المربحة السلطان السياسيّ، وأصبحوا أكثر حضارةً وأقوى نفوذًا من غيرهم.
إذًا، الأصحّ القول إنَّ هذه اللغة المشتركة هي مزيجةٌ من لهجاتٍ عربيَّةٍ، مبنيَّةٍ على لهجةِ قريش، وقد كانت مفهومةً لدى جميع العرب؛ لذلك أنزل الله بها القرآن المجيد؛ لكي يؤثِّر في مستمعيه ويُعجزهم عن الإتيان بمثله. هذا، مضافًا إلى ما لهذه اللغة من خصائص تبرِّر اختيارها لتكون لغةَ القرآن الكريم، ومن هذه الخصائص:
ـ الخاصِّيَّة الأولى: كونها أرقى مستوى من كلِّ لهجةٍ كانت شائعة في بيئة نزول القرآن الكريم: فقد كانت هذه اللغة فوق مستوى العامَّة، أي لم يكن بمقدور عامَّة العرب استخدامها في محادثاتهم اليوميَّة، بل كان الشعراء والخطباء هم الذين يستخدمون هذه اللغة التي كانت ذات مرتبة مرموقة في المتخيّل العامّ. وهي أفصح اللغات؛ فقد خلت ممَّا يخلّ بالفصاحة، وبقيت فيها عناصرُ تجعلها صعبة التناول لعامَّة الناس. وهذا ما عبَّر عنه بعض علماء البلاغة بقوله إنَّما يُدرك إعجاز القرآن «من كان متناهيًا في معرفة وجوه الخطاب وطرق البلاغة والفنون التي يمكن فيها إظهار الفصاحة»؛ ذلك لأنَّ القرآن الكريم نزل بهذه اللغة التي هي لغة الأدب، لغة أهل الاختصاص، وبينما كان الجميع قادرًا على فهمها، لم يكونوا قادرين على التكلُّم بها، فكانوا ينظرون إلى متكلِّمها وكأنَّه أديبٌ بارع. ومن هذه العناصر عنصر الإعراب الذي يمثِّل الميزة التفوقيَّة للعربيَّة الفصحى، بناءً على ما صرَّح به بعض العلماء الأسلاف من أنَّ العرب لم يكونوا يحقِّقون الإعراب.
ـ الخاصِّيَّة الثانية: عدم انتماء عناصرها أو صفاتها إلى بيئةٍ محلِّيَّةٍ بعينها:
لم يكن سهلًا على من يستمع إلى شعر شاعرٍ أو كلمةِ خطيبٍ اكتشاف لهجتهما الأصليَّة. وببيانٍ آخر: كانت هذه اللغة المشتركة مزيجةً من اللهجات، وفي الوقت ذاته مستقلةً عنها. والشاهد على ذلك هو خلوُّها من الصفات اللهجيَّة التي سبقت الإشارة إليها. وعليه، لم تكن هذه اللغة تابعةً لقبيلة معيَّنة أو محسوبةً على أهلِ قبيلةٍ محدَّدة، حتَّى يكون النصُّ المنشأُ بها محلَّ رفضٍ لمواصفاتها القَبَليَّة؛ ولذلك اختيرت من بين اللغات لتكون لغة القرآن الكريم؛ لئلّا يتَّصف كلام الله -تعالى- بسماتِ قبيلةٍ محدَّدة، فيقتصر عليها، بل ليتمكَّنَ من التغلغل في قلوب العرب برمَّتهم، ولئلَّا يَحُولَ اختصاصُه بلهجةِ إحدى القبائل دون قبوله من قِبَل القبائل الأخرى.
ـ الخاصِّيَّة الثالثة: عدم كونها لغة سليقة العرب:
بمعنى أنَّهم كانوا يتكلَّمون بها بلا وعي بخصائصها. والأخبار التي تحكي الألحان الواقعة في كلامهم خير دليلٍ على هذه الحقيقة؛ فإنّ مَنْ يتحدَّث بلغةٍ على سليقته لا يُخطِئ في ظواهر تلك اللغة -من التركيب في أصولها، أو ترتيب كلماتها، أو الأساليب المستخدمة فيها- دون أن يدرك أنَّه أخطأ، فالعربيُّ لا يخطِئ في عامِّيَّته، وإنْ زلَّ لسانه وارتكب هفوةً رجع عنها في لمح البصر؛ لأنَّ العامِّيَّة هي لغة سليقته لا العربيَّة الفصحى، فأحيانًا يُخطِئ في الفصحى، كما كان العرب قبل الإسلام وبعده يُخطئون بين الفينة والأخرى في تلك اللغة المشتركة التي كانت تُستخدم في مجال الأدب، كالشعر والخطابة، ولا التحادث اليوميّ وما يجري في الأسواق. وما يلفت الانتباه هو أنَّ اللحنَ لم يكن مقصورًا على الناس العاديّين، بل كان فحول الشعراء الجاهليِّين -أيضًا- يلحنون بعض الأحيان، ومن أمثلة ذلك: ما يسمَّى عند علماء العروض بالإقواء، وهو أنَّ
الشاعر الذي يلتزم حركةً معيَّنةً في رَويّ القصيدة -أيْ يختار حركةً معيَّنةً لجميع الأبيات- قد يغفل عن الإعراب -الذي ليس من لغة سليقته- فيجرّ ما حقّه الضمّ أو العكس؛ احتفاظًا بموسيقى القصيدة. وهذا يُثبت أنَّ الإعراب -أحد خصائص اللغة المشتركة- لم يكن لغةَ سليقةِ العرب، بل كانوا يلحنون عند التحدُّث بها.
وخلاصة ما تقدَّم هو: أنَّ القرآن الكريم نزل بلغةٍ مشتركةٍ بين جميع العرب، لغةٍ مزيجةٍ من مختلف اللهجات، مبنيَّةٍ على لهجةِ مكَّة أمّ القرى، فهي أقرب إلى لهجة قريش من غيرها، وتختلف عنها في ظواهر عدَّة. ولقد نشأت هذه اللغة منذ القرن السادس الميلاديّ في مكَّة بشكلٍ لا شعوريٍّ عند اختلاط الوفود العربيَّة، وترعرعت في الأسواق الأدبيَّة، وانتشرت منها إلى أرجاء شبه الجزيرة العربيَّة. فهي لغة الأدب، ذات المكانة الأرقى والأسمى بين اللهجات الدارجةِ بينهم، وما كانت لغة تعاملهم اليوميّ، وكانوا يلحنون فيها، حتَّى الشعراء منهم؛ إذ لم تكن لغة سليقتهم، وكان الجميع أمامها سواء، أيْ لم تختصّ بإحدى القبائل، حتَّى تكون معرفة موطن الناطق بها أمرًا سهلًا. وعليه، فليس من الإجحاف أن ننسب الخلافات التي وقعت بين النحاة إلى عدم إيضاح الفارق بين اللغة الأدبيَّة المشتركة -التي أنزل الله تعالى بها القرآن- وبين لهجات الخطاب في أذهانهم؛ لأنّهم كانوا يتطلَّعون إلى تخريج قواعد اللغة العربيَّة التي نزل بها القرآن، بغضِّ النظر عن أنَّها ليست لغة قريش أو لهجة قبيلة أخرى بعينها، بل هي لغةٌ مشتركةٌ بين العرب، متكوِّنةٌ من أفصح مفردات شتَّى اللهجات وتعابيرها.
يدَّعي لكسنبرغ -كما تقدَّم- أنَّ الخطَّ العربيّ اتَّخذ الخطَّ السريانيّ أنموذجًا له، واحتذاه في تطوُّره، وأنَّه لا وجود لكتابةٍ عربيَّةٍ قبل القرآن الكريم إلَّا في عددٍ ضئيلٍ من النقوش. وهذه الدعوى من الأهمِّيَّة بمكان؛ لأنَّ لكسنبرغ يراها مبرّرًا لتغيير
كتابة القرآن الكريم كيفما يشاء. وعليه، فإذا ما ثبت خلاف هذه الدعوى انهار أحد أهمّ أركان نظريَّته، واتَّضح ضعف دعاويه الأخرى التي تفرَّعت على هذه الدعوى. وردًّا على هذه الدعوى لا بدَّ من تقديم خلاصةٍ لتاريخ الخط العربيّ قبل الإسلام.
قضى الإنسان قرونًا كثيرةً دون أن تكون له معرفةٌ بالكتابة، حتَّى إذا خطا خطوةً نحو الحضارة والتجارة أدرك الحاجة إليها، فبدأ برسم صُوَرٍ، ليعبِّر بها عمَّا يدور في خلده، وينقل المعنى إلى ذهن مخاطبه، فلما أتعبه رسم هذه الصور عمل على تبسيطها وتحويلها إلى رموزٍ، ومن ثَمَّ إلى الأبجديَّة. وهذا ما يُعرَف بأطوار الكتابة، وهي خمسة، على التفصيل الآتي:
ـ الطور الصوريّ: اعتمد فيه الإنسان على تصوير ما يريد، فكان يرسم شجرةً دلالةً عليها، ويمثِّل ذلك الخطّ الهيروغليفيّ في مصر، والحثيّ في الشام، والآشوريّ (المسماريّ) في العراق أثناء القرن السابع قبل الميلاد، والصينيّ.
ـ الطور الرمزيّ: وظَّف فيه الإنسان الرموز للتعبير عن الأفكار المجرَّدة، فكان يرسم تاجًا ليدل على الملِك، وتوجد أمثلة له في الخطَّيْن الهيروغليفيّ والصينيّ. ويمكن اعتبار إشارات المرور مثالًا لها في عصرنا هذا.
ـ الطور المقطعيّ: ويُعدّ هذا بداية الكتابة الهجائيَّة؛ إذ انتقل فيه الإنسان من الرسم إلى اللغة. فإذا أراد أن يعبِّر عن الفعل «يدرس» مثلًا، رسم يدًا غيرَ قاصدٍ اليد نفسها، بل لفظها. والخطّ البابليّ والمصريّ القديم من أمثلته.
ـ الطور الصوتيّ: وضع فيه الإنسان صورًا للدلالة على الحروف، فكان يرسم عينَ إنسانٍ -مثلًا- ليدل على حرف العين، لا على عين الإنسان أو لفظة «عين» نفسها.
ـ الطور الهجائيّ: وهو الطور الأخير، وقمَّة تطوُّر الإنسان من حيث الكتابة، وفيه استخدم الإنسان رموزًا تدلُّ على الحروف.
إذًا، الخطوط المستعملة اليوم تعود إلى الأصول الأربعة التي ذُكرت في الطور الصوريّ، وما يهمّنا -هنا- هو الخطّ المصريّ القديم الذي يُعتبر الحلقة الأولى للخطِّ العربيّ. فبينما استُخدم في بلاد الرافدين القصب بغرزه في ألواح الطين الطري، وبدت الكتابة بشكل المسامير، استُخدم في وادي النيل ورق نبات البردي -الذي يكثر في مستنقعات البلاد- وظهرت الكتابة الهيروغليفيَّة. وكان الفينيقيُّون أكثر الناس اشتغالًا بالتجارة ومخالطةً للمصريِّين، فأخذوا الكتابة المصرية -بعد حذفهم الصور وجملة من الحروف منها- واختاروا منها اثنين وعشرين (٢٢) حرفًا توافق الأصوات الموجودة في لسانهم، ولم يُدخلوا تغييرًا كبيرًا على خمسة عشر (١٥) حرفًا منها. وبهذا، تكون الكتابة الفينيقيَّة هي الحلقة الثانية للخطِّ العربيّ. ولكن ثمَّة خلاف بين علماء الآثار في اشتقاق هذا الخطّ من الخطّ المصريّ، حتّى تمَّ العثور على النقوش السينائيَّة، وعُدّت هذه النقوش الحلقة المفقودة بين الكتابة المصريَّة القديمة والكتابة الفينيقيَّة. وانتشرت الكتابة الفينيقيَّة عبر تجارتهم البحريَّة لتصل إلى بابل، ومن ثَمَّ شاع استعمالها في العراق وفارس وغيرهما. كذلك أخذ اليونانيُّون
أبجديَّتهم عن الفينيقيِّين في ما بين القرن الثامن والتاسع قبل الميلاد، ويشهد لذلك عدم وجود نصٍّ يونانيٍّ سابقٍ للقرن الثامن قبل الميلاد.
وبينما كان الفينيقيُّون يسيطرون على ساحل البحر الأبيض المتوسط وموانئه، كان الآراميُّون إلى الخلف في سوريا وبوادي الشام مسيطرين على محطَّات القوافل المطلَّة على خطوط التجارة البريَّة القديمة، فأخذ الآراميُّون الأبجديَّة الفينيقيَّة ونشروها في معظم أنحاء آسيا حتَّى التخوم الصينيَّة، وأصبح الخطُّ الآراميّ مستخدَمًا من مصر إلى الهند، وقد تبنَّته حتَّى بعض الشعوب غير الساميَّة، مثل: سكان آسيا الوسطى وفارس، وتولَّدت منه خطوطٌ أخرى: كالخطِّ الهنديّ؛ والفارسيّ القديم؛ والعبريّ المربّع؛ والتدمريّ؛ والسريانيّ؛ والنبطيّ. وقد كانت الآراميَّة لغة كتابة في بعض المناطق عربيَّة اللغة والمجاورة لمحيطها الجغرافيّ، وهي واضحة التأثير في اللهجات العربيَّة البائدة، خصوصًا في اللهجات العربيَّة الشماليَّة القريبة من مناطق التغلغل الآراميّ، أيْ شمال الحجاز المحاذية لتخوم الدويلات الآراميَّة. فيمكن اعتبار الخطّ الآراميّ ثالث حلقة من حلقات الخطّ العربيّ على رأي المستشرقين.
ولكنّ هناك عددٌ مِنَ الباحثين العرب يرون أنَّ الخط المسند هو الحلقة الثالثة من حلقات نشأة الخطّ العربيّ. ومن أدلَّتهم النقوش التي عُثر عليها في المناطق الشماليَّة من شبه الجزيرة العربيَّة وهي مكتوبةٌ بالخطوط الجنوبيَّة، وكذلك وجود بعض الحروف في الخطّ المسند (ث/خ/ذ/ض/ظ/غ) التي لا توجد في الآراميَّة. وتؤيِّد رأيَهم جملةٌ من الروايات المرسلة. وجدير بالذكر أنَّ الخطَّ المسند -وهو الخطّ العربيّ الجنوبيّ، ويتمثَّل في الكتابات المَعينيَّة والسبئيَّة والحضرميَّة والقتبانيَّة والحميريَّة- قد شاع استخدامه في أنحاء شبه الجزيرة قبل الميلاد. ويتألَّف هذا الخطّ من تسعة وعشرين (٢٩) حرفًا صامتًا، لا تُكتب فيها حركاتٌ أبدًا. ويُكتب من اليمين إلى اليسار كما يمكن عكسه، كذلك من الأعلى إلى الأسفل أو العكس، أو بشكلٍ لولبيّ، كما يحلو لكاتبه. وحروف هذه الكتابة غير متَّصلة، ويُفصل بين كلماتها بخطوطٍ مستقيمةٍ عموديَّة. وهناك خلاف بين علماء الآثار في أصل الخطّ المسند، أهو مأخوذٌ من الأبجديَّة الفينيقيَّة أو الكنعانيَّة أو السينائيَّة، أو من أصل لم يُعرف بعد؟ وقد اشتقّت منه الخطوط اللحيانيَّة والثموديَّة والصفويَّة في المناطق الشماليَّة، والحبشيَّة والجعزيَّة في المناطق الجنوبيَّة من شبه الجزيرة .
وما ينفي رأي أولئك الباحثين هو الاختلاف الشديد بين الأبجديَّة الجنوبيَّة (المسند) والأبجديَّة العربيَّة القديمة، كما صرَّح بذلك بعض علماء اللغة القدماء. وفضلًا عن هذا الاختلاف، فإنَّ النقوش التي كُتبت بالخطوط الجنوبيَّة في المناطق الشماليَّة هي من آثار الاستعمار اليمنيّ لتلك المناطق، وقد زالت بزوال ذلك السلطان، فلا وجود لنقشٍ من هذه النقوش -أي الثموديَّة واللحيانيَّة والصفويَّة،
التي كُتبت بأقلامٍ قريبة الشبه من الخطِّ المسند- بعد القرن الرابع للميلاد؛ حيث ترك العرب القاطنون في شمال شبه الجزيرة الخطَّ المسندَ وأقبلوا على الخطوط الشماليَّة. فليس من المستبعد أن يكون هذا الإعراض عن الخطوط الجنوبيَّة من أجل هيبة الإمبراطوريَّة الفارسيَّة -التي اختارت الآراميَّة لغةً للكتابة- بينما كانت الإمبراطوريَّة اليمنيَّة -التي كانت تستخدم الخطَّ المسند- في حالة الانهيار، وما يفسِّر هذا الإعراض أيضًا -رغم وجود حروف فيها لا توجد في الأبجديَّة الآراميَّة- هو مرونةُ الخطّ الآراميّ في مقابل المسند. إذًا، ليس الخطّ المسند من حلقات الخطّ العربيّ، بل الخطّ الآراميّ هو الحلقة الثالثة، كما تؤيِّد ذلك النقوشُ المكتشفة.
أمَّا الحلقة الرابعة، فلعلَّها أكبر موضع للخلاف حول أصل الخط العربيّ، وفيها أقوال عدَّة، يمكن حصرها في أقوال ثلاثة:
- القول الأوَّل: ما ورد في الروايات والأخبار من نسبة أصل الكتابة إلى بعض الأنبياءعليهمالسلام أو إلى بعض الأشخاص
- القول الثاني: القول بأنَّ الأصل السريانيّ هو أصل الخطّ العربيّ، وهو قول لكسنبرغ
- القول الثالث: القول بأنّ الأصل النبطيّ هو أصل الخطّ العربيّ، وهو قول معظم المستشرقين والباحثين المسلمين.
فلا بدَّ من دراسة هذه الأقوال، وتمييز الغثّ والسمين منها؛ ليتَّضح القول الأصحّ من بينها؛ وذلك على ضوء الوثائق والمعطيات العلميَّة التي بين أيدينا في عصرنا الراهن.
هناك عددٌ من الروايات والأخبار يُنهي الخلاف السائد بين العلماء في أصل الخطّ العربيّ، ويحلّ المعضلة بكلّ بساطة، ألا وهي أخبار اختراع الخطِّ على أيدي أحد الأنبياء العظام عليهمالسلام ، كما ورد في خبرٍ أنَّ: أوَّل من كتبَ بالعربيّ والسريانيّ وغيرهما آدمُ عليهالسلام ، وذلك قبل موته بثلاثمئة سنة، كتبه في طين وطبخه، فلما أصاب الأرض الغرق وجد كلُّ قوم إحدى الكتابات فكتبوا بها، وكتب إسماعيل عليهالسلام بالكتابة العربيَّة. وبما أنَّ العرب -وفقًا للمتخيّل العامّ- من ولد إسماعيل عليهالسلام ، يعود أصل الخطّ العربيّ لديهم إلى نبيّ الله إسماعيل عليهالسلام . وهناك أخبارٌ تنسب اختراع الخطّ إلى أولاده، أو إلى هود عليهالسلام ، وتُشدِّد على تعلٌّمه إيَّاه بالوحي الإلهيّ. وقد ربط بعض الأعلام القدامى بين هذه الأخبار وبين الآيات الأولى من سورة العلق. لكنَّ الحقيقة هي أنَّ هذه الرويات وُضعت لتفسير تلك الآيات والنظريَّات العربيَّة التي كانت شائعة في ذلك الزمن؛ فإنَّ الخطَّ من الصنائع البشريَّة الحضاريَّة، وليس وحيًا إلى الأنبياء والرسل. ونظريَّة توقيفيَّة الخطّ مرفوضة؛ لأنَّها لا تقوم على أساسٍ علميٍّ صحيح، بل هي مجرَّد أخبار وردت بلسان «رُوي» أو «قيل»، وليس لها سندٌ يمكن التعويل عليه.
ثمَّة قسمٌ آخر من الروايات لا يختلف عن سابقه في الصحَّة والصدق، وهي الروايات التي تنسب اختراع الخطّ إلى أشخاصٍ معيَّنين: منها ما روي عن الشرقي بن القطامي: اجتمع ثلاثة من طيء وهم مرار (مرامر) بن مُرَّة وأسلم بن سدرة وعامر بن جدرة، فوضعوا الخطّ وقاسوا الأبجديَّة العربيَّة على الأبجديَّة السريانيَّة،
فتعلَّمه منهم أهل الأنبار، وتعلَّم منهم أهل الحيرة، ثمَّ تعلَّم منهم بشر بن عبد الملك -وكان نصرانيًّا- حينما كان مقيمًا بالحيرة، فأتى مكَّة، فطلب منه سفيان بن أمية وأبو قيس بن عبد مناف أن يعلِّمهما الخطَّ العربيّ، فعلَّمهما. ثم تعلَّمَ غيلان بن سلمة من هؤلاء الثلاثة الخطَّ في الطائف، ثم ذهب بشر إلى مضر وعلَّم عمرو بن زرارة الخطّ، وأخيرًا ذهب إلى الشام وعلّم الناس الخطّ. كذلك تعلَّم -أيضًا- رجلٌ من طابخة كلب الخطَّ من أولئك الثلاثة الطائيِّين، ومنه تعلَّمَ أهل وادي القرى الخطّ. ورُوِي مثل ذلك عن ابن عبَّاس -أيضًا-، لكن فيه: وضع مرار الصورَ (أي الحروف)، ووضع أسلم الفصل والوصل، ووضع عامر الإعجام. وعنه في خبرٍ آخر أنَّ قريشًا تعلَّمت الخطَّ من حرب بن أُمَيَّة، وتعلَّمَ حرب من عبد الله بن جدعان، وتعلَّم عبد الله من أهل الأنبار، وتعلموا جميعًا من رجلٍ يمنيٍّ من كِندة مرَّ بهم، وتعلَّم هو من الخلجان بن القاسم، وهو كاتب الوحي لهود عليهالسلام.
ويُستنتجُ من هذه الأخبار أنَّ الخطَّ العربيَّ مأخوذٌ من أهل الحيرة، وهم الذين أخذوه من أهل الأنبار، كما يصرِّح بهذا بعض الأخبار، وربما تعلَّم هؤلاء من أهل اليمن، كما يؤيِّد هذا الأخير ما ورد في بعض الكتب أنَّ العرب كانت تُسمِّي خطَّهم بـ«الجزم»، فقالوا في تسميته: لأنه جُزم -أي قُطع- من المسند. وقالوا [أوَّل] من كتب بالجزم رجل من بني مخلد بن النضر بن كنانة، ومنه تعلَّمت العرب. وهناك رواية أقرب إلى الخيال، وهي أنَّ رجالًا أسماؤهم «أبجد، هوز، حطي، كلمن، سعفص، وقرشت»، وكانوا نزولًا مع عدنان بن أدد، وضعوا الكتابة على أسمائهم، وأضافوا إليها الحروف التي لم تكن في أسمائهم (ث/خ/ذ/ض/ظ/غ)، وقيل: إنَّهم
كانوا من الملوك. وقد أشرنا -في ما سبق- إلى أنَّ الخطَّ العربيَّ لم يُشتقّ من المسند، بل أخبار ذلك آحاد بالنسبة إلى ما ينسب أخذه من العراق (الحيرة والأنبار)، وستأتي أدلَّة أخرى تثبت اشتقاقه من الخطِّ النبطيّ.
من نافلة القول: إنَّ الرواية التي تعرِّف مخترعي الخطّ رجالًا أسماؤهم الحروف الأبجديَّة رواية لا يقبلها العقل، وليس أدلّ على سذاجة واضعها أنَّه أخذ الترتيب الأبجديّ وزعمه أسماءَ ملوكٍ، فلا تستحقّ المناقشة. وأمَّا رواية اختراع الخطّ على أيدي مرار وأسلم وعامر، فهي ضعيفة من حيث السند؛ لضعف الشرقي بن القطامي، كما ضعَّفه البعض، وقالوا إنَّ في أحاديثه مناكير. وعلاوةً على ذلك، فإنَّ فيها أثر الصنعة والاختراع (الأسماء الموزونة: مرة، سدرة، جدرة)، فليست هذه التسميات نتيجة الصدفة. هذا فضلًا عن أنَّ الكتابات القديمة لم تكن معجَمةً كما تدَّعي تلك الرواية أنَّ عامرًا وضع الإعجام، بل إنَّ دراسة النقوش المكتشفة تثبت خلافه. وليس من المستبعد أن يكون هذا الخبر وأمثاله موضوعًا؛ لاختلاق فضيلةٍ للذين ذُكرت أسماؤهم كمن نقل الخطّ إلى الحجاز؛ إذ كانت الكتابة موجودة قبل هؤلاء، كما يشير إليها بعض الأخبار. وعليه، يبقى هناك أمران لا بدَّ من الحديث عنهما:
- الأمر الأوَّل: إنَّ الرواية التي نقلها الشرقي تقول إنَّ مخترعي الخطّ العربيّ وضعوه قياسًا على الخطِّ السريانيّ. وهذا يؤيِّد نظريَّة لكسنبرغ.
- الأمر الثاني: ثمَّة روايات أخرى تصرِّح بأخذ الخطِّ العربيّ من الحيرة والأنبار.
أمَّا بالنسبة إلى الأمر الأوَّل، فقد تقدَّمت الإشارة إلى أنَّ الرواية ضعيفة السند، وفيها أثر الوضع، وأنَّه ليس من المنطقيّ الاستناد إليها لإثبات حقيقة تاريخيَّة. هذا، مضافًا إلى أنَّ الرواية وردت بألفاظٍ أخرى ليست فيها إشارة إلى اختراع الأبجديَّة العربيَّة قياسًا على السريانيَّة
وأمَّا انتقال الخطّ العربيّ من الحيرة والأنبار، فلم يستبعده بعض المؤرِّخين، وهو ما يشير إليه أحدهم في كلامه عن المدارس التي كانت ملحقة بالكنائس والأديرة في العراق -الحيرة والأنبار بالتحديد- وقتئذٍ لتعليم الكتابة، وعن الصلة التجاريَّة الوثيقة بين عرب العراق وأهل مكَّة، بحيث لا يستبعد تعلّم الخطّ منهم، وكذلك التبشير المسيحيّ الذي لعب دورًا مهمًّا في نشر الخطّ النبطيّ أو الآراميّ المتأخِّر في جزيرة العرب، فلعلَّ المبشِّرين نقلوا الخطَّ إلى الحجاز. ولكنَّه نفسه يصرِّح في نهاية المطاف أنَّ هاتين المنطقتين -أي الحيرة والأنبار- لم تعطِ الباحثين أيَّ نصٍّ مكتوب، كما لم تعطِ مكَّة -أيضًا- أيَّ نصٍّ جاهليٍّ مكتوب، فلا يمكن البتّ في الأمر بمجرَّد هذه الأخبار والروايات. ولعلَّ السبب في ذكر هاتين المنطقتين خاصَّة هو مكانتهما الجغرافيَّة وظروفهما السياسيَّة التي جعلت العرب تزعم أنَّ لهما دورًا خطيرًا في نقل الخطِّ إلى الحجاز.
أمَّا القول الثاني -وهو الأصل السريانيّ للخطّ العربيّ- فلم ينفرد به لكسنبرغ، بل ثمَّة من وافقه الرأي من مستشرقين آخرين. وقد كانت هذه النظريَّة موضع تبنٍّ من قبل جملة من المستشرقين في القرن الثامن عشر وأوائل القرن التاسع عشر، إلى أن تمَّ اكتشاف النقوش النبطيَّة والسينائيَّة، حيث بدأت هذه النظريَّة بالتراجع والبطلان. وعندما أعلن «نولدكه» -في منتصف القرن التاسع عشر- الخطَّ النبطيّ أصلًا للخطِّ العربيّ، ووافقه في ذلك «لاوي» و«دي فوغويه» و«كارباسك» و«أُيتينغ»، حصل إجماع على هذا الموضوع؛ ولكن ما هي إلَّا نصف قرن حتَّى عاد «استركي» وتراجع عن هذا الرأيّ، ظانًّا الخطَّ السريانيّ المتَّصل أصلًا للخطّ العربيّ، من دون أن يعتمد في حكمه النهائيّ سوى على خبرٍ أورده البلاذري، وهو بنفسه يقرّ بأنَّه لا يوجد إثباتٌ أثريٌّ لذلك. ولكن ردّ عليه «غروهمان» ـ في كتابه «دراسة الكتابات العربيَّة القديمة» ـ مُدَعِّمًا نظريَّة نولدكه.
وفي أوائل القرن العشرين ادَّعى «مينغانا» أنَّ اللغة العربيَّة لم تكن تمتلك أيّ أبجديَّة في صدر الإسلام، ولو وُجدت كتابة في مكَّة والمدينة فهي قريبة الشبه
من السريانيَّة أو العبريَّة. ودافعت «عبُّود» عن هذا المدَّعى بعض الشيء في كتابها «نشأة الخطّ العربيّ الشماليّ»، بتشدُّدها وتأكيدها على تأثير الخطّ السريانيّ، وبقولها إنَّ الخطَّ العربيّ المسيحيّ بدأ يفقد تدريجيًّا تماثُله مع الخطِّ السريانيّ منذ القرن العاشر للميلاد، وأصبح يشبه الخطّ العربيّ الإسلاميّ، بحيث لا يمكن التمييز بينهما.
وهناك من العلماء المسلمين من يرى الخطَّ السريانيّ أصلَ الخطّ العربيّ، وأدلّته في ذلك تتمحور حول تقارب أشكال الحروف بينهما. ثمَّ إنَّ لكسنبرغ -أيضًا- لم يقدِّم دليلًا أثريًّا لإثبات دعواه، بل اكتفى ببيان القواسم المشتركة بين الخطِّين، واستنتج منها تطوُّرَ الخطِّ العربيّ من السريانيّ. ولكن ليست هذه الخصائص المتَّفِقة والحروف المتقارِبة في الخطَّيْن إلَّا لأنَّهما اشتُّقَا من أصلٍ واحد -أيْ الخطّ الآراميّ- وخَضَعَا لظروفٍ واحدةٍ في أدوارٍ متشابهة.
وقد أصبحت هذه النظريَّة -أي الأصل السريانيّ للخطّ العربيّ- مرفوضةً اليوم، خصوصًا بعد العثور على مئات النقوش وأوراق البردي المكتوبة بالخطّ النبطيّ المتَّصل. وبينما لا يوجد أيُّ نقشٍ عربيٍّ كُتبت بالخطِّ السريانيّ، ثمَّة نقوشٌ عربيَّةٌ كثيرةٌ كُتبت بالخطّ النبطيّ.
وهو القول الثالث الذي يرى الخطَّ النبطيَّ أصلًا للخطِّ العربيّ، وعليه جلّ الباحثين المعاصرين، من المسلمين والمستشرقين.
وقبل الحديث عن الخطّ النبطيّ، لا بدَّ من عرضٍ موجزٍ عن تاريخ الأنباط. فقد كان الأنباط شعبًا عربيًّا يعود تاريخهم إلى القرن الرابع قبل الميلاد. وتأسَّست المملكة النبطيَّة خلال القرن الثاني قبل الميلاد بسبب الاضطراب الذي ساد الإمبراطوريَّة السلوقيَّة، ولكن كانت لازدهارها أسبابٌ اقتصاديَّةٌ؛ إذ كانت مملكتهم تقع على طريقٍ تجاريٍّ من الهند والصين إلى منطقة البحر المتوسِّط في غضون قرنين (من حوالي عام ٥٠ قبل الميلاد إلى ١٥٠ بعده)، مضافًا إلى طرقٍ أخرى، ولكنَّها كانت قليلة الاستخدام. وكانت هذه المملكة ممتدَّة من شمال شبه الجزيرة العربيَّة إلى جنوب فلسطين وبلاد الشام. وكانت عاصمتها الشماليَّة سلع أو البتراء (أي الصخرة)، الواقعة في وادي موسى بالقرب من معان. وكانت عاصمتها الجنوبيَّة الحِجر أو مدائن صالح، الواقعة على سكَّة حديد الحجاز في شمال بلاد العرب. أمَّا الطرق التي كانت تمرّ بالممكلة النبطيَّة، فثلاثة:
الطريق الأوَّل: طريق الخليج الفارسيّ، مع استراحة في الغرة، وعبور شبه الجزيرة عن طريقٍ يصل لتيماء والحِجر.
الطريق الثاني: طريق اليمن عبر صنعاء، فمكَّة، فيثرب، فديدان، ثمَّ إلى الحِجر.
الطريق الثالث: طريق البحر الأحمر، مع استراحة إمَّا في أيلة (في خليج العقبة) وما يصل مباشرة إلى البتراء، وإمَّا في لويكه كومه وما يصل إلى ديدان والحِجر.
وكانت البضائع التي تصل إلى الحجر أو البتراء تُباع في اليونان وإيطاليا ومصر والشام. وهذه التجارة المربحة والثروات الطائلة جعلت الأنباط يأخذون في التوسُّع
والسيطرة على الطرق التجاريَّة أكثر؛ لكنَّهم لم يستطيعوا الصمود أمام الرومان، على الرغم من أنَّهم تمكَّنوا من السيطرة بقوَّة على جنوب دمشق ومنطقة حوران، فأسَّسوا في أطراف الشام مركزًا تجاريًّا آخر -فضلًا عن الحجر والبتراء- اسمه بصرى، وظلَّت في التوسُّع من شمال الحجاز إلى التخوم الجنوبيَّة للشام خلال القرن الأوَّل للميلاد. وقد كانت المملكة النبطيَّة خصمًا للإمبراطوريَّة الرومانيَّة، بحيث أدَّى هذا الخصام إلى احتلال دمشق من قبَل الرومان في منتصف القرن الأوَّل الميلاديّ، وقبل ذلك ببضعة سنوات أقام الرومان حملةً ضد البتراء، واضطرّ الملك النبطيّ إلى دفع مبلغٍ هائلٍ؛ بغية شراء السلام وانسحاب جيش الرومان. ويبدو أنَّ الرومان اعتبروا المملكة النبطيَّة ولايةً تابعةً لهم منذ ذلك الزمن. وبما أنَّ هذه التبعيَّة لم تكن مرضيةً للأنباط، أبدوا الرغبة في الاستقلال في مرَّاتٍ عدَّة. فعلم الرومان أن الأنباط ليسوا أتباعًا متمرِّدين فحسب، بل إنَّهم منافسوهم في التجارة أيضًا، فحالوا دون حركة الأنباط التجاريَّة نحو مصر، وازدهرت الحركة التجاريَّة للمينائيّين المصريّين على البحر الأحمر، والتي كانت شبه مهجورة قبل ذلك الوقت. ولم تكن حاجةٌ إلى إبادة تجارة الأنباط بكاملها؛ إذ كان التنافس التجاريّ على طريق النيل كفيلًا بها، فوجَّهت الإمبراطوريَّة الرومانيَّة الضربة القاضية لحاكم الشام للمملكة النبطيَّة عام ١٠٦ للميلاد عندما احتلَّت البتراء، لكن بقيت المناطق الجنوبيَّة للمملكة -أي مدائن صالح وشمال الحجاز- مستقلةً، بينما حلَّت تدمر محلّ البتراء بوصفها عاصمةً تجاريَّةً.
أمَّا الأنباط، فلاشتغالهم بالتجارة شعروا بمسيس الحاجة إلى الكتابة، وقد كانت الآراميَّة اللغة السائدة يومئذٍ في بلاد الشرق الأدنى، فاختاروها للكتابة؛ إذ لم تكن بعد للعربيَّة أبجديَّة، وبقيت العربيَّة اللغة المحكيَّة بينهم للتعامل اليوميّ. وقد عُثر على نقوشٍ نبطيَّةٍ كثيرةٍ في سيناء ودمشق والأردن وصيدا، تَحمل أسماء ملوكهم
وآلهتهم وأشخاصٍ كُثُر. ويظهر من هذه النقوش -التي كُتبت بالخطِّ الآراميّ- أنَّ اللغة العربيَّة كانت تُستخدم عندهم في الحوارات اليوميَّة؛ نظرًا إلى احتوائها على بعض خصائص العربيَّة التي لا توجد في الآراميَّة.
وقد صرَّح عددٌ من المستشرقين بأنَّ الأنباطَ عربٌ من حيث النسب، وكانوا ينطقون بهذه اللغة، وأنَّ الآراميَّة التي استخدموها لتسجيل الكتابات لم تكن لغةَ أحاديثهم اليوميَّة، فأدخلوا على كتاباتهم عناصر عربيَّة، خلافًا لغيرهم من العرب الذين كتبوا بالخطِّ الآراميّ. والأسماء الكثيرة التي وردت في النقوش النبطيَّة مع أعاريبها الواضحة تثبت أنَّهم كانوا عربًا. مضافًا إلى ذلك، فقد عُثر في البتراء -عاصمة الأنباط- على مجموعةٍ تضمُّ نحو ١٤٠ ورقة بردي، ترجع إلى القرن السادس للميلاد، ورغم أنَّها مكتوبة باليونانيَّة، لكن فيها عدد لا بأس به من الأسماء العربيَّة، وهذا يكشف بالتأكيد عن اللغة المنطوقة في تلك المنطقة. ويردّ أحد المستشرقين على من يزعم أنَّ الآراميَّة لم تكن لغة الكتابة للأنباط فحسب، [بل لغة حواراتهم أيضًا]، قائلًا: تحتوي الأغلبية الساحقة من هذه النقوش على إحدى مفردات «سـلـم/ذكـر/بـرك»، إلى جانب اسم صاحب النقش، وفضلًا عن أنَّ جذروها عربيَّة، تدلّ كثرة ورودها في النقوش على أنَّها فقدت هويَّتها بوصفها مفردةً آراميَّةً. وما يلفت الانتباه هو نقشٌ جنائزيٌّ عُثِرَ عليه في الحِجر، وكان كاتبه العربيّ ينوي أن يكتب بالآراميّ، لكنَّه لم يتقن العمل، فخلط بين اللغتين وارتكب
أخطاءً في الإعراب والنحو. وإذا ثبتت عروبة الأنباط، لا يُستبعد انتقال الخطّ منهم إلى بني عمومتهم في الحجاز. وما يقوِّي هذا الرأي هو وجود سوقٍ نبطيَّةٍ في يثرب في نهاية القرن الخامس للميلاد؛ بما يدلّ على علاقاتٍ تجاريَّةٍ بين الأنباط وعرب الحجاز.
أمَّا بالنسبة إلى الكتابة، فيتبيَّن من خلال النقوش النبطيَّة أنَّ الخطَّ الآراميَّ تطوَّر رويدًا رويدًا، وابتعد عن أصله شيئًا فشيئًا عند أجيال الأنباط حتَّى أصبح ما يُعرف بالخطّ النبطيّ، ويُقدَّر حصول هذا التفرَّع في أواخر القرن الثاني قبل الميلاد. ثمَّ إنَّ هذا الخطّ أصبح ذا طابعٍ مميَّزٍ في النصف الأخير من القرن الأوَّل الميلاديّ، ومن ثَمَّ تطوَّر بسرعةٍ مدهشةٍ في غضون القرنين الثالث والرابع، حيث انصبغت النقوش النبطيَّة بالصبغة العربيَّة، إلى أن اندثرت الكتابة النبطيَّة في القرنين الخامس والسادس، وتفرَّعت منها كتابةٌ جديدة، ألا وهي الكتابة العربيَّة. ويصف أحد علماء الساميَّات سرعة هذا التطوُّر، قائلًا: «إنَّ الخطَّ النبطيّ هو أسرع الخطوط في الابتعاد عن أصله الساميّ القديم (الآراميّ)؛ إذ لا وجود لأدنى تشابهٍ بين حروفه في القرن الأوَّل قبل الميلاد وبين هذه الحروف في ثلاثة أو أربعة قرونٍ سابقة. وتطوَّرَ بعد ذلك -أيضًا- بسرعة، بحيث يختلف تمامًا عن الأبجديَّة العربيَّة؛ لكنَّ حجم التغيير يختلف وفقًا للمنطقة؛ ففي المناطق الجنوبيَّة -وخصوصًا في سيناء- تفقد النقوش خصائصها بسرعةٍ أعلى من غيرها».
بدأ التنقيب عن آثار الأنباط منذ أوائل القرن التاسع عشر من قبَل البعثات الفرنسيَّة والألمانيَّة، وتلتها البعثات الأمريكيَّة، في مناطق البتراء وحوران وبصرى
والحِجر والعلا وتيماء وغيرها التي كانت مأهولةً بالأنباط، كذلك طرقهم التجاريَّة، ومن أهمِّها شبه جزيرة سيناء. ومن أهمِّ هذه النقوش التي تُسفر عن مسار تطوُّر الخطّ وتحوُّله من النبطيّ إلى العربيّ هي ما اشتهرت بالأسماء الآتية، مرتَّبةً حسب زمن صنعها: أمّ الجمال الأوَّل (٢٧٠م)، والنمارة (٣٢٨م)، وزبد (٥١٢م)، وجبل أُسيس (٥٢٨م)، حرَّان (٥٦٨م)، وأمّ جمال الثاني (القرن السادس). وتكفَّلت جملة من الكتب والمقالات -التي تعالج تطوُّر الخطّ العربيّ- دراسة هذه النقوش بعمقٍ وإسهاب، فلا داعي للوقوف على تفاصيل هذه الدراسات ونتائجها، بل تكفي الإشارة الموجزة إليها. وحريٌّ بالذكر أنَّ «ليلى نعمة» جمعَتْ ما يربو على ١١٠ نقوشٍ نبطيَّةٍ، يعود تاريخها إلى ما بين القرنين الثالث والخامس للميلاد، وتحدَّثت عن الحروف الواردة فيها، وسمَّتها «النصوص الانتقاليَّة»؛ لأنَّها تُظهر مسار انتقال الخطّ من النبطيّ إلى العربيّ.
ولا إشارة إلى النقوش التي دُوِّنت قبل القرن الثالث الميلاديّ؛ لأنَّها مكتوبةٌ بالخطِّ النبطيّ الكلاسيكيّ، وهي تخلو من كلمات كاملة تتَّفق أشكال حروفها مع حروف الخطِّ العربيّ، وإن كانت فيها حروفٌ مفردةٌ تتَّفق مع حروف الخطّ العربيّ، أو ما يصحّ أن يكون أصلًا تطوَّرت منه هذه الحروف. ومن النقوش التي ترجع إلى النصف الأخير من القرن الثالث هو ما عُثر عليه في بلدة أمّ جمال من أعمال حوران، ويُظهر هذا النقش أنَّ ملوك العرب أقبلوا على الخطِّ النبطيِّ منذ هذه
البرهة من الزمن بدلًا من الخطوط الساميَّة الأخرى؛ كالخطِّ اللحيانيّ، والثموديّ، والصفويّ. ثم إنَّ هناك نقشًا نبطيًّا بالغ الأهمِّيَّة يعود إلى القرن الرابع، ألا وهو «النمارة»، الذي عُثر عليه داخل قصرٍ صغيرٍ للروم بالقرب من دمشق ومنطقة الصفاة، محفورٌ على قبر الملك امرئ القيس بن عمرو، مكتوبٌ [في الأعمّ الأغلب] بالعربيَّة الصحيحة الفصيحة.
وأوَّل ظهورٍ للنقوش المكتوبة بالخطِّ العربيّ يعود إلى ما بعد القرن الخامس الميلاديّ، ومن هذه النقوش ما يسمَّى بـ«زبد»، وهو اسم خربة بين قِنَسْرين ونهر الفرات عُثر فيها على النقش المذكور، والنقش مكتوبٌ باللغات الثلاث؛ العربيَّة، واليونانيَّة، والسريانيَّة، وهو يشتمل على أسماء الرجال الذين ساهموا في بناء الكنيسة التي وُضع فيها هذا النقش. ويماثله نقشٌ آخر اكتشف بحران اللجا الواقعة جنوب دمشق في المنطقة الشماليَّة من جبل الدروز، وهو مكتوبٌ باللغتين العربيَّة واليونانيَّة، موضوعٌ فوق باب الكنيسة التي بُنيت هناك، يشتمل على أسماء مؤسِّسيها وتاريخ إنشائها. وهذا النقشُ أقرب إلى العربيَّة من النقشين السابقين -النمارة وزبد- لغةً وخطًّا؛ فهو أوَّلُ نصٍّ عربيٍّ جاهليٍّ كامل في كلماته كلِّها. وليس من الصعب على القارئ المتمعِّن قراءة هذا النقش؛ إذ هو قريبٌ جدًّا من الخطِّ العربيّ. ثمَّ إنَّ ثمَّة نقشًا آخر يمكن قراءته بشكل عامّ، وهو ما يسمّى بجبل أُسَيس، اكتُشف جنوب شرق دمشق، وهو يدلّ على تطوُّر الخطِّ العربيّ وامتيازه ببعض خصائصه في رسم أشكال الحروف والكلمات في أوائل القرن
السادس الميلاديّ. والنقش الآخر الذي عُثر عليه في أمّ الجمال -المشهور بأمّ الجمال الثاني- غير مؤرّخ، ويُحتمل أنَّه يرجع إلى أوائل القرن السادس للميلاد. ومن ميزة هذه النقوش أنَّها تتضمَّن ظاهرة الإعراب، التي هي من خصائص العربيَّة الفصحى -التي اصطلحنا عليها باللغة المشتركة- والأكادية.
ويمكن تلخيص خصائص الكتابة النبطيَّة بالآتي:
ـ تختلف أشكال بعض الحروف حسب موقعها في الكلمة، وهي من أبرز الظواهر في الكتابة النبطيَّة
ـ ترتبط الحروف بعضها ببعض منذ أواخر القرن الأوَّل الميلاديّ، ويتَّسع نطاق هذه الظاهرة في القرنين الثاني والثالث حتَّى يشمل تقريبًا جميع حروف كلّ كلمة في القرن الرابع.
ـ يُترك بين كلّ كلمتين فراغٌ يفصل بينهما، وشاعت هذه الظاهرة منذ أواخر القرن الثالث.
ـ تُكتب تاء التأنيث مبسوطةً، كما كانت تُكتب في صدر الإسلام.
ـ تخلو الكتابة من حروف المدّ، كما يظهر أثر هذه الظاهرة في المصاحف الشريفة.
ـ لا إعجام في الكتابة النبطيَّة، فكان الكاتب يضع علامة صغيرة فوق بعض الحروف دفعًا للالتباس.
ـ ابتعدت الحروف النبطيَّة على مرّ الزمن ابتعادًا شاسعًا عمَّا كان أصلها، واقتربت بالتزامن إلى الحروف العربيَّة.
تهدينا مقارنة الكتابات النبطيَّة والعربيَّة إلى القول بأنَّ الخطَّ النبطيَّ هو أصل الخطِّ العربيّ، لكنَّ الأمر غير محسومٍ؛ لضآلة النقوش المكتشفة إلى الآن والفواصل الزمنيَّة بينها. إذًا، أمامنا نظريَّتان حول أصل الخطّ العربيّ؛ نظريَّة مبنيَّة على وجود المماثلة بين الخطَّين العربيّ والسريانيّ، وهي التي لا تؤيِّدها أيّ مادَّة تاريخيَّة كالنقوش والمخربشات وأوراق البردي، فصرف المستشرقون والمسلمون النظر عنها؛ ونظريَّة أخرى مبنيَّة على عددٍ قليلٍ من النقوش التي توحي بأصلٍ نبطيٍّ للخطِّ العربيِّ. ولا تكافؤ بين أدلَّة النظريَّتين؛ إذ لا يمكن لأيِّ أحد، وبمجرَّد وجود مماثلة بين الخطِّ العربيّ وأيِّ خطٍّ آخر، أن يدَّعي تفرُّع الخطّ العربيّ منه، من دون تقديم أيّ دليلٍ تاريخيّ على دعواه، في حين تبقى النظريَّة الثانية هي الراجحة إلى الآن؛ لابتنائها على وثائق تاريخيَّة.
وقد يُطرَح سؤال مفاده: إن كان الخطُّ النبطيُّ هو أصلُ الخطِّ العربيّ، فلمَ نجد العرب الذين نشروا تلك الروايات الدالَّة على انتقال الخطّ من الحيرة والأنبار إلى الحجاز مشدِّدِين على هاتين المدينتين، وهي التي تقترح اشتقاق الخطّ العربيّ من السريانيّ؟ والجواب هو: من ناحيةٍ، كانت السريانيَّة لا تزال منطوقة في القرون الأولى من الهجرة، ومن ناحيةٍ أخرى، كانت المملكة النبطيَّة قد أُطيحَ بها قبل قرونٍ وتلاشى ذكرها؛ وربَّما السبب في ذلك هو أنَّ الخطَّ الكوفيّ -القلم الذي كُتب به القرآن الكريم- نما وازدهر في الكوفة التي كانت بجوار الحيرة. فهذه الروايات
تكشف عن المتخيّل العامّ عند العرب في تلك الأيام، ولا تُثْبِتُ حقيقةً تاريخيَّةً يمكن التعويل عليها. هذا، مضافًا إلى أنَّ تطوُّر الخطِّ يحتاج إلى مجتمعٍ مدنيٍّ في غاية الرقي، بحيث يمتلك القوَّة الكافية لاختراع الخطّ ونشره. والخطُّ السريانيُّ لم يصل قطّ إلى هذه المنزلة، خلافًا للنبطيّ. وعلى الأرجح أنَّ الخطَّ النبطيّ تحوَّل إلى العربيّ في الحجاز؛ إذ كان أهلها تجَّارًا مفتقرين إلى الكتابة، وكانوا على علاقةٍ مع أهل الحضارة في اليمن والشام أثناء رحلتي الشتاء والصيف، وكانت الأسواق الأدبيَّة والتجاريَّة تنعقد فيها. وعلى الرغم من عدم اكتشاف نقشٍ عربيٍّ في هذه المنطقة، لكنّ الكتابات النبطيَّة التي عُثر عليها في شمال الحجاز (العلا والحجر) تمتاز عن غيرها باتِّجاهها السريع نحو الكتابة العربيَّة، وهذا ما يرجِّح -أيضًا- ما أسلفناه عن أصل الخطِّ العربيِّ وتطوُّره.
تجدر ـ في نهاية المطاف ـ الإجابة عن شبهة أثارها لكسنبرغ حول إعجام الخطِّ العربيّ وتنقيطه. فهو -كما تقدَّم- يرى ذلك اتِّباعًا للسريانيَّة -لأنَّ فيها يتميَّز حرفا «ܪ» و«ܕ» بنقطةٍ فوق الأوَّل ونقطةٍ تحت الثاني- ويُرجع تاريخه إلى عهد عبد الملك بن مروان (٦٥-٨٦ للهجرة)، وبالتالي يعتبر عدم وجوده في الكتابات الأولى سببًا للأخطاء في قراءة القرآن وفهمه.
لا ندَّعي أنَّ الكتابات الأولى والمصاحف الشريفة كانت معجمة مئةً بالمئة منذ تدوينها؛ لأنَّ النقوش المكتشفة والمصاحف الشريفة التي تعود إلى القرن الأوَّل والقرن الثاني للهجرة تثبت خلاف ذلك، ولكن في الوقت نفسه لا نوافق مع لكسنبرغ على أنَّ
إعجام الحروف العربيَّة اتِّباعٌ للسريانيَّة، وأنَّه بدأ في عهد عبد الملك.
أمَّا عدم صحَّة اتِّباع الخطِّ العربيّ في الإعجام السريانيَّ؛ فلأنَّ هناك عددًا من النقوش النبطيَّة التي تحوي حروفًا معجمة. فيمكن افتراض أنَّ الخطَّ العربيّ اتَّبع النبطي ـ الذي هو أصله المشتقّ منه ـ ولا ضرورة لاتِّباعه السريانيّ في هذا الموضوع. بل دعوى لكسنبرغ لا دليل عليها إلَّا المماثلة بين إعجام حرفَي «ܪ» و«ܕ» في السريانيَّة وإعجام بعض الحروف العربيَّة، في حين أنَّ المماثلة نفسها موجودة بين الحروف العربيَّة والنبطيَّة. فضلًا عن أنَّ الحاجة إلى الإعجام لا تختصّ بالأبجديَّة العربيَّة فحسب، بل كلٌّ من الأبجديَّات العربيَّة والعبريَّة (الآراميَّة) والسريانيَّة ناقصةٌ في تمثيل الأصوات، إلى جانب نقصها في عدد أشكال الحروف أمام عدد صوامتها، وقد انحلَّت المشكلة في كلٍّ منها بإضافة علاماتٍ صغيرةٍ ـ كنقطةٍ أو خطوطٍ طفيفة ـ إلى الحروف، فوقها أو تحتها أو بجانبها. إذًا، إنَّ دعوى لكسنبرغ من اتِّباع الخطِّ العربيّ السريانيَّ في الإعجام مردودةٌ عليه، ولا تصحّ.
وأمَّا دعواه بدء الإعجام في عصر عبد الملك، فلا تصحّ أيضًا؛ إذ ثمَّة أدلَّة تُثْبِتُ معرفة العرب بالإعجام قبل ذلك بأعوام، واستخدامه في عددٍ قليل من الوثائق التي وصلتنا إلى الآن. وعلى فرض صحَّة ما ورد في الموروث الإسلاميّ، فإنَّ أوَّلَ من قام بإعجام القرآن هو أبو الأسود الدؤلي؛ وذلك بعد أن طلب منه زياد بن أبيه أن يضع شيئًا يستطيع به الناس إعرابَ القرآن بشكلٍ صحيح، وكان الداعي إلى ذلك أخطاء العجم المسلمين في قراءة القرآن، فَكَرِهَ أبو الأسود إجابة زياد، ولكنه لـمَّا سمع رجلًا يُخطِئ في قراءته القرآن، استعظم الأمر وعاد إلى زياد ولبَّى طلبه، فاستدعى لذلك كتَّابًا، واختارا منهم واحدًا؛ لينقِّط القرآن كما يعلّمه أبو الأسود، بلون يخالف المصحف، فوضع نقطةً فوق الحروف دلالةً على الفتحة، ونقطةً تحتها دلالةً على
الكسرة، ونقطةً بجانبها دلالةً على الضمَّة، ونقطتين للدلالة على الغُنَّة (التنوين). وكان هذا الحادث في زمن معاوية، أي قبل حكم عبد الملك بسنواتٍ عدَّة. وقيل: إنَّ أول من نقَّط القرآن هو يحيى بن يعمر العَدواني، وقيل: هو نصر بن عاصم الليثي، ومن المحتمل أنَّهما أخذا ذلك عن أبي الأسود، الذي كان سابقًا عليهما بوضع الحركات والتنوين، ثمَّ أخذ الناس عن هذين البصريَّيْن التنقيط، وكان لهم تنقيطٌ آخر فتركوه.
يعلِّق أحمد رضا -على خبر إعجام القرآن على يد أبي الأسود- مستغربًا: «كيف بدأ أبو الأسود بوضع الحركات خوفَ الالتباس في الإعراب، ولم يضع النقط خوفَ الالتباس في الحروف؟ فإنَّ تقويم أصل الكلمة أولى من تقويم إعرابها». ويقول يوسف ذنون: «لو لم تكن [في المصحف] نقطٌ من جنس لون أشكال الحروف لمَا استعمل أبو الأسود لونًا آخر لوضع نقط التشكيل»، ويستطرد قائلًا عن عمل نصر ويحيى: «إنَّهما قاما بعمليَّة تثبيت نقاطٍ محدَّدةٍ للإعجام [أيْ توافق النقاط قراءةً ترتضيها الدولة المروانيَّة]، فلم يتلقَّ نمطهما بالقبول عند المغاربة، وتعدَّدت أنماط التنقيط والإعجام في البلدان الإسلاميَّة، كما نجد نموذج ذلك في نقش قبَّة الصخرة الذي يعود إلى عام ٧٢ الهجريّ، يعني عهد عبد الملك نفسه، وفيها حروف معجمة تختلف عن طريقة إعجام أهل المشرق والمغرب».
وقيل: إنَّ الحجَّاج بن يوسف غيَّر في مصحف عثمان حروفًا، منها (هُوَ الَّذِي
يَنْشُرُكُمْ) ، فجعله (يُسَيِّرُكُمْ) . ولو صحَّ ذلك، فهو يدلّ على أنَّ تلك الكلمة كانت منقَّطة قبل زمنه، وإلَّا كيف غيَّر قراءتها، والحال أنَّه لا فرق بين «ينشركم» و«يسيركم» إلا بالنقط. وهذا يردّ الروايات التي تُعرِّف نصرًا أو يحيى بأوَّل من وضع النقط في زمن عبد الملك بأمرٍ من الحجَّاج، وهي التي تُرجع تاريخ الإعجام إلى سنة ٧٥ للهجرة فصاعدًا.
وما يدلّ على أنَّ التنقيط والإعجام كان معروفًا لدى العرب في صدر الإسلام، هو ما روي عن بعض الصحابة والتابعين أنَّهم كانوا يكرهون الإعجام، بل أمروا بتجريده من القرآن، وكان في المقابل مَنْ يُرخِّص ذلك أو يستجيزه في مصاحف يتعلَّم بها الصبيان القرآن لا في المصاحف كلِّها. فإن لم يكن العرب يعرفون الإعجام، فكيف أفصح بعضهم عن كرهه له؟ أو إن لم تكن في المصاحف الشريفة نقطٌ، فكيف أمر بعضهم بتجريدها؟
وعلى الرغم من معرفة العرب بالإعجام والتنقيط كانوا يهملونهما كثيرًا ويتركونهما إلَّا في مواضع الالتباس، وكان ذلك إعظامًا لمقام القارئ؛ لأنَّ الكتابة إذا كانت منقَّطةً مشكَّلةً عُدَّت إساءةً إلى القارئ كأنَّه لا يفهم النصَّ إلَّا بالنقط والشَكل. فالعرب كانوا لا يضعون النقط إلَّا في الموارد التي لا يُؤمَنُ من دونها اللبس، بل كانوا يرون في الإكثار منها فسادًا للنصِّ، فلم ينقِّطوا من الحروف سوى
الـمُشْكِلَةِ منها وفي موارد الضرورة فقط. وربَّما يكثر ذلك في الكتابات القصيرة، فالنقوش التي عُثر عليها إلى الآن لا تتجاوز سطورًا وكلماتٍ معدودة، فلعلَّ عدم الإعجام ناجمٌ عن اطمئنان الكاتب إلى أنَّ القارئ قادرٌ على فهم ذلك النصّ، بينما نجد خلاف ذلك في عددٍ ضئيلٍ من الكتابات الإسلاميَّة الطويلة نسبيًّا، وهي سابقةٌ لزمن عبد الملك، وفيها حروف معجمة. منها ورق بردي كُتبت بالعربيَّة واليونانيَّة، تعود إلى سنة ٢٢ هجريَّة، كذلك نقشٌ يُسمَّى بـ«سد الطائف»، يرجع إلى عهد معاوية، أيْ سنة ٥٨ للهجرة. وعلاوة عليهما، هناك نقشٌ إسلاميّ يؤرَّخ بعام ٢٤ للهجرة، يُسمَّى بـ«نقش زهير»، بعض حروفه معجمة، مضافًا إلى نقشٍ نبطيٍّ يعود تاريخه إلى فترة ما بين الربع الثاني من القرن السادس ومطلع القرن السابع للميلاد، وفيه مفردةٌ بالخطِّ العربيّ حروفها معجمة.
وما يمكن استنتاجه أخيرًا هو أنَّ العرب كانوا يعرفون الإعجام، ولكن كان إهماله عندهم شائعًا للغاية، فما كانوا يستخدمونه إلَّا عند الضرورة والالتباس؛ لذلك جرد الكُتَّابُ المصاحفَ من النقط، زاعمين أنَّها في مأمنٍ من اللبس لكثرة الحفظة للقرآن الكريم. فلما كثُر أهل الإسلام دعت الحاجة إلى الإعجام. وهذا يخالف دعوى لكسنبرغ في أنَّ الإعجام موضوعٌ في عهد عبد الملك اتِّباعًا للسريان.
ونختم البحث بملحوظة قدَّمتها عبُّود، بشأن فريق الباحثين غير المسلمين الذي انقسم إلى فريقين؛ فريق من المسيحيِّين العرب وفريقٍ من المستشرقين الغربيِّين،
فتقول عن الفريق الأوَّل -وقد أشرنا سابقًا أنَّ الذي تستَّرَ تحت اسم لكسنبرغ هو لبنانيٌّ مسيحيّ ـ إنَّهم يرفضون التراث الإسلاميّ مطلقًا ـ خلافًا للفريق الثاني الذي من كبارهم نولدكه [وهو يستند إلى المصادر الإسلاميّة لإثبات دعاويه]- ويؤرِّخون أوَّل جمع القرآن إلى عهد عبد الملك، وخاصَّةً الحجاج بن يوسف، مشدِّدين على التأثير المهمّ للنصارى العرب. ويرون الخطّ العربيّ المبكر غير صالح للكتابة، وبما أنَّ المسيحيِّين الأوَّلين لم يشيروا إلى كِتاب المسلمين، فيفترضون عدم وجوده!
(79)
(81)
اختارت هذه الدراسة الفصلين الرابع عشر والخامس عشر من كتاب «القراءة السريانيَّة ـ الآراميَّة للقرآن» وتناولتهما بالنقد؛ لأنَّهما يتضمَّنان أهمّ دعاوى لكسنبرغ بشأن المفردات والتعابير التي قُرئت -بحسب رأيه- خطأً أو فُهمت فهمًا خاطئًا من القرآن. ويكفي تحليل النماذج الواردة في هذين الفصلين ونقدها؛ ليَثْبُتَ عدم نجاح لكسنبرغ في الكشف عن أصول القرآن. ففي الفصل الرابع عشر يركِّز لكسنبرغ على مفردات قُرئت خطأً، وفي الفصل الخامس عشر على تعابير فُهمت فهمًا خاطئًا. وفي ما يأتي بيانٌ للمواضيع الأصليَّة التي يتمحور حولها هذان الفصلان من الكتاب، ومن ثَمَّ التطرُّق إلى منهجيَّة الكاتب ودراستها النقديَّة.
يرى لكسنبرغ أنَّ آية: (وَاسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُم بِصَوْتِكَ وَأَجْلِبْ عَلَيْهِم بِخَيْلِكَ وَرَجِلِكَ وَشَارِكْهُمْ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ وَعِدْهُمْ ۚ وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا ) سُجِّلت بشكلٍ خاطئٍ في القرآن، ويُخطِّئ خمس مفرداتٍ واردةٍ فيها، هي: واستفزز، وأجلب، بخيلك، ورجلك، وشاركهم، ومن ثَمَّ يُقدم قراءةً حديثةً لها؛ مستدلًّا بأنَّ السياق هو إخراج إبليس من الجنَّة وإذنه من الله لتضليل الناس فيعطيه الله مطلبه. ثمَّ يقدِّم لكسنبرغ أدلَّته على مدَّعاه، وهي:
ـ إنَّ إبليس أُمر في هذه الآية أن يُخوِّف الناس بصوته، وهذا يعارض ما ورد في آيةٍ أخرى أنَّه يوسوس في صدور الناس. وورد معنى «استفزّ» في معجم لسان العرب هكذا: واستفزّه ختله حتَّی ألقاه فی المهلكة. وبما أن هذا المعنى غير موجود في الأدب العربيّ بعد القرآن والعربيَّة العاميَّة فهو معنى موضوع. فيُحتمل أن تكون النقطتان
فوق الزايَين زائدتين، والقراءة الصحيحة هي: واستفرر، أيْ واجعلْهم يفرُّون.
ـ إنَّ المعنى الذي يقدِّمه لسان العرب لـ«واجلب عليهم» هو أن يهاجم صائحًا. وهذا معنىً غير مقنع، بينما معنى «خلبَه أي خدعه» ملائم. وعليه، فلتُنقل نقطة الجيم إلى فوقها، وتُقرأ: «واخلب عليهم»، يعني في العربيَّة المعاصرة: وانصب عليهم.
ـ قراءة «بخيلك ورجلك» خاطئة؛ لأنَّ الخيل والرجل لا تتناسبان مع الخدعة فلنقترح لهما قراءة أخرى. بالنسبة لـ«بخيلك»، يمكن قراءته بشكل «بحيَلك» وبما أنَّه لم يرد في القرآن هذا اللفظ بهذا المعنى، يمكن قراءة أخرى وهي «بحبلك». هذه كلمة دخيلة من السريانيَّة، ولتُفهم بصيغة المذكَّر في السريانيَّة الآراميَّة: «ܚܒܠܐ» (حبلا/ habla) ومعناها في معجم «مَنّا»: أحبولة، شرك، مصيدة، مكر، مكيدة. بناءً على هذه المعاني، يصحُّ كلا المعنيين «بحيلك وبحبلك».
ـ الخطأ الرابع هو كتابة «برجلك» الذي يأتي نتيجة للاستنساخ الخاطئ لـ«ܕ» في السريانيَّة الآراميَّة، كـ«ر» في العربيَّة. إذًا، القراءة الصحيحة هي «بدجلك» ومعناه في السريانيَّة الآراميَّة (ܕܓܠ) (دگل daggel) وفقًا لقاموس «منّا» هو: كذب، مكر، خدع.
ـ وأخيرًا، «وشاركهم» ليس له معنى. يقول الطبريّ أجمع المفسِّرون على أنَّه بمعنى المساهمة. وإجابةً عن هذا التساؤل: كيف يشارك الشيطانُ الناسَ في الثروات والأولاد؟ قالوا: إنَّه يشارك في الأموال المحرَّمة، وأولاد الزنا، والذين يسمَّون بأسماء الأصنام كـ«عبد شمس». لكن على الأرجح، المعنى المجازيّ لفعل «ܣܪܟ»
(سرك sarrek) السريانيّ الآراميّ وما يعادله في العربيَّة هو: أولع، أغرى، حسب قاموس «منّا». ولم يُعرف في العربيَّة من هذا الجذر إلَّا «شَرَكٌ»، ومعناه في لسان
العرب: حبائل الصائد. وقد ورد في الحديث النبويّ: أعوذ بك من شرِّ الشيطان وشركه. لذلك، فالقراءة الصحيحة هي باب التفعيل في السريانيَّة الآراميَّة من الجذر نفسه (أي شَرِّكْهُمْ) وليس باب المفاعلة في العربيَّة.
ـ بناء على ما تقدَّم، تُفهم الآية المزيجة من العربيَّة والسريانيَّة الآراميَّة هكذا: فأبعِدْ بصوتك من استطعتَ منهم، واخدعهم بحيَلك وأكاذيبك، ووسوسهم بالأولاد وثرواتك، وعِدهم، وما يعدهم الشيطان إلا غرورًا!
وهناك أنموذج آخر ممَّا قُرئ خاطئًا، وهو مفردة «إناه» الواردة في الآية 53 من سورة الأحزاب. وقد فُهمت فهمًا خاطئًا بمعنى الطعام المحضَّر، لكنَّ القراءة الصحيحة هي «إنَثَه» (أي أزواجه) التي وردت في نصٍّ مدنيٍّ متأخِّر. فقد طُلِبَ من المؤمنين ألَّا يدخلوا بيوت النبيّ إلَّا أن يُدعَوا إلى طعامٍ، فإذا دخلوا لا ينتظروا تحضير الطعام (وفقًا للقرآن الحديث)؛ والصحيح هو «غير ناظرين إنَثَه» ويعني لا ينظرون إلى أزواج النبيّ. وعندما عجز المفسِّرون العرب من إدراك العلاقة بين الطعام -بدلًا من الأزواج- وبين النظر، ترجموه إلى الانتظار.
يطرح لكسنبرغ في هذا الفصل دعواه المثيرة للجدل بالنسبة إلى الحور العين والفهم الحديث عنها؛ هادفًا تفنيد المعتقدات الإسلاميَّة العريقة التي بُنيت -بحسب زعمه- على أساس قراءة خاطئةٍ من القرآن، ومنها أبكار الجنَّة (Virgins of Paradise). ويطلب المؤلِّف من القرّاء مراجعة مادة «Hur» من «Encyclopedia of Islam» (موسوعة الإسلام) للتعرُّف على هذا المعتقد.
يقول لكسنبرغ: الحور (جمع الحوراء، ومذكَّرها: أحور) يعني حرفيًّا الأناس البيض، يعني جاريات الجنَّة، واللاتي لهنّ فارق شديد بين سواد قُزَحيّاتهن وبين بياض حولها. وعُرِّفت هذه الكلمة بمن يُثِرنَ جذل ناظريهن، وهو تعريف خاطئ يرفضه اللغويُّون العرب. وهي مفردة ذُكرت في القرآن مرارًا وتكرارًا، وقد سُمِّيَت -أيضًا- بأزواجٍ مطهَّرة، وقال المفسِّرون إنَّهن بلا نقصٍ جسدًا وروحًا، ووَصَفَهُنَّ القرآنُ بأنَّهن (فِيهِنَّ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ لَمْ يَطْمِثْهُنَّ إِنسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا جَانٌّ) ، أيْ لا ينظرن إلَّا إلى أزواجهن، ومن آية (لَمْ يَطْمِثْهُنَّ إِنسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا جَانٌّ ) يُفهم أنهنَّ على قسمين الإنس والجنّ. ووصفهنَّ -أيضًا- بأنَّهنّ (حُورٌ مَّقْصُورَاتٌ فِي الْخِيَامِ)، وشبَّههنّ كذلك بالياقوت والمرجان.
ثمّ يذكر بعض التفاصيل الواردة في ما يسمِّيه الأدب المتأخِّر عن الحور العين، ومنها خلقُهُن من الزعفران والمِسك والعنبر والكافور في أربعة ألوان: الأبيض، والأخضر، والأصفر، والأحمر، وهنَّ شفّافات إلى درجةٍ يُرى مخُّ عظامِهن عندما يلبسن ٧٠ ثوبًا حريريًّا، ولو بصقت إحداهن في الدنيا يصبح مِسكًا! ومكتوبٌ على ثديي كلٍّ منهن اسم الله واسم زوجها، متزيناتٌ بكمية هائلة من المجوهرات، ساكناتٌ في أماكن فاخرةٍ مع خادمات. إذا دخل الرجال المؤمنون الجنَّة يُستقبلون هكذا: لكلٍّ منهم عددٌ كبيرٌ منهن، فيتعايش معهنَّ بقدر ما صام من رمضان وعمِل من الصالحات؛ لكنهنَّ ما زلن أبكارًا ، ومع أزواجهن في سنٍّ واحدة، وهو عمر الثلاثة والثلاثين (٣٣) تقريبًا.
يرى لكسنبرغ أنَّ هذه التفاصيل كلَّها مداليل مادِّيَّة وحسِّيَّة، وينقل التساؤل
الذي أجاب عنه البيضاويّ، وهو عن جدوى هذا التعايش بين الرجال المؤمنين والحور العين في الجنَّة، فإنَّ الإنسان يحتاج في الدنيا إلى الحياة الزوجيَّة لبقاء جيله، فما الفائدة من ذلك في الجنَّة؟ والجواب هو أنَّه على الرغم من أنَّ الأطعمة والأزواج في الجنَّة تشترك في الاسم مع ما يعادلها في الدنيا؛ لكنَّها مجرَّد استعارة بغية التمثيل، ولا مشابهة حقيقيَّة بينها وبين ما يعادلها في الدنيا. ويضيف البيضاوي: ليس إجماعًا على أنَّ الحور العين هنّ نساء الدنيا أنفسهن أو غيرهن. وتُقدِّم الصوفيَّة للحور العين تفاسيرَ باطنيَّة.
ثمّ يشير لكسنبرغ إلى آراء بعض المستشرقين -منهم: «سِيل»، «بِرثلز»، و«دُزي»- الذين ادَّعَوا أنَّ النبيّ صلىاللهعليهوآله قد أخذ فكرة فتيات الجنَّة عن الفُرس. كما يشير إلى ما ادَّعاه «ونسينك» من أنَّ ما قاله النبيّ صلىاللهعليهوآله عن الغلمان والحور العين ليس إلَّا تأويلًا خاطئًا عن الجنَّة في الفكر المسيحيّ والملائكة فيها. ومن ثَمَّ يتطرَّق إلى منهجيَّة البحث والهدف الذي يطمح إليه، قائلًا: إنَّ هذه الدراسة تستخدم فقه اللغة؛ ليُظهر أنَّ البيضاويّ كان محقًّا في تساؤله عن حقيقة نساء الجنّة، وليُثبت أنَّ الرسول صلىاللهعليهوآله لم يكن خاطئًا في إدراك صورة الجنَّة في المسيحيَّة، بل إنَّ المفسِّرين المسلمين المتأخِّرين هم الذين أخطأوا في فهم العبارات القرآنيَّة المستوحاة من الترانيم المسيحيَّة السريانيَّة التي تحتوي على وصفٍ مماثلٍ للجنَّة، وأخطأوا في ترجمتها أيضًا؛ متأثِّرين بالمفاهيم الفارسيَّة حول الأبكار الخرافيَّة للجنَّة.
يقول لكسنبرغ: «يعتبر القرآن العهدين وحيًا، وفي عددٍ لا بأس به من آياته ينعت نفسه مصدِّقًا لهما. فهو يعرِّف العهدين تمهيدًا لنفسه وتثبيتًا لأصالته،
قائلًا: ( أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ ۚ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِندِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا )، يعني لو لم يكنالقرآن من عند الله، لكان فيه عدم الاتِّساق مع العهدين. إذًا، سيكون نقضًا إن وجدنا تنافرًا بين القرآن وبين العهدين. ثمَّ إنَّ الحوريَّات من العناصر الضروريَّة في إسخطالوجيَّة القرآن، ولم تُذكر في العهدين، فيظهر أنَّ القرآن ليس من عند الله. لكنَّنا نفترض أنَّ القرآن صحيح، بل قد أخطأ الناس في قراءته، وفهموه وفقًا لأحلامهم في الرؤيا».
ومن هنا يبدأ لكسنبرغ بسرد بعض الآيات التي تدلُّ على وجود الحور العين في الجنَّة، ويحاول تقديم قراءة وفهم حديثين لها؛ مستهلًّا ذلك بآية: (وَزَوَّجْنَاهُم بِحُورٍ عِينٍ) . وبعد أن ينقل ثلاث ترجمات لاتينيَّة لهذه الآية، يقول: إنَّ الآية سوف تُفهم بعد هذه الدراسة -بناءًا على السريانيَّة الآراميَّة- بالآتي: وسنجعلكم مرتاحين تحت البِلَّوْرات البِيْض (من الأعناب).
يُشيد لكسنبرغ بالدراسات الغربيَّة للقرآن، قائلًا: «إنَّها لم تُشكِّك في نقط الإعجام من القرآن؛ لكن هناك -اليوم- مخطوطات تشهد بأنَّ هذه النقاط غير أصيلة. وعلى الرغم من أنَّ هذا الاعتقاد الفاسد [يعني التنقيط] لم يتحدَّ قطُّ؛ لأنَّ هذا التنقيط المتأخِّر مبنيٌّ على تراثٍ شفهيٍّ موثوقٍ به، لكنَّ التحليلَ اللغويَّ يكشف عن الحقيقة، ويُثبت أنَّها أخطاءٌ تاريخيَّة».
يرى لكسنبرغ أنَّ فعل «زوّجناهم» -الذي يفيد معنى الزواج- جرى تنقيطه بشكلٍ خاطئ؛ ولهذا يقترح إزالة نقطتَي «الزاي» و«الجيم» لتصبح الكلمة
«روّحناهم»، وهو يعني: نَدَعُهم يستريحون. ودليله على ذلك هو الجذر الفعليّ لـ«روح/ܪܘܚ» المشترك بين السريانيَّة-الآراميَّة وبين العربيَّة، ويعادله -بحسب لكسنبرغ- في العربيَّة فعل «أراح» المتعدِّي، طبقًا لمعجم «منّا». ثمَّ يستطرد، قائلًا: ربَّما يأتي هذا التساؤل، فلمَ قرأه القرَّاء كذلك؟ ويجيب نفسه بأنَّهم لم يعلموا ماذا يصنعون بحرف الجرّ الباء، الذي يتعدى بها الفعل «زوّج» ولا يتعدى بها «روّح». فاللغويُّون العرب -بزعم لكسنبرغ- جهلوا معنى الباء في السريانيَّة-الآرامية. ويُتابع بأنَّ لهذا الحرف ٢٢ معنىً، ومعناه العشرون هو «بين»، كما ورد في معجم «منّا»، وأنَّ الفعل «روّح» يتناسب مع هذا المعنى للباء. وعليه، يرى أنَّ المعنى الصحيح هو: نَدَعُهم يستريحون تحت (بين) [ما يُسمَّى] الحور العين.
أمَّا بالنسبة إلى تعبير «الحور العين» الثنائيّ، فيعتقد لكسنبرغ أنَّ ضمير «هم» -الذي يشير إلى جماعة من الرجال- في «زوَّجناهم» حدا بالمفسِّرين العرب أن يتخيَّلوا الحور العين إناثًا. ويقول: إنَّ علماء فقه اللغة العرب كانوا مصيبين في فهم معنى صفة «الحور (ج. الحوراء)» أنَّها مأخوذة عن السريانيَّة-الآراميَّة «ܚܘܪ» (حور hwar) وهي تعني البياض؛ لكنَّهم فهموا بطريقة مماثلة الصفة التالية «العِين» بناءًا على تصوّر الأبكار، بينما هي مبهمة في وصف العَين من جانب اللفظ والكتابة، وبالتالي ترجموا الحور العين بشكلٍ خاطئٍ إلى [النساء] ذوات العيون الواسعة؛ كما فُهمت «العِين» جمعًا للعيناء أي ذات عين وسيعة. لذلك يرتكز ثبوت أو سقوط هذا المعتقد القرآنيّ (الحوريَّات) -بحسب لكسنبرغ- على ترجمتها الصحيحة.
ثمّ يتناول لكسنبرغ ثانيةً معنى الحور، ويرى معناه عند اللغويِّين العرب صحيحًا، ويضيف إليه: بما أنَّ مدلول «الحور» لم يرد في القرآن، فلا بدَّ من تصوُّره. وليس من الواجب حسب السياق القرآنيّ أن يكون هذا الكائن ثيِّبًا أو بكرًا؛ فقد أشار القرآن في آيتين إلى أنَّ المؤمنين يدخلون الجنَّة مع أزواجهم في الدنيا: (ادْخُلُوا
الْجَنَّةَ أَنتُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ تُحْبَرُونَ) ، وعندما يَعِدُ المتَّقين، يقول: (هُمْ وَأَزْوَاجُهُمْ فِي ظِلَالٍ عَلَى الْأَرَائِكِ مُتَّكِئُونَ ) .
يستنتج لكسنبرغ من الآيتين أنَّه: فضلًا عن أنَّ القرآن يُعارض العهدين بتصوُّر الحوريَّات، سوف يعارض نفسه بعد هذا الكلام؛ فإنَّه نظرًا إلى المضامين الواضحة لهاتين الآيتين، يرفض القرآن وجود أيَّ ضرّة [في الجنَّة]. بعبارة أخرى، يستطيع الشخص أن يتصوَّر كم سيكون مزعجًا للزوجات الدنيويَّة أن ينظُرن إلى أزواجهن وهم يستمتعون بالحوريَّات! ثمّ ينقل لكسنبرغ مقالةً عن أحد المستشرقين الذي يوافقه في الرأي على أنَّ الأزواج في الجنَّة ليسوا إلَّا النساء في الدنيا. لكنَّ لكسنبرغ يُشكِل على هذا المستشرق أنَّه لم يُقدِم على الخطوة التالية للكشف عن هذا التناقض في القرآن؛ فإنَّ الحور صفةٌ للجمع المؤنَّث، ولها موصوفٌ محذوفٌ لم يُشِر إليه القرآن، وعلينا أن نتعرَّف عليه عبر المواصفات الأخرى للجنَّة في القرآن.
يحاول لكسنبرغ تقديم قراءةٍ حديثةٍ عن كلمة «العِين»؛ ليغيِّر المعنى المشهور لتعبير «الحور العين». فبعد أن يقرّ بأنَّ لفظ «العَين» لهيئة مفرد «العِين» تُستخدم في كلتا العربيَّة والسريانيَّة-الآراميَّة، يُخطِّئ المفسِّرين العرب الذين فهموها على أنَّها صيغة جمع، قائلًا في ذلك: «تُجمع [العَين] على العيون والأعين؛ تبعًا للتغيُّر الذي يحدث في الكلمة عند جمعها، ولم يرد في القرآن إلَّا في تعبير «عِين»، يأتي هذا التساؤل عن تغيير رسم الكلمة من جمع في السريانيَّة-الآراميَّة إلى العربيَّة؛ لكن للتمييز بين هيئة هذه الكلمة المعرَّبة لدى الوقف عليها (أي حذف [الحركة الأخيرة للكلمة] في السريانيَّة-الآرامية وبين مفردها، قُرئت [هيئة الجمع] «العِين». بالنسبة للـ«ܥܝܢ»، يجب أن تُفهم على أنَّها مفردة بسيطة في السريانيَّة-الآراميَّة. ونقاش من يناقش ليُثبت أنَّها جمع جاء تبعًا للمفردة السابقة عليها (الحور)، فهي
جمع، وبما أنَّه من الواجب اتِّباع الصفة للموصوف، فـ»عِين» -أيضًا- اعتُبرت جمعًا [لا مفرد].
يرى لكسنبرغ أنَّ تعبير «الحور العِين» الذي يُعدُّ علامةً على جمال نساء الجنَّة، لا يتنافى مع استعمال العرب فحسب [بل في اللغات الأخرى أيضًا]؛ فالشخص عندما يصف جمال العين يقول هي سوداء أو بنّيَّة أو زرقاء، ولا يقول هي بيضاء، إلَّا أن تكون عمياء! ثمَّ يستند في كلامه إلى آيةٍ من القرآن تقول إنَّ يعقوب عليهالسلام ابيَّضت عيناه من الحزن، فهنا وُصِفَتْ عيناه بالبياض؛ لأنَّه صار أعمى. وبالتالي يستنتج أنَّ تبريرات المفسِّرين العرب الدالَّة على جمال العين الواسعة البيضاء موضوعة مؤقَّتة؛ لذلك، وبناءً على الدلائل اللغويَّة، إذا لم يصحّ معنى العَين في «عيون النساء» [يعني العيون البيض لا تدلّ على جمال النساء]، فالحوريَّات المزعومات اللاتي ترتبط بهذه العيون [البيض] تتلاشى فجأة. وبعد هذه الفقرة يفتخر لكسنبرغ بمساعيه؛ لأنَّه تمكَّن أن يحلّ تناقضات القرآن، ويعود بالموضوعيَّة إليه حتَّى يصبح متَّسقًا مع ما ورد في الإنجيل من أنَّ أهل الجنَّة لا يُزوَّجون ولا يتزوَّجون.
عندما أثبت لكسنبرغ أنَّ المعنى المشهور لـ«الحور العِين» غير مناسب، يباشر الخطوة التالية للكشف عن معناه الصحيح، فيقول: يكمن الجواب في فواكه الجنَّة؛ ففيها النخل والرمَّان، وكذلك العنب. لم يُذكر العنب على أنَّه من فواكه الجنَّة إلَّا في آية واحدة، بينما ذُكر من فواكه الدنيا في ما يربو على عشر آيات، وهذه نقطة مهمَّة لتشخيص المعنى الاستعاريّ لـ«الحور العين». وإذا كان العنب أحد العناصر الضروريَّة للبساتين الدنيويَّة، ويُسمِّيها القرآن الجنَّة -وهي كلمة سريانيَّة-آراميَّة (ܓܢܬܐ) (گنتا gannta) دخيلة على العربيَّة- فلا بدَّ من توفُّره بأعلى
جودته في الجنَّة الأخرويَّة بطريقة أولى. فثمَّة شبهة ما في ذكر العنب في معظم الجنَّات الدنيويَّة، مع عدم ذكره إلَّا مرَّةً واحدةً في الجنَّة الأخرويَّة!
لا يزال لكسنبرغ ملحًّا على أنَّ صورة الجنَّة وحوريَّاتها في القرآن مقتبسة عن مصدرٍ سريانيٍّ-آراميّ؛ فاختار -هنا- «أفرام» الراهب والشاعر المسيحيّ الذي كثيرًا ما كان يُنشد في الجنَّة، محاولًا القول إنَّ محمَّدًا [ص] قد اتَّبع هذا الراهب وأخذ عنه في تصويره للجنَّة ونعيمها. فيؤيِّد دعواه بما قاله المستشرق «آندرا» حول أهمِّيَّة أشجار العنب في الجنَّة عندما أراد أن يُثبت اقتباس القرآن من [ذلك الكتاب] السريانيّ المسيحيّ؛ لأجل المشابهة بينهما في تصوير الجنَّة؛ لكنَّه يدافع -أيضًا- عن الإشارة إلى أبكار الجنَّة في ترانيم «أفرام». ثمّ ينقل تعليقًا عن المستشرق «بيك» على ما قاله «آندرا» عن وجود الحوريَّات بعد أن يذكر ترجمةً عن كتاب «أفرام»: «من تجنَّب عن الخمر، تحنّ إليه أشجار العنب في الجنَّة، تقرّب إليه عناقيدها المتدليَّة، ومن عاش عفيفًا يحتضنَّه في أحضانهنَّ الطاهرات؛ لأنَّه كان كراهبٍ لم يقع في حبِّ الدنيا»، فيقول: اكتفى بيك بالقول إنَّ الذي كان في كتاب «أفرام» هو مجرَّد سؤال عن أشجار العنب في الجنَّة، ولا يعني هذا أبكار الجنَّة؛ لكنَّه لم يتقدَّم إلى الخطوة التالية التي يبيّن بها لآندرا أنَّ العلاقة على العكس، أيْ أبكار الجنَّة -طبقًا لما قاله أفرام- هي نفس الأعناب. والقرآن لا يزيد على هذا التعبير الاستعاريّ (الحور العِين) إلَّا أن يعرِّفه من الفواكه ذات الجودة العالية في الجنَّة، ويؤكِّد عليها بين الفواكه الأخرى، فليس هذا إلَّا ما قاله «أفرام»، أيْ الأعناب.
ثمَّ يبذل لكسنبرغ قصارى جهده؛ ليُثْبِت أنَّ «الحور العين» لا تعني إلَّا الأعناب. ففي بادئ الأمر يلفت إلى نقطةٍ ـ يريد أن نأخذها بعين الاعتبار ـ وهي أنَّ لفظة «ܓܘܦܢܐ» (گوپنا gupna) (أي الكَرْم)» التي استخدمها «أفرام» في ترانيمه هي كلمة مؤنَّثة في السريانيَّة-الآراميَّة، وهي ما دلَّت «آندرا» إلى أن يرى فيها تلميحًا إلى أبكار الجنَّة، كما سبَّبت في خطأِ المفسِّرين العرب في هذا الافتراض المقيت. ومن ثَمَّ يتناول هو دراسةً مقارنةً ثالثة بين هذه الكلمة -التي تتعلَّق بالأدب السريانيّ المسيحيّ في القرن الرابع الميلاديّ- وبين كلمة الحور -التي تعود إليها صفة العِين- فيقول: هذه الكلمة [أي العين] تنعت الأعناب ذاتها، وقد ذُكرت في القرآن مرَّتين مفردةً وتسع مرَّات بصيغة الجمع (والمفرد المؤنَّث لها في السريانيَّة الآراميَّة: «ܥܢܒܬܐ» (عنبتا enbte). وهنا يتَّضح بجلاء -من خلال تعابير استعاريَّة أخرى في القرآن تقارن الأعناب [يقصد الحور العين] باللؤلؤ- أنَّ البياض لا يرتبط بالعَين [بل بالأعناب]، ثمَّ يستند إلى معنىّ يقدِّمه معجم لسان العرب لمفردةٍ متقاربةٍ إلى الحور وهي «البيضة: عنب بالطائف أبيض عظيم الحَبّ»؛ ليُثبت أنَّ العنب قد يكون أبيض. وأخيرًا، ينقل المعنى الذي ورد في معجم «تِزاروس» السريانيّ لكلمة «ܚܘܪܐ»، (حورا hewwara) مؤنّثها: ܚܘܪܬܐ (حورتا hewwarta) «ضربٌ من العنب الأبيض» الذي يراه منسجمًا مع ما تقدَّم.
يقترح لكسنبرغ حلَّيْن لمعضلة معنى «العين»:
الحلّ الأوَّل: ادِّعاؤه أنَّ الأمثلة السابقة تنقض خيال الأبكار في الجنَّة؛ لأنَّ القرآن لم يُشِر إليهنّ؛ بوصفهنّ مدلولًا للحور (أي الأعناب)، بينما الأعناب ذُكرت مرارًا في البساتين الدنيويَّة. وهذا جعله يستنتج أنَّ «الحور» بديلًا عن الأعناب، وأنَّ معنى «العِين» -التي قد تكون صيغة الجمع- ليس ذوات الأعين الواسعة. وبما أنَّه أثبت
أنَّ البياض يتعلَّق بمظهر الأعناب، أخذ يبحث عن معادلٍ لـ« العِين» في السريانيَّة-الآراميَّة؛ حتَّى يتناسب مع مواصفات الأعناب البيض.
وما يختاره لكسنبرغ من معجم «تزاروس» هو الشرح الذي يعطى للفظة «ܥܝܢ» وهو: المظهر واللون، وهو الشرح الذي يقدِّمه معجم «منّا» أيضًا. ومن ثَمَّ ينقل مستغربًا الشرحَ العربيَّ الذي ورد في معجم لسان العرب، وهو قريب من الشرح السريانيّ ـ الآراميّ السابق، وهو: عين الرجل مظهره، كما ورد بعد ذلك، عين الشيء النفيس منه؛ إذًا، اتَّضح معنى لفظة «العِين»، وهو أنَّها اسم جاء بدلًا من الحور ولها دور في الوصف؛ فإن كانت مفردةً فمعناه [ذو] مظهر باهر، وإن كانت صيغة جمع فمعناه الكنز [أي الثمين]، والراجح هو أن تكون مفردةً جمعها العيون، وهذا يستلزم أن تكون «العِين» لفظةً مفردةً مأخوذةً من «ܥܝܢܬܐ» (عينتا aynta) السريانيَّة-الآراميَّة. وقيل: إنَّ اللغويِّين السريان يفرِّقون بين «ܥܝܢܐ» (عینا ayna) و«ܥܝ̈ܢܐ» (عینه ayne)؛ فالأوَّل يُستخدم للأحياء، والثاني للأشياء. ورسمُ الكلمة العربيَّة المأخوذة من «ܥܝ̈ܢܐ» عند الوقف من اختلافات مصحف أُبَيْ [بن كعب] في الآية الثانية والعشرين من سورة الواقعة.
الحلّ الثاني: يتمثَّل في النظر إلى مقارنة القرآن بين البيض [يقصد الحور] واللؤلؤ؛ لتبيين المدلول الحقيقيّ لـ «العِين». فيقول: نضع إشراق المجوهرات نقطة الانطلاق، ونرى معنى «ܥܝܢ»(عين in ) السريانيَّة ـ الآراميَّة انتقل إلى المجوهرات وفقًا لمعجم «تزاروس». وبما أنَّ القرآن يقارن الأعناب باللؤلؤ، فليست [العِين] المجوهرات الحقيقيَّة، فنرجِّح معناه البديل في معجم «تزاروس»، وهو البِلَّوْر (لأنَّه شفافٌ لامع) أو الحجر الكريم؛ تفسيرًا للنَفاسة، ويؤيِّده ما تقدَّم من لسان العرب: عين الشيء النفيس منه. وبما أنَّ «الحور» الذي استُخدم للبيض جمعٌ، فمن المنطقيّ أن يكون «العِين» جمعًا، وهكذا يتلاءم مع القراءة التقليديَّة للقرآن. وحصيلة البحث هي أنَّ الحور العِين يعني البِلَّوْرات البيض [من العنب]. وبعد هذه الجهود
المضنية، يفتخر لكسنبرغ بعمله، فهو يدَّعي إبطال خرافة حوريَّات الجنَّة، وإعادة التناسب إلى آيات القرآن.
وعندما يرى لكسنبرغ عمله يسير على قدمٍ وساق، يبدأ بوضع اللمسات الأخيرة في تبرير التعابير الأخرى الواردة في القرآن التي توهم تصوُّر الحوريَّات؛ معدِّلًا فهمها إلى أنَّها نعوتٌ أخرى لتلك البِلَّوْرات البيض من العنب، وليست الأبكار في الجنَّة. فيستهلّ بالآية (وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُّطَهَّرَةٌ) التي تُرجمت -على حدِّ قوله- خطأً، ويقول: لم تُستخدم لفظة الزوج في القرآن لزوج الإنسان فحسب، بل استُخدمت بمعنى الفصيلة والجنس للحيوانات والنباتات أيضًا؛ فقد استخدمت في جميع الكائنات الحيَّة في (وَالَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا وَجَعَلَ لَكُم مِّنَ الْفُلْكِ وَالْأَنْعَامِ مَا تَرْكَبُونَ)، بينما استُخدمت في خصوص نبات الأرض في (فَأَنبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ) . ولقد أصاب «بارت» -بحسب لكسنبرغ- في ترجمته هذه الآية إلى اللغة الإنكليزيَّة؛ باستعماله مفردة «الأنواع» معادِلًا لها. وبما أنَّ الجنَّة القرآنية تتكوَّن من الأشجار والنباتات والفواكه، فالأزواج المطهَّرة تعني الأنواع الطيِّبة [من الفواكه] .
أمَّا التعبير الثاني الذي يسعى لكسنبرغ إلى تجديد فهمه، فهو: «قاصرات الطرف عين»، وترجمته الصحيحة -بزعمه- طبقًا للقراءة السريانيَّة-الآراميَّة، هي: الفواكه (الأعناب) المتدلِّية؛ إذ يقول بالنسبة إلى «الطَرف»: «بعد أن أُثبِتَ عدم الحوريَّات، لا معنى للتحدُّث عن عيونهن، كما فُهم هذا التعبير مسبقًا في العربيَّة بقصر النظر إلى الأزواج؛ لكن المنشود هو معنى يتناسب مع الأعناب. المرادفُ السريانيُّ-الآراميُّ
لـ «الطَرف» هو «ܛܪܦܐ» (طرپا tarpa) الذي يشرحه معجم «تزاروس» بـ: «قطف أوراق الأعناب»، ويضرب في شرحه المثل القائل: «ܘܠܐ ܕܢܛܪܦ ܟܪܡܐ» (ولا دنطرپ کرما wala da-ntarrep karma) أيْ لنقطفْ الكَرْم، ويشرحه معجم «منّا» بـ: «قطف، قطع، جني الورق والثمر»، وهو المعنى نفسه الذي يفيده معجم السريانيَّة الشرقيَّة الحديثة، أيْ: الورق، والغصن الصغير. وهذا يدلُّ على أنَّ معنى الطرف هو الأغصان الصغيرة الممتلئة بالأوراق والأعناب، وربَّما يعني القطف، كما يقول القرآن: إنَّ قطوف الثمار دانية. وبعد أن تبيَّنَ معنى الطرف، يسهل فهم «القاصرات»، إذ يزوِّدنا معجم «منّا» بمعنى «قصر، خفض» للفظة «ܩܨܪ» (قصر qsar)، وهو قريب ممَّا فهمه المفسِّرون للقرآن؛ لكنَّه يعني المنخفض، ولا يرتبط بالأعين بل يصف الأغصان. وعليه يُفهم أنَّ المقصود من قاصرات الطرف هي الأغصان المنخفضة التدلِّي [الممتلئة بالثمار]. والمفردة الأخيرة هي «عِين»، وهي صيغة جمعٍ في السريانيَّة-الآراميَّة، وسقوط [علامة الجمع] منها بسبب الخطأ في كتابتها. هذا، إلى جانب معنى اللمع أو الإشراق للمجوهرات، قد تُستخدم هذه المفردة للمجوهرات نفسها. وبناءًا على ما تقدَّم، سيُفهم التعبير المذكور بالآتي: الثمار (الأعناب) المتدلِّية [كـ] المجوهرات.
ثُمَّ يتطرَّق لكسنبرغ إلى الآية التالية التي استُخدمت فيها البِيض لنعت قاصرات الطرف، وبعد أن يستحسن ترجمة «بلاشر» و«بل» اللذَين ترجماها باللؤلؤ، يلفت إلى ما ورد في تفسير الطبريّ وأنَّ معظم المفسِّرين عرَّفوها بالبيض غير المكسورة. ثُمَّ يقول: إنَّ البيض اسم [جنس] جمعيّ كاللؤلؤ، وقد سُجِّل للمؤنَّث منها [يعني البَيضة] في معجم لسان العرب معنى اللون الأبيض مشيرًا إلى ضربٍ من العنب. ويقول لكسنبرغ: مرَّة أخرى نجد هذا المعنى عند مراجعة السريانيَّة الآراميَّة؛
فمعجم «تزاروس» يستخدم كلمتي «ܒܪܘܠܐ» (برولاberulla) و«ܒܪܘܠܚܐ» (برولحا berulha) (أي اللؤلؤ أو البِلَّوْر) بمعنى الأبيض. والنتيجة هي أنَّ مراد القرآن من البَيض هو [اللؤلؤ] الأبيض الذي يوافق السريانيَّة-الآراميَّة.
والمفردة التالية التي يطمح لكسنبرغ إلى تجديد قراءتها وفهمها هي «أتراب» في قوله -تعالى- ( وَعِندَهُمْ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ أَتْرَابٌ ) . يعتقد لكسنبرغ أنَّ هذه المفردة كانت فاعلةً أكثر من غيرها في خيال الحوريَّات؛ إذ فرضوهن مغريات، ويبقى مؤشِّرٌ ينقُصْنَه وهو أن يكنَّ شابات، وهذا الفهم الخاطئ أدَّى إلى ترجمتها [أي الأترابَ] إلى «في سنّ واحدة» ويُستنتج منه أنَّهنَّ شابات دائمًا، وقد أضاف بعض المفسِّرين أنَّهنَّ يبلغن من العمر ثلاثة وثلاثين (٣٣) سنة. ثمَّ يوضح لكسنبرغ العلَّة التي من أجلها أخطأ المفسِّرون في فهم لفظة «أتراب»، وهي أنَّ فكرة الحوريات جعلتهم لا يفكِّرون في أيِّ شيءٍ غيرها، وأغمضوا عن السياق القرآنيَّ؛ لأنَّ الآية ٥٤ من السورة نفسها تقول عن الحوريات: (إِنَّ هَٰذَا لَرِزْقُنَا مَا لَهُ مِن نَّفَادٍ) وهي تعني أنَّه ليس في الجنَّة إلَّا الأطعمة والأشربة. ويؤيِّد رأيه هذا بما يقوله القرآن للمتقين: (كُلُوا وَاشْرَبُوا )، وبأنَّ السور المدنيَّة المتأخِّرةلم تَعِد المؤمنين إلَّا بـ(جَنَّاتٌ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ)، وبأنَّه حتَّى الذين قُتلوا في سبيل الله لم يوعدوا بالحوريَّات بل وُعِدوا بالرزق عند ربِّهم. ويستنتج لكسنبرغ قائلًا: إنَّ لفظة «أتراب» لم يصف بها القرآن إلَّا تلك الفواكه التي برهنَّا على صحَّتها من خلال المعاجم السريانيَّة-الآراميَّة. وهنا يحاول الكشف عن المعنى الصحيح للفظة «أتراب»، فينقل الشرح الوارد في معجم «تزاروس» لكلمة «ܬܪܒܐ» (طرپا tarpa) ويقول: تعادلها كلمة «الثرب» المعرَّبة (وهي غير مستخدمة بعدُ) وهي تعني الضخم أو لبّ الفاكهة،
وكذلك صفة «ܬܪܒܢܝܐ» (تربینا tarbanaya) التي تعني الطازج. وكذلك يستفيد من معجم «منّا» في شرحه لـ«ܬܪܒܐ» (تربا tarba) معنىً قريبًا ممَّا تقدَّم وهو «شحم الرمان وغيره من الثمار». وعليه، فالآية السالفة الذكر تُترجم -بحسب لكسنبرغ- إلى: عندهم فواكه نضجة (طازجة) متدلِّيَة.
هذا، وينتقل لكسنبرغ إلى كلمة «الطمث» محاولًا تعديل فهمها السابق. فهي قد تُرجمت حسبما اقترحه الطبري بـ«الجماع». وبعد أن يُشدِّد على أهمَّيَّة الفهم الصحيح لهذه الكلمة للبلوغ إلى الغاية، يلوم الذين أغمضوا عن الجذر الفعليّ لمفردة «الطمث» في العربيَّة، ومن ثَمَّ يقول: زعم اللغويُّون العرب أنَّ لاحقة «ܐܬ»
(ـِت et) السريانيَّة-الآراميَّة للاسم المؤنَّث في صفة «ܛܡܐܬܐ» (طماتا tmata) هي جزءٌ من جذرها، بينما فعل «طمث» العربيّ جاء مشتقًا منها. وهذا لم ينشأ من «طامث» أي اسم الفاعل في العربيَّة فحسب، بل وكذلك من فعل «ܛܡܐ/ܛܡܐܐ» (طما tamma) السريانيّ ـ الآراميّ، لكن في معنى آخر. وبينما لم يرد معنى جذر «طمئ» العربيّ في معجم لسان العرب، تعطي القواميس السريانيَّة شرحًا له من منظورٍ إتيمولوجيّ. وهذا يدلّ ـ بحسب لكسنبرغ ـ على أنَّ هذه الكلمة دخيلة على العربيَّة. ولمّا كان معنى هذا الجذر في السريانيَّة ـ الآراميَّة هو «النجاسة»، وهو معنى مرتبطٌ بالحيض وبالدم طبعًا، فإذا قالت المرأة: أنا طامث، يُفهم في العربيَّة: أنا ملطَّخة بالدم، وفي السريانيَّة-الآراميَّة: أنا نجسة. وقد جرى -وفق لكسنبرغ- استخدام هذا المعنى في العربيَّة؛ ولذلك أصبح بمعنى الجماع. وبعد عقد مقارنة بين معجم لسان العرب ومعجم «تزاروس» حول مفردة (الطمث) يستنتج لكسنبرغ أنَّ المتبادر من تصوُّر الدم في المتخيّل العربيّ هو معنى الجماع، بينما يفهم الشخص في السريانيَّة الآراميَّة منه معنى التلويث والتدنيس. ومن ثَمَّ يرى لكسنبرغ أنَّ الفعل «لم يطمثهن» قد استخدم في القرآن متعدِّيًا نتيجةً لهذا الفهم الخاطئ، ولم يُفهم منه غير هذا المعنى [من فعل «طمث»] بسبب الحوريات المزعومة، مع أنَّ معناه في السريانيَّة-الآراميَّة هو التدنيس والتلويث.
بعد هذه المحاولة شرع في بيان سبب هذا الفهم الخاطئ، فقال: ما جعل المفسِّرين العرب أن يزعموا الأعنابَ النساءَ هو ضمير «هنّ» [في: لم يطمثهنّ] الذي يُطلق على جمع المؤنِّث لذوي العقول، بينما القرآن لا يُلاحظ هذا الفارق دومًا، وفقًا للقواعد السريانيَّة-الآراميَّة. وهو يقصد بقوله هذا أنَّ ضمير «هنَّ» يستخدم لغير ذوي العقول أيضًا، ويستشهد لذلك في الهامش بقوله -تعالى-: (يَأْكُلُهُنَّ سَبْعٌ عِجَافٌ) .
وختم لكسنبرغ بأنَّ الفهم الصحيح لكلمة (الطمث) هو المعنى الذي ذكره الطبريّ، وهو (اللمس)، وهذا المعنى -على حدِّ قوله- يتوافق ويتناسب مع فكرة الأعناب البيض؛ لكنَّه في فكرة الحوريَّات يعتبره من لطف التعبير.
ثمَّ يعالج لكسنبرغ الآيتين الآتيتين: (فِيهِنَّ خَيْرَاتٌ حِسَانٌ ﴿٧٠﴾ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿٧١﴾ حُورٌ مَّقْصُورَاتٌ فِي الْخِيَامِ) . وبعد أن يستشكل على ترجمة المترجمَيْن الأوروبيَّيْن «بِل» و«بارت» لفهمهم الأبكار الجميلات من الآيتين، يقوم بتعديل الفهم الباطل، قائلًا: صفة «خَيرات» (ومن الأفضل أن تُقرأ: خيِّرات) تعادل «ܓܒܝܬܐ» (گبیتا gabyata) في السريانيَّة-الآراميَّة، ومعنى ذلك في معجم «تزاروس»: المختار، وفي معجم «منّا»: طاهر، كريم، خيار الشيء. والمعنى المراد من «خيرات» هو الأخير؛ والطاهر هو المعنى الحقيقيّ لـ«أزواج مطهَّرة»، والكريم -الذي جرى استخدامه في سياقٍ مماثل [يقصد: رِزْقٌ كَرِيمٌ] يؤيِّد ذلك.
ثُمَّ يعتني بالصفة التالية، وهي «الحسان»، فيقول: لتُدرك هذه الصفة مرادفةً للأولى، إنَّ لمعادلها في السريانيَّة-الآراميَّة «ܛܒܐ» (طبا taba) معنى سواء، كما يشرحه معجم «منّا» بهذه المعاني: «خيّر، حسن، كريم». فالتعبير السريانيّ-الآراميّ يبرِم معادله في العربيَّة (أيْ خيرات حسان) الذي ورد في القرآن بمعنى «المختار، الممتاز». وعليه، يرى لكسنبرغ أنَّه يجب فهم آية (فِيهِنَّ خَيْرَاتٌ حِسَانٌ) على الوجه الآتي: فيهنّ [فواكه] مختارة ممتازة.
أمَّا آية (حُورٌ مَّقْصُورَاتٌ فِي الْخِيَامِ) ، فلا يرى لكسنبرغ صعوبةً في توجيهها وفق ما يريده؛ إذ يرى أنَّ «الخيمة» هي واحدة (الخيام)، ومعناها: التعريشة. وبسهولة يستنتج ترجمة هذه الآية بـ: الأعناب البيض المتدلِّية في التعريشات. والأمر المثير للاهتمام هو أنَّ هذا الكلام يماثل ما قاله «أفرام» السريانيَّ: إنَّ أعناب الجنَّة متوفِّرة للصالحين.
لم تبقَ أمام لكسنبرغ سوى مفردات أخرى قليلة ليُقدِّم فهمها الحديث، ولينقذ العلماء المسلمين -على حدِّ تعبيره- من مزاعمهم بالنسبة إلى حوريَّات الجنَّة. فيأتي -هنا- إلى الآيات الآتية من سورة الواقعة: (وَفُرُشٍ مَّرْفُوعَةٍ ﴿٣٤﴾ إِنَّا أَنشَأْنَاهُنَّ إِنشَاءً ﴿٣٥﴾ فَجَعَلْنَاهُنَّ أَبْكَارًا ﴿٣٦﴾ عُرُبًا أَتْرَابًا)، حيث يواصل نهجه مستهلًّا بكلمة الفُرُش، ويقول: هو جمع في العربيَّة، ومعناه: «الفراش، السرير أو السجاد» وفي هذا المعنى يشابه كلمة «ܦܪܣܐ» (پرسا prasa) في السريانيَّة-الآراميَّة وقد اشتقَّت منها، وفق المعنى الذي يقدِّمه معجم «منّا»، وهو: «خيمة، مظلّة». فمن الممكن -بحسب لكسنبرغ- فهمها بالمعنى المتقدِّم الذي اختاره للفظة «خيام». ومع صفتها أيْ «مرفوعة» ترجم الآية بـ: تعريشات مرتفعة للأعناب.
ثمّ بالنسبة إلى الفعل «أنشأ» اقترح معادِلًا له من السريانيَّة-الآراميَّة، وهو كلمة «ܐܘܝܝ» (أوي awi) (أو مرادفها: «ܐܫܘܚ» (أشوح aswah)، التي يشرحها معجم «منّا» بـ: «أنبت، أخرج». وعليه، يفهم لكسنبرغ آية (إِنَّا أَنشَأْنَاهُنَّ إِنشَاءً) بمعنى: نحن أنبتناها.
لا يزال لكسنبرغ ملحًّا على إثبات مدَّعاه إلى جانب تخطئة فهم المفسِّرين المسلمين، فيقول: يبدو من آية (فَجَعَلْنَاهُنَّ أَبْكَارًا) أنَّ الله قد خلق الحوريَّات
أبكارًا، لكنَّ كلمة «بكر» ليست بمعنى «عذراء»، لا في العربيَّة ولا في السريانيَّة-الآراميَّة، بل تعني «العمل الأوَّل» وكذلك «المولود الأوَّل». لكن لها معناها الخاصّ في السريانيَّة-الآراميَّة الذي ينسجم هنا، وهو المعنى الذي يقدِّمه معجم «منّا» في شرحه لكلمة «ܒܟܪܐ» (بكرا bakkara)، وهو: «باكورة، أوَّل الثمر خاصَّة». ولذلك استنتج الشرط المسبق لفهم جميع الموارد المذكورة، وهو أنَّ هذه الفواكه طازجة، ومعنى الآية حينئذٍ هو: نحن خلقناها؛ كالثمار الأولى.
وهكذا يتابع كلامه في الآية الأخيرة (عُرُبًا أَتْرَابًا) فيقول: أمَّا وقد زُعم أنَّ الله خلق الحوريَّات ممتعات بشكلٍ عاطفيّ أو في سنٍّ واحدة، فليس من الغريب أنَّه لم يتأمَّل أحدٌ في كلمة «عُرُب»؛ لأنَّها قد قُرئت خاطئةً، لكنَّها تُقرأ صحيحةً في السريانيَّة-الآراميَّة: «ܥܪ̈ܝܐ» (عريه arraye) (أي البارد، البرد الصقيع)، ويجب أن تُقرأ في العربيَّة: «عرَيا». وعليه، يرى أنَّ الصحيح أن تُفهم هذه الآية وفق الآتي: إنَّ فواكه الجنَّة ممتازة وكذلك مثلّجة. ويؤيِّد مدَّعاه هذا بما ورد في سورة الواقعة نفسها من أنَّ أصحاب النَّار يستلمون ما هو (لَّا بَارِدٍ وَلَا كَرِيمٍ).
وآخِر آية يعمل لكسنبرغ على تعديل فهمها هي قوله -تعالى- (وَكَوَاعِبَ أَتْرَابًا) ، وتحديدًا كلمة «كواعب» التي تعني ذوات الأثداء الكبيرة، بينما يرى هو أنَّ الإشارةَ إلى صدورهنّ دون ذكر أنفسهنّ محطّ غرابة، ثمَّ يفاجئ القارئ بكلامه أنَّ لفظة «كواعب» عربيَّةٌ، لكنَّ ترجمتها خاطئة. وبعد ذلك نقل الإجماع الذي أورده الطبري من أنَّ معناها النساء العظيمات الصدر، وكذلك ما أورده لسان العرب في معنى الفعل «كَعَبَ»: كعب الإناء وغيره ملأه. واعتبر أنَّ هذه الترجمة لا تليق بالقرآن، ولا تتناسب مع معنى (الطازجة) الذي رجَّحه لكلمة «أتراب»، وأنَّه إذا
كانت كلمة «أترابًا» نعتًا للفواكه والأعناب، فهذا يناسبه أن تكون كلمة «كواعب» نعتًا آخر لفواكه الجنَّة، وهي تُحمل على أوانٍ مفعمة بها. وكعادته يحاول تأييد مدَّعاه بآية من القرآن، فيشير -هنا- إلى الآية ٧١ من سورة الزخرف والآية ١٥ من سورة الإنسان، الآيتين اللتين تلفتا إلى الصِّحاف والأكواب والآنية، بينما تلفت الآية ٣٤ من سورة النبأ إلى الكأس فقط دون الصِّحاف. وبهذا يرى أنَّ الفهم الصحيح لهذه الآيات هو أنَّ في الجنَّة فواكهَ طريَّةً عصيريَّةً وكؤوسًا ممتلئة [من الخمر].
وفي آخر المطاف، يُعبِّر لكسنبرغ عن رأيه البديع حول فكرة الحوريَّات، ويدَّعي أنَّ دراسته من المنظور الفيلولوجيّ تُثبت أنَّ تأريخ وضعها يعود إلى القرن التاسع أو العاشر الميلاديّ لدى مفسِّري القرآن.
تقدَّمت في ما سبق أهمّ دعاوى لكسنبرغ، وتبيَّن أنَّه يعتقد بأنَّ بعض آيات القرآت قد قرِئت قراءة خاطئة أو فُهمت فهمًا خاطئًا، ما دفعه إلى تعديل هذه الأخطاء التاريخيَّة المستمرَّة عند العلماء المسلمين منذ أمد بعيد، وإلى إعادة تصحيح قراءة هذه الآيات أو تصحيح فهمها.
وقبل الشروع في الردّ على دعاويه هذه التي لا تخلو من تجاهل لحقائق كثيرة، نقدِّم ملخَّصًا عن منهجه الذي يسير عليه في إصلاح الأخطاء الواردة في القرآن وتفاسيره بحسب زعمه، ومن ثمَّ دراسة دعاويه دراسةً فيلولوجيَّة، وتوجيه انتقاداتٍ إليها مبنيَّة على أساس معاجم اللغات الساميّة، وكذلك دراسة أشعار العرب قبل الإسلام، مضافًا إلى مطالعة السياق القرآنيّ للآيات موضع البحث؛ لنتبيَّن
ما إذا كان السياق يقبل -فعلًا- ما قاله لكسنبرغ أو لا؟ وبعد ذلك نذكر جملةً من الروايات الواردة عن الأئمَّة المعصومين عليهمالسلام؛ نقدًا لما قاله لكسنبرغ، ومن ثمَّ نتطرَّق إلى المصادر التي راجعها لكسنبرغ وندرس مدى اعتبارها. وفي الختام نشير إلى بعض الانتقادات التي وجَّهها المستشرقون الآخرون إلى لكسنبرغ ومزاعمه، وبالتالي نقيِّم محاولته في فكِّ رموز القرآن.
تحدِّد منهجيَّة كلِّ مؤلِّف مسارَه نحو النتائج التي يتوصَّل إليها، وللمنهجيَّة علاقةٌ وثيقةٌ بصحَّتها أو بطلانها. فتجدر الإشارة إلى منهجيَّة لكسنبرغ في تعديل قراءة الآيات أو فهمها قبل البدء بالنقد على أيِّ أساس آخر. ومن نافلة القول: إنَّ لكسنبرغ ليس أوَّل من شمَّر عن ساعديه في الكشف -كما يزعم- عن أصول القرآن؛ فادِّعاء أصلٍ غير إلهيٍّ للقرآن ادِّعاء قديم قِدَمَ نزولِ القرآن؛ فقد لفَّق المشركون التُّهم لرسول الله صلىاللهعليهوآله بأنَّ اليهود يعينونه على ما يقول، وأشار القرآن الكريم إلى مقالهتهم هذه في قوله -تعالى-: (وَأَعَانَهُ عَلَيْهِ قَوْمٌ آخَرُونَ) . وقد اكترث جمٌّ غفيرٌ من المستشرقين بدراسة أصول القرآن، مفترضين أنَّه تلفيقٌ من عناصر الثقافة السائدة في البيئة العربيَّة أو كتب اليهود والنصارى. وفي ما يأتي عرض موجز لأبرز المؤلَّفات في هذا المجال.
أوَّل من حاول أن يُثبت أصلًا يهوديًّا للقرآن هو المستشرق الألمانيّ «آبراهام غايغر» في كتابه: «ما أخذه محمَّد من اليهوديَّة؟» الذي كان له عظيم الأثر في عصره؛ بما قدَّمه المؤلِّف من رؤيةٍ متطرِّفةٍ إلى إسهام اليهود في القرآن. وجاء
بعده المستشرق «فيليام موير»، مؤلِّف كتاب: «حياة محمَّد»، الذي كان يرى أنَّ جزءًا كبيرًا من الإسلام مقتبسٌ من المسيحيَّة. ثمّ تبعهم «تيودور نولدكه» في كتابه: «تاريخ القرآن»، حيث عقد بابًا لإنكار نبوَّة رسول الله صلىاللهعليهوآله وعَزْا تعاليمه إلى اليهود والنصارى. وفي أواخر هذا القرن ألَّف «هارتويغ هيرشفلد» رسالةَ دكتوراه بعنوان: «العناصر اليهوديَّة للقرآن». ومن مدعاة التعجُّب هو أنَّ محاولات المستشرقين اليهود في القرن التاسع عشر كانت تهدف إلى وضع الإسلام إلى جانب اليهوديَّة في صفٍّ واحد في معارضة المسيحيَّة، وحتَّى نهاية هذا القرن لم يُطلق الاستشراق نفسه من الخلفيَّة الدينيَّة إلَّا قليلًا.
وظلَّت فكرة عدم أصالة الإسلام واقتباسه من الأديان السابقة سائدةً بين عموم المستشرقين في القرن العشرين، لكنَّ دراساتهم في هذا القرن اتَّجهت نحو المقارنة بين ما في القرآن من المصطلحات، والقصص، والمعتقدات وما يشاكلها في التعاليم المسيحيَّة واليهوديَّة. ويمكن الإشارة إلى أهمّ المؤلَّفات في هذا المجال وهي: «مصادر
القرآن الأصليَّة» للقسِّ المبشِّر المسيحيّ «ويليام تيزدال»، و«محاضرات حول الإسلام» للمستشرق المَجَري «إجناس جولدتسيهر»، و«العناصر اليهوديَّة في أجزاء القرآن الروائيَّة» للمستشرق البولنديّ «إسرائيل شبيرو»، و«اعتماد القرآن على اليهوديَّة والمسيحيَّة» للمستشرق الألمانيّ «ويلهلم رودولف»، و«أسماء العلَم اليهوديَّة ومشتقَّاتها في القرآن» للمستشرق الألمانيّ اليهوديّ «يوزف هروفيتس»، و«قصص العهدين في القرآن» لتلميذه «هنريش شباير»، و«شخصيَّات الكتاب المقدَّس في القرآن» للمستشرق الإسكتلندي «جان والكر»، و«الأساس اليهوديّ للإسلام» لعالِم الآثار الأمريكيّ «تشارز توري»، و«أصول الإسلام في بيئته المسيحيَّة» للمستشرق البريطانيّ «ريتشارد بل»، و«اليهوديَّة والإسلام: الخلفيَّة العهدينيَّة والتلموديَّة للقرآن وتفاسيره» للمستشرق الأمريكيّ «آبراهام كاتش»،
و«محمَّد» للمؤرِّخ البريطانيّ «ميخائيل كوك». وأخيرًا، تجدر الإشارة إلى الأب «يوسف درَّة الحدَّاد» الذي انكبَّ -زهاء عشرين سنة- على تأليف مجموعةٍ من الكتب؛ ليُثبت نصرانيَّة دعوة القرآن، وكذلك الكاتب الهنديّ العَلماني المعروف بـ«ابن ورّاق» الذي ألَّف مجموعةً من الكتب ضدَّ الإسلام، من أهمِّها: كتاب «مصادر القرآن». والكتب والمقالات في هذا المجال كثيرة جدًّا، لا تتَّسع هذه العجالة لذكرها.
تُظهر دراسة مسار تأليف الكتب والمقالات على مرِّ التاريخ أنَّ دعوى اقتباس القرآن من اليهوديَّة والنصرانيَّة تغيَّرت من رؤية جدليَّة إلى رؤية أكاديميَّة، وقد ألزم المستشرقون أنفسهم بأن يثبتوا دعاويهم وفقًا للمعايير العلميَّة، وانتقادات المستشرقين أنفسهم بعضهم على بعض من نتائج هذه الرؤية العلميَّة. وكانت دراسات علم اللسانيَّات الرؤية السائدة في هذا المجال، لكنَّ هذه الدراسات تسير نحو زيادة التقارب من رؤية المسلمين حول القرآن الكريم ومصدره الإلهيّ، وقليلًا ما نجد مستشرقًا يدَّعي دعوى الاقتباس في العصر الراهن.
من هنا، اتَّضح بجلاء أنَّ مبنى لكسنبرغ (أيْ الأصل المسيحيّ للقرآن) لا يختلف عمَّا كان بصدده أسلافه من المستشرقين، عندما سعوا في إثبات اقتباس القرآن
من التوراة والإنجيل وغيرهما؛ استنادًا إلى موافقته مع بعض مواضيعها، لكنَّ المسلمين يرون أنَّ سبب هذه الموافقة هو صدورها جميعها من مصدرٍ واحد لا أخذَ بعضِها من بعض ولا عن صدفة. ومضافًا إلى ذلك، فإنَّ القرآن الكريم يصف نفسه بالمهيمن على الكتب السماويَّة الأخرى، وهو قوله -تعالى-: (وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ)، وتبيِّن الهيمنةُ أنَّ للقرآن الكريم سماتٍ من قبيل: المرجعيَّة، والجامعيَّة، والسيطرة على الكتب السماويَّة الأخرى، وأنَّه مرجعٌ يلجأ إليه الخصماء، وفيصلٌ حاكمٌ تُختم عنده الأشياء.
ونهدف في هذا الكتاب إلى الردِّ على ما امتاز به لكسنبرغ عن غيره، ألا وهو منهجيَّته الغريبة في إعادة فهم النصّ القرآنيّ والنتائج التي تترتَّب عليها. يمرّ لكسنبرغ بالمراحل الآتية واحدةً تلو الأخرى؛ ليصل -على حدِّ قوله- إلى الفهم الصحيح من المفردات القرآنيَّة:
ـ الخطوة الأولى: هي فحص تفسير الطبريّ؛ بحجة أنَّ فيه بعض النقاط التي أغمض عنها مترجمو القرآن إلى اللغات اللاتينيَّة
ـ الخطوة الثانية: تتمثَّل بالرجوع إلى معجم لسان العرب؛ بغية تبيينٍ أوضح للمفردات؛ فإنَّ الطبريّ والمفسِّرين المتقدِّمين لم يراجعوا القواميس قطّ
ـ الخطوة الثالثة: ينتقل لكسنبرغ إلى هذه الخطوة في ما لو لم ينجح في إثبات مراده من الخطوتين السابقتين، فيأتي إلى المعاجم السريانيَّة-الآراميَّة؛ ليجد مشتركًا لفظيًّا يختلف معناه عن معنى تلك المفردة الغامضة في العربيَّة، ويتناغم مع السياق القرآنيّ.
ـ الخطوة الرابعة: في حال أعجزته الخطوات السابقة، يقدِّم لكسنبرغ قراءةً جديدةً للمفردة عبر تغيير نقاطها؛ لأنَّ القرآن قد نُقِّطَ في وقتٍ لاحقٍ [عن نزوله وكتابته]، ولربَّما حدث خطأٌ في ذلك.
ـ الخطوة الخامسة: إن بقيت المفردة مبهمةً يعمل لكسنبرغ على إيجاد معادِلٍ لها في السريانيَّة ـ الآراميَّة بعد تغيير نقاطها.
ـ الخطوة السادسة: إنْ لم تُجدِ محاولاته السابقة نفعًا، يلجأ إلى ترجمة هذه المفردة العربيَّة إلى السريانيَّة؛ لأنَّها -بحسبه- قد أُخذت من السريانيَّة. وهذه الخطوة تنطوي على أهمِّيَّة كبرى، وقد أعطت للنصِّ القرآنيّ مفهومًا منطقيًّا يرتضيه المؤلِّف.
يتَّضح ممَّا أقرَّ به المؤلِّف نفسه ومارسه خلال كتابه أنَّ له فرضًا مسبقًا، وهو أنَّ المفردات الغامضة في القرآن -مع أنَّه لم ينبس ببنت شفة عن معاييره في تحديد هذا الغموض- مأخوذةٌ عن السريانيَّة. وهذا رأيٌ ناجمٌ عن اعتقاد أنَّ رسول الله صلىاللهعليهوآله كان يقرأ الكتب المقدَّسة ويقتطف منها ما يشاء: ولكنَّ الله -سبحانه وتعالى- قد ردَّ هذه الشبهة البائسة في قوله: (وَمَا كُنتَ تَتْلُو مِن قَبْلِهِ مِن كِتَابٍ وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ ۖ إِذًا لَّارْتَابَ الْمُبْطِلُونَ) . وفضلًا عن هذا الكلام الشريف -الذي هو الحجَّة البالغة- يمكن القول: إنَّه لم تكن هناك أيَّ نسخة عربيَّة من التوراة والإنجيل في العصر النبويّ، بل إنَّ أقدم المخطوطات المتبقِّية من الكتب المقدَّسة يعود تاريخها إلى القرن الهجريّ الثاني، ثمَّ إنَّ بعض المستشرقين نقلوا عن يهود المدينة أنَّ رسول الله صلىاللهعليهوآله لم يكن عالمًا بالأسفار المقدَّسة، ولم يكن قد قرأها أبدًا.
وعليه، فإنَّ ما انتهجه لكسنبرغ هو أشبه بتفسير القرآن بالرأي؛ إذ إنَّه بهدف تقديم بيانٍ أوضح لمفردة رآها غامضة، لم يفحص -لذلك- سوى تفسير الطبريّ، والأشنع من ذلك كلِّه تغاضيه عن تفاسير علماء الشيعة بأسرها، كما أنَّه لم يستخدم منهجًا إيتيمولوجيًّا للبحث عن أصل المفردة واللغة التي أُخِذت منها، بل راجع مباشرةً المعاجم السريانيَّة، واختار المعنى الذي يتناسب مع متخيّله عن السياق القرآنيّ، أو غيَّر نقاطها بشكلٍ يتناسب مع فرضه المسبق، بمعزل عن دراسةِ تاريخ القرآن وقراءاتها المقبولة لدى العلماء المسلمين، وتراثهم العلميّ والأدبيّ. وقد وجّه المستشرقون أنفسُهم انتقاداتٍ -لاذعةٍ أحيانًا- إلى لكسنبرغ ومنهجيَّته، وهي من أفضل الأدلَّة على بطلان قوله.
تقدَّم أنَّ لكسنبرغ عمل على إعادة فهم التعابير القرآنيَّة، وهذا بعد أن شكَّك في عربيَّة هذه التعابير، ورأى أنَّها مأخوذة من السريانيَّة-الآراميَّة، وأنَّ المفسِّرين المسلمين أخطأوا في قراءتها أو فهمها؛ لعدم علمهم بتلك اللغة، واستند في مواضع كثيرة إلى المعاجم السريانيَّة-الآراميَّة. هذا، ولكنّ دراسةً لغويَّةً تُثبت أنَّ دعاويه قد تُعارِض ما ورد في المعاجم الساميَّة، من العربيَّة والسريانيَّة معًا، بل هناك شواهد عدَّة في هذه المعاجم تؤيِّد فهم المسلمين من تلك التعابير.
أوَّل مفردةٍ شكَّك لكسنبرغ في صحَّة قراءتها هي لفظة «استفزِزْ»، واقترح إزالة نقطتَي الزايَين -أيْ استبدالها بـ«استفرِرْ»- ليصبح المعنى أنَّ الشيطان يطلب من الناس أن يفرّوا، حسب القواعد العربيَّة. لكنَّ المشكلة هي أنَّ «الاستفرار» لم يرد في معجمٍ واحدٍ من المعاجم العربيَّة، بل لا أصل لها، ولم يقرأ أحد من القرَّاء بهذه القراءة.
أمَّا المفردة الثانية، وهي «وأجلِبْ»، فرأى لكسنبرغ أنَّه من الواجب وضع نقطة الجيم فوقها وتعديلها إلى «واخلِبْ» بمعنى الخدعة بحسب لسان العرب، لكنَّه لم ينتبه إلى أنَّ هذا الفعل متعدٍّ إلى المفعول بنفسه، ولا يتعدَّى بواسطة حرف الجرّ، كما يتبيَّن ذلك من لسان العرب: «خَلَبَه يَخْلُبُه خَلْباً وخِلابَةً: خَدَعَه»، بينما يتعدَّى الفعل «أجلبَ» بواسطة حرف الجرّ. ثمَّ إنَّه لم يختلف في قراءتها أحدٌ من القرَّاء، وهذه قرينة على أنَّ رسول الله صلىاللهعليهوآله قرأها كذلك. وبذلك تبقى دعوى لكسنبرغ موضع ريبٍ وشكّ.
ثمَّ شكَّك لكسنبرغ في معنى مقطعٍ من الآية 53 من سورة الأحزاب (غَيْرَ نَاظِرِينَ إِنَاهُ)، حيث ادَّعى أنَّ المفسِّرين ترجموا «إِنٰاهُ» بالطعام المحضَّر، بينما القراءة الصحيحة هي «إِنٰثه» وتعني أزواجه. ويُستشكل عليه بأنَّه ما المشكلة في تفسير المسلمين، وما الدليل على خطئه؟ فهو لم يبرهن على ما ادَّعاه، بل نقل عنهم أنَّهم ترجموه بالطعام المحضَّر، ولم يقل مَن قال به منهم؛ فإنَّ الهاء ضمير عائد إلى الطعام المذكور قبل هذا المقطع، و«الإِنَى» مصدر «أَنَى يَأنِي» ومعناه الإدراك والبلوغ، وقد ورد فعله في قوله -تعالى-: ( أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّه) ، ويؤيِّده ما أنشده الحطيئة:
وهذه قرينة على أن رسول الله صلىاللهعليهوآله قرأها كذلك، وما ادعاه لكسنبرغ موضع ريب وشك.
وآنيتُ العَشــاءَ إلَى سُهَــيــلٍ أوِ الشّـــِعْرَى فطال بيَ الأنَاءُ
أمَّا بالنسبة إلى نظريَّته عن الحور العين، فنبدأ من قوله -تعالى-: (كَذَٰلِكَ
وَزَوَّجْنَاهُم بِحُورٍ عِينٍ) ؛ فالتزويج من مادَّة «الزوج» وله وجوهٌ من المعاني، كالحليلة والصنف والقرين. وإذا ورد في باب التفعيل يتعدَّى إلى مفعولين، كما في قوله -تعالى-: (زَوَّجْنَاكَهَا)، ولا يحتاج إلى حرف الجرّ، وهو بمعنى النكاح؛ لكنَّ التزويج في قوله -تعالى-: (وَزَوَّجْنَاهُم بِحُورٍ عِينٍ) متعدٍّ بحرف الباء، ويعني قرناهم بحورٍ عين؛ لأنَّه ليس في الجنَّة عقد تزويجٍ أو نكاح؛ ويدلّ على ذلك عدم التكليف في الجنَّة. إذًا، ليس التزويج في الجنَّة بمعنى النكاح المتعارف في الدنيا. وعليه، فإنَّ دعوى لكسنبرغ -على فرض صحَّة فرضه المسبق بتأسِّي القرآن بالعهدين- بتعارض القرآن والعهدين في جزاء المؤمنين في الجنَّة -أي وعد القرآن بنكاح المؤمنين وعدم ذلك في العهدين- يعاني من تعسُّفٍ وتعجُّل؛ لأنَّ في الجنَّة القرآنيَّة -أيضًا- لا يوجد نكاح بالمعنى المتعارف، كما زعم لكسنبرغ.
لفظة «الزوج» خلاف الفرد، وتعني: امرأة الرجل، والقرين، أو ضرب من النبات. وهذه المعاني تماثل ما ورد في معاجم اللغات الساميَّة؛ فمعنى ܙܘܓ (زوج) في المعجم الكلدانيّ: «زوج، قرن»، وفي معاجم السريانيَّة: «انضمّ بعضهم ببعض، التوحُّد بالزواج، الحليلة، الصاحب، الزوجة، المتساوي»، وفي معجم «بار بلهول»، وهو من أقدم المعاجم السريانيَّة: «ܙܘܓܐ (زوجا). ܒܪ ܙܘܓܐ: (بر زوجا) الشفيق، الرفيق، الربيب، الخدن». وهذا التقارب في معاني هذه
المفردة دليل على وجودها في اللغات الساميَّة. إذًا، لا داعي لإزالة نقطة الجيم في «زوَّجناهم»؛ فإنَّ لكسنبرغ ـ حسب المنهج الذي يسير عليه- يحكم بإزالة النقطة وتغيير القراءة إذا كانت الكلمة غير موجودة في المعاجم العربيَّة والسريانيَّة، بينما هي -أيْ لفظة الزوج- مستعمَلة في كلتا اللغتين.
اللفظة التالية في الآية سالفة الذكر هي حرف الباء، ويرى لكسنبرغ أنَّه يعني بين وتحت» في السريانيَّة-الآراميَّة، فيقدِّم قراءةً جديدةً للآية، وهي: «وروّحناهم بحورٍ عين»، ويقدِّم معنى جديدًا لها، وهو ترويح المؤمنين تحت حور عين. وبما أنَّ الحور العين تعادل -عنده- الأعناب البيض، فسيكون المعنى الجديد: ترويحهم تحت [أشجار] الأعناب البيض. لكن لهذا الحرف (الباء) أربعة عشر معنى في العربيَّة وأكثر من عشرين معنى في معجم «منّا» -وهو المعجم الذي استند إليه لكسنبرغ- والمعنى العشرين هو «بين». ولم يرد معنى «تحت» للباء لا في العربيَّة، ولا في معجم «منّا»، ولا في المعاجم السريانيَّة. إذًا، معنى «تحت» لحرف (الباء) هو من اختلاق مخيِّلة لكسنبرغ ومن صنعه، ولا يصحّ حمله على الآية الشريفة.
اللفظة الثالثة في الآية هي «الحور»، وهي جمع الأحور أو الحوراء، وقد ذُكرت لها معانٍ ثلاثة:
ـ بِيضُ الوجوه
ـ شديد بياض العين وشديد سوادها
ـ والتي يحار فيها الطَرف
وقد استبعد الطبري المعنى الأخيرَ لعدم موافقته مع القواعد العربيَّة؛ لأنَّ الحَوْرَ تعني شدَّة بياض العين وشدَّة سوادها. وتعادلها كلمة «ܚܘܪ» (حور) في الكلدانيَّة وهي، تعني: «اشتدَّ بياض عينه»، وكذلك معناها في القاموس السرياني ذيل «ܚܘܪ» (حور): «أن يصير أبيضَ، أن يلتزم بثيابٍ بيضٍ كرمزٍ للحزب»، مضافًا إلى: «أن يرى، أن يلاحظ، أن يلمح». ومعنى هذا الجذر: «أن يكون أبيض». وبهذا اتَّضح معنى هذه اللفظة في اللغات الساميَّة، وهناك علاقة ملحوظة بينها وبين العَين في هذه اللغات، فلا داعي لتخطئة تفاسير المسلمين؛ إذ إنَّهم أوَّلوا الحور ببِيض الأعين، وهذا ما تؤيِّده الدراسة اللغويَّة.
ثمّ تجدر الإشارة إلى ما تشبَّثَ به لكسنبرغ ليُثبت ما ادَّعاه، وهو المعنى الوارد في لسان العرب ذيل لفظة البيضة: «عِنَبٌ بالطائف أَبيض عظيم الحَبّ». ولكنَّه أغمض عمَّا ورد بعده: «بَيْضةُ الخِدْر: الجاريةُ؛ لأنَّها في خِدْرها مكنونة». فدعوى عدم العلاقة بين البياض والعَين غير صحيح، بل يُثبتها المعجم نفسه الذي استخدمه لكسنبرغ.
أمَّا مفردة «العِين»، وهي جمع الأعين أو العيناء -والتي فسَّرها لكسنبرغ باللامع والشفَّاف، لافتًا إلى حبوب العنب- فمعناها في العربيَّة واسعات العيون، وتعادلها كلمة «ܥܝܢܐ» (عينا) في الكلدانيَّة، وتعني: «عين، باصرة، نظر؛ وجه، منظر، لون»، ومن مشتقَّاتها كلمة «ܥܝܢܢܐ» (عيننا) التي تعني: «أعين، متّسع العينين». وقد ورد في المعجم السريانيّ ذيل لفظة «ܥܝܢ» (عين): «أن ينظر، أن يرى، أن يشاهد؛ أن يشير، أن يُظهِر»، وكذلك ورد معنى «ذو عين عظيمة» ذيل لفظة «ܥܝܢܢܐ» (عيننا). ولم يرد في معانيها اللامع وما شابه ذلك، بل هو ما أتى به لكسنبرغ من تلقاء نفسه. وحريٌّ بالذكر ورود معنى «أوسع عينه» في معجم «تزاروس» -وهو من مصادر لكسنبرغ في إثبات نظريَّته- وقد أغمض عنه، وهذا المعنى يؤيِّد ما ورد في المعاجم العربيَّة لمفردة «العِين».
وبعد دراسة مفردات الآية المذكورة نعالج شبهةً أثارها لكسنبرغ عن تعبير «أَزْواجٌ مُطَهَّرَةٌ»؛ حيث قال إنَّ الزوج أُطلقتْ على النباتات في القرآن الكريم كما أُطلقتْ على زوجة الرجل، ومن ثَمَّ فسَّر هذا التعبير بأنواعٍ طيِّبةٍ من الأعناب. والجواب هو أنَّ مشتقَّات «الزوج» وردت في إحدى وثمانين آية من القرآن الكريم، وكلَّما استُخدمت للنباتات رافقتْها قرينةٌ، ومن هذه القرائن:
ـ «مِن» البيانيَّة: كما في قوله -تعالى-: (وَمِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ جَعَلَ فِيهَا زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ) ، أو ( فِيهِمَا مِن كُلِّ فَاكِهَةٍ زَوْجَانِ).
ـ الفعل «أنبت»: كما في قوله -تعالى-:(وَأَنبَتَتْ مِن كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ)، أو (فَأَنبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ).
ـ الفعل «أخرج»: كما في قوله -تعالى-: (فَأَخْرَجْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّن نَّبَاتٍ شَتَّىٰ) .
هذا، فضلًا عن أنَّه لم تُطلق صفة «المطهَّر» في القرآن الكريم على النباتات؛ إلَّا أن نعتبر «أزواج مطهَّرة» فواكهَ الجنَّة، وفقًا لما قاله لكسنبرغ، وهذا يعني أنَّ فواكه الدنيا غير مطهَّرة؛ لأنَّها لم تُنعت بالطهارة في القرآن، بينما امتازت فواكه الجنَّة بها. ولكن ليس الأمر كذلك؛ فإنَّ الطهارة في هذه العبارة ضدّ الحيض، كما ورد هذا التضادّ في قوله -تعالى-: (وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ ۖ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ ۖ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّىٰ يَطْهُرْنَ) ؛ وتؤيِّد هذا المعنى الأحاديث التي ستأتي لاحقًا.
نعت القرآن الكريم الحورَ العِين بسِماتٍ أخرى، حاول لكسنبرغ أن يُغيِّر مداليلها إلى ما يتناسب مع الأعناب البيض، ومنها «قاصرات الطرف»، التي فسَّرها لكسنبرغ بـ[الأعناب] المنخفضة المتدلِّية. وإذا بدأنا بـ«القصر»، فمعناها «الغاية» في العربيَّة، وجملة «قصرتُ طرفي» تعني «لم أرفعه إلى ما لا ينبغي»، و«قصر النفس» معناه كفّها عن شيءٍ ما؛ ولذلك قال الله -تعالى-: (وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ) ، وقيل معناه: ترك بعض أركانها؛ لأنَّ القِصَرَ خلاف الطول، وقاصر الطرف قريبٌ من الخاشع. وورد المعنى المذكور نفسه في معجم
«منّا» ذيل «ܩܨܪ» (قصر)، ولم يُقتصر استعماله على الأغصان والأشجار. وعليه، يفتقر فهم المقصود من القصر إلى فهم ما أضيف إليه، أيْ الطرف.
أمَّا «الطرف»، فهو اسمٌ جامعٌ للبصر، وثمَّة آيات شريفة ورد فيها «الطرف» بهذا المعنى؛ كقوله -تعالى-: ( أَنَا آتِيكَ بِهِ قَبْلَ أَن يَرْتَدَّ إِلَيْكَ طَرْفُكَ) ، و(وَتَرَاهُمْ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا خَاشِعِينَ مِنَ الذُّلِّ يَنظُرُونَ مِن طَرْفٍ خَفِيٍّ) . وما يلفت الانتباه هو معنى كلمة «ܛܪܦ» (طرپ) في الكلدانيَّة: «التفت، وجّه نظره»، ومعنى كلمة «ܡܛܪܦ» (مطرپ) في السريانيَّة: «طرفة العين»، مضافًا إلى معنى الورق ذيل كلمة «ܛܪܦܐ» (طرپا). لكنَّ لكسنبرغ اختار المعنى الثاني؛ بناءً على فرض عدم وجود الحوريَّات. وحريٌّ بالذكر أنَّ مصطلح «قاصرات الطرف» كان معروفًا قبل الإسلام، وقد أورده امرؤ القيس في قصيدته:
من القاصرات الطَّرْفِ لو دَبّ مُحْوِلِ
من الذَّرّ فوق الإتْــــب مـنهــا لأثَّرا
وثمَّة سمةٌ أخرى مُدحت بها الحور العِين، هي «خَيْرَاتٌ حِسَانٌ»، مفردتان يرى لكسنبرغ أنَّهما يعادلان «ܓܒܝܬܐ ܛܒܐ» (گبیتا طبا) في السريانيَّة-الآراميَّة، بينما هناك خلافٌ جذريٌّ بين اللفظ العربيّ واللفظ السريانيّ، ولا يُعرف من أين وجدهما معادلَين للَّفظ القرآنيّ؟ إذًا، دعواه غير مستدلّ عليها ولا تستحقّ
الردّ. وكذلك ما ادَّعاه بشأن «العُرُب»؛ إذ استبدل قراءتها بـ«العُري»، من دون أن يأتيَ بدليلٍ على خطأ القراءة التي بين أيدينا، والتي اتَّفق عليها القرَّاء بقراءة الباء معجَمةً موحَّدةً. وقد نقل الطبري أكثر من عشر روايات عن الصحابة والتابعين في معنى العُرُب، واتَّفقوا على أنَّها تعني «غنجات متحبّبات إلى أزواجهن»، وهذا دليلٌ على أنَّ هذه المفردة كانت تُقرَأ هكذا منذ القرن الأوَّل، وتغيير قراءتها موضع ريبٍ وشكّ. وإن سلَّمنا أنَّ القراءة الصحيحة هي «عريا»، فهذه المفردة موجودة في العربيَّة بمعنى الريح الباردة، وليست بالضرورة مفردةً مأخوذةً من السريانيَّة، كما يعتقد لكسنبرغ.
نكتفي بهذا القدر لإثبات أخطاء ارتكبها لكسنبرغ في تحليله اللغويّ، وهناك إشكالاتٌ على المنهج الذي اتَّبعه للوصول إلى هذه النتائج، نذكر جملةً منها في مبحثٍ لاحق.
تقدم سابقًا أنَّ لكسنبرغ يقول: إنَّ المسلمين أخطأوا في فهم بعض المفردات والتعابير الواردة في القرآن الكريم، لزعمهم أنَّها بالعربيّة، ففسَّروها على أساس تلك اللغة؛ ولكنَّ الحقيقة هي أنَّها باللغة السريانيَّة ويجب إعادة فهمها على أساس هذه اللغة.
لكن في المقابل، تُظهِر دراسة الأدب العربيّ في العصر الجاهليّ أنَّ هناك عددًا لا بأس به من الأشعار التي أنشدها شعراء ذلك العصر، وقد استخدموا في أشعارهم المفردات والتعابير نفسها، ولم تكن معانيها موافقة لِما ادَّعاه لكسنبرغ، بل بقرينة السياق والمفردات الأخرى التي وردت في الأبيات ندرك أنَّ تلك المفردات والتعابير كانت معروفة لدى العرب قبل الإسلام، واستُخدمت في القرآن الكريم بالمعاني نفسها، فكان المفسِّرون المسلمون محقِّين في فهمها. ونقصد على وجه التحديد
مفهوم «الحور العين» وكلّ لفظةٍ قرآنيَّةٍ أخرى تُشعر بوجود جواري الجنَّة. ونستنتج من دراسة أشعار العرب قبل الإسلام أنَّ شعراءهم كانوا يستخدمون هذه التعابير مشيرِين إلى جمال النساء؛ فدعوى لكسنبرغ بأنَّ هذه الألفاظ تدلّ على الأعناب البيض موضع ريبٍ ولا تمتّ إلى الواقع بصلة. ونذكر في ما يأتي نماذجَ من الكمِّيَّة الهائلة ممَّا أنشده شعراء العصر الجاهليّ في وصف جمال حبيباتهم، وهي شواهدُ على وجود هذه الألفاظ في اللغة العربيَّة قبل نزول القرآن المجيد، وبالمعاني نفسها التي قال بها علماء اللغة والتفسير.
نبدأ بتعبير «الحور العين»، وقد كان لافتًا للانتباه منذ القرن الهجريّ الأوَّل، وهو ما سأل عنه نافعُ بن الأزرق ابنَ عباس، فأجابه منشدًا بيتًا عزاه إلى الأعشى:
وحورٌ كأمثالِ الدّمى ومَناسف
ومــاءٌ ورَيحــانٌ وراحَ يَــضــــعُ
وقد وردت لفظة «الحور» في أشعارٍ كثيرة أخرى؛ منها ما أنشده عبيد بن الأبرص، يشرح فيه قصّة سبي عددٍ من الشابَّات الحور اللاتي تشبه الدمى، فيقول:
وَأَوانِــسٍ مِــثـــلِ الدُمــى
حورِ العُيـونِ قَدِ اِسـتَـبَـيــنا
وفي شعرٍ آخر، يُشبّه بياضَ السحابِ ببياضِ أسنان فتيات شابَّات يتبسَّمن ويضحكن:
ولاحَ بها تــبــسُّـم واضحــاتٍ
يَزينُ صفائـحَ الحورِ القلاصِ
وأنشد عمرو بن سعد بن مالك ـ الملقَّب بالمُرقِّش الأكبر ـ في وصف منطقة اسمها «برقة رعم» قائلًا:
وفـــيــهـنَّ حُورٌ كمـثـلِ الظِّـبـاء
تَقَرَّوا بأعلى الســلـيـلِ الهَــدالا
وفيه يشبِّه الحور بالظباء، وهذا تشبيهٌ شائع يُستخدم لوصف جمال المرأة؛ إذ لا يشبّه عاقل الأعناب بالظباء. كما استخدم -أيضًا- ابن عمّ أبيه، الحارث بن عُبَاد، تشبيها مماثلًا للحور، مُنشدًا:
أَقـوَت وَقَـد كـانَـت تَحُـلُّ بِجـوِّهـا
حـورُ المَــدامِـعِ مِن ظِبـاءِ الشـامِ
وكذلك ما أنشده عرفجة بن جنادة بن أبي نعمان، وفيه يشبِّه الحور بالظباء، فيقول:
فروضُ ثُوَيْـرٍ عن يمـيـنٍ رَويّةٍ
كـأن لم تـربَّعــْه أوانسُ حورُ
رقاقُ الثّنايا والوجُوهِ، كأَنَّها
ظِباءُ الملا في لحظهنَّ فتور
وقد نعت بعضهم الحور بالناعمات، كما أنشد عدي بن زيد العبادي ـ وهو من أشهر شعراء النصارى من الجاهليِّين ـ قائلًا:
هَـــيَّــجَ الدَّاء في فُـــــؤادِكَ حُـورٌ
نـاعِـمـاتٌ بِجــانِــبِ الِمــلــطَــاطِ
آنِسَــاتُ الَحديـــثِ في غَيرِ فُحشٍ
رافِـــعــاتٌ جَـوانِـبَ الفِــسـطـاطِ
وتأويل ما ورد في البيتين إلى الأعناب البيض دونه خرط القتاد، بل هو أصعب؛ ولكنَّه يمدح الفتيات جزمًا. وليس هو الوحيد مَن يصف الحور بالناعمات، بل كان هذا تشبيهًا شائعًا لدى الشعراء الجاهليِّين. وأنموذجٌ آخر من ذلك هو ما أنشده سلامة بن جندل، في شعرٍ له يمدح فيه محبوبته أسماءَ قائلًا:
وَعِـنـدَنا قــيـنَـةٌ بَـيــضــاءُ ناعِـمَـةٌ
مِـثـلُ المَـهـاةِ مِنَ الحورِ الخَراعيبِ
وقد استخدم بعضهم مفردة «الحور» مضافةً إلى العيون، كما أنشد خليفة بن بشير بن عمير شعرًا يمدح فيه حبيبته. وواضحٌ من كلامه أنَّه لا يصف عنبًا؛ إذ يقول:
ما زالَ يــفـتـحُ أبـوابـاً ويـغــلـقُــها
دوني ويـــفـتـحُ بـابـًا بــعـد إرْتــاجِ
حـتـى أضـاءَ سِـراجٌ دونـه حَـجَـلٌ
حُورُ العيـونِ مِلاحٌ طرفُهـا سـاجي
يـكْــشـرْنَ للّهو والـلـذاتِ عن بُـرُدٍ
تـكـشُّفَ البرق عن ذي لُجَّةٍ داجي
ثمَّ هناك أبياتٌ تضمُّ مفردة «الحوراء»، تشير إلى محبوبة الشاعر، كما أوردها عبيد بن الأبرص في شعرٍ يمدح فيه حبيبته سَعدة قائلًا:
لِسَعدة إذ كانت تُـثـيـبُ بِـوُدِّها
وإذ هي لا تَـلقـاك إلّا بأَســعُــدِ
وإذ هي حوراء المــدامِع طَـفلةٌ
كمــــثــــل مَهـاة حُرَّة أمّ فَــرقَـــــدِ
وكذلك ما أنشده عمرو بن قميئة في مدح حبيبته خَولَة وذكر فراقه عنها قائلًا:
وَفــيهِــنَّ خَــــولَةُ زَينُ النِــســا-
ءِ زادَت عَلى الناسِ طُرّاً جَمالا
لَها عَـيــنُ حَـــوراءَ في رَوضَـــةٍ
وَتَقرو مَعَ النَبتِ أَرطىً طِوالا
ومثالٌ آخر هو ما أنشده عاجنة الهمداني؛ وكان قد بُعث إلى تجارة، فعثر على مالٍ في الطريق، فأخذه وعاد جذلًا، ثمَّ قال:
فأسْرَعْتُ الإيابَ بخَيْرِ حالٍ
إلى حَـوْرَاء خُرْعـبـُةٍ لَــعُــوبِ
ويماثله ما أنشده ابن إسرائيل عندما يذكر قصَّة لقائه مع حبيبته، ويقول:
وعدت بوصلٍ والزمانُ مسوَّفٌ
حوراءُ ناظــرُها حُسـَامٌ مُرهَـفٌ
نَشوَانَة خَصـــباءُ مَنهَلٌ ثـــغـــرها
وَردٌ ورِيــقـــتُها سُلافٌ قَــرقَفٌ
والجدير بالانتباه ما أنشده حامل لواء الشعر، امرؤ القيس بن حجر، وفيه دلالةٌ واضحة على أنَّه يحكي عن امرأة تعطف على طفلها، ويعبِّر عنها بـ«الحوراء»، فيقول:
نَظَرَتْ إليكَ بِعَيْنِ جازئَةٍ
حَوْرَاءَ حانِيَةٍ على طِـفْـلِ
وأوضح منه دلالةً ما أنشده مالك بن فهد الأزدي -وكان من ملوك عمان- وهو يحكي قصَّة حياته، بعد إصابته بسهمٍ رماه وَلدُه سليمة:
نَكَـــحـــتُ بهــا فَتاةَ بَني زُهَيرٍ
وَخَودَةَ بنــتَ نَصـــرِ الأَسودانِ
وَجعــدةَ بنـتَ حارثَـة بن حَربٍ
من الحور المُحَـــــبَّرةِ الحــِســــانِ
وأُمُّ جَـذيــمــةٍ وَهـنــاةَ بِــكــرٌ
عَقيلَةُ من ذُرى العربِ الهِجانِ
وقد استخدم بعض الشعراء الجاهليِّين مفردة «الكواعب» فضلًا عن «الحور»، ما يثبت أنَّهما كانتا معروفتين لديهم لوصف الفتيات؛ كما يَظهر ذلك بجلاء ممَّا أنشده بشر بن أبي خازم الأسدي:
الواهبُ البيضَ الــكــواعبَ كالدمى
حورًا بأيــديهــا المـــزاهـــرُ تَــــعـــزفُ
وليست «الكواعب» دالةً على الأعناب أو فواكه أخرى، بل تدلّ على الشابَّات الناهدات الثدي منذ أمدٍ بعيد، وهذا ما يُستنتج من أشعار العرب قبل نشأة الإسلام. ونموذج ذلك ما أنشده امرؤ القيس قائلًا:
ويا رُبَّ يـــوم قـد أروح مرجَّـــــلا
حبيبا إلى البيـض الــكواعب أملسا
يُرعـنَ إلى صـــوتي إذا ما سَمعـــنَـــه
كما تَرعَوي عَـيطٌ إلى صوتِ أَعيَسا
وثمَّة أشعار كثيرة وردت فيها لفظة «الكاعب»، قصدًا بها إلى فتاةٍ شابة. ومثال ذلك ما أنشده تأبّط شرًّا بعد أن لقي الغول فقتله، وقال:
وأَدهمَ قد جُـبــتُ جلــبــابَــه
كما اجتابتِ الكاعبُ الخَيعلا
ومثالٌ آخر، هو ما أنشده أوس بن حَجر في شعر يعزّي نفسه في رزيَّةٍ قد أصابته، فيقول:
وكانتِ الكاعبُ الممنَّعةُ الـ
حسناء في زَاد أهلِها سَبُعا
وكذلك ما أنشدتْه جَنوب الهذيليَّة، وهي ترثي أخاها عَمرًا ذا الكلب وتقول:
المُخرِجُ الــكاعِبَ الحَــسْـنـاءَ مُذْعِنةً
في السَّبْيِ يَنفَحُ من أَرْدانِها الطِّيبُ
ويماثله ما أنشدتْه هند بنت معبد في رثاء ابن عمها خالد بن حبيب، وموضعُ الشاهد قولُها:
إذْ يَخرجُ الكاعبُ مِن خِدرِها
يِــومَك لا تــذكر فيه الَحيَـــــا
وزِد عليه ما أنشدتْه خويلة الرئاميَّة القضاعيَّة، وذلك بعد مجزرةٍ ارتكبها بنو داهن وبنو ناعب في قبيلتها، فقطَّعت خويلة خناصر أُسرتها وصنعتْ بها قِلادة، ثم علَّقتْها في عنقها، وقالت:
هذي خَـــنــاصِـــرُ أُسرتي مَسرُودةً
في الجِيد مِنّي مثلُ سِمْط الكاعب
وما أنشده المنخَّل بن الحَرث اليشكري يثبت أنَّ لفظة «الكاعب» تدلّ على المرأة، لا على العنب ولا أيّ فاكهة أخرى؛ فهو القائل:
ولقَد دَخَـلتُ على الفَتاةِ
الخــدرِ في اليَومِ المَـــطيرِ
الكاعِبُ الحَــســنــاءُ تَر-
فُلُ في الدِّمَقسِ وَفي الحَريرِ
وهناك أشعار وردت فيها الكواعب إلى جانب الأتراب -كما ورد في القرآن الكريم- وأنموذج ذلك ما أنشده زهير بن جناب، وفيه يعيِّر بني تغلب بعد قتالٍ شديد شنَّه عليهم:
حيِّ دارًا تَغـيّـرتْ بالجَـنـاب
أقفَرتْ مِن كَواعِبَ أترابِ
وكذلك الأمر في «الأتراب»، فهي بمعنى الذين هم في سنٍّ واحدة، ولا تدلّ على فواكه طازجة، كما ادَّعى لكسنبرغ. والدليل على ذلك ما أنشده المسيّب بن علس وهو يشيد بحبيبته ليلى قائلًا:
فدَعْ عَنك لَــيـــلَى وأترابَهــا
فَقد تَقَطَّعَ الغانيات الوِصالا
ويماثله ما أنشده عبد الله بن عجلان النهديّ يذكر فيه هندًا، وهذا بعد أن طلَّقها وأُنكحت في بني عامر، فنشب بينهما قتال دامٍ وانهزمت بنو عامر، فقال عبد الله:
ذكرتُ بهــا هِنــدًا وأَترابَهــا الأُلى
بها يُكذبُ الواشي وَيُعصَى أَميرُها
وفي شعرٍ آخر يمدحها قائلًا:
أتَتْ بَين أترابٍ تَمايَسُ إذ مَشتْ
دَبيبُ القَطا أَو هُنّ مِنهنَّ أقطَفُ
وكذلك ما أنشده عنترة بن شدَّاد واستخدم فيه لفظة «الأتراب» لافتًا إلى أقران حبيبته، وهو يقول:
أسائِل عَن فتاةِ بَني قُرَاد
وَعن أَترابِهـا ذَاتِ الجَمال
وقد نعت القرآن الكريم الحور العين بسِماتٍ أخرى، من قبيل: الأبكار، والعُرُب، والمقصورات. وهذه كلها مستعمَلة في أشعار الشعراء الجاهليِّين، ومنها على سبيل المثال ما قاله عبيد بن الأبرص، وهو يصف مشهد رحيل الأحبَّة:
وفوقَ الجِمال الناعِجَاتِ كَوَاعبٌ
مَخامِيـصُ أَبكارٌ أَوانِسُ بِـيـضُ
وقد وصف الرحيلَ بشرُ بن أبي خازم مادحًا خليله وهو يقول:
تبيَّنْ خَليلي هَل تَرى مِن ظَعائِن
غَرائــرَ أَبــــكارٍ بِــــبُرقَةِ ثَمــــثَم
وأنشد أوس بن حجر شعرًا يمدح فيه الجواري الحسان قائلًا:
غرٌّ غَرائرُ أَبـــكارٌ نَشَــأنَ معًـا
حُســنُ الَخلائِق عَمَّا يَتقى نور
لَبِسنَ رَيطًا وَدِيباجًا وأَكسِيةً
شَتَّى بِهــا اللَون إِلَّا أَنّهــا فور
والحريُّ بالذكر ما أنشده النابغة الذبياني في نهي قومه عن رعي مواشيهم في وادي «ذي أُقر»، خوفًا من إغارة الغساسنة عليهم وسبي نسائهم، وعندما يشبِّههن بالبقر الوحشيّ في الجَمال، يقول:
لا أَعرِفَنْ رَبْرَبا حُورًا مَدامِعُها
كَأَّنَ أَبــكَارَها نـِــعـَـــاجُ دُوّار
وأمَّا لفظة «العُرُب» فقد استُخدم مفردها في أشعارٍ عدَّة؛ ومن جملة ذلك ما أنشده لبيد بن ربيعة العامري وهو يتغنَّى بمناظر الحياة الصحراويَّة قائلًا:
وفي الْحُدُوجِ عَرُوبٌ غيرُ فاحِشَةٍ
رَيَّا الرَّوَادِفِ يَعْشَى دوَنها البَصَرُ
وكذلك ما أنشده النابغة الذبياني وهو يصف حبيبته سُعدى قائلًا:
عَهِدتُ بِها سُعدى، وسُعدى غَرِيرةٌ
عَروبٌ، تَهــادَى في جَـــوارٍ خَرائدِ
ووردت مفردة «العروب» في شعر أنشده طفيل الغنوي وهو يصف حبيبته قائلًا:
عَرُوبٌ كأنَّ الشَمسَ تَحتَ قِناعِهَا
إِذَا ابتَسَــمتْ أو سَــافِرًا لَم تَبسَّمِ
وهو مَنْ أنشد شعرًا، واستخدم فيه مفردة «المقصورة» ناعتًا امرأةً محبوسةً في بيتها، وهو يقول:
فَقـالَ اِركَبوا أَنتُم حُمَاةٌ لِمِــثلِــها
فَـطِـرنـا إِلَى مَقـصـورَةٍ لَم تُعَـبَّلِ
وقد تقدَّم في ما سبق أنَّ لكسنبرغ اتَّخذ من مقارنة القرآن الكريم بين الحور العين وبين الياقوت والمرجان أو اللؤلؤ المكنون -يعني تشبيههنّ بها- مؤيِّدًا لدلالة الحور العين على الأعناب البيض، معتبرًا وجه الشبه بينهما هو المساواة في اللون. ولكنَّ الشعراء الجاهليِّين قد شبَّهوا المرأة بالدرّ وما شابه ذلك، فكان التشبيه معروفًا لديهم لبيان جمال النساء، لا لذكر بياض الأعناب. ومن هذه الأشعار: ما أنشده سويد بن أبي كاهل اليشكري وهو يشبِّه حبيبته سُليمى بدرّة عمانيّة قائلًا:
كالتُّوأَمِيَّـــةِ إِنْ بــاشَــــرْتَهــــا
قَرَّتِ العَيْنُ وطابَ المُضْطَجَعْ
وشبَّه المسيِّب بن علس حبيبتَه بدرّة وأباها بغوّاص وجدَّها بأعماق البحر، فأنشد قائلًا:
كَجُمانَةِ البَحرِيِّ جاءَ بِها
غَوّاصُها مِن لُجَّةِ البَحرِ
وتجدر الإشارة إلى قصيدةٍ أنشدها الأعشى الكبير وهو يحنّ إلى حبيبته قَتْلَة، ويشبِّهها بأجمل ما يعرفه العرب، قائلًا:
وَقَد أَراهَــــا وَســـطَ أَترَابِهــا
فِي الحَيِّ ذِي البَهجَة والسَامرِ
كَدُمــيَـــةٍ صُوِّر مِحــــرَابُهــــا
بمُــــذهَــــبٍ فِي مَرمَرٍ مَــــائرِ
أَو بَيضَةٍ فِي الدِّعصِ مَكنُونةٍ
أَو دُرَّةٍ شِيفَـــتْ لَدى تَــــاجرِ
يَشفِي غَلِــيــلَ النَفْس لَاهٍ بِها
حَورَاءُ تُصبِي نَــظَـــرَ النَاظرِ
ومن تشبيه العرب النساءَ بالبيضة قصيدةُ عدي بن زيد العبادي، وكان مسجونًا لمَّا أنشدها، فوصف حبيبته قائلًا:
كَدُمَى العَاجِ في المَحارِيبِ أَو كالـ
بَيضِ في الرَوضِ زَهوه مُسـتَـنِـيرُ
والآخر قول المخبّل السعدي وهو يمدح حبيبته الرباب، حيث أنشد قائلًا:
أَوْ بَيْضَةِ الدِّعْصِ التي وُضِعَتْ
في الأَرضِ ليس لِمَسِّها حَجْمُ
والأفصح من ذلك ما أنشده امرؤ القيس، وهو يشبِّه لون العشيقة بلون بيض النعام قائلًا:
كِبكْرِ المُقاناةِ البَيَاضِ بصُفْرةٍ
غَذَاها نَمِيرُ المَــاءِ غَيْرَ مُحلَّلِ
وعلى الرغم من وصف الشعراء الجاهليِّين النساء بالبيض،لم يتمكَّنوا من الإتيان ببلاغة القرآن ولم يقدروا على ذلك؛ فلقد أبدع القرآن الكريم في الوصف؛ إذ شبّه الحور العين بالبيض المكنون؛ فلفظة «المكنون» تتضمَّن معنى السلامة من جميع العوارض التي تُنقص رونقه، وتشين بياضه، وتكسف بهاءه.
ويكفينا ما ذكرنا من أشعار الشعراء الجاهليِّين لنثبتَ أنَّ المفردات القرآنيَّة وتشبيهاته كانت معروفة لديهم لوصف جمال النساء. فما حار المفسِّرون في فهمها -كما زعم لكسنبرغ- بل كانوا مصيبين في تأويلها إلى جواري الجنَّة الحسان، وهو ما يوافق التراث العربيّ العريق.
ادَّعى لكسنبرغ غير مرَّة عدم تناسب فهم المفسِّرين المسلمين لبعض التعابير والمفردات القرآنيَّة مع السياق الذي وردت فيه؛ ما دفعه إلى تقديم فهمٍ آخر ومعاني أخرى لهذه المفردات، اعتبرها أكثر ملائمةً وتناسبًا مع السياق القرآنيّ.
لذا، كان لا بدَّ من عرض السياق القرآنيّ ودراسته؛ لمعرفة ما إذا كان فهم المفسِّرين المسلمين معارضًا للسياق، وما إذا كانت المعاني التي قدَّمها لكسنبرغ تنسجم مع السياق كما يدَّعي.
أمَّا الأنموذج الأوَّل، فهو قوله -تعالى-: (قُلْ أَؤُنَبِّئُكُم بِخَيْرٍ مِّن ذَٰلِكُمْ ۚ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا عِندَ رَبِّهِمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَأَزْوَاجٌ مُّطَهَّرَةٌ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ) ، وفيه وعد الله المؤمنون بنعَمٍ يجزيهم بها في الجنَّة، ومن هذه النعم الأزواج المطهَّرة، التي ترجمها لكسنبرغ بنوعٍ من الفاكهة، وتحديدًا الأعناب الطيِّبة.
ولفهم المقصود منها الذي يتناسب وينسجم مع السياق الواردة فيه لا بدَّ من دراسة الآيات السابقة واللاحقة لها؛ ففي الآية السابقة يذمّ الله -تعالى- الناس لحبِّهم الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضَّة، وما إلى ذلك من متاع الدنيا القليل الفاني التي وعدهم -في الآية موضع الدراسة- بخيرٍ منها، ويحثّهم على العمل للآخرة والنعم الأخرويَّة البديلة عن متاع الدنيا هذه والتي لا تُقارن بها، وقد ترك ما يقابل شهوات الدنيا في ذكر نعَم الآخرة، وكذلك المال والبنين؛ للاستغناء عنها في الجنَّة، وأبقى النساء والحرث؛ بما يُفهم منه أنَّ جنَّات الآخرة بديلةٌ من حرث الدنيا، وهي خير منه جزمًا، وأنَّ الأزواج المطهَّرة تقابل نساء الدنيا. وافتراض أنَّ الأزواج المطهَّرة هي الأعناب البيض معناه وعد
المؤمنين بما هو أسوأ ممَّا في الدنيا، وهو مخالفٌ لسياق الوعد ومناقضٌ له؛ إذ لا يقول عاقلٌّ بأنَّ الأعناب خير من النساء، ولا يُعقل أن يوعد الإنسان بأسوء ممَّا لديه مقابل كفّ نفسه عنه! وعليه، فإنَّ المعنى الذي اقترحه لكسنبرغ في غاية الغرابة والبعد عن السياق، على العكس تمامًا من المعنى الذي فهمه المفسِّرون المسلمون والذي هو في غاية الانسجام والتناسب والتناسق مع السياق.
وأمَّا الأنموذج الثاني، فهو قوله -تعالى- في الآية ٢٢ من سورة الواقعة: (وَحُورٌ عِينٌ) . وقد فسَّر لكسنبرغ الحور العين في هذه الآية بالأعناب البيض، كما تقدَّم مرارًا وتكرارًا. ولكنَّ هذا المعنى غير متناسب مع الآيات السابقة؛ لأنَّ هذه الآيات -كما هو واضح - بصدد بيان نِعَم الجنَّة؛ ففي الآية ٢٠ ذَكَرَ الفواكه التي يتخيَّرها المؤمنون، وهو طعامهم النباتيّ، ويليها ذكرُ طعامهم من لحوم الطير، ثمَّ جاء بعدهما ما هو أفضل منهما، وهو الحور العين التي يعرفها المسلمون بالجواري الحسان. وتفسيرها بالأعناب البيض غير صحيح، وهو تكرار لا فائدة منه؛ لأنَّ العنب من الفواكه، وقد ذُكرت بعمومها، فيكون ذكر العنب بالخصوص لغوًا. واعتبارها من باب ذكر الخاصّ بعد العامّ لإفادة التأكيد غير صحيح أيضًا؛ لأنَّه قد فُصِلَ بينهما بفاصلٍ من جنسٍ آخر، وهو لحوم الطير.
وزيادةً على ذلك، فإنَّ سياق الآيات يُظهر أنَّ الحور العين أفضل ممَّا ذكر قبلها؛ لأنَّ الشخص إذا وعد شخصًا آخر ليحرِّضه على عمل، وعده أوَّلًا بما يحبُّه وبما هو أفضل ممَّا عنده، ثمَّ إن أراد ترغيبه أكثر في العمل وعده بما هو أفضل ممّا وعده به أوَّلًا، وهكذا يعده بالأفضل ممَّا تقدَّم كلَّما أراد ترغيبه أكثر. فإن وعده أوَّلًا بما يحبُّه ثُمَّ جاء ثانية بما هو أقلّ منه درجةً فقد آيسَه. وكذلك الأمر بالنسبة إلى الآيات الشريفة، فإنَّها تعد المؤمنين بالطعام النباتيّ ثمَّ بالحيوانيّ وتختار أطيبها وهي لحوم الطير، فإنْ جاءت بعدهما وفي مقام ترغيبهم بنوعٍ خاصٍّ من المأكولات النباتيَّة فقد آيستهم عن العمل وحطَّت من عزيمتهم عليه. وهذا لا ينسجم أبدًا مع سياق الدعوة إلى عملٍ ما والترغيب به.
لا ينتهي تعارض تفسير لكسنبرغ مع السياق القرآنيّ في هذه الآيات فحسب، بل إنَّ معظم آيات هذه السورة -أيضًا- ترفض ما ادَّعاه بشأنها؛ فالآيات (١٠-٢٦) تصف نعيم «السابقون السابقون»، والآيات (٢٧-٣٨) تصف نعيم أصحاب اليمين، وفيها إشارة إلى كائناتٍ أبكارٍ عرُبٍ أتراب، وفسَّرها لكسنبرغ بالأعناب الطازجة الباردة. فتبدأ نِعَم هؤلاء الأبرار بالأشجار الوارفة الظلال، ثمَّ تليها ثمار الأشجار وهي(وَفَاكِهَةٍ كَثِيرَةٍ ﴿٣٢﴾ لَّا مَقْطُوعَةٍ وَلَا مَمْنُوعَةٍ ) ، ثمَّ يتغيَّر الضمير بعد ذلك من المفرد المؤنَّث إلى جمع المؤنَّث، فيقول -تعالى-: (إِنَّا أَنشَأْنَاهُنَّ إِنشَاءً ﴿٣٥﴾ فَجَعَلْنَاهُنَّ أَبْكَارًا) ، وهذا التغيير يفيد تغيير مرجع الضمير، ولو كانت هذه الكائنات من جنس الفواكه لقال: إنَّا أنشأناها إنشاءً، فجعلناها أبكارا؛ لأنَّ الأبكار العرُب الأتراب -وهي الأعناب على فرض صحصَّة تفسير لكسنبرغ- ليست الفواكه الوحيدة التي هي طازجة طريّة، وغيرها من فواكه الجنة ذابلة! إذًا، ما قاله لكسنبرغ لا يمكن قبوله إلَّا بقطع النصّ القرآنيّ من سياقه وتجاهل الآيات السابقة واللاحقة.
والأنموذج الثالث، هو قوله -تعالى-:(وَكَوَاعِبَ أَتْرَابًا) في سورة النبأ، وقد تقدَّم سابقًا أنَّ لكسنبرغ يرى «الكواعب» نعتًا للأعناب. ولكنَّ هذا التفسير يخالف قواعد اللغة العربيَّة؛ لأنَّ الآية السابقة تحدَّثت عن الأعناب، قائلةً: (حَدَائِقَ وَأَعْنَابًا) ، ثمّ عُطفت عليها الكواعب، وبما أنَّ النعت لا يُعطف على المنعوت ، لا يمكن أن تكون الكواعب نعتًا للأعناب.
ثمَّ إنَّ أغرب دعاوى لكسنبرغ قولُه بأنْ ليس في الجنَّة إلَّا الأطعمة والأشربة . ولكن يردّ دعواه هذه قولُه -تعالى- في وصف نعيم الآخرة: (جَنَّاتُ عَدْنٍ يَدْخُلُونَهَا
تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ۖ لَهُمْ فِيهَا مَا يَشَاءُونَ ۚ كَذَٰلِكَ يَجْزِي اللَّهُ الْمُتَّقِينَ) ؛ فإنَّ الإطلاق في الآية دليل على وجود كلِّ نعمةٍ ممَّا يخطر على البال وما لا يخطر، كما قال -سبحانه- في وصف الذين يسهرون الليالي بذكره جلَّ جلاله: (فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ)، وهو دليلٌ على التلذُّذ في الجنَّة بما لا نعرفه من النِعَم، فليس من المستبعد أن تشتمل على نساءٍ حسانِ الوجوه تسرّ ناظرِيها، كما يُشعر بذلك قوله -تعالى-: (وَفِيهَا مَا تَشْتَهِيهِ الْأَنفُسُ وَتَلَذُّ الْأَعْيُنُ).
فهذه جملة من النماذج الكافية في تثبيت ضعف دعاوى لكسنبرغ وتعارضها مع العقل والنقل.
يتجاهل لكسنبرغ التراث الإسلاميّ بكامله سوى القرآن الكريم، ويحاول دومًا تقديم قراءةٍ جديدةٍ من الآيات القرآنيَّة عبر تعديل رسمها أو إصلاح فهمها، مستدلًّا بأنَّ المفسِّرين المتأخِّرين -أيْ في القرنين الثالث والرابع الهجريّ، كما أشار إلى ذلك في آخر مقاله- قد حاروا في فهم المراد الحقيقيّ للمقاطع القرآنيَّة وأخطؤوا في تأويلها.
ولا شكَّ بأنَّ أفضل الطرق لفهم القرآن هو مراجعة من نزل عليه القرآن؛ فله مهمَّة تبيين القرآن، كما أكَّد ذلك قوله -تعالى-: (وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ)؛ إذ فيه دليلٌ على حجِّيَّة قول الرسول صلىاللهعليهوآله في بيان القرآن، وهو صلىاللهعليهوآله المرجع الأوَّل في الكشف عمّا أُشكل من القرآن. وقد ثبت عنه صلىاللهعليهوآله بالتواتر لدى الفريقين أنَّه قال: «يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي تَارِكٌ فِيكُمُ الثَّقَلَيْنِ أَمَا إِنْ تَمَسَّكْتُمْ بِهِمَا لَنْ تَضِلُّوا كِتَابَ اللَّهِ وَعِتْرَتِي أَهْلَ بَيْتِي فَإِنَّهُمَا لَنْ يَفْتَرِقَا حَتَّى يَرِدَا عَلَيَّ الْحَوْضَ»،
وعدمُ افتراقهما يدلّ على أنَّ العترة عليهاالسلام هم مفسِّرو القرآن، وهم خزَّان علمه وتراجمة وحيه، وهم أهل البيت الذين نزل عليهم جبرائيل، وأهل البيت بما في البيت أدرى، وقد شدَّد جملة من المفسِّرين على أهمِّيَّة الاستفادة من كلماتهم عليهاالسلام في فهم القرآن.
وليس هذا الأمر غريبًا؛ إذ ليس رسول الله صلىاللهعليهوآله بِدْعًا من الرسل، وكان الأنبياء السابقون عليهمالسلام -أيضًا- يبيّنون لأقوامهم آياتِ الله، وقد أعطى عيسى عليهالسلام لحوارييه أن ينشروا تعاليمه في العالم، وتُعتبر كلمتهم كلمةً من الله، وكذلك أهل بيت رسول الله صلىاللهعليهوآله، حديثُهم حديثُ رسول الله صلىاللهعليهوآله، وهو قول الله سبحانه وتعالى. ثمّ إنَّ من عاصرَ تكوُّنَ نصٍّ ما هو أقربُ إلى فهمه ممَّن لم يدرك ذلك الزمن ولم يعش الخطاب السائد في بيئته؛ فالأئمَّة المعصومون عليهمالسلام والصحابة والتابعون يفهمون النصَّ القرآنيّ والمرادَ الحقيقيَّ من آياته أفضل ممَّن جاء بعدهم بقرونٍ عدَّة ولم تَصله سوى مرويَّات شتَّى عمَّا مضى في تلك العصور.
من هذا المنطلق نذكر -هنا- جملةً من الروايات الواردة عن النبيّ الأكرم صلىاللهعليهوآله وعن الأئمَّة الأطهار عليهمالسلام، ونستكمل النقد بما نُقل عن الصحابة والتابعين -وقد عاش جميعهم قبل القرن الثالث الهجريّ-؛ لنتبيَّن كيف كانوا يفهمون المقاطع القرآنيَّة آنذاك؛ وما إذا كان في التراث الإسلاميّ ما يؤيِّد دعاوى لكسنبرغ أو يرفضه. والأحاديث النبوية تدلّنا على المراد الحقيقيّ للتعابير القرآنيّة حتّى على مقولة
لكسنبرغ وزعمه الباطل بأنّ رسول الله صلىاللهعليهوآله قد ألّف القرآن من تلقاء نفسه وليس هو وحيًا من الله، فلا تزال تمسّ الحاجة إلى كلماته الشريفة ومنقولات من أدركه ومن توارثوا علمه في الحصول على مقاصد الآيات ومفرداتها الغامضة لدينا.
ليس في التراث الروائيّ الإسلاميّ ما يؤيِّد الألفاظ البديلة التي اقترحها لكسنبرغ لبعض مفردات الآية ٦٤ من سورة الإسراء، بل ثمَّة ما يؤيِّد ويؤكِّد الألفاظَ والمفردات نفسها الواردة في الآية وينفي بالتالي مزاعم لكسنبرغ. فممَّا ورد عن أمير المؤمنين عليهالسلام -وهو من أدرك الرسول الأعظم صلىاللهعليهوآله وتعلَّم منه القرآن الكريم والمعنى المنشود لآياته- خطبته القاصعة التي يذمّ عليهالسلام فيها إبليس ويدعو الناس إلى الاعتبار ممَّا صنع، بقوله: «فَاحْذَرُوا عِبَادَ اللَّهِ عَدُوَّ اللَّهِ أَنْ يُعْدِيَكُمْ بِدَائِهِ وَأَنْ يَسْتَفِزَّكُمْ بِنِدَائِهِ وَأَنْ يُجْلِبَ عَلَيْكُمْ بِخَيْلِهِ وَرَجِلِه»؛ فهو عليهالسلام يستخدم الألفاظ القرآنيَّة من دون أيّ تغييرٍ في قراءة مفرداتها، ولو كانت القراءة الصحيحة لتلك الألفاظ ما ادَّعاه لكسنبرغ، كان على أمير المؤمنين عليهالسلام ـ وهو الذي رأى نور الوحي والرسالة- أن يقرأها بشكلٍ مختلف عمَّا بين أيدينا من القرآن. وكذلك ما ورد عن ابن عبَّاس ـ وهو من كبار أصحاب النبيّ صلىاللهعليهوآله، وحبر الأمَّة على ما لقبَّه بذلك أهل السنَّة- في وصفه من حارب أمير المؤمنين عليهالسلام، قائلًا: «وَاللَّهِ لَقَدْ أَجْلَبَ إِبْلِيسُ عَلَى أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ كُلَّ خَيْلٍ كَانَتْ فِي غَيْرِ طَاعَةِ اللَّهِ وَاللَّهِ إِنَّ كُلَّ رَاجِلٍ قَاتَلَ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ كَانَ مِنْ رَجَّالَةِ إِبْلِيسَ»، فهذا -أيضًا- دليلٌ على صحَّة النَقط القرآنيّ وفقًا لقراءة رسول الله صلىاللهعليهوآله، وخصوصًا عندما عبَّر عن أعداء أمير المؤمنين عليهالسلام برَجَّالَة
إبليس. وبذلك يتَّضح بجلاء أنَّ اللفظ القرآنيّ الصحيح هو الرِجل وليس الدجل.
أمَّا بالنسبة إلى مفردة «شارِك»، فهناك روايات عدَّة تُصرِّح بأنَّ إبليس يشارك في الأولاد إذا كان المولود مبغِضًا لأمير المؤمنين عليهالسلام، من قبيل الروايات التي تدلّ على أنَّ أمير المؤمنين عليهالسلام قد رأى إبليس، وبينما هما يتحادثان قال له اللعين أنَّه يدخل في رحم أمّ مبغضيه. ومن هذه الروايات:
ـ ما نُقل عن أمير المؤمنين عليهالسلام أنه صادفَ إبليسَ، وقال اللعين له بعد كلام: «يَا ابْنَ أَبِي طَالِبٍ مَا أَحَدٌ يُبْغِضُكَ إِلَّا أَشْرَكْتُ فِي رَحِمِ أُمِّهِ».
ـ ما نُقل من أنَّه عليهالسلام كان جالسًا عند باب الدار مع رسول الله صلىاللهعليهوآله، وإذ أقبل شيخ وعرَّفه الرسولُ صلىاللهعليهوآله عليه عليهالسلام أنَّه إبليس، فأراد الإمام عليهالسلام أن يضربه بالسيف، فقال له اللعين: «ظَلَمْتَنِي يَا أَبَا الْحَسَنِ، أَمَا سَمِعْتَ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يَقُولُ: وَشارِكْهُمْ فِي الْأَمْوالِ وَالْأَوْلادِ؛ فَوَ اللَّهِ مَا شَارَكْتُ أَحَداً أَحَبَّكَ فِي أُمِّه».
ـ ما رواه جابر بن عبد الله الأنصاري من أنَّه كان بمنًى مع الرسول الأعظم صلىاللهعليهوآله، فرأى الأصحاب شيخًا يُصلِّي متضرِّعًا، فاستحسنوا صلاته حتى قال الرسول الأكرم صلىاللهعليهوآله أنَّه من أخرج أباهم من الجنَّة، فَهَمَّ عليٌّ عليهالسلام بقتله، فأقبل إبليس قائلًا: «لَنْ تَقْدِرَ عَلَى ذَلِكَ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ مِنْ عِنْدِ رَبِّي. مَا لَكَ تُرِيدُ قَتْلِي؟ فَوَ اللَّهِ مَا أَبْغَضَكَ أَحَدٌ إِلَّا سَبَقَتْ نُطْفَتِي إِلَى رَحِمِ أُمِّهِ قَبْلَ نُطْفَةِ أَبِيهِ وَلَقَدْ شَارَكْتُ مُبْغِضِيكَ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ».
ـ وكذلك ما نقله ابن عبَّاس من أنَّه عليهالسلام كان جالسًا مع رسول الله صلىاللهعليهوآله فرأوا حيَّةً عظيمةً، فقام عليٌّ عليهالسلام ليضربها بالعصا، فنهاه الرسول صلىاللهعليهوآله قائلًا: «إِنَّهُ إِبْلِيسُ وَإِنِّي قَدْ أَخَذْتُ عَلَيْهِ شُرُوطاً، أَلَّا يُبْغِضَكَ مُبْغِضٌ إِلَّا شَارَكَهُ فِي رَحِمِ أُمِّه».
وقد ورد هذا المعنى -أيضًا- عن الرسول الأكرم صلىاللهعليهوآله في تفسير الآية الشريفة، عندما قال صلىاللهعليهوآله: «أَخْلِفُوا ظَنَّ إِبْلِيْسَ اللَّعِيْنِ فِيْمَا سَأَلَ رَبَّهُ، فَإِنَّ شِرْكَهُ فِيْ الأَمْوَالِ المُكْتَسَبَةِ مِنْ غَيْرِ حِلِّهَا، وَشِرْكُهُ فِيْ الأَوْلَادِ الحَرَامِ، فَطَيِّبُوا النِّكَاحَ، وَازْدَجَرُوا عَنِ الزِّنَا».
تُظهِر هذه الروايات أنَّ القراءة الصحيحة للآية المذكورة هي «شَارِكْ»، وتعني إسهام الشيطان في الولادة، وليست «شَرِّكْ» بمعنى إضلال الشيطان الناس بالحبائل. أمَّا لكسنبرغ، فقد تبنَّى القراءة الثانية (أيْ شرِّك) بحجَّة أن لا معنى لمشاركة الشيطان في الأولاد، متجاهلًا هذه الأحاديث الكثيرة التي تُثبت أنَّ هذا المعنى معروفٌ لدى المسلمين؛ ولكنَّه تجاهل ذلك كلّه، ومن ثَمَّ قام بتغيير رسم القرآن بشكلٍ لا يتناسب والتراث الإسلاميّ.
التحدِّي الأكبر للكسنبرغ يتمحور حول مدلول الحور العين؛ إذ يدَّعي أنَّ هذا التعبير يدلّ على العنب الأبيض لا على جواري الجنَّة، ومن هذا المنطلق عدَّل مداليل كلّ ما يُشعِر بأنَّ في الجنة نساءًا يتزوَّج بهنّ أهلُها، وحصر نِعَمَ الجنَّة بالفواكه، وبأعلاها جودةً وهي العنب. ويكفي في الردّ عليه إثبات وجود كائناتٍ أنثويَّة في الجنَّة القرآنيَّة يستمتع بهنّ أهلُها. ولكن قبل الأخذ باستعراض الروايات التي تثبت ذلك، نقف على بعض الملاحظات المفيدة في المقام:
ـ الملاحظة الأولى: إنَّه على فرض الحكم على هذه الروايات برمَّتها بأنَّها موضوعة مختلقة، لا يزال بالإمكان إثبات أنّ متخيّل المسلمين من الحور العين في القرون الأولى لم يكن إلَّا نساءًا متواجداتٍ في الجنَّة، بغضِّ النظر عن تفاصيلهن. وهذه قرينةٌ على أنَّ رسولَ الله صلىاللهعليهوآله قد عرَّفهم بالنساء، وذاع المفهوم في المجتمع الإسلاميّ، وإلَّا كيف يتبادر إلى أذهان المسلمين أنَّ الحور العين -قبل أن ينبس الرسول صلىاللهعليهوآله ببنت شفة ويبيِّن حقيقتها- نساء؟ وبما أنَّ الروايات الواردة في هذا المجال كثيرةٌ جدًا -سيأتي ذكر عددٍ منها- يثبُت التواتر المعنويّ في هويَّة هذه الكائنات في الجنَّة.
ـ الملاحظة الثانية: لو لم تكن هذه الكائنات نساءًا بل كانت أعنابًا لكان من المتوقَّع أن نجد أثرًا لذلك في الأخبار الواردة عن الأئمَّة عليهمالسلام أو الصحابة الذين أدركوا رسول الله صلىاللهعليهوآله وتعلَّموا منه تفسير القرآن الذي قرأه عليهم، خصوصًا مع توفُّر الدواعي الكثيرة لنشر هذه الأخبار؛ نتيجةً لكثرة تساؤل النَّاس عمَّا يجري في الحياة الآخرة عامَّة، وعمَّا يجزى به المؤمنون في الجنَّة، وما سيستلمون حيال كفّ أنفسهم عن الشهوات في الحياة الدنيا خاصَّة. هذا، مضافًا إلى انتفاء موانع النشر، من قبيل الحظر الحكوميّ أو التقيَّة؛ فإنَّها لا تهدِّد أيًّا من التيَّارات السياسيَّة أو الطائفيَّة في عصر البعثة وما بعدها حتَّى يحاول فريقٌ منهم طمسَها.
ـ الملاحظة الثالثة: إنَّه حتَّى على فرض كون تعبير «الحور العِين» مشتركًا بين جواري الجنَّة وبين الأعناب، لكان لزامًا على النبيّ صلىاللهعليهوآله أن يبيِّن أنَّها فواكه أو شيءٌ آخر -لأنَّه صلىاللهعليهوآله هو المرجع الأساس والمعوَّل عليه في تبيين آيات القرآن المجيد– حتَّى لا يبقى المقصود من هذا التعبير مختلطًا على الأمَّة، ومن ثَمَّ كنَّا سنشهد -نتيجةً لتلك الروايات الصحيحة إلى جانب الروايات الموضوعة- اضطرابًا في التراث الروائيّ بين الأحاديث التي تعتبر الحور العين أعنابًا وبين ما تعتبرها نساءًا؛ ولكن لم يكن الأمر كذلك، بل إنَّ كثرة الروايات التي تعرِّف الحور العين بأبكار الجنَّة، مضافًا إلى عدم وجود رواية واحدة تعرِّفها بالأعناب البيض تفيد الاطمئنان بأنَّ رسولَ الله صلىاللهعليهوآله أو خلفاءَه لم يقولوا بأنَّ الحور العين أعناب، وكذلك المسلمون منذ القرن الهجريّ الأوَّل كانوا يعدّون الحوريَّات فتيات لا فواكه مثل الأعناب. وهذا خلاف ما يدَّعيه لكسنبرغ حين يصف الحور الحين بالخرافة، ويحدِّد تاريخ وضعها بالقرن الهجريّ الثالث فصاعدًا، إلَّا أنْ نفترض أنَّ رسول الله صلىاللهعليهوآله لم يعرف مدلول هذا التعبير، ولم يسأله الصحابةُ عنه حتَّى جاء المفسِّرون في القرن الثالث واختلقوا هذه الأكذوبة، وبقي هذا التعبير رمزًا غامضًا إلى أن جاء لكسنبرغ وكشف الستار عنه؛ ولكنَّه فرضٌ لا يعدو الخيال، وبالتالي ليس فرضًا علميًا واقعيًا حتَّى يكون قابلًا للدراسة والتحقيق.
أمَّا الروايات، فهي على طوائف سبع:
(140)توضح هذه الروايات بجلاء أنَّ الحور العين غير نساء الدنيا، وأنَّهنَّ من نوع الإنسان لا الفواكه؛ إذ لا يُعقل السؤال عن التفاضل بين الإنسان وبين العنب. ومن هذه الروايات:
ـ ما ورد عن أبي عبد الله عليهالسلام أنَّه قال: «الْخَيْرَاتُ الْحِسَانُ مِنْ نِسَاءِ أَهْلِ الدُّنْيَا وَهُنَّ أَجْمَلُ مِنَ الْحُورِ الْعِينِ». وهذه الرواية نصٌّ في أنَّ الخيرات الحسان نساءٌ، ولا تبقي مجالًا لتخيَّل أنَّهنَّ فواكه ممتازة، كما زعم لكسنبرغ. وبمقارنتهنّ بالحور العين ندرك أنَّ الحور العين -أيضًا- من الجنس نفسه ولسن من جنس المأكولات!
ـ وما ورد عن أبي عبد الله عليهالسلام عن أبيه عليهالسلام في روايةٍ أخرى، يشيد فيها بالشيعة ويحثّهم على التنافس في فضائل الدرجات، فيصف كلَّ مؤمنةٍ بحوراء عيناء وكلَّ مؤمنٍ بصدّيق. ومن غير المنطقيّ -طبعًا- أن يوصف الإنسان بالفاكهة! بل المراد من هذا التشبيه أنَّ كلَّ مؤمنة في الجنَّة تحظى بمواصفات الحوريَّات من الحسن والجمال.
ـ ما ورد من نقاشٍ دار بين التابعين حول التفاضل بين الحور العين ونساء الدنيا. وهو دليلٌ آخر على أنَّهم كانوا يرونهنّ نساءًا؛ فإنَّ العاقل لا يجادل على التفاضل بين العنب والإنسان. ويُستنتج من هذا الخبر أنَّ الذين أدركوا الصحابة كانوا جازمين بأنَّ الحور العين نساءٌ. وهذه قرينةٌ أخرى تُثبت -لنا- أنَّ الرسول صلىاللهعليهوآله فسَّر لهم الحور العين بنساء الجنة؛ إذ لا يوجد مبدأ لهذه النقاشات سوى تفسيره صلىاللهعليهوآله، وما يوصلنا إلى هذا التفسير هو ذلك النقاش المذكور.
ـ ما استدلَّ به بعضهم في إثبات أفضليَّة الحور العين، وهو دعاء الرسول الأعظم صلىاللهعليهوآله في تشييع أحد المؤمنين بعد أن استغفر الله له وطلب منه الرحمة والعفو عنه: «وَأَبْدِلْهُ دَارًا خَيْرًا مِنْ دَارِهِ وَأَهْلًا خَيْرًا مِنْ أَهْلِهِ وَزَوْجًا خَيْرًا مِنْ زَوْجِهِ».
ـ ما استدلَّ به آخرون ممَّا نقلت عنه صلىاللهعليهوآله أمُّ سلمة عندما سألتْه عن أفضلهما، فأجاب صلىاللهعليهوآله : «نِسَاءُ الدُّنْيَا أَفْضَلُ مِنَ الْحُورِ الْعِينِ كَفَضْلِ الظِّهَارَةِ عَلَى الْبِطَانَةِ»، لافتًا إلى عبادتهنّ اللهَ.
فهذه الروايات توضح وضوح الشمس أنَّ في الجنَّة نساءًا يتزوَّج بهنَّ المؤمنون، وأنَّ نِعَمَ الجنَّةِ لا تقتصر على الفواكه.
وقد وردت في هذه الأخبار نعوتٌ يستحيل انطباقها إلَّا على الإنسان؛ فبعض هذه الروايات ناظرة إلى أفعالهنَّ في الجنَّة العليا، وأخرى تدلّ على مجيئهنّ العابر إلى الدنيا.
نبدأ ذكرها من استقبالهنّ المؤمنين بحفاوة عند دخولهم الجنَّة؛ إذ تضرب الملائكة حلقة بابها الأعظم، فيتنامى صوت صريرها إلى «كُلّ حَوْرَاءَ خَلَقَهَا اللَّهُ وَأَعَدَّهَا لِأَوْلِيَائِهِ فَيَتَبَاشَرْن»، وتُرسل الحور إلى من بكى على الإمام الحسين عليهالسلام في الدنيا قائلات: «إِنَّا قَدِ اشْتَقْنَاكُمْ مَعَ الْوِلْدَانِ الْمُخَلَّدِينَ». والأروع منهما مشهد دخول السيِّدة فاطمة الزهراء عليهاالسلام المحشر تستقبلها سبعون ألف حوراء مستبشرات
بالنظر إليها، يحملن مِجمرات من نورٍ يفوح منها ريح العود.ثمَّ إنَّ المؤمنين إذا دخلوا الجنَّة وسكنوا منازلهم ووُضع على رؤوسهم إكليل الكرامة وأُلبسوا بالحلل والذهب، مشت الحور العين صوبهم مع وصائفهن، ولها مشيٌ باهرٌ يُسمع من ساقيها تقديس الخلاخيل ومن ساعديها تمجيد الأسورة. وللمؤمن أن يعانق الحور الحسان إن كان قد أدَّى حقَّه على أخيه وأحبَّ أمير المؤمنين عليهالسلام .
ثمَّة روايات تشير إلى كلامٍ تقوله الحور العين؛ منها:
ـ ما ورد عن أبي بصير، أنَّه سأل الإمام الصادق عليهالسلام عن كلامهن فقال عليهالسلام: «[لهن] كَلَامٌ يَتَكَلَّمْنَ بِهِ لَمْ يَسْمَعِ الْخَلَائِقُ بِمِثْلِهِ».
ـ ما نُقل عن أمير المؤمنين؛ إذ قال إنَّ في الجنَّة سوقًا تجتمع فيه الحور العين، «يَرْفَعْنَ أَصْوَاتًا لَمْ يَرَ الْخَلَائِقُ مِثْلَهَا». وبما أنَّه في الجنَّة لا يُسمع لغو ولا تأثيم، بيَّن رسول الله صلىاللهعليهوآله المقصود من الرواية بأنَّ غناء الحور العين «لَيْسَ بِمِزْمَارِ الشَّيْطَانِ وَلَكِنْ بِتَمْجِيدِ اللَّهِ وَتَقْدِيسِهِ».
ـ ما ورد في بعض الروايات من ضحكهنّ في وجوه أزواجهنّ.
ـ ما نُقل عن قراءتهن القرآنَ يومَ زوَّج الله -تعالى- فاطمة عليهاالسلام من عليٍّ عليهالسلام ، وتهاديهنّ وتفاخرهنّ بهذا الزواج المبارك.
وردت جملة من الروايات التي تصف جمال الحور العين وتنسب إليهن سماتٍ لا يتَّصف بها إلَّا الإنسان. ومن هذه الروايات ما نقله ابن عبَّاس عن رسول الله صلىاللهعليهوآله في فضائل شهر رمضان الكريم، وأوَّلها تزيُّن الجنَّة في بداية هذا الشهر، ثمَّ هبوب ريحٍ من تحت العرش، فتصفق ورق أشجار الجنَّة، ومن ثمَّ تتزيَّن الحورُ العينُ واقفاتٍ على شُرَف الجنَّة، ينادين الله أن يزوِّجهنّ مَنْ يخطبهنّ. وقد ورد الخبر ذاته باختلافٍ يسيرٍ في اللفظ. وفي بعض الروايات إشارة إلى بروزهنّ، أو مجيئهنّ، أو نظرهنّ بدلًا من تزيُّنهنّ. وقد أعد الله -تعالى- لصائمي هذا الشهر المبارك في الجنَّة قصورًا تسكنها الحور العين مع خدَّام لهنّ، وترتدي كلٌّ منهنَّ خمارًا «خِمَارُ إِحْدَاهُنَّ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا».
الروايات التي تتحدَّث عن المجيء العابر للحور العين إلى الدنيا أو إشرافهن عليها كثيرةٌ، وتُعدُّ دليلًا على هويَّتهن الإنسانيَّة إنْ قبلنا صحَّة نقلها، وإن لم نقبل
ذلك فهي دليل على الشيء نفسه في متخيّل واضعيها -على فرض وضعها جميعًا- من الصحابة والتابعين أو أصحاب الأئمَّة عليهمالسلام في القرنين الأوَّل والثاني، ثُمَّ نُسبت إلى رسول الله صلىاللهعليهوآله. وهذا –أيضًا- دليلٌ آخر يبطل دعوى لكسنبرغ من أنَّها قد اختُلقت في القرنين الثالث والرابع.
من هذه الروايات ما ورد في فضل يوم الجمعة، وهي تشير إلى إشراف الحور العين على الدنيا وقولهن آنذاك: «أَيْنَ الَّذِينَ يَخْطُبُونَّا إِلَى رَبِّنَا». وتزيد بعض الروايات في وصف هذه الحوريَّات، فتقول: «لَوْ أَنَّ حُوراً مِنْ حُورِ الْجَنَّةِ أَشْرَفَتْ عَلَى أَهْلِ الدُّنْيَا وَأَبْدَتْ ذُؤَابَةً مِنْ ذَوَائِبِهَا لَأَفْتَنَ أَهْلَ الدُّنْيَا».
وهذه الصفات التي أثبتتها هذه الروايات للحور العين -من استقبالٍ، ونمشيٍ، وتفاخرٍ، وقراءة قرآنٍ، وتحادثٍ، وتزيُّنٍ، وإشرافٍ على الدنيا، ومجيءٍ إليها- تُثبِتُ جميعها بما لا يبقى معه مجالٌ للشكّ إنسانيَّة الحور العين، وبالتالي بطلان دعوى لكسنبرغ؛ إذ لا تنطبق هذه الصفات على الأعناب البيض بوجهٍ من الوجوه، ولو بالتكلُّف والتعسُّف.
تصرِّح جملة من الأحاديث بوجود نساء في الجنَّة هنَّ من الحور العين؛ وذلك باستخدام «مِنْ» البيانيَّة. ومن هذه الأحاديث:
ـ ما ورد عن النبيِّ الأكرم صلىاللهعليهوآله في آخِر خطبة له قبل وفاته، يتناول فيها ثواب الحسنات وعقاب السيئات، ويوصي فيها -بعد أن نهى عن قطع الرحم- بالتزويج بين المؤمنين قائلًا: «مَنْ عَمِلَ فِي تَزْوِيجٍ بَيْنَ مُؤْمِنَيْنِ حَتَّى يَجْمَعَ بَيْنَهُمَا زَوَّجَهُ اللَّهُ أَلْفَ أَلْفِ امْرَأَةٍ مِنَ الْحُورِ الْعِينِ».
ـ ما ورد عنه صلىاللهعليهوآله في تفسير (مساكن طيِّبة) في قوله -تعالى-: (وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّاتِ عَدْنٍ ۚ ذَٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ) ؛ بأنَّها قصرٌ في الجنَّة يضمُّ عددًا كبيرًا من البيوت، فيها فرشٌ كثيرة، «عَلَى كُلِّ فِرَاشٍ امْرَأَةٌ مِنَ الْحُورِ الْعِينِ». ومثله حديثٌ آخر نُقل عن أبي الحسن الرضا عليهالسلام، لكن فيه «زَوْجَةٌ مِنَ الْحُورِ الْعِينِ»؛ بدلًا من (امرأة من الحور العين).
ـ ما ورد في وصف مشهد دخول المؤمنين الجنَّة: «تُشْرِفُ عَلَيْهِمْ أَزْوَاجُهُمْ مِنَ الْحُورِ الْعِينِ وَالْآدَمِيِّينَ». فهذا المقطع من الرواية يثبت أنَّ الحور العين من الأزواج لا من الفواكه، ويُبطل في الوقت نفسه الدليل الذي حاول لكسنبرغ التمسُّك به لإنكار وجود الحور العين في الجنَّة. فقد أنكر لكسنبرغ وجود الحوريَّات في الجنَّة بحجَّة أنَّ تمتُّع الرجال بهنّ سيكون سببًا لاستياء زوجاتهم من النظر إلى هذا المشهد حسدًا لهنّ؛ ولكنَّ هذه الرواية تبيِّن أنَّ للمؤمنين أزواجًا من الآدميِّين -وهم رجال الدنيا للمؤمنات أو نساءها للمؤمنين- ومن الحور العين. وإنْ ترجمنا الحور إلى الأعناب سيكون المعنى ممّا يُضحك الثكلى! هذا، مضافًا إلى أنَّ دعوى لكسنبرغ هذه لا يمكن تعميمها على المؤمنين بأَسرهم؛ فمن المؤمنين من يمت قبل أن يتزوَّج في الدنيا، ومنهم من يكون مصير زوجته النار، كما أكَّد القرآنُ الكريم على أنَّ بعضَهنَّ أعداءٌ للمؤمنين، فهذا الحسد النسويّ -بتعبيره- لا يصلح دليلًا على نفي وجود الحور العين بمعناها المتصوَّر عندنا . هذا، مضافًا إلى قوله -تعالى-: ( فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا
يَتَسَاءَلُونَ) ؛ ما يعني الاختلاف الكبير بين الدنيا والآخرة من ناحية الأنساب؛ فقد لا تُرافق المؤمنَ زوجتُه التي كانت معه في الدنيا، وبالتالي لن يكون هناك معنىً للحسد النسويّ لزوجة المؤمن عند مشاهدتها استمتاعَه بالحور العين.
ثمَّة نقاش في التراث الإسلاميّ عن كيفيَّة استمرار نسل البشر بعد مقتل هابيل، وقد اختلف العلماء المسلمون في الجواب عن هذا السؤال المحرج؛ فمنهم من حكم بزواج أبناء آدم ببناته، واستدلُّوا لذلك بقول الصحابة، ومنهم من خالفهم وحكم بزواج أولاد آدم بغيرهم. والنقاش يطول وذو شجون؛ لكن هناك روايات تنفي نظريَّة زواج أولاد آدم بعضهم ببعض؛ لأنَّ زواج المحارم حرام، وتؤيِّد الرأي الثاني المذكور في المصادر الشيعيَّة.
من هذه الروايات ما رواه زرارة عن أبي عبد الله عليهالسلام عندما سأله عليهالسلام عن قول العامَّة في هذه المسألة وعقيدتهم في التزاوج بين أولاد آدم، فشنّع الإمام على معتقدهم واعتبره سببًا لخَلْق صفوة خَلْق الله وأحبَّائه من الأنبياء والمرسلين والمؤمنين والمؤمنات من حرام، بينما كان الله -تعالى- قادرًا على خلقهم من حلال، وقد أخذ ميثاقهم على ذلك، ثمّ أخذ الإمام عليهالسلام ببيان حقيقة الأمر، فقال: «إنَّ الله أنزل حوراء من الجنَّة، فأمر آدم أن يزوِّجها شَيْثًا، وهكذا استمرَّ النسل من الحلال».
وتؤيِّد هذه الروايةَ رواياتٌ أخرى تماثلها في المضمون. وهي جميعها تصوِّر للحور العين هويَّةً إنسانيَّةً، أو شيئًا غير الفاكهة على أقلّ تقدير.
بدأ لكسنبرغ في إثبات نظريَّته -من أنَّ المقصود بالحور العين هو الأعناب البيض- بقوله تعالى: (كَذَٰلِكَ وَزَوَّجْنَاهُم بِحُورٍ عِينٍ) ، ما اضطرَّه إلى تعديل قراءة (وزوَّجناهم) إلى (وروَّحناهم)، ثمَّ أخذ يُغيِّر مدلول كلّ عبارة قرآنية أخرى تُشعر بوجود نساءٍ في الجنَّة يستمتع بهن المتَّقون.
وما يُستشكل به على هذه النظريَّة هو نفس البدء بهذه الآية، فلو بدأ بآية آخرى لمَّا استطاع الوصول إلى النتيجة التي وصل إليها. وبعبارة أخرى: لو بدأ بتعابير أخرى تحمل المعنى نفسه ولكن بألفاظٍ أخرى لما وصل إلى ما وصل إليه، ولكانت النتيجة ستختلف عمَّا انتهى إليه. ومن هذه التعابير ما ورد في روايات متعدِّدة تلفت إلى الآية ذاتها مع اختلاف يسيرٍ في الألفاظ المستخدمة فيها .
يعتقد لكسنبرغ بأنَّ المسلمين أخطأوا في قراءة الآية حين قرأوها زوّجناهم، وفهموا الآية مخطِئين لسبب قراءتهم الخاطئة في القرون التالية. لكن ثمَّة -في التراث الإسلاميّ- روايات جمَّة استخدم راويها مادَّة «زوج» لا «روح»، وعلى فرض القبول بدعوى لكسنبرغ والأخذ بها، يلزم تغيير كلّ رواية ورد فيها هذا اللفظ –أيْ التزويج أو أيَّ صيغة أخرى من هذا الجذر- وتعديل قراءتها إلى ما ادَّعاه لكسنبرغ.
ولكن يجب ألَّا نغفل عن أنَّ هذه الروايات منقولةٌ عن الصحابة والتابعين أو أصحاب الأئمَّة الطاهرين عليهمالسلام، وبعضهم أدركوا رسول الله صلىاللهعليهوآله وسمعوا قراءته مشافهةً، وبعضهم تعلَّموا من الطبقة السابقة عليهم قراءة رسول الله صلىاللهعليهوآله. فلو كانت القراءة الصحيحة «روّحناهم» بدلًا من «زوَّجناهم»، لوجدنا لها أثرًا في التراث الروائيّ، فضلًا عن القراءات. ولكن الأمر على العكس، بل إنَّ الروايات الكثيرة تعبِّر عن استلذاذ المتَّقين في الجنَّة بمادَّة «التزويج»، وهذا دليل على أنَّ الذين سمعوا
قراءة النبيّ الأكرم صلىاللهعليهوآله أو سمعوا القراءة ممَّن تعلَّم منه القرآن -على فرض وضع جميع الروايات على أيدي هؤلاء- كانوا يقرأون الآية «وَزَوَّجْناهُمْ بِحُورٍ عينٍ»؛ ولذلك استخدموا في ما رووه هذا اللفظ، أيْ التزويج وما إلى ذلك. إذًا، القراءة التي بين أيدينا ليست خاطئة، وبناءًا على هذه القراءة لا يمكن إنكار التزويج في الجنَّة. وقد تقدَّم كلام في معنى هذه العبارة في مبحث الردّ على أساس المعاجم.
أمَّا الروايات التي تتحدَّث عن تزويج المؤمنين بالحور العين مستخدمةً عباراتٍ غير اللفظ القرآنيّ الشريف، فمنها:
ـ الروايات الواردة في بيان ثواب جملةٍ من الأعمال الحسنة، وعبّر الرواي عن جزاء عاملها بـ«التزويج من الحور العين»؛ إذ لا يمكن تأويله بما ادَّعاه لكسنبرغ لاختلافه عن اللفظ القرآنيّ، وهو دليل على وجود تزويج المتقين في الجنة، بغضّ النظر عن تفاصيله. ومن ذلك ما نقله الحسين بن خالد عن أبي الحسن الرضا عليهالسلام، من أنَّه عليهالسلام قال: «إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى أَوْجَبَ عَلَى نَفْسِهِ أَنْ لَا يُكَبِّرَهُ مُؤْمِنٌ مِائَةَ تَكْبِيرَةٍ وَيُحَمِّدَهُ مِائَةَ تَحْمِيدَةٍ وَيُسَبِّحَهُ مِائَةَ تَسْبِيحَةٍ وَيُهَلِّلَهُ مِائَةَ تَهْلِيلَةٍ وَيُصَلِّيَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ مِائَةَ مَرَّةٍ ثُمَّ يَقُولَ: اللَّهُمَّ زَوِّجْنِي مِنَ الْحُورِ الْعِينِ، إِلَّا زَوَّجَهُ اللَّهُ حَوْرَاءَ مِنَ الْجَنَّة». وما ورد في دعاءٍ عن الإمام الصادق عليهالسلام في تعقيب الصلاة: «اللَّهُمَّ أَعْتِقْنِي مِنَ النَّارِ وَأَدْخِلْنِي الْجَنَّةَ وَزَوِّجْنِي مِنَ الْحُورِ الْعِينِ»، وما ورد عنه عليهالسلام -أيضًا- في دعاءٍ يستعيذ فيه بالله من سكرات الموت وغمراته، ويستعينه على ضيق القبر ووحشته، ويستنجده من أهوال القيامة، ثمَّ يقول: «اللَّهُمَّ زَوِّجْنِي مِنَ الْحُورِ الْعِينِ».
ـ الروايات الواردة في حثِّ المؤمنين على عددٍ من الأعمال الصالحة، والتي تعرِّف هذه الأعمال الصالحة بأنَّها مهور الحور العين، ما يعني أنَّهنَّ نساء الجنَّة،
وكأنَّ الزواج بهنّ وتمكُّن المؤمن من التمتُّع بهنَّ في الجنَّة، يتطلَّب سدادَ مهورهن قبل الموت. ومن هذه الأعمال -مثلًا- تلك التي أوصى الرسول الأعظم صلىاللهعليهوآله أمير المؤمنين عليهالسلام بها، والتي منها خدمة العيال، وأكل ما يقع من الطعام تحت المائدة. هذا، وقد اعتبر رسول الله صلىاللهعليهوآله -في مواضع أخرى- تنظيف المساجد وإخراج القمامة منها -أيضًا- مهورَ الحور العين.
ـ الروايات التي ورد فيها التعبير بالخطوبة؛ فالخطوبة –أيضًا- مفردة من المفردات التي ترتبط بموضوع الزواج من الحور العين، وورودها في بعض الروايات يرشدنا إلى الهويَّة الإنسانيَّة لهنّ؛ إذ لا تُعقل الخطوبة من الفواكه. ومن هذه الروايات المرتبطة بالخطوبة من الحور ما نُقل عن الإمام زين العابدين عليهالسلام عندما خرج إلى المسجد ليلةً معطَّرًا بالغالية فسُئل عن قصده، فقال عليهالسلام: «إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أَخْطُبَ الْحُورَ الْعِينَ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فِي هَذِهِ اللَّيْلَة». ونُقل في رواية أخرى ما تقوله الحور العين عند إشرافهن على الدنيا أيَّام الجمعة: «أَيْنَ الَّذِينَ يَخْطُبُونَّا إِلَى رَبِّنَا».
ـ هاتان الروايتان وما يماثلهما دليلٌ على الحياة الزوجيَّة بين المتَّقين والحور العين في الجنَّة. ووجود هذا المضمون الواحد -أيْ الحياة الزوجيَّة- في جملةٍ من الأحاديث بألفاظٍ شتَّى يكشف بالتواتر المعنويّ عن صحَّته.
يرد في بعض الروايات ذكر الحور العين من نِعم الجنة إلى جانب الأشجار والفواكه، ولكنَّها ترد قسيمًا لها لا قسمًا منها. وبما أنَّه ليس من المنطقيّ أن يجعل المتكلِّم العاقل
قِسمَ الشيء قسيمًا له، يُستنتج أنَّ الحور العين لسن من نوع المأكولات بل لهنَّ هويَّة أخرى اتَّضحت عَبْر الروايات السالفة الذكر. ومن هذه الروايات:
ـ دعاء الإمام زين العابدين لأهل الثغور يطلب لهم من الله إنساءَهم ذكر دنياهم الخدّاعة، وإمحاء خطرات المال الفتون عن قلوبهم، وجعْل الجنة نُصب أعينهم والتلويح لأبصارهم ما أعدّ لهم فيها: «مِنْ مَسَاكِنِ الْخُلْدِ وَمَنَازِلِ الْكَرَامَةِ، وَالْحُورِ الْحِسَانِ، وَالْأَنْهَارِ الْمُطَّرِدَةِ بِأَنْوَاعِ الْأَشْرِبَةِ وَالْأَشْجَارِ الْمُتَدَلِّيَةِ بِصُنُوفِ الثَّمَرِ»؛ لكيلا يهمّ أحدهم بالإدبار ويحدّث نفسه بالفرار. فلو كانت الحور الحسان من جنس الأشجار والأعناب لكان لزامًا ألّا يذكرهنّ عليهالسلام قسيمًا لهما ويفصل بينهما -أي الحور والأشجار- بنعمةٍ أخرى، أيْ الأنهار.
ـ ما ورد في مناجاته عليهالسلام –أيضًا- ممَّا فيه دلالة أوضح على تباين الحور العين والأعناب؛ إذ يصف عليهالسلام الجنَّة وينادي الله خاشعًا: «اللَّهُمَّ إِنَّكَ خَلَقْتَ جَنَّةً لِمَنْ أَطَاعَكَ، وَأَعْدَدْتَ فِيهَا مِنَ النَّعِيمِ الْمُقِيم ... وَأَخْبَرْتَ عَنْ سُكَّانِهَا وَمَا فِيهَا مِنْ حُورٍ عَيْنٍ كَأَنَّهُنَّ بَيْضٌ مَكْنُونٌ، وَوِلْدَانٌ كَاللُّؤْلُؤِ الْمَنْثُورِ، وَفَاكِهَةٍ وَنَخْلٍ وَرُمَّانٍ، وَجَنَّاتٍ مِنْ أَعْنَابٍ». ففي هذا الخبر يذكر الإمام السجاد عليهالسلام الحور العين وكذلك الأعناب، ولو كانتا شيئًا واحدًا لكان حشوًا ولغوًا في الكلام، بل لا توجد علاقة بينهما سوى توفُّرهما في الجنَّة لمن يدخلها.
وختامًا لهذا المبحث، نشير إلى حكايتين يعود تاريخهما إلى القرنين الأوَّل والثاني، وقد ميَّز راوِيهما بين العنب والحور؛ فهما تنفيان وتدحضان بقوَّة ما ادَّعاه لكسنبرغ من أنَّ عبارة «الحور العين» فُهمت خطأً منذ القرن الثالث للهجرة، وتُثبتان -في الوقت نفسه- وضوح الفارق الجوهريّ بين الحور العين والعنب منذ العصر النبويّ.
ـ الحكاية الأولى: نقل الأصبغ بن نباتة ـ وكان من أصحاب أمير المؤمنين عليهالسلام
ـ أنَّ جماعة من أصحاب عليٍّ عليهالسلام دخلوا عليه عليهالسلام طالبين منه المعجزة، فانطلقوا إلى الصحراء فأشار بيده المباركة نحوها، فرأوا قصورًا فاخرة، فيها حورٌ وغلمانٌ، وأشجارٌ وأنهارٌ، وطيورٌ ونباتٌ، وما كانت سوى لحظات حتى انمَحَت بأسرها.
ـ الحكاية الثانية: قصَّة رجل شارك في غزو الروم، فدخل كرمًا قبل جهاده، وبينما كان يملأ مائدته من عنبه لمح امرأة من الحور العين عيانًا فغضَّ بصره عنها، وكان أوَّل من استشهد في تلك الحرب الدامية. ولا اعتبار لصحَّة هذا النقل أو عدمه؛ إذ المهمّ هو ورود هذه الحكاية في كتابٍ أُلِّف قبل القرن الثالث الهجريّ، وهذا دليل على وجود تأويل الحور العين إلى نساء الجنَّة قبل ذلك الزمن، وليس تأويلًا مختَلَقًا من القرن الثالث فصاعدًا.
تتحدَّث جملة من الروايات الواردة عن الأئمَّة الأطهار عليهمالسلام عن فتيات الجنَّة، وبعض صفاتها وخصائصها وما يتعلَّق بها، وتستعمل في وصفها بعض الأوصاف التي استعملها القرآن الكريم في وصف الحور العين، من دون أن تشير هذه الروايات إلى عبارة «الحور العين» بحدِّ ذاتها. فهذه الروايات تبيِّن حقيقة هذه الكائنات، وتصفها بالأوصاف نفسها التي وصف بها القرآن الكريم الحور العين، وتشرح -بلسان من يعرف القرآن ظاهره وباطنه- تلك الأوصاف بما لا يبقي مجالًا للشكّ بأنَّها صفات توصف بها الفتيات والنساء لا الفواكه والأعناب. ومن هذه الأوصاف:
ـ «الأزواج المطهَّرة»: يبيَّن الإمام الصادق عليهالسلام المقصود من المطهَّرة بأنَّها المطهَّرة
من الحيض والحدث، ويفصِّل الإمام العسكري عليهالسلام المراد منها بقوله: «أَزْواجٌ مُطَهَّرَةٌ مِنْ أَنْوَاعِ الْأَقْذَارِ وَالْمَكَارِهِ، مُطَهَّرَاتٍ مِنَ الْحَيْضِ وَالنِّفَاسِ، لَا وَلَّاجَاتٍ وَلَا خَرَّاجَاتٍ وَلَا دَخَّالاتٍ وَلَا خَتَّالاتٍ وَلَا مُتَغَايِرَاتٍ وَلَا لِأَزْوَاجِهِنَّ فَرِكَاتٌ وَلَا صَخَّابَاتٍ وَلَا عَيَّابَاتٌ وَلَا فَحَّاشَاتٍ، وَمِنْ كُلِّ الْعُيُوبِ وَالْمَكَارِهِ بَرِيَّاتٍ». وقد ذُكر أنَّه من أجل ذلك سُمِّيت فاطمة الزهراء عليهاالسلام بالحوريَّة؛ فهي لم تر دمًا.
ـ «الكواعب»: فسَّرها الإمام الباقر عليهالسلام بالفتيات الناهدات.
ـ «العُرُب»: ورد عن أمير المؤمنين عليهالسلام تفسير لفظة «العَرِبَة» بالغنجة الرضيَّة المرضيَّة، في جوابه عليهالسلام لشابٍّ استفسره الآية (عُرُبًا أَتْرَابًا) .
ـ «الخيرات الحسان»: وقد فسَّرها رسول الله صلىاللهعليهوآله بخيّرات الأخلاق وحسان الوجوه، وزاد الإمام الصادق عليهالسلام: «هُنَّ صَوَالِحُ الْمُؤْمِنَاتِ الْعَارِفَات».
ذكرنا إلى هنا عددًا لا بأس به من الروايات، وهو أكثر ممَّا فيه الكفاية للحصول على التواتر المعنويّ بأنَّ المسلمين -من مختلف الاتِّجاهات المذهبيَّة- كانوا يرون الحور العين جواري الجنَّة منذ القرن الهجريّ الأوَّل، ولم يختلفوا في هويَّتهن قطُّ. وهذا دليل على أن المراد الحقيقيّ من هذا التعبير القرآنيّ كان واضحًا وضوحَ الشمس لدى المجتمع الإسلاميّ. ولو كان الرسول صلىاللهعليهوآله ـ وهو المرجع في تفسير
كلام الله سبحانه وتعالى ـ فسّره لهم بالأعناب البيض، لبَان أثرٌ من ذلك في التراث الروائيّ، أو اضطرابٌ في الروايات على أقلّ تقدير، بل قد اتَّفقت الروايات على هويَّتهن الإنسانيَّة، وما كان لهذا الاتِّفاق أن يتحقَّق إلَّا لأنَّ له مبدأً واحدًا، وهو تفسير رسول الله صلىاللهعليهوآله .
وعليه، فإنَّ نظريَّة لكسنبرغ تعارض التراث الروائي الإسلاميّ، ولا يمكن قبولها حتَّى إن فرضنا ضعف الروايات برمّتها؛ لأنَّ الروايات يعود تاريخها إلى القرن الأوَّل أو الثاني، بينما ادَّعى لكسنبرغ أنَّ دلالة الحور العين على نساء الجنَّة موضوعةٌ في القرن الثالث أو الرابع.
أثار كتاب لكسنبرغ «القراءة السريانيَّة ـ الآراميَّة للقرآن» جدلًا واسعًا في الأوساط العلميَّة، وتلقَّى ردودًا وانتقاداتٍ كثيرةً من قِبَل المستشرقين. وهي انتقادات تُثبت ـ في حدِّ نفسها ـ ضعف منهج لكسنبرغ؛ إذ لم يكن هؤلاء المنتقدون مسلمين حتَّى ينتقدوه دفاعًا عن معتقداتهم وتعاليم أسلافهم. وقد تعدَّت هذه الانتقادات وتنوَّعت على أكثر من صعيد وفي أكثر من جهة:
ـ فمنهم من عابَ على لكسنبرغ منهجه، وأنَّه ليس منهجًا فيلولوجيًّا في الأصل، بل اعتمده وسيلةً لتبرير ما افترضه مسبقًا. وفي ذلك قال «كينغ»: أغرب شيءٍ في عَمَلِه هو أنَّه يحاول بكلِّ ما أوتي من قوَّة أن يعيدَ إلى القرآن معناه الحقيقيّ عبر إيجاد الموافقة بينه وبين العهدين؛ ليؤيِّد ما ادَّعاه القرآن بشأن اتِّساقه مع العهدين. وهذا بغرابته كلِّها، نقاشٌ دينيٌّ وإيديولوجيٌّ لم يثبت من قبل، ما يضع مشروعه الفيلولوجيّ موضع ريبٍ ويجعله يبدو كلاميًّا؛ فهو يقدّم قراءةَ ما بعد الحداثة للقرآن من أجلِ حوارٍ بين الأديان. ويأتي في السياق نفسه ما قاله «غريفيث»
في ذمِّه؛ إذ يقول: يتعهَّد لكسنبرغ السيرَ على منهجٍ فيلولوجيٍّ بحت في البحث عن المواضيع؛ لكنَّه يبدأ البحث -بالتأكيد- على أساس غير فيلولوجيّ. وكذلك قول «بويرينغ»: دراسة لكسنبرغ من المنظور الفيلولوجيّ ضيِّقٌة في المنهج، وفي الوقت نفسه تخمينيَّةٌ في النتائج بوجهٍ عامّ. وهذا ماديغان يؤكِّد -أيضًا- ارتكاز دراسة لكسنبرغ على الافتراضات المسبقة اللاهوتيَّة والتأويليَّة، ويقول: إنَّ ضعفه في فهم كيفيَّة عمل اللغات وتطوُّرها يزيد الطين بلّة. وللسبب نفسه يستهزئ «وايلد» من حجَّة لكسنبرغ في ما قاله حول الآية ٧٤ من سورة الرحمن التي حاول تغيير معنى الطمث فيها لتصوُّره أنَّ الوحي لا يتحدَّث عن الجنس بصراحة، فيشبِّه محاولته بعمل شخصٍ يطبِّق المنهج الفيلولوجيّ على سِفر «نشيد الأناشيد»؛ لتضمُّنه إشاراتٍ جنسيّة؛ بغية تعديل مفرداته.
ـ ومنهم من اعتبر عمله مبنيًّا على الدور والصدفة. فهذا «هرستن» يُعرب عن أسفه لعدم تحديد لكسنبرغ معاييره في دراسته، ويقول: يواجه القارئ استدلالًا دائريًّا، إن لم يجد عمله اعتباطيًّا. وهذه «نويفيرت» ترى أنَّ كثيرًا من مواضيع لكسنبرغ يعتمد على نقاشٍ دائريٍّ واضح، وتصف السريانيَّة بالزاخرة بالمفردات الدينيَّة التي توفِّر كمِّيَّةً هائلةً من النماذج للدراسة الإتيمولوجيَّة، ولكنَّها ليست -في الوقت نفسه- بالضرورة دليلًا على تماسٍّ ثقافيٍّ بين السريانيَّة والعربيَّة، وبالتالي
تستشكل على لكسنبرغ منهجه؛ إذ اتَّخذ الأصول السريانيَّة للمفردات العربيَّة حجَّةً كلاميَّةً، إلى جانب دليلٍ على التقارض اللغويّ، ومن ثَمَّ تصف تحليله اللغوي بأنَّه آليَّة وظَّفها لتساعده على نظريَّته الكلاميَّة. أمَّا «شودري» فقد لامه على اختياره الآيات بشكلٍ عشوائيّ، على الرغم من قوله: إنَّه بصدد دراسة النصوص القرآنيَّة الصعبة.
ـ ومنَّهم من اتَّهمه باتِّخاذه هذه الدعوى بشأن لغة القرآن -من أنَّها مزيجة من العربيَّة الآراميَّة- ذريعةً من أجل تفسير القرآن كيف يشاء. قال «دونر»: يلجأ لكسنبرغ إلى تعريفٍ سقيمٍ للُّغة المزيجة، تعريفٍ يعطيه عذرًا ليدَّعي أنَّ قواعد اللغات المعروفة (يعني العربيَّة والآراميَّة) لا يمكن تطبيقها على النصوص الغامضة، وهذا يُطلِق له العنان ليصنع ظنونًا نزويَّةً حول نصوصٍ مختارة، على الرغم من أنَّها مرفوضةٌ لمخالفتها القواعد. وقوله هذا يُماثله ما صدر عن «وايلد» في هذا المجال، من أنَّ: اللغة المزيجة من العربيَّة والآرامية التي افترضها لكسنبرغ لفترة ما قبل [نزول] القرآن لا تخضع لقواعد علم الصرف العربيّ ولا الصرف الآراميّ؛ ولذلك تزداد التفاسير المحتملة [من الآيات] بينما تَقلّ المعايير للتمييز بينها. ثمَّ إنَّ دراسة النقوش المتبقيَّة من قَبل الإسلام ونشوء الخطِّ العربيّ، حدَتْ بـ«هويلاند» إلى اعتبار فكرة لكسنبرغ حول تأثُّر القرآن بالبيئة السريانيَّة نوعًا من المبالغة.
ـ ومنهم من فنّد مزاعم لكسنبرغ وفروضه المسبقة مستدلِّين بضعف وثائقه
وحججه. ومن هؤلاء: «برينشتيل» الذي نعت محاولاته بأنَّها فاشلة ومحرِّفة، قائلًا: كلّ تعديل اقترحه لكسنبرغ يثبت أنَّه بُني على مزاعمَ خاطئةٍ أو استناد خاطئٍ إلى مصادر اللغة السريانيَّة. ومنهم -أيضًا- «باستن» الذي نعت نتائجه بأنّها بعيدة التناول، ووثائقه بأنّها ضعيفة جدًّا. وكذلك «داي» الذي عاب على لكسنبرغ مهجه في أكثر من موضع، مُرجعًا السبب في استخدامه هذا المنهج إلى عدم مبالاته بالسياق التاريخيّ والأدبيّ [للآيات] واستخدامه الاعتباطيّ للأدلَّة اللغويَّة. ومثله «شودري» الذي يرى بأنَّ لكسنبرغ افترض من البداية ماهيَّةً سريانيَّةً للقرآن وقام بقراءة [الآيات] بشكلٍ يتناسب مع افتراضه هذا، ويلومه بالتالي على دراسة القرآن بمعزلٍ عن تاريخه الحقيقيّ. واستشكلت «نويفيرت» على لكسنبرغ ارتكاز نظريَّته على أسسٍ متواضعةٍ، قائلةً: لكسنبرغ لم يأخذ بعين الاعتبار المؤلَّفات السابقة عليه في شتَّى المجالات المرتبطة بالقرآن؛ لا التاريخيَّة ولا الدينيَّة، ولا التراث الجاهليّ، ولا العلاقات اليهوديَّة، على الرغم من ارتباط أبحاثه بمعظم هذه الجوانب، بل قصر نفسَه على منهجٍ لغويٍّ آليٍّ وضعيٍّ دون الالتفات إلى الملاحظات النظريَّة في علم اللسانيَّات الحديثة. وفي هذا السياق يقول «ستيوارت» أيضًا: لم يكترث لكسنبرغ بالدراسات الأكاديميَّة ذات الصلة بالموضوع، ومن الواضح أنَّه تجاهل في جملةٍ من المواضع النتائج المقبولة [يعني البحوث الأكاديميَّة] على نطاقٍ واسع، من دون أن يُقدِّم حجَّةً مقنعةً لفعله هذا. وهذا إشكالٌ واردٌ على كتاب لكسنبرغ
بكامله، ومن أجل ذلك قال «كورينت» حينما يردّ عليه: بما أنَّه ليست هناك مصادر تاريخيَّة لصدر الإسلام أو رواية موثوقة عن الوضع الاجتماعيّ واللغويّ في ذلك العصر تؤيِّد دعاوى لكسنبرغ، فهو يلفّق نظريَّته على أساس جدوى القراءة السريانيَّة ـ الآراميَّة بديلًا لفهم النصوص المبهمة من القرآن، وقد يفاجَأ الشخص بالحلّ الذي قدَّمه في كلّ حالة، فيجد قليلاً منها مقبولًا، وعلى الرغم من إمكان قبول بعضها؛ لكنَّها ليست بالضرورة صحيحةً، وبعضها الآخر يجب أن يُستبعد على الإطلاق؛ لخطأ الفهم أو المعلومات الخاطئة.
ـ ومنهم من وجد عنده مشكلة في الفهم والمعلومات، أمثال: «هابكينز» الذي رأى أنَّ لكسنبرغ ارتكب أخطاءً عدَّة في نسخ المفردات السريانيّة، وقال -بعد أن وصف منهجه بالتهوُّر: لجأ المؤلِّف غير مرَّة إلى معاجم العربيَّة المعاصرة، وهذا أمرٌ غريبٌ في دراسةٍ تركِّز على اللغة العربيَّة القديمة، وأضاف قائلًا: إلى جانب تطرُّفه في الفيلولوجيا ونزوته في التفسير، لم يحاول لكسنبرغ قطّ أن يضعَ نتائج البحث في سياقٍ تاريخيٍّ معقول. وإلى جانب ذلك، تحدَّث «غريفيث» عن سوء فهم لكسنبرغ لكتاب «أفرام»، واعتبر السببَ في ذلك تصوُّره المسبق عن الكتاب المقدَّس ورؤيته الفريدة عن أصول القرآن، ثم عدَّ الفيلولوجيا آليَّةً وظَّفها لكسنبرغ لإنتاج قراءةٍ جديدةٍ عن القرآن. وتوقّعَ «دي بلوا» أن تُشكِّل هذه البدع والشذوذ جاذبيَّةً للكتاب لدى العامَّة، على الرغم من أنَّه لا يسلط الضوء على القرآن أو تاريخ الإسلام.
وهذا غيض من فيض. وثمَّة ردودٌ جمَّةٌ أخرى لا تتَّسع لها هذه العجالة.
لا شكَّ أنَّ للمصادر التي يراجعها المؤلِّف ويسند إليها قولَه دخلًا في اعتبار بحثه، بحيثُ يستطيع القارئ أن يثق بنتائج البحث في ما إذا كانت المصادرُ معتمدة وموثوقة، بينما تقلّ صلاحيَّة البحث ونتائجه ويضعف اعتبارهما في ما إذا كانت المصادر ضعيفةً وتَجَاهل المؤلِّف المصادر الموثوقة. وضعف المصادر هذا سمةٌ ملحوظة في كتاب القراءة السريانيَّة ـ الآراميَّة للقرآن عامَّة، وفي الفصلين الرابع عشر والخامس عشر خاصَّةً.
فعلى صعيد التفاسير، لم يراجع لكسنبرغ من التفاسير سوى تفسير الطبري، بل وصل به الأمر في بعض الأحيان إلى تجاهل بعض ما يقوله الطبري نفسه أو الاستهزاء ببعض ما أورده عن الصحابة والتابعين. ولم يدرس آراء علماء المسلمين، ولا سيَّما الشيعة منهم، ولم يراجع من مؤلَّفاتِهم شيئًا.
وعلى صعيد الرجوع إلى القواميس والمعاجم العربيَّة، فلم يرجع إلَّا إلى لسان العرب. وهذه بدعة غريبة؛ فإنَّ هذا الكتاب من المصادر المتأخِّرة في علم اللغة، ويحتوي على المعاني الحديثة للمفردات الواردة فيه، وابن منظور [م ٧١١ هـ.ق] نفسه يقول إنَّه جمع فيه ما ورد في كتب أهل اللغة المتقدِّمين عليه. فكان على لكسنبرغ النظر في هذه المعاجم المتقدِّمة المعتبرة لأجل العثور على معاني المفردات القرآنيَّة.
وأمَّا بالنسبة إلى المعاجم السريانيَّة والآراميَّة، فقد استخدم لكسنبرغ المعجم الكلدانيّ لـ«أوجين منّا»، ومعجم «تزاروس» السريانيّ لـ«باين اسميث»، مضافًا إلى
المعجم السريانيّ لـ«كارل بروكلمان». وقد أثبتنا -في ما سبق- أنَّ لكسنبرغ اختار المعنى الذي يحلو له، وأغمض عن المعنى المتناسب مع التفاسير الإسلاميَّة.
وبناءً على هذا كلِّه، فإنَّ دراسة لكسنبرغ تفتقر إلى المصادر الموثوقة، وتعاني من تجاهل الحقيقة وكلّ ما خالف نظريَّته.
تبين ممَّا تقدَّم أنَّ المستشرق «كريستوف لكسنبرغ» حاول أن يقدِّم قراءةً جديدةً للقرآن الكريم في كتابه المسمَّى بـ«القراءة السريانيَّة-الآراميَّة للقرآن». وتتلخَّص أهمّ دعاويه في نقاط ستّ:
1- نزل القرآن بلغةٍ مزيجةٍ من العربيَّة والآراميَّة، وهي اللغة التي كانت مستخدمةً في مكَّة أمّ القرى؛ وذلك للوجود الحاشد للعرب النصارى فيها الذين كانوا يشاركون في الطقوس المسيحيَّة-السريانيَّة، فأدخلوا عناصر ديانتهم في لغتهم العربيَّة.
2- لا توجد كتابات عربيَّة قبل القرآن؛ إذ كان الخطُّ العربيُّ متخلِّفًا إلى حدٍّ لا يصلح للكتابة به في صدر الإسلام، فكان الخطُّ السريانيُّ أنموذجًا لتطوير الخطِّ العربيِّ لدى مخترعيه، ثمَّ إنَّ الخطَّ العربيّ أخذ من الخطِّ السريانيِّ الإعجامَ.
3- ثمَّة بعض المفردات القرآنيَّة التي سُجِّلت في القرآن بشكلٍ خاطئٍ، ما أدَّى إلى الإبهام في فهم هذه الآيات وعدم التماسك في مضامين القرآن؛ وأنموذج ذلك الآية ٦٤ من سورة الإسراء، والآية ٥٣ من سورة الأحزاب.
4- ثمَّة في القرآن -أيضًا- مفرداتٌ وتعابير فُسِّرت بشكلٍ خاطئٍ، وأساءَ المسلمون فهمَها؛ لعدم علمهم باللغة السريانيَّة؛ إذ كانت هذه الكلمات سرياينَّة الأصل لا عربيَّة؛ وأنموذج ذلك الآيات التي تُشعر بوجود الجواري الحسان في الجنَّة الأخرويَّة، ويجب تعديل هذا الفهم؛ لأنَّ المقصود الحقيقيَّ منها هو: الأعناب البيض.
5- إنَّ دراسةً فيلولوجيَّةً تُعيد إلى القرآن معانيه الحقيقيَّة، وتثبِت أنَّ القرآن يتوافق مع كتاب ترانيم «أفرام» السريانيَّة؛ فلا نِعَمَ في الجنَّة القرآنيَّة -أيضًا- إلَّا من الأطعمة والأشربة، وأفضلها الأعناب البيض.
6- التفاسير الخاطئة عن الحور العين موضوعة في القرن الثالث الهجريّ فصاعدًا.
وقد أثبتنا في ما سبق أنَّ هذه الدعاوى لا تمتّ إلى الواقع بصلة؛ لتعارضها مع حقائق كثيرة؛ منها:
1- لم يثبت تاريخيًّا أنَّ اللغة السريانيَّة هيمنت على أهل مكَّة، أو كانت منطوقة لديهم بشكلٍ واسع النطاق؛ بل تُظهر الدراسات التاريخيّة أنَّ مكَّة كانت مأهولةً بالعرب قبل الإسلام.
2- لم تكن هناك جماعةٌ مسيحيَّةٌ متأصلةً في مكَّة أو في يثرب قبل الإسلام، بل كان المسيحيُّون جاليةً قليلة العدد، ولم يتمتَّعوا بالنفوذ فيهما، فضلًا عن إدخال عناصر ديانتهم أو نشرها في أناسٍ أقاموا على عبادة الأصنام منذ عهودٍ سحيقة.
3- أنزل الله -تعالى- القرآن الكريم باللغة العربيَّة الفصحى، وهي التي اصطلحنا عليها باللغة المشتركة، لا لغة قريش أو أيّ قبيلة أخرى بعينها، فهي لغةٌ نشأت بشكلٍ غير شعوريٍّ في مكَّة؛ بسبب اختلاط وفود الحجاج، ونمت وازدهرت في الأسواق الأدبيَّة التي كانت تعقد قبل الإسلام، وهي متأثِّرةٌ تأثُّرًا شديدًا بلغة قريش، ولكنَّها -في الوقت نفسه- تتفوَّق عليها وعلى أيّ لغة غيرها.
4- تُظهر دراسة النقوش المكتشفة أنَّ الخطَّ العربيَّ مشتقٌّ من الخطِّ النبطيِّ، وهو فرعٌ من الخطِّ الآراميّ الذي يرجع أصله إلى الخطِّ الفينيقيّ، وهو بدوره مأخوذٌ من الخطِّ المصريّ القديم.
5- كانت ظاهرة الإعجام والتنقيط معروفةً عند العرب في عهد رسول الله صلىاللهعليهوآله، وقد عُثر على نقوشٍ نبطيَّةٍ، وفيها حروفٌ معجمةٌ؛ لكنَّ إهمال الإعجام كان شائعًا للغاية؛ فنادرًا ما يُعثر على وثيقةٍ عربيَّةٍ تحمل نقط الإعجام ويعود تاريخها إلى ذلك الزمن.
1- الفحص في المعاجم السريانيَّة وغيرها يُثبت أنَّ لكسنبرغ اختار من معاني المفردات ما يتناسب مع نظريَّته، وتجاهلَ المعاني الأخرى في المعاجم نفسها، والتي تؤيِّد تفاسير العلماء المسلمين للآيات.
2- إنَّ مفردة «الحور» والمفردات الأخرى التي عرَّفها لكسنبرغ بميِّزات أعناب الجنَّة وصفاتها كانت معروفةً لدى الشعراء الجاهليِّين لوصف جمال المرأة، فلم يكن القرآن أوَّل من وصف المرأة بهذه الأوصاف، ولم يكن استخدامها من قِبَلِه غريبًا عند العرب أو مذهلًا لهم.
3- إنَّ التفاسيرَ التي قدَّمها لكسنبرغ لبعض الآيات لا تتناسب مع السياق القرآنيّ، وتارةً تعطي للآية معنى مضحِكًا لا يمكن القبول به.
4- تُظهر الروايات الإسلاميَّة -بالتواتر المعنويّ- أنَّ تعبير «الحور العين» والتعابير الأخرى المماثلة لها تدلُّ على كائناتٍ أنثويَّة، يستمتع بهنَّ المؤمنون في الجنَّة. وهذا ما يُبطل دعاوى لكسنبرغ بشأنها.
5- وجَّه جملة من المستشرقين انتقاداتٍ حادَّة إلى لكسنبرغ وخطّأوا منهجَه ونتائجَ بحثه، وهذا أقوى دليل على فشله في فكِّ غموض القرآن، خلافًا لما يَظهر من عنوان كتابه.
6- لم يُراجع لكسنبرغ من تفاسير المسلمين سوى تفسير الطبري. وهذا التغاضي عن المصادر الإسلاميَّة الأخرى، وخصوصًا مؤلَّفات علماء الشيعة، دليلٌ على ضعف مستواه العلميّ في هذا المجال.
سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ
وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ
وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

خارطة أسماء المدن الواردة في هذا الكتاب
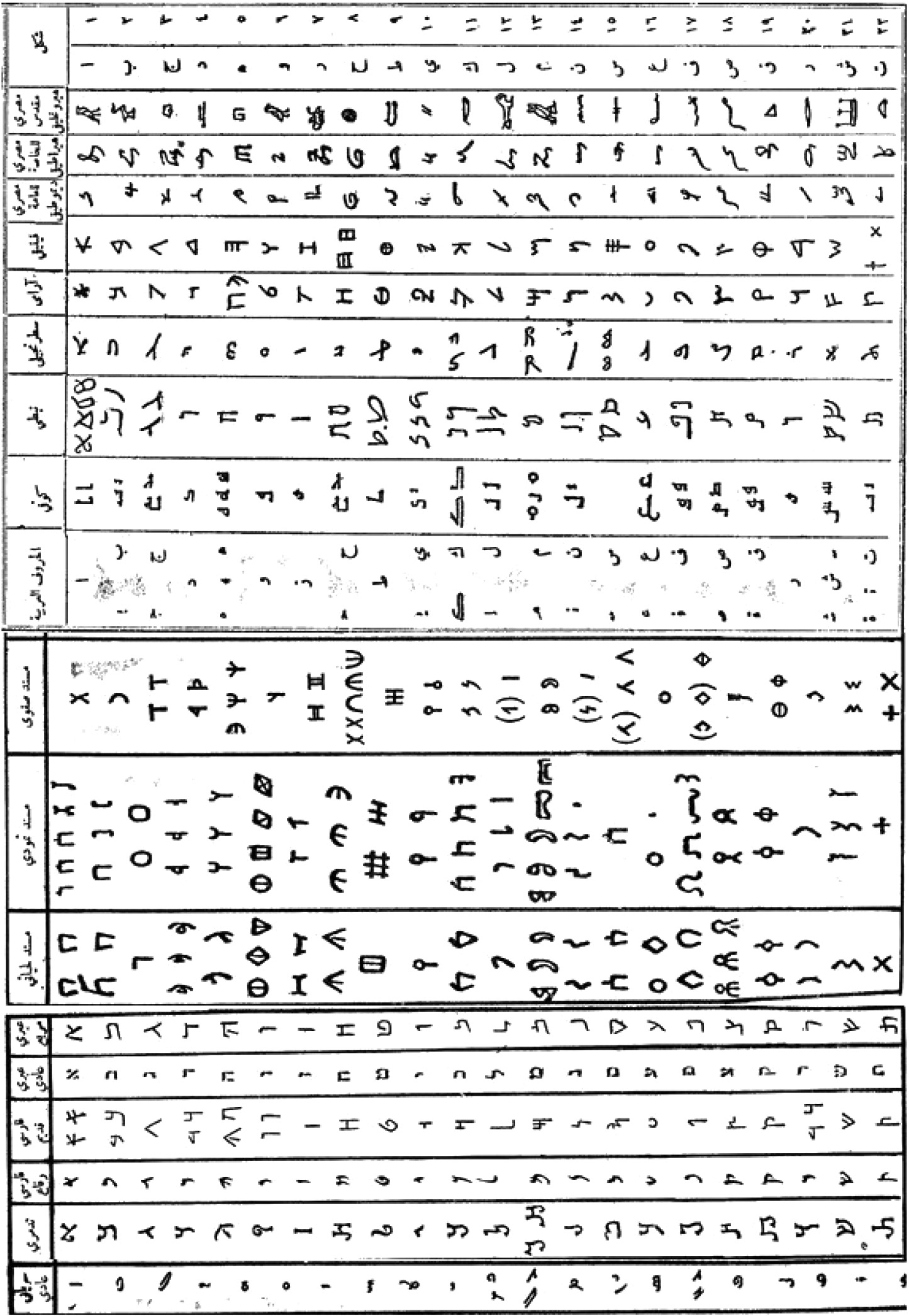
جدول المقارنة بين الأقلام
(165)صورٌ من النقوش المكتشفة ونقحرتها وترجمتها
1- نقش أمّ الجمال الأوَّل
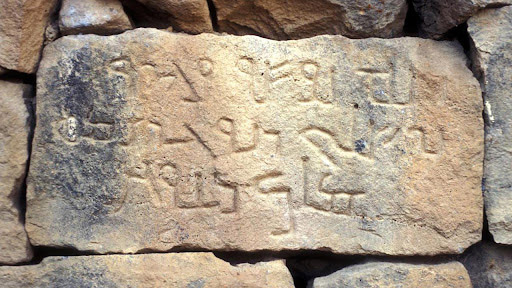
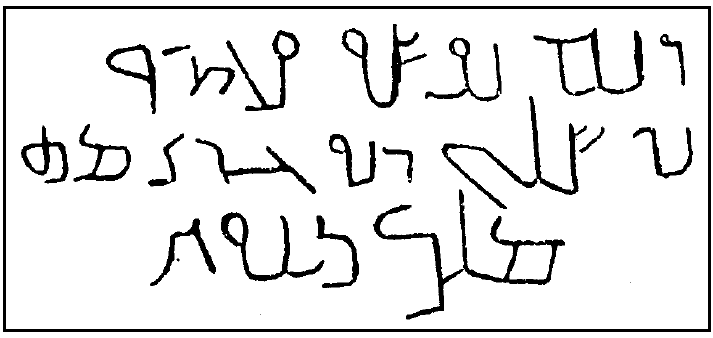
دنه نفسو فهربر سلي ربو جذيمت ملك تنوخ
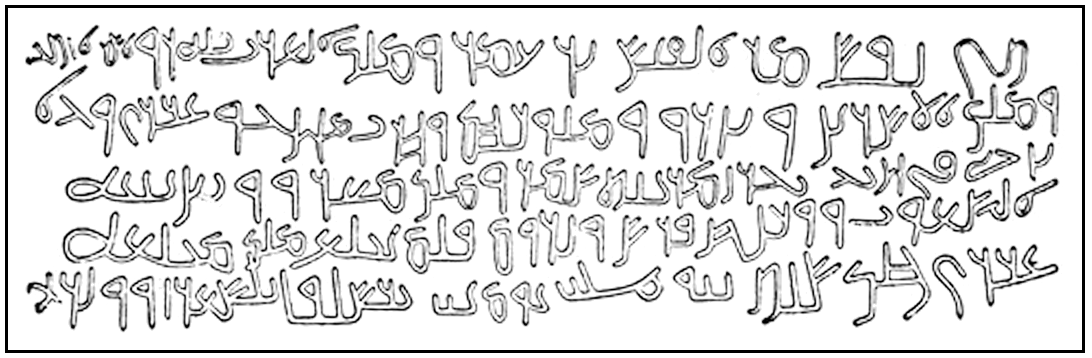
هذا قبر فهر بن سلي مربي جذيمة ملك تنوخ
2- النمارة

تي نفس مر القيس بر عمرو ملك العرب كله ذو أسر التج
وملك الأسدين ونزرو وملوكهم وهرب مذحجو عكدي وجا
بزجي في حبج نجرن مدينة شمر وملك معدو ونزل بنيه
الشعوب ووكلهن فرسو لروم فلم يبلغ ملك مبلغه
عكدي هلك سنة 223 يوم بكسلول بلسعد ذو ولده
هذا قبر امرئ القيس بن عمرو ملك العرب كلهم الذي حاز التاج
وملك الأسدين ونزارًا وملوكَهم وهزّم مزحج بقوته وجاء
إلى نزجي في حبج نجران مدينة شمر وملّك معدًا وقسّم بين بنيه
[أرض] الشعوب ووكّله الفرس والروم فلم يبلغ ملك مبلغه
في الحول عكدي هلك سنة 223 يوم سبعة من كسلول ليسعد الذي ولدَه
3 - زبد
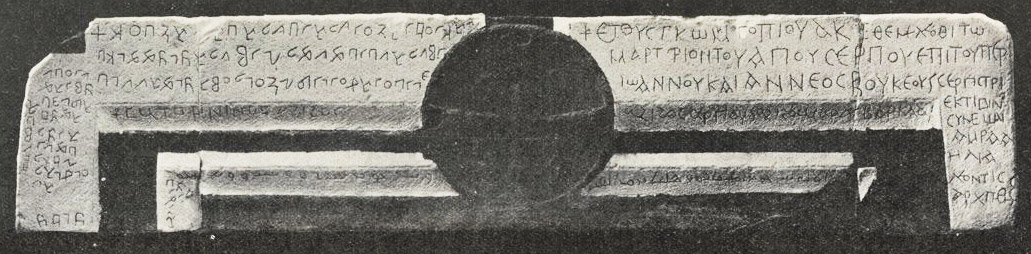
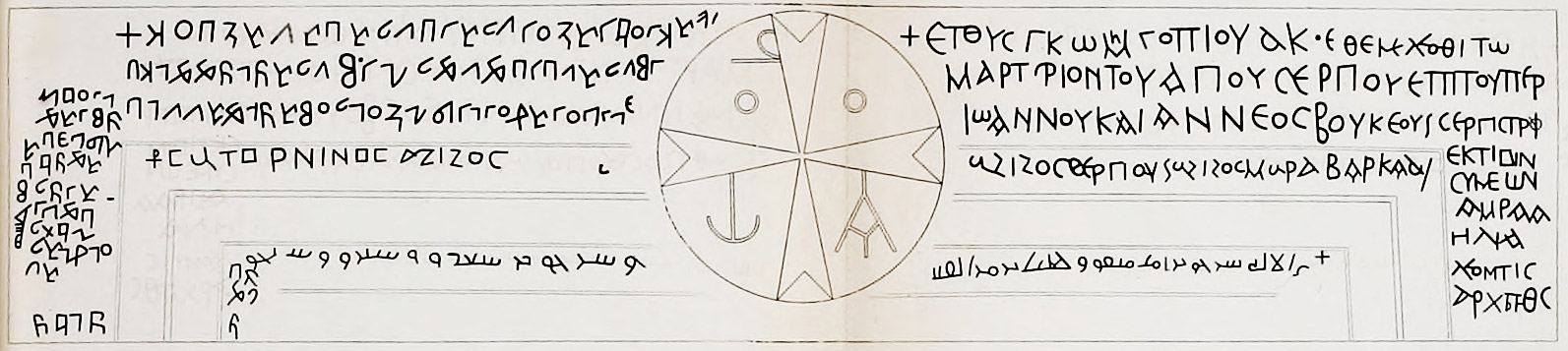
قراءة ليتسبارسكي: [بسـ]م الإله شرحو... بر مع قيمو... بر مر القس
قراءة ليتمان: [بنصر] الإله شرحو بر امت منفو وظبى بر مر القس
وشرحو بر سعدو وستر وشريحو بتميمي (المفردة الاخيرة مكتوبة بالسريانية)
4 - جبل أُسَيس

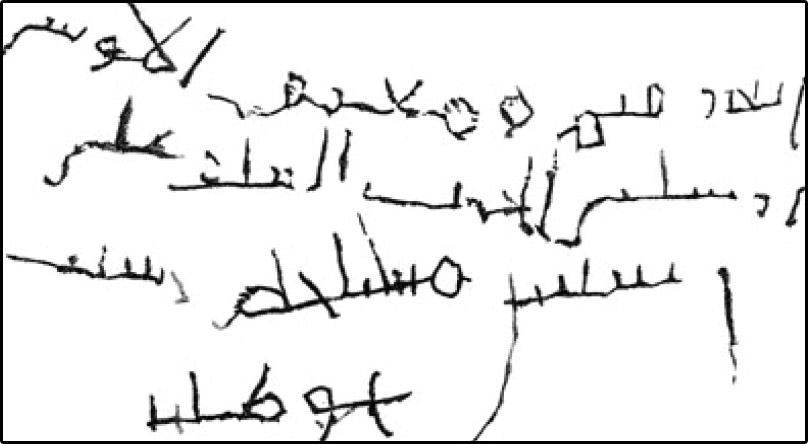
أنه قيم/قثم بن مغيرة الأوسي
أرسلني الحرث الملك على أسيس مسلحة سنت 423
5 - حران

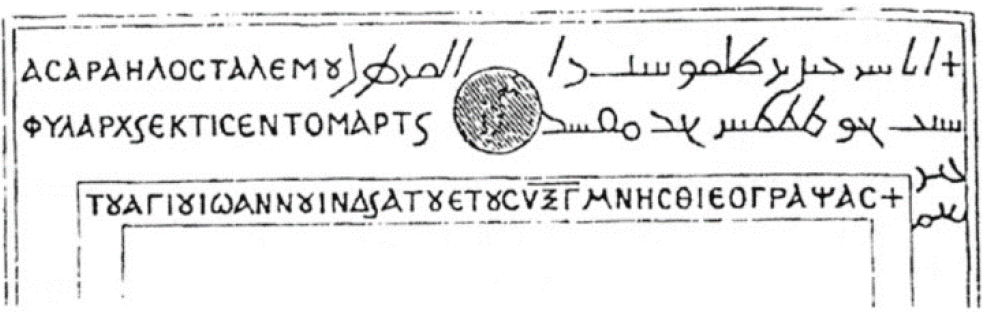
أنا شر حيل بر ظلمو بنيت ذا المرطول
سنت 463 بعد مفسد
خيبر
بعم
أنا شراحيل بن ظالم بنيت هذه الكنيسة
سنت 463 بعد مفسد
خيبر
بعام
6 - أمّ الجمال الثاني

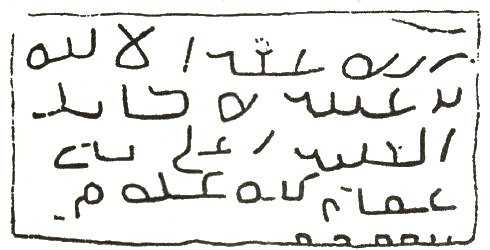
الله غفرا لاليه
بن عبيدة كاتب
الخبير اعلى بنى
عمري صلو عليه من
يقراه
يا رب اغفر لأليه بن عبيدة الكاتب
الخبير أششرف بني
عمرو ادعُ له أيها
القارئ
7 - ورق بردي يعود إلى سنة 22 للهجرة
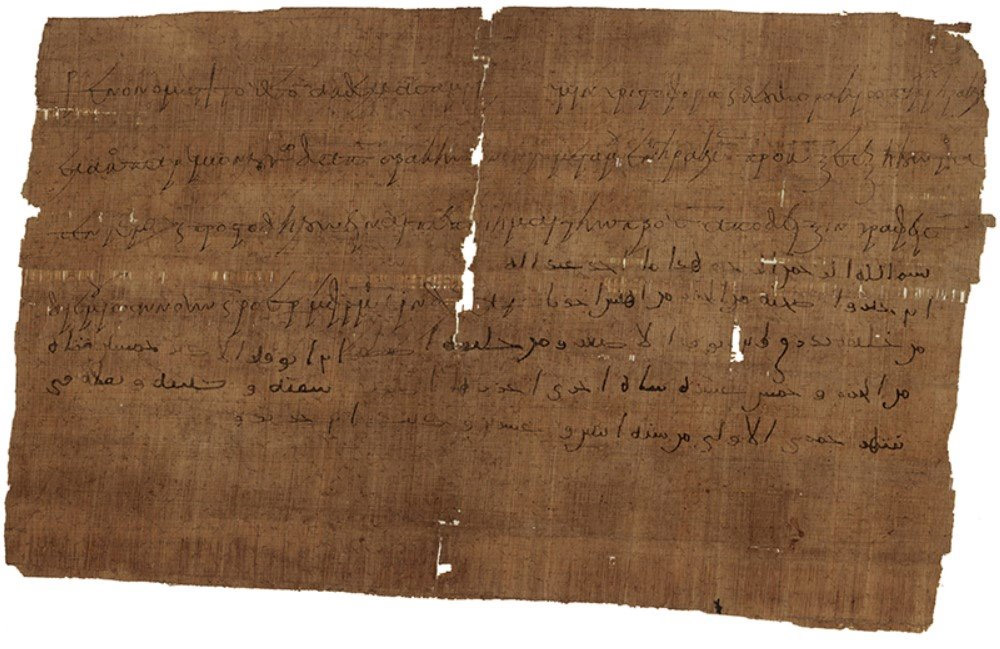
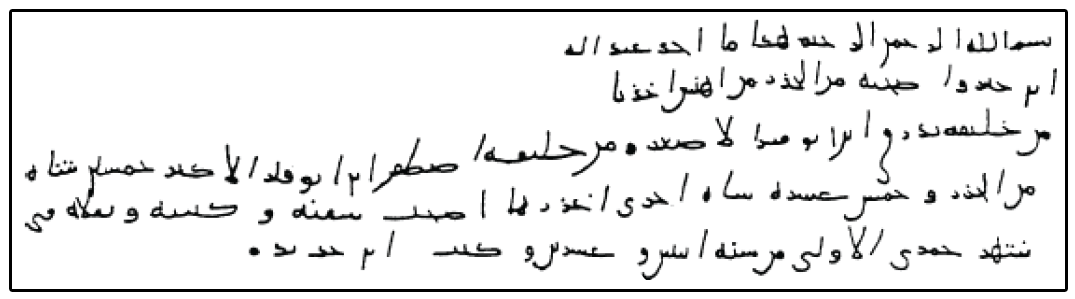
بسم الله الرحمن الرحيم هذا ما أخذ عبد الله
ابن جبير وأصحبه من الجزر من أهنس أخذنا
من خليفة تذرق ابن أبو قير الأصغر ومن خليفة اصطفن ابن أبو قير الأكبر خمسين شاة
من جزر وخمسة عشرة شاة أخرى أجزرها أصحب سفنة وكتتبه وثقلاه في
شهر جمدي الأولى من سنة اثنتين وعشرين وكتب ابن حديده
8 - سدّ الطائف

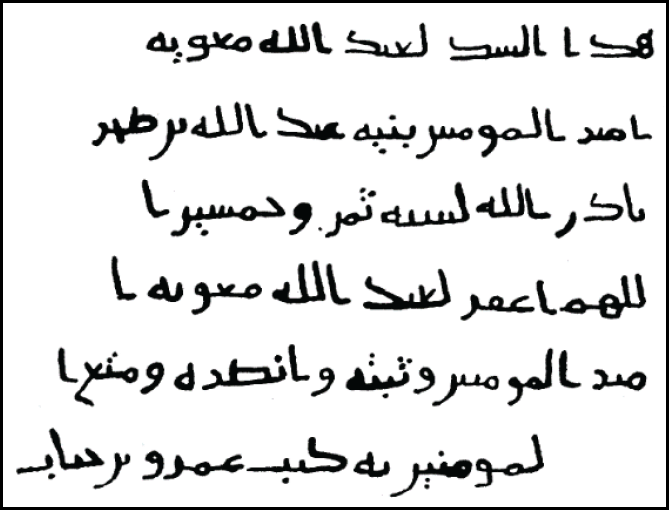
هذا السد لعبد الله معاوية أمير المؤمنين بنيه عبد الله بن صخر
بإذن الله لسنة ثمن وخمسين اللهم اغفر لعبد الله معاوية امير المؤمنين وثبّته وانصره ومتّع المؤمنين به كتب عمرو بن جناب
(172)
9 - زهير
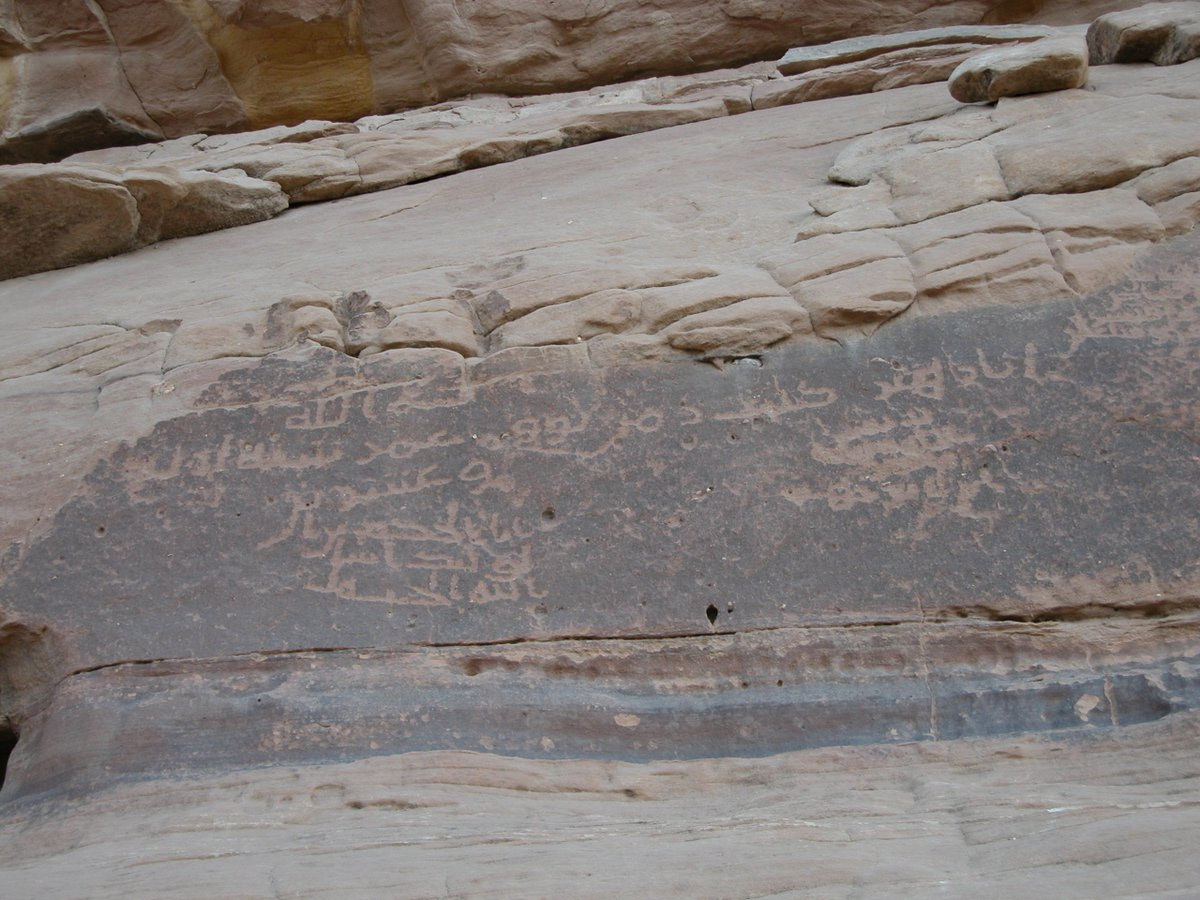
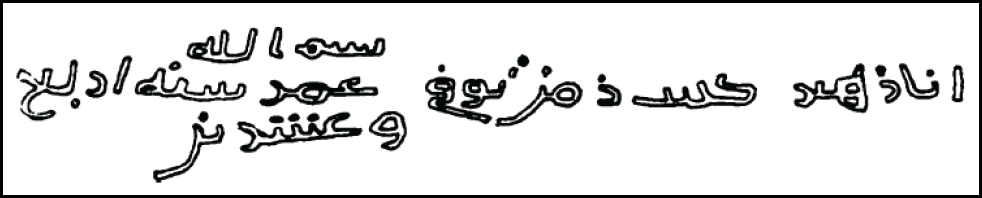
بسم الله أنا زهير كتبت زمن توفي عمر سنة أربع وعشرين
10 - نقش نبطيّ منقَّط
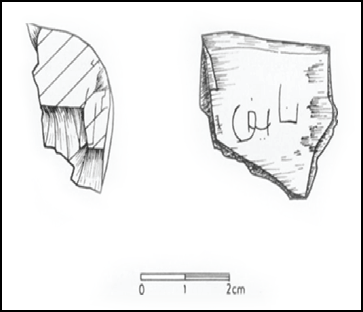
(173)
ـ القرآن الكريم
1. ابن أبي خازم الأسديّ، بشر: ديوان بشر، جمع وتحقيق: مجيد طراد، لا ط، بيروت، دار الكتاب العربيّ، 1415هـ.ق.
10. ابن النديم، محمَّد بن إسحاق: الفهرست، تحقيق: إبراهيم رمضان، بيروت، دار المعرفة، 1417هـ.ق.
100. الفاصل بين الحقّ والباطل من مفاخر أبناء قحطان واليمن، تحقيق: محمَّد عبد الرحيم جازم؛ منير عربش، لا ط، صنعاء، المعهد الفرنسيّ للآثار والعلوم الاجتماعيَّة والمعهد الألمانيّ للآثار، 1430هـ.ق.
101. الفاكهي، محمَّد بن إسحاق: أخبار مكَّة في قديم الدهر وحديثه، تحقيق: عبد الملك عبد الله دهيش، لا ط، بيروت، دار خضر، 1414هـ.ق.
102. الفتَّال، محمَّد بن أحمد: روضة الواعظين و بصيرة المتَّعظين، لا ط، قم المقدَّسة، انتشارات رضي، 1375هـ.ش.
103. الفخر الرازي، محمَّد بن عمر: التفسير الكبير، تصحيح: مكتب تحقيق دار إحياء التراث العربيّ، ط3، بيروت، دار إحياء التراث العربيّ، 1420هـ.ق.
104. الفرَّاء، يحيى بن زياد: معاني القرآن، تحقيق: أحمد يوسف النجاتي ومحمَّد علي النجَّار، لا ط، القاهرة، الدار المصريَّة للتأليف والترجمة، 1980م.
105. الفراهيدي، الخليل بن أحمد: العين، لا ط، قم المقدَّسة، نشر هجرت، 1409هـ.ق.
106. الفيروز آبادي، محمَّد بن يعقوب: بصائر ذوي التمييز فى لطائف الكتاب العزيز، لا ط، القاهرة، المجلس الأعلى للشؤون الإسلاميَّة، 1416هـ.ق.
107. الفيض الكاشانيّ، محسن: تفسير الصافي، تحقيق: حسين أعلمي، لا ط، طهران، مكتبة الصدر، 1415هـ.ق.
108. القرطبي، محمَّد بن أحمد: الجامع لأحكام القرآن، تحقيق: أحمد البردوني؛ إبراهيم أطفيش، ط2، القاهرة، دار الكتب المصريَّة، 1962م.
109. القشيري، عبد الكريم بن هوازن: لطائف الإشارات، تحقيق: إبراهيم البسيوني، لا ط، مصر، الهيئة المصريَّة العامَّة للكتاب، لا ت.
110 ابن بابويه، محمَّد بن عليّ: الأمالي، لا ط، طهران، کتابچي، 1376هـ.ش.
110. القميّ، عليّ بن إبراهيم: تفسير القميّ، تصحيح: طيِّب موسويّ جزائريّ، لا ط، قم المقدَّسة، دار الكتب، 1404هـ.ق.
111. الكردي، محمَّد طاهر بن عبد القادر: تاريخ الخطّ العربيّ وآدابه، لا ط، لا م، مكتبة الهلال، 1939م.
112. الكلينيّ، محمَّد بن يعقوب: الكافي، تحقيق: علي أكبر الغفَّاري، لا ط، طهران، دار الكتب الإسلاميَّة، 1407هـ.ق.
113. الكمالي، طلال فائق: نظريَّة الهيمنة في القرآن الكريم، لا ط، كربلاء المقدَّسة، مركز كربلاء للدراسات والبحوث، 1427هـ.ق.
114. الكوفي الأهوازي، الحسين بن سعيد: الزهد، تحقيق: غلام رضا عرفانيان يزدي، لا ط، قم المقدَّسة، المطبعة العلميَّة، 1402هـ.ق.
115. المبرَّد، محمَّد بن يزيد: التعازي، تحقيق: إبراهيم محمَّد حسن الجمل، لا ط، مصر، نهضة مصر للطباعة والنشر والتوزيع، لا ت.
116. المبرّد، محمَّد بن يزيد: نسب عدنان وقحطان، تحقيق: عبد العزيز الميمنيّ الراجكوتيّ، لا ط، الهند، لا ن، 1936م.
117. المجلسي، محمَّد باقر: بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمَّة الأطهار، تحقيق: جمعٌ من المحقِّقين، لا ط، بيروت، دار إحياء التراث العربيّ، 1403هـ.ق.
118. المجلسي، محمَّد باقر: مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، تصحيح: هاشم رسولي محلاتي، لا ط، طهران، دار الكتب الإسلاميَّة، 1404هـ.ق.
119. المظفر، محمَّد رضا: المنطق، لا ط، قم المقدَّسة، مؤسَّسة انتشارات دار العلم، 1394هـ.ق.
120 ابن بابويه، محمَّد بن علي: الخصال، تحقيق: علي أكبر الغفَّاري، لا ط، قم المقدَّسة، مؤسَّسة النشر الإسلاميَّ التابعة لجماعة المدرِّسين، 1362هـ.ش.
120. المفيد، محمَّد بن محمَّد: الاختصاص، تحقيق: علي أكبر الغفَّاري؛ محمود محرمي زرندي، لا ط، قم المقدَّسة، المؤتمر العالميّ لألفيَّة الشيخ المفيد، 1413 (ب) هـ.ق.
121. المفيد، محمَّد بن محمَّد: الأمالي، تحقيق: حسين استاد ولي؛ عليّ أكبر غفَّاري، لا ط، قم المقدَّسة، کنگرهي شيخ مفيد، 1413 (أ) هـ.ق.
122. الموصلي، أحمد بن عليّ: مسند أبي يعلى، تحقيق: حسين سليم أسد، لا ط، دمشق، دار المأمون للتراث، 1404هـ.ق.
123. الميداني، أحمد بن محمَّد: مجمع الأمثال، تحقيق: محمَّد محي الدين عبد الحميد، لا ط، بيروت، دار المعرفة، لا ت.
124. النابغة الذبياني، زياد بن معاوية بن ضباب المري: ديوان النابغة الذبياني، جمع وتحقيق: حنَّا نصر الحتّي، لا ط، بيروت، دار الكتاب العربيّ، 1411هـ.ق.
125. اليزيدي، عبدالله بن يحيى: غريب القرآن وتفسيره: تحقيق: محمَّد سليم الحاجّ، لا ط، بيروت، عالم الكتب، 1405هـ.ق.
126. امرؤ القيس، ابن حجر بن الحارث الكنديّ: ديوان امرئ القيس، تحقيق: مصطفى عبد الشافي، لا ط، بيروت، دار الكتب العلميَّة، 1425هـ.ق.
127. أنيس، إبراهيم: من أسرار اللغة، لا ط، القاهرة، مكتبة الأنجلو المصريَّة، 1966م.
128. بروكلمان، كارل: فقه اللغات الساميَّة، ترجمة: رمضان عبد التوَّاب، لا ط، المملكة العربيَّة السعوديَّة، جامعة الرياض، 1977م.
129. تفليسي، حبيش بن إبراهيم: وجوه قرآن، لا ط، طهران: دانشگاه طهران، ۱۳۷۱هـ.ش.
130 ابن بابويه، محمَّد بن عليّ: ثواب الأعمال وعقاب الأعمال، لا ط، قم المقدَّسة، دار الشريف الرضي للنشر، 1406هـ.ق.
130. حاجي خليفة، مصطفى بن عبد الله: كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون، لا ط، بغداد، مكتبة المثنى، 1941م.
131. حسام الدين، كريم زكي: العربيَّة تطوُّر وتاريخ، لا ط، لا م، لا ن، 1422هـ.ق.
132. حسان، تمام: الأصول دراسة إبستيمولوجيَّة للفكر اللغويّ عند العرب، لا ط، القاهرة، عالم الكتب، 1420هـ.ق.
133. خشيم، علي فهمي: هل في القرآن أعجميّ: نظرة جديدة إلى موضوع قديم، لا ط، بيروت، دار الشرق الأوسط، 1997م.
134. ديورانت، ويل: قصَّة الحضارة، ترجمة: زكي نجيب محمود وآخرون، لا ط، بيروت، دار الجيل، 1408هـ.ق.
135. ذنون، يوسف: «قديم وجديد في أصل الخطّ العربيّ وتطوّره في عصوره المختلفة»، مجلَّة المورد، المجلَّد 15، العدد 4، 1986م.
136. رضا، أحمد: رسالة الخطّ، لا ط، صيدا، مطبعة العرفان، 1332هـ.ش.
137. زالي، آن؛ بيرثييه، آني: تاريخ الخطّ العربيّ وغيره من الخطوط العالميَّة، ترجمة: سالم سليمان العيسى، لا ط، دمشق، الأوائل، 2004م.
138. شيخو، لويس: النصرانيَّة وآدابها بين العرب الجاهليَّة، لا ط، بيروت، دار المشرق، 1989م.
139. صالح، سلوى بالحاج: المسيحيَّة العربيَّة وتطوُّراتها من نشأتها إلى القرن الرابع الهجريّ، لا ط، بيروت، دار الطليعة، 1998م.
140 ابن بابويه، محمَّد بن عليّ: علل الشرائع، لا ط، قم المقدَّسة، كتاب فروشی داوری، 1385هـ.ق.
140. ضمرة، إبراهيم: الخطّ العربيّ جذوره وتطوّره، لا ط، الأردن، مكتبة المنار، 1407هـ.ق.
141. ضيف، شوقي: تاريخ الأدب العربيّ العصر الجاهليّ، لا ط، القاهرة، دار المعارف، 1940م.
142. ظاظا، حسن: الساميُّون ولغاتهم، لا ط، دمشق، دار القلم، 1410هـ.ق.
143. عبَّاس، إحسان: تاريخ دولة الأنباط، لا ط، الأردن، دار الشروق، 1987م.
144. عبد الباقي، محمَّد فؤاد: المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم، لا ط، القاهرة، دار الحديث، 1364هـ.ق.
145. عبد التوَّاب، رمضان: فصول في فقه العربيَّة، لا ط، القاهرة، الخانجي، 1420هـ.ق.
146. علي، جواد: أصنام الكتابات، لا ط، بغداد، دار الورَّاق، 2007م.
147. عمر، أحمد مختار؛ مكرم، عبد العال سالم: معجم القراءات القرآنيَّة، لا ط،
الكويت، مطبوعات جامعة الكويت، 1408هـ.ق.
148. عوَّاد، كوركيس: مكتبة نور أقدم المخطوطات العربيَّة في مكتبات العالم، لا ط، العراق، دار الرشيد للنشر، 1982م.
149. كانتينو، ج.: اللغة النبطيَّة، ترجمة: مهدي الزعبي، لا ط، الأردن، وزارة الثقافة، 2015م.
15. ابن بابويه، محمَّد بن عليّ، عيون أخبار الرضا عليهالسلام، تحقيق: مهدي لاجوردي، لا ط، طهران، نشر جهان، 1378هـ.ش.
150. ماسبيرو، غاستون: تاريخ المشرق، ترجمة: أحمد زكي، لا ط، القاهرة، هنداوي، 2014م.
151. مختار، أحمد: معجم اللغة العربيَّة المعاصرة، لا ط، لا م، عالم الكتب، 1429هـ.ق.
152. معرفت، محمَّد هادي: شبهات وردود حول القرآن، لا ط، قم المقدَّسة، مؤسَّسة التمهيد، 1423هـ.ق.
153. مغنية، محمَّد جواد: شبهات الملحدين والإجابة عنها، لا ط، بيروت، دار ومكتبة الهلال، 1984م.
154. منّا، يعقوب أوجين: قاموس كلدانيّ عربيّ، تصحيح: روفائيل بيداويد، لا ط، بيروت، منشورات مركز بابل، 1975م.
155. مهنّا، عبد: معجم النساء الشاعرات في الجاهليَّة والإسلام، لا ط، بيروت، دار الكتب العلميَّة، لا ت.
156. ناصف، حفني: حياة اللغة العربيَّة، لا ط، لا م، مكتبة الثقافة الدينيَّة، 1423هـ.ق.
157. نامي، خليل يحيى: أصل الخطّ العربيّ وتاريخ تطوّره إلى ما قبل الإسلام، لا ط، القاهرة، مطبعة بول باربيه، 1935م.
158. نولدكه، تيودور: تاريخ القرآن، ترجمة: جورج تامر، ط1، بيروت، نشر جورج ألمز، 2004م.
159. ولفسون، إسرائيل: تاريخ اللغات الساميَّة، لا ط، مصر، مطبعة الاعتماد، 1929م.
16. ابن جناب الكلبيّ، زهير: ديوان زهير بن جناب الكلبيّ، جمع وتحقيق: محمَّد شفيق البيطار، لا ط، بيروت، دار صادر، 1999م.
160. يموت، بشير: شاعرات العرب في الجاهليَّة والإسلام، لا ط، بيروت، المكتبة الأهليَّة، 1352هـ.ق.
161.ابن العربيّ، محمَّد بن عبد الله: أحكام القرآن، تحقيق: محمَّد عبد القادر عطا، لا ط، بيروت، دار الكتب العلميَّة، 1424هـ.ق.
162.ابن بابويه، محمَّد بن عليّ: من لا يحضره الفقيه، تحقيق: علي أكبر الغفَّاري، لا ط، قم المقدَّسة، مؤسَّسة النشر الإسلاميّ التابعة لجماعة المدرِّسين، 1413هـ.ق.
163.ابن حجر، أوس: ديوان أوس بن حجر، جمع وتحقيق: محمَّد يوسف نجم، لا ط، بيروت، دار بيروت للطباعة والنشر، 1400هـ.ق.
164.ابن دريد، محمَّد بن الحسن: جمهرة اللغة، تحقيق: رمزي منير بعلبكي، لا ط، بيروت، دار العلم للملايين، 1988م.
165.ابن شدَّاد، عنترة: ديوان عنترة بن شدَّاد، جمع وتحقيق: محمَّد معروف الساعدي، لا ط، بيروت، دار الكتب العلميَّة، 2009م.
166.ابن شهر آشوب، محمَّد بن عليّ: مناقب آل أبي طالب عليهم السلام، لا ط، قم المقدَّسة، علامة للنشر، 1379هـ.ش.
167.ابن عبد البرّ، يوسف بن عبد الله: التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد، تحقيق: مصطفى بن أحمد العلويّ؛ محمَّد عبد الكبير البكريّ، لا ط، المغرب، وزارة عموم الأوقاف والشؤون الإسلاميَّة، 1387هـ.ق.
168.ابن علس، المسيِّب: ديوان المسيِّب بن علس، جمع وتحقيق: عبد الرحمن محمَّد الوصيفي، لا ط، القاهرة، مكتبة الآداب، 1423هـ.ق.
169.ابن فارس، أحمد: معجم مقاييس اللغة، تحقيق: عبد السلام هارون، لا ط، قم المقدَّسة، مكتب الإعلام الإسلاميّ، 1404هـ.ق.
170 ابن جندل، سلامة: ديوان سلامة، جمع وتحقيق: محمَّد بن الحسن الأحول، لا ط، بيروت، دار الكتاب العربيّ، 1414هـ.ق.
170.ابن قتيبة، عبد الله بن مسلم: تأويل مشكل القرآن، تحقيق: إبراهيم شمس الدين، لا ط، بيروت، دار الكتب العلميَّة، 1423هـ.ق.
171.ابن قولويه، جعفر بن محمَّد: كامل الزيارات، تحقيق: عبد الحسين أميني، لا ط، النجف الأشرف، دار المرتضويَّة، 1356هـ.ق.
172.اسكندرلو، محمد جواد؛ عتابي، أحمد سالم عبد عليّ: «ردّ شبهات يوسف درَّة الحدَّاد في كتابه القرآن دعوة نصرانيَّة»، مجلَّة دراسات استشراقيَّة (تصدر عن المركز الإسلاميّ للدراسات الاستراتيجيَّة التابع للعتبة العبَّاسيَّة المقدَّسة، بيروت، العدد 6، 2016م.
173.الأبشيهي، محمَّد بن أحمد: المستطرف في كلِّ فنٍّ مستظرف، لا ط، بيروت، عالم الكتب، 1419هـ.ق.
174.الإسكندريّ، أحمد؛ عناني، مصطفى: الوسيط في الأدب العربيّ وتاريخه، لا ط، مصر، مطبعة المعارف، 1925م.
175.الآمدي، الحسن بن بشر: المؤتلف والمختلف في أسماء الشعراء وكناهم
وألقابهم وأنسابهم وبعض شعرهم، تحقيق: ف. كرنكو، لا ط، بيروت، دار الجيل، 1411هـ.ق.
176.الأندلسي، محمَّد بن يوسف: البحر المحيط في التفسير، تحقيق: صدقي محمَّد جميل، لا ط، بيروت، دار الفكر، 1420هـ.ق.
177.الباقلاني، محمَّد بن الطيِّب: إعجاز القرآن، تحقيق: أحمد صقر، لا ط، مصر، دار المعارف، 1997م
178.البحراني، هاشم: البرهان في تفسير القرآن، تحقيق: قسم الدراسات الإسلاميَّة في مؤسَّسة البعثة، لا ط، قم المقدَّسة، مؤسَّسة البعثة، 1374هـ.ق.
179.البقاعيّ، إبراهيم بن عمر: نظم الدرر فى تناسب الآيات و السور، تحقيق: عبد الرزَّاق غالب مهدي، لا ط، بيروت، دار الكتب العلميَّة، 1427هـ.ق.
180 ابن حزم، علي بن أحمد: جمهرة أنساب العرب، لا ط، بيروت، دار الكتب العلميَّة، 1403هـ.ق.
180.الخصيبي، الحسين بن حمدان. (۱۴۱۹). الهداية الكبرى. بيروت: البلاغ.
181.الداني، عثمان بن سعيد: التيسير في القراءات السبع، تحقيق: أوتو تريزل، لا ط، بيروت، دار الكتاب العربيّ، 1404هـ.ق.
182.الشعراء الهذليُّون: ديوان الهذيليِّين، ترتيب وتعليق: محمَّد محمود الشنقيطي، لا ط، القاهرة، الدار القوميَّة للطباعة والنشر، 1385هـ.ق.
183.الطبري الآملي، محمد بن جرير. (۱۴۱۳). دلائل الإمامة. (قسم الدراسات الإسلامية مؤسسة البعثة، محقق). قم: بعثت.
184.الكوفيّ، فرات بن إبراهيم: تفسير فرات الكوفيّ، تحقيق: محمَّد كاظم، لا ط، طهران، مؤسَّسة الطبع والنشر في وزارة الإرشاد الإسلاميّ، 1410هـ.ق.
185.انظر: ابن الفخار، محمَّد بن عليّ: شرح الجمل، تحقيق: روعة ناجي، لا ط، بيروت، دار الكتب العلميَّة، 1434هـ.ق.
186.انظر: ابن قتيبة، عبد الله بن مسلم: عيون الأخبار، لا ط، بيروت، دار الكتب العلميَّة، 1418هـ.ق.
187.تأبّط شرًّا، ثابت بن جابر: ديوان تأبّط شرًّا وأخباره، جمع وشرح وتحقيق: علي ذو الفقار شاكر، لا ط، لا م، دار الغرب الإسلاميّ، 1404هـ.ق.
188.علي، جواد: المفصَّل في تاريخ العرب قبل الإسلام، لا ط، لا م، دار الساقي، 1422هـ.ق.
189.القلقشندي، أحمد بن علي: صبح الأعشى في صناعة الإنشاء، لا ط، بيروت، دار الكتب العلميَّة، لا ت.
19. ابن حنبل، أحمد: فضائل الصحابة، تحقيق: وصيّ الله محمَّد عبَّاس، لا ط، بيروت، مؤسَّسة الرسالة، 1403هـ.ق.
190.مسلم، ابن الحجَّاج: صحيح مسلم، تحقيق: محمَّد فؤاد عبد الباقي، لا ط، بيروت، دار إحياء التراث العربيّ، لا ت.
191.نامي، خليل يحيى: العرب قبل الإسلام، القاهرة، دار المعارف، 1986م.
2. ابن أبي شيبة، عبد الله بن محمَّد: الكتاب المصنَّف في الأحاديث والآثار، تحقيق: كمال يوسف الحوت، لا ط، الرياض، مكتبة الرشد، 1409هـ.ق.
20. ابن خالويه، الحسين بن أحمد: الحجَّة في القراءات السبع، تحقيق: عبد العال سالم مكرم، لا ط، بيروت، دار الشروق، 1401هـ.ق.
21. ابن خلدون، عبد الرحمن بن محمَّد: ديوان المبتدأ والخبر في تاريخ العرب والبربر ومن عاصرهم من ذوي الشأن الأكبر، تحقيق: خليل شحادة، لا ط، بيروت، دار الفكر، 1408هـ.ق.
22. ابن خلكان، أحمد بن محمَّد: وفيَّات الأعيان وأنباء أبناء الزمان، تحقيق: إحسان عبَّاس، لا ط، بيروت، دار صادر، 1900م.
23. ابن ربيعة العامريّ، لبيد: ديوان لبيد بن ربيعة العامريّ، تحقيق: حمدو طمَّاس، لا ط، بيروت، دار المعرفة، 1425هـ.ق.
24. ابن سعد، عمرو (المرقش الأكبر)؛ ابن حرملة، عمرو (المرقش الأصغر): ديوان المرقشَين، تحقيق: كارين صادر، بيروت، دار صادر، ۱۹۹۸م.
25. ابن سليمان، مقاتل: تفسير مقاتل بن سليمان، تحقيق: عبد الله محمود شحاته، لا ط، بيروت، دار إحياء التراث العربيّ، 1423هـ.ق.
26. ابن سيده، عليّ بن إسماعيل: المحكم والمحيط الأعظم، تحقيق: عبد الحميد هنداوي، لا ط، بيروت، دار الكتب العلميَّة،1421هـ.ق.
27. ابن عاشور، محمَّد الطاهر بن محمَّد: التحرير والتنوير، لا ط، تونس، الدار التونسيَّة للنشر، 1984م.
28. ابن عبَّاد، إسماعيل: المحيط في اللغة، تحقيق: محمَّد حسن آل ياسين، لا ط، بيروت، عالم الكتب، 1414هـ.ق.
29. ابن عبد ربّه، أحمد بن محمَّد: العقد الفريد، لا ط، بيروت، دار الكتب العلميَّة، 1404هـ.ق.
3. ابن الأبار، محمَّد بن عبد الله: التكملة لكتاب الصلة، تحقيق: عبد السلام الهراس، بيروت، دار الفكر، 1415هـ.ق.
30. ابن فارس، أحمد: الصاحبي في فقه اللغة العربيَّة ومسائلها وسنن العرب في كلامها، ط1، لا م، نشر محمَّد علي بيضون، 1418هـ.ق.
31. ابن قميئة، عمرو: ديوان عمرو بن قميئة، جمع وتحقيق: خليل إبراهيم العطية، لا ط، بيروت، دار صادر، 1994م، ص55..
32. ابن قيس، سليم: كتاب سليم بن قيس الهلاليّ، تحقيق: محمَّد أنصاري زنجاني خوئيني، لا ط، قم المقدَّسة، الهادي، 1405هـ.ق.
33. ابن مجاهد، أحمد بن موسى: كتاب السبعة في القراءات، تحقيق: شوقي ضيف، لا ط، مصر، دار المعارف، 1400هـ.ق.
34. ابن منظور، محمَّد بن مكرم: لسان العرب، لا ط، بيروت، دار صادر، 1414هـ.ق.
35. ابن ناقيا، عبد الله بن الحسين: كتاب الجمان في تشبيهات القرآن، تحقيق: محمود حسن أبو ناجي الشيباني، لا ط، جدَّة، براج وخطيب، 1407هـ.ق.
36. ابن هشام، جمال الدين بن يوسف: مغني اللبيب عن كتب الأعاريب، تحقيق: محمَّد محيي الدين عبد الحميد، لا ط، قم المقدَّسة، مكتبة آية الله المرعشي النجفيّ، 1404هـ.ق.
37. أبو الفرج الأصفهانيّ، علي بن الحسين: الأغاني، لا ط، بيروت، دار إحياء التراث العربيّ، 1415هـ.ق.
38. أبو عبيدة، معمر بن المثنى: مجاز القرآن، تحقيق: محمَّد فؤاد سزگين، لا ط، القاهرة، مكتبة الخانجي، 1381هـ.ش.
39. آرمسترونغ، كارين: الله والإنسان على امتداد 4000 سنة من إبراهيم الخليل حتَّى العصر الحاضر، ترجمة: محمَّد الجورا، لا ط، دمشق، دار الحصاد للنشر والتوزيع، 1996م.
4. ابن الأبرص، عبيد: ديوان عبيد بن الأبرص، جمع وتحقيق: أشرف أحمد عدرة، لا ط، بيروت، دار الكتاب العربيّ، 1414هـ.ق.
40. الآبي، منصور بن الحسين: نثر الدرّ في المحاضرات، تحقيق: خالد عبد الغني محفوظ، لا ط، بيروت، دار الكتب العلميَّة، 1422هـ.ق.
41. الأزرقي، محمَّد بن عبد الله: أخبار مكَّة وما جاء فيها من الآثار، تحقيق:
رشدي الصالح ملحس، لا ط، بيروت، دار الأندلس للنشر، 1403هـ.ق.
42. الأزهريّ، محمَّد بن أحمد: تهذيب اللغة، لا ط، بيروت، دار إحياء التراث العربيّ، 1421هـ.ق.
43. الأسد، سيِّد فرج: الكتابة من أقلام الساميِّين إلى الخطِّ العربيّ، لا ط، القاهرة، الخانجي، 1415هـ.ق.
44. الأسد، ناصر الدين: مصادر الشعر الجاهليّ، لا ط، مصر، دار المعارف، ۱۹۸۸م.
45. الأعشى الكبير، ميمون بن قيس: ديوان الأعشى الكبير، جمع وتحقيق: محمَّد حسين، لا ط، القاهرة، مكتبة الآداب، لا ت.
46. الألوسي، شهاب الدين محمود بن عبد الله: روح المعاني في تفسير القرآن العظيم و السبع المثاني، تحقيق: علي عبد الباري، لا ط، بيروت، دار الكتب العلميَّة، 1415هـ.ق.
47. الأنباري، محمَّد بن القاسم: شرح القصائد السبع الطوال الجاهليَّات، تحقيق: عبد السلام محمَّد هارون، لا ط، لا م، دار المعارف، لا ت.
48. البرقي، أحمد بن محمَّد: المحاسن، تصحيح: جلال الدين محدث، لا ط، قم المقدَّسة، دار الكتب الإسلاميَّة، 1371هـ.ق.
49. البغوي، الحسين بن مسعود: معالم التنزيل في تفسير القرآن، تحقيق: المهدي عبد الرزَّاق، لا ط، بيروت، دار إحياء التراث العربيّ، 1420هـ.ق.
5. ابن الأثير، المبارك بن محمَّد: النهاية في غريب الحديث والأثر، تحقيق: طاهر أحمد الزاوي؛ محمود محمَّد الطناحي، لا ط، بيروت، دار الكتب العلميَّة، 1399هـ.ق.
50. البلاذري، أحمد بن يحيى: فتوح البلدان، لا ط، بيروت، دار ومكتبة الهلال، 1988م.
51. البيضاوي، عبد الله بن عمر: أنوار التنزيل وأسرار التأويل، تحقيق: محمَّد عبد الرحمن المرعشلي، لا ط، بيروت، دار إحياء التراث العربيّ، 1418هـ.ق.
52. التبريزي، يحيى بن علي: ديوان الحماسة، لا ط، بيروت، دار القلم، لا ت.
53. الثعلبي، أحمد بن محمَّد: الكشف والبيان عن تفسير القرآن، تحقيق: أبو محمَّد بن عاشور، لا ط، بيروت، دار إحياء اتلتراث العربيّ، 1422هـ.ق.
54. الجبوري، سهيلة ياسين: الخطّ العربيّ وتطوّره في العصور العبَّاسيَّة في العراق، لا ط، بغداد، المكتبة الأهليَّة، 1962م.
55. الجوهريّ، إسماعيل بن حمَّاد: تاج اللغة وصحاح العربيَّة، تحقيق: أحمد عبد الغفور عطَّار، لا ط، بيروت، دار العلم للملايين، 1407هـ.ق.
56. الحرّ العامليّ، محمَّد بن الحسن: إثبات الهداة بالنصوص والمعجزات، لا ط، بيروت، مؤسَّسة الأعلمي، 1425هـ.ق.
57. الحسكاني، عبيد الله بن عبد الله: شواهد التنزيل لقواعد التفضيل، تحقيق: محمَّد باقر محمودي، لا ط، طهران، مجمع إحياء الثقافة الإسلاميَّة، 1411هـ.ق.
58. الحلبي، عليّ بن إبراهيم: السيرة الحلبيَّة، لا ط، بيروت، دار الكتب العلميَّة، 1427هـ.ق.
59. الحمد، غانم قدوري: علم الكتابة العربيَّة، عمان، دار عمار، 1425هـ.ق.
6. ابن الأزرق، نافع: سؤالات نافع بن الأزرق إلى عبد الله بن عبَّاس، جمع وتحقيق: إبراهيم السامرائيّ، لا ط، بغداد ، مطبعة المعارف، 1968م.
60. الحموي، ياقوت بن عبد الله: معجم البلدان، لا ط، بيروت، دار صادر، 1995م.
61. الخصيبي، محمَّد بن راشد: شقائق النعمان على سموط الجمان في أسماء شعراء عمان، لا ط، مسقط، وزارة التراث القوميّ والثقافة، 1427هـ.ق.
62. الداني، عثمان بن سعيد: المحكم في نقط المصاحف، تحقيق: عزة حسن، لا ط، دمشق، دار الفكر، 1407هـ.ق.
63. الذهبي، محمَّد بن أحمد: سِيَر أعلام النبلاء، أشرف على التحقيق: شعيب الأرناؤوط، لا ط، لا م، مؤسَّسة الرسالة، 1405هـ.ق.
64. الراغب الأصفهانيّ، الحسين بن محمَّد: المفردات في غريب القرآن، تحقيق: صفوان عدنان داودي، لا ط، بيروت، دار القلم، 1412هـ.ق.
65. الراوندي، سعيد بن هبة الله: الدعوات، لا ط، قم المقدَّسة، انتشارات مدرسه امام مهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف، 1407هـ.ق.
66. الرضا، عليّ بن موسى: صحيفة الإمام الرضا عليهالسلام، تحقيق: محمَّد مهدي نجف، لا ط، مشهد المقدَّسة، كنگره جهانى امام رضا عليهالسلام، 1406هـ.ق.
67. الرفاعي، بلال عبد الوهاب: الخطّ العربيّ تاريخه وحاضره، دمشق؛ بيروت، دار ابن كثير، 1410هـ.ق.
68. الزمخشري، محمود بن عمر: أساس البلاغة، لا ط، بيروت: دار صادر، ۱۹۷۹م.
69. السجَّاد، عليّ بن الحسين عليهالسلام: الصحيفة السجَّاديَّة، لا ط، قم المقدَّسة، دفتر نشر الهادي، 1376هـ.ش.
7. ابن العجلان النهدي، عبد الله: ديوان عبد الله بن العجلان النهدي، جمع وتحقيق: إبراهيم صالح، لا ط، أبو ظبي، هيئة أبو ظبي للثقافة والتراث، 2009م.
70. السجستاني، عبد الله بن سليمان: المصاحف، تحقيق: محمَّد بن عبده، لا ط، القاهرة، دار الفاروق الحديثة، 1423هـ.ق.
71. السمين الحلبيّ، أحمد بن يوسف: عمدة الحفّاظ فى تفسير أشرف الألفاظ، تحقيق: محمّد التونجي، بيروت، عالم الكتاب، 1414هـ.ق.
72. السيِّد، رضوان: المستشرقون الألمان النشوء والتأثير والمصائر، لا ط، لا م، دار المدار الإسلاميّ، 2016م
73. السيوطي، عبد الرحمن بن أبي بكر: المزهر في علوم اللغة وأنواعها، تحقيق: فؤاد علي منصور، لا ط، بيروت، دار الكتب العلميَّة، 1418هـ.ق.
74. الشافعي، محمَّد بن إدريس: الرسالة، تحقيق: أحمد شاكر، لا ط، مصر، مكتبة الحلبيّ، 1358هـ.ش.
75. الشرقاوي، محمَّد عبد الله: الاستشراق في الفكر الإسلاميّ المعاصر، لا ط، القاهرة، لا ن، 1992م.
76. الشريف الرضي، محمَّد بن الحسين: نهج البلاغة (الجامع لخطب ومواعظ ورسائل وكلمات أمير المؤمنين الإمام عليّ بن أبي طالب عليهالسلام)، تحقيق: صبحي الصالح، لا ط، قم المقدَّسة، دار هجرت، 1414هـ.ق.
77. الشعيري، محمَّد بن محمَّد: جامع الأخبار، لا ط، النجف الأشرف، المطبعة الحيدريَّة، لا ت.
78. الشمري، نهاد حسن حجي: «نظريَّة التأثير الآراميّ في اللهجات العربيَّة البائدة دراسة ساميَّة مقارنة»، مجلَّة لارك للفلسفة واللسانيَّات والعلوم الاجتماعيَّة، المجلَّد 3، العدد 32، 2019م.
79. الصرصري، سليمان بن عبد القوي: موائد الحيس في فوائد القيس، تحقيق: مصطفى عليان، لا ط، الكويت، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلاميَّة، 1435هـ.ق.
8. ابن المبارك، عبد الله: الجهاد، تحقيق: نزيه حمَّاد، لا ط، تونس، الدار التونيَّة، 1972م.
80. الصفَّار، محمَّد بن الحسن: بصائر الدرجات في فضائل آل محمّد عليهمالسلام، تصحيح: محسن كوچه باغى، قم المقدَّسة، مكتبة آية الله المرعشي النجفيّ، 1404هـ.ق.
81. الصولي، محمَّد بن يحيى: أدب الكتاب، تصحيح: محمَّد بهجة الأثري، لا ط،
مصر؛ بغداد، المطبعة السلفيَّة، المكتبة العربيَّة، 1341هـ.ق.
82. الضبي، المفضل بن محمَّد: المفضليات، تحقيق: أحمد محمَّد شاكر؛ عبد السلام محمَّد هارون، لا ط، القاهرة، دار المعارف، لا ت.
83. الطباطبائي، محمَّد حسين: الميزان في تفسير القرآن، لا ط، بيروت، مؤسَّسة الأعلمي للمطبوعات، 1390هـ.ش.
84. الطبراني، سليمان بن أحمد: المعجم الکبير، تحقيق: حمدي بن عبد المجيد، لا ط، القاهرة، مكتبة ابن تيميَّة، 1994م.
85. الطبراني، سليمان بن أحمد: مسند الشاميِّين، تحقيق: حمدي بن عبد المجيد السلفي، لا ط، بيروت، مؤسَّسة الرسالة، 1405هـ.ق.
86. الطبرسي، أحمد بن عليّ: الاحتجاج على أهل اللجاج، تحقيق: محمَّد باقر خراسان، لا ط، مشهد المقدَّسة، نشر مرتضى، 1403هـ.ق .
87. الطبرسي، الحسن بن الفضل: مكارم الأخلاق، لا ط، قم المقدَّسة، مطبعة الشريف الرضي، 1412هـ.ق.
88. الطبرسي، الفضل بن الحسن: مجمع البيان في تفسير القرآن، تحقيق: فضل الله يزدي؛ هاشم رسولي، لا ط، طهران، ناصر خسرون، 1372هـ.ش.
89. الطبري، محمَّد بن جرير: جامع البيان في تفسير القرآن، تحقيق: أحمد محمَّد شاكر، لا ط، بيروت، دار المعرفة، 1412هـ.ق.
9. ابن المبارك، عبد الله: الزهد، تحقيق: حبيب الرحمن الأعظمي، لا ط، بيروت، دار الكتب العلميَّة، لا ت.
90. الطريحي، فخر الدين بن محمَّد: مجمع البحرين ومطلع النيّرين، تصحيح: أحمد حسيني أشكوري، لا م، دفتر نشر فرهنگ اسلامی، 1375هـ.ش.
91. الطوسي، محمَّد بن الحسن: الأمالي، تصحيح: مؤسَّسة البعثة، لا ط، قم
المقدَّسة، دار الثقافة، 1414هـ.ق.
92. الطوسي، محمَّد بن الحسن: التبيان في تفسير القرآن، تصحيح: أحمد حبيب العامليّ، لا ط، بيروت، دار إحياء التراث العربيّ، لا ت.
93. الطوسيّ، محمَّد بن الحسن: تهذيب الأحكام، تصحيح: حسن الموسويّ خراسان، لا ط، طهران، دار الكتب الإسلاميَّة، 1407هـ.ق.
94. العبادي التميميّ، عدي بن زيد: ديوان عدي بن زيد، جمع وتحقيق: محمَّد جبَّار المعيبد، لا ط، بغداد، شركة دار الجمهوريَّة للطباعة والنشر، 1385هـ.ق.
95. العسقلانيّ، أحمد بن عليّ: لسان الميزان، لا ط، بيروت، مؤسَّسة الأعلمي للمطبوعات، 1406هـ.ق.
96. العسكري، الحسن بن عبد الله: تصحيح الوجوه والنظائر، تحقيق: محمَّد عثمان، لا ط، القاهرة، مكتبة الثقافة الدينيَّة، 1428هـ.ق.
97. العسكري، الحسن بن عليّ: التفسير المنسوب إلى الإمام الحسن العسكريّ عليهالسلام، تحقيق ونشر: مدرسة الإمام المهدي (عج)، لا ط، قم المقدَّسة، 1409هـ.ق.
98. العيَّاشي، محمَّد بن مسعود: تفسير العياشي، تصحيح: هاشم رسولي محلاتي، لا ط، طهران، المطبعة العلميَّة، 1380هـ.ق.
99. الغنوي، طفيل: ديوان طفيل الغنوي، جمع وتحقيق: حسان فلاح أوغلي، لا ط، بيروت، دار صادر، 1997م.
192. آذرنوش، آذرتاش: تاريخ فرهنگ و زبان عربی، تهران، سمت، 1381هـ.ش.
193. پاکتچي، أحمد: فقه الحديث با تکيه بر مسائل لفظ، تهران، دانشگاه امام صادق عليهالسلام، 1396هـ.ش.
194. جوادي آملي، عبد الله: تفسير تسنيم، تحقيق: عليّ إسلامي، لا ط، قم المقدَّسة، إسراء للنشر، 1388هـ.ش.
195. چهرقاني، رضا: تأملی ريشه شناختی در خاستگاه و معنای کلمه «مکه»، فصلنامه لسان مبين، العدد 38، 1398هـ.ش.
196. خداياري، عليّ نقي: «نقش احاديث معصومان در تفسير قرآن»، مجله سفينه، العدد 2، 1383هـ.ش.
197. شاکر، محمَّد کاظم؛ فيَّاض، محمَّد سعيد: «سير تحوُّل ديدگاههای خاورشناسان در مورد مصادر قرآن»، پژوهشهای قرآن وحديث، العدد 1، 1389هـ.ش.
198. عبد الجليل، ج. م.: تاريخ ادبيات عرب، ترجمة: آذرتاش آذرنوش، تهران، امير كبير، 1363هـ.ش.
199. نفيسي، شادي؛ حقاللهي، مهديه: «تأثير عرضه شواهد مادی در گزارشها و آرای خاستگاه و تاريخ خط ابداع عربی»، مطالعات قرآنی و فرهنگ اسلامی، العدد 4، 1397هـ.ش.
200. نويفيرت، أنجليكا: قرآن پژوهی در غرب در گفت وگو با خانم آنگليکا نويورت، هفت آسمان، المجلَّد 9، العدد 34، 1386هـ.ش.
201. همَّتي، محمَّد علي؛ شاكر، محمَّد كاظم: گزارش نقد و بررسی آراء کريستف لوگزنبرگ در کتاب قرائت آرامی-سريانی قرآن، لا ط، قم المقدَّسة، دانشكده اصول الدين، 1395هـ.ش.
202.راميار، محمود: تاريخ قرآن، تهران، امير كبير، 1369هـ.ش.
203.رضائي اصفهاني، محمَّد علي؛ پروان، صديقه: «دفاع دانشمندان شيعه از قرآن در برابر شبههى اقتباس»، مجلَّة قرآن پژوهشی خاورشناسان، العدد 23، 1369هـ.ش.
204.صرفي، زهرا: «نقد ديدگاه لوگزنبرگ درباره سرياني بودن خط قرآن در نگارش نخستين»، ادب عربيّ، العدد (1)، 1395هـ.ش.
205.كريمي نيا، مرتضى: مسأله تأثير زبانهاى آرامى وسريانى در زبان قرآن، لا ط، نشر دانش، 1382هـ.ش.
206.Abbott, Nabia: The rise of the North Arabic script and its Kur’ānic development, Chicago, University of Chicago, 1939.
207.Al-Azami, Muhammad Mustafa: The History Of The Qurani Text, England, UK Islamic Academy, 2003.
208.Al-Ghabban, ʿAlī Ibrāhīm: The evolution of the Arabic script in the period of the Prophet Muḥammad and the Orthodox Caliphs in the light of new inscriptions discovered in the Kingdom of Saudi Arabia, In The develop-ment of Arabic as a written language, UK, Oxford, 2010.
209.Al-Ghabban, ʿAlī Ibrāhīm: The inscription of Zuhayr, the oldest Islamic inscription (24 AH/AD 644–645), the rise of the Arabic script and the nature of the early Islamic state, (R. Hoyland, tran.), Arabian Archeology and Epigraphy, 19(2), 2008.
210.Al-Ghul, Omar: An Early Arabic Inscription from Petra Carrying Diacritic Marks, Syria, 81, 2004.
211.Ali, Muhammad Mohar: The Qur’an And The Orientalists: An Examination of their Main Theories and Assumptions, Ipswich: Jamiyat Ihyaa Minhaj Al-Sunnah, 2004.
212.Al-Jallad, Ahmad: Pre-Islamic Arabic. In Arabic and contact-induced change, Berlin, Language Science Press, 2020.
213.Baasten, Martin F.J.: A Syriac Reading of the Quran? The
(194)Case of Sūrat al-Kawṯar, In Arabic in Context, Leiden, Brill, 2017.
214.Bar Bahlule, Hassano: Lexicon Syriacum, Parisiis, E Reipubli-cae Typographaeo, 1886.
215.Beeston, Alfred Felix Landon: Languages of Pre-Islamic Arabia, Arabica, 2(28), 1981.
216.Bellamy, James: The Arabic Alphabet, In The Origins of Writing, Lincoln & London: University of Nebraska, 1991.
217.Birnstiel, Daniel: Illibration or Incarnation? A critical as-sessment of Christoph Luxenberg’s alleged Christmas liturgy, Horizonte der Koranexegese und Koranwissenschaften, 2015.
218.Blau, Joshua: The emergence and linguistic background of Judaeo-Arabic: A study of the origins of Neo-Arabic and Middle Arabic (second), Jerusalem, Ben-Zvi Institute, 1981.
219.Böwering, Gerhard: Recent research on the construction of the Qur’an, In The Quran in its Historical Context, USA and Canada, Routledge, 2008.
220.Chowdhury, Saf: Grapes in Heaven: Lüling, Luxenberg and The Ol’ Syriac Route, Birkbeck College, 2009.
221.Cooke, George: A Text-book of North-Semitic Inscriptions, Clarendon, Oxford, 1903.
222.Coppieters, Honoré: Apostles, In The Catholic
(195)Encyclopedia, New York, Robert Appleton Company, 1907.
223.Corriente, Federico: On a proposal for a “Syro-Aramaic” reading of the Qur’ān, Collectanea Christiana Orientalia, (1), 2003.
224.Costaz, Louis: Dictionnarie Syriaque-Francais (Troisième), Beyrouthm Dar El-Macheq, 2002.
225.De Blois, Francois: Review of Die Syro-aramäische Lesart des Koran by Christoph Luxenberg, Journal of Qur’anic Studies, (5), 2003.
226.Donner, Fred: The Qur’an in recent scholarship: challenges and desiderata, In The Quran in its Historical Context, USA and Canada, Routledge, 2008.
227.Dye , Guillaume: Traces of Bilingualism/Multilingualism in Qurʾānic Arabic, In Arabic in Context, Leiden, Brill, 2017, p. 337, footnote.
228.Fiema, Zbigniew; Al-Jallad, Ahmad; Macdonald, Michael; Nehmé, Laïla: Provincia Arabia: Nabataea, the Emergence of Arabic as a Written Lan-guage, and Graeco-Arabica. In Arabs and Empires before Islam, United King-dom, Oxford, et al, 2015.
229.Grafton, David: The identity and witness of Arab pre-Islamic Arab Christianity: The Arabic language and the Bible, HTS Teologiese Studies, 1(70), 2014.
(196)230.Griffith, Sidney: St. Ephraem the Syrian, the Quran, and the Grapevines of Paradise: An Essay in Comparative Eschatology, In Roads to Par-adise: Eschatology and Concepts of the Hereafter in Islam, Leiden, Brill, 2017.
231.Gross, Markus: Foreword to the English Edition, In Early Islam, A Critical Reconstruction Based on Contemporary Sources, New York, Prometheus Books, 2013.
232.Grüendler, Beatrice: The Development of the Arabic Scripts: from the Nabatean era to the first Islamic century according to dated texts, Georgia, Scholars Press, 1993.
233.Grunebaum, Gustave Edmund: Medieval Islam: A study in cultural orientation (Second), Chicago & London, The University Of Chicago Press, 1953.
234.Hawting, Gerald: Book Review: Die dunklen Anfänge, Journal of Qur’anic Studies, 8(2), 2006.
235.Henninger, Joseph: Pre-Islamic bedoun religion, In The Arabs and Arabia on the Eve of Islam, London and New York, Routledge, 2017.
236.Heschel, Susannah: German Jewish Scholarship on Islam as a Tool for De-Orientalizing Judaism, New German Critique, 39(3), 2012.
237.Hopkins, Simon: Review of Christoph Luxenberg, Jerusalem Stud-ies in Arabic and Islam, (28), 2003.
(197)238.Horsten, Piet: Review of Christoph Luxenberg, Islamochristia-na, (28), 2002.
239.Hoyland, Robert: Arabia and the Arabs: from the Bronze Age to the coming of Islam, London and New York, Routledge, 2001.
240.Hoyland, Robert: Epigraphy and the linguistic background to the Qur’an, In The Quran in its Historical Context, USA and Canada: Routledge, 2008.
241.Hoyland, Robert: Language and Identity: The Twin Histories of Arabic and Aramaic, Scripta Classica Israelica, 23, 2004.
242.Ibn Warraq: An Introduction to, and a Bibliography of, Works by and about Christoph Luxenberg, In Christmas in the Koran, Luxenberg, Syriac, and the Near Eastern and Judeo-Christian Background of Islam, New York, Prometheus Books, 2014.
243.Kaufman, Stephen: Aramaic. In The Semitic Languages. London and New York: Routledge, 2005.
244.Khagga, Feroz-ud-Din Shah; & Warraich, Mahmood: Revisionism: A Modern Orientalistic Wave in the Qurʾānic Criticism, Al-Qalam, 2015.
245.King, Daniel: A Christian Qur’ān? A Study in the Syriac back-ground to the language of the Qur’ān as presented in
(198)the work of Christoph Luxenberg, Journal for Late Antique Religion and Culture, (3), 2009.
246.Koren, Judith; Nevo, Yehuda: Methodological Approaches to Islamic Studies, Der Islam, (68), 1991.
247.Lecker, Michael: Idol Worship in Pre-Islamic Medina (Yathrib), In The Arabs and Arabia on the Eve of Islam, London and New York, Routledge, 2017.
248.Luxenberg, Christoph: Al-Najm (Q 53), Chapter of the Star, A new Syro-Aramaic reading of verses 1 to 18. In New Perspectives on the Qur’an: The Qur’an in Its Historical Context 2, Oxon - New York, Routledge, 2011.
249.Luxenberg, Christoph: No Battle of “Badr.” In Christmas in the Koran, Luxenberg, Syriac, and the Near Eastern and Judeo-Christian Background of Islam. New York, Prometheus Books, 2014a .
250.Luxenberg, Christoph: Syriac Liturgy and the “Mysterious Letters” in the Qur’ān: A Comparative Liturgical Study. In Christmas in the Koran, Luxenberg, Syriac, and the Near Eastern and Judeo-Christian Background of Islam. New York, Prometheus Books, 2014b.
251.Luxenberg, Christoph: The Syro-Aramaic Reading of the Koran, Berlin, Verlag Hans Schiler, 2007.
252.Maclean, Arthur John: A Dictionary of the Dialects of
(199)Vernacular Syriac, London, Edinburgh and New York, Oxford, 1902.
253.Madelung, Wilferd: Book Review: Arabische Paläographie, Jour-nal of Near Eastern Studies, 34(3), 1975.
254.Madigan, Daniel: Foreword, In The Quran in its Historical Con-text, USA and Canada, Routledge, 2008.
255.Mansour, Kamal: On the Origin of Arabic Script, In Proceedings of Graphemics in the 21st Century, Brest, Fluxus Editions, 2018.
256.Martin, Richard: Islamic Studies: History of the Field, In The Oxford encyclopedia of the modern Islamic world, New York, Oxford University Press, 1995.
257.Miles, George: Early Islamic Inscriptions Near Ṭāʾif in the Ḥijāz, Journal of Near Eastern Studies, 7(4), 1948.
258.Mingana, Alphonse: Syriac Influences On The Style Of The Kur’an. Bulletin of the John Rylands Library, 11, 1927.
259.Mingana, Alphonse: The Transmission of the Quran, The Journal of the Manchester Egyptian and Oriental Soeicty, 5, 1916.
260.Morisson, Toni: The Throne of Solomon in the Islamic World, In The Wandering Throne of Solomon, Objects and Tales of Kingship in the Medieval Mediterranean, Leiden, Brill, 2016.
(200)
261.Moritz, Bernhard: Arabic Palaeography: A Collection of Arabic Texts from the First Century of the Hidjra till the Year 1000, Cairo, The Khe-dival Library, 1905.
262.Moscati, Sabation: An Introduction to the Comparative Grammar of the Semitic Languages. Wiesbaden: Otto Harrassowitz, 1980.
263.Motzki, Harald: Alternative accounts of the Qur’ān’s formation, In The Cambridge Companion to the Qur’ān, Cambridge, Cambridge University, 2006.
264.Motzki, Harald: Dating Muslim Traditions: A Survey. Arabica, 2(52), 2005.
265.Moukarzel, Joseph: Maronite Garshuni texts, on their evolution, characteristics, and function, Journal of Syriac Studies, 17.2, 2015.
266.Mousa, Issam: The Arabs in the First Communication Revolution: The Development of the Arabic Script, Canadian Journal of Communication, 26(4), 2001.
267.Naveh, Joseph: The Origin of the Mandaic Script, Bulletin of the American Schools of Oriental Research, 198, 1970.
268.Nehmé, Laïla: A glimpse of the development of the Nabataean script into Arabic based on old and new epigraphic material, In The develop-ment of Arabic as a written language, UK, Oxford, 2010.
(201)
269.Neuwirth, Angelika: Qur’an and History: a Disputed Relation-ship Some Reflections on Qur’anic History and History in the Qur’an, Journal of Qur’anic Studies, (5), 2003.
270.Osman, Ghada: Pre-Islamic Arab converts to Christianity in Mecca & Medina: An investigation into the Arabic Sources, The Muslim World, (95), 2005.
271.Peters, Francis: Mecca: A literary history of the Muslim holy land. USA: Princeton University Press, 1994.
272.Rabin, Chaim: Ancient West-Arabian, London, Taylor’s Foreign Press, 1951.
273.Revell, E.J: The diacritical dots and the development of the Ar-abic alphabet, Journal of Semitic Studies, 20(2), 1975.
274.Rippin, Andrew: The role of the study of Islam at the university: A Canadian perspective. In The Teaching and Study of Islam in Western Universities. Oxon - New York, Routledge, 2014.
275.Rodinson, Maxime: A Critical Survey of Modern Studies on Muham-mad, In Studies on Islam, New York, Oxford University Press, 1981.
276.Rubin, Aaron: A Brief Introduction to the Semitic Languages. USA, Gorgias Press, 2010.
277.Said, Edward: Orientalism, London, Penguin, 1977.
(202)
278.Schöller, Marco: Post-Enlightenment Academic Study of the Qurān. In Encyclopaedia of the Qurān, Leiden-Boston, Brill, 2004.
279.Smith, J. Payne: A Compendious Syriac Dictionary–Found upon the Thesaurus Syriacus of R. Payne Smith, London, University of Oxford, 1903.
280.Smith, R. Payne: Thesaurus Syriacus, Londini, E Typographeo Clarendoniano, 1895.
281.Steenbrink, Karel: New Orientalist Suggestions on the Origins of Islam, The Journal of Rotterdam Islamic and Social Siences, 1(1), 2010.
282.Stewart, Devin: Notes on medieval and modern emendations of the Qur’an, In The Quran in its Historical Context, USA and Canada, Routledge, 2008.
283.Stillman, Norman: The story of Cian and Abel in the Qur’an and the Muslim commentators: Some observations, Journal of Semitic Studies, 19(2), 1974.
284.Trimingham, Spencer: Christianity Among the Arabs in Pre-Islamic Times. London and New York: Longman, 1979.
285.Wild, Stefan: Lost in Philology? The Virgins of Paradise and the Luxenberg Hypothesis, In The Qurʾān in Context, Leiden, Brill, 2010.
(203)
286.Fraenkel, Siegmund: Die Aramäischen Fremdwörter im Arabischen, Leiden, Brill, 1886.
287.Lidzbarski, Mark: Handbuch der nordsemitischen Epigraphik, Nebst Ausgewählten Inschriften, Leipzig, Weimar, 1898.
288.Luxenberg, Christoph: Neudeutung der arabischen Inschrift im Felsendom zu Jerusalem. In Die dunklen Anfänge, Neue Forschungen zur Entstehung und frühen Geschichte des Islam, Berlin, Verlag Hans Schiler, 2007a.
289.Luxenberg, Christoph: Relikte Syro-aramäische Buchstaben in frühen Korankodizes im hijazi- und kufi-Duktus. In Der frühe Islam, Eine historisch-kritische Rekonstruktion anhand zeitgenössischer Quellen, Berlin, Verlag Hans Schiler, 2007b.
290.Nöldeke, Theodor: Die semitischen Sprachen (Zweite), Strassburg, Leipzig, 1899.
(204)