

الفصل الأوَّل: ميور والسيرة النبويّة بين الإرث الاستشراقيّ والتحوّلات الأيديولوجيّة
المبحث الأوّل: الرّسول محمّد صلىاللهعليهوآله في التصوّرات البريطانيّة حتّى القرن 13هـ/ 19م | 29
المبحث الثاني: وليم ميور ومستحثّات اهتمامه بالتاريخ الإسلاميّ | 63
المبحث الثالث: الجهد التدوينيّ لميور في الدراسات الاستشراقيّة | 99
الفصل الثاني: ميثولوجيّة الجذور الإبراهيميّة في رؤية ميور
المبحث الأوّل: أسطوريّة الرحلة الإبراهيميّة إلى مكّة | 139
المبحث الثاني: الكعبة وإشكاليّة الجذور الوثنيّة | 169
المبحث الثالث: مصادر معرفة العرب بالتّراث الإبراهيميّ | 203
المبحث الرابع: النبوّة ومشروعيّتها في الفرع الإسماعيليّ | 219
الفصل الثالث:كينونة الوحي والنبوّة في تصوّرات ميور
المبحث الأوّل: الوحي من منظار الإشكاليّة المرضيّة والنفسيّة لدى ميور | 251
المبحث الثاني: الأثر الشيطانيّ وحيثيّات النبوّات الكتابيّة | 279
المبحث الثالث: القرآن من منظار الوحي والنبوّة وفق رؤية ميور | 303
الفصل الرابع: العامل الاجتماعيّ وإشكاليّة المنابع البشريّة للوحي والنبوّة في رؤية ميور
المبحث الأوّل: أثر البيئة الوثنيّة في الوحي والنبوّة | 335
المبحث الثاني: المؤثّرات المسيحيّة في الوحي والنبوّة | 353
المبحث الثالث: المؤثّرات اليهوديّة في الوحي والنبوّة | 383
المبحث الرابع: إشكاليّة التّماثل بين القرآن والكتاب المقدّس | 407
ـ مقدِّمة المركز7
ـ مقدِّمة المؤلِّف11
ـ المختصرات العامّة25
الفصل الأوَّل: ميور والسيرة النبويّة بين الإرث الاستشراقيّ والتحوّلات الأيديولوجيّة
ـ المبحث الأوّل: الرّسول محمّد صلىاللهعليهوآله في التصوّرات
البريطانيّة حتّى القرن 13هـ/ 19م29
ـ المبحث الثاني: وليم ميور ومستحثّات اهتمامه بالتاريخ الإسلاميّ63
ـ المبحث الثالث: الجهد التدوينيّ لميور في الدراسات الاستشراقيّة99
الفصل الثاني: ميثولوجيّة الجذور الإبراهيميّة في رؤية ميور
ـ المبحث الأوّل: أسطوريّة الرحلة الإبراهيميّة إلى مكّة139
ـ المبحث الثاني: الكعبة وإشكاليّة الجذور الوثنيّة169
ـ المبحث الثالث: مصادر معرفة العرب بالتّراث الإبراهيميّ203
ـ المبحث الرابع: النبوّة ومشروعيّتها في الفرع الإسماعيليّ219
الفصل الثالث:كينونة الوحي والنبوّة في تصوّرات ميور
ـ المبحث الأوّل: الوحي من منظار الإشكاليّة
المرضيّة والنفسيّة لدى ميور251
ـ المبحث الثاني: الأثر الشيطانيّ وحيثيّات النبوّات الكتابيّة279
ـ المبحث الثالث: القرآن من منظار الوحي
والنبوّة وفق رؤية ميور303
الفصل الرابع: العامل الاجتماعيّ وإشكاليّة المنابع البشريّة للوحي والنبوّة في رؤية ميور
ـ المبحث الأوّل: أثر البيئة الوثنيّة في الوحي والنبوّة335
ـ المبحث الثاني: المؤثّرات المسيحيّة في الوحي والنبوّة353
ـ المبحث الثالث: المؤثّرات اليهوديّة في الوحي والنبوّة383
ـ المبحث الرابع: إشكاليّة التّماثل بين القرآن والكتاب المقدّس407
ـ قائمة الملاحق431
ـ المصادر والمراجع461
ـ ملخّص الأطروحة بالإنكليزيّة486
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله ربّ العالمين الذي بعث نبيّه محمّدًا صلىاللهعليهوآله رحمة للعالمين، وأنزل القرآن هدى للنّاس أجمعين، وصلّى الله على محمّد خاتم النبّيين وإمام المرسلين وعلى آل بيته الطيّبين الطاهرين، أوصياء النبوّة، وترجمان الوحي المبين، وعلى أصحابه المنتجبين.
لا يخفى على الباحثين في مجال الاستشراق ما تميّزت به مدرسة الاستشراق البريطانيّ من ريادة على مستوى التأسيس في هذا المجال؛ بحكم المكانة السياسيّة والدور الاستعماريّ للدولة البريطانيّة وهيمنتها على دول عديدة في الشرق، ولا يخفى أيضًا، تنوّع اهتمامات هذه المدرسة وانشغالاتها: تاريخ، أدب، عقيدة، تفسير، ترجمة، علوم، وفنون... وإنْ بدا التركيز على العقيدة، والقرآن، وتاريخ الدين الإسلاميّ، جليًّا في مصنّفات هؤلاء المؤسّسين، وهذا ما فرضته التوجّهات التبشيريّة للمستشرقين الأوائل الذين اندفعوا إلى الحطّ من شأن الإسلام ورسوله، والتشكيك في نبوّة النبي محمّد صلىاللهعليهوآله، والطعن في أصالة الدين الإسلاميّ.
ويعدّ المستشرق وليم ميور (1819-1905م) أنموذجًا للاستشراق البريطانيّ القديم، الذي تتّخذ معه دراسة الشرق أبعادًا تبشيريّة واستعماريّة واضحة، ومنحى لأدلجة هذا التوجّه التّنصيريّ الاستعماريّ باتّهام عقيدة الشرق وثقافته وأديانه، وبالخصوص الإسلام ونبيّه صلىاللهعليهوآله.
احتلّ (ميور) مواقع سياسيّة وإداريّة في الحكومة البريطانيّة، ودفعته
رحلته إلى الهند (شركة الهند الشرقيّة) إلى الاهتمام بالإسلام، ودراسة اللغات الشرقيّة الإسلاميّة: كالعربيّة، والفارسيّة، الأرديّة. ولا تخفى علاقاته بالإرساليّات التبشيريّة؛ خاصّة المبشِّر المشهور كارل غوتليب فاندر (1803-1865م)؛ ما عزّز تعصّبه للمسيحيّة ومحاولة إرجاع كلّ مآثر الإسلام إلى منابع نصرانيّة.
ألَّف ميور كتبًا عديدة أشهرها: (القرآن: تأليفه وتعاليمه وشهادته للكتب المقدّسة)، و(حياة محمّد)، و(الخلافة: نشأتها انحلالها وسقوطها: دراسة من المصادر الأصليّة)، و(المماليك ودولة العبيد في مصر)، ...
ويعتبر كتابه في السيرة من الدراسات التأسيسيّة الأولى التي كُتبت بالإنجليزيّة، معتمدة المصادر الأصليّة للسيرة النبويّة الشريفة.
ولا نريد أن يتحوّل تقديم هذا الكتاب إلى ترجمة لهذا المستشرق، ولكنْ سنكتفي ببيان مجموعة من النقاط المرتبطة بخلفيّات هذا المستشرق ومن يمثِّل أهدافه، وبالإشكالات المنهجيّة التي وقع فيها، وخاصّة تلك التي تتعلّق بآرائه في مجال الدراسات القرآنيّة، التي سلّطت هذه الدراسة الضوء على كثير منها وهذه النقاط هي:
ـ الاهتمام الأساس لدي ميور هو التاريخ، وقد عمّق هذا التوجّه للتاريخ المهام التأطيريّة للحركة التنصيريّة التي أوكلته إيّاها السلطات البريطانيّة لمستعمراتها في الهند، ولكنّ وظيفته التنصيريّة حتّمت عليه الاهتمام بالقرآن الكريم ونقده.
ـ دمج المنهج التاريخيّ، مع المنهج اللاهوتيّ ووظّف سيرة النبي وتاريخ الإسلام المبكر في التنصير.
ـ اعتمد القرآن؛ كما اعتمد التوراة، والإنجيل، والسيرة النبويّة، لتقويض نبوّة النبي محمّد صلىاللهعليهوآله والتشكيك في القرآن الكريم.
ـ شخّص مشكلة الكنيسة وإخفاق مشروعها التبشيري، وهو المواكب، والشاهد على هزيمة المبشِّر فاندر، بالخطاب العدائيّ والنبرة الحماسيّة، ولذا غلّف خطابه، في مراوغة شكليّة، بقالب ناعم؛ موهمًا المسلمين بالموضوعيّة وعدم
معاداة الإسلام، فعلى سبيل المثال: استبدل مصطلح المنتحل الذي كان يطلقه المستشرقون المبّشرون على النبي محمّد صلىاللهعليهوآله بخداع الذات!!
ـ ربط بين دراسة التاريخ والسيرة، وبين دراسة القرآن، ففي كتابه عن سيرة الرسول يفرد فصلًا كاملًا عن القرآن، تناول فيه قضايا: جمعه، وترتيبه، وأسلوبه.
ـ هذا الجمع بين التّاريخ والقرآن، وحرصه على إرجاع القرآن الكريم إلى مصادر بشريّة، وتأكيده على تاريخيّة القرآن وربطه حصرًا بالحوادث المحيطة به، وظروف نزوله، كلّ ذلك أفشل محاولته لإعادة ترتيب القرآن (ستّ مراحل)؛ وهي المحاولة التي سبق بها المستشرق الألمانيّ ثيودور نولدكه (1836-1930م) في تاريخ القرآن.
ـ اعتمد ميور -مع الأسف- منهجًا تعسّفيًّا في استنطاق الآيات، فيه كثير من التّوظيف الإيديولوجيّ، والأفكار المُسبَقة، والنوايا المبيَّتة، والإسقاطات الخارجيّة على النصّ.
ـ يعتبر ميور من المؤسّسين لنظريّة المصدر البشريّ للقرآن، حيث يُرجِع الوحي المحمّديّ إلى مؤثّرات بيئيّة، بل يعتبر القرآن نسقًا تأليفيًّا من إبداع النبي محمّد صلىاللهعليهوآله يعكس تطوّر فكرة الوحي في العقليّة المحمّديّة، حسب الظروف والملابسات التي شهدتها الدّعوة.
ـ قاده المنهج الفيلولوجي إلى ادّعاء انتحال القرآن من الموروث الكتابيّ، وسعى جاهدًا لتقديم شواهد على ذلك؛ كالأصول المسيحيّة للبسملة، والتقسيم الثلاثينيّ للقرآن، والعلاقة بالمزامير!!...
ولقد نجح الباحث الدكتور حيدر مجيد حسين العَليلي في الكتاب الذي بين أيدينا: (الدراسات القرآنيّة عند المستشرق وليم ميور -الوحي والنبوّة أنموذجًا-) (وهي في الأصل أطروحة دكتوراه) في تحليل هذه الخصائص العلميّة لكتابات وليم ميور، والإشكالات المنهجيّة في بحوثه؛ خاصّة في موضوعَي الوحي والنبوّة، ومع أنّ
المنطلق الأساس للباحث في دراسة ميور يرتبط بالتاريخ وسيرة الرسول صلىاللهعليهوآله، ولكنّ الانشغال القرآنيّ غير قليل في هذه الأطروحة؛ بحكم الارتباط المتين بين النصّ القرآنيّ وقضيّة الوحي والنبوّة، وبحكم منهج ميور نفسه الذي يربط بين التاريخ والسيرة من جهة، وبين القرآن من جهة أخرى.
ولذا يسرّ المركز أنْ تكون هذه الأطروحة عنوانًا لحلقة جديدة ضمن سلسلة (القرآن في الدراسات الغربيّة)، وأن تشكّل إضافة علميّة نوعيّة لدراسة تراث هذا المستشرق خاصّة، وللرؤية الاستشراقية القرآنيّة في المدرسة البريطانيّة عامّة.
نسأل الله -تعالى- أن يجد المتخصّصون، وكذا عموم القرّاء في هذا الكتاب مادّة علميّة نافعة: (كَذَٰلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْحَقَّ وَالْبَاطِلَ ۚ فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً ۖ وَأَمَّا مَا يَنفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ ۚ كَذَٰلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ) (سورة الرعد، الآية 17).
بسم الله الرحمن الرحيم
اللهم صلّ على محمّد وعلى آل محمّد، كما صلّيت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمّد وعلى آل محمّد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنّك حميد مجيد.
يُعدّ المستشرق السِيْر وليم ميور من المستشرقين البريطانيّين (William Muir) الذين اختصّوا بدراسة السيرة والتاريخ الإسلاميَّين وألّفوا فيهما، وكان له عناية أيضًا بالدراسات القرآنيّة ضمن دراسته للسيرة والتاريخ. ولذا وقع الاختيار على جعله محورًا للدراسة والتقويم، بالتركيز على خصوصيّة رؤيته للوحي والنبوّة. وفي ما يلي بيان بأسباب اختيار الموضوع، ومنهج الدراسة ومحاورها ونتائجها ومصادرها والمعيقات التي واجهتها.
1. اعتمد الباحث مناهج الدراسات التاريخيّة والأكاديميّة وفلسفة التاريخ لنصرة الرّسول الأكرم محمّد صلىاللهعليهوآله وردّ المفتريات التي وردت في سيرته العطرة، وبيان مدى التضليل الذي قام به الاستشراق البريطانيّ، من خلال مناقشة وردّ مفتريات أحد أبرز جهابذة هذه المدرسة؛ وهو المستشرق البريطانيّ الاسكتلنديّ الأصل السِير ولـيم ميور (Sir William Muir) (1819-1905م).
2. يمثّل ميور أوّل مستشرق بريطانيّ يصنّف سيرة للرسول صلىاللهعليهوآله بالاعتماد
على المصادر الإسلاميّة الرئيسة للسيرة التي عثر عليها في عصره، وجهد لتوظيفها في بناء أيديولوجيّ متحيّز. لذلك تهدف الدراسة إلى تحرّي دقّة ميور وأمانته العلميّة في الرجوع إلى هذه المدوّنات، كما تهدف إلى دحض الروايات المتهافتة التي عوّل ميور عليها وبثّها بين طيّات كتب السيرة التي تتعارض مع التصوّرات الموضوعيّة للسيرة النبويّة.
3. سعة التأليف عند المستشرق ميور: لم يقف الباحث بحسب اطّلاعه العلميّ على مستشرق خاض في تاريخ العرب والإسلام بقدر ميور، إذ غطّت مؤلّفاته الـ (23) حقبة زمنيّة واسعة لشبه جزيرة العرب امتدّت من حقب زمنيّة غابرة؛ مرورًا بعصر إبراهيم الخليل، حتّى نهاية عهد المماليك عام 1517م، موليًا اهتمامًا خاصًّا بسيرة الرّسول صلىاللهعليهوآله وقضيّة النبوّة والوحي.
4. تعدّ مؤلّفات ميور من أبرز الطروحات في الأروقة الأكاديميّة والاستشراقيّة حتّى غدت مناهج تاريخيّة تدرس في الجامعات البريطانيّة والهنديّة عن مادّة الإسلام، وغدت ركنًا رئيسًا في صيرورة الدراسات الإسلاميّة الحديثة والمعاصرة، بعد أن غَدَت موضع اقتباس للمختصّين في الدراسات الإسلاميّة منذ القرن 19 حتّى الآن.
5. يعدّ ميور من روّاد المستشرقين الذين أولوا اهتمامًا بقضيّة إعادة ترتيب سور القرآن الكريم حسب تاريخ النزول، وآراؤه في هذا الجانب تسبق طروحات الألمانيّ نولدكه.
6. تمثّل رؤية ميور في تفسير جذور الإسلام طيفًا تاريخيًّا لأهمّ الإرهاصات الفكريّة التي ظهرت في سماء الاستشراق البريطانيّ، إذ تمثّل تأصيلًا للموروث القروسطيّ الميثولوجيّ، لكنْ بصبغة المتغيّرات المنهجيّة والمفاهيميّة التي ظهرت إبّان القرن التاسع عشر.
7. تهدف الدراسة إلى التعريف بمكانة المستشرق وليم ميور، والأدوار التي اضطلع بها خدمةً للخطاب السياسيّ والتنصيريّ البريطانيّ، ولا سيّما وأنّ الوقوف
على مثل هذا الموضوع يعدّ أمرًا ضروريًّا لبيان رؤية الاستشراق البريطانيّ للسيرة النبويّة إبّان القرن التاسع عشر ومطلع القرن العشرين.
8. يمثّل ميور أنموذجًا نادرًا للسياسيّ والمبشِّر، إذ أهّلته عقليّته المتشدّدة للنصرانيّة إلى المزاوجة بين المنهج التاريخيّ والمنهج الجدليّ اللاهوتيّ الذي يتّبعه المنصّرون بمنتهى البراعة، ولعلّ ذلك كان سببًا لانتدابه للعمل مع مجموعة المبشِّر فاندر (Carl Gottaleb Pfander)، علاوة على مكانته السياسيّة الرفيعة في حكومة الهند، لتكون كتاباته جزءًا من مرحلة سياسيّة تفضي بتحقيق غايات اِستعماريّة عن طريق الأنشطة التنصيريّة.
9. يُعدّ المستشرق وليم ميور أوّل باحث في التاريخ الحديث، حيث قدّم نظريّة بشأن المصادر البشريّة للوحي وأثر المسيحيّة واليهوديّة في الإسلام.
10. يُعدّ ميور رائد الاستشراق البريطانيّ في تحديد رؤية تعليليّة لأسباب الإخفاقات التي مُنيت بها الكنيسة في حربها مع غريمها «الإسلام» حسب ميور، والتي كان أبرزها النبرة العدائيّة الحماسيّة في الكتابات الأوروبيّة، لافتًا إلى أهمّيّة اعتماد المصادر الإسلاميّة سلاحًا فاعلًا لكسب هذه الحرب، التي عدّها مُستلّات نفيسة من ترسانة العدو.
11. أحدث ميور نقلة نوعيّة في الخطاب الاستشراقيّ البريطانيّ، بعد أنْ كان خطابًا حماسيًّا تحامليًّا موجّهًا للمتلقّي الغربيّ لتأليبه تجاه الإسلام، غدا ذا تأثير مزدوج مُوَجّه إلى شريحتين يمثلّان قطبين متناقضين؛ الأولى: شريحة المبشّرين المسيحيّين ونحوهم، لتكون آراؤه حججًا بحوزتهم لمناكفة المسلمين في معركة التنصير، والثانية: شريحة المسلمين لدعوتهم إلى إعادة النّظر في موروثهم الدينيّ.
12. يُعدّ ميور رائد الاستشراق البريطانيّ في تَتَبّع الجذور الإبراهيميّة للنبوّة والوحي المُحَمَّديّ.
13. تنوّع الحيثيّات المنهجيّة في معالجاته لقضيّة الوحي والنبوّة، على غرار
منهج التأويل التعسّفي للنصّ، ومنهج التوظيف الأيديولوجيّ، والمنهج القبليّ، ومنهج الأثر والتأثّر.
14. لم تُفرَد دراسة أكاديميّة مستقلّة تُعنى بدراسة مصنّفات المستشرق ميور أو تناولت سيرته أو موقفه من قضيّة الوحي والنبوّة في الجامعات العراقيّة خاصّةً، والعربيّة عمومًا، على الرغم من أهمّيّة طروحاته في الأروقة الاستشراقيّة، ولعل آراء ميور استنهضت رهطًا من الباحثين لمناقشتها بنحو ضمني في مصنّفاتهم، من بينهم السيد أحمد خان (Sayed Ahmmad Khan) (7181-8981م)، أحد روّاد الحركة التجديديّة في الهند إبّان القرن 19 في كتابه «(A series of Essays on the Life of Mohammad) الخطابات الأحمديّة» الذي ينطوي على ردود على كتاب «حياة محمّد» لـ «وليم ميور»؛ فضلًا عن دراسة الكاتب الهندي «محمد موهر علي (Muhammad Mohar Ali) 1932-2007م»، في كتابه «Sirat al Nabi and the orientalists» سيرة النبي والمستشرقون، الذي ناقش جانبًا من آراء موير (Muir) ومارجليوث (Margoliouth) ومونتكمري واط (Watt,W. Montgomery)، زيادة على رسالة الباحث البريطاني الغاني الأصل «جبل محمّد بوبن (Jabal Muhammad Buaben)» الذي ناقش بعض الجوانب المنهجيّة في دراسته الموسومة حياة محمّد صلىاللهعليهوآله في الأبحاث البريطانيّة «The life of Muhammad in British scholarship»، أيضًا دراسة المستشرق البريطاني المعاصر «كلنتون بنيت Clinton Bennett» الموسومة «صورة الإسلام في العصر الفيكتوري Victorian Images of Islam»، الذي تناول فيها جانبًا من سيرة ميور ومنهجه، ولعلّ جميع هذه الدراسات الأجنبيّة لم تفرد فيها دراسة مستقلّة عن نظريّة الوحي والنبوّة المحمديّة، ولم تقف على قراءة تفصيليّة بالحيثيّة نفسها التي نهجها الباحث.
15. تقديم مسح تاريخيّ لمؤلّفات ميور وترجمة بعض متونها ضمن نطاق الدّراسة، بعد الاطّلاع على الطبعات الأولى لمصنّفات ميور، ولا سيّما أنّ أغلب مصنّفاته لم يتمّ تعريبها، عدا كتابه «تاريخ دولة المماليك في مصر» الذي نقله
إلى العربيّة محمود عابدين وسليم حسن، فضلًا عن ترجمة مالك مسلماني لكتاب ميور «القرآن نظمه وتعاليمه»، لتكون هذه الأطروحة بمثابة دراسة تأصيليّة خدمة لطلبة العلم ورفدًا للمكتبة العربيّة.
حرص الباحث في دراسته على إقامة البراهين على رؤية ميور للوحي والنبوّة والقرآن بنحو تتبّعيّ استقرائيّ سرديّ حصريّ للجزئيّات والمعطيات بالتحليل والنقد، ومن خلال تفكيك البنية النصّيّة، والكشف عن أدواته اللغويّة، وملامسة نبرة الخطاب الاستشراقيّ لديه، وعزل الآراء الشاذّة ذات الشأن بموضوع البحث ولجميع مؤلّفاته، ولا سيّما كتاب «حياة محمّد» الذي حمل بين دفّتيه القسم الأوسع من آرائه بهذا الصدد، ومن ثمّ إعادة تشكيلها في هياكل مستقلّة مثّلت أركان الأطروحة، ومن ثمّ عكف على مناقشة هذه المضامين بالحجج العقليّة والنقليّة، مع مراعاة اقتناص آراؤه المتعارضة مع خطابه العامّ والمبثوثة بين طيّات مؤلّفاته لتكون حجّة عليه، كما عوّل الباحث في المناقشة على بعض الآراء الموضوعيّة لبعض المستشرقين، ونظرًا إلى أن جُلّ محاكمات وليم ميور جاءت من منظور «كتابيّ- قرآنيّ- سِيَريّ»، فقد لجأ الباحث إلى اتّباع المنهج التحليليّ والمقارن، عبر مقابلة آراء ميور مع النصوص الدينيّة، وشروحاتها، أو من خلال مقابلتها ومقارنتها بالمادّة السيريّة، واعتماد مضامينها أساسًا لردّ مطاعنه، على الرغم ممّا تنطوي عليه هذه المدوّنات أحيانًا من نصوص مثيرة للجدل، لكنّ الحكمة من وراء ذلك قلب السحر على الساحر، إنْ صحّ البيان، وعصب الدراسة تقويض مركّب الإرث الاستشراقيّ وإيحائيّة النّصّ السيريّ لدى ميور في إطار الحاضنة المعرفيّة نفسها التي عوّل عليها في المقام الأوّل، وتراتبيّة الوحي، ومن ثمّ النبوّة؛ وفقًا لتصوّراته.
(15)اقتضت طبيعة الدراسة أنْ تقسّم إلى أربعة فصول وخاتمة تضمّنت أهمّ النتائج، أمّا الفصل الأوّل فيعدّ تمهيدًا لموضوع البحث تناول مبحثه الأوّل لمحة عن جذور النظرة الاستشراقيّة البريطانيّة لسيرة الرّسول صلىاللهعليهوآله وفق رؤية سرديّة تتبّعيّة لتحديد مكانة وليـم ميور من هذا الموروث الذي ظهر أنّه ينطوي على ثلاثة مضامين: الأوّل، يمثّل المضمون المثيولوجي، والثاني يمثّل المضمون التدوينيّ المنهجيّ، أمّا الثالث فيمثّل المضمون الشعبيّ الفلكلوريّ، ولم يُفرد للمواقف الجدليّة التي سبقت ميور جانبًا من التفصيل، بل اُدّخر الحديث إلى مناقشة آراء ميور بشأن الوحي والنبوّة المحمّديّة التي تجمع بين دفتيها الكثير من جنس هذه التقوّلات.
المبحث الثاني تضمّن بيانًا لأهمّ العوامل التي حملت ميور على الاهتمام بتاريخ الإسلام، منها ما يتعلّق بالمتغيّرات الفكريّة والأيديولوجيّة (الاستعماريّة-التنصيريّة) في الهند إبّان القرن 19، ومنها ما يتعلّق بموروثه الأسري وسيرته الذاتيّة أو مكانته الإداريّة، أمّا المبحث الثالث، فقد تعرّض الباحث فيه للجهد التدويني لميور، من خلال مسح سريع لمؤلّفاته، مع بيان لأبرز الملاحظات المنهجيّة والخطابيّة التي سجّلت على هذه المدوّنات.
كما عكف الباحث في الفصل الثاني على مناقشة الجذور الإبراهيميّة للوحي والنبوّة المحمديّة في رؤية ميور التي تتمحور حول صلتها بإبراهيم الخليل وذريّته، إذ ناقش المبحث الأوّل نظريّة «الأسطورة الإبراهيميّة» التي أنكر ميور من خلالها وفادة إبراهيم وهاجر وإسماعيل عليهمالسلام على مكّة المكرّمة، أمّا المبحث الثاني فقد تناول فيه رؤية ميور حول أصل الكعبة التي عدّها جزءًا من منظومة وثنيّة قديمة لا تمت إلى دين إبراهيم الخليل بصلة مع بيان الحجج التي تذرّع بها في هذا الصدد؛ أمّا المبحث الثالث فقد تناول رؤية ميور عن مشروعيّة النبوّة في إسماعيل وذريّته في إطار إنكاره التّام وتشكيكه بنسب الرّسول محمّد صلىاللهعليهوآله من إسماعيل.
الفصل الثالث خُصِّص للحديث عن الوحي والنبوّة المحمّديّة، فجاء المبحث الأوّل والمبحث الثاني لبيان رؤية ميور لمفهوم الوحي من حيث اللغة والدلالة في ضوء إشكاليّة التّلقّي والإلهام، وإشكاليّة الاستشراف المسبق، وحيثيّات الاتّصال بين الرّسول صلىاللهعليهوآله وبين جبريل والنظريّة المرضيّة تبعًا لرؤية ميور، والتي خلص بها إلى أنّ الوحي يمثّل حالة من الاضطرابات المرضيّة العقليّة المزعومة ظهرت على الرّسول صلىاللهعليهوآله منذ الطفولة المبكرة بفعل التأثير الماورائي الشيطاني -والعياذ بالله- والرغبة العارمة في لقاء الوحي الذي بلغ منتهاه حدّ خداع ذاته بفعل الإسراف في أحلام اليقظة؛ والوحي المتخيّل في تصوّر ميور ليس وحي السماء، بل ألمح إلى كونه أحد أتباع الشيطان الذي كانت له السطوة على مكنون الرّسول صلىاللهعليهوآله العقلي مقابل الصفقة التي أبرمها معه لإحكام قبضته على العالم، التي عرضت على المسيح فرفضها، وأتى الباحث على بطلانها من منظار كتابيّ صِرْف؛ من خلال تطبيق شروط النبوّات الصادقة في الكتاب المقدّس على نبوّة محمّد صلىاللهعليهوآله، التي تمثّل من منظار ميور تجلّ لتلك الرؤى ظهرت في مرحلة صارت الحاجة ملحّة إلى التغيير بفعل جاهليّة العرب أو بفعل التّشظي الدّيني لدى اليهود والنّصارى؛ حيث زعم ميور أنّ الرّسول صلىاللهعليهوآله عكف على دراسة حيثيّات اليهوديّة والنصرانيّة والمفاهيم الدينيّة لدى عرب الجاهليّة وجزئيّاتها؛ والخروج بمنصهر هجين أو نبوّة اصطبغت طابعًا إصلاحيًّا؛ كي يتسنّى للرسول صلىاللهعليهوآله إحداث التغيير بإزاحة مراكز القوّة الدينيّة القديمة ويكون له السطوة على الجميع، أمّا المبحث الثالث فقد أُفرد عن القرآن الكريم من منظار الوحي والنبوّة الذي يرى فيه أنّه وحدة تأليفيّة بشريّة إبداعيّة تجسّد مراحل تطوّر فكرة الوحي في العقليّة المحمّديّة، من التأمّليّة الاعتباطيّة المتّشحة بالمسحة الشعريّة الحماسيّة نحو النبوّة اليقينيّة النثريّة والنزعة الخطابيّة السلطويّة، في إطار آليّة استلال مزدوجة من الموروثات البيئويّة والكتابيّة، فضلًا عن إشارته لعلاقة القرآن بالتطوّر التعاقبي للوحي والترتيب الزمني للسّور القرآنيّة، وإشكاليّة التّكرار، مع الإشارة إلى جانب من آرائِه بشأن المعجزة وإنكاره لدلائل النبوّة المحمّديّة.
أمّا الفصل الرابع فقد عالج رؤية ميور بشأن المصادر البشريّة المزعومة للوحي
(17)أو (العامل الاجتماعي) وإشكاليّة تأثّر الرّسول صلىاللهعليهوآله بالمؤثّرات الكتابيّة في بيئته، فجاء المبحث الأول للحديث عن مؤثّرات البيئة الوثنيّة وتجلّياتها، أما المبحث الثاني فتناول المؤثّرات المسيحيّة المزعومة على الوحي والنبوّة المحمديّة، أمّا المبحث الثالث فقد تناول المؤثّرات اليهوديّة وصلتها بشرائع الإسلام، في ما تناول المبحث الرابع إشكاليّة التّماثل ما بين القرآن والكتاب المقدّس.
تمخّضت الدراسة عن جملة من النتائج؛ أبرزها:
- أظهرت الدراسة أنّ ميور جهد في إثارة إحدى أخطر الجدليّات التاريخيّة بين الأديان السماويّة؛ وهي جدليّة (فاران-مكّة)؛ بوصفها أساسًا لإزاحة الجذور التوحيديّة للنبوّة المحمديّة، والتي تُظهِر وجود رؤية توراتيّة تقويضيّة إزاحيّة لقيام نبوّة توحيديّة أصيلة في شبه الجزيرة العربيّة، حيث سعى الباحث إلى تقويضها وإثبات أصالة الإرثيّة الإبراهيميّة وترجيح نظريّة أنّ فاران التوراتيّة هي عينها مكّة القرآنيّة، وفق معايير شتّى، أبرزها: وجود أكثر من فاران في الخارطة الجغرافيّة للمنطقة.
- أظهرت الدّراسة أنّ إيحائيّة النّصّ (التوراتي- الإنجيلي- القرآني- السِيَري) كان لها أثر في صيرورة الخطاب التّقويضي لدى ميور، فوحي التوراة ألهمه إنكار المكانة الروحيّة للفرع الإسماعيلي من إبراهيم؛ أمّا وحي الإنجيل فقد عزّز لديه موروثاته الكنسيّة الميثولوجيّة وأوحى له بنظريّة الصفقة الميكافيلية مع الشيطان؛ بوصفه عنوانًا للجانب الماورائي للنبوّة المحمديّة؛ أمّا القرآن فلعلّه استوحى منه التعليلات التي تفسّر الحيثيّات المنهجيّة والخطابيّة والآليات التطوّريّة لصيرورة النبوّة المحمّديّة، أمّا النّصّ السِيَري فيظهر أنّ ميور قد رسم من خلاله ملامح الشخصيّة النبويّة (المتأمّلة والحالمة والمتشكّكة والمضطربة والميكافيليّة والمتقلّبة؛ فضلًا عن الشخصيّة الوجدانيّة).
(18)- شرع ميور إلى استبدال مصطلح المنتحل (imposter) الذي ذاع في الموروث الاستشراقي إلى مصطلح (self-deception) خداع الذات، واعتماد النظريّات المرضية ولَيّ النّصوص لتكون متّسقة مع الموروث الأيديولوجي للكنيسة ونظرتها إلى الإسلام في عصره.
- تبنّى ميور فلسفة مزدوجة (مثاليّة-ماديّة) في قراءة حيثيّات الوحي والنبوّة، فتارة يحتكم إلى التوراة لتصديق فروضه حول نفي صلة إبراهيم بمكة، وتارة يذهب إلى عقلنة كل ما هو غيبيّ في الإسلام، وقد ظهر للباحث غياب النظرة الموضوعيّة للتاريخ عند ميور، من خلال أحكامه المتعارضة أحيانًا، أو الكيل بمكيالين، ولا سيّما وأنّ التّشابه من وجهة نظره مأخوذ من التوراة أو الإنجيل، بينما الفرادة تُعدّ انحرافًا في معرض حديثه عن العلاقة بين القرآن الكريم والكتاب المقدّس.
- إنّ الجانب الأيديولوجيّ كان الأكثر حضورًا في طروحات ميور بالمقارنة مع الجانب العلميّ، على الرغم من غزارة التأليف في حقل الإسلام، لذلك عوّل على اتّباع منهج القراءة الاجتزائيّة السلبيّة للنصوص التي تتوافق مع توجّهاته، وعمد إلى توظيف اعتباطيّة الرموز أو من خلال التحريف والتّقوّل أو الالتفاف على النّصوص؛ لتكون متناغمة مع الرؤية القروسطيّة عن الوحي الشيطانيّ المزعوم، ولا سيّما في إشارته إلى كلمة «أصيب» الواردة في رواية ابن هشام.
- تطبيق ميور للمنهج المادّيّ على موضوع ذي حيثيّات ماورائيّة التي كان يتحتّم عليه النظر إليها نظرة اعتدال من خلال التّمعّن في تجلّياتها الأخلاقيّة والمفاهيميّة.
(19)اعتمد الباحث في إعداد هذه الأطروحة على الكتب الدينيّة: الكتاب المقدّس، والقرآن الكريم، كما اقتضت الدراسة الرجوع إلى أمّهات كتب التفسير وبعض الشروح الحديثة، نذكر منها: تفسير «جامع البيان في تأويل القرآن» لمحمّد بن جرير الطبري (ت: 310هـ)، الذي أغنى البحث في تفسير الآيات الواردة في الفصلين الثالث والرابع.
واعتمدت الأطروحة على المصادر الأوّليّة للسيرة، وتحديدًا «سيرة ابن هشام» (ت 213هـ)، و«المغازي» لمحمد بن عمر الواقدي (ت: 207هـ)، و«الطبقات الكبرى» لمحمّد بن سعد (ت 230هـ)، ولا سيّما أنّ ميور قد عدّ هذه المؤلّفات أساسًا لبناء تصوّراته عن الوحي والنبوّة المحمّديّة.
أمّا الكتب البلدانيّة، ومنها: «معجم البلدان» لياقوت الحموي (ت: 626هـ)، و«مراصد الاطّلاع على أسماء الأمكنة والبقاع» لابن عبد الحق البغدادي (ت 739هـ)، فقد تركّزت أهميّتها في الفصل الثاني، إضافة إلى المعاجم اللغويّة التي أغنت الدراسة لبيان المصطلحات اللغويّة، ومنها «معجم ابن فارس» (ت 395هـ)، و«لسان العرب» لابن منظور، (ت 711هـ/ 1311م).
وتضمّنت الأطروحة قائمة من المراجع الأجنبيّة الحديثة والمعاصرة، منها: المعربة؛ مثل: كتاب «صورة الإسلام في القرون الوسطى» لريتشارد سوذرن، وكتاب «The sum of all heresies» حصيلة كلّ الهرطقات لفريدرك كوين «QuinnFrederick»، التي أغنت الدراسة في بيان تطوّر نظرة الاستشراق البريطانيّ للسيرة، كما ضمّت الدراسة بعض النّصوص الكلاسيكيّة التي يعود تاريخ بعضها إلى القرن 11هـ/ 17م، مثل كتاب «Relation of a journey» صلات الرحلة لجورج ساندي «George,Sandy’s» عام 1610م، وكتاب «تاريخ العالم» «The history of the world» لولتر رولف «Walter Raleigh» عام 1614م؛ كما اعتمد الباحث
على عدد من الوثائق الرسميّة والمقالات الواردة في بعض الدوريّات الشهيرة إبّان القرن 13ه؛ مثل: «مجلّة الجمعيّة الملكيّة الآسيوية Journal of the Royal Asiatic Society» التي ضمّت جانبًا من سيرة المستشرق وليم ميور.
ومن بين الشروح الكتابيّة التي نهل منها الباحث على امتداد صفحات الأطروحة، تندرج «دائرة المعارف الكتابيّة» و«قاموس الكتاب المقدّس»؛ كما أفاد من بعض الشروحات الكلاسيكيّة الغربيّة للكتاب المقدّس، ولا سيّما في بيان قضيّة فاران في الفصل الثاني؛ ومنها: شروحات: «آدم كلارك Adam Clarke»، و«جيمس هاستنك James Hastings»، و«ماثيوبول Matthew Poole»، و«جون جل Gill John».
كما زخرت الأطروحة بطائفة من المراجع العربيّة، ومن جملة هذه المراجع كتاب «حياة محمّد» لمحمد حسنين هيكل، وكتاب «مصدر القرآن، دراسة لشبهات المستشرقين والمبشّرين» لإبراهيم عوض، اللذان أثريا الفصل الثالث من الأطروحة، ولا تفوت الإشارة لجهود الباحث سامي عامري في كتابه «هل القرآن مقتبس من التوراة والإنجيل» الذي عوّل على بعض آرائه في الفصل الرابع، ومن المراجع الأخرى مؤلّفات هشام جعيط، «الوحي والقرآن والنبوّة»، وكتاب «تاريخيّة الدعوة المحمّديّة في مكّة» التي أسهمت في تحليل رؤية ميور بشأن مسألة الوحي، وأيضًا مؤلّفات محمّد عبد الله دراز «النبأ العظيم» و«مدخل إلى القرآن الكريم» التي أغنت الدراسة في ردّ العديد من الافتراءات عن القرآن الكريم.
فضلًا عن مئات المصادر العربيّة والمعرّبة والأجنبيّة.
واجهت الباحث صعوبات كثيرة، لكنّ الله (عزّ وجلّ) وحده قد أعان الباحث على تجاوزها، وأبرزها التّعامل مع النّبرة المتجرّئة والحادّة بحقّ إمامنا وسيّدنا محمّد صلىاللهعليهوآله لم يكنْ أمرًا يسيرًا على الباحث، لكنْ ما دام ناقل الكفر ليس بكافر،
والغاية التي يصبو إليها الباحث دحض مزاعم ميور بالحجّة الدّامغة، فلا يجد حرجًا من إدراج هذا النوع من النّصوص.
وكانت مشكلة الترجمة من بين المعوّقات التي اقتضت التأنّي والدقّة في النقل حتّى تكون الترجمة صورة صادقة لرؤية ميور، ولا غرو فقد سُلخت نصف مدّة البحث في ترجمة مؤلّفات ميور التي كُتِبَت بلغة أدبيّة لا يختلف أصحاب الشأن في مشقّة فكّ طلاسمها بالمقارنة مع اللغة المقاليّة الإنكليزيّة الدارجة، ولا سيّما وأنّ الباحث لم يجد لبعض العبارات معنى إلّا في نوع تخصّصي من القواميس (إنكليزي- إنكليزي) من جنس:
1-The Century Dictionary.
2- A Concise Dictionary Of Middle English.
3- Concise Etymological Dictionary Of The English Language.
4- Merriam-Webster’s Dictionary.
5- A New English Dictionary On Historical Principles.
6- The Concise Oxford Dictionary.
ومن العقبات التي واجهت الباحث، طبيعة الموضوع المتناثرة التي تقتضي التنقّل بين مادّة التاريخ القديم والتاريخ الإسلامي والتاريخ الأوروبي، فضلًا عن دراسة مقارنة الأديان، ومنهج تحقيق النصوص، ومن المعوقات الأخرى التي واجهت سير الدراسة ندرة المصادر التي تنطوي على بيان لسيرة المستشرق وليم ميور أو التي تغني الدراسة في مناقشة آرائه بنحو خاصّ، ولا سيّما مع افتقار المكتبة العربيّة لكتب تبسّط الحديث عن سيرته في ما عدا بعض الإشارات المحدودة في الموسوعات الاستشراقيّة التي لا تتجاوز بضعة سطور على غرار «موسوعة المستشرقين» لعبد الرحمن بدوي، مع الالتفات إلى أنّ مصنّفات ميور لم يتمّ تعريبها، عدا كتابه «تاريخ دولة المماليك في مصر» الذي نقله إلى العربيّة محمود عابدين وسليم حسن، فضلًا عن ترجمة مالك مسلماني لكتاب ميور «القرآن نظمه وتعاليمه»
(22)المنشور على الشبكة الدوليّة للمعلومات وهي نسخة مجهولة الطبعة، وتتطلّب بعض التصويبات.
وهكذا تكون محاولة الباحث الأولى من نوعها في جامعة البصرة.
كلمة أخيرة ينبغي قولها: إنّ الباحث لا يدّعي أنّه أوفى الموضوع حقّه أو أنّه استكمله من جميع جوانبه أو قام بنقد جميع الآراء المخطوءة في هذه القضيّة، وإنْ حاول جاهدًا فعل ذلك، لكنْ تبقى قدرات الإنسان عاجزة عن بلوغ الكمال؛ لأنّ الكمال لله وحده، ولكنْ حسبه أنّه لم يدّخر في سبيل ذلك وسعًا، وإنّه ليرجو أنْ يسهم من خلال هذه الدراسة في التقرّب إلى الله (عزّ وجلّ) ويكون له نصيب من الأجر الثواب، ومن الله التوفيق.
(23)
بسم الله الرحمن الرحيم
(وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ ۖ وَقُولُوا آمَنَّا بِالَّذِي أُنزِلَ إِلَيْنَا وَأُنزِلَ إِلَيْكُمْ وَإِلَٰهُنَا وَإِلَٰهُكُمْ وَاحِدٌ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ) سورة العنكبوت: الآية 46
قائمة الرموز والمختصرات المستخدمة في الأطروحة
|
الرمز |
معناه |
|
ت |
المتوفى في عام |
|
تح |
تحقيق |
|
ج |
الجزء |
|
د ت |
من دون تاريخ |
|
د م |
من دون مكان |
|
ص |
صفحة |
|
ط |
طبعة |
|
ق.م |
قبل الميلاد |
|
م |
بعد الميلاد |
|
مج |
مجلد |
|
هـ |
بعد الهجرة |
|
A.C |
After Christ |
|
A.H |
After hijra |
|
B.C. |
Before Christ |
|
Ibid |
Ibidem, |
|
No. |
Number |
|
Op. cit., |
opus citatum, |
|
p. |
Page |
|
pp. |
Pages |
|
Vol. |
Volume |
(27)
(29)
الاستشراق تعريب للكلمة الإنكليزيّة (Orientalism)، وقد أجمعت المعاجم الأكاديميّة على أنّه مصطلح يخصّ الشرق كما اكتشفته أوروبا والغرب؛ يحمل بين دفّتيه نبرة الخطاب الغربيّ نحو الشرق، الذي ينطوي على ركام هائل من النّصوص في ميادين الأدب وعلم الاجتماع والعلوم والتاريخ واللغة والسياسة والأنثروبولوجيا والطبوغرافيّة.
ويرى البعض أنّ الاستشراق تيّار فكريّ يمثّل دراسات مختلفة عن الشرق الإسلاميّ؛ بحيث يشمل الحضارة والديانة والآداب واللّغات واللّهجات والثقافة والعادات والتقاليد، والمستشرق عالم متمكّن من المعارف الخاصّة بالشرق ولغاته وآدابه، ويذهب إدوارد سعيد إلى عدّه نوعًا من الإسقاط الغربيّ على الشرق وإرادة حكم الغرب للشرق؛ لأنّه أسلوب في التفكير قائم على تميّز متعلّق بوجود المعرفة بين الشرق وبين الغرب، وليس موضوعًا سياسيًّا أو ميدانًا بحثيًّا ينعكس سلبًا باختلاف الثّقافات والدراسـات أو المؤسّسات، وليس تكديسًا لمجموعة كبيرة من النّصوص حول المشرق؛ لأنّه توزيع للوعي الجغرافيّ على نصوص جماليّة وعلميّة واقتصاديّة واجتماعيّة وفي فقه اللغة.
لقد أفاض الكُتّاب من الشرق والغرب في بيان مفهوم الاستشراق، لذا سينأى البحث عن هذا الإطار ليركّز على تتبّع رؤية المستشرقين البريطانيّين لسيرة الرّسول صلىاللهعليهوآله، ولا سيّما وأنّ البعض يرجع جذور الدّراسات الاستشراقيّة إلى ظهور الرّسول صلىاللهعليهوآله على مسرح الأحداث التاريخيّة وعهد الهجرة الأولى إلى الحبشة، أو إلى العقود الأولى لالتقاء المسلمين الجدلي بالعقائد اللاهوتيّة النصرانيّة.
لقد مثّلت سيرة الرّسول الكريم محمّد صلىاللهعليهوآله موضوعًا خصبًا لأقلام إنجليزيّة منذ أن بزغ فجر الإسلام وحتى اليوم، وغدت شخصيّته إحدى أكثر الموضوعات التي ركّزت عليها بريطانيا في خطابها حيال الشرق لتغدو جزءً من تراثها الشعبي، ولعلّ المتتبّع لما أنتجته الأمّة البريطانيّة عبر تاريخها من المصنّفات والمسرحيّات والأعمال الأدبيّة والمقالات التي كتبت بشأن الرّسول صلىاللهعليهوآله، سوف يلمس أنّه ليس من شخصيّة كان لها مثل هذا القدر من الاهتمام بالتاريخ البريطاني، لكن على الرغم من غزارة هذه المؤلّفات والمدونات، فقد خلت من الموضوعيّة، وافتقرت إلى الرّوح الإنسانيّة، إلّا في ما ندر من شذرات نزرة من المؤلّفات؛ وإلى ذلك يشير المستشرق مونتكمري واط قائلًا: «ليست هناك شخصيّة في التاريخ حُطَّ من قدرها في الغرب؛ كمحمّد، لأنّ الكتّاب الغربيّين أظهروا ميلهم لتصديق أسوأ الأمور عنه».
لقد اقتضت الدّراسة عدم إمكانيّة الخوض في سيرة وليم ميور وصلته بتاريخ النبوّة المحمّديّة دون الإطلالة على ما حفل به موروثه في هذا الجانب؛ فعلى الرغم من نمطية الصورة المشوّهة عن سيرة الرّسول صلىاللهعليهوآله في التاريخ البريطاني، فقد لمس الباحث أنّ الكتابة عن سيرة الرّسول صلىاللهعليهوآله في بريطانيا مرّت بخمس حقب تاريخيّة؛ هي الآتية:
يعود أوّل اتصال بين بريطانيا وبين الشرق إلى منتصف القرن الثالث للميلاد عندما وصل بعض الرحّالة الرهبان إلى مصر وسوريا وفلسطين في طريقهم إلى الأراضي المقدّسة، بيد أنّه لم تظهر أيّ دراسات للبريطانيّين عن الشرق إلّا في نهاية القرن (1ه/ 7م) على يد الرحّالة البريطاني «ويلبولد Wilibold» الذي تعدّه المصادر أوّل من دوّن كتابًا عن رحلته إلى البلاد العربيّة.
شكّل الإسلام حال ظهوره مشكلة لأوروبا المسيحيّة فنظرت إلى المسلمين على أنّهم أعداء يتسوّرون حدودها، وظل الرّسول صلىاللهعليهوآله زمنًا طويلًا يُعْرف في الغرب معرفةً سيّئة، فلا تكاد توجد خرافة ولا فظاظة إلّا نسبوها إليه، ولقد تزامن ظهور الإسلام مع وصول المسيحيّة إلى بريطانيا عندما بلغت بعثة القديس أوغستين مدينة «كينت Kent» البريطانيّة عام 597م.
ولعلّ الإشارة الأقدم إلى الإسلام في الأدب المسِّيحيّ وردت في رسالة رجل بيزنطي يدعى «جوستوس Justus» إلى شقيقه أبراهام في عام (12ه/ 634م)، يخبره أنّ نبيًّا مخادعًا ظهر وسط السراسنة، فأعرب جوستوس عن دهشته قائلًا: «وهل يبُعث الأنبياء بسيف وعربة حرب؟ إنّكم سوف لن تلمسوا أي شيء حقيقي من هذا النبيّ سوى إراقة الدماء».
وقد وردت في كتابات القس هيسبالينسيس «Hispalensis» (ت14هـ/ 636م) رئيس أساقفة مدينة إشبيليّة الإسبانيّة Seville وآخر باحث في تاريخ العالم القديم، الذي عاصر الرّسول صلىاللهعليهوآله، وأسهم في بلورة الصورة المبكّرة عن النبوّة في
المخيّلة المسيحيّة، فعَدّ الإسلام عدوًّا للمسيحيّة، وأنّه هرطقة وثنيّة ضد المسيح، وقد ظلّت آراؤه مصدر إلهام للكتّاب المسيحيّين لقرون طويلة.
وخلال المدّة ما بين عامي (13-19ه/ 634-640م) أعرب القس ماكسيموسMaximus عن ذهوله من انتشار الإسلام قائلًا: «لا يوجد اسوأ من انتشار الشرّ بين سكّان العالم»، وفي نهاية القرن (1ه/ 7م) أشار القس أناستاتيويس Anastasius أسقف سيناء إلى الأحوال العسكريّة للمسلمين معربًا عن مدى سعادة البيزنطيّين باندلاع الحرب الأهلية بين صفوفهم، ويبدو أنّ أوّل إشارة عن سيرة الرّسول صلىاللهعليهوآله في مدوّنة تاريخيّة وردت عام (40ه/ 660م) في «الحوليات الأرمنيّة Armenian chronicles» للمؤرخ سيبيوس Sebeos (ت41ه/ 661م) الذي كان معاصرًا للرسول صلىاللهعليهوآله، بقوله: «إنّ رجلا اسمه مُحَمَّدًا من أصول إسماعيليّة، ادّعى النبوّة وعلّم أبناء بلده العودة إلى ديانة إبراهيم».
لم تحمل كتابات هذه المرحلة بين دفتيها غاية لفهم الإسلام أو التعرّض لمضامينه بقدر تعلق المسألة بطبيعة الخطاب الديني للكنيسة الذي كان يتعارض مع كل عقيدة تظهر خارج حظيرة المسيحيّة الكاثوليكيّة.
وإلى ذلك يشير سوذرن Southern: «إنّ القرون الوسطى حقبة الجهل المتأتّي إمّا من ضيق الأفق بالبعدين الفكري والجغرافي أو الجهل الناجم عن أوهام مخيّلة
متّسعة، فكان الإسلام بالنسبة للكنيسة رقمًا في قائمة الأعداء الطويلة، ولم يكن هؤلاء على استعداد للتمييز بين وثنيّة الأوروبيّين الشماليّين وتوحيد الإسلام، لقد انحصرت جهود المؤلفين اللاتين في المدّة من (81-493ه/ 700م-1100م) باستنطاق الكتاب المقدّس ومعرفة أصول السراسنة ضمن مدارج السلالات في العهد القديم ومعرفة مكانتهم بين شعوب العالم، لأنّ الكتاب المقدّس كان الأداة الفكريّة الوحيدة الفعّالة في أوروبا في مطلع العصور الوسطى.
وتبرز في هذه المرحلة المبكّرة كتابات البطريرك «سوفرونيوس» Sophronius (ت16ه/ 638م) أسقف مدينة القدس، الذي عقد الصلة بين نصوص توراتيّة وبين ظهور الإسلام عادًّا هجمات العرب السراسنة عقابًا من الربّ للمسيحيّين على خطاياهم ونقضهم للمواثيق.
كان للكنيسة السورية أثر فاعل في بلورة الموقف السلبي تجاه الإسلام وفي صيرورة الإدراك الأوروبي في القرون الوسطى، ولعلّ مـؤلّفات يوحنا الدمشقي تعدّ من أبكر الدراسات المـسيحيّة الشرقيّة عن الإسلام، ولا سيّما مؤلّفه الجدلي «مناظرة بينساراتي ومسيحي» الذي زعم بتقديم حجج ضد الطبيعة الإلهيّة للنبوّة المحمّديّة؛ كالقول إنّه لم يبشّر بها الأنبياء السابقون، أو أنّ محمدًا صلىاللهعليهوآله لم يقم بأيّ أعجوبة تثبت حقيقة نبوّته وأنّه من غير الممكن أن يغدو نبيًّا نظرًا إلى أنّ سلسلة الرسالات النبويّة ختمت بيوحنا المعمدان، وجدير بالذكر أنّ التصوّرات بشأن عدّ
الإسلام بدعة مسيحيّة وجدت طريقها إلى البيزنطيّين ومنهم إلى الأوروبيّين بعد أن انتقلت من مسيحيّي سوريا.
لقد انتشرت في المـسيحيّة الشرق أوسطيّة قصّة خرافيّة مؤدّاها أنّ محمّدًا صلىاللهعليهوآله كان في البداية تلميذًا للراهب «سرجيوس أو بَحِيرا» وأنّه تلقّى عنه بعض المعارف عن التوراة والإنجيل، ومن ثمّ أعلن نفسه نبيًّا وكوَّن عقيدة خاصة به، ومن جملة الأباطيل التي أفرزتها هذه المخيّلة الجامحة عدّ الإسلام من ابتداع محمد صلىاللهعليهوآله الذي كان يوحى إليه من الشيطان، وإظهار الرّسول صلىاللهعليهوآله على أنّه (المسيح الدجال)، وتأكيد أنّه قد مات في عام (46ه/ 666م) والعدد 666 ، يطابق عدد الوحوش في التوراة، كما ذهبت هذه المخيّلة أيضًا إلى تصويره على أنّه كان قسًّا منشقًّا عن الكنيسة لجأ إلى شبه الجزيرة العربيّة، فأسّس هنالك كنيسته الخاصّة التي استوحاها من التوراة والإنجيل، ومن ثمّ جعل يوم الجمعة يوم عبادة على غرار يوم السبت لدى اليهود ويوم الأحد عند المسيحيّين.
شهد القرنان (1-2ه/ 7-8م) توحيدًا لمناطق شمال أفريقيا وحوض البحر المتوسط تحت سلطة المسلمين التي كانت تمثّل خسارة لأهم مناطق الإيمان المسيحي فكان ذلك باعثًا رئيسًا لاندلاع الحروب الصليبية لاحقًا، وعلى الرغم من أنّ المسلمين كانوا يهدّدون نصف أوروبا ويجتاحون أقاليم كثيرة فيها؛ فقد كان المعاصرون لهذه الأحداث أقلّ عداء للإسلام من الأوروبيّين اللاحقين، فالمؤلّفون الأوروبيّون الشماليّون ومنهم البريطانيّون كانوا بعيدين عن مواقع الخطر الإسلاميّة، ويندرج في طليعة هؤلاء المؤرخ «بيــد المبجّل Venerable Bede (ت116ه/ 735م)» الذي يعدّ من آباء الكنيسة وأوّل كاتب بريطاني انبرى للكتابة عن الإسلام، وانصبّ اهتمامه لعقد الصلة بين ظهور الإسلام ونصوص الكتاب المقدّس، ولم يصدر عنه سوى الخطابات الهجوميّة والنبرة التحامليّة بحقّ المسلمين حينما نظر إليهم على أنّهم وثنيّون برابرة وكسالى، ولم تلبث آراؤه أن غدت أساسًا استندت إليه أوروبا حتّى القرن (6ه/ 12م)، وقد أشار في كتابه «التاريخ الكنسي للشعب الإنكليزي Historia ecclesiastica gentis Anglorum» إلى أنّ أصل السراسين يرجع إلى هاجر المصريّة زوجة إبراهيم الواردة في العهد القديم.
وبين الأعوام (493-534ه/ 1100-1140م) أخذ الكتّاب البريطانيّون على عاتقهم توجيه اهتمامهم صوب حياة الرّسول صلىاللهعليهوآله من دون أي اعتبار للدقّة،
فأطلقوا العنان لجهل الخيال، فكان الرّسول صلىاللهعليهوآله في عرفهم ساحرًا هدم الكنيسة في أفريقيا وفي الشرق؛ عبر السحر والخديعة، وضَمِن نجاحه بأنْ أباح الاتّصالات الجنسيّة. وقد استعملوا أساطير من الفولكلور العالمي ومن الأدب الكلاسيكي ومن القصص البيزنطيّة عن الإسلام، فاتّهموا المسلمين بعبادة الأوثان، وبأنّ محمّدًا صلىاللهعليهوآله صنمهم الرئيس، فكان معظم الشعراء الجوّالة يعدّونه كبير آلهة السراسنة، ولم تشهد هذه الحقبة المظلمة ظهور مؤلف يطبع الإسلام بنزر من الموضوعيّة عدا، ما ورد عن «بدرودي ألفونسو Pedro de Alfonso» طبيب الملك هنري الأول ملك إنجلترا (460-529ه/ 1068–1135م) الذي يعدّ أوّل من صنف كتابًا يحتوي على معلومات لها بعض الموضوعيّة عن سيرة محمّد صلىاللهعليهوآله في بريطانيا في عام (499ه/ 1106م) بالمقارنة مع سابقيه.
ولم تجلب الحروب الصليبيّة (492-690ه/ 1099-1291م) للغرب معرفة حقيقيّة عن الإسلام بل أحدثت العكس، ولا سيّما وأنّ اسم الرّسول صلىاللهعليهوآله بات متداولًا على الألسن منذ سنواتها الأولى، فكان كلّ غربي تقريبًا يعي من هو محمّد صلىاللهعليهوآله، لكن في صورة مشوّهة من نتاج مخيّلة مغرقة في التوّهم، ويبدو أنّ الحروب الصليبيّة أفرزت وحدة أيديولوجيّة تكوّنت ببطء في العالم المسيحي أدّت إلى ترسيخ معالم العدو.
لقد حصل الكتّاب البريطانيّون على معلوماتهم في هذه المرحلة من مصدريْن: الروايات البيزنطيّة؛ ومن التواصل الشّخصي مع المسلمين خلال الحملات الصّليبيّة، كما أسهم في تركيبها الفرسان العائدون من الشرق والكهنة والرّهبان، من خلال قصص الأبطال والحجّاج والقدّيسين والمـؤلّفات الجدليّة اللاهوتيّة الدفاعيّة للمسيحيّين الشرقيّين وشهادات بعض المسلمين وترجمات مفكّريهم وعلمائهم
في القرن(6ه/ 12م) الذين زودوا المخيّلة الأوروبيّة بطرائف عن الإسلام ونبيّه، فوصلت هذه الصورة الخيالية إلى المدارس والأديرة بعد وضعها في قالب يشجّع على قبولها، ومن ثم خلق انطباع شعبي مروّع في قدرته على البقاء ومقاومته لكل المعارف الصحيحة التي توالت لاحقًا عن سيرة الرّسول صلىاللهعليهوآله ولكنّ المـعلومة المـقدّمة كانت تنتزع في معظم الحالات من سياقها الأصلي ثم تقدّم إلى القارئ الأوروبي بهذا الشكل المشوّه في إطار البحث الحماسي عن حل سريع لمشكلة الإسلام.
واللّافت في الأمر مسألة التزامن بين ظهور الأقاصيص الخرافيّة عن حياة الرّسول صلىاللهعليهوآله في العقود الزمنيّة نفسها التي أنتجت التاريخ الأسطوري لبريطانيا في هذه المرحلة، فجاء الشعر الشعبي ليردّد الصورة الخياليّة المتكوّنة عن الإسلام، لتنمو دائرة التخيّل في هذا المجال وصولًا إلى القول إنّ الإسلام أخذ فكرة الثّالوث المـقدّس ضمن توجّه وثنيّ يزعم مُرَوِّجوه أنّ مُحَمَّدًا صلىاللهعليهوآله واحدًا من ثلاثة معبودات: أبولّون Apollon، وتروفونيوسTrophonios، وماهومت (محمد) Mahomet، كان يُعتقد بأنّها معبودات المسلمين على نطاق شعبي، أو أنّها كائنات جنّيّة خفيّة أو ربّما ثلاثة أصنام كبرى، وتعبيرًا عن ازدرائهم قام الأوروبيّون بتحريف اسم محمّد صلىاللهعليهوآله إلى أكثر من ثلاثين اشتقاقًا، تأتي جميعها بمعنى النبي المزيّف بلغات أوروبا المختلفة أو بمعنى إله الظلام أو الإله المزيّف أو الصنم أو الشيطان، أو للدلالة على الوثنيّة أو على الأتراك.
كما شاعت في العصور الوسطى أيضًا كلمة «بافومت» Baphome المأخوذة من لفظ محمّد المحرّفة الذي يرمز إلى إله خيالي كان فرسان الهيكل المقدّس يبجّلونه ويقيمون لأجله طقوس العبادة، وغدت كلمة «Mahomet» تدلّ على معنى الصنم أو إله العرب التي تطوّرت دلالاتها إلى معنى الدمية، لتنصهر مع المصطلح الأدبي الإنكليزي، ولعلّ ذلك يظهر جليًّا في بعض الأعمال الأدبيّة الشهيرة؛ مثل: مسرحية روميو وجولييت للكاتب البريطاني وليم شكسبير التي ورد فيها:
«And then to have a Wretched puling fool
A whining Mammet, in her fortunes tender»
ومعناها: «وما بالك إذا كانت حمقاء تعسة تُحمل مثل دمية باكية»، إنّ تلك الأساطير اﻟﻤﺨتلقة تمثّل سخريّة مأساويّة؛ لأنّ الرّسول صلىاللهعليهوآله قد انبرى لمناجزة عقائد الشرك والوثنية وليحطّم جميع أصنام الجاهليّة.
منذ منتصف القرن (7ه/ 12م) ظهرت ملامح مرحلة جديدة حملت بين طيّاتها نبرة من التعقّل من قضيّة النبوّة، كانت في بدايتها تباشير نظرة علميّة شاملة،
من نتائجها انبثاق محاولات جديدة لرؤية الإسلام من دون أحكام مسبقة، وقد حدث ذلك في دير كلوني Cluny عام (537ه/ 1143م)، عندما شرع رئيس الدير بطرس المـبجّل Petrus Vernailes برعاية أول ترجمة للقرآن الكريم من العربيّة إلى اللاتينيّة بيد مساعده الإنكليزي روبرت كيتون Robert Ketton التي تمثّل أوّل ترجمة كاملة للقرآن الكريم بلغة أوروبيّة، ويمكن اعتبار هذا التاريخ باكورة لانبثاق الاستشراق الأكاديمي، وبطرس المبجّل مؤسّسًا للدّراسات الإسلاميّة لدى مسيحيّي القرون الوسطى.
انطلق بطرس من مسلّمة حتمية الصراع مع الإسلام ولكن ليس بالسيف؛ وإنّما بالكلمة والإقناع، إذ يرى أنّ المسلمين هراطقة بالإمكان إعادتهم إلى فلك الكنيسة في ما لو تمكّن اللاهوتيّون والمـبشّرون من أن يظهروا لهم بنحو مقنع أين تكمن مواطن انحرافاتهم، وقامت مجموعة كلوني أيضًا بترجمة بعض الأحاديث المـنسوبة إلى الرّسول صلىاللهعليهوآله وترجمة رسالتين جدليّتين بعنوان: «رسالة المسلم عبد الله بن إسماعيل الهاشمي وجواب المـسيحي عبد المـسيح بن إسحق الكندي»، وعلى أساس تلك الترجمات صنّف بطرس المبجّل ما أسماه «دحض العقيدة الإسلاميّة»
Liber Contra sectam sive haeresim Saracenorum.
لكنّ هذه الحقبة كانت قصيرة وسرعان ما تلاشت لأنّ المعاصرين لبطرس
المبجل لم يروا في الإسلام موضوعًا حقيقيًّا للدراسة المتأنّية ولم تستخدم المادّة التي تضمّنتها المجموعة أساسًا لمزيد من الدراسة المعمّقة عن الإسلام؛ إذ لم يكن أحد يهتمّ بمثل هذه الدراسة، فلم يظهر لها فائدة من الصراعات الجارية، ولا سيّما وأنّ الجدل الديني كان يستهدف مسلمين خرافيّين، ويبدو أنّ الهدف إنّما كان لتزويد المسيحيّين بحجج سليمة لتثبيت إيمانهم، ثم إنّ الحالة العقليّة للغرب لم تكن مشجّعة على الاهتمام بمذاهب دينيّة بحدّ ذاتها؛ كتلك التي كانت موجودة في الشرق، وعلى الرغم من ذلك فإنّ هذه المجموعة صارت بالنسبة للأوروبيّين المـصدر الرئيس للمعلومات عن الإسلام على مدى خمسمائة عام.
ولعلّ ظهور المغول في المسرح التاريخي في القرن (7ه/ 13م) كان عاملًا كبيرًا في أن تغيّر أوروبا من نظرتها تجاه الإسلام، على فرض أنّ المغول لم يكنْ لعقائدهم وزن فكريّ، فضلًا عن إدراك الأوربيّين وجود مشتركات بين المسيحيّة والإسلام، ولعلّ غرابة وثنيّات المغول وضعت هذه القواسم المشتركة في ضوء جديد، كما أظهر تحرّك المغول نحو العالم الإسلامي وجود أقليّات مسيحيّة شرقيّة قويّة بين صفوف المسلمين ما كان الأوروبيّون يعرفون عنها شيئًا من قبل، لكن على الرغم من أنّ هذه المعرفة المفاجئة سرعان ما تلاشت بين الحقيقة ومبالغات الخيال؛ فإنّها كانت حاسمة في تغيير نظرة أوروبا نحو الخارج في تلك الحقبة.
ومنذ منتصف القرن (7ه/ 13م) شعر الأوروبيّون أنّ الحملات الصليبيّة لا تملك حظًّا من النّجاح، وأنّه لا بدّ من وسيلة جديدة لمناجزة الإسلام بعد أن أيقنوا أنّ الصراع العسكري معه لا يكفي لإسقاطه، وأنّه لا بدّ من التوغّل بنحو أعمق لفهم مضامينه بغية التّشكيك في صحّة عقيدته.
وقد لمع في هذه المرحلة اسم الفيلسوف البريطاني روجر بيكون Roger Bacon الذي استطاع وللمرّة الأولى أن يضع المسيحية في موقعها الحقيقي جغرافيًّا وبشريًّا، فآمن بأنّ هنالك مسيحيين قليلين في العالم اليوم، أمّا سائر الأرض المعمورة فيعجّ بالكفّار حسب قوله، الذين لا يجدون أحدًا يهديهم، وهو يرى أنّ المسيحيّة لن تنتشر وتنتصر بغير التبشير السلمي بعد الحروب الصليبيّة الفاشلة، غير أنّ المسيحيّة عاجزة في نظره عن القيام بهذه المهمّة لثلاثة أسباب: الأول لا أحد من الأوروبيّين يعرف لغات الشعوب التي يراد التبشير بينها، والثاني، لا أحد يعرف ماهيّة عقائد الكفّار الذين يراد تبشيرهم، والثالث لا أحد يملك حُججًا مؤسّسة على المعرفة لدعوة غير المسيحيّين إلى الكاثوليكية، لذلك أورد بيكون حُججًا ضدّ الإسلام وتشكيكات وجدها كفيلة بنقضه غير أنّها في الحقيقة كانت غير كافية لاستمالة المسلمين نحو المسيحيّة، لكنّها كانت جديدة. وفي هذا الصدد دعا بيكون لإنشاء مدارس لمعالجة هذا القصور.
كانت نظرة الغرب إلى الإسلام قبل بيكون تقوم على أنّه دين ذو دور سلبي في التاريخ حال دون اعتناق الناس للمسيحيّة، ويعدّ إمارة ظهور (المسيح الدجال) في سياق نهاية العالم وقيام يوم الدينونة، أمّا بيكون فإنّه خالف ذلك وذهب إلى عدّ الإسلام ليس له أي دور تخريبي في العالم، وليست إمارة للدجال أو القيامة، بل إنّ للإسلام دورًا قبل نهاية العالم، وبذلك تجاوز بيكون الرؤية التقليديّة للكتاب المقدّس في مجال فهم الإسلام، ورأى أنه دين ذو صلة بالفلسفة، ولعلّ مبعث هذا التحوّل في رؤية بيكون يرتدّ إلى مصادره عن الإسلام التي تنوّعت بين ترجمات الفلاسفة المسلمين وتقارير الرحّالة. وصفوة القول: يمكن اعتبار بيكون منظّرًا للفكر الاستشراقي ومؤسّسًا لحيثيّاته الأيديولوجيّة والمنهجيّة في مرحلة زمنيّة مبكرة قبل أن يتم تداوله مفهوميًّا.
وفي القرن (8ه/ 14م) بدأ الحصول على الشرعيّة والدعم لإنشاء مدارس اللغة الشرقيّة التي دعا إليها بيكون، وبدأت مادّة الإسلام تدخل ضمن البرنامج الرسمي للكنيسة الغربية منذ مجمع فيينّا الكنسي عام (711ه/1312م) والتي قرّر تأسيسها في أكسفورد، وباريس، لتعلّم العربيّة والعبريّة والإغريقيّة، لكنّ عدم توافر العناصر البشريّة والمادّيّة أدّى إلى اندثار هذا المشروع، فكانت السنوات التي أعقبت مجمع فيينّا حقبة حبلى بالخيبة في تاريخ أوروبا فلم تعد هناك قوّة ثقافيّة فاعلة مهتمّة بتحديد الموقف من الإسلام، أمّا عن الانفتاح المعجب الذي لقيته الفلسفة الإسلاميّة إبّان القرن (6ه/ 12م) حتّى منتصف القرن (7هـ/ 13م) فقد عاد العداء الأصمّ بنحو تدريجي ليحلّ محلّه، ويبدو أنّ أوروبا لم تعد آمنة على مصيرها؛ ما شجّع على إعادة نصب أشرعة الخيال من جديد، ويظهر ذلك جليًّا في النظرة المعتمة للرسول صلىاللهعليهوآله التي انبعثت فيها الحياة من جديد.
ولعلّ الكاتب البريطاني جون ويكلف (John Wycliffe ت785ه/ 1384م) كان الأوضح في بيان موضوع الربح والخسارة التي جلبها القرن (8ه/ 14م)، فكان القسم الأكبر من معارفه عن الإسلام مستمدّ من دائرة معارف (Vinzenz)، ودائرة معارف (Von Beaunais)، ودائرة معارف (Ranulf Higden) الذي رسم صورة شاملة عن الإسلام الصاعد في العالم والساعي للسيطرة والممتلئ بشهوة التملّك؛ بخلاف المسيحية التي هي عقيدة الألم والفقر، من ثمّ حاول أن يدل على وجهة نظره في طريقة إصلاح الكنيسة لتحقيق الانتصار على الإسلام، فشريعة محمّد صلىاللهعليهوآله من وجهة نظره تميّزت بالاستيلاء على نصوص العهدين لتدعم توجّهًا دنيويًّا ثمّ تشرع بمهاجمة بقية الإنجيل المخالفة لمقاصدها، وزعم أنّ النبي صلىاللهعليهوآله أضاف لتلك المستلات مبتدعات من عنده واستطاع أن يضع كل خصومه جانبًا عندما حرّم
مناقشة أي من آرائه، لكن لم يكن ذلك ما زعمته الكنيسة عندما حرمت مناقشة عصمة البابا وسلطته المطلقة. كما أشار إلى أنّ أخطاء الإسلام لا يمكن أن تصحَّح إلا بالتبشير الناجح المقترن بإصلاح للكنيسة، وعدّ الإسلام خطرًا أخلاقيًّا وعامل تهديد مادّيّ للوجود الغربيّ، لهذا زعم بعدم وجود تباين بين رجال الكنيسة والمسلمين.
ومن الأعمال المميّزة في هذه الحقبة يرد ديوان الرّاهب والشاعر الإنكليزي جون ليدجيت (John Lydgate ت 854ه/ 1451م) الموسوم «سقوط الأمراء Fall of Princes» الذي اشتمل على قصيدة عن الرّسول صلىاللهعليهوآله تغصّ بالمبتدعات، على شاكلة أنّ الرّسول صلىاللهعليهوآله كان أوّل من استخدم الجِمال لنقل البضائع، وأنّه زار مصر لدراسة الإنجيل، ومن ثمّ سافر إلى خراسان بمعيّة سيّدة تُدْعى خديجة، من ثمّ أعلن أنّه المسيح ليغدو نبيًّا عظيمًا وسط قومه فتزوّجته هذه السيدة لهذا السبب، من ثم أصبح ملكًا على العرب والأتراك وسرعان ما جمع جيشًا وحارب هرقل واحتل الإسكندريّة، ويبدو للباحث أن كتابات هذه المرحلة تحمل صورة مبعثرة وغير واقعيّة ترسّخ نظرية الانتحال من المسيحية من خلال الرحلة في طلب العلم مع التّأكيد على الأثر المصري، ولعلّ هذه القصيدة تحمل بين ثناياها تحذيرًا من المدّ الإسلامي للعالم المسيحي، المتمثّل بالعثمانيّين الذين حاول الكاتب أن يظهر صلتهم المباشرة بالرسول صلىاللهعليهوآله.
ولم يمضِ على وفاة وِيكْلِف خمسة أعوام حتّى إنهار الصربيّون أمام الزحف العثماني. وقد أظهرت تطوّرات الأحداث إبّان القرن (9ه/ 15م) أنّ على أوروبا المسيحيّة القيام بعمل ما لمواجهة خطر الإسلام المحدق المتمثّل بالعثمانيّين، الذين تركوا أثرًا كبيرًا في توسيع البون الذي يفصل بين الإسلام والمسيحيّة بعد الهزائم التي أوقعوها بالأوروبيّين؛ ما جعل أوروبا تعمّق من كراهيّتها تجاه الإسلام، معتبِرة أن الرّسول صلىاللهعليهوآله كان معتادًا على غزو الآمنين وسبي النساء.
وشهد القرن (10ه/ 16م) ظهور مصنّفات تُعنَى بتاريخ الإسلام من خلال تاريخ العثمانيّين، ففي عام (982ه/ 1575م) صدر في لندن كتاب «التاريخ البارز للسراسنة A Notable History of the Saracens» لتوماس نيوتن (Thomas Newton) أسقف الكنيسة الإنجليكانية، كما صنّف مؤرخ الكنيسة جون فوكس (John Foxe) عام (994ه/ 1587م) كتاب «تاريخ الأتراك History of the Turks» الذي أفرد منه 100صفحة وَجّه من خلالها نقدًا عنيفًا للنبوّة.
ولعلّ أشدّ ما ورد بحق الرّسول صلىاللهعليهوآله في هذه الحقبة جاء على لسان الشاعر الاسكتلندي «وليام دينبار William Dunbar» المولود عام (864ه/ 1460م) في قصيدته «السبع الموبقات» التي اشتمل عليها وصف الأشخاص الراقصين في الجحيم الذين خرجوا عن سلطة الكنيسة، مشيرًا إلى أن السراسنة يعبدون إلهًا للشرّ يدعى ماهون.
ومنذ منتصف القرن (9ه/ 16م) بدأت تشيع لهجة التّخوين والاتّهام المـتبادل بين الأطراف المـسيحيّة المـتخاصمة فقد ظهر في ديوان «CalvinoTurcismus» للكاتب واللاهوتي الإنكليزي «وليم رينولد» William Rainolds عام (1002ه/ 1594م) الذي رأى أن كلًا من الكالفينيّة والإسلام يجتمعان على تحطيم المسيحيّة فكلاهما ينكر ألوهيّة المسيح وأن إنجيل كالفن ليس أفضل من القرآن لكنه أكثر بغضًا.
ولعلّ هذه النظرة تُعدّ تطوّرًا في الخطاب الديني تجاه الإسلام، فقد أضحى الإسلام يوازي عقيدة مسيحيّة منشقّة بعد أن كان عبادة شيطانيّة أو وثنيّة، ولا سيّما وأنّ مارتن لوثر وضع المسلمين والبابا في سلة واحدة، عادًّا الأتراك الشيطان الأسود بالنسبة للشرق أمّا البابا فصوّره شيطانَ الغرب، وعلى الرغم من لغته السمجة بحقّ
الرّسول صلىاللهعليهوآله؛ لكنّه أقرّ بصلاح منظومة المسلمين القيميّة المتمثّلة باعتزالهم الخمور وحياة التكلّف واحترامهم لإمبراطورهم.
وإلى ذلك يشير برنارد لويس قائلًا: «إنّ مسيحيّة العصور الوسطى انكبّت على دراسة الإسلام بغية التشكيك به وحماية المسيحيّين من إلحاد المسلمين وحمل المسلمين على اعتناق المسيحيّة، لذلك تجد أن أغلب الباحثين من طبقة رجال الدين الذين خلقوا إطارًا أدبيًّا يتعلّق بالإسلام ونبيّه وكتابه، وقد حملت الجدالات الدينيّة نبرة بذيئة ترمي إلى تشويه صورة الإسلام وحماية المسيحيّة بدلًا من التبليغ، وعلى الرغم من ظهور بعض الأبحاث المتناثرة إلا أنّ سمة التعصّب والتحيّز ظلّت طاغية عليها، وقد لعب التجديد دورًا في التّقليل من حدّة النظرة التقليديّة للإسلام حينما عكف الكُتاب الكاثوليك على تشبيه البروتستانتيين بمحمّد».
يمثّل عام 1600م فجر الكتابة البريطانيّة الحديثة من خلال تبنّي العالم المسيحي للروح العلمانيّة في قراءة تاريخ العالم التي جعلت من الإنسان محورًا لأحداث العالم؛ بدلًا عن القوّة الإلهيّة، لتغدو الأحداث التاريخية بوتقة تتشكّل من انصهار الفواعل مع التجارب؛ وسرعان ما بات الاهتمام واسعًا بالمصادر والدراسات اللغويّة، وفي هذه الحقبة ظهرت الكتابات التخصصيّة عن الرّسول صلىاللهعليهوآله، ولعلّ أقدم مصنّف باللغة الإنكليزيّة، كُرّس للحديث عن الرّسولصلىاللهعليهوآله ويحمل عنوان محمّد صلىاللهعليهوآله ظهر في هذه الحقبة لكاتبه والتر رالي WalterRaleigh «حياة محمّد ووفاته
وغزو أسبانيا وقيام إمبراطورية السراسنة وخرابها «The Life and Death of Mahomet The Conquest of Spaine Together with the Rysing and Ruine of the Sarazen Empire»، الذي طبع لاحقًا عام 1637م، وحمل بين دفّتيه العديد من المغالطات، إذ اعتقد بأنّ الرّسول صلىاللهعليهوآله ذهب إلى المدينة غازيًا وأخذها عنوة بالسيف، لكنّه ناقض نفسه بعد صفحات قلائل ليقول إنّ محمّدًا دخل المدينة سلمًا.
وظهر أيضًا للكاتب وليم بيدويل (William Bedwell) كتاب «الكشف عن محمّد المنتحل والقرآن A Discovery of the Impostures of Mahomet and of the Koran.» الذي صدر في لندن عام 1615م، وعكس عنوان غلافه ما ينطوي عليه محتواه من التعصّب والاجترار للأفكار القديمة نفسها، حيث نظر بيدويل إلى مقام الرّسول صلىاللهعليهوآله على أنّه شخص مُغَرّر به وأنّ القرآن في تصوّره كتاب للزندقة. وقد أسّس بيدويل آراءه بناءً على ترجمته للقرآن الكريم، التي تعدّ أوّل ترجمة باللغة الإنكليزيّة من اللغة اللاتينيّة، كما تمكّن من الاطّلاع على بعض المخطوطات العربيّة والمعاجم اللغويّة المترجمة إلى اللاتينيّة.
واقتفى تلميذه إدوارد بوكوك Edward Pococke أثره، فصبّ اهتماماته على دراسة اللغتين العبريّة والعربيّة، وكان الكاتب الوحيد في عصره الذي حاز على فرصة الاطّلاع على المصادر الإسلاميّة، وقد أصدر في عام 1650م كتابه «لمع
من تاريخ العرب Specimen Historiae Arabum» الذي يُعدّ ترجمة لكتابات ابن العبري وكتابات أبي الفداء التي شفعها بتعليقات باللغة اللاتينيّة، كما شرع بوكوك أيضًا بترجمة حياة محمّد صلىاللهعليهوآله من العربيّة إلى الإنكليزية، ولم تخلُ هذه الترجمة من التقوّلات القديمة المتمثّلة بأنّ الإسلام دين زائف. وقد اعتمد كتّاب عصر النهضة في كتاباتهم عن السيرة على المصادر العربيّة الأصليّة المترجمة إلى اللاتينيّة لكنّ أغلب هذه الأعمال كانت معادية بشكل مرير وذات أحكام تعسّفيّة مسبقة.
لقد ترسّمت في هذه الحقبة صورة الإسلام على هيئة أنموذج قبيح يتعارض مع الأنموذج المـثالي للمسيحيّة؛ بوصفها ديانة الحقيقة التي تتميّز بالأخلاق الصارمة وروح السّلام، وأنّها عقيدة الإقناع وليست عقيدة السّيف، وضمن هذا المـنحى نسبت إلى الإسلام بعض الرموز المـسيحيّة التقليديّة، لكن بدلالات سلبية مثلًا صورة الحمامة التي ترمز إلى روح القدس في المـسيحيّة، التي أشار لها والتر رالي في كتابه «تاريخ العالم» The History of the World في خضم حكاية أسطورية شاعت في بريطانيا؛ مفادها: أنّ الرّسول صلىاللهعليهوآله درَّب حمامة لتنقر حبوب القمح من أُذنه؛ لإقناع العرب أنّ تلك الحمامة هي رسول الروح القدس الذي كان يبلّغه الوحي الإلهي، وقد انصهرت هذه الحكاية في التّراث البريطاني حتّى أنّ وليم شكسبير اقتبسها في مسرحيّته هنري السادس Henry VI: «Was Mahomet inspired with a dove Thou with an eagle art inspired then».
«كان محمّد تلهمه الحمامة أمّا أنت فلعلّ النّسر سيلهمك».
كما كان للأمثال الشعبيّة الإنكليزيّة نصيب من هذا التّراث، ففي المثل الشّائع «اذا لم يأتِ الجبل إلى محمّد فإنّ محمّدًا يذهب إلى الجبل»، If the mountain won’t come to Muhammad then Muhammad must go to the mountain التي تعدّ عبارة مجازيّة ظهرت لأوّل مرّة في كتابات فرانسيس بيكون (Francis Bacon) عام 1597م، ومضمونها: «أنّ محمّدًا لمّا دعا الناس إلى الإيمان به طلب من التلّة أن تتقدّم نحوه فلمّا لم تتحرك نحوه تحرّك هو باتّجاهها».
أمّا عن وفاته صلىاللهعليهوآله فقد كثرت الافتراءات عن ذلك، ولا سيّما قصّة ضريحه المعلّق بين السقف والأرض بواسطة أحجار مغناطيسيّة في المدينة؛ وغدت مقولة «تابوت محمّد المعلّق» مثلًا للتعبير عن أيّ أمر يثير الريبة في الموروث البريطانيّ.
وجدير بالذكر أنّ الخطاب البريطاني حمل بين دفّتيه نبرة عنصريّة لدى الحديث عن قضايا الإسلام فكان النعت المفضّل لدى الكُتّاب البريطانيّين عند حديثهم عن المسلمين في القرون الوسطى وفترة عصر النّهضة (مورس) Moors، وهذه الكلمة تحمل بين طيّاتها دلالات متعدّدة لكنّها كانت تستخدم للدّلالة على العرب البدو أو البرابرة أو العرب الأفارقة، كما ترد لها دلالة أبناء هاجر، وهذا المعنى يوازي مدلول مصطلح سراسنة، في كتابات الشاعر روبرت بارون (Robert Baron) في مسرحية ميرزا (Mirza) التي عرضت في لندن عام 1655م في معرض حديثه عن القرآن قائلًا: «إنّ القرآن يُعدّ التاريخ الموثق لمحمّد بين أتباعه المورس، كما يُمثّل الإنجيل بالنسبة لنا نحن المسيحيّون». كما أشار بارون أيضًا إلى أنّ الرّسول صلىاللهعليهوآله
استعان بطبقة العبيد المسيحيّين في مكّة الذين كانت لديهم معرفة مشوّشة عن العهد الجديد في نظمه للقرآن.
وقد شهد القرن (11ه/17م) تزايدًا في عدد المؤلّفات البريطانيّة المتخصّصة في تاريخ الأتراك وحيثيات الإسلام، ورُدّدت الأفكار الشائعة القديمة مِن قِبل أكثر الكُتّابِ البريطانيّين في هذه الحقبة، برؤية تتماشى مع التصوّرات الجديدة عن الإسلام، كما ورد في كتاب «التاريخ العام للأتراك HistorieGenrral Turkes» لريتشارد نولز Richard Knolles، الذي عُدّ في بريطانيا بمثابة سجل لأعمال القسوةِ العُثمانيةِ، وقد اقتفى نولز أثر سلفه، في نظرتهم إلى الإمبراطوريّةِ العُثمانيّةِ على أنّها الإرهاب الأعظم في العالمِ، وأنّ الإسلام عمل شيطانيّ.
وفي عام 1632م أُنْشِئَ في جامعة كامبردج كرسيُّ اللغة العربيّة من قبل تاجر أقمشة في لندن يدعى ثوماس ادمز (Thomas Adams)، كما شرع وليم لاود (William Laud)، بتأسيس كراسٍ للعربيّة في جامعة أكسفورد، وتمكّن من أن يحرّر رسالة ملكيّة إلى إدارة شركة الهند الشرقيّة الموجودة في الشرق يحثّهم فيها على إرسال كل ما بحوزتهم من المخطوطات العربيّة والفارسيّة والشرقيّة، وبذلك تمكّن من حيازة أكثر من ستمائة مخطوطة وعدد من صناديق العملات الشرقية.
ويَرد من كتابات هذه الحقبة أيضًا كتاب «علاقات الرحلة» A Relation of
a Journey للشاعر والرحّالة البريطاني جورج سيدني (George Sandys) (1577-1644م)، الذي صدر في لندن عام 1610م، واشتمل على أربعة اقسام قدّم فيه مسحًا عامًّا عن الدولة العثمانيّة ومصر والأراضي المقدّسة والجزر الإيطاليّة البعيدة، وبسط فيه الحديث عن سيرة المصطفى صلىاللهعليهوآله بنحو مجحف، وعدّه شخصًا تظاهر بأنّه اختير بفضل العناية الإلهيّة لتبليغ شريعة جديدة للبشريّة، وأن يُخضع العالم لطاعته بواسطة السّلاح.
كما صدر في عام 1656م، للكاتب «فرانسيس أوسبورن (Francis Osborn’s)»، «كتاب العلاقات السياسية لحكومة الأتراك Political Reflections on the Government of theTurks»، وصدر كذلك في عام 1668م في لندن كتاب «أوضاع الامبراطوريّة العثمانيّة» Present State of the Ottoman Empire لـ«بول ريكوتس Paul Rycaut’s» (1629-1700م)، وقد ظهر في هذين الكتابين نقد عنيف للسيرة النبويّة والإسلام.
لقد بلغ الخطاب الاستشراقي البريطاني أوجّ حدّته في هذه الحقبة بسبب العثمانيّين، بعد أن كانت نظرة الأوروبيّين إلى النبوّة من منظار ديني لاهوتي ذي طابع خيالي متعسّف، غدت طموحات السّلاطين العثمانيّين وسياستهم التوسّعية تجليًّا يقترن بصورة الرسول صلىاللهعليهوآله، لذلك قلّما نلمس مصنّفًا منذ القرن (9ه/ 15م) وما تلاه، لا يحمل بين دفّتيه أسلوب المزامنة المفاهيميّة بين «صورة محمدصلىاللهعليهوآله =صورة الأتراك»، على الرغم من الاختلافات العرقيّة والزمكانيّة، وغدت صورة النبوّة المشوّهة في أوروبا أداة تحريضيّة ضد العثمانيين إبّان هذه الحقبة.
وفي هذه الحقبة فرغ الكاتب واللاهوتي الإنكليزي ألكسندر روز (Alexander Ross) (1592-1654م) من ترجمة نسخة القرآن الكريم من الفرنسيّة إلى الإنكليزيّة
عام 1649م؛ هذه الترجمة التي عمد خلالها إلى تشويه العبارات وتحريفها، كما تمكّن روز في عام 1652م من تصنيف كتاب «عرض لجميع أديان العالم» View of all the Religions in the World الذي أفرد القسم السادس منه للحديث عن الرّسول صلىاللهعليهوآله والمسلمين العرب، والفرس، والأتراك، وقد اشتمل كتابه على جانب من الموضوعية مقارنة بمعاصريه، إذ أنكر الاعتقاد السائد بأن محمّدًا صلىاللهعليهوآله (المسيح الدجال) مشيرًا إلى أنّه لم يكن يومًا عدوّ المسيح، خلافًا لما ذهب إليه بيتر هيلين (Peter Heylyn) (1599-1662م) في كتابه الكوزموغرافيا (Cosmographie) الذي صدر في عام 1652م، حيث اعتقد أنّ الرّسول صلىاللهعليهوآله تمكّن من بناء إمبراطوريّته بفعل ما استحوذ عليه من مبادئ شيطانيّة.
وفي عام 1671م انبلج إلى حيّز الدراسات الاستشراقيّة وفي سابقة غير معهودة أوّل فجر لعمل موضوعي منصف عن سيرة الرّسول صلىاللهعليهوآله في التاريخ البريطاني بعنوان: «الاعتبار في نهوض وتنامي المحمّدية مع حياة محمّد والدفاع عنه وعن دينه من مطاعن المسيحيّين An Account of the Rise and Progress of Mahometanism: With the Life of Mahomet and a Vindication of Him and His Religion from the Calumnies of the Christians» للكاتب والفيزيائي البريطاني هنري ستوب Henry Stubbe (1632–1676م)؛ هذا المصنَّف لم يرَ النور إلا في عام 1911م، قدّم فيه ستوب مماثلة بين الإسلام والمسيحيّة، مقرًّا بحقيقة الإسلام، ومنكرًا جميع الاتّهامات القديمة، وعادًّا الرّسول صلىاللهعليهوآله أعظم مشرّع عرفته البشريّة. لقد مثّل ستوب جزءًا من تقليد فكري متنام آنذاك قائم على نقد التّناقضات الفكريّة التي تحملها مسألة الثالوث في المسيحيّة، من خلال التفتيش عن جذور التوحيد الأصليّة في تاريخ الشرق الأوسط.
أضحى الإسلام إبّان القرن (10ه/ 16م) جزءًا من حالة الجدل الديني المحتدم بين الكاثوليكيّة والبروتستانتيّة، ولا سيّما بشأن مسألة أصل المسيحيّة وحيثيّاتها، فأصبح الإسلام دلالة تنكيل يستخدمها كل معسكر في تقريع غريمه وتشبيهه بأنّه يحوز على مبادئ الإسلام نفسها، وأتباع وثنيّين على شاكلة الأتراك، لكن سرعان ما ظهرت سمة جديدة في الكتابة عن الإسلام جلبتها بواكير عصر النهضة، فأصبحت الدراسات الأكاديميّة مهتمّة بمقارنة الأديان، ولا سيّما بعد أن لفت الفيلسوف البريطاني روبرت بويل (Robert Boyle) (1691-1727م) إلى ضرورة النّظر بجدّيّة إلى مقارنة محتويات كلًّا من اليهوديّة والإسلام مؤسّسًا بذلك روحًا نقديّة جديدة.
ولعلّ السّمة الأبرز في رؤية الاستشراق البريطاني إبّان هذه المرحلة؛ تأكيد الصورة التقليديّة المشوّهة عن الرّسول صلىاللهعليهوآله، على الرّغم من المحاولات الخجولة التّي شرّع بها بعض الباحثين التي لم تأتِ اُكلها؛ لأنّ العقليّة البريطانيّة لم تبلغ يومها حدّ الانسلاخ الفعليّ عن الموروث الكلاسيكي المتحامل، وهذا ما دلّت عليه عنوانات المصنّفات التي كانت تحمل على أغلفتها عبارة «Imposter المنتحل»، كما اتّسمت كتابات هذه المرحلة بأنّها قدّمت أحكامًا مسبقة قبل أن تشرع بسرد تفاصيل السيرة النبويّة بين ثنايا متونها لتحاكي ما استهلّ عليه عنوان المصنف في المقام الأوّل.
ويرى المستشرق ألموند (Almond): «أنّ عبارة المنتحل «Imposter» ظلّت التعبير الملازم لاسم محمّد لتميّزه عن أسماء من لديهم التّسمية نفسها حتّى وقت قريب من القرن التاسع عشر، ومن أمثلة ذلك ما ورد في دائرة المعارف الإنكليزيّة (English Encyclopedia) لعام 1802م، ودائرة المعارف البريطانيّة Encyclopedia of Britannica للأعوام 1817 و1832م».
لكن أعنف نقد تعرّضت له سيرة الرّسول صلىاللهعليهوآله في هذه الحقبة ظهر في عام 1697م على يد الكاتب البريطاني همفري برديو (Humphrey Prideaux)
(8461-0271م) في كتاب «طبيعة الانتحال الصريحة تظهر كاملة في حياة محمّد The True Nature of Imposture Fully Displayed in the Life of Mahomet» وقد اصطبغ خطاب بريدو بإنكار تامّ لنبوّة الرّسول صلىاللهعليهوآله قائلًا: «خلق محمّد دينًا ظنّ أنّه غدا مستساغًا لكنّه لا يعدو أن يكون مزيجًا مضطربًا من اليهوديّة وهرطقة مسيحيّة كانت منتشرة في الشّرق آنذاك، وطقوس وثنيّة قديمة عند العرب من ثمّ شرع بإباحة كل أصناف الغرائز الشهوانية بشتّى أشكالها بغية اجتذاب أصناف البشر لاعتناق دينه... ولمّا كانت تعصف به نوبات المرض فتسقطه صريعًا كان يدّعي أنّها غشية الملك جبريل عندما يقبل عليه بوحي من الرب».
في مطلع القرن (12ه/ 18م) برز اسم المستشرق سيمون أوكليSimon Ockley قس من مدينة كامبردج البريطانيّة، درس العربيّة، وأصدر في عام 1708م كتابه «غزو السراسنة لسوريا وفارس ومصر The Conquest of Syria ,Persia, and Aegypt by the Saracens» تبعه في عام 1718م بإصدار كتابه «تاريخ السراسين» The Historyof the Saracen وقد اعتمد أوكلي في تصنيفه على كتاب فتوح الشام لمحمّد بن عمر الواقدي، وتعدّ مصنّفات أوكلي أوّل محاولة شاملة للكتابة عن تاريخ العرب والمسلمين باللغة الإنكليزيّة، ويبدو أنّ صورة الرّسول صلىاللهعليهوآله بدت مشوّهة في كتاباته لأنّه سار في أثر برديو في تصويره لطبيعة الإسلام وسيرة الرّسول صلىاللهعليهوآله.
ويأتي الكاتب البريطاني جان جانيه (Jean Gagnier) ، أستاذ اللّسانيات الشرقيّة في جامعة أكسفورد الذي صنّف مصنّفًا في سيرة النبي محمّد صلىاللهعليهوآله في عام 1732م يقع في ثلاثة أجزاء بالاعتماد على كتاب أبي الفداء، أشار في مطلعه إلى أنّه رغب في إظهار البواعث التي أدّت إلى إيمان العرب به، وقد أصبح كتابه مرجعًا أساسًا في تاريخ السيرة في أوروبا حتّى ظهور كتاب المستشرق الألماني غوستاف فايل (Gustav Weil) «Mohammed der Prophet محمّد النبي» في عام 1843م الذي أذن ببداية عهد جديد في دراسات السيرة في أوروبا، علاوة عن ترجمته لكتاب أبو الفداء «المختصر في تاريخ البشر» عام 1723م إلى اللغة اللاتينيّة.
خصّص جانيه مقدّمة كتابه بصفة رئيسة لتفنيد الآراء المتحاملة للكاتب الفرنسي هنري بونافلييه (Henri de Boulainvilliers) الذي صنّف في باريس عام 1731م كتابه «تاريخ العرب مع حياة محمّد Histoire des Arabes avec la Vie de Mahomet». وقد عُدّ جانيه صاحب مهارة لدرجة أنّ كتابه غدا من أفضل ما كُتِب عن سيرة النبي محمّد صلىاللهعليهوآله، فاغترف منه كثير من المؤرّخين، لكنْ على الرّغم من ذلك لم يكن جانيه مُنصفًا للرسول صلىاللهعليهوآله إنصافًا تامًّا، فقد وصفه بأنّه أكثر النّاس شرًّا، وقد علّق المستشرق بفانمولر (Pfanmuller) على ذلك قائلًا: «إنّ الأمر هنا ليس له إلّا تفسير واحد؛ أي توجيه القارئ من بادئ الأمر لقراءة الكتاب
في ضوء هذه الأحكام، وبهذا يؤثّر جانيه على القارئ ويقيّد حريّته ويقلّده بذلك نظارة سوداء تلوّن كل ما تقع عليه عينه بهذا اللّون القاتم؛ وهذا ليس من العلم والإنصاف ولا يمت إلى الأمانة العلميّة بسبب».
وفي عام 1734م وبعد خمسة وثمانين عامًا من ترجمة روس (Rose) ظهرت ترجمة جديدة للقرآن على يد الكاتب البريطاني جورج سيل (George Sale)، اشتملت على حواشي وتعليقات مقتبسة من نسخة القرآن اللاتينيّة الجدليّة المناوئة للإسلام التي صدرت في روما عام 1698م لـدوفيشيوماراشي (Lodovico Marracci) قدّم سيل نبذة عن حياة محمّد صلىاللهعليهوآله، لم يخرج فيها عن النظرة التقليديّة السلبيّة تجاه النبوّة، لكنّه اختلف عمّن سبقه بأنّه أشاد بالقيم الأخلاقيّة التي يحملها محمّد صلىاللهعليهوآله الأمر الذي يُعدّ تطوّرًا في نظرة البريطانيّين إلى شخصيّة محمد صلىاللهعليهوآله، حتّى أنّ سيل عُدَّ نصف مسلم بسبب مواقفه إذ يرى: «محمّد رجل ذو أخلاق رفيعة وليس وحشًا أو شرًّا؛ كما ينظر إليه في العادة».
ولم تخلُ كتابات هذه المرحلة من النزعة العدائية ففي عام 1753م عرض في مسرح لندن مسرحية «محمد المنتحل Mahomet the Imposter» للكاتب المسرحي جيمس ميلر (James Miller) الذي ذهب إلى أنّ الرّسول صلىاللهعليهوآله لم يكن لديه وحي إلهي ولم يُبعث من السّماء وإنّما دعوته هذه جاءت بسبب رغبة جامحة وطموح شديد لديه للرئاسة والمال تحت ستار الدين مصوّرًا الرّسول صلىاللهعليهوآله زعيمًا
لجماعة من قطّاع الطّرق من خلال محاورة مفترضة بين شخصيّة محمّد المزعومة وشخصيّة فرعون في مسرحيّته.
جلب القرن (12ه/ 18م) معه تحوّلات في طبيعة الرؤية الاستشرافيّة البريطانيّة تجاه السيرة النبويّة، إذ يرى برنارد لويس أنّه: «ظهرت في كتابات عصر التنوير وما تلاها شهادات إيجابيّة بحقّ محمّد على أنّه الحكيم والمتسامح والمشرّع والحاكم والمجدّد، على الرغم من إدانتهم واتّهاماتهم له بالتعصّب والتّلفيق» ويبدو أنّ ظهور نزعة التناقض بين الموروث السلبي واعتماد وجهات نظرة جديدة تتّسم بالموضوعيّة في كتابات هذه المرحلة أدّت إلى تغيّر النظرة حيال الإسلام لكن بنحو بطيء.
وقد بلغت هذه النزعة أوجّها في طروحات المؤرّخ الإنكليزي إدوارد جيبون (Edward Gibbon)، التي تضمّنها مصنّفه «تاريخ انحدار الإمبراطورية الرومانيّة وسقوطها The History of the Decline and Fall of the Roman Empire» الذي أفرد فيه القسم الخمسين من المجلد التاسع في طبعة عام 1789م للحديث عن تاريخ الجزيرة العربيّة وعن سيرة الرّسول صلىاللهعليهوآله، إذ استهل هذا القسم بعبارته الشهيرة «استطاع محمّد باستخدام السيف في يد والقرآن باليد الأخرى أن يُقيم عرشه على أنقاض المسيحيّة وأنقاض روما»، وأشار في موضع آخر إلى: «أنّ عقيدة محمّد خالية من الخرافات والقرآن شهادة مجيدة على وحدانيّة الربّ»، كما ذهب إلى: «أنّ محمّدًا تفادى أن يقع فريسة لطموحه حتّى بلوغه سن الأربعين، وأنّ طموحه
السياسي جرفه لتبنّي منهج مغاير في المدينة؛ خلافًا لما كان عليه في مكّة. وسرعان ما ذهبت عنه ملامح شخصيّته المكيّة المتسامحة بفعل هذا الطموح».
ويمكن أن نحكم على مبلغ التناقض والحيرة التي بلغها كتّاب هذا العصر من خلال النصّ الآتي: «إنّ الخلاصة من حياة محمّد توجب أن نقيم توازنًا بين فضائله وأخطائه وأن نُقرّر عنوانًا لهذا الرجل الاستثنائي هل كان متحمّسًا أم منتحلًا؟ كيف يمكن لرجل حكيم أن يخدع نفسه، وهل يمكن لرجل صالح أن يخدع الآخرين؟ هل يهجع الضمير في خليط مضطرب من خداع الذات والاحتيال الاختياري؟ هذا الرجل يشهد له صهره علي: بأنّه جمع كل المزايا فهو الشاعر والمحارب والقديس، الذي لا زالت حكمته تَشْهقُ الأقوال الأخلاقيّة والدينيّة، الذي وقف بفصاحته وشجاعته بمنازلات السيف واللسان منذ أن صدح بدعوته حتّى آخر طقس في جنازته الذي لم يُخذَل من صاحبه الكريم وأخيه ونائبه الذي أخلص له وكان له بمنزلة هارون من موسى».
ولعلّ الإشارة إلى شخصيّة الإمام علي في هذه المرحلة يدلّ بنحو لا يرقى إليه الشكّ على تطوّر جديد في قراءة سيرة الرّسول صلىاللهعليهوآله ليشمل آفاقًا أوسع تستوعب شهادة الأعلام المقرّبين من الرّسول صلىاللهعليهوآله. هذا التطوّر يبدو أنّه أضفى حالة من التوازن النسبي على الصورة الكلاسيكيّة المشوّهة بفعل تجلّيات النزعة العقليّة التي برزت في هذه المرحلة، زد على ذلك أنّ اختيار جيبون لشهادة الإمام علي تحديدًا في صياغة خلاصته عن حياة محمّد صلىاللهعليهوآله يقطع بأنّ الكتّاب البريطانيّين كانت لهم أحكام وتصوّرات عن علاقات النبي صلىاللهعليهوآله بأصحابه، وهذا يدلّ على ظهور النزعة التحليليّة ذات الطابع الشّمولي في قراءة تفصيلات السّيرة في هذه المرحلة النقديّة المبكرة.
لقد شهد القرن (12ه/ 18م) ولادة مفكّرين نظروا في سيرة الرّسول صلىاللهعليهوآله من زاوية مغايرة للموروث السّائد؛ وهذا ما نلمسه لدى الشاعر والفيلسوف الإنكليزي
تايلور كولوردج (Taylor Coleridge) (1722-1834م) مؤسّس الحركة الرومانسيّة الإنكليزيّة الذي نظّم عام (1799م) قصيدته الموسومة «محمد Mahomet» وهي من الأعمال الأدبيّة المنسيّة، ولعلّها تعدّ أروع ما كُتب عن الرّسول صلىاللهعليهوآله في الأدب الإنكليزي، وتقع في أربعة عشر بيتًا، دافع فيها عن الرّسول صلىاللهعليهوآله؛ واصفًا إيّاه بأنّه النبي الواعظ والثائر البروتستانتي والمحارب المتحمّس الذي سحق طقوس الكفر عند وثنيي مكّة، وعند وثنيي المسيحيّة، ناشرًا تعاليم الإنجيل الحقيقيّة للمسيح.
وفي أواخر القرن (12ه/ 18م) تحوّلت الكتابة في بريطانيا إلى ما يعرف بالتاريخ الاستعماريّ عقب تزايد نفوذ بريطانيا في مناطق الشرق الذي أدّى إلى تزايد في الدراسات الاستشراقيّة، بعد أن فرضت شركة الهند الشرقية هيمنتها على الهند واستحوذت على السّلطة من الحكّام المسلمين، صَاحَب التوسّع الاستعماري البريطاني تبدّلًا في المواقف حيال الشرق وفي هذه المرحلة، ظهرت طائفة من رجالات الشركة المنبهرين بالثقافة المحلّيّة في الهند والمنجز الحضاري للشرق، هؤلاء كان لهم أثر بالغ في تغيّر نبرة الخطاب عن الشرق فباتت أقل حدّة وتهدِيدًا من السّابق، بيد أنّ السّمة البارزة على كتابات هذه المرحلة كانت تعزيز السيادة البريطانيّة وتسويغ الحكم الاستعماري.
وعلى الرغم من ذلك فثمّة من يرى أنّ الاستشراق البريطاني في ميدان السيرة ليس أصيلًا كونه يحمل تبعيّة لمدارس أوروبيّة أخرى؛ ففي عصر النهضة كان متأثّرًا بنماذج الأدب الإيطالي، وفي عصر التجديد تأثّر من خلال الاتّصال بالأدب الفرنسي ثم أسّس على الفكر الألماني، وإنّه لم ينفك أن يتّبع المنهج النفعي في صيرورة خطابه نحو الإسلام.
إنّ التصوّرات الغربيّة المـعاصرة عن المسلمين لم تكن لترتسم في صفحة بيضاء خالية، بل انعكست في مرآة قديمة مشوّهة لأنّ سكّان أوروبا ورثوا عن أسلافهم مجموعة عريضة وراسخة من الأفكار عن الإسلام كانت تتغيّر مظاهرها الخارجيّة تدريجيًّا؛ تبعًا لتغيّر الظروف في أوروبا ذاتها، وتبعًا لطبيعة علاقاتها ومواقفها المـستجّدة نسبيًّا مع البلدان الإسلاميّة وثقافاتها الحديثة.
وصفوة القول، فقد تكوّنت في وعي البريطانيّين في القرون الوسطى ملامح مشوّهة عن الإسلام؛ حيث يرونه: عقيدة ابتدعها محمّد صلىاللهعليهوآله تتّسم بالتّزييف والتّشويه، ودين يقوم عل العنف والقسوة والقسريّة والتساهل مع المـلذّات والشهوات الحسّيّة، أمّا الصورة الناصعة لرسول الله صلىاللهعليهوآله فلم تجد طريقها إلى المخيّلة البريطانيّة بفعل تشويه الكنيسة حتّى عُدّ الإسلام عقابًا بدلًا عن كونه تحديثًا قيميًّا قائمًا على الوحدانيّة، من ثمّ أمست هذه الصورة موروثًا شعبيًّا متداولًا، أسهمت في بلورته وتعميقه حالة الخلاف المفاهيمي بين الشرق والغرب، ولعلّ سياسة الحكّام المسلمين تركت أثرًا في تفاقم حجم الخلاف، حينما شرعوا بنشر الإسلام بدقّ طبول الحرب، ولعلّ أرض العرب التي آمنت بدعوة الرّسول صلىاللهعليهوآله لم تكن أَسْوَأَ حالًا من أوروبا عشية القرون الوسطى وما تلاها، لكنّ وجه النبوّة المشرق لم يجد من يمثّله تمثيلًا حقيقيًّا للغرب المستلب في غمرة صراع المصالح، بين الحكّام المسلمين وآباء الكنيسة، الذي نجم عنه تمازج بين القيم الروحيّة النبيلة مع الطموحات الدنيويّة الزّائلة. إنّ ما يلفت الانتباه في هذه القضيّة ليس طبيعة الخطاب ولهجته المتباينة بين الحدّة والاعتدال، بل عناصره المتمثّلة بالتأليف واقتناء المخطوطات والترجمة والقصيدة والمسرح والأدب وكل ملمح من ملامح الفنّ والرقيّ الإنساني، سُخِّرت بنحو أيديولوجي لبناء هذه السّدود الفكريّة العالية التي تجعل من الإسلام عدوًّا مخيفًا لبريطانيا.
(63)
يرجع اهتمام وليم ميور بسيرة الرّسول صلىاللهعليهوآله وتاريخ الإسلام إلى جملة من العوامل؛ منها: ما هو موضوعي يتعلّق بالمتغيّرات السياسيّة والفكريّة التي شهدها عصره، ومنها: ما هو ذاتي يتعلّق بموروثه الأسري أو تأسيسه المعرفي أو بمناصبه التي تبوّأها طوال حياته، ويمكن أن نجمل هذه العوامل في المحاور الآتيّة:
تمثّل الهند الأرض التي قضى فيها وليم ميور قرابة أربعين عامًا من حياته، ومنها ظهرت أبرز مؤلّفاته، وبغية التّركيز سينأى البحث عن ذكر المتغيّرات العامّة التي شهدها القرن 13ه /19م وسيُقصر الحديث على الهند؛ لأنّ مناخها السياسي والفكري كان له أثر مباشر في توجيه اهتمام ميور نحو تاريخ الإسلام؛ وفق الآتي:
وفقًا لأقدم الأساطير المسيحيّة؛ فإنّ المسيحيّة بلغت الهند على يد القديس توما (SaintThomas) أحد الحواريّين الاثني عشر للسيّد المسيح، وبرز اهتمام الأوروبيّين بالهند منذ وصول البرتغاليّين إليها نهاية القرن (10ه/16م) خلال العهد المغولي في الهند (1526-1857م)، حينما حصلت الكنيسة الكاثوليكيّة على الإجازة بالعمل التبشيري في الهند، وكان من العسير إدراك التأثيرات التي جلبتها المسيحيّة على الهند إبّان القرن (11ه/17م) حتّى ظهرت الإرساليّات التبشيريّة البروتستانتيّة بحدود عام 1607م؛ لمّا وصل البريطانيّون إلى الهند وكان بصحبتهم قس مسيحي، لكنّ أغلب المسيحيّين الذين وطئوا أرض الهند يومها ولم يؤثّروا بمسيحيّتهم في السكّان المحلّيين.
بدأ النشاط التبشيري رسميًّا في الهند ببعثة وليام كايري William Careyعام 1793م الذي تمكّن من تأسيس جمعيّة التبشير المعمدانيّة، فكانت الإرساليّات الأولى تشتمل على عدد قليل من المبشّرين، وقد واجهت بعثتهم صعوبات بسبب الحظر الذي فرضته شركة الهند الشرقيّة على أنشطة المبشّرين، ونهجت الشركة يومها منهجًا محايدًا في تعاملها مع مسألة الأديان في الهند، وأدّى الحظر إلى اندلاع جدل حادّ انتقل إلى بريطانيا، وسرعان ما حصل المبشّرون على مبتغاهم لاحقًا بقرار برلماني يقضي برفع الحظر عن أنشطتهم في الهند في عام 1813م، ومنذ عام 1835م اتّبعت شركة الهند الشرقيّة سياسة التنصير القسري في الهند، فأقام المبشّرون المدارس والمطابع وشرعوا بترجمة الكتاب المقدّس باللغات المحليّة وشرعوا بنشره في الصحف المحليّة؛ كصحيفة البنغال، فضلًا عن تنفيذ العديد من المشاريع لتغطية أنشطتهم التبشيريّة، فبلغ عدد المطبوعات في مدن كلكتا وسيرامبور مائة ألف كرّاس وواحد وسبعين ألف كتاب منهجي عام 1828م، وقد جهد المبشّرون في إشاعة ثقافة القراءة، لكنّهم عمدوا إلى مناهضة معتقدات السكان في الأروقة العامّة، ويرجع سبب توجّه الحكومة البريطانيّة نحو سياسة التنصير القسري إلى أن الهند بعد أن صار لها حاكم واحد وتربط أقاليمها شبكة موحّدة لخطوط
سكك الحديد وخطوط التلغراف، فالأجدر أن تكون موحّدة تحت ديانة واحدة هي المسيحيّة.
إلى ذلك يشير وليم ميور قائلًا: «إنّ القرن التاسع عشر بزغ بفجر مشرق من الإمكانيّات والفرص بعد أن أمست كوابيس الظلمة والوثنيّة والخرافة والتعصّب في مواجهة تدريجية مع ضياء الإنجيل. إن إنكلترا تنفق ما بحوزتها من الذهب لجلب الرحمة وهداية الشعوب بسواعد أبنائها الموجودين على أرض الهند الذين جعلوا من التنوير ونقل المعارف إلى هناك غايتهم الجوهريّة».
لقد عدّ المبشّرون أنفسهم أدوات بيد الربّ لإشاعة الفضيلة بين أوساط الشعوب المتخلّفة، في المقابل نظر الهندوس والمسلمون إليهم، على أنّهم امتداد للحروب الصليبيّة التي اندلعت في العصور الوسطى.
لقد تعاطف الجيل الأوّل من المبشّرين مع الديانات المحليّة في الهند، لكن سرعان ما نظر البريطانيّون إلى مسلمي الهند على أنّهم العدوّ الأوّل والوحيد، وأخذوا يتقرّبون إلى الهندوس على حساب المسلمين، ولا سيّما وأن استجابتهم للمسيحيّة كانت أكثر من استجابة المسلمين، وكان أغلب المتنصّرين من الطبقات الاجتماعية الفقيرة من الهندوس، وقد عبّر وليم ميور عن ذلك قائلًا: «لعلّ المحمديّة الخصم الهائل الوحيد والمكشوف للمسيحيّة، وليس لدى المسيحيّة ما تخشاه حيال الأديان الوثنيّة المتنوعة، بواجهتها السلبيّة الحالكة والظلمة التي ستنجلي أمام ضياء الإنجيل، لكن الإسلام عدوّ عتيد ومؤثّر، فالمحمديّة خصم خطير لأنّها تعترف بالأصل الإلهي زيادة على استعارتها عددًا من أسلحة المسيحية»، ويرى أيضًا أنّه قد: «أظهرت المسيحيّة إصرارًا
ومثابرة رائعة بتماسكها وبسعيها لتعزيز مبادئها ومرتكزاتها طوال اثنتي عشرة قرنًا من الاحتكاك مع غريمها المهلك (الإسلام)».
ومنذ مطلع القرن (13ه/ 19م) شهدت بريطانيا تحوّلًا نحو الإسلام أدّى إلى تجديد فكرة التعارض بين المسيحيّة والإسلام بفعل روح التبشير الجديدة، التي ترى بأنّ الشخص الذي يدرك أنّه سينال الخلاص تقع على عاتقه مسؤولية مكاشفة الآخرين بهذه الحقيقة؛ هذه المجابهة باتت الآن ممكنة من ذي قبل بفعل تزايد الأنشطة التبشيريّة التي حملت موقفًا سلبيًّا وعدائيًّا من الإسلام، ولا سيّما مع حدوث مزامنة بين الدين والسياسة بين الرغبة في تنصير الهند، وبين توسيع الإمبراطوريّة الاستعماريّة، لذلك تمتّع المبشّرون برعاية أعضاء الحكومة البريطانيّة في الهند؛ ومنهم: جيمس تومسون (James Thomson) (1804-1853م) نائب الحكومة البريطانيّة الذي عمل ميور تحت أُمرته، والذي يرى فيه أنّه: «جلب نور الإنجيل إلى الأرض التي تعجّ بالوثنيّة والجهل والخرافات».
لقد أضحت الهند مناخًا خصبًا للمبشّرين والباحثين في الإسلاميّات، على شاكلة هنري مارتن (Henry Marten) الباحث من جامعة كامبردج، الذي قَدِم إلى الهند عام 1806م بصفته راهبًا، وشرع بترجمة الإنجيل إلى لغة الأردو، كما صنّف بعض الشروحات للكتاب المقدّس والمجادلات اللاهوتيّة مع العلماء المسلمين باللغة الفارسيّة، وكان مارتن من المبشّرين الذين عدّوا الإسلام ألد أعداء المسيحيّة، لافتًا إلى ذلك في رسالة بعثها إلى إنكلترا يقول فيها: «لقد طالعت القرآن مرّتين وبات علينا أن نشن حربًا على علماء الإسلام».
ولم يتورّع كايري ومارتن وسواهما من المبشّرين ممّن اضطلعوا بمهمّة الكتابة عن سيرة الرّسول صلىاللهعليهوآله عن التقوّلات عن الإسلام التي سببت هيجانًا بين صفوف المسلمين، ولا سيّما بعد أن أخذوا يجهرون بأنّ الإسلام ونبيّه مزيّفان، وعدّ المسلمين جهلة يمنعهم تعصّبهم من إبصار ضياء المسيحيّة، هذه الوسيلة كانت غير مجدية وغير حكيمة، وبحلول عام 1838م بلغ عدد المتنصّرين قرابة 2500 إلى 3000، هذا الرقم يعدّ مؤشرًا على فشل المبشّرين في مسعاهم اذا أخذنا بالحسبان الإمكانيّات المسخّرة لهذه القضيّة.
لقد أجّجت حالة الرفض الشعبيّ مشاعر المرارة والتّعصب تجاه الإسلام؛ ما أدّى إلى قصور في إيجاد سبيل للتعايش مع المسلمين، زد على ذلك فإنّ الشعور بالتفوّق وإحساس المبشّرين بأنّ الهند سترضخ لاحقًا للمسيحيّة كان أحد فواعل التعصّب حيال قضايا الإسلام، ولعلّ أنشطة المبشّرين كانت فاعلًا مباشرًا في اندلاع الثورة الكبرى في الهند عام 1857م، وإلى ذلك يشير بيرسون (Pearson) بقوله: «إنّ التبشير المسيحي لم يلقَ قبولًا بين أوساط المسلمين في الهند. إنّ آرائهم لم تخلّف سوى تعميق حالة الكره والمواجهة؛ الأمر الذي حملهم على اتّباع استراتيجية أقلّ حدة وأكثر اعتدالًا عند تعرّضهم لقضايا النبوّة لتفادي المواجهة، والسعي لتقصّي المعلومات الدقيقة الموثوقة عن النبي وتوظيفها؛ لمناظرة المسلمين وكشف حقيقة هذا الدين لهؤلاء الجهال». وعند هذه النقطة سيظهر دور وليم ميور الذي سيشار إليه لاحقًا في موضوع «مكانته من الكنيسة وأنشطتها التبشيريّة».
شهدت الهند إبّان القرن (13ه/ 19م) ظهور العديد من الحركات الإسلاميّة؛ ومن بينها الحركة الوهّابيّة الهنديّة أو جماعة أهل الحديث التي شكّلت تهديدًا لبريطانيا، وقد تبنّت هذه الحركة الرفض لمبدأ الإجماع والقياس عند أهل السنّة وصبّوا اهتمامهم على دراسة الحديث النبويّ، فأسهموا في طباعة العديد من المنشورات في مدن بومباي ودلهي، وقد أظهر ميور ميلًا لآراء هذه الجماعة عندما كان يزاول مهامه السياسيّة، وفي الوقت الذي كانت فيه الخلافات الأيديولوجيّة قائمة ظهرت في الهند حركة إصلاحيّة في عام 1870م تعدّ امتدادًا لسياسة الإصلاحات التي تبنّتها الدولة العثمانيّة في الأقاليم التابعة لها لمواكبة التحرّر الغربي وحقوق الإنسان، ومن سمات هذه المدّة ظهور حركة لبعض المجدّدين المسلمين؛ أمثال السيد أحمد خان، الذي تمكّن في عام 1887م من تصنيف كتابه «الخطابات الأحمديّة» بلغة الأردو، وقد اشتمل على ردود على كتاب حياة محمّد لـ «وليم ميور»، وكان خان قد صنّف كتابًا تعرّض فيه إلى الخلل في الترتيب الزماني للكتاب المقدّس.
شهد القرن (13هـ/19م) انعطافة تاريخيّة في ميدان الكتابة في سيرة الرّسول صلىاللهعليهوآله؛ وذلك باكتشاف أقدم مدوّنات تاريخيّة عن سيرة الرّسول صلىاللهعليهوآله صنّفها الإخباريّون المسلمون إبّان القرون (2-4ه/ 8-10م)، هذه المصنّفات كان لها جلّ الأثر في صيرورة تصوّرات وليم ميور عن قضيّة الوحي والنبوّة والقرآن، فقد أثمرت الدراسات التي قام بها المستشرقون الألمان في نهاية النّصف الأوّل من القرن 19 عن اكتشاف هذه المدوّنات، إذ يشير المستشرق الفرد فون كريمر (Alfred von Kremer)، الذي تمكّن في عام 1851م من العثور على مخطوط كتاب المغازي للواقدي في مدينة دمشق، وطُبِعَ لاحقًا في كلكتا في عام 1856م؛ إلى أهميّة هذه المكتشفات، قائلًا: «لا توجد سوى ثلاثة مصنّفات في سيرة محمّد تمثّل منهلًا لجميع التطوّرات التي حدثت في تاريخ الإسلام هذه المصادر باتت الآن في متناول أيدينا، وهي: كتاب السيرة لابن هشام وكتاب الطبقات لابن سعد وتاريخ الطبري، أمّا بالنسبة إلى نسخة سيرة ابن هشام التي بين أيدينا فهي اختصار وتهذيب لسيرة ابن إسحاق التي دوّنها في دمشق أحمد بن إبراهيم الواسطي عام (707ه/ 1307م)، هذه النسخة محفوظة في المكتبة الإمبرياليّة في باريس، كما توجد نسخة منها في مكتبة الجمعيّة الآسيويّة في كلكتا».
وقد نشر المستشرق الألماني فوسفيلد Wüstenfeld سيرة ابن هشام
بعنوان «حياة محمّد برواية ابن اسحاق Das Leben Muhammed’s nach Muhammed Ibn Ishâk» الذي يقع في ثلاثة مجلدات، طبعة غوتينغِن للأعوام (1857-1859م).
ويضيف كريمر قائلًا: «أمّا العمل الثاني: كتاب الطبقات الكبرى لابن سعد الذي يوجد قسم منه الآن في المكتبة الدوقية في مدينة جوتا الألمانية، وقد نشر فوسفيلد تفصيلات عن محتويات هذا القسم من طبقات ابن سعد في المجلد الرابع والمجلد السابع من جريدة الجمعية الآسيوية الألمانية، أمّا المجلد الثاني من كتاب الطبقات الذي يشتمل على سيرة محمّد فهو الآن في حيازة السيد شبرنجر».
وقد أعرب وليم ميور عن امتنانه العميق لأبحاث شبرنجر الذي كان له الفضل في العثور على الجزء المتعلّق بالسيرة من مخطوط الطبقات الكبرى لابن سعد في مكتبة المظفّر حسين خان في كونابور (Cawnpore)، التي حُرّرت في دمشق في عام (718هـ/ 1318م)، كما أثمرت جهود شبرنجر أيضًا عن تعقّب واكتشاف القسم الرابع المطوّل والمفقود من تاريخ الطبري المتعلّق بحياة الرّسول صلىاللهعليهوآله في المدينة.
من أهمّ ملامح القرن (13هـ/ 19م) ظهور تحوّل استثنائي في نبرة الخطاب البريطاني تجاه السيرة النبويّة بظهور عدد من المصنّفات والمقالات ذات الصبغة الموضوعيّة التي نُظّمت من قبل رهط من المؤلفين البريطانيين الذين تبنّوا منهجًا
يناهض موروثهم المفاهيمي السلبيّ عن سيرة رسول الله صلىاللهعليهوآله وإقرارهم بنبوّته ورسالته السماويّة والإشادة بمنزلته العظيمة ودوره التاريخي؛ بصفته أحد أعظم رجال التاريخ، والاعتراف بصدق القرآن والوقوف على ما اشتمل عليه من الشمائل السَنِيّة والقيم الأخلاقيّة، فضلًا عن سعيهم لإشاعة ثقافة التسامح بين الأديان؛ جاء ذلك بمنهج تحفّه عبارات الاعتذار، ومن بين هؤلاء الكُتاب يَرِد اسم عالم الآثار والكاتب البريطاني گودفراي هگنز (Godfrey Higgins) (1772-1833م) الذي صدر له في لندن كتاب بعنوان «الاعتذار من حياة ومزايا نبي العربيّة المحتفى به محمد An apology for the life and character of the celebrated prophet of Arabia, called Mohamed» في عام 1829م، وقد أشار في صدر كتابه إلى: «أنّ الغاية من هذا الكتاب إشاعة روح التسامح بين أتباع المسيح وأتباع محمّد، من خلال بيان الجذور المشتركة لكلا الديانتين من القيم والمبادئ، ونحن نسعى من وراء ذلك إلى تعميق الروابط الأخويّة تجاه العلماء المسلمين».
كما صنّف الكاتب البريطاني جون ديفن بورت (John Daven Port) (1789-1877م) كتابه الموسوم بـ «الاعتذار لمحمّد والقرآن An Apology For Mohammed And The Koran» الذي صدر في لندن عام 1869م، ويعدّ من بين أبرز الدراسات المنصفة للسيرة النبويّة في هذه المرحلة، وجاء في مقدّمته: «إنّ الغاية من عملنا الحالي، أن نسعى بكل تواضع لأن نحرّر تاريخ محمّد من الاتّهامات الزائفة والافتراضات ضيّقة الأفق وتَبْرِئة ساحته مما نسب إليه لكونه أحد أعظم المحسنين إلى البشريّة».
ولا تفوت الإشارة إلى مجهودات الفيلسوف الأسكتلندي توماس كارليل (Thomas Carlyle) (1795-1881م) صاحب المقالات الشهيرة الموسومة بـ «الأبطال وعبادة البطل والبطوليّة في التاريخ On Heroes and Hero Worship
and the Heroic in History» وأصلها ستّ مقالات ألقاها في لندن عام 1840م، وأفرد المقالة الثانية منها للحديث عن الرّسول صلىاللهعليهوآله بعنوان «النبيّ البطل مثل محمد-الإسلام» The Hero as Prophet Muhammad: Islam للدّفاع عن سيرة الرّسول صلىاللهعليهوآله بأسلوب موضوعي رفيع يعدّ من أروع ما كتب عن الرّسول صلىاللهعليهوآله في الأدب البريطاني والعالمي، وفي ذلك نورد قبسًا من إحدى مقولاته الشهيرة:
«جاء اختيارنا لمحمّد ليس فقط لأنّه النبي الأسمى والأصدق من بين الأنبياء؛ لقد جاء الوقت الذي ننفض فيه عن تاريخ محمّد هذا الموروث البالي، إنّ الجزء الأعظم من خلق الله يؤمن بكلمة محمّد طوال اثني عشر قرنًا، فهل يعقل أن تكون هذه الرسالة التي عاشت وماتت عليها هذه الملايين من البشر أكذوبة؟ إنّ هذه النظريّات لمدعاة للأسف لذلك فلنسع إلى محوها كلّها، إن الرجل الكاذب لا يستطيع أن يقيم بيتًا من الآجر لجهله بخصائص البناء، وإذا بناه فما ذلك الذي يبنيه سوى كومة من الأخلاط، فما بالك بالذي بني بيتًا تقوم دعائمه على اثني عشر قرنًا ويؤوي هذه الملايين من البشر».
لقد تزامن ظهور هذا النوع من المصنّفات مع انتشار حركة الترجمة على نطاق واسع، إذ اهتمّ علماء اللغة الأرديّة بترجمة معظم مؤلّفات الغرب الإنجليزية في القرن (13هـ/ 19م) عن السيرة النبويّة إلى اللغة الأرديّة والغاية من هذه الترجمات إخبار رجال الدين المسيحيّين والمستشرقين في الهند وغيرهم أنّ هناك بعضًا من أهل دينهم وجلدتهم من يُقرّ بأنّ الإسلام دين سماوي ونبيّه صلىاللهعليهوآله رسول الله، كما ترمي هذه الكتابات أيضًا إلى اطّلاع المسلمين على أن ليس جميع المسيحيّين على درجة من التعصّب وإنّ منهم العادل والمنصف، على سبيل المثال شرع عبد العزيز خان بترجمة المحاضرة الثانية من كتاب المستشرق توماس كارلايل؛ بعنوان (اسلام اور اس كا بانى) (الإسلام ونبيّه) ونشرها مع تعليقاتها.
ويبدو أنّ وليم ميور قد شخّص حالة التزاحم في الدراسات الغربيّة في ميدان الإسلام والسيرة النبويّة إبّان عصره؛ حيث رأى قصورها ونقصها، ويظهر ذلك في قوله: «لا توجد أطروحة أو مدوّنة في ميدان السيرة باللغة الإنكليزية أو في لغات أوروبا الأخرى تماثل من حيث القيمة والكمال والوثاقة مقارنة بالمخطوطات التي تمكّنت من الولوج إليها». يبدو أنّ هذا الصنف من الكتابات الموضوعيّة قد ألقى بضلاله على نبرة الخطاب البريطاني الموجّه عن الإسلام بفعل التطوّر المنهجي والخروج من أغلال الموروث الكلاسيكي للكنيسة، وهذا ما نلمسه في نبرة ميور الخطابيّة التي ذهب فيها أحيانًا إلى إظهار إعجابه بشخصية الرّسول صلىاللهعليهوآله في مواضع عديدة، لكن من دون الخروج عن موروثه القروسطي المتحامل.
بزغ الاهتمام بالدِّراسات الشرقيّة منذ مَطْلع القرن (13ه/ 19م) الذي انبلج مع ظهور جهود الاستشراق الألماني في ميدان السيرة النبويّة، ولعلّ عمل المستشرق فايل الموسوم «محمّد النبي وحياته وتعاليمه Muhammad der Prophet, sein Leben und seine Lehre» الذي طبع في شتوتغارت الألمانيّة عام 1843م يمثّل أوّل أنموذج تطبيقي لمنهج تاريخيّ في معالجة السيرة النبويّة، ويعدّ فجرًا لعصر نقدي جديد في هذا الميدان، ولعلّ فايل لم يذهب بعيدًا في تقصّيه لتفصيلات حياة الرّسول صلىاللهعليهوآله كون مصادره لم تزل محدودة، لكنّه طبّق منهجًا مغايرًا أحرز من خلاله تقدّمًا في هذا الميدان، ولا سيّما بعد أن فرغ من ترجمته لسيرة ابن هشام Leben Mohammed’s عام 1864م.
أمّا عمل المستشرق الفرنسي غوسّان دي بِيرسفال A.P.Caussin de Perceval الموسوم «مقالات في تاريخ العرب Essai sur l’Histoire des Arabes» الذي
يقع في ثلاثة مجلّدات طبعت في باريس عام 1847م، فقد تابع فيه وصف حياة محمّد صلىاللهعليهوآله وأعماله، لكنّ قيمته الحقيقيّة تتأتّى من المادّة الكبيرة من المصادر العَرَبِيّة التي اشتملت عليها هذه المقالات.
وتبرز أيضًا في هذه الحقبة كتابات نقديّة واضحة السّمات للمستشرق فوستِنفِلد التي أسهمت من خلال طبعاته الممتازة للنصوص العَرَبِيّة المبكرة، في إضاءة التاريخ المبكر لهذه الحقبة، ومن جملة ذلك كتاب «جداول النسب للأسر والقبائل العربيّة «Genealogische tabellen der arabischen stämme und familien» الذي صدر عام 1852م، و«تاريخ المدينة Das Gebiet von Medina» عام 1860م، و«تاريخ مكّة Chroniken der Stadt Mekka» ما بين الأعوام (1857-1861م)، زيادة على ذلك تبرز أعمال المستشرق شبرِنجر (Sprenger) التي تعدّ إضافة مهمّة في ميدان السيرة، ولا سيّما في كتابه «حياة محمّد» عام 1851م.
كما كانت لإسهامات الألماني نِولدِكه في كتابه «تاريخ القرآن Geschichte des Qorans» طبعة غوتينغِن 1860م، دور مؤثّر في ميدان الدراسات النقديّة، بل ولعلّها تمثّل المحاولة الأولى لتقييم المصادر الأكثر أهميّة؛ بغية إعادة كتابة سيرة لحياة محمّد صلىاللهعليهوآله، لأنّه الأحرص في أحكامه التَّاريِخيّة في هذه المرحلة المبكرة، أمّا كتابه حياة محمّد «Das Leben Mummads» طبعة هانوفر 1863م، فيعدّ العمل الأكثر شعبيّة، الّذي بات الآن شبه منسيٍ، أمّا العمل التتويجي لهذا العصر يتمثّل في كتاب حياةُ محمّد life of Mahomet لـ «وليم ميور» الّذي ظهر في لندن بأربعة مجلدات، بين سنوات 1856- 1861م.
ينحدر وليم ميور من أسرة اسكتلندية كانت تقطن في مدينة كليرمونت على مسافة ميلين من مدينة كلاسكو الإسكتلندية، وهي من الأُسر العريقة في إسكتلندا، كان جدّه جون ميور (John Muir) أحد أبرز الشخصيّات في عصره؛ فهو رجل سياسة واقتصاد شغل بين الأعوام (1786-1806م) منصب عضوية المجلس المحلّي في مدينة كلاسكو؛ فضلًا عن عضويّته في مجلس التعليم، وعضويّة مجلس السابات Sabbath الذي كان يُعنى بتوفير الأجواء التعليميّة لأبناء الطبقة العاملة من كلا الجنسين.
كان لجون ولد وحيد هو وليم الأكبر الذي ولد في عام 1783م، من زوجته الثانية جين فيرلي (Jean Fairlie) التي تنحدر من أسرة ذات نفوذ تجاري في ما وراء البحار، ولا سيّما في الهند وأمريكا الشماليّة وكانت لهذه الأسرة علاقة وطيدة بشركة الهند الشرقيّة، فكان لهذا الزواج أثر في اقتران عائلة ميور بشركة الهند الشرقيّة.
تزوّج وليم الأكبر من السيّدة هيلين مكافي (Helen Macfie) التي كانت عائلتها من العوائل التجاريّة الشهيرة في كلاسكو، وعمل في مجال التجارة وكان من بين التجّار البارزين في إسكتلندا وقد تكلّلت جهوده بالنجاح عندما تمّ اختياره لعضويّة المجلس التجاري في كلاسكو في عام 1808م، فسعى إلى إقامة صلات عمل تجاريّة مع الهند عن طريق خاله جيمس فيرلي (James Fairlie).
ورث وليم الأكبر عن أجداده ميولًا قويّة نحو التبشير بالمسيحيّة، فقد اضطلعت أسرة والده ميور (Muir)، وأسرة والدته فيرلي (Fairlie) بمهام تبشيريّة تنوّعت
بين تأسيس الكنائس والأبرشيات المسيحيّة، كما اضطلع أخواله جون ووليم فيرلي (Fairly William and John) بدور بارز في تشجيع الأنشطة التبشيريّة في مدينة كلكتا الهنديّة.
وكان لآبائه دور بارز أيضًا في نشر التعاليم المسيحيّة في المناطق الجنوبيّة من إسكتلندا وبقية أجزاء بريطانيا، فكانت لوليم الأكبر مشاركة بارزة في العمل التبشيري عندما كان عضوًّا في الجمعيّة المساندة للكتاب المقدّس في كلاسكو بين (1812-1819م)، وقد ترأّس جمعيّة كوربال Gorbal للكتاب المقدّس، وتوجّهت أنظاره صوب الهند عادًا مسألة مزاولة العمل التبشيري في الهند أكثر واقعيّة من أي مكان آخر.
أسهم وليام الأكبر في دعم المبشّرين الإسكتلنديّين المتوجّهين نحو الهند، وقد حصد شهرة واسعة في الأروقة التبشيريّة، ولا سيّما من خلال الجمعيّة الإسكتلندية المساندة للكتاب المقدّس التي صدر عنها العديد من الكتيبات التي حملت شعار «تطبيق المسيحيّة على الشؤون التجاريّة والاعتياديّة للحياة»، توفّي وليام الأكبر بنحو مفاجئ في عام 1820م عن ثمانية وثلاثين عامًا، تاركًا أرملة وثمانية أطفال.
ولد المستشرق وليم ميور في مدينة كلاسكو الإسكتلندية في 27 نيسان من عام 1819م، قبل أقل من عام من وفاة والده، وكان أصغر إخوته؛ بعد وفاة والده عادت والدته السيدة مكافي HelenNee Macfie ذات الشخصيّة القويّة إلى مدينة كلمارنوك Kilmarnock بصحبتها أربعة صبيان وأربع فتيات جميعهم تحت سنّ الحادية عشرة وصار إليها أمر كفالتهم وتعليمهم بدعم من عائلتها، وعندما بلغ
ميور سنّ التاسعة التحق بمعهد كلمارنوك Kilmarnock في عام 1828م وتلقّى فيه تعليمه الأولي والثانوي حتّى عام 1833م من ثم انتقل بعدها مع عائلته إلى أدنبره، وهناك التحق بكلية آداب كلاسكوفي جامعة أدنبره عام 1833م، لكنّه ترك الدراسة بعد عامين بسبب الضائقة الماليّة؛ الأمر الذي حمله إلى قبول عرض عم والدته السير جيمس شاو Sir James Shaw عضو البرلمان وعمدة سابق لمدينة لندن، للانخراط في خدمة شركة الهند الشرقية بعد أن قدّم تزكيات لأخوته من قبله.
التحق ميور إثرها بجامعة هايلوبيري Haileybury التي أسّستها شركة الهند الشرقية عام 1804م في لندن لإعداد الضباط والقيادات المناطة بهم رعاية المصالح البريطانيّة الملكيّة في مستعمراتها، لم تكن جامعة هايلوبيري معهدًا ذا طابع كاثوليكي صارم لإعداد المبشّرين، لكنها أدّت دورًا بارزًا لتحقيق الغاية ذاتها. تلقّى ميور في هذه الجامعة محاضرات مكثّفة في اللغات الشرقيّة القديمة واللغة السنسكريتيّة والفارسيّة والعربيّة وأصول الأديان، فضلًا عن مبادئ العمل الإداري والسياسي والعسكري والتبشيري على مدار عامين (1835-1837م) وقد أولى ميور عناية خاصة بدراسة التّاريخ.
وفي جامعة هايلوبيري ذاع اسم وليم ميور من بين الطلبة الأكثر تفوّقًا على مدى تاريخ الجامعة؛ إذ استطاع خلال هاتين السنتين أن يحصد عددًا من الجوائز والميداليّات ولا سيّما في مادة اللغة العربيّة على غرار أخيه جون ميور الذي حظي بالقدر نفسه من التكريم في مادة اللغة السنسكريتيّة.
وفي عام 1837م التحق ميور بكليه فورت وليم Fort William في ولاية كلكتا الهنديّة التي أسّسها «ويسلي» Wellesley أسقف شركة الهند الشرقيّة عام 1800م وكانت يومها مركزًا لدراسة اللغة البنغالية والسنسكريتيّة، ومكث فيها حتّى عام 1838م.
حصل وليم ميور لاحقًا على درجة الدكتوراه الفخريّة في القانون D.C.L من جامعة أكسفورد 1882م، ودرجة الدكتوراه الفخريّة في القانون المدنيL.L.D من جامعة كامبردج، وجامعة كلاسكو وجامعة أدنبره 1885م، وحاز على درجة الدكتوراه Ph.D. في القانون من جامعة بولونيا Bologna الإيطاليّة 1888م.
تزوّج ميور في عام 1840م من إليزابيث هاندلي التي أنجبت له 15 ولدًا كان أكبرهم الكولونيل وليم جيمس William James في سلاح المدفعيّة الملكيّة في إقليم البنغال؛ والذي عمل أيضًا في القسم السياسي في الإقليم عام 1862م. توفّي السِيْر وليم ميور في 11 تموز 1905م عن عمر ناهز السادسة والثمانين ودفن في مقبرة دين Dean cemetery في أدنبره.
وصفوة القول: إنّ اهتمام وليم ميور بالسيرة النبويّة وتاريخ الإسلام يرتدّ في قسم منه إلى فاعل ذاتي يتعلّق بموروثه، ولا سيّما أنّه ينحدر من أسرة لها باع طويل في مجال التبشير المسيحي وخدمة الكنيسة، على الرغم من عدم حيازة الباحث
على أدلّة كافية تربط بين هذا الموروث وبين شغفه بتاريخ الإسلام، لكن ما لا شك فيه أن لهذا الموروث أثر فاعل في صيرورة شخصيّته الاستشراقيّة، ويبدو أنّ شغفه باللغة العربيّة واللغات الشرقيّة قبل أن يضطلع بأيّ مهامّ حكوميّة كان فاعلًا رئيسًا في انتدابه لاحقًا من قبل حكومته للاضطلاع بهذه المهمّة الأيديولوجيّة.
زاول وليم ميور العمل السياسي حال وصوله إلى ميناء بومبي في 16 كانون الأوّل 1837م لينخرط بين صفوف شركة الهند الشرقيّة في حكومة الهند، بعد أن سبقه إخوته الثلاثة، جون John، الذي اشتهر بأبحاثه في ميدان اللغة السنسكريتيّة، وجيمس James، ومونغو Mungo تباعًا، اللذان لقيا حتفيهما بعد مدّة قصيرة من الخدمة في الهند.
أصبح ميور حال وصوله إلى الهند عضوًا متدرّبًا في إدارة حاكم الولايات الشماليّة تحت إشراف السير جيمس طومسون James Thomsonsir (1804-1836م)، الذي عهد إليه بمهمّة العمل عضوًا في مجلس تحصيل ضرائب الأراضي في منطقة الولايات الشمالية الغربيّة، من ثم تولّى منصب مساعد المفوّض العام في مقاطعه الله آباد للمدّة (1839 -1843م) وقد اشتملت مهام عمله فيها على مهنة قاضي تحقيق مشترك في مدينه كانبور؛ فضلًا عن توليه لمنصب منسق لشؤون الاستيطان في مدينة بندلهانك.
تولّى ميور بين (1843-1846م) منصب نائب مستحصل جباية مدينة فيتهابور، ثم شغل منصب السكرتير الأعلى لمجلس الدخل في ولاية اگرا Agra (1847-1852م)، ثم عمل سكرتيرًا لحكومة المقاطعة الشماليّة الغربيّة في مدينة اگرا ومقاطعة الله آباد (1852-1858م).
ترأّس ميور مكتب الاستخبارات البريطانيّة في مدينة اگرا إبّان الثورة الهنديّة الكبرى التي اندلعت في مايس عام 1857م التي سرعان ما انتشرت في مناطق واسعة من الهند، بعد أن حصل على الترشيح لإدارة شؤون الحكومة البريطانيّة في الهند خلال مدّة الثورة، ولم يكن هنالك منصب لإدارة المصالح البريطانيّة خلالها سوى هذا المنصب الذي شغله ميور الذي يعدّ مركزًا خطيرًا يندرج في السلّم الإداري بين صلاحيات نائب الملك وبين صلاحية القائد العام للقوات الملكيّة في عموم الهند.
وفي عام 1859م أصبح ميور عضوًّا للمجلس الأعلى للدخل في ولاية الله آباد، ثم أصبح سكرتيرًا للسياسة الخارجيّة لحكومة الهند في كلكتا في عام 1865.
وفي عام 1867م قُلّد ميور نجمة الهند للفرسان K.C.S.I، ويعدّ أرفع وسام يخلع على فرسان التّاج البريطاني في الهند، وقد أُعلِنَ بمرسوم ملكي من الملكة فيكتوريا عام 1861م عقب أحداث الثورة الهنديّة، وفي عام 1868م أصبح وليم ميور نائب الحكومة للولايات الشماليّة الغربيّة في مدينة الله آباد ومكث في هذا المنصب حتّى عام 1874م، وقد عثر الباحث على وثيقة تعود إلى سجلّات القوّات المسلّحة البريطانيّة في حكومة الهند، يرد فيها اسم وليم ميور بين موظّفي الطبقة الثانية عندما كان نائبًا لحكومة الهند للولايات الشماليّة الغربيّة، واللّافت أنّه كان يتقاضى أجرًا أعلى من أجور موظفي حكومة الهند قاطبة؛ بما فيهم موظفي الدرجة
الأولى أو موظفي المحكمة العليا الذين تزيد خدمتهم على 35 عامًا ولعلّ مبعث ذلك يرتدّ إلى دوره الاستخباري، وفي عام 1875م أصبح ميور عضوًا ماليًّا في مجلس التشريع النيابي الملكيّ في كلكتا، وتولّى بعدها منصب وزير المالية في حكومة البنغال في عام 1876م، ومكث في هذا المنصب لمدّة عامين، بعدها ترك العمل السياسيّ في الهند وقفل راجعًا إلى لندن، وهنالك أُوكل إليه منصب عضويّة مجلس الدولة الهنديّة في لندن الذي مكث فيه حتّى عام 1885م.
تمتّع وليم ميور بشخصيّة مؤثّرة، فكان من طراز القادة الذين لا يتورّعون عن الإفصاح عن رأيهم أو توجيه النقد إلى سياسة بلادهم، واشتهر بفعاليّته في مواجه الأزمات التي كانت تواجه الولايات الشماليّة من خلال سنّ التّشريعات المناسبة واتّخاذ التدابير للحيلولة دون تفشّي المجاعات بين أوساط المزارعين المحليّين. أسهم ميور في تشريع العديد من القوانين في حكومة البنغال، ولا سيّما التي تتعلّق بحيازة الأراضي في الولايات الشماليّة الغربيّة، وطالب بإيقاف احتكار الحكومة البريطانيّة لتجارة الأفيون، ولا سيّما أنّ الهند كانت من أكبر البلدان المنتجة له، وأعطى توجيهاته في عام 1868م في أن تنسحب بريطانيا من هذه التجارة. ودعم وليم ميور سياسة الوقوف على الحياد ووجد من غير الصواب أن تقوم الحكومة البريطانيّة باتّباع أسلوب التمييز والمفاضلة في معاملة الهندوس والمسلمين.
كان ميور إداريًّا من طراز رفيع ورجل اقتصاد، زيادة عن كونه باحثًا يتقن اللغة العربيّة، عاش في ثلاثة عوالم مختلفة، الباحث والموظّف الحكومي والمبشّر، استطاع أن يزاوج بين العمل البحثي والعمل السياسي والإداري.
حصد ميور سمعة عالميّة ليس على صعيد المملكة المتّحدة فحسب، بل في آسيا وأوروبا خلال حياته بصفته باحثًا في تاريخ الإسلام إذ أسهم بنشر خمس عشرة مقالة في مجلة كلكتا أصبحت لاحقًا جزءًا من مؤلّفاته الشهيرة التي أسندها إلى المخطوطات العربيّة وأسهم في تزويد مكتبة الهند الملكيّة ومكتبة جامعة أدنبره بهذه المخطوطات.
إنّ إجادته للغات العربيّة والفارسيّة والأردو مكّنته من الاطّلاع على عدد من المخطوطات الإسلاميّة؛ مثل كتابات: ابن هشام والواقدي وابن سعد والطبري، وخلال مدة رئاسته لجامعة أدنبره (1885- 1903م) تابع دراساته لتاريخ الإسلام، كرّس ميور وقت فراغه طوال خدمته في الهند لدراسة التاريخ الإسلامي، وتصنيف المؤلّفات والكتيبات للقراء المسلمين، كما أظهر اهتمامًا بقضايا المرأة الهنديّة، ولا سيّما في مسألة التعليم التي أولاها عناية بالغة، في الوقت الذي كان فيه التعليم شحيحًا على المرأة في بريطانيا نفسها للنهوض بسياسة بلاده في المستعمرات.
في عام 1868م خصّص وليم ميور جائزة سنويّة للحركات التحرّريّة، إثرها ظهرت العديد من المصنّفات التي تعزّز من مكانة المرأة، وقد جاء في أحد خطاباته قوله: «عندما تحظى نساؤكم بحق التعليم سيصبحن شركاء لحياتكم بنحو يبعث البهجة أسوة بالبلدان المتحضّرة والنتائج ستنتشر كما ينتشر ثلج الهملايا وبذوبانه تسيل جداول تسهم في تكوين حياة جديدة»، كما عمل على إلغاء قانون وأد البنات الهندوسي دون حدوث أزمة سياسية.
كان ميور يحثّ الحكومة البريطانيّة على ضرورة إقامة معاهد ذات مستوى عال للدراسات، فكان شعب الهند يتذكّر اهتمام وليم ميور بكلّ شيء له صلة بالتعليم، كما شرع بإنشاء مدرسة ثانويّة في كانون الثاني 1870م بقيمة 13000 روبية، وكان ميور قد تلقّى دعمًا من الحكومة البريطانيّة بمقدار 2500 روبية لإنشاء الجامعة المركزيّة في الله أباد.
عمل ميور مساعدًا للملكة فكتوريا ملكة بريطانيا في دراساتها عن الهندوسيّة وتحديدًا في بحثها الموسوم «قيصر الهند» في المدّة التي وجهت اهتمامها لبعض المدوّنات المترجمة.
اقترح وليم ميور إبّان توليه لمنصب نائب الحكومة الهندية للولايات الشمالية الغربية تأسيس كلية ميور المركزية (MCC) التي وضع لها حجر الأساس في تموز عام 1872م ثمّ افتُتحت بعد عام؛ أي في 1873م، ويومها أزيل الستار عن تمثال للسير وليم ميور في القاعة الرئيسة.
حدّد وليم ميور مبلغًا قدره 5000 روبية هنديّة جائزةً ماليّةً لتشجيع الكتاب المحلّين في الهند في فترة (1873-1874م) لتأليف أعمال مميّزة، وقد مُنحت هذه الجائزة النقديّة إلى ستة عشر فائزًا صنّفت مؤلّفاتهم باللغة الأردية والهنديّة.
قام ميور بتأسيس كلية الدّراسات المحمديّة الأنكلو-شرقيّة (MAO) في ولاية عليكرة التي ترأسّها السيد أحمد خان بهادور في تشرين الثاني عام 1875م، وباتت هذه الكلية مركزًا للدّراسات الإسلاميّة، إذ خصّص ميور؛ وكان يومها نائب الحاكم الشمالي، عائدات «74 اكرا» من الأراضي الزراعية المحيطة بالكلية لتمويلها، وقد عدّ تأسيس هذين المعهدين اللبنة الأساسيّة التي قامت عليها جامعة الله آباد لاحقًا في 23 أيلول 1887م .
شارك وليم ميور أخاه جون ميور في حصوله على درجة الأستاذيّة في الدّراسات الأدبيّة المقارنة في اللغة السنسكريتيّة من جامعة أدنبره، كما عمل في هايلوبيري Haileybury بصفة مستشار على المرشحين للعمل في المستعمرات البريطانيّة بعد أن قضى 40 عامًا من الخدمة في حكومة الهند.
شغل ميور لسنوات عدّة منصب نائب للجمعيّة الملكيّة الأسيويّة لبريطانيا العظمى وإيرلندا، وقد أسهم بشكل فاعل في إثراء المعرفة عن تاريخ الإسلام بين أوساط الناطقين بالإنكليزيّة وتقديرًا لجهوده عُيّن رئيسًا لهذه الجمعيّة للمدّة (1884-1885م)، وتقديرًا لجهوده في الدّراسات العربيّة والإسلاميّة قامت الجمعيّة الملكيّة الأسيويّة بتقليده الميداليّة الذهبيّة في عام 1903م وعام 1912م.
وفي عام 1885م ترك لندن متوجّهًا إلى إسكتلندا لتسلّم مهام عمله؛ بصفته رئيسًا لجامعة أدنبره ومستشارًا في مجلس الجامعة، بين (1885-1903م) بعدها استقال من رئاسة الجامعة، بعد أن أظهر تعاطفًا ودعمًا لطلبة جامعة أدنبره، ولا سيّما بعد الإصلاحات الدستوريّة التي جرت في عام 1899م؛ واشتملت على تعديلات في النظام الجامعي القديم. وقد رحب ميور بالقانون الجديد الذي يكفل المساواة الاجتماعيّة بين الطلبة.
وفي الاحتفال السنوي الخمسين بعد المائتين وعندما افتتح معهد ميور في جامعة أدنبره في عام 1960م لدراسة اللغات العربيّة والفارسيّة والسنسكريتيّة، صنّف وليم ميور من بين الـ 2000 شخصيّة التي أسهمت في تطوّر جامعة أدنبره عبر تاريخها، وتثمينًا لجهوده أقيم له تمثال في الجامعة.
من خلال دراسة حيثيّات هذه القضيّة يظهر أنّ المستشرق وليم ميور سخّر مسيرة حياته السياسيّة والإداريّة والأكاديميّة لخدمة أهداف الكنيسة ضمن اتّجاهين:
اضطلع وليم ميور بدور فاعل على مدى أربعين عامًا من الخدمة في حكومة الهند لتحقيق الأهداف التبشيريّة للكنسية، من خلال أحداث التّمازج بين منصبه السياسيّ والعسكريّ وبين كونه باحثًا في تاريخ الإسلام، ولقد أعرب وليم ميور عن امتعاضه من سياسة الحياد الدينيّة التي تبنّتها بريطانيا في الهند قبل عام 1813م
وأشار إلى ذلك قائلًا: «أنّه لمدعاة للأسف أن تهمل بريطانيا مسؤوليّتها الروحية تجاه الهند؛ واكتفت بإظهار المسيحيّة في الديار فقط، وأغفلت حالة الظلام الروحي الذي يكتنف الخارج في الوقت الذي تَبَنّى فيه أولادها قضيّة الهند وأصبحت بمثابة وطن لهم، متغافلين عن مشاركة السكّان المحليّين بمزايا إزاحة معتقداتهم القديمة من عقولهم بتصوير لوحة حزينة لهؤلاء الوثنيّين والمحمّديّين عن حالة الإنسان دون إيمان بالمسيحيّة»، وأشار أيضًا: «إنّ التبشير واجب قومي ملقى على كاهل الأمّة البريطانيّة، ولا سيّما بالأنشطة المتعلّقة بجمعيّة الكنيسة التبشيريّة CMS في الهند التي جعلت الغاية من نشر المسيحيّة أسبق من نقل الحضارة».
وحال تولّيه لمنصب نائب الحكومة عن الولايات الشماليّة الغربيّة عقب تمرّد عام 1857م تابع سياسة سلفه جيمس تومسن James Thomson في دعم المبشّرين لتحقيق الغايات السياسيّة، وقد أدّت جمعيّة الكنيسة التبشيريّة دورًا كبيرًا في سياسة التّنصير القسري للهند التي ارتبطت بها أنشطة وليم ميور التبشيريّة، وفي عام 1857م صرّح ميور أنّ سياسة الحكومة ينبغي أن تكون فاعلة في رعاية الأنشطة التبشيريّة في اگرا، وردّد ذلك في الكلمة التي ألقاها بمناسبة افتتاح كلّيّة الدّراسات المحمديّة (الأنجلو-شرقيّة).
وقد عبّر ميور عن روحه التنصيريّة المتشدّدة قائلًا: «لن تتهاون بريطانيا حتّى ترى خضوع الملايين في الشرق وهم يتخلّون عن النبي المزيّف والمعابد الوثنيّة ويؤمنون بنور الحقّ الذي يحمله الإنجيل»، لقد كرّس ميور منصبه الحكومي لتحقيق الأهداف التبشيريّة في الهند، زيادة على ذلك فقد اضطلع بمهمّة تقديم
الدعم للمواطنين الإسكتلنديّين غير المنضوين تحت الكنيسة في إقامة المراسم الدينيّة، مشيرًا إلى أنّ الهند أحوج إلى الوعظ والإرشاد من بقيّة مناطق أوروبا، وأنّ المسافر من هؤلاء عندما يطوي المسافات الواسعة عبر خُطوط السكك الحديديّة عليه أن يبلغ تعاليم الإنجيل، كما أسهم ميور في تمويل افتتاح فرعين جديدين لجمعيّة الكنيسة التبشيريّة في عام 1877م.
كما شرّع ميور بتأسيس مستعمرة خاصّة بالمسيحيّين حملت اسمه «ميور آباد Muirabad» كان يسكنها المسيحيّون والهنود الذين اعتنقوا المسيحيّة، وكذلك المبشّرون وطبقة العمال المسيحيّين. واشتهرت هذه القرية بكنيستها التي تحيط بها حلقة من المنازل، وقد قامت السيّدة ميور بوضع حجر الأساس لهذه المستعمرة في 17 مارس 1872م.
كان المسيحيّون ينظرون إلى قرية ميور آباد على أنّها هبة نبيلة من السيّد وليم ميور، كان ميور بمثابة الأخ للهنود المسيحيّين أكثر من كونه حاكمًا سياسيًّا، وكان رجلًا مسيحيًّا متديّنًا، يشارك بخدمة الكنيسة بنفسه في أمسيات الأربعاء والأحد ويقوم بالوعظ وإعطاء الدروس في كنائس ولاية الله آباد، فضلًا عن ذلك فقد عرف عن زوجته اهتمامها بالمرضى والأطفال المسيحيّين، إذ كانت عادتها أن تزور المستشفى المقام في ميور آباد كل صباح، كما أسهمت السيّدة ميور بالعديد من
الأنشطة التبشيريّة إلى جانب زوجها، فقد شغلت في العام 1895م منصب رئيسة فرع الجمعيّة التبشيريّة الأنغلو-هنديّة في أدنبره في إسكتلندا، كما شغلت منصب نائبة رئيس اتّحاد السيّدات الأنجلو-هندية.
وعندما تأسّست «جمعيّة المسار والكتاب» بتوصية من كارل فاندر Carl Pfander، أوّل المبشّرين الألمان الذين التحقوا بالهند في عام 1838م بتلبيته لدعوى الانخراط في صفوف الجمعيّة الهنديّة التبشيريّة، أصبح وليم ميور رئيسًا لها لتسهم في تسهيل مهمّة المبشّرين في الهند وقد تولّت هذه الجمعيّة طباعة الكتب وإصدار المطبوعات الإنجيليّة باللّغتين العربيّة والهندوسيّة، وتولّى وليم ميور رئاسة الجمعيّة لعشرين عامًا؛ وكان أحد أهم الممولّين لأنشطتها على مدى خمسين عامًا (1848-1898م) إذ تكفّل بكلفة المطبوعات التي كانت تصدر عن هذه الجمعيّة، وكان نظام الجمعيّة يقضي بتجهيز المطبوعات وتوزيعها بين الهندوس والمسلمين والمسيحيّين. ويمكننا أن نخمّن مقدار التأثير الذي تركته هذه الجمعيّة من عدد المنشورات التبشيريّة التي بلغت «908.000» مجلّد حتّى عام 1904م، وكان أغلبها باللّغة الأرديّة والهندوسيّة، وتوزّع في الولايات الشماليّة الغربيّة في إقليم البنجاب.
أصبح ميور عضوًّا في جمعيّة الكتاب والمطبوعات المسيحيّة لشمال الهند NICTBC ، كما خدم بصفته عضوًا في جمعيّة العون المسيحيّة التركيّة، وفي العام 1895م أصبح نائبًا لرئيس الجمعيّة التبشيريّة (الأنغلو- هنديّة)، لكن على الرغم من الدور الحافل الذي اضطلع به ميور في دعم الأنشطة التبشيريّة؛ فإنّ بيرسون Parsons لا يدرج ميور بين قوائم المبشّرين، حيث يقول: «على الرغم من صداقة وليم ميور الحميمة مع المبشّرين ودعمه المالي والسياسي لأنشطتهم لكنّه لم يكن
مبشّرًا فهو باحث استشراقي بعبارة أدقّ»، ولعلّ بيرسون نظر إلى سيرة حياة ميور بعين واحدة متغافلًا عن الخدمات الكبيرة التي قدّمها للكنيسة على الصعيدين الميداني والأكاديمي حتّى بات من المستشارين الذين تستعين بهم الكنيسة الإسكتلنديّة في تحقيق غاياتها، زد على ذلك فإنّ الصبغة التعليميّة والبحث الأكاديمي كانت السمة التي تميّز الكنيسة الإسكتلنديّة، ففي عام 1899م تأسّست الكنيسة الإسكتلنديّة الحرّة في الهند بعد أن كانت مجرّد فكرة عرضها الدكتور نورمان ماكدونالد في تقريره عن زيارته للهند مستعرضًا آراء 84 خبيرًا كان وليم ميور من بينهم، مشيرًا إلى ذلك بقوله: «إنّ الصفة التي تميّز الأمّة الإسكتلنديّة؛ كنيستها التي اعتمدت على مبدأ التعليم في تبليغ تعاليمها المسيحيّة، إنّ المدارس غير الدينيّة والكليّات إذا تركت وحيدة في المحصلة ستنفصل عن السرب وإذا كان التعليم بمعزل عن الإيمان بالرب أو الخشية منه حينها سوف تنزاح باتّجاه العلمانيّة».
وقد أشار ميور إلى هذا الجانب بقوله: «إنّ قيمة الكليّات المسيحيّة، والمدارس الإسكتلنديّة التي كانت الرائدة في استمالة تعاطف الهندوس نحو التعليم واستمالتهم نحو المسيحيّة، ومن واجبنا أن نعمل على الحفاظ عليها».
لقد قضى وليم ميور قرابة نصف قرن من حياته في العمل على تأسيس المدارس التبشيريّة بين الهند وإنكلترا وإسكتلندا ودعمها، فضلًا عن جميع إسهاماته في افتتاح العديد من المدارس والمؤسّسات التعليميّة والجامعات خدمة للأغراض التبشيريّة، كما أسهم في التّبرع من نفقته الخاصّة لبناء هذه المؤسسات، وأسهم هو وأخيه جون ميور خبير اللغة السنسكريتيّة في انتشال الملايين من الهندوس من حالة الأمّيّة
عن طريق فتح المدارس وتطبيق التدابير التعليميّة، من خلال نشر التعليم الابتدائي والجامعي إذ قام بإنشاء جامعة حملت اسمه في منطقة الله آباد تكون ريعها لمصلحة المسيحيّين، ويبدو أنّ السمات البانوراميّة واضحة في شخصيّة ميور، لكنّ هذا التنوّع لا يخفي حقيقة مؤدّاها أنّ الشخصيّة السياسيّة المسخّرة لخدمة الخطاب الاستعماري تمثّل البوتقة التي تنصهر فيها جميع المعايير الأكاديميّة والتنصيريّة والفكريّة.
وبعد استقالته من العمل السياسي في الهند قفل وليم ميور راجعًا إلى إسكتلندا وهناك تابع أبحاثه عن الإسلام ومقارنة الأديان في جامعة أدنبره، ولمّا كان في منصبه رئيسًا لجامعة أدنبره قدّم ميور عددًا من الدّراسات عن العلاقة بين المسيحيّة والإسلام معربًا عن تعاطفه مع طائفة المبشّرين على شاكلة بفاندر وسواه، وكان وليم ميور قد رحّب بتسمية هنري مارتن بطلًا لأنكلترا ومدافعًا عن الحقّ ضدّ الدين المزيّف على الرغم من اعترافه بأنّ مارتن وبفاندر هما ألدّ عدوين للإسلام.
حصد وليم ميور شهرة واسعة لكونه واحدًا من أشهر الباحثين الغربيّين في ميدان السيرة النبويّة وتاريخ الخلافة الإسلاميّة. لقد مثّل ميور النزعة الاستعماريّة التبشيريّة في نظرته إلى الإسلام وعدّه ندًّا عنيفًا لسياسة بلاده؛ فهو يرى: «أنّ الإسلام الخصم العلني الأعظم بالنسبة للمسيحيّة، أمّا بقيّة الديانات الوثنيّة فلا خوف منها، لأنّها مجرّد معروض سلبي من الأفكار المظلمة التي ستتلاشى أمام ضياء الإنجيل، أمّا الإسلام فالأمر مختلف فلدينا عدوّ فاعل وقويّ»، كان الفاعل المباشر الذي حمل ميور لإطلاق العنان لطاقته الفكريّة؛ رغبته في المشاركة في حركة التبشير من
خلال التأليف، فكانت الهند عشيّة وصول وليم ميور ساحة للمجادلات والمناظرات الدينيّة بين المبشّرين وبين رجال الدين المسلمين العلماء، وقد اشتدّ ساعد الكنيسة حينما دخل الساحة مجادلون محنّكون من أمثال بفاندر، الذي كان المحفّز الرئيس الذي استحثّ وليم ميور على الاهتمام بسيرة الرّسول صلىاللهعليهوآله وتاريخ الإسلام، فمنذ عام 1847م، صار ميور على اتّصال مع البعثة التبشيريّة لبفاندر الذي أعطاه فكرة الكتابة عن سيرة الرّسول صلىاللهعليهوآله بالاعتماد على المصادر الإسلاميّة الأصليّة التي باتت متاحة، واعتقد بفاندر أنّ مثل هذه الدراسات عندما تترجم إلى الأرديّة سوف تخدم أهدافه التبشيريّة، وقد دأب وليم ميور على البحث والتأليف في ميدان السيرة ليعين البعثة التبشيريّة على عملها وكانت الحصيلة مجموعة مقالات نشرت في مجلّة كلكتا ظهرت لاحقًا في كتابه «حياة محمد» بين عامي (1858-1861)، هذا الكتاب الذي بات المرجع الرئيس للمعلومات عن الإسلام بالنسبة للمبشّرين والموظفين البريطانيّين الذين يكونون على تماس مباشر مع المسلمين، ولولا دعم بفاندر لكانت مهمّته في الكتابة عن تاريخ الإسلام غير مجدية، كان وليم ميور صديقًا حميمًا لبفاندر، ومن أشدّ المعجبين بمنهجه، وقد شرع بفاندر بمهاجمة الإسلام من خلال مؤلّفاته التي صنّفها باللغة الفارسيّة وأبرزها «كتاب ميزان الحق» الذي هاجم القرآن ومحتوياته زاعمًا أنّ معلوماته مستقاة من كتب العهدين من دون وحي من السماء، كما دافع فيه عن العقائد المسيحيّة وبذل جهودًا مضنية للتقليل من قيمة التشريعات الإسلاميّة الخلقيّة والقول بأنّها تشريعات عاديّة لا
امتياز ولا أصالة فيها، وأنّ النبي صلىاللهعليهوآله أخذها عن يهود المدينة بحكم الجوار، وقد ردّ عليه الشيخ رحمة الله الهندي بكتاب «إظهار الحق».
كان لفاندر مصنَّف آخر عنوانه «طريق الحياة» وأيضًا كتاب «مفاتيح الأسرار»، كما تمكّن من تصنيف كتاب جديد ردًّا على كتاب الاستفسار وسمّاه «حلّ الإشكال» طبعة أكبر أباد عام 1847م.
لاقت كتب بفاندر ردود أفعال مناهضة من المفكّرين المسلمين الذين كتبوا في دحض مزاعمه عن الإسلام العديد من الردود باللغة الأردية كانت بهيئة مقالات أو رسائل أو كتيّبات للمدّة من كانون الثاني ولغاية شهر آب من عام 1845م ظهرت في صحيفة «خير خوا أي هند Khair khwah-i-Hind» وقد أشار وليم ميور إلى هذه المجادلات في مقالة نشرها في مجلة كلكتا في عام 1845، هذه المقالة ومن جنسها ظهرت لاحقًا في كتابه «الجدل المحمّدي» لجذب الدعم الأوسع لنشاط المبشّر الألماني بفاندر.
كان ميور مفعمًا بالروح التبشيريّة الإنجيليّة التي شاعت في القرن التاسع عشر، فثمّة شبه إجماع على أنّه صنّف كتاباته الأخرى المتعلّقة بتاريخ السيرة والإسلام لتقديم يد العون للمبشّرين في مجادلاتهم الروحيّة مع المسلمين، ولعلّه كان أكثر تحسّسًا من بفاندر بالتداعيات السياسيّة الواسعة التي نجمت جرّاء الكتابات المناوئة للمسيحيّة من قبل المفكّرين المسلمين، ولا سيّما «كتاب صولة الزيغم
لمجموعة من العلماء المسلمين»، الذي نشر في عام 1845م ولقي رواجًا كبيرًا، وفي نيسان عام 1854م جرت في مدينة اگرا مناظرة علنيّة بين بفاندر والشيخ رحمت الله وزميله الدكتور محمّد وزير خان استمرت ليومين متتالين، وقد حضرها ميور، وتمحورت حول قضايا الثالوث، وتحريف نصوص الكتاب المقدّس، والقرآن، وغيرها من المسائل العقدية، ويبدو أنّ النّقاش لم يفضِ إلى نتيجة حاسمة لأنّ بفاندر انسحب بعد الجلسة الثانية، عندما أظهر الشيخ رحمة الله تفوّقًا في المناظرة، ومبعث ذلك أنّه اطّلع على بحوث نقديّة حديثة للتوراة ظهرت في ألمانيا بمساعدة زميله الطبيب فكانت الغلبة للهندي وزميله، لكنّ ميور علّل هذه الانتكاسة بطريقة مغايرة بقوله: «لقد شهدت المناظرة الكبرى تقدّمًا صامتًا لصالح المحمّديّين ومبعث ذلك أنّ أراءهم ومجادلاتهم جاءت لتعبّر عن نظرتهم لنا لما تخلّقنا به من أخلاق الغزاة الكفرة».
إنّ فشل المبشّرين في تحقيق غاياتهم حملهم إلى تغيير منهجهم في تعاملهم مع المسلمين، ويبدو أنّ ميور قد شخّص جوهر المشكلة التي حالت دون تحقيق الإرساليّات التبشيريّة الإنكليزيّة لأهدافها منذ أن وطأت شواطئ الهند في عام 1607م، وهي نبرة الخطاب الموجّه للإسلام وطبيعة مصادره قائلًا: «لطالما خاطبنا عقل المسلم بلغة الغرب التي جسّدتها طروحات ماراشي Marraci وبريديو Prideaux التي جعلت المسلم ينظر إلينا بازدراء ويؤمن بعدم موثوقيّة كلماتنا، أمّا مصادرنا عن نبيّهم وعقيدتهم فهي مجرّد حجج واهية من وجهة نظرهم، لكن الآن نستطيع أن نتحدّث بمنتهى الجرأة مع خير من يمثّل أعداءنا بعد أن صار متاحًا لنا الولوج بحريّة تامّة إلى مصادرهم الأصليّة؛ كمصنّفات ابن إسحاق والواقدي وابن هشام وابن سعد والطبري، ودون أدنى ريبة سنقابلهم بحزمة من الأسلحة المُستلّة من ترسانتهم الدفاعيّة وبعدها سوف لن ترى إلّا الخجل في عيون
كل من يحاول أن يعترض على ما ورد في سيرة نبيّهم وتعاليمهم، زد على هذا فإنّ المصنّفات الرائعة لبفاندر وإرساليّته ستكون كفيلة بإحداث مثل هذا التأثير في عقول المحمّديّين».
لا ريب أنّ هذه العبارات تعدّ تعبيرًا حيًّا عن حالة الجدل المحتدمة بين المبشّرين والعلماء المسلمين فالروح التبشيريّة الجيّاشة والنبرة المتحاملة تبدو واضحة في النصّ أعلاه، ودون أدنى ريب، هيمنت على ميور لهجة المجادل المتعصّب أكثر من لهجة الباحث الموضوعي وهذا ما يؤكّد أن مبعث اهتمامه بالسيرة النبويّة كان خدمة لأغراض التبشير.
لقد شدّد وليم ميور على أن حدّة اللّهجة تمثّل موطن الضعف في الخطاب الموجّه للمسلمين في أكثر من مناسبة، فقد ذكر في إحدى مقالاته المنشورة في مجلة كلكتا عام 1845م قائلًا: «دعونا نتجنّب من خلال مجادلاتنا مع المسلمين أسلوب التجريح غير الضروري حفاظًا على المشاعر القوميّة، كلا لاستخدام العبارات القاسية أو التعبيرات الساخطة أو التلميحات التي تؤجّج المواقف لكوننا نتعامل مع خصوم من أصحاب القناعات الراسخة»، وعلى الرغم من هذا الموقف لم يلمس الباحث التزامًا تامًّا بمنهج الاعتدال من لدن ميور إذ تخلّلت متون مؤلّفاته العديد من العبارات ذات النبرة الهجوميّة الكلاسيكيّة المبثوثة بين ثنايا خطابه كما سيوضّح لاحقًا، لقد قدّم التبشير دافعًا لدراسة الإسلام في الوقت الذي أصبح فيه الفاعل الديني أقل حدّة من الفاعل الاستعماري الذي يرتصف في المقدمة، وقد ذكر جورج سيل في عام 1734م أنّ البروتستانتية وحدها قادرة على مقارعة القرآن بنجاح، وبعد أكثر من قرن جاء السير ميور ممثّل الإمبراطوريّة البريطانيّة ليعبّر عن هذا الشعور نفسه، متسائلًا لِمَ لم يعتنق العالم الإسلامي المسيحيّة لغاية الآن؟ وجاءت إجابته: إنّها تعصّب المسلمين، ورخصة تعدّد الزوجات، ورخصة العبوديّة
التي تعبّر عن مستوى متدّن من الأخلاق، والجزء الآخر من الإجابة يتعلّق بالكنيسة نفسها فهي تجمّد الحاضر.
إنّ مبعث الخطورة في كتابات ميور يرتدّ إلى أنّه قرّر خوض الحرب الفكريّة ضدّ الإسلام بمنهج قائم على اعتماد الثّغرات المنهجيّة لمصنّفي كتب السيرة بغية إحداث حالة من الإرباك الأيديولوجي لصورة الإسلام ونبيّه صلىاللهعليهوآله في أذهان المسلمين ومن ثمّ تشويهها، باستخدام لغة أقل حدّة ونبرة أقل وطأة على مسامعهم من النبرة القروسطيّة، ولا سيّما بعد أن فشلت جميع محاولات وليام كايري وهنري مارتن وسواهم ممّن سبقه من المبشّرين في تحقيق هذا المسعى، وبذلك يبدو للباحث أنّ ميور أعاد هيكلة الاستراتيجيّة الفكريّة للكنيسيّة ليؤسّس منهجًا جديدًا للتبشير المسيحي في عصره، كما أنّ مكانته السياسيّة وتعمّقه في قراءة أحداث السيرة النبويّة والتاريخ الإسلامي جعل من كتاباته معيارًا لفهم وتحليل الأسس التي ترتكز عليها الحركات التجديديّة الإسلاميّة ذات الصبغة السياسيّة المناهضة لسياسة بريطانيا التي تزامن ظهورها في القرن التاسع عشر بغية الإحاطة بالفواعل المفاهيميّة لانبثاقها والوقوف على الجذور الفكريّة التي تغذيها والإحاطة بالأدوات المنهجيّة التي سوف تعتمدها في تحقيق أهدافها. ولعلّنا نتّفق مع رأي واهدور Wahidur الذي عدّ وليم ميور أبًا للباحثين الغربيّين في مجال السيرة ورائد المدرسة البريطانيّة في استخدام المصادر الأصليّة في الكتابة عن تاريخ الإسلام.
(99)
يعدّ المستشرق وليم ميور واحدًا من بين الكُتّاب الأوسع تأليفًا في القرن التاسع عشر ومطلع العشرين لما تركه من الآثار والمصنّفات، أبرزها الآتية:
1. مقالات مجلّة كلكتا Calculta review : ظهرت لميور بين أعوام (1845-1852م) سلسلة مقالات تمثّل مراجعات حول مناظرات الجدل الإسلامي المسيحي باللغتين الإنجليزيّة والأرديّة، إذ نشر عام 1847م مقالة، بناءً على طلب القس بفاندر، لكتابة رأي حول أبحاثه في ميدان الجدل المحمّدي، وفي عام 1854م نشر وليم ميور أوّل مقالة له عن سيرة الرّسول صلىاللهعليهوآله في مجلة كلكتا الهنديّة The Calcutta Review بعنوان «محمد مولده وحياته» The Birth and Childhood of Mahomet، صارت لاحقًا المبحث الأوّل لكتابه الأشهر «حياة محمّد» The life of Mahomet، ومن ثمّ صدرت له مقالتان الأولى بعنوان «حياة محمّد من شبيبته حتّى سنّ الأربعين» The Life of Mahomet. from his youth to his fortieth والأخرى وُسِمت «بإيمان محمّد بوحيه» Belief of Mahomet in his inspiration اللّتان أصبحتا لاحقًا المبحث الثاني والثالث من كتاب حياة محمّد.
كتب ميور مراجعات طويلة ردًّا على كتابات بعض العلماء المسلمين الذين صنفوا
كتابات تحاجج المسيحية؛ ومنهم «مولانا رحمة الله»، و«مولانا محمّد قاسم علي»، و«مولانا سيد علي حسان»؛ وهم مجتهدون في ولاية اگرا، وسيد محمّد هادي مجتهد مدينة لكنو الذين صنّفوا كتابًا بلغة الأردو اسمه (صولة الزيغم) عام 1845م .
كما شرع ميور بتحرير المناظرة التي جرت بين رام جاندرا Ram Chandra وهو متنصّر من الهنود مع حاكم ولاية دلهي وعالم مسلم يدعى مولانا ألفت حسين، ونشرها بلغة الأردو بعنوان «باهس مفيد أل أم في تحقيق الإسلام Bahs Mufid Al Amm Fi Tahqiq Al Islam»، ردّ فيها على مسألة أنّ القرآن جاء بما ينسخ كتب العهدين، وقد ردّ ميور عليه بكتاب «الشهادة التي يحملها القرآن في صدق النصوص اليهوديّة والمسيحيّة».
2. الشهادة التي يحملها القرآن للنصوص اليهوديّة والمسيحيّة The Testimony borne by the Coran to the Jewish and Christian Scriptures 1856، كتاب ردّ من خلاله ميور على معارضي بفاندر في مناظرة عام 1854م الذين رفضوا موضوعيّة الإنجيل من منظاره، ويعدّ من الكتب المصنّفة للمرامي التبشيريّة جمع فيه النّصوص القرآنيّة الواردة في اليهود والنصارى، زاعمًا اعتراف القرآن بنصوص العهدين القديم والجديد، ونافيًا دلالة أي موضع من القرآن على التحريف والتلاعب في العهدين، وقد اشتمل هذا الكتاب على مقدّمة وثمانية أقسام، تتألّف المقدّمة من آيات من السور المكيّة وآيات من السور المدنيّة التي رتّبها تبعًا للتتابع الزمني للنزول (كرونولوجيا)، أمّا الأقسام الثمانية فقد زعم من خلالها أنّ القرآن شهد على أنّ هذه النصوص كاملة غير منقوصة، وعكف على إثبات أنّ كتب العهدين كانت موجودة ومتداولة في عهد الرّسول صلىاللهعليهوآله، وأشار إلى ثناء القرآن على كتب العهدين ودعوة الرّسول صلىاللهعليهوآله لمعاصريه إلى الاحتكام إلى هذه النصوص، كما فصّل الحديث عن الاتّهامات الموجّهة لليهود، وفصّل أيضًا في عدم وجود أيّ اختلاف بين نصوص
العهدين إبّان عهد الرّسول صلىاللهعليهوآله والنصوص الحالية، وخلص إلى أنّه «يتعيّن على جميع المحمديّين أن يتفحصّوا ويؤمنوا بكتب العهدين»، وقد ترجم الكتاب إلى الأردو في العام نفسه وقامت بنشره جمعيّة المطبوعات المسيحيّة لشمال الهند بعنوان «شهادات أي قراني بار كتابي رباني».
3. حياة محمّد Life of Mahomet، شهدت المدّة من (1858-1861م) صدور المصنّف الأوسع شهرة عن السيرة النبويّة في القرن التاسع عشر كتاب حياة محمّد Life of Mahomet، الذي صدر المجلّدان الأوّل والثاني منه في لندن عام 1858 بعنوان «حياة محمّد وتاريخ الإسلام حتّى فترة الهجرة The life of Mahomet and history of Islam, to the era of the hegira» من ثمّ ظهرت المجموعة الكاملة لكتاب حياة محمّد في عام 1861م في أربعة مجلدات، ثمّ صدرت الطبعة الثانية في عام 1878م، وحملت عنوان «حياة محمّد من المصادر الأصليّة The life of Mahomet from original sources»، ونظرًا لما حصده الكتاب من شهرة واسعة أعيدت طباعته في عام 1894م، وبعد وفاة وليم ميور صدرت الطبعة المنقحة لهذا الكتاب في عام 1923م برعاية ت.ه ويير T. H. Weir أستاذ اللغة العربيّة في جامعة كلاسكو في إسكتلندا، الذي حمل غلافه تسمية للرسّول صلىاللهعليهوآله تتّسق مع اللفظ باللغة العربيّة the life of Mohammed from original sources خلافًا للصيغة القروسطيّة المحرّفة السابقة Mahomet.
تعدّ طبعة عام 1861م الطبعة الأبرز وقد تميّزت بمقدّمتها المطوّلة والموسّعة التي بلغت 271 صفحة، وقد خُصّص المبحث الأوّل من المقدّمة للحديث عن مصادر السيرة النبويّة؛ بدءًا بالروايات القديمة، ومرورًا بالمصنّفات الرئيسة لكتب السيرة، وبسط الحديث عن القرآن الكريم؛ بوصفه مصدرًا من مصادر حياة الرّسول صلىاللهعليهوآله إبّان عهد الرّسول وبعد وفاته، مشيرًا إلى سبل جمعه وتدوينه وترتيب سوره، كما
تعرّض إلى الحديث النبوي وعدّه المصدر الثاني لحياة الرّسول صلىاللهعليهوآله ومن خلال اطّلاعه على طائفة من كتب الحديث، وذهب إلى عدّ التراث الشفاهي متحيّزًا لخضوعه لأهواء المذاهب والفرق، كما عرج على استعراض أحوال الرواة وبواعث القصور في عدم الوثاقة، معلّلًا ذلك بغياب المنهج النقدي، ومشيرًا إلى قضيّة التّداخل بين الحديث وبين الروايات الشعبيّة والتّراث اليهودي.
ثمّ تعرّض إلى الشعر العربي؛ بوصفه أحد المصادر الضعيفة للسيرة من خلال الأبيات الشعرية المعاصرة للنبي التي حملت بين طيّاتها بعض المادّة التاريخيّة، ثمّ انتقل إلى تقييم مصادر السيرة مؤكّدًا على بيان طبيعة الاختلافات بين هذه المصادر ودرجة مصداقيّتها وقد عكف على المقارنة والمفاضلة بين كتب الحديث وبين المصادر الرئيسة للسيرة.
أمّا المبحث الثاني من المقدّمة فبسط فيه الحديث عن تاريخ الجزيرة العربيّة وعن سكانها الأصليّين وتاريخ العرب وطبيعة المنطقة طبيعيًّا وجغرافيا، وخطوط التجارة والموانئ القديمة وعلاقتها مع القوى المحيطة.
أمّا المبحث الثالث من المقدّمة فقد أفرده لمناقشة ما أوردته المصادر الإسلاميّة عن أحوال الجزيرة العربيّة وجغرافيّتها ثم بسط الحديث عن ممالك اليمن القديمة وملوكها وأحوالها السياسيّة والاقتصاديّة والدينيّة على الصعيدين الداخلي والخارجي قبل بناء سدّ مارب وعقب انهياره مع بيان لحركة الهجرات نحو الشمال، وتاريخ مملكة الحيرة، وتاريخ مملكة الغساسنة، ثمّ استعرض تاريخ مكّة الديني والتجاري، تلاها الحديث عن أحوال القبائل البدويّة وتقسيماتها وأيّامها، ثم أفرد جانبًا من هذا المبحث للحديث عن مدينة يثرب والنظريّات المتوافرة حول نشأتها وتاريخها وأحوال قبائل العرب واليهود فيها حتّى الهجرة النبويّة.
أمّا المبحث الرابع من المقدّمة فقد بسط فيه الحديث على أجداد الرّسول صلىاللهعليهوآله وآبائه وأحوال مكّة منذ منتصف القرن الخامس الميلادي حتّى مولد الرّسول صلىاللهعليهوآله.
قسّم ميور مجلّداته الأربعة إلى سبعة وثلاثين مبحثًا شفّع القسم الأكبر منها بملاحق وخرائط وجداول ومشجّرات نسب، فضلًا عن تفصيلات عن طبيعة الآيات القرآنيّة المنزَلَة أو الأحكام والتشريعات التي شرّعت في كلّ مرحلة، زيادة على المبحث الأوّل المشار إليه في المجلد الأوّل أفرد الحديث في المبحث الثاني عن سيرة الرّسول صلىاللهعليهوآله حتّى سنّ الأربعين، ثمّ شرع في القسم الثالث بمناقشة إيمانه بفكرة الوحي وأفرد المبحث الرابع للحديث عن أحوال المسلمين الأوائل وأمر الهجرة إلى الحبشة، مشيرًا إلى تنامي الإسلام منذ السنة الخامسة للبعثة حتّى الهجرة. وقد خصّص الفصل السابع للحديث عن صلة الإسلام بالمسيحيّة، وختم ميور هذا المجلد بجدول يمثل ترتيبًا مفترضًا لسور القرآن الكريم حسب ترتيب نزولها.
خصّص ميور المبحث (8) وما تلاه حتّى المبحث (33) للحديث عن حياة الرّسول صلىاللهعليهوآله في المدينة؛ سياسته ومغازيه وبتفصيل واسع بنحو لا يخلو من التحيّز، والملاحظ على تقسيمات ميور للمجلّدات الثلاثة الأولى ضمّت (18) قسمًا في حين اشتمل المجلد الرابع لوحده على 19 قسمًا تمثّل الأحداث من السنة 6ه/ 627م-628م وما تلاها. وقد بسط ميور في الأقسام (34-36) للحديث عن الأحداث التي أعقبت وفاة الرّسول صلىاللهعليهوآله من أمر السقيفة والأحداث التي رافقت اعتلاء أبي بكر للخلافة، أمّا المبحث (37) فخصّصه للحديث عن شخصيّة الرّسول صلىاللهعليهوآله.
عوّل ميور في تصنيفه لهذا الكتاب على التوراة وعلى كتاب «الرواية الشخصيّة لحج مكّة والمدينة»، للسير ريتشارد بورتون Sir Richard Francis Burton، وكتاب «رحلات في الجزيرة العربيّة»، لجون بوركهارد John Burckhardt، و«ورحلة علي باي العباسي»، ومؤلّفات كوستاف فايل وشبرنجر، ودي برفيسال، وجيبون وغيرهم
فضلًا عن طائفة واسعة من المصادر الأصليّة كسيرة ابن هشام ومغازي الواقدي وطبقات ابن سعد وتاريخ الطبري الذي عوّل عليه في بيان السنوات الخمس الأخيرة من سيرة الرّسول صلىاللهعليهوآله، كما أفاد من وفَيَات الأعيان لابن خلكان في ترجمات الأعلام.
4. القرآن، نظمه وتعاليمه وشهادته التي يحملها للنصوص المقدّسة :The Coran Its Composition and Teaching & the Testimony it bears to the Holy Scriptures، صدر في لندن في 17 مارس 1878م ويمثّل الجزء الثاني والطبعة الثالثة لكتاب «شهادة القرآن التي يحملها للنّصوص اليهوديّة والمسيحيّة» مع بعض التعديلات الطفيفة؛ كما يرى ميور، بعد أن نفذت الطبعة الثانية «طبعة الله آباد 1860»، وقد عوّل ميور في هذه الطبعة على آراء الألماني فايل Gustave Weil في كتابه «مقدّمة إلى القرآن» Einleitung in den Koran التي اقتبس منها ودون حرج على الرغم من بعض الاختلافات مع آرائه، يتألّف الكتاب من ثلاثة أقسام، ينطوي القسم الأول على ثلاثة مباحث، خصّص المبحث الأول لمناقشة سيرة الرّسول صلىاللهعليهوآله مشيرًا إلى أنّ القرآن يفسَّر بسيرة الرّسول صلىاللهعليهوآله، أمّا المبحث الثاني فذكر فيه قضيّة جمع القرآن وترتيبه الزمني للسّور، بينما فصّل في المبحث الثالث تعاليم القرآن، أمّا القسم الثاني فقد أشار فيه إلى شهادة القرآن الكريم لكتب العهدين، وخصّص المبحث الأول منه إلى الآيات المكّيّة أمّا السور المدنيّة فكانت في المبحث الثاني، أمّا القسم الثالث فاشتمل على خلاصة كانت بمثابة تكرار لما خلص له في الطبعة الأولى من كتاب «الشهادة التي يحملها القرآن».
5. تاريخ الكنيسة المسيحيّة، صنّف ميور كتابًا باللغة الأرديّة نيابة عن الجمعيّة المسيحيّة الهنديّة بعنوان «تاريخ الكنيسة المسيحيّة» طبعة أكبر آباد 1878م، استعرض فيه بنحو موجز تاريخ الديانة المسيحيّة للسكان المحليّين، فضلًا عن اشتماله على بعض المقالات ذات الصلة بالطقوس الدينيّة وتاريخيّة استخدام الكتاب المقدّس في الهند.
6. الشعر العربي القديم أصالته ووثاقته Ancient Arabic Poetry; Its Genuineness & Authenticity في عام 1879 نشر ميور مقالة حول الشعر العربي القديم بسط فيها الحديث عن رونق الشعر العربي وصلته بثقافة العرب ومصادر الإلهام الشعري، كما تناول أثر الحياة الاجتماعيّة للعرب في صيرورة العقليّة الشعريّة، ورأى أنّ استقراء الشعر العربي القديم تسهم في بيان طبيعة الخطاب العربي في القرآن والسنّة من خلال الوقوف على لغة البيان والقواعد والأنساق التي ينتظم بها؛ كمحسّناته وبديعه وجزالته وإيقاعه، والتباين في أوزانه وقوافيه وعروضه وصرفه وأثرها على العقول حسب قوله، كما أورد أهميّة الشعر في توثيق الحوادث التاريخيّة ولا سيّما في العصر الجاهلي وظهور المعلّقات، ومن حيث التأثير الدينيّ والسياسيّ إبّان حياة الرّسول صلىاللهعليهوآله مرورًا بعهود الخلافة الإسلاميّة، أظهر ميور إعجابًا بحافظة العرب الشعرية مستعرضًا أثر بعض المدارس الأدبيّة؛ كمدرسة البصرة والكوفة وبغداد ودمشق والأندلس في صيرورة فنّ القصيدة.
7. منتخبات من القرآن Extracts from the coran، وفي عام 1880 نشر ميور كتابه «منتخبات من القرآن» اشتمل على 35 اقتباسًا من القرآن الكريم باللغتين العربيّة والإنكليزيّة مرتّبة وفقًا للترتيب المعهود؛ ابتداء من سورة الفاتحة وبعض المنتخبات من سورة البقرة وسورة آل عمران وسورة النساء، حتّى سورة عبس التي أوردها كاملة، دون أن يزيد عليها أيّ تعليق أو تفسير، والغريب أنّ ميور لم يورد البواعث التي حملته على هذا الانتخاب تحديدًا ما عدا زعمه أنّها آيات مقدّسة من وجهة نظر المسلمين، ورأى أنّ الفاعل الذي حمله على تصنيف هذا الكتاب كان لأغراض مدرسيّة.
8. الخلافة المبكّرة ونهوض الإسلام The Early Caliphate and Rise of Islam: في عام 1881م ألقى ميور محاضرة عن الخلافة المبكّرة ونهوض الإسلام، في جامعة
كامبردج في لندن، اشتملت على طروحات ظهرت لاحقًا في كتابه حوليات الخلافة.
9. الآية 91 من السورة 5 من القرآن Sura v, v. 91. The Coran: في عام 1882م نشر ميور هذه المقالة في مجلة الطالب العبري The Hebrew Student، التي أخطأ فيها الإحالة لأنّه ناقش مضمون الآية 81 من سورة المائدة التي تشير إلى حالة العداء بين المسلمين واليهود وليس الآية 91؛ إذ يرى ميور أنّ اليهود أشدّ عداءً للإسلام من النصارى بدعوى إحاطة الرّسول صلىاللهعليهوآله بنصوصهم واعترافه بالمسيح، فلذلك خاطب المسيحيّين بلغة عاطفيّة ولا سيّما الرهبان والقساوسة، ورأى أنّ القرآن لم يتّهمهم بليّ النصوص حتّى الذين لم يعتنقوا الإسلام منهم. ولعلّ هذه المقالة تحمل بين طيّاتها بعدًا تبشيريًّا يرمي من ورائها إلى توظيف الآية المشار إليها في تحسين صورة المبشّرين في المستعمرات البريطانيّة من منطلق أنّ القرآن يذمّ اليهود ويمدح النّصارى.
10. حوليّات الخلافة المبكّرة caliphate Annals of the early: في عام 1883م أصدر ميور مؤلّفه الموسّع الثاني عن تاريخ الإسلام «حوليّات الخلافة المبكّرة من المصادر الإسلاميّة الأصلية» الذي عدّه استكمالًا لكتابه حياة محمّد، وأشار فيه إلى جانب من حياة الرّسول صلىاللهعليهوآله في قسمه الأول، متتبّعًا بإسهاب الأحداث السياسيّة والعسكريّة والاجتماعيّة والاقتصاديّة والفكريّة التي تلت وفاة الرّسول صلىاللهعليهوآله وتأسيس نظام الخلافة الراشديّة وقيام الدولة الأمويّة حتّى نهاية حكم يزيد بن معاوية، إذ اشتمل هذا المصنّف على 50 قسمًا وملحقًا من الخرائط والجداول وقائمة بأسماء الأعلام والأماكن الواردة التي غصّت بالحواشي والإحالات والعناوين الفرعيّة والشروح في (508 صفحة)، ذهب فيها إلى تسمية هذه الأقسام تبعًا للحدث الأبرز ووفقًا للتبويب الحولي، وقد عوّل في صياغة متونه على طائفة من المصادر الأصليّة من جنس تاريخ الطبري وكتاب الكامل في التاريخ لابن الأثير وتاريخ ابن خلدون، كذلك تاريخ الخلافة Geschichte der Chalifen لغوستاف فايل، ومقالات في
تاريخ العرب لـ بِيرسفال Essai sur l’histoire des arabes وفون كريمر Von Kremer في كتابه التاريخ الثّقافي للشرق في عهد الخلافة Kulturgeschichte des Orientsunter den Chalifen.
11. عشاء الربّ شاهد حي على موت المسيح The Lord’s Supper an Abiding Witness to the Death of Christ، الذي صدر في لندن عام 1886م، ويعدّ من المصنّفات التبشيريّة.
12. محمّد والإسلام Mahomet and Islam، وفي عام 1887م صدرت نسخة مختصرة من كتاب «حياة محمّد» نشرت برعاية جمعيّة المسار الدينيّ المسيحيّ بعنوان «محمّد والإسلام»، وعلى الرغم من صغر حجم الكتاب بالمقارنة مع كتاب حياة محمّد، بيد أنّه ضمّ بين دفّتيه أغلب الطروحات القديمة. وقد اختلفت هذه النسخة عن سابقتها بأقسامها ال 48 وعناوينها الفرعيّة وبقلّة حواشيها والذيول وندرة الإحالات المصدريّة مع ظهور بعض الأشكال التوضيحيّة التي أضيفت إليها، أخذها من كتاب «حضارة العرب» لغوستاف لوبون ورحلات علي بك وكتاب ريتشارد بورتون وشفعها بملحق بسط فيه الحديث عن القرآن والحديث، وشرائع الإسلام، والعلاقة بين الإسلام والمسيحيّة، كما أشار إلى التقويم العربي.
13. الإسلام نهوضه وانهياره The rise and decline of Islam، وفي عام 1890م نشر وليم ميور مقالة بعنوان «الإسلام نهوضه وانهياره» برعاية جمعية المسار الدينيّة، أسهب فيها الحديث عن أسباب سرعة انتشار الإسلام ومكامن قوّته بالمقارنة مع المسيحيّة، مكرّرًا النتائج ذاتها التي توصّل إليها في كتاب «حياة محمّد»، ومشيرًا إلى أنّ النجاح في مكّة كان محدودًا بالمقارنة مع ما تحقّق في المدينة، لافتًا إلى حدوث تغيّر في سياسة الرّسول صلىاللهعليهوآله من الدّعوة واللّين، نحو استخدام مبدأ السيف. وقد ربط بين شغف العرب بالقتال وبين توجيهات العقيدة الجديدة، ورأى أنّ الحماسة العربيّة
للحرب حرّكتهم لغزو البقاع البعيدة إبّان عهد أبي بكر وعمر، تحت ذريعة الجهاد، وقد أفاض في هذه المقالة في بيان النتائج التي أفضت إليها هذه الحملات العسكريّة، ولا سيّما عوائد الترف التي تأصّلت في نفوس المحاربين المسلمين، كما أشار إلى دور الآيات القرآنيّة؛ بوصفها عاملًا محفّزًا على الحروب والغزوات.
وقد ضمّ الكتاب بين ثناياه مقارنة بين الإسلام والمسيحيّة في بعض النّصوص، وعوّل ميور في إعداده لهذه المقالة على كتابه «حياة محمّد» و«رسالة الكندي»، ثمّ ظهرت هذه المقالة لاحقًا في كتاب «الأديان غير المسيحيّة في العالمNon- Christian religions of the world» لمجموعة باحثين في عام 1890م، كما أعيد نشرها ضمن كتاب «معتقدان قديمان Tow old faiths»، بالتّعاون مع الكاتب جي.متشيل J. Mitchell في نيويورك 1891م.
14. الخلافة قيامها انحدارها وانهيارها The Caliphate its Rise Decline and Fall: في عام 1891م صدر لميور كتاب الخلافة قيامها وانحدارها وانهيارها، الذي يعدّ الطبعة الثانية والمزيدة لكتابه حوليات الخلافة وتشتمل هذه الطبعة على تلخيص لما ورد الطبعة الأولى واستكمالًا لسرد الأحداث التي تلت خلافة يزيد بن معاوية؛ إذ اشتمل هذا المجلد على 79 مبحثًا أفرد المباحث من 1-48 لتلخيص ما تضمّنته الطبعة الأولى من هذا الكتاب، وأفرد المباحث من 48-58 للحديث عن خلافة الفرع الأموي المرواني حتّى قيام الدولة العباسيّة سنة 132ه، وتابع وفقًا لمنهج الحوليات استعراض سنوات الخلافة العباسيّة حتّى سقوط بغداد على يد هولاكو عام (656ه/ 1258م) في المبحث 77 من دراسته، أمّا المبحث 78 فبسطه للحديث عن آخر الخلفاء العبّاسيّين الذي وسمه بالمزيّف، وكان قد لجأ إلى المماليك
في مصر، بينما خصّص المبحث الأخير لمراجعة شاملة لجملة الآراء والنتائج التي خلص إليها من خلال دراسته لتاريخ الإسلام، وقد أولى ميور عناية بالغة في تبويب تقسيماته فهو يشرع ببيان العناوين الفرعيّة دون الخروج عن النسق العامّ لنظام الحوليات، ولا سيّما في حديثه عن المدن وتأسيسها ونشأة الفرق والمذاهب.
15. المماليك أو مملكة الرقيق في مصر The Mameluke or Slave Dynasty of Egypt، وقد وضعه ميور في عام 1896م، تناول فيه تاريخ دولة المماليك التي تأسّست عام (658ه/ 1260م) على يد الظاهر بيبرس حتّى أفولها على يد السلطان العثماني سليم الأول عام 1517م، والكتاب يعدّ استكمالًا لتاريخ الخلافة العباسيّة، اعتمد في صياغة متونه على مجلدين من كتاب فايل تاريخ الخلافة Geschichte der Chalifen الذي وصفه بأنّه غنّي بالمادة التاريخيّة، لكنّ القسم الأكبر من كتابه استقاه من المخطوطات الأصليّة للمؤرّخين المسلمين من أمثال أبو الفداء، والنويري، وابن بطوطة، والمقريزي، وأبو المحاسن، وابن إياس الذي عوّل عليه في بيان الخمسين عامًا الأخيرة من حياة المماليك كما عوّل على بعض الكتاب الأتراك، وقد اختص هذا الكتاب بتاريخ مصر وسوريا، فضلًا عن تاريخ بعض الممالك مثل التيموريّة والعثمانيّة، ورأى ميور أنّ الكثير من الفجوات التاريخيّة التي أغفلتها المصادر التاريخيّة شرع بمعالجتها من خلال التخمين، وعلى الرغم من المادّة التاريخيّة القيّمة التي انطوت عليها صفحات هذا المصنّف إلّا أن ميور تعامل مع مادة الإسلام في هذا الكتاب بصبغة لا تخلُ من التعصّب بسبب بعض النعوت على شاكلة «طموح الغطرسة والعداء بفعل روح الإسلام».
16. الجدل المحمّدي وسيرة محمّد وتعليقات شبرنجر على الحديث والطقوس الهنديّة والمزامير The Mohammedan controversy; Biographies of Mohammed; Sprenger on tradition; The Indian liturgy; and the Psalter كتاب ينطوي على خمس مقالات ظهرت قبل سنين خلت في مجلة كلكتا، أعاد ميور نشرها مع إيراد
تعليقات عليها في عام 1897م، وقد ظهرت المقالة الأولى في 1845م بعنوان «الجدل المحمّدي» أشار فيها إلى أنّه صنّفها بناءً على طلب كارل بفاندر، وتحدّث فيها عن المجادلات المسيحيّة في ذلك الوقت، لا سيّما مجادلات هنري مارتن مع مشايخ فارس، وتعليقاته على أعمال بفاندر ومناظرة عام 1852م، أمّا المقالة الثانية فصدرت عام 1852م بعنوان «مصادر سيرة محمّد» استهلها بالتحذير من مغبّة نشر سيرة غير صحيحة لمحمّد صلىاللهعليهوآله لا سيّما في الدراسات غير الناضجة ككتاب حياة محمّد لواشنطن أرفنج الذي رأى بأنّه التزم بمنهج غير سليم يتعارض مع سياق الاعتذار المسيحي أو الدّفاع المسيحي من خلال الركون إلى مؤلّفات السيرة المحليّة الكثيرة في الشرق، التي تعرّضت للإهمال في الفترات المبكّرة للرواية الإسلاميّة، ورأى أنّ السيرة الحاليّة نشأت على نوع من الفنتازيا الخياليّة التي ظهرت لاحقًا، أمّا المقالة الثالثة فصدرت عام 1868م بعنوان «السير شبرنجر ومصادر وتنامي الحديث عند المسلمين»، وهي دراسة للحديث تقع في أكثر من 180 صفحة تضمّنها كتابه «حياة محمّد وتعاليم محمد»، إذ أجمل فيها دراسته عن قيمة الحديث والأنساب ومصنّفات السيرة والشروح زيادة عن القرآن نفسه؛ أمّا المقالة الرابعة فصدرت عام 1850م تناول فيها الشعائر الدينيّة والعبادات في الهند، أمّا المقالة الخامسة، فصدرت عام 1887م بعنوان «التحرير في قراءة المزامير في الكنيسة» وهي مقالة دينيّة. لقد اشتمل الكتاب على الطروحات المناوئة للإسلام التي تبنّاها فوستر وهنري مارتن، وإثره حصل ميور على عضوية مجلس الولايات التعليميّة.
17. العهد القديم والعهد الجديد، التوراة والزبور والإنجيل دعوة المسلم لمطالعتها
The Old and New Testaments:Tourât, Zubûr, and Gospel: Moslems invited to see and read them في عام 1899 أضاف ميور إلى مجموعة كتبه التبشيريّة كتاب «دعوت إسلام» ظهرت طبعة لهذا الكتاب باللغة الأردية عام 1903م، وقد مثّل كتابه تكرارًا لما جاء في مصنّفات سابقة، واشتمل على إيراد آيات
من القرآن فيها ذِكْر التوراة والإنجيل، ودعى من خلالها القارئ المسلم إلى قراءة كتب العهدين والاتّعاظ بما جاء فيها من تعاليم المسيحيّة.
1. اعتذار الكندي The Apology of Al Kindy 1882م، ويعدّ من إسهامات ميور في ميدان الجدل المسيحي الإسلامي، في ترجمته لوثيقة عربيّة مثيرة للجدل تدافع عن المسيحيّة ضدّ الإسلام، وتمثّل محاورة جرت في القرن (3ه/ 9م)؛ كما يزعم ميور، نسبت لبلاط المأمون العباسي الذي نسب ميور لعصره حريّة الرأي. وقد جرت هذه المناظرة بين مدافع عن المسيحيّة اسمه أبو إسحاق الكندي وبين وزير من البلاط العبّاسي اسمه عبد الله أبو إسماعيل الهاشمي، حملت هذه الوثيقة عنوان «رسالة عبد الله بن إسماعيل الهاشمي إلى عبد المسيح إسحاق الكندي يدعوه فيها إلى الإسلام ورسالة الكندي إلى الهاشمي يردّ بها عليه ويدعوه إلى النصرانيّة في أيام الخليفة المأمون» التي ترجمها وأعاد نشرها بعنوان «اعتذار الكندي» عام 1882م، بعد أن قرأ ملخّصها أمام الجمعيّة الملكيّة الآسيويّة ونشرت لأوّل مرّة في جريدتها بعنوان: «رسالة الكندي مقالة بصدد العصر والتأليف»، وظهرت لها طبعة ثانية في لندن عام 1887م.
ورأى ميور أنّ الرسالة أصيلة معوّلًا على إشارة البيروني (390هـ/ 999م) في معرض حديثه عن طقوس الصابئة في كتابه الآثار الباقية عن القرون الخالية، الذي يعدّه ميور حجّة على تداول هذا العمل، لكنّ المستشرق الفرنسي ماسينيونMassignon عارض هذا الرأي بناءً على إحالة تضمّنتها الرسالة إلى تاريخ الطبري
المتوفّى (عام 310ه)ـ، وهو تاريخ لاحق لعهد المأمون (198-218)، وليس هنالك من وزراء المأمون من عُرِف بهذا الاسم، لقد حاول ميور أن يقف على شخصيَّتَي الرسالة الذين يرجّح أن ما جاء بشأنهما مجرّد نعوت لينفي أن يكون الكندي المذكور هو الفيلسوف المعروف أبو إسحاق الكندي.
ورأى ميور أنّ هذه الوثيقة من أخطر الأسلحة التي يمكن أن يحوز عليها المسيحي في عمله التبشيري، ولا سيّما أنّ الغاية الأولى من ترجمتها خدمة المسيحيّة، لقد حملت الرسالة بين طيّاتها نعوتًا قاسية للإسلام ولليهوديّة والمجوسيّة من لدن المحاور المسيحي، أشار ميور إلى أنّ تداول الرسالة لا يمكن أن يكون مستساغًا بل إنّه بلغ حدًّا أنّ القانون السابق لمصر كان يقضي في حال العثور على المخطوطة في أي بيت أن يهدم ذلك البيت وأربعين بيتًا أخرى محيطة به.
ولم يشِر ميور إلى موضع حفظ المخطوطات الأصليّة أو تاريخ تحريرهما ما عدا إشارته بالقول: «إنّ العمل طبع أصلًا من مخطوطتين تمّت حيازة الأولى من مصر والثانية من اسطنبول ولا تحتوي أيّ منهما على اسم الناسخ ولا سنة النسخ وكلتاهما مليئتان بالأخطاء»، الأمر الذي يسجّل أحد المآخذ المنهجيّة على ميور ولا سيّما مع اعتقاده التّام بصحّة هاتين الوثيقتين.
2. الحلو أوّل القطاف وحكاية القرن التاسع عشر حول حقيقة الديانة المسيحيّة
Sweet first-fruitsa tale of the nineteenth century on the truth and virtue of the Christian religion كتاب ظهر في عام 1893م وهي قصّة مجهولة المؤلّف نظّمت باللّغة العربيّة في القرن التاسع عشر عكف ميور على ترجمتها وتحريرها وعدّها الثمرة الأولى لجهود الكنيسة الشرقيّة في التبشير المسيحي عندما
أرسلت كنيسة حلب السورية في سنة 1861م رسالة إلى والي حلب أحمد عبد الهادي للفت الانتباه إلى أنّ الإنجيل لم يكن يومًا محرّفًا لأنّ القرآن أكّد الاحتكام إليه فأوعز الشيخ عبد الهادي إلى بعض خواصّه المسلمين لدراسة فحوى الرسالة وعكفوا على دراسة الكتاب المقدّس ويشير ميور أنّ بعضهم اقتنع بما جاء في صميم الرسالة حتّى أنّ أحدهم اعتنق المسيحيّة، وكان سببًا في أن يُحاكم بقطع رأسه وهو شخصيّة شيخ علي الذي عدّه محورَ هذه الحكاية الذي تَتَبّع سيرته حتّى موته، وقد تَتَبّع ميور في هذه القصّة المجادلات الدينيّة التي تخلّلتها ليضيف كتابًا آخر إلى سلسلة كتب التبشير المسيحيّة.
3. منارة الحقّ أو شهادة القرآن على صدق المسيحيّة the beacon of truth or testimony of the Coran truth of the Christian religion، وفي عام 1894م ترجم ميور من العربيّة كتاب مصباح الهدى لمؤلّف كتاب الحلو أوّل القطاف المجهول، وهو بحث صنِّف لإظهار الأدلّة القرآنيّة على صدق الديانة المسيحيّة، ورأى ميور أنّ العمل برمّته عبارة عن جدليّة صِيغَت بلغة معتدلة لفت بها عناية الكنيسة، وأوصى أن تكون بحوزة المبشّرين في جدالهم مع المسلمين، يجمع الكتاب بين طيّاته أدلّة من القرآن الكريم تؤكّد صحّة الديانة المسيحيّة.
وقد جهد ميور إلى تسطيح النّصوص وليّها بغية إثبات أنّ القرآن يقرّ بآراء مسيحيّة، ولا سيّما مسألة ألوهيّة المسيح التي شرع بنسفها مؤكّدًا على بشريّة المسيح، ولعلّ الغاية الرئيسة من هذا الكتاب مخاطبة المسلمين المعاصرين، وقد دلّت على ذلك عبارات مثل: «مؤمنو اليوم Believer of the day»، وعلى الرغم من انتقائه لبعض النماذج من تفاسير المسلمين في إثبات وجهة نظره، لكنّها لم
تسلم من نقده لكونها لا تَتَّسق مع غايته التي يرمي إليها على سبيل المثال قوله في تفسير الفخر الرازي أحيانًا أنّه يُميّز بين المتناقضات التي تجاوز حدّ الاختلاف بين النّار والماء والمحرّم والشرعي.
4. مصادر الإسلام The sources of Islam، في عام 1901م صنّف ميور كتاب مصادر الإسلام The sources of Islam وهو نسخة ملخّصة ومراجعة لأحد أهم الكتب المثيرة للجدل والموسوم (ينابيع الإسلام) باللّغة الفارسيّة، للمؤلّف البريطاني كلير تسديل T.Clair-Tisdall (1859-1928م) ممثّل جمعيّة التّبشير المسيحيّة في مدينة جولفا Julfa في أذربيجان وأصفهان، وقد شرّع ميور بترجمته من الفارسيّة إلى لغة الأردو وإلى اللّغة الإنكليزيّة، وخصّصه للحديث عن المنابع المزعومة للوحي والطقوس الدينيّة في الإسلام في ضوء فكرة بشريّة النبوّة وبلورة مفاهيمها بالاقتباس من الأمم أو الأديان الأخرى، مستهلًّا الحديث بالإشارة إلى انطباع المسلمين حول مصادر الإسلام، زاعمًا بوجود أصول عربيّة جاهليّة لهذا الوحي كما أشار إلى أثر الديانة اليهوديّة في صيرورة معتقدات المسلمين.
1. تقرير عن الاستيطان في ولاية Zilla Humeerpore، لم تنحصر دائرة اهتمامات ميور في مجال التبشير المسيحيّ وتاريخ الإسلام فحسب، بل ظهرت عددًا من الدراسات السياسيّة والاستراتيجيّة والسّيَر الشخصيّة، ففي عام 1842م نشر في مدينة اگرا تقريرًا عن الاستيطان في ولاية زيلا هوميربور Zilla Humeerpore، اشتمل على تفصيلات دقيقة عن الأوضاع الاستراتيجيّة والجغرافيّة والطبغرافيّة والاقتصاديّة والسكّانيّة لهذه الولاية.
2. عائدات الأفيون The Opium Revenue، في عام 1875م صدر لميور كتاب عائدات الأفيون The Opium Revenue الذي يشتمل على مذكّرات وملخّصات مقتبسة من الصحف الصادرة من حكومة كلكتا في الهند، ومراسلات جرت بين شخصيّات سياسيّة رفيعة المستوى فضلًا عن بعض محاضر البرلمان البريطاني، وقد عالج الكتاب السّياسة الاقتصاديّة والإداريّة لحكومة الهند البريطانيّة، واشتمل على إحصائيّات كثيرة عن تجارة مادّة الأفيون المخدّرة وعائدتها.
3. الخطبة الافتتاحيّة لطلبة جامعة أدنبره Inaugural address to the students of the University of Edinburgh ومن الأعمال التي حملت إمضاء وليم ميور؛ الخطبة الافتتاحيّة التي ألقاها وليم ميور على طلبة جامعة أدنبرة ومدرّسيها في 27 تشرين الأول 1885م عشيّة تولّيه لمنصبه رئيسًا لجامعة أدنبره، وقد نشرتها مطبعة جامعة أدنبره، وهي تعدّ تلخيصًا لتاريخ الجامعة العلمي والعمراني، اشتملت على إحصائيّات تعليميّة مهمّة فضلًا عن إشارات عن سيرته الذاتيّة.
4. المبجّل جيمس ثومسون Honorable James Thomason وفي عام 1897م صنّف ميور كتابًا يحمل عنوان المبجّل جيمس ثومسون، يحكي السيرة الذاتيّة لعرّابه النّائب العام لحكومة بريطانيا للأقاليم الشماليّة ودوره في ميدان التّبشير ورعاية الأنشطة التبشيريّة.
5. سجلّات دائرة الاستخبارات في حكومة الهند الشماليّة، تمثّل سجلات دائرة الاستخبارات في حكومة الهند الشمالية خلال التمرد الكبير عام 1857م مذكراته التي وثّقها إبّان الثورة الهنديّة الكبرى عندما كان رئيسًا لمكتب الاستخبارات في حكومة الولايات الشماليّة، ويقع في جزأين نشر فيهما عددًا كبيرًا من المراسلات السرّيّة التي جرت إبّان مدّة الثورة.
زيادة على ذلك فقد أسهم ميور في كتابة المقدّمات الافتتاحيّة لبعض المؤلّفات؛ منها:
مخطّطات البنجاب، من إعداد صديقين Panjabi sketches by two friends.
حياة وأعمال بيناريس وكوماون Life and work in Benares and Kumaon.
البعثات الطبيّة موقعها وسلطتها Medical Missions Their Place And Power.
التوبة النصوح The repentance of Nussooh.
تُعدّ إسهامات المستشرق وليم ميور فريدة من نوعها ليس لكونه من الروّاد في استخدام المصادر الإسلاميّة الأصليّة، بل بسبب اعتماده على منهج تخاطبي وتفاعلي مع المسلمين تابع من خلاله الرؤية التحامليّة التي ذاعت في القرون الوسطى، بتطبيق منهج النقد الغربي على مادّة السّيرة لإعادة كتابة سيرة الرّسول صلىاللهعليهوآله من وجهة نظر تبشيريّة بالاعتماد على المخطوطات الإسلاميّة الأصليّة، بعد أن كان يعوّل على طروحات رجال الكنيسة أو المادّة التاريخيّة المتداولة عن الرّسول صلىاللهعليهوآله في الغرب حصرًا، لخلق التصوّرات عن سيرة الرّسول صلىاللهعليهوآله، لذلك تمثّل إسهامات ميور حالة التمازج بين منهج النقد العلمي وبين الخطاب التّبشيري، في إطار محاولة لإدانة المنهج التّقليدي في معالجة قضايا الإسلام، ويبدو أنّ مصنّفات ميور حملت
بين دفتيها قيمة تاريخيّة نوردها من قبيل الأمانة العلميّة؛ وهي:
1. الشموليّة في تغطية تاريخ الجزيرة العربيّة منذ أقدم العصور وإيراد الدّراسات الأثريّة المبكرة عن المنطقة والإشارات التوراتيّة مرورًا بأحوال العرب وسيرة الرّسول صلىاللهعليهوآله وتاريخ الخلافة الإسلاميّة وما تلاها في مدة حكم الإمارات المغولية حتّى سقوط عهد المماليك وقيام الدولة العثمانية 1517م، وبمحاولة حسابيّة بسيطة لإحصاء المادّة التاريخيّة لديه وجدنا أنّه خلف مادّة بنحو2773 صفحة في تاريخ العرب والمسلمين غصّت بالشروح والإحالات والإشارات المرجعيّة والعنوانات الجانبيّة تعرّض من خلالها إلى أدق التفاصيل التاريخيّة والسياسيّة والدينيّة والاجتماعيّة والعمرانيّة والفكريّة والاقتصاديّة، وتبرز عنايته بحياة الرّسول صلىاللهعليهوآله بنحو استثنائي حتّى أنّه اعتقد أنّه ليس هنالك سيرة حقيقة للنبي، وأنّ سيرته مفقودة؛ لذلك دأب على تصنيف كتاب للسيرة بنفسه.
2. تعدّ مؤلّفات ميور مصدرًا رئيسًا لبيان حالة الجدل الدينيّ الإسلامي المسيحيّ في الهند إبّان القرن التاسع عشر ولا سيّما في كتابه «مناظرة المسلم» الذي أحصى فيه أسماء المجادلين المسيحيّين ومناظريهم من العلماء المسلمين فضلًا عن بيان لبعض المصنّفات التي اختصّت بهذه المسألة.
3. تُعَدُّ مؤلّفات ميور من أكثر المصنّفات انتشارًا في الأروقة الاستشراقيّة حتّى باتت محل اقتباس العشرات من المستشرقين منذ القرن التاسع عشر إلى واقعنا الراهن، ولعلّ شهادة باترك هوك Patrick Hughes أدلّ حجّة على مكانة ميور في ميدان الاستشراق قائلًا: «ثمّة استحالة أن يقوم أيّ باحث يروم الكتابة في ميدان الإسلام أن لا يشعر بالامتنان إلى مصنّفات السير وليم ميور»، وكان ميور الباحث الأبرز الذي انكبّ على دراسة الإسلام بهذا التعمّق، وغدت مصنّفاته مرجعًا
للمشتغلين في ميدان الاستشراق والأنشطة التبشيريّة، بل غدت مصنّفاته في تاريخ الإسلام مراجع يعوّل عليها في الجامعات البريطانيّة والهنديّة، الأمر الذي حمل العديد من الباحثين والمبشّرين على السير على خطى ميور في توجيه النقد للإسلام لما تركته كتاباته من آثار.
4. يُعدّ ميور رائِدَ الدّراسات الإسلاميّة الحديثة في الاستشراق البريطاني فلم يسبقه أحد من البريطانيّين عدا الألماني غوستاف فايل والنمساوي ألوي شبرنجر للكتابة عن سيرة الرّسول صلىاللهعليهوآله وتاريخ الخلافة الإسلاميّة من المصنّفات الرئيسة للسّيرة وحوليّات الإسلام، مع ملاحظة أن ميور صهر في بوتقة واحدة روايات مدرستين متعارضتين: المدرسة الأوروبيّة المتمثّلة بكتابات جورج سيل وجيبون مع مصادر السيرة الأصليّة التي زامن ميور عصر اكتشافها، مع بيانه لدلالة التغاير بينهما، مضيفًا إليها إرهاصات المدرسة الألمانيّة الجديدة، التي تركت أثر بارزًا في معالجاته لمجريات التاريخ الإسلامي لما تأثّر به من كتابات المنصّرين الألمان بفاندر ووليم كلير تسديل وفايل، التي وقف منها أحيانًا موقف النّاقد المعارض، وبالتّالي فإن ضبط إيقاع هذا النسيج غير المتجانس يدلّ على براعة عالية على الرّغم من الأخطاء التي لُمست في منهجه في هذه الدراسة.
5. عنايته بدراسة القرآن الكريم ومحاولته لتتبّع الآيات القرآنيّة وترتيبها تبعًا لأحداث السيرة وضمن ترتيب زمنيّ، فقد امتلأت متون مؤلّفاته بالإحالات القرآنيّة، وقلّما نجد صفحة من مؤلّفاته لا تنطوي على نص قرآني بالإنكليزيّة، ولا نعلم مستشرقًا سبق ميور في محاولة ترتيب القرآن زمنيًّا كما أفرد 36 صفحة في مقدّمة كتابه «حياة محمّد» لدراسة تاريخ القرآن، وأصالته، وجمعه، وناسخه، ومنسوخه،
وكتبة وحيه، ونسخه حتّى أنّه أشار إلى نسخة الإمام علي الذي كان يحوز على نسخ مزيدة من القرآن، قيل إنّه توجد منها نسخة في القرن (8ه/ 14م) في مشهده وقد حملت ختمه، وقد دوّن بعض الصحائف بنفسه وهي محفوظة في ولاية لاهور الهنديّة، كما نسبت بعض الصفحات الأخرى إلى الإمام الحسين، وخلص ميور إلى أنّ: «القرآن هو السجلّ الأوثق لوحي محمد»، وأنّه: «لا يوجد في العالم على الأرجح كتاب آخر بقي اثني عشر قرنًا بنصّ بمثل هذا النّقاء»، لكنّه على الرغم من ذلك لا يعتقد بالأصل الإلهي للقرآن، كما فصّل في كتابه القرآن نظمه وتعاليمه عن السور المكيّة والمدنيّة وتفكيكها تبعًا لأحداث السيرة وعلاقة النصّ القرآني بكل مرحلة من حياة الرّسول صلىاللهعليهوآله، فلا غرو أنّ ميور كان رائدًا للدّراسات القرآنيّة في بريطانيا وأوروبا ولعلّ محاولة المستشرق الألماني نولدكة في مصنّفه «تاريخ القرآن» المحاولة الثانية لأنّها اشتملت على بعض النقود لكتاب ميور، كما تأثّرت الترجمات الإنكليزيّة التي ظهرت في القرن التاسع عشر بكتابات ميور بنحو كبير ومن أمثلة هؤلاء ج. رودويل J. M. Rodwell القرآن الترجمة من العربيّة The Koran Translated from the Arabic.
6. يُعَدّ ميور من طلائع الباحثين الذين وجهوا عنايتهم إلى الحديث النبوي، فكانت كتاباته وانتقاداته في هذا الشأن ركيزة في الدراسات اللاحقة للمستشرقين، كالألماني شاخت Chacht والهنغاري غولدزيهر Goldziher، لكن ميور قلّل من قيمة الحديث بدعوى عدم الموضوعيّة والتحيّز وعدم الدقة، ويبدو أنّ الخطأ الجسيم الذي وقع به المستشرقون والكتّاب الغربيّون ومنهم ميور أنهم عبّروا عن
انتقادهم بشدّة للحديث في الوقت الذي تقبّلوا فيه الضعيف من روايات أهل السّيرة على أنّها إنجيل صادق.
7. عناية ميور بضبط التواريخ بنحو ملفت فقد عوّل على مقالات المستشرق الفرنسي (دي بِيرسفال) في ضبط التواريخ، الذي يورد ما توفّر لديه من نصوص في تاريخ حدث معيّن من ثمّ يعكف على المفاضلة بينها، ولعلّ ما يميّز منهج ميور عنايته البالغة بتبويب الأحداث التاريخيّة وفقًا لترتيبها الزمنيّ، وتبعًا للحدث الأبرز لهذه المرحلة كما في المبحث 12 الذي أفرده للحديث عن معركة بدر في رمضان من السنة الثانية للهجرة/ كانون الثاني 624م وما تلاها من الأحداث، وأشار في المبحث 13 عن غزوة أحد في شوال 2هـ/ كانون الثاني، مع الإشارة إلى عمر الرّسول صلىاللهعليهوآله يومها كما في ورد المبحث 15 «أحداث سنة 4هـ و5هـ من منتصف عام 625م إلى نهاية 626م العمر 57-58».
8. عنايته بالمخطوطات الإسلاميّة وإجادته للّغة العربيّة والفارسيّة ولغة الأردو مكّنته من الاطّلاع على كثير من المخطوطات التي لم يطّلع عليها قبله سوى شبرنجر، الذي اقتفى أثره بالاعتماد على كتابات الواقدي وابن هشام والطبري وابن سعد، من خلال تقديمه وصفًا مفصّلًا عن حالة هذه المخطوطات التي كانت يومذاك مخطوطات لا زالت مكتشَفة حديثًا، كما جاء وصفه مخطوطة ابن سعد التي وصفها وصفًا دقيقًا، وشرع ميور ليفاضل بينها من حيث القيمة ودرجة الوثاقة عادًا القسم المتعلّق بسيرة الرّسول صلىاللهعليهوآله من الطبقات الكبرى الأوثق الذي عوّل عليه كثيرًا وعدّه معيارًا لصحّة الروايات فكان يستخدم عبارة They arenot given by the secretary أي لم ترد عند كاتب الواقدي للتشكيك بالروايات التاريخيّة الأخرى، ورغم ذلك فإنّه في بعض الأحيان يوجّه الاتّهام إلى ابن سعد بأنّه: «أكثر
سخفًا وسذاجة من ابن إسحاق وابن هشام»، كما أنّ حذره في الاقتباس من المصادر الأصليّة أخرج مصنّفاته بصورة أقلّ وطأة من سواه من مصنّفات من سبقه من المستشرقين.
9. اشتملت مصنّفات ميور على شهادات منصفة في حق الرّسول صلىاللهعليهوآله، ولا سيّما في سنيّ حياته المبكرة التي أقرّ فيها باستقامةالرّسول صلىاللهعليهوآله وعفّته وسمو أخلاقه وترفّعه عن مجتذبات شباب مكّة التي عدّها أمرًا قلّ نظيره كما جاء في قوله: «أظهر محمّد في شبابه استقامة وعفّة نادرة في أخلاقه مقارنة بسكان مكّة»، وقوله: «تجنّب محمّد الانحلال والممارسات الفظّة مع الأصدقاء والمقرّبين فكان له عقل مصقول وذوق رفيع، فكان متحفّظًا ومعتدلًا عاش مع ذاته وكان يمعن النظر في مكنونه القلبي في ساعات فراغه التي كان يقضيها الرّجال من المراتب الدنيا في الرياضة وحياة الصخب، لقد تخلّق محمّد في شبابه بمزايا مشرفة إذ نالت شخصيّته المتوارية استحسان قومه واحترامهم حتّى صار يعرف بينهم بالأمين».
وقد أبدى ميور إعجابًا بشخصيّة الرّسول صلىاللهعليهوآله وإصراره على تحقيق رسالته بقوله: «وقف نبي الجزيرة العربيّة لثلاث عشرة عامًا بوجه الزجر والتخويف والرفض والاضطهاد متمسّكًا بإيمان لا يتزعزع يدعو النّاس إلى التوبة ويشجب آلهة قومه الوثنيّين، وحوله ثلّة قليلة من الرجال والنّساء المؤمنين، يجابه الإهانة والتّرهيب والخطر بالصبر والثقة بالمستقبل، ولماّ جاء الوعد بالأمن من الحيّ الأقصى تريّث حتّى غادر جميع أتباعه من ثمّ اختفى عن أنظار قومه الجاحدين القساة».
ولم يغب عن ميور أن يقدّم انطباعًا عن علاقة الرّسول صلىاللهعليهوآله بمحيطه بقوله: «أظهر محمّد عطفًا وإيمانًا بأتباعه فقد عرف عنه صداقاته الدائمة وكرمه وسعة صدره في الحياة
العامّة، كما تمكّن من الاستحواذ على قلوب الساخطين عليه برشاقة وحسن توقيت»، ويرى بأنّه كان محسنًا في قوله: «كان محمّد يوزّع الصدقات المتراكمة على الفقراء».
ويبدو أنّ ميور لامس بعض الجوانب الإنسانيّة في شخصيّة الرّسول صلىاللهعليهوآله، ولا سيّما في معرض حديثه عن مرحلة الطفولة، إذ يصف حالته عشيّة فقدانه لجدّه عبد المطلب بقوله: «لقد جُرح قلب محمّد الدافئ والحنون بقسوة مرة أخرى»، ويرى بوجود أسباب ذاتيّة وقفت وراء نجاحه كما جاء في قوله: «عندما يلقي محمّد مواعظه كان خطابه واضحًا متريّثًا مشدّدًا، فاحمرار عينيهِ، وصوته الذي يرتفع جهورًا وعاطفته الثّائرة، ولا سيّما عندما يحذّر النّاس من مغبة الوقوع فريسة لأعدائهم المتربّصين بهم ليل نهار كانت سرّ نجاحه».كما أشار ميور إلى زهده وترفعه عن مظاهر التّرف على الرغم من أنّ ميور يجعل من السلطة والزعامة السياسيّة غاية يصبو إلى تحقيقها، إذ يشير إلى: «أنّ البون شاسع بين حياة مُحَمّد وبين حياة التّرف التي عاشها الخلفاء من بعده في دمشق وبغداد».
كما أقرّ ميور بموقف الرّسول صلىاللهعليهوآله من الكتاب المقدّس بقوله: «لم يذكر محمّد كتب العهديْن القديم والجديد من البداية حتّى النهاية إلّا بتبجيل واحترام».
كما بيّن ميور مواقف الرّسول صلىاللهعليهوآله الإنسانيّة في مواقف عدّة كما جاء في قوله: «أوصى محمّد بالعبيد: إطعامهم من طعامكم، وكسوتهم من ثيابكم، واذا اقترفوا ذنبًا ليس لكم أن تصفحوا عنه فبيعوهم ولا تعذّبوا عباد الله»، وقوله في مكان آخر عن تجارة الرقيق: «دون أدنى شكّ سيكون لمحمّد موقف من تجارة الرقيق غير الإنسانيّة في إفريقيا لأنّه سيكون أوّل من يدينها بجميع تفاصيلها الهمجيّة».
وقد أشار ميور إلى موقف الرّسول صلىاللهعليهوآله من الأسرى بقوله: «عندما اقتيد الأسرى إلى المدينة حثّ محمّد أتباعه على معاملتهم بلطف واحترام إلى حدّ إقرارهم بأنّهم كانوا يركبون بينما كان أهل المدينة يسيرون على أقدامهم، وبأنّهم قدّموا لهم الخبز ولم يكن منه سوى القليل واحتفظوا لأنفسهم بالتمر لوحده فلا غرو أنّ بعض الأسرى آمنوا بمحمّد لما وجدوه من هذا التأثير وحازوا على حريّتهم على الفور».
وكانت لميور وقفة مع شخصيّة الرّسول الإنسانيّة في فتح مكّة بقوله: «إنّ موقف محمّد في غزوة مكّة اتّسم بالشهامة والاعتدال والحق لقد أظهر محمّد تسامحًا وعفوًا لكل ما لحق به من الأذى والطرد في الماضي».
وقد أورد ميور أيضًا في وصف شخصية المصطفى صلىاللهعليهوآله المتسامحة في قوله: «كان محمّد عادلًا غير متطرّف... استثنى بعفوه بعض المجرمين ومنح العفو العام وأقدم على نسيان الماضي الأليم بكلّ سخريّته واضطهاداته، فقد قابل خصومه بكرم وودّ، فأمسك عن النيل من عبد الله بن أُبي وحزب المنافقين في المدينة الذين لم ينفكوا عن الإيقاع به وتثبيط همم أتباعه ورفض سلطانه».
ليس ذلك فحسب، بل أشار ميور إلى مقدار الأثر الذي أحدثه الرّسول صلىاللهعليهوآله والإسلام في حياة الجزيرة العربيّة وبعض المناطق في العالم بقوله: «لقد أزاح محمّد إلى غير رجعة عددًا من العناصر الخرافيّة المظلمة التي كفنت الجزيرة العربيّة في العهود الماضية، لقد اختفت الوثنيّة أمام معركة الإسلام وغدت عقيدة التوحيد والعناية الإلهيّة اللامحدودة عقيدة في قلوب أتباع محمّد والأذعان المطلق للإرادة الإلهيّة تحت مسمى الإسلام وغدا الحب الأخوي يزين رابطة الإيمان فقد كُفل الأيتام وعُومل العبيد باعتبار وإحسان، وحُظر شرب السّموم، ولا ريب بأنّ المحمديّة تفاخر الشرائع الأخرى بأنّها الأكثر اعتدالًا».
وقوله أيضًا: «لم يغب عن ذاكرة مكّة وعموم الجزيرة العربيّة التي ظلّت ساكنة وخاملة فكانت تقبع في سباتها الروحي وكان تأثير اليهوديّة والمسيحيّة بسيطًا وعابرًا على العقليّة الفلسفيّة العربيّة، أشبه بملامسة سطح بركة دون أن تعكّر صفوتها كان الناس غارقين في الخرافات والظلم والرذيلة، فكان الإبن الأكبر يرث أرملة أبيه كما يرث ممتلكاته، كما استحكم فيهم وأد الإناث والخوف من الماورائيّات والخشية من سطوتها الذي حلّ بدل الإيمان بالعناية الإلهيّة وقدرتها كما لم يكن لهم معرفة بحياة الثواب والعقاب والخير والشر».
ويبدو أنّ ميور أقرّ بالأثر الذي أحدثه الإسلام خارج الجزيرة العربيّة بقوله: «نجح الإسلام في الارتقاء بأمم غارقة في حضيض الوثنيّة والهمجيّة إلى مراتب عليا كتلك التي تقبع في أواسط إفريقيا ولا سيّما في معايير الاعتدال المادّيّة والارتقاء بمستوى الأخلاق».
إنّ مثل هذه الشهادات المنصفة، وإن شحّت بين ثنايا كتابات المستشرق وليم ميور لكنّها تعدّ سلاحًا مستلًّا من ذخائر الاستشراق النفيسة التي يمكن الإفادة منها في ردّ التقوّلات على السيرة النبويّة العطرة من بعض المستشرقين المتحاملين ومن شايعهم من ذوي النبرة العدائيّة.
10. اشتملت مصنّفات وليم ميور على ذِكْر بعض المصنّفات في ميدان السيرة النبويّة بلغة الأردو ومنها كتاب «مولود شريف» عام 1840م لغلام إمام شهيد، الذي بسط فيه الحديث عن معجزات ولادة الرّسول صلىاللهعليهوآله،كما أشار إلى بعض المؤلّفات الفارسيّة في السيرة منها كتاب «مدارج النبوّات» وكتاب «روضة الأحباب»، الذين لم يشِر إلى مؤلّفيهما،كما ظهر في عام 1847م في اگرا كتاب «حياة محمّد» بالأردو لـ أسد أكبري، ورأى ميور أنّ الكتاب الأخير أكثر شموليّة وتفصيلًا من كتاب «المولد الشريف» على الرغم من النقد الذي وجّهه ميور لهذا النوع من المصادر،
في أنّه يتّسم بالخيال والمبالغة والاعتماد على المصادر المختلقة، التي يرى أنّ كتَّاب السِيَر الأوائل بريئون منها، كما أتى ميور على ذِكْر أهم المصادر الأوروبيّة المعتمدة في القرن 13ه/ 19م لدراسة القرآن والسيرة؛ إذ يرى أنّ ترجمة جورج سيل Gorge sale وحواشي كتابه «القرآن...» الذي ألّفه عام 1734م، كانت ولا زالت يومذاك النسخة المعتمدة في اللغة الإنكليزيّة.
11. لم تخل مصنّفات ميور من الانتقادات لعدد من المستشرقين، إذ أعرب عن تحفّظه من كتاب المبشّر فوستر Forster «كشف المحمّديّة Mahometanlsm Unveiled»؛ لكن سرعان ما شرع إلى تبنّي وجهات نظر مماثلة لاحقًا، كما عارض العديد من آراء المستشرق النمساوي ألوي شبرنجر الذي عوّل على مؤلّفاته، ففي معرض حديثه عن تاريخ تأسيس مكّة ينتقد ميور Muir رأيه الذي أدلى به بشأن قصي جدّ الرّسول صلىاللهعليهوآله وكونه باني مكّة ومشيّد الكعبة، ورأى أنّ هذا الرأي غير صائب لكونه لا ينسجم مع الروايات والاحتمالات الأوفر حظًّا، كما أظهر نقدًا حادًّا لشكوك شبرنجر بشأن موثوقيّة رواية ابن إسحاق في السيرة النبويّة، ورأى أن شبنجر أخطأ وبغرابة بقوله إنّ الإسلام ليس من إنتاج محمد صلىاللهعليهوآله، وأعرب ميور عن سروره لأن ثمّة كاتبًا متعقلًا ومتعلّمًا يشاطره هذا الرأي؛ وهو الألماني نولدكه في كتابه تاريخ القرآن.
كما وجّه نقدًا إلى المستشرق الأمريكي واشنطن أرفنج Irving Washington وعدّ كتابه عن سيرة محمّد صلىاللهعليهوآله من المدوّنات التي يغلب عليها الطابع القصصي والرومانسي وأنّه صنّفه كما تصنّف الرواية ولم يكن حازمًا في الإفادة من المصادر بل صوّر الرّسول صلىاللهعليهوآله من زاوية رومانسيّة متحيّزة وفي غمرة انبهاره فقد أحسن
التعبير عن الحقيقة، وعدّه لم يلتزم جانب التمحيص التاريخي ورأى أنّ هذا الطراز من الدراسات قد راج بسبب جهل كتّاب الغرب باللغة العربيّة وعدم إحاطتهم بالمصادر الأصليّة.
كما ردّ ميور رأي فايل في معرض حديثه عن رحلات الرّسول صلىاللهعليهوآله المبكرة من أنّ الرّسول صلىاللهعليهوآله سافر مع عمه الزبير إلى اليمن وليس مع عمّه أبي طالب إلى الشام، وعوّل على المتواتر في هذا الصدد لكون الرّسول صلىاللهعليهوآله لم يسافر مع أحد من أعمامه ما عدا أبا طالب.
من خلال مطالعة مصنّفات ميور يمكن تسجيل بعض المآخذ الخطابيّة والمنهجيّة على معالجاته التاريخيّة؛ وهي:
1. التباين في نبرة الخطاب، حمل منهج ميور تباينًا في نبرة الخطاب إذ بدا حادًّا تحامليًّا يغصّ بعبارات العداء، ولا سيّما في مؤلّفاته التي صدرت إبّان مدّة عمله في حكومة الهند بفعل استخدامه لمصطلحات يشكّك خلالها في المصدر الإلهي للوحي المحمّدي كما في قوله: pretended revelation الوحي المزعوم، assumption by Mahomet افتراضات محمّد، so-called revelation الوحي المدّعى، Mahomet obtained Deceptive Information حصول محمّد على المعلومات المضلّلة، Pseudo-Inspiration الإلهام الزائف، Speaking Falsely الحديث الباطل.
فضلًا عن اتّباعه لقواعد إملاء لأسماءِ المعاني الإسلاميّة المتداولة من دون تغييرِ كما درج عليه موروثه، فيكتب مكّة Mecca، ولَيسَ Makka، ومحمّد Mahomet
التي تحمل دلالة متعصّبة ولَيسَ Muhammad بدعوى أن يميّز الرّسول صلىاللهعليهوآله عن باقي الرجال الذين يحملون اسم محمّد، وهذه حجّة ضعيفة لأنّ مكانة الرّسول صلىاللهعليهوآله من أحداث عصره لا يمكن لها أن تتقاطع مع أيّ شخص يحمل الاسم نفسه، ولا سيّما في كتابه حياة محمّد، مع ملاحظة ندرة استخدامه لعبارة Moslems أو المسلمين في خطابه معوّلًا على جملة من العبارات ذات المدلولات المتعصّبة: Saracensالسراسنة أو Mahometan المحمّديّين، زيادة على استخدامه عبارات من جنس The Blind Zeal of His Followers الحماسة العمياء لأتباعه، credulous Moslems المسلمين السذّج، Credulous Believers المؤمنون السذّج، كما يرد له نعوت حادّة من قبيل: Unscrupulously Adopted تبنّوها من دون ضمير، Unblushing Inventions مبتدعات قليلة الحياء، Pueril صبيانيّة.
زيادة على أنّ مؤلّفاته غصّت بعبارات النقد اللّاذعة للروايات الإسلاميّة التي عوّل عليها ولا سيّما في المواضع التي لا تنسجم مع طروحاته فغالبًا ما يحاكمها بعبارات من قبيل: Exaggerated مبالغ فيها، Extravagant Legends أساطير متطرّفة، Unfounded Traditions روايات لا أساس لها، Amplified مضخّمة، Bias And Prejudice منحازة ومجحفة، Suspect مريبة، Gross Superstition الخرافات الجوفاء، Fabrications مفتريات، Ridiculous Details التّفاصيل السّخيفة، Foolish Story قصّة حمقاء، The Fable Contains So Many Absurdities، تلفيقات تنطوي على العديد من السّخافات Childish Legends أساطير طفوليّة، Blind And Implicit Credulity الترّهات الضمنيّة العمياء، Romantic Colouring Of The Story قصص رومانسيّة ملوّنة، Fictionsوهميّة، Apocryphal ملفّقة، Fanciful خياليّة، Feeble واهنة، Groundless لا أساس لها Impugned مطعون فيها، Mythical خرافيّة.
ولم تخلُ مؤلّفاته من الأحكام والتعميمات ذات الحمولات القروسطيّة المتحاملة على الإسلام، إذ يرى في خلاصة كتابه «حياة محمّد»: «إنّ سيف محمّد وقرآنه، هما أكثر أعداء الحضارة والحريّة والحقيقة فتكًا، واللّذان لم يعرف العالم لهما نظيرًا»، ولا نعلم كيف بات القرآن عدوًّا للحضارة والحريّة، وعلى أركانه تأسّست حضارة نهل من علومها القاصي والدّاني، فضلًا عن العبارات الهجوميّة اللّاذعة ذات الصبغة الحماسيّة التبشيريّة المتعصّبة التي لا يليق أن تجد مكانًا لها في دراسة يتشدّق صاحبها بالموضوعيّة من قبيل: «الروح الهمجيّة والاستعباديّة للقرآن التي لم تمت، وانكمشت أمام نكير أوروبا».
وليس ذلك فحسب بل لم تخلُ مصنّفاته من النظرة العنصريّة الاستعلائيّة، فقد ردّد في أكثر من موضع عبارة العرق الإسلامي Moslem Race، أو عرق المحمّديّين Mohammedan Races، معتبرًا الإسلام وقفًا على العرب، والرسول صلىاللهعليهوآله مختصًّا بهم Mohammed Declared Himself A Prophet To The Arabs وعدّ العرب عرقًا متخلّفًا خشنًا غير متعلّم ليس لهم أدب ولا علم «Arabs were a people without literature or science, rude and unlearned» أو عرقًا جاهلًا شبه بربري Semi-Barbarous Race، والعرب عرق بسيط غير متطوّر Arabs, a simple and unsophisticated race، أوthe blue blood of Arabiaالدماء الزرقاء للجزيرة العربيّة.
ولم تخلُ مؤلّفاته من النظرة العرقيّة العنصريّة، على سبيل المثال لا يذكر الصحابي بلال الحبشي إلّا بعبارة Negro الزنجي، كما أن تشبيهاته لم تخلُ من المقاربات العنصريّة ولا سيّما عندما يضع الأثيوبي الأفريقي والفهد في سلّة واحدة فيرى إمكانيّة أن يغيّر الأثيوبي لونه، والفهد أن يغيّر بقع جلده ولا يرى
إمكانيّة تغيّر الشرّ في نفوس المسلمين
can the Ethiopian change his skin or the leopard his spots The evil lies deeper than that.
ويبدو أنّ ميور تعامل مع مادّة السيرة النبويّة من منظار متحيّز حاول من خلاله أن يميّز فئة دون أخرى مؤسّسًا لنظريّة الرواية العباسيّة والعلويّة الضعيفة في السيرة التي يطلق عليها العلويّات أو العبّاسيّات أو الموضوعات الزائفة Alyite or Abasside Spurious أو المفتريات العلويّة Alyite Fabrication، والنيل من الرواية الأمويّة وتاريخ الأمويّين، وبالمقابل تبجيل منزلة الإمام علي بن أبي طالب في السيرة Fabricated To Enhance The Merits of Ali.
ويذهب ميور إلى أبعد من ذلك حينما يعرب عن أسفه، لأنّ المخطوطات العربيّة الأقدم عن السيرة النبويّة دوّنت في مرحلة تجعل كل متحدّث عن معاوية مصيره الموت وتصوّر الإمام علي بأنّه أعظم الجنس البشري، ومن أمثلة ذلك رواية وفاة الرّسول صلىاللهعليهوآله في حضن الإمام علي وعدّها: «دليلًا على هذا التلفيق»، خلافًا للأمويّين الذين تبنّوا الرواية الأصيلة من وجهة نظره، ومن جملة ذلك الزهري الذي عاش في بلاط عدد من ملوك السلالة الأمويّة، وثمّة بواعث للاعتقاد بأنّ روايته غير متحيّزة.
إنّ تنزيه ميور للخطّ الأمويّ يدلّ على تعمّد إغفال الحوادث التاريخيّة لأنّ الخلفاء الأمويّين اتّخذوا موقفًا سلبيًّا من الخطّ العلويّ، وعكفوا على تضعيف كل ما يتّصل به من إسناد، وأحوال الرواة كانت تجلّيات لأحوال دُوَلِهم فلا يمكن أن يزكّى طرف من دون آخر، كما أنّ النبرة التحامليّة على الإمام علي تدلّ على إغفال
متعمّد لدوره في تاريخ الإسلام، الذي لا يختلف عليه أحد في أنّه كان بموقع القطب من الرّحى كونه أوّل مؤمن من الرجال وآخر خليفة شورى انتقلت الدولة إثره إلى عصر الوراثة، وليس من شيء أنّ محمّدًا صلىاللهعليهوآله توفّي في حجره، فقد فداه بنفسه عشية هجرته إلى يثرب، فهو ربيبه، ولا عجب أنه أغمض عينيه في حجره وليس من دليل على اعتماد مثل هذه الروايات شاهدًا على التحيّز إلّا إذا كان ميور حاضرًا يومذاك.
ولعلّ مبعث التحيّز في رؤية ميور ضدّ العلويّين، جماعة أهل الحديث؛ أو لأنّ أغلب العلماء الذين تصدّوا للمبشّرين في الهند كانوا من المجتهدين الشيعة، ولعلّ السبب الآخر أنّ الطوائف الهندوسيّة في الهند كانت أكثر تعاطفًا مع المسلمين الشيعة من المسلمين السنّة، ومن ثم فإنّ الغايات السياسيّة واضحة في محاولة تبنّي هذا الموقف غير المتوازن من المذاهب الإسلاميّة.
لكنّ نبرة العداء للمسلمين سرعان ما تغيّرت في نسيج خطابه ولا سيّما المرحلة التي تلت عودته من الهند إلى بريطانيا، فقد ظهرت بين ثنايا كتابات هذه المدّة عبارات توحي باحترام مخيّلة القارئ المسلم في المواضع التي يدعو فيها المسلمين إلى الاحتكام للقرآن الكريم التي ضمّت عبارات مثل: Noble and pious reade القارئ المتّقي النبيل أو The honest and enlightened Moslem المسلم المخلص المتنوّر True Mahometans، المحمّديّون الحقّ، Honest and enquiring Mussulman المسلم المخلص المتحرّي Devout Mahometans المحمّدون الخاشعون، وأحيانًا نراه يسعى لمداهنة القارئ المسلم بعبارة المسلمين الأذكياء في عصرنا Intelligent Moslems of the present day أو العقول الحكيمة النبيلة Wise And Noble Mind، والأدهى من ذلك أنّه سجّل إقرارًا في كتاب منارة الحق أفاد بسعيه للخروج من دائرة التحيّز والعنصريّة بكل جهده بقوله: «أنا أثق بقارئي أنّه سيصدّقني إذا أخبرته بأنّي هممت بالكتابة في هذه الأطروحة من دون
أيّ مقصد تحيّزي أو عرقي أو لرغبة في نصر في مناظرة؛ لقد سعيت بأقصى جهدي لتلافي أيّ كلمة قد تكون مسيئة».
لقد جهد ميور في أن يصطبغ خطابه بطابع موضوعي حتّى أنّه بات يتعامل مع اسم محمّد صلىاللهعليهوآله بالتسمية العربيّة: Mohammed بدلًا من Mahomet ، في المؤلّفات اللّاحقة.
ولكن على الرغم من تشدّقه بالاعتدال والموضوعيّة والحياد، فإنّه الباحث يلتمس تغيّرًا حقيقيًّا في مواقف ميور من المسائل الجوهريّة في الإسلام ولا سيّما مسألة الوحي والنبوّة، ما عدا أنّه بات يداهن المتلقّي المسلم بعد أن كان يستخفّ بعقله ويميل إلى استخدام عبارات أقلّ وقعًا، ممّا سبق، ويبدو أنّ مردّ ذلك إلى أنّ وليم ميور خرج في هذه المدّة من دائرة الصّراع الأيديولوجي المباشر في الهند، بعد أن علت أصوات الاتّهامات في بريطانيا للمبشّرين وعرّابيهم من السياسيّين على شاكلة ميور بالخروج عن سياسة الحياد الدينيّ وإثارة الأزمات. وتجدر الإشارة إلى أنّ كتابات وليم ميور لم تترك أثرًا سلبيًّا لدى مسلمي الهند فحسب بل أثارت الامتعاض في مصر وغيرها من البلدان الإسلاميّة.
2. توظيف المنهج الفيلولوجي، لتحقيق غايات أيديولوجيّة من خلال السعي إلى تأصيل المفاهيم الكلاسيكيّة عن تاريخ الإسلام بنصوص أصليّة مستمدّة من رحم الإرث الإسلامي وتقديم مادّة السيرة وفقًا لصياغات تتجاوز الحقائق العلميّة من خلال تطويع هذا المنهج بعمليّات مركّبة من التفكيك والحذف وإعادة التركيب وإقحام التأويلات سعيًا لجرف الحدث التاريخي عن مساره وتأصيله في مسار آخر
يخدم غايات سياسيّة وتبشيريّة، من خلال التحايل على النصّ أو لَيِّه أو اجتزائه، حتّى تكون متّسقة مع الأحكام القبلية المسبقة، والسعي لتوظيف المتون والشروح؛ بوصفها مصاديق لهذه الرؤية، إذ يشير إدوارد سعيد: «إنّ عمل المستشرق المحترف تجميع عناصر صورة معيّنة ثم ترميمها للشرق، والباحث هو الذي يضع الشكل السردي لها ويكفل لها الاستمرار ويحدّد معالم شخصيّتها، أي إنّه يعبّر عن ذلك بأسلوب التحايل على الشرق».
3. الإحالات القرآنيّة الخاطئة: غصّت متون ميور بالإحالات القرآنيّة الخاطئة، وعدم الدقّة في ضبط تخريج الآيات، مع استخدام نعوت السور وليس أسمائها المتداولة؛ مثل سورة بني إسرائيل، سورة الملائكة، سورة المؤمن، سورة الأسرى.
4. إيراده لروايات مجهولة السند: حيث يسجّل عليه إقحامه لكثير من الآراء من دون إحالات مرجعيّة، ومن شواهد ذلك معالجته لحادثة الغرانيق التي سيأتي الحديث عنها من خلال تصوير حالة الريبة في نفوس أصحاب الرّسول صلىاللهعليهوآله ومبلغ التهكّم الذي مثّل ردّ فعل قريش على هذه الحادثة.
5. عدم التزامه بضبط أسماء المؤلّفين: مثل ابن هشام يدعوه هشامي Hishami، أمّا ابن سعد فلم يشِر إلى كنيته بل أشار إليه بعبارة كاتب الواقدي Katib Wackidi أو Secutary Wackidi.
6. التّكرار المستمّر للمقولات: إذ نلمس أنّ كتاب «حياة محمّد» ينطوي على مادّة واسعة بسط فيها الحديث عن مصادر القرآن وشهادة القرآن عن كتب العهدين وانتشار الإسلام بواسطة الحرب ومصادر دراسة الإسلام ومنها الشعر... هذه المعالجات نلمس تكرارها في مؤلّفات لاحقة بعناوين مستقلّة وبإضافات
سطحيّة من دون الخروج عن القالب العامّ لهذه الطروحات التي أوردها بالأصل في كتابه حياة محمّد.
7. تعمّد القياس الأيديولوجي: أقرّ وليم ميور بمحاكماته لأحداث السيرة وتاريخ العرب والإسلام واستخلاص النتائج من خلال المضاهاة بين أمّة الإسلام والأمم الأخرى Judging From the Analogy of Other Nations، متجاهلًا طابع الخصوصيّة التي تتباين من خلالها الأمم من حيث الأصول العرقيّة والاجتماعي والتاريخ واللغة والعامل الاقتصادي والموقع الجغرافي والموروث الفكري والعقدي والمستوى الحضاري والبعد الزمني، بالتالي فإنّ منهج القياس في استخلاص النتائج يعد خللًا منهجيًّا في معالجة وليم ميور لأحداث السيرة.
8. الصيغ الأدبيّة والمجازيّة: لم تخلُ متون مصنّفات وليم ميور من مقاطع اصطبغت بالألوان الأدبيّة والتشبيهات المجازيّة التي تحمل بين طيّاتها رؤيةً سلبيّة ماديّة لقضيّة الوحي والنبوّة يغفل من خلالها ميور عن الأصل الإلهي ويحدّد طبيعتها الإصلاحيّة المصطنعة ومحدوديّتها الزمكانيّة، ومن أمثلة ذلك تصوّره لنبوة محمّد صلىاللهعليهوآله مثل: «إنّ الشجرة هي زرع صناعي، وبدلًا من أن تحتوي في داخلها بذرة النمو، والتكيّف مع المتطلّبات المختلفة للزمن والبيئة والظروف، وتتفتّح بأشعة الشمس الدافئة والمطر من السماء فإنها أبقت نفسها معوقة عن النمو كما قد غرست منذ اثنتي عشر قرنًا»، أو قوله: «ليس من الضروري أن ينمو الإسلام خارج الجزيرة العربيّة كنسيج بهي من خيوط حريريّة رفيعة أو كسفينة فخمة معمولة من أخشاب الغابة غير المصقولة أو كقصر مشرق ظهر وسط كُتل من الصخور الخشنة» أو في حديثه عن الرّسول صلىاللهعليهوآله: «لقد ابتكر آليّة ذات قوّة طيّعة وطاقة تكيفيّة أعاد بالتّدريج تشكيل العرق العربّي المتشرذم إلى حالة من التّناغم».
9. تقمّص الأدوار التاريخيّة: اتّبع وليم ميور في بعض معالجاته منهج التقمّص الأيديولوجي إن صحّ البيان ولا سيّما عند حديثه بصيغة الأنا عن لسان الرّسول صلىاللهعليهوآله، مفترضًا حوارًا داخليًّا كان يجول في نفس الرّسول صلىاللهعليهوآله كما في قوله: why, should not I, the Vicegerent of God لماذا لا أكون وكيلًا لله؟
I, thus acknowledged their Prophet لذلك سيعترف بي نبيًّا عليهم.
I will show to them from their own Book that they have corrupted and obscured the Truth. سأظهر لهم من خلال كتابهم بأنّهم يحجبون ويفسدون الحقيقة.
إنّ اتّباع هذا المنهج لهو دلالة جليّة على عدم التزام ميور جانب الموضوعيّة فلا يمكن لأي أحد أن يحاكي ما يجول في مخيّلة شخص آخر، وإنّ هذا النوع من الافتراضات يدلّ على سطحيّة ميور في تجسيده لشخصيّة الرّسول صلىاللهعليهوآله وفق رؤية قاصرة وتجلٍّ لصورة قديمة مشوّهة طبعت مخيّلة لم يستطع التّجرّد منها.
(137)
(139)
يعدّ المستشرق وليم ميور من طلائع المستشرقين الذين أولوا اهتمامًا بالغًا بسيرة إبراهيم الخليل وعلاقتها بالبعثة المحمّديّة الخاتمة، هذه الجذور تمثّل مباني التّصورات ومنطلقات التّشكل الأوّلي لرؤية ميور بشأن قضيّة الوحي والنبوّة، إذ تمثّل مقولة الأسطورة الإبراهيميّة Abrahamic legend عنوانًا بارزًا للرؤية التاريخيّة لمشروعيّة الوحي والنبوّة في الإسلام لدى ميور، الذي أنكر وفادة إبراهيم وزوجته هاجر وابنه إسماعيل على مكّة، والتي سيُعبّر عنها بمفهوم (الرحلة الإبراهيميّة)، لافتًا إلى: «أنّ ما يدور حول بناء الكعبة مجرّد خيال أسطوري لم يَكنْ من الضّرورة أنْ يشار إليه مطلقًا لولا الحاجة لبيان الأفكار الشعبيّة التي نجمت من جرّاء تناميها»؛ وقوله: «إنّ الروايات الإسلاميّة المتواترة حول بناء الكعبة على يدي إبراهيم وإسماعيل ليست سوى خرافة نسبت إليهما»، كما جزم ميور بأنّ إبراهيم لم يهجر زوجته وولده في وادي مكّة كما يشير المتواتر الإسلامي في هذا الصدد، بل تركهما في موضع يُدعى برّيّة فاران شمال الجزيرة العربيّة.
يبدو جليًّا أنّ وليم ميور استند في دراسته لهذه القضيّة على التفصيلات التوراتيّة لحياة إبراهيم وزوجاته وأبنائه، التي غدت حجر الزاوية في الأديان السماويّة الثلاث، ولا سيّما في قضيّة النبوّة وصلتها بذرية إبراهيم، وقضية الكعبة، قبلة الإسلام وهمزة الوصل التاريخيّة والروحيّة بين الحنيفيّة والإسلام، التي دأب ميور على تصويرها مركزًا وثنيًّا لا يمتّ لدين التوحيد بصلة، وبغية توضيح هذه المسألة يتحتّم الوقوف على جذور القضيّة وأن توضع في ميزان النقد التاريخي لبيان حقيقة مزاعم ميور من عدمها، ولا سيّما أنّ هذه المسألة تعدّ من الجدليّات التاريخيّة بين الأديان، لذا سيسعى الباحث إلى فك طلاسمها من خلال بيان رمزيّة عناصر الرحلة
ودلالتها في النص التوراتي، ضمن الرؤية المنطقيّة لبيان مرامي الرحلة الحقيقيّة من حيث الفواعل والغايات.
تذكر التوراة أنّ إبراهيم حينما تطاول به العمر، ولم يرزق بمولود طلبت منه سارة أن يتزوّج من جاريتها هاجر المصرية التي رزقه الله منها بإسماعيل، فلما حملت هاجر دبّت عقارب الحسد والغيرة في صدر سارة، فأنزلت النوازل بهاجر؛ ما حملها على الهرب، ولم يكن لإبراهيم أن ينصف زوجته أم ولده، بل نراه يطلق العنان لسارة في ظلم هاجر: «فَلَمَّا رَأَتْ أَنَّهَا حَبِلَتْ صَغُرْتُ فِي عَيْنَيْهَا يَقْضِي الرَّبُّ بَيْنِي وَبَيْنَكَ، فَقَالَ أَبْرَامُ لِسَارَايَ: هُوَذَا جَارِيَتُكِ فِي يَدِكِ افْعَلِي بِهَا مَا يَحْسُنُ فِي عَيْنَيْكِ فَأَذَلَّتْهَا سَارَايُ، فَهَرَبَتْ مِنْ وَجْهِهَا».
لكن سرعان ما رزق إبراهيم بولده إسحاق وهو في عمر المائة من زوجه سارة التي ناهزت التّسعين من عمرها، فلمّا رأت سارة أنّ ابن جاريتها يشاطر ولدها في حقوق أبوّته من إبراهيم، ضاقت ذرعًا بإسماعيل وأمّه فطلبت من إبراهيم أن يطردهما بعيدًا: «اطْرُدْ هذِهِ الْجَارِيَةَ وَابْنَهَا»، ودون أدنى جريرة عدا أنّها لا ترغب في أن يرث مع ولدها: «وَرَأَتْ سَارَةُ ابْنَ هَاجَرَ الْمِصْرِيَّةِ الَّذِي وَلَدَتْهُ لإبراهيم يَمْزَحُ، فَقَالَتْ لإبراهيم اطْرُدْ هذِهِ الْجَارِيَةَ وَابْنَهَا، لأنّ ابْنَ هذِهِ الْجَارِيَةِ لاَ يَرِثُ مَعَ ابْنِي إِسْحَاقَ»، فامتثل إبراهيم لرغبة سارة وهو لا يلوي على زوجته وابنه البكر فطردهما؛ فلم يزوّدهما إلّا بقربة بماء وبعض الخبز، فتاهت هاجر مع إسماعيل في البريّة حتّى كاد يجهز عليهما العطش لكن العناية الإلهيّة كانت أسبق فجاءها
ملاك الربّ بالبُشرى بنبع الماء ومن ثم غدت هذه الأرض المجدبة التي تدعى فاران وطنًا لإسماعيل وأمّه هاجر: «وَكَانَ يَنْمُو رَامِيَ قَوْسٍ وَسَكَنَ فِي بَرِّيَّةِ فَارَانَ».
يقابل الرؤية التوراتية ما ورد في القرآن الكريم على لسان إبراهيم في قوله: (رَّبَّنَا إِنِّي أَسْكَنتُ مِن ذُرِّيَّتِي بِوَادٍ غَيْرِ ذِي زَرْعٍ عِندَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمِ رَبَّنَا لِيُقِيمُوا الصَّلَاةَ فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ وَارْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ) (سورة إبراهيم: الآية 37)، وقد ورد في صحيح البخاري عن ابن عباس قوله: «أنّ الله (عزّ وجل) أوحى لإبراهيم بالمسير إلى بلد الله الحرام، فحمل ابنه الرضيع إسماعيل، وهاجر خلفه، وليس بمكّة يومئذ أحد، وليس فيها ماء ولا عمارة ولا زراعة ووضع عندهما جرابًا فيه تمر، وسقاء فيه ماء، ثم قفى إبراهيم منطلقًا فتبعته أم إسماعيل فقالت: يا إبراهيم أين تذهب وتتركنا بهذا الوادي الذي ليس فيه إنس ولا شيء فقالت له ذلك مرارًا وجعل لا يلتفت إليها فقالت له: آلله الذي أمرك بهذا قال نعم قالت إذن لا يضيّعنا ثم رجعت فانطلق إبراهيم حتّى إذا كان عند الثنية من حيث لا يرونه استقبل بوجهه البيت ثم دعا بهذه الكلمات ورفع يديه فقال: (رَّبَّنَا إِنِّي أَسْكَنتُ مِن ذُرِّيَّتِي بِوَادٍ غَيْرِ ذِي زَرْعٍ) وجعلت هاجر ترضع إسماعيل وتشرب من ذلك الماء حتّى إذا نفذ ما في السّقاء عطشت وعطش ابنها وجعلت تنظر إليه يتلوّى فإذا هي بالملك عند موضع زمزم فبحث بعقبه حتّى ظهر الماء فجعلت تحوضه وتقول بيدها هكذا وجعلت تغرف من الماء في سقائها وهو يفور بعد ما تغرف فشربت وأرضعت ولدها فقال لها الملك لا تخافوا الضيعة فإنّ ها هنا بيت الله يبني هذا الغلام وأبوه وإنّ الله لا يضيّع أهله».
ولدى المقابلة بين هاتين الرؤيتين نرى أنّ التّوراة صوّرت إبراهيم بنحو يجعله رازحًا تحت وطأة سارة مستسلمًا لرغباتها، فهي التي تقوم بتزويجه وفقًا لمشيئتها، حتّى إنّه عندما ظهرت على وجهه ملامح الأسى بعد أن أمرته بطرد هاجر ووليدها،
جاء الخطاب السماوي يأمره أن لا يأسى لأمر الجارية والغلام وأن يذعن لأمر سارة: «فَقَبُحَ الْكَلاَمُ جِدًّا فِي عَيْنَيْ إبراهيم لِسَبَبِ ابْنِهِ فَقَالَ اللهُ لإبراهيم لاَ يَقْبُحُ فِي عَيْنَيْكَ مِنْ أَجْلِ الْغُلاَمِ وَمِنْ أَجْلِ جَارِيَتِكَ فِي كُلِّ مَا تَقُولُ لَكَ سَارَةُ اسْمَعْ لِقَوْلِهَا»، الأمر الذي يتعارض مع العدالة الإلهيّة التي لا تميّز بين البشر، ويبدو أنّ التجنّي في النصّ التوراتي لم يطل هاجر وإبراهيم فحسب، بل طال سارة التي صوّرتها بهذه الحال من التسلّط وقسوة القلب.
لقد أورد العهد القديم على لسان سارة صيغة فعل الأمر «اطْرُدْ» ولم تشِر إلى صيغة «تخلّص من هذه الجارية وابنها»، فإن كانت المسألة معقودة على إرضاء النّساء وهواجسهنّ كما صوّرت التوراة، كان حريًّا بإبراهيم أن ينزل هاجر وإسماعيل في موضع بعيد عن سارة وذرّيتها شريطة أن يكون موضعًا لا يخلو من العمران؛ إنّ المطّلع على هذه القصّة يبدو له أنّ إبراهيم أراد الإجهاز عليهما بنفيها إلى موضع يخلو من آثار الحياة، وذلك يتعارض مع خِلال إبراهيم التوراتيّة التي تسامت به إلى حدّ أن ظهر له الله (عزّ وجل) وليبلغ مرتبة الكمال «وَلَمَّا كَانَ أَبْرَامُ ابْنَ تِسْعٍ وَتِسْعِينَ سَنَةً ظَهَرَ الرَّبُّ لأَبْرَامَ وَقَالَ لَهُ: أَنَا اللهُ الْقَدِيرُ سِرْ أَمَامِي وَكُنْ كَامِلًا».
إنّ تحكيم العقل في قضيّة من هذا النوع تحملنا إلى الريبة في شخصية إبراهيم ولا سيّما وأن شخصًا بسجاياه لا يمكن أن يقدم على ترك امرأة وطفل في صحراء مقفرة فذلك فعل بمنتهى القسوة؛ إلّا إذا كانت المسألة تحمل خصوصيّة من نوع نادر وتمثّل وجهًا من أوجه التجلّي الإلهي للإنسان فهذا شأن آخر يخرج عن دوائر النقاش العُقلائي، وكما جرت الأحداث بنحو مماثل في قصّة الذبيح التي انتهت بمشهد من هذا القبيل عندما أوحى الله (عزّ وجل) إلى إبراهيم بذبح ولده البكر قربانًا لله.
لذلك يبرز جليًّا أن الأمر الذي حمل إبراهيم على هذا الأمر العظيم هو ذات الأمر الذي حمله على محاولته نحر ولده؛ أي الامتثال لأمر إلهي وليس امتثالًا لرغبات سارة، وهذا يحاكي الرؤية الإسلاميّة بهذا الصدد.
لقد كانت الغاية من الرحلة كما أورد القرآن الكريم إقامة شعائر العبادة في منطقة البيت الحرام الذي خرّبته طسم وجديس، ولكي يجعل الله سبحانه قلوب الخلق تحنّ إلى ذلك الموضع ليكون في ذلك أُنس ذرّيته بمن يرد من الوفود ويدر أرزاقهم على مرور الأوقات.
إنّ محور الجدل في هذه القضيّة يكمن في تعيين الموضع الحقيقي الذي آلت إليه أحداث الرحلة، إذ تذكر التوراة أنّ هاجرًا استقرت مع إسماعيل في موضع فاران، بينما تذهب الروايات الإسلاميّة إلى أنّ إبراهيم أسكنهما في مكّة، على الرغم من عدم ذكر القرآن الكريم موضع الإسكان بنحو صريح؛ لكن دلّ عليه بقوله: (بِوَادٍ غَيْرِ ذِي زَرْعٍ عِندَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمِ ) (سورة إبراهيم: الآية 37)، ويبدو أنّ صلة مكّة وكعبتها بإبراهيم لم تكن قضيّة خلافيّة في تصوّرات المعاصرين للوحي، لكن وليم ميور عدّ غياب التّشديد النصّي في القرآن نقطة جوهريّة يمكنه النفاذ منها لنسف هذا التّصور وإنكار اللبنة التوحيديّة التي أرساها إبراهيم في مكّة وأتمّها الرّسول صلىاللهعليهوآله برسالته الخاتمة، وبغية تحديد هذا الموضع سنبسط في بيان موضع فاران التوراتي الذي عوّل عليه ميور في رؤيته التاريخيّة لهذه القضيّة.
فاران وأَلِفها الأُولَى لَيْسَت بهَمْزَة، اسْمٌ لِجبالِ مكّة بالعبرانِيّة، أطلقه عرب الشمال على البرّية الشاسعة الممتدة من العَقـَبة حتّى مشارف اليمن على طول البحر الأحمر، التي وسمها العرب المتأخّرون بالحجاز لاحقًا تضمّ سلسلة جبال السراة؛ وقد أطلقت العرب البائدة على الحجاز «فاران» نسبة إلى أحد زعماء العرب العماليق، المسمى فاران بن عمرو بن عمليق بن لود بن سام بن نوح؛ وتمثل جبال فاران أرض مكّة وموضع البيت العتيق، إذ يتّفق البلدانيّون على وجود ثلاثة مواضع تحمل تسمية فاران: الأولى في الحجاز وهي اسم لجبال مكة؛ والثانية قرية من نواحي صغد من أعمال سمرقند؛ والثالثة كورة من كور مصر القبليّة، وثمّة رأي مؤدّاه أنّ فاران كانت مدينة من مدن العماليق.
تقع على تل بين جبلين، وهناك من يرى أنّ فاران؛ الصحراء الفسيحة التي تمتدّ باتجاه الشمال وتقع عليها مكّة المكرمة، وقد أخذت تسميتها من فاران بن عوف بن حمير الذي عاش قرابة عام 1778ق.م من الطوفان، أي بنحو 30 سنة قبل ولادة إبراهيم تقريبًا.
بريّة فاران، البريّة وتطلق على الأرض الخربة غير الصالحة لشيء، أو الصحراء أو أي أرض مقفرة غير معمورة، وردت كلمة «فاران פאךנParan» اثنتي عشرة مرّة في أسفار العهد القديم، وعادة ما ترد الكلمة مسبوقة بالحرفین «ھ ر» أي «ھار فاران הךפאךנ» في النسخ الأصليّة وكلمة «ھار» عند علماء اللغة العبریة تعني صیغة مختصرة من الجذر «ھرر הךך»، غیر المستخدم في العبرية، الذي عادة ما يترجم إلى اللغة الإنكليزيّة بصيغة «إیل فاران EL-Paran»، أمّا «إیل EL» فتترجم بدورها إلى اسم الجلالة الله فیكون منطوق العبارة «فاران الله» بمعنى أنّ التسمية تنسب إلى الله (عزّ وجل).
ولعلّ هذا المعنى يتّسق مع أن الكعبة بيت الله؛ وجاء في قاموس الكتاب المقدّس: «أنّ فاران بريّة تقع إلى جنوب يهوذا إلى الشرق من برية بئر سبع وشور بين جبل سيناء وكنعان».
وورد في دائرة المعارف الكتابية أنّ فاران: «تعني الموضع المغاير؛ بريّة شاسعة تقع في أقصى جنوبي فلسطين ويرجّح كثير من العلماء أنّها كانت تقع في الشمال الشرقي من شبه جزيرة سيناء، ويرى البعض أنّها برّية التيه، في وسط هضبة سيناء، ويقول روثنبرج (Rothenberg) في كتابه «برّية الله» إنّ برّيّة فاران كانت الاسم القديم لكلّ شبه جزيرة سيناء في العصور الكتابية»، ويرد في القاموس العبري اليوناني للكتاب المقدس رأي مخالف مؤدّاه أنّ فاران تقع في صحراء العرب، وقد أورد الكاتب اليهودي حسيب شحادة في معرض تعليقه على نسخة الترجمة العربيّة للتوراة السامرية على أنّ فاران هي أرض الحجاز.
وورد في سفر العدد في تحديد موضع فاران أنّها تقع في شبه جزيرة سيناء بعد حضيروت، «ارْتَحَلَ الشَّعْبُ مِنْ حَضَيْرُوتَ وَنَزَلُوا فِي بَرِّيَّةِ فَارَانَ»، وورد في سفر
التثنية أنّ فاران تقع في الأردن: «هذَا هُو الْكَلاَمُ الَّذِي كَلَّمَ بِهِ مُوسَى جَمِيعَ إِسْرَائِيلَ، فِي عَبْرِ الأُرْدُنِّ، فِي الْبَرِّيَّةِ فِي الْعَرَبَةِ، قُبَالَةَ سُوفَ، بَيْنَ فَارَانَ وَتُوفَلَ».
وحدّد سفر صموئيل موقع فاران في محيط معين والكرمل في منطقة الجبل من أرض يهوذا التي وردت في قصة داود مع نابال، فبعد موت صَمُوئِيلُ، «فَاجْتَمَعَ جَمِيعُ إِسْرَائِيلَ وَنَدَبُوهُ وَدَفَنُوهُ فِي بَيْتِهِ... وَقَامَ دَاوُدُ وَنَزَلَ إلى بَرِّيَّةِ فَارَانَ»، وتشير التوراة إلى أنّ داود لما سمع بأمر نابال ويومها كان في فاران أرسل إليه عشرة غلمان «فَسَمِعَ دَاوُدُ فِي الْبَرِّيَّةِ أَنَّ نَابَالَ يَجُزُّ غَنَمَهُ فَأَرْسَلَ دَاوُدُ عَشَرَةَ غِلْمَانٍ»، ويرد في تفسير هذا الإصحاح أنّ نابال كان أحد أصحاب القطعان وكان يقيم في بلدة معون، «وكان يرعى قطعانه في الكرمل وكان غنيًّا جدًّا، وكان عنده زوجة اسمها أبيجايل أرسل إليه داود يطلب أكلًا، لأنّ رجال داود حموا المنطقة فرفض نابال وصرفهم بغضب، فأخذ داود أربعمائة من جنوده واتّجه نحوه ليستولي على ما يريد بالقوّة فأخبر أحد عمال نابال زوجته لذلك أسرعت وحملت طعامًا بكميّات وفيرة، وأخذتها إلى داود وطلبت الصفح عن زوجها معتذرة عنه فرضي داود عنها، وقبل هديّتها، وعفا عن زوجها».
ولعلّ هذا النصّ يرجّح أنّ موضع بريّة فاران المجدبة التي نفيت إليها هاجر وإسماعيل هي ليست بريّة فاران التي نزل إليها داود وكان له فيها مقام وحاشية يرسلهم وجنود يقومون بحماية المنطقة ويأمرهم بتأديب من يخالف أوامره.
ويرد في دائرة معارف الكتاب المقدّس وتحت موضوع فاران ما نصّه: «ليس من اليسير علينا فهم جميع فقرات العهد القديم ذات الصلة بموضع فاران»، وقد
تتبّع الباحث هذه القضيّة في عدد من الخارطات القديمة والنادرة للمنطقة، وظهر أن الجغرافيّين كانوا يعيّنون موضع فاران في الجزيرة العربية في منطقة الحجاز إلى الجنوب من سيناء في الصحراء العربية حتّى القرن 12ه/ 18م؛ مع ملاحظة أنّ جزيرة العرب في أغلب هذه الخارطات تمتدّ لتشمل منطقة شبه جزيرة سيناء، ويلحظ أنّ موضع فاران في هذه الخارطات يعدّ الأقرب بالنسبة لموضع مكّة الحالي من الموضع الذي يعيّنه علماء الكتاب المقدّس.
ليس ذلك فحسب، بل يبدو أنّ ثمّة موضع جديد لفاران خارج شبه جزيرة سيناء كشف عنه الباحث ستيف رود Steve Rudd في خريطته التي رسمها لتتبع خط سير رحلة الخروج (التيه الشهيرة لبني إسرائيل) الواردة في سفر الخروج من العهد القديم.
والأعجب من ذلك أنّ التّناقض في تحديد موضع فاران وصل إلى متون الكتاب المقدّس، إذ ورد في الترجمات العربية للعهد القديم في سفر صموئيل أن داود نزل إلى فاران بعد موت صموئيل، في الوقت الذي تذهب بعض الترجمات الإنكليزيّة للكتاب المقدّس إلى عد داوود نزل في صحراء معون:
«Now Samuel died، and all Israel assembled and mourned for him; and they buried him at his home in Ramah. Then David moved down into the Desert of Maon»
كما أنّ بعض التّرجمات الإنكليزيّة المعتمدة تذهب إلى اعتماد المعنى ذاته في الترجمات العربيّة، وترى أن داود نزل على فاران:
«Now Samuel died, and all Israel assembled and mourned for him; and they buried him at his home in Ramah. Then David moved down into the Desert of Paran»
لقد وردت في نسخة ماثيوبول Matthew Poole (1624-1672م) لتفسير الكتاب المقدّس الصادرة عام 1700م وعام 1853م، ونسخة جون ويسلي John Wesly (1703-1791م)، ونسخة جون جل GillJohn (1697-1771م): «إنّ فاران الواردة في سفر التثنية ليست الموضع ذاته الواردة في سفر العدد الإصحاحان 10 و12 وإنّ فاران الأخرى تقبع في مكان آخر بعيد جدًّا وإنّ ثمّة أماكن تحمل تسميات مماثلة»، كما ورد في تفسير آدم كلارك ClarkeAdam (1762-1832م) للكتاب المقدّس شهادة تضعف الدلالة الجغرافيّة التوراتيّة لموضع فاران في العهد القديم جاء نصها: «لا يمكن أن تكون فاران المجاورة للبحر الأحمر، التي لا تبعد شيئًا عن جبل حوريب ذلك الموضع الذي يقع على حدود أرض الميعاد على بعد شاسع من الموضع سابق الذكر كما يرد في العهد القديم».
ومن بين الآراء المخالفة للرؤية الكتابيّة المتداولة وردت شهادة على لسان يوسيوس Eusehius في بيان موقع فاران أشار إليها محرّر الموسوعة بأنّها مثيرة للدهشة وجاء نصّها: «إن فاران بلدة تتاخم الجزيرة العربيّة من جهة الجنوب على مسيرة ثلاثة أيام من بيت المقدس شرقًا لتبلغ الجزيرة العربيّة»؛ كما زاد جيروم Jerome على ذلك قائلًا: «إنّ الأرض التي تجاور جبال وصحراء العرب تدعى فاران».أمّا عن
إسماعيل فلم تأتِ التوراة على تفاصيل عن حياته بعد فاران، عدا أنّه حضر جنازة أبيه إبراهيم، وأنّه توفي وانضم إلى قومه: «وَهذِهِ سِنُوحَيَاةِ إِسْمَاعِيلَ مِئَةٌ وَسَبْعٌ وَثَلاَثُونَ سَنَةً، وَأَسْلَمَ رُوحَهُ وَمَاتَ وَانْضَمَّ إلى قَوْمِهِ» وعلى الرغم من ذلك لم يعثر الباحث على إشارة تدلّ على موضع قبر إسماعيل بين قومه ولم نجد له ذكرًا في مقبرة مكفيلة التي ضمّت مدافن إبراهيم وسارّة وإسحاق ورفقة وليئة ويعقوب الذي يفترض أن يعرف من خلالهم على غرار بقيّة أسرته، ولعلّ عبارة «وَانْضَمَّ إلى قَوْمِهِ» التوراتيّة لا تعني الالتحاق المكاني، بل الانتقال إلى العالم الغيبي بدليل أنّها وردت أيضًا في موضع وفاة إبراهيم وفاة إسحاق اللذين توفيا في حبرون في فلسطين.
كذلك تذكر التوراة أنّ إسحاق توفّي وقام ولديه عيسو ويعقوب بمراسيم دفنه، ويبدو أنّ إسماعيل توفّي قبل إسحاق الأمر الذي يحملنا على الريبة في إغفال التوراة مشاركة إسحاق في جنازة أخيه إسماعيل أو دفنه في مدفن العائلة، ولا سيّما أنّ التوراة لا تذكر وجود أيّ قطيعة بين إسحاق وإسماعيل، والإشارات الواردة في سفر العدد وسفر التثنية وسفر صموئيل عن موضع فاران، تفيد بأنّها كانت في المحيط الجغرافي لفلسطين، إلّا إذا كان مدفن إسماعيل في مكان آخر بعيدًا عن أخوته، هذا المكان هو مكّة عند المشعر الحرام تَحْتَ الميزاب بَيْنَ الركن والبيت؛ كما تُجمع على ذلك المصادر الإسلاميّة.
أمّا أبناء إسماعيل فلم ترد في التوراة إشارة إلى سكنهم في أرض سيناء بل أوردت أنّ موضع استيطانهم يمتدّ بين حويلة وشور باتّجاه مصر، «أمّا حويلة فمقاطعة في بلاد العرب، يسكن بعضها الكوشيّون ويسكن البعض الآخر اليقطانيّون وهم شعب
من أصول سامية والصلة بين حويلة وحضرموت وأماكن أخرى تشير إلى موقع في وسط البلاد العربيّة أو جنوبها؛ ولا يعرف إلى أي حدّ كانت تمتدّ الحويلة شمالًا، كما أن قسمًا من الصحراء العربيّة، يمتدّ عدّة مئات الأميال شمال اليمامة ويحمل اسم حويلة»، ولعلّ الكوشيّين هم الأحباش، واليقطانيّين هم القحطانيّون، وربّما أنَّ قسمًا من الصحراء العربيّة يمتدّ عدّة مئات الأميال شمالي اليمامة ويحمل اسم حويلة، ويبدو أنّ الموقع التقريبي لموضع حويلة، في المنطقة الممتدّة من القسم الغربي لجزيرة العرب شمالي اليمن؛ لأنّه لا يدلّ على اسم مدينة أو نقطة جغرافيّة توضع على الخريطة، بل تمثّل على الأغلب منطقة تمتدّ من شمالي اليمن بنحو عدّة مئات من الأميال شمالًا على الجزء الغربي لجزيرة العرب، وهذه المنطقة هي بعينها المنطقة المعروفة باسم الحجاز، ومن أشهر مدنها مكّة المكرّمة.
ويبدو أنّ ذكر «حويلة» بين العرب اليقطانيّين يحمل على الظنّ بأنّه كانت هناك حويلة في الجزيرة العربيّة، وقد اكتشفت بعض النقوش في جنوبي الجزيرة العربيّة في المنطقة باسم «خولان»، وما زال هناك مكان بهذا الاسم في منطقة تهامة، وكذلك في الجنوب الشرقي من صنعاء، كما يشير سترابو إلى موضع آخر باسم «حويلة» في البحرين على الخليج، ولعلّ معظم المخطوطات القديمة تضع موقع حويلة في الجزء الغربي من شبه الجزيرة العربيّة شمال اليمن، وأنّها تمتد من شمال اليمن وإلى عدة مئات من الأميال شمالًا على الجزء الغربي لجزيرة العرب، وثمّة رأي مؤدّاه أن حويلة تقع في اليمن نظرًا لورود اسم مؤسّسها حويلة بن يقطان في تخوم اليمن، ولعلّ البلدانيّون والمؤرّخون المسيحيّون أخطؤوا في تعيينهم موقع «حويلة» في منطقة فم الفرات في الشمال.
أمّا «شور» فاسم عبري معناه «سور»، أو موضع في البريّة جنوب فلسطين، «وعلى طريق شور وجد الملاك هاجر على عين الماء في البرّيّة؛ فكان طريقًا للقوافل، يمتد من بئر سبع إلى مصر، وفي وقت من الأوقات سكن إبراهيم بين «قادش وشور، كما أنها كانت موطن الإسماعيليّين الذين سكنوا من حويلة إلى شور»، وقد تمّ العثور على مدينة شور في أقصى الجنوب الغربي، بعد الاستعانة بالاكتشافات الآثارية الحديثة، إذ كانت مدينة شور من أشهر المدن القديمة شرقي اليمن.
ويبدو أنّ علماء التوراة وقعوا في خطإ آخر بظنهم أنّ «شور» تقع إلى الغرب من البتراء، وقد ورد في النسخة العبرية الأصلية أنّ موضعي «شور שור» و«اشورאשור» ذكرتا دون كلمة «صحراء יְשִׁימוֹן» لذا تكون الأولى «سوريا» والثانية «بلاداشور» ولعلّ ذلك يرجح أنّ الإسماعيليّين استقروا في الفسحة الممتدّة من الحدود الشماليّة لليمن حتّى تخوم سوريا الجنوبيّة هذه المساحة تمثّل الحجاز.
أمّا «اشور» فينقطع عليها الاتّفاق أنّها تقع في شمال العراق في الجزء الأعلى من نهر دجلة وعليه فإنّ إسماعيل وبنيه قد سكنوا في تلك البلاد الممتدّة جنوب الحجاز وشماله، أو أنّ منازلهم كانت شمالي اليمن في تهامة والحجاز، وما وراء ذلك شمالًا إلى مشارف الشام.
كما يرد تعليق في التّرجمة اليسوعيّة للكتاب المقدّس جاء نصه: «أحفاد إسماعيل عرب الصحراء وحياتهم حياة التّرحال والاستقلال وهذا ما يذكرنا بالعصر الجاهلي».
أو كما ترد في لسان العرب القديم، الذي يعدّ المعين الأصلي للغة العبريّة، فتعدّ فاران صيغة تثنية من فار أو فارّ، بمعنى الفارَّان من مكان إلى مكان أو المهاجران مع ملاحظة الفرق؛ فالفارّ يخرج من مكان إلى مكان آخر بفعل فاعل، والمهاجر هو الخارج من مكان إلى آخر طواعية وهاتان الصفتان نلمسهما في حالة هاجر وابنها إسماعيل.
ويبدو أنّ ما ذهب إليه البلدانيّون في أول اسم سميت به بلاد العرب «عرابة» صحيح، وقد أصاب هذا الاسم التّحريف على مرّ الزمن، فأصبح بلاد العرب، وقد تبع ذلك أن سُمّي الشعب باسم العرب نسبة إلى بلادهم، هذا وتعني كلمة «عرابة» في اللغات السامية صحراء، ومعنى هذا اللفظ في العبريّة حقل أو غابة، وفي العربيّة تقرن بحياة البدو؛ ولذا سمّيت هذه البلاد باسم بلاد العرب، وعرف أهلها تدريجيًّا باسم العرب، لأنّ بلاد العرب في مجموعها صحراء أو غابة عديمة الماء والمرعى، ولا سيّما تلك البقعة التي تمتد بين الحجاز وسوريا وطور سيناء، ولم يذكر القرآن كلمة عرب في سياق حديثه عن بلاد العرب، فقد أشار إلى إسماعيل في بعض مواضعه، أنّه نزل «بواد غير ذي زرع»، فيبدو أنّ القرآن الكريم وصف ما كان يسود من ظروف طبيعيّة لاتّفاق هذا مع معنى كلمة عرابة؛ ولما كانت البقعة التي نزل فيها إسماعيل، لا تحمل اسمًا فقد أطلق عليها «واد غير ذي زرع»، وقد استخدمت كلمة مدبار بالعبريّة «חידבךMidbar» في النّسخة العبريّة للعهد القديم للإشارة إلى موطن إسماعيل، وهذه الكلمة تعني الصحراء أو الأرض القاحلة التي تقابل الوصف القرآني لهذا الاسم .
ويبدو أنّ ثمة تعمّدًا لمحو الأحداث التي وقعت في منطقة الحجاز ونقل ما لم يمكن محوه منها شمالًا إلى فلسطين، اعتمادًا على الخريطة التي رسمها بعض الباحثين في جامعة إسرائيل في طبعة عام 1977 بغية تصوير أحداث التوراة جغرافيا؛ ولعلّ الأمثلة في الملحق (17) تدعم فرض ازدواج أسماء المواقع بفعل
هجرات مبكّرة أو بفعل ظاهرة بشريّة، تؤدّي إلى الاستدلال على ظهور حضارات عربيّة في منطقة الحجاز في المواقع ذات الأسماء المتشابهة بما في ذلك الأماكن الأصليّة بمكّة وما حولها؛ وأنّ هذه الهجرات أدّت إلى نزوح قبائل بأكملها شمالًا باتّجاه فلسطين والشام فأطلقوا على مناطق التّجمع في المهجر أسماء ترتبط بمسقط رأسهم وأنسابهم ومقدّساتهم.
ومن بين الدراسات التي تحاكي هذا الرأي دراسة كمال صليبي المثيرة للجدل حول أصل اليهود التي تقوم على أنّ أحداث العهد القديم وقعت في جنوب غربي الجزيرة العربيّة، في منطقة جبال عسير، وأنّ البيئة التاريخيّة للتوراة نشأت بداية على الساحل الشرقي للبحر الأحمر وليس في فلسطين، وتحديدًا في بلاد السراة بين الطائف ومشارف اليمن، وتبعًا لذلك فإن اليهوديّة نشأت في عسير ثم انتشرت إلى أطراف الجزيرة العربيّة ومنها فلسطين، وتستند هذه النظريّة على المقاربات اللغويّة بين اللغتين العربيّة والعبريّة بين مسمّيات البلدان. إنّ وجود منطقة اسمها فاران في جنوب سيناء لا يمنع وجود فاران أخرى، فقد ورد مثلًا إطلاق اسم سعير على المنطقة التي تقع في أرض أدوم التي تقع حاليًّا في الأردن، وتكرّر ذلك في مواضع عديدة في الكتاب، ولم تمنع كثرتها أن يطلق الاسم ذاته على جبل في وسط فلسطين غربي القدس في أرض سبط يهوذا، وقد ورد في القاموس العبري أنّ هنالك أرضًا اسمها سبأ غير سبأ اليمنيّة وبها جبل اسمه المروة.
وثمّة قرينة تدعم موقف الباحث، في دلالة معنى الجنوب الواردة في العهد القديم في وصف خطّ سير الرحلات الإبراهيميّة: «فَصَعِدَ أَبْرَامُ مِنْ مِصْرَ هُو وَامْرَأَتُهُ وَكُلُّ مَا كَانَ لَهُ، وَلُوطٌ مَعَهُ إلى الْجَنُوبِ وَكَانَ أَبْرَامُ غَنِيًّا جِدًّا فِي الْمَوَاشِي وَالْفِضَّةِ وَالذَّهَبِ وَسَارَ فِي رِحْلاَتِهِ مِنَ الْجَنُوبِ إلى بَيْتِ إِيلَ، إلى الْمَكَانِ الَّذِي كَانَتْ خَيْمَتُهُ
فِيهِ فِي الْبَدَاءَةِ، بَيْنَ بَيْتِ إِيلَ وَعَايَ، إلى مَكَانِ الْمَذْبَحِ الَّذِي عَمِلَهُ هُنَاكَ أَوَّلًا وَدَعَا هُنَاكَ أَبْرَامُ بِاسْمِ الرَّبِّ»، «ثُمَّ ارْتَحَلَ أَبْرَامُ ارْتِحَالًا مُتَوَالِيًا نَحْو الْجَنُوبِ»، ويبدو أنّ الغاية من هذه الرحلة الجنوبيّة كانت بلوغ بيت إيل ليقوم إبراهيم بالدعاء باسم الربّ، فإذا بدأت الرحلة طريقها متّخذة اتّجاه الجنوب فإنّه من المؤكّد وجود بيت إيل في اتّجاه الجنوب؛ وإلّا لا معنى لسير القافلة جنوبًا وبيت إيل في أقصى شمال شرق حدود مصر الشرقيّة أي في فلسطين كما يرى أهل التوراة.
أمّا عن بئر الماء التي اقترن ذكرها مع قصّة إسماعيل في العهد القديم أو بئر زمزم كما يعرفها المسلمون، إذ أشارت التوراة أنّ إبراهيم ترك هاجر وإسماعيل في برية (بئر سبع) قبل أن ينتهي بهم المقام إلى فاران: «فَبَكَّرَ إبراهيم صَبَاحًا وَأَخَذَ خُبْزًا وَقِرْبَةَ مَاءٍ وَأَعْطَاهُمَا لِهَاجَرَ، وَاضِعًا إِيَّاهُمَا عَلَى كَتِفِهَا، وَالْوَلَدَ، وَصَرَفَهَا، فَمَضَتْ وَتَاهَتْ فِي بَرِّيَّةِ بِئْرِ سَبْعٍ» وتسمية «بئر السبع» تعود إلى إبراهيم الذي حفرها بسبب إعطاءه سبع نعاج لأبي مالك، شهادة على حفره لهذه البئر، وهناك مكث إبراهيم مدّة طويلة ومن بعده رجع إسحاق إلى الموضع نفسه وجدّد البئر وأطلق اسم البئر على المدينة التي نشأت حولها وتبعد عن حبرون نحو ثمانية وعشرين ميلًا جنوبًا.
ويبدو جليًّا أنّ ثمّة اضطراب في نصوص العهد القديم لأنّ تسمية (بئر السبع)
أو بئر السبعة جاءت من النعاج السبعة أو قصّة إبراهيم وأبي مالك سابقة الذكر؛ بالتالي فقد وردت تسمية البئر نفسها في قصة هاجر التي تعود إلى حادثة وقعت لاحقًا ولم يكن قد تمّ تسمية المكان بهذا الاسم أصلًا في قصّة هاجر ولا سيّما أنّه لم يرد في الكتاب المقدّس موضع آخر يحمل التّسمية نفسها، الأمر الآخر كيف تاهت هاجر في صحراء واسعة وعرف إبراهيم مكانها لاحقًا؟ فإذا كان إبراهيم قد حفر بئرًا في برّيّة بئر السبع، لذا سيتوافر مصدر للمياه في هذه البقعة، فلماذا يترك إبراهيم زوجته وابنه في منطقة مقفرة وفي أحد جوانبها بئر ماء حفرها بنفسه، فحري به أن ينزلهم على أدنى تقدير في موضع ذلك البئر، وإذا سلّمنا بذلك فتكون البئر مألوفة لهاجر على فرض أنّها تعود إلى إبراهيم، لكن البئر ليس لإبراهيم: «وَفَتَحَ اللهُ عَيْنَيْهَا فَأَبْصَرَتْ بِئْرَ مَاءٍ».
وعند العودة لمناقشة النّصوص التوراتيّة الواردة في هذه القضيّة نلمس اضطرابًا واضحًا في سياق الأحداث ولا سيّما في عمر إسماعيل الذي أشارت إليه التوراة بأن هاجر كانت تحمله وقربة الماء على كتفها ومن ثم طَرَحَته تَحْتَ إِحْدَى الأَشْجَارِ، وبعد أن ظهر لها ملاك الرب قال لها: قُومِي احْمِلِي الْغُلاَمَ فلا يعقل أن يكون هذا الغلام هو إسماعيل، لأنّ إسماعيل كان في سن 16 على أدنى تقدير؛ فإسماعيل كان عمره 14 سنة عندما ولد إسحاق، وقد جرى طرد هاجر بعد فطام إسحاق ولا يتمّ فطام الأطفال إلّا بعد عامين كما هو متّفق عليه، وصفوة القول: إنّ البرّيّة التي نزلت بها هاجر قد أخذت تسميتها من حدث وقع لإبراهيم لاحقًا، وأنّ ثمّة اضطرابًا مختلقًا في سياق النّصوص لتشتيت القارئ عن مسار هاجر وإسماعيل، وأنّ البئر المقدّسة هي في موضع غير الموضع الذي حفر فيه إبراهيم بئر القسم.
أمّا كلمة زمزم فقد وردت باللغة العبريّة بصيغة «זחזח» والنسبة إليها زَمْزُمى
فى صيغة الأفراد، وزَمْزُميون فى صيغة الجمع، وفي العربيّة نلفظها زَمْزَمىّ وزَمْزَميون ولعلّ اللغة العبريّة تميل إلى الضَّمّ على خلاف العربيّة التي تميل إلى الفتح في معظم كلماتها، فكلمة زَمْزَمْ في العربيّة تُقرأ في العبريّة زُمْزُمْ بضم الميم الأولى والثانية وأحيانًا تلفظ زَمْزُمْ بفتح الميم الأولى وضمّ الثانية وهذا التّشكيل مُغرض يهدف إلى تشتيت المعنى للكلمة غير العبريّة، ويرد في قاموس الكتاب المقدّس أن الزمزميّين اسم سامي معناه متزمرون أو صانعوا الضجيج وهم شعب أقدم من الكنعانيّين كانوا طوال القامة أشدّاء البأس يقطنون الأرض شرقي الأردن والبحر الميت، وكانوا يدعون بالوفائيّين أو الزوزيّون، إنّ هذا القول يعود إلى العماليق الذين تزوّج منهم إسماعيل وأقاموا إلى جواره حول ماء زمزم.
ويُعد المستشرق زتلن Zeitlin من بين الذين راجعوا قضيّة الرحلة الإبراهيمية ويرى أنّه: «ليس ثمّة أيّ سبب يدعو للريبة في إجماع المؤرّخين المسلمين وتأكيدهم على رحلة إبراهيم إلى مكة»، كما يرتاب محمّد حسين هيكل من وجهة نظر وليم ميور حول هذه القضية قائلًا: «إنّ السير وليم ميور والذين ارتأوا في هذه المسألة رأيه يقولون بإمكان انتقال جماعة من أبناء إبراهيم وإسماعيل بعد ذلك من فلسطين إلى بلاد العرب واتّصالهم وإيّاهم بصلة النّسب فكيف لا يكون جائزًا في شأن الرجلين بالذات؟».
وصفوة القول: إنّ عدّ الرحلة الإبراهيميّة أسطورة يمثّل خللًا تاريخيًّا في خطاب ميور ولا سيّما وأنّه أسّس هذا الخطاب على مرتكزات توراتيّة تقضي بأنّ إبراهيم كان دائم التّرحال، لذا فإنّ عدم الإشارة إلى موضع مكّة في التوراة لا يعني أنّه لم يشرع بزيارتها، فالتوراة لم تشِر إلى جميع تفصيلات سِنِي حياة إبراهيم الخمس
والسبعين بعد المائة، رغم تقديمها لجانب من خط سير رحلاته؛ كما لم تذكر بعض الأنبياء مثل صالح وهود وذا الكفل وغيرهم من الأنبياء، لقد كان إبراهيم صاحب دعوة دينيّة وليس في المصادر الإسرائيليّة ما يدلّ على أنّه صنع شيئًا لنشر دعوته وكل ما ورد عنه أنّه أقام مذبحًا في كلّ منزل من منازل الطريق ثم ترك البلاد جميعًا في رعاية الأحبار الذين كانوا مؤمنين «بايل عليون» قبل وفادته إلى كنعان وليس ذلك مقنع لصاحب دعوة دينيّة يغادر دياره في سبيل هذه الدعوة.
كذلك لا يمكن عدّ رحلته صوب مكّة أسطورة؛ لأنّ الأسطورة هي الخبر المكتوب الكاذب والخرافة؛ بما تمثّله من قصّة متواترة عن الأبطال والآلهة، وهي حكايات القدماء في الدّين، وصورة من صور الفكر البدائي لديهم، ليست بمنزلة العقيدة الدينيّة؛ وإنّما تشبه حكايات الكهّان، وتتّخذ شكل الروايات، وتدور حول الأصنام، وتمثّل تراث القبائل، فكانت تحلّ محل المصاحف المكتوبة، وتمثّل بالنسبة للعرب آراء البداوة التي تطرق ذهن الجاهليّ لأنّها قديمة العهد وبعيدة عن الوضوح، ووفقًا لذلك لا يمكن أن نعدّ رحلات إبراهيم أسطورة لأنّ مبعث الخلاف في التوراة إشكاليّة زيارته لمكّة. لذا فإنّ ميور لا يملك حجّة قويّة من شأنها أن تزيح الجذور التاريخيّة لمدينة ذات صبغة عالميّة؛ كمكّة، يقوم تاريخ وجودها على زيارة إبراهيم لها، وعدها حكاية أو أرجوزة من أراجيز الشعراء والكهنة.
إنّ وليم ميور قد ضلّ السبيل بإنكاره حقيقة الرحلة الإبراهيميّة المقدّسة صوب مكّة المكرّمة التي تمثّل الركيزة الأساس لبذرة التوحيد في الجزيرة العربيّة وخطّ المشروع الذي اختطّه إبراهيم وكانت خاتمته على يد محمّد صلىاللهعليهوآله لقد حاول ميور استبدال مكّة الإسلاميّة بفاران التوراتيّة ولعلّ الدلالة بينهما واحدة. لقد تجلّت الحكمة الإلهيّة بأن يكون موضع فاران في التوراة أشبه بأحجية على خلاف الأماكن
والمواضع التي وردت في الكتاب المقدّس التي لم ترد بصيغة ثابتة لكي تحمل القارئ إلى التّأمل والتحرّي في دلالتها الجغرافيّة، ومن المآخذ الأخرى التي تسجل على وليم ميور في عرضه لهذا الموضوع أنّه لم يخضعه للمنهجيّة العلميّة التحليليّة ولم يتجشّم عناء استقصاء المعلومات التاريخيّة والجغرافيّة لموضوع بهذه الخطورة، ولم يقم وزنًا للمصادر الإسلاميّة، متبنّيًا طروحات جاهزة، فأتت معالجاته بالكامل في هذا الموضوع على شكل محاكمة مصمّتة من زاوية توراتيّة لا يخلو جوهرها من الاضطراب وعدم الاتّساق، إذ كان شحيحًا في نقاشه لهذه الرحلة فلم يشِر إليها إلّا في سطور نزرة متغافلًا عمدًا عن جميع الإشارات التي ترجّح النظريّة الإسلاميّة حولها.
وصفوة القول: كيف أضحت تسمية مكّة بديلًا عن تسمية فاران؟ وإذا كان موضع البئر المقدّسة في بريّة بئر السبع ومن ثم غدت برية فاران الأرض التي ترعرع بها إسماعيل، والمعنى واحد وفقًا للتصوّرات الإسلاميّة ومضطرب ويلفه الغموض وفقًا للتصوّرات التوراتيّة التي عوّل عليها ميور، والقضيّة برمّتها بحاجة إلى أدلّة إضافيّة ولا يملك الباحث إلّا الأدوات المنهجيّة والنّصوص المتداولة التي حاول من خلالها تصويب مزاعم ميور عن عدم صلة الإسلام بدين إبراهيم، فإنّ العمق الديني والتجاري عبر العصور جعل صفتها تحلّ بديلًا عن تسمية المنطقة جغرافيا.
ذكر ميور: «إنّ مكّة تدين في أصلها وأهميّتها إلى موقعها المميّز لأنّها تتوسّط الطريق بين اليمن والبتراء فكان خط القوافل التجاريّة بين الشرق والغرب ينتقل خلال الجزيرة العربيّة وكان وادي مكّة يقع على الطريق الغربي المعتاد»، ويرى أيضًا: «أنّ وفرة مياهها جذبت القوافل التجاريّة؛ ما جعلها محطّة استراحة لتلك القوافل وغدت تدريجيًّا مركزًا تجاريًّا».
إنّ جميع الطروحات الإسلاميّة تتفق على أنّ الباعث الجوهري لقيام مكّة هو الباعث الديني بعد أن كانت أرضًا مجدبة غير مأهولة بالسكان؛ إذ كانت وفادة الأسرة الإبراهيمية عليها بمثابة خط الشروع لبدء تاريخها، إن أوّل نواةٍ قرآنيّة تنتظم حولها الرؤية الإسلاميّة بشأن مكّة جاءت في قوله تعالى: ( إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا وَهُدًى لِّلْعَالَمِينَ) (سورة آل عمران: الآية 96) وقد أجمع المفسّرون على أن الكعبة أول بيت وضع لعبادة الله في الأرض، إذ نقل الأزرقي: «خلق الله تعالى هذا البيت قبل أن يخلق شيئًا من الأرضين»، ويشير الفاسي أنّـها بنيت عشر مرات: أولّها بناء الملائكة، وثانيها بناء آدم، وثالثها بناء شيت بن آدم، ورابعها بناء الخليل إبراهيم، ونقل العمري خلق الله البيت قبل الأرض بألفي سنة، فلمّا حدث الطوفان بقي موضع البيت خرابًا ألفي سنة حتّى
أمر الله تعالى إبراهيم أن يبنيه مع ابنه إسماعيل فتتبع أثرًا بعد ذلك فبناه على أساس قديم كان قبله فذلك، وقد تولّى إبراهيم وإسماعيل تشييد البيت الحرام كما جاء في قوله تعالى: (وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا ۖ إِنَّكَ أَنتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ) (سورة البقرة: الآية 127)، ثم أوحى الله تعالى إلى إبراهيم أن يدعو الخلق إلى العبادة وتقديس هذا الموضع وإقامة شعائر الحج ليكون موضعًا للسجود والطواف قائلًا: (وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَن لَّا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ ﴿٢٦﴾ وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِن كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ) (سورة الحج: الآيتان 26-27)، لمّا شهد إبراهيم قيام البلد واطمأنّ قلبه دعا الله تعالى أن يجعله آمنًا: (وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُم بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۖ قَالَ وَمَن كَفَرَ فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا ثُمَّ أَضْطَرُّهُ إِلَىٰ عَذَابِ النَّارِ ۖ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ) (سورة البقرة: الآية 126).
ويرى ريتشارد بوليت Richard W. Bulliet الذي انصرف لدراسة طرق الشرق قائلًا: «إنّ مكّة لم تكن يومًا على طريق التّجارة الرئيسيّة بين اليمن والشام لأنّها تقبع بعيدًا على حافة شبه الجزيرة العربيّة»، ويؤيّد هذا الرأي كلًّا من كروم Groom ومولر Muller، اللذين استشهدت بهما لاحقًا المستشرقة باتريشيا كرون Patricia Crone لما وجدت أن مكّة لم يكن من الممكن أن تكون محطّة تجاريّة في وسط طريق القوافل لأنّ هذا يتضمّن انحرافًا عن طريق التجارة الطبيعي، لأنّ مكّة كانت تبعد عن طريق تجارة البخور بنحو مائة ميل في موضع مجدب، وعادة لا تشكّل المواقع المقفرة محطات للاستراحة ولا سيّما مع وجود مواقع خصبة بالجوار، كمدينة الطائف التي بوسعها أن توفّر جميع متطلّبات القوافل من المؤن.
إن مكّة المكرّمة قامت على أسس دينيّة بحتة؛ فالكعبة كانت العامل الرئيس
لنشوئها ومن ثم صار لها أهميّة (دينيّة-تجاريّة) بنحو تدريجي، فكان تعظيم العرب للبيت الحرام فاعلًا جوهريًّا في قيامها، وإنّ طقوس الحج الإبراهيميّة جعلت من المدينة مركز استقطاب ديني الأمر الذي أدّى إلى تنامي الحركة التجاريّة في هذه المدينة، بعد تفجر بئر زمزم الذي حمل الوافدين على المنطقة لحفر آبار أخرى في الجوار.
يرى بعض العلماء المسلمين أنّ ما ورد في سفر التثنية وسفر حبقوق بشارة بمحمّد صلىاللهعليهوآله تتّصل بمكّة المكرّمة: «جَاءَ الرَّبُّ مِنْ سِينَاءَ، وَأَشْرَقَ لَهُمْ مِنْ سَعِيرَ، وَتَلأْلأَ مِنْ جَبَلِ فَارَانَ»، «الله جاء من تيمان والقدوس من جبل فاران» أي جاء أمر الله وشرعه من طور سيناء وهو الجبل الذي كلّم الله موسى عنده وأشرق من سعير وهي جبال بيت المقدس التي كان بها عيسى واستعلن أي ظهر وعلا أمره من جبال فاران، وهي جبال الحجاز بلا خلاف، ولم يكن ذلك إلّا على لسان محمّد صلىاللهعليهوآله فذكر تعالى هذه الأماكن الثلاثة على الترتيب الوقوعي، ذكر محلّة موسى، ثم عيسى، ثم بلد محمّد صلىاللهعليهوآله .
وإلى ذلك يشير رحمة الله الهندي قائلًا: «لا شك أن إسماعيل كانت سكونته بمكّة، ولا يصحّ أن يراد أنّ النار لما ظهرت من طور سيناء ظهرت من ساعير ومن فاران أيضًا فانتشرت في هذه المواضع، لأنّ اللّه لو خلق نارًا في موضع، لا يقال
جاء اللّه من ذلك الموضع إلّا إذا أتبع تلك الواقعة وحي نزل في ذلك الموضع أو عقوبة أو ما أشبه ذلك، وقد أقروا أن الوحي اتّبع تلك في طور سيناء فكذا لا بد أن يكون في ساعير وفاران ومضمون هذه البشارة موافق لمضمون قوله تعالى: (وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ ﴿1﴾ وَطُورِ سِينِينَ ﴿2﴾ وَهَٰذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ) (سورة التين: الآيات 1-3) ففيه إشارة لأماكن بعث الأنبياء الثلاثة ولما كان في القرآن التعظيم تدرج من أدنى إلى أعلى لأن رسالة موسى أعظم من رسالة عيسى ورسالة محمّد أعظم من رسالتيهما كذلك مكّة أقدس من سيناء والقدس ولما كان المقصود في التوراة الخبر التاريخي ذكرت هذه الأماكن مرتبة حسب زمان بعثة الأنبياء».
كما ترد أيضًا بعض الإشارات التوراتيّة التي تنطوي على دلالات رمزيّة تشير إلى مكّة، كما في نسخة الملك جيمس من الكتاب المقدس: «مَا أَحْلَى مَسَاكِنَكَ يَا رَبَّ الْجُنُودِ تَشْتَاقُ بَلْ تَتُوقُ نَفْسِي إلى دِيَارِ الرَّبِّ قَلْبِي وَلَحْمِي يَهْتِفَانِ بِالإِلهِ الْحَيِّ. الْعُصْفُورُ أَيْضًا وَجَدَ بَيْتًا، وَالسُّنُونَةُ عُشًّا لِنَفْسِهَا حَيْثُ تَضَعُ أَفْرَاخَهَا، مَذَابِحَكَ يَا رَبَّ الْجُنُودِ، مَلِكِي وَإِلهِي. طُوبَى لِلسَّاكِنِينَ فِي بَيْتِكَ، أَبَدًا يُسَبِّحُونَكَ. سِلاَهْ. طُوبَى لأُنَاسٍ عِزُّهُمْ بِكَ طُرُقُ بَيْتِكَ فِي قُلُوبِهِمْ عَابِرِينَ فِي وَادِي الْبُكَاءِ As they pass through the Valley of Baca».
والغريب في الأمر أنّ الترجمات الإنكليزية للنص تكتب اسم بكا «Baca» على حاله ولا يترجم معناها إلى «وادي البكاء» كما في النسخ العربيّة الأمر الذي يثير الريبة، والأغرب أن صيغة المزمور (84: 6) وردت متغايرة في نسخ الكتاب المقدّس على النحو الآتي:
1. وادي بكا «Valley of Baca» في نسخة جون ستيرلنغ لسنة 1954 وسنة 1956.
2. وادي بكا «Valley of Baca» في نسخة العالمية الجديدة «NIV» لسنة 1978.
3. وادي العطشى «Valley of Thirsty» نسخة أكسفورد طبعة الولايات المتحدة 1976.
4. وادي الدموع «Valley of Tears» في نسخة Douay Rheims Bible.
5. وادي أشجار البلسم «Valley of Balsam-trees» نسخة Bible In Basic English.
وبغية الفصل في هذه القضيّة استنتج علماء التوراة أن «وادي البكا» تعني «وادي أشجار البكا» أي «أشجار البيلسان أو البلسم» إذ تنطق الكلمتان بالنطق بنفسه باللغة العبريّة، أو الوادي الذي تكثر فيه أشجار البلسم ويبدو أنّه لا توجد علاقة بين اسم بكة وبين أشجار البلسم فلا يمكن التوفيق بين هذه الترجمة وبين التراجم الأخرى إلّا في حالة واحدة وهي أنّ جميع الرموز المذكورة تنطبق على مكّة المكرّمة فالعطشى هما هاجر وإسماعيل، أمّا عن الدموع فلا يوجد مكان على وجه الأرض يماثلها في اجتماع النّاس للبكاء طلبًا للمغفرة، أمّا شجر البلسم أو شجر البكّا، فقد أقرّ قاموس الكتاب المقدّس بوجوده قرب مكّة في وادي الرفائيّين أو العماليق.
وبذلك أضحت الرمزيّة التفسيريّة في حق مكّة المكرّمة جلية، وثمّة دلالة أخرى، هي دلالة الأمن «حتى طائر السنونو وجد فيها مكانًا آمنًا» كما يرد في المزمور أعلاه ولا يمكن أن تكون صفة الأمن متوفّرة في بيت المقدس التي شهدت عبر تاريخها العديد من الانتهاكات والمعارك مالم تشهده مدينة على وجه الأرض كالمذابح التي أحدثها الأشوريّين والفراعنة والبابليّين والرومان ثمّ الفرس في الوقت الذي بلغت فيه حرمة مكّة منزلة أنّ الرجل يلقى في الحرم قاتل أبيه فلا يرفع نظره إليه.
وورد أيضًا دلالة رمزيّة أخرى في سفر أشعياء: «قُومِي اسْتَنِيرِي لأَنَّهُ قَدْ جَاءَ نُورُكِ، وَمَجْدُ الرَّبِّ أَشْرَقَ عَلَيْكِ لأَنَّهُ هَا هِيَ الظُّلْمَةُ تُغَطِّي الأَرْضَ وَالظَّلاَمُ الدَّامِسُ الأُمَمَ أَمَّا عَلَيْكِ فَيُشْرِقُ الرَّبُّ، وَمَجْدُهُ عَلَيْكِ يُرَى فَتَسِيرُ الأُمَمُ فِي نُورِكِ، وَالْمُلُوكُ فِي ضِيَاءِ إِشْرَاقِكِ اِرْفَعِي عَيْنَيْكِ حَوَالَيْكِ وَانْظُرِي. قَدِ اجْتَمَعُوا كُلُّهُمْ. جَاءُوا إِلَيْكِ. يَأْتِي بَنُوكِ مِنْ بَعِيدٍ وَتُحْمَلُ بَنَاتُكِ عَلَى الأَيْدِي حِينَئِذٍ تَنْظُرِينَ وَتُنِيرِينَ وَيَخْفُقُ قَلْبُكِ وَيَتَّسِعُ، لأَنَّهُ تَتَحَوَّلُ إِلَيْكِ ثَرْوَةُ الْبَحْرِ، وَيَأْتِي إِلَيْكِ غِنَى الأُمَمِ تُغَطِّيكِ كَثْرَةُ الْجِمَالِ، بُكْرَانُ مِدْيَانَ وَعِيفَةَ كُلُّهَا تَأْتِي مِنْ شَبَا تَحْمِلُ ذَهَبًا وَلُبَانًا، وَتُبَشِّرُ بِتَسَابِيحِ الرَّبِّ كُلُّ غَنَمِ قِيدَارَ تَجْتَمِعُ إِلَيْكِ كِبَاشُ نَبَايُوتَ تَخْدِمُكِ تَصْعَدُ مَقْبُولَةً عَلَى مَذْبَحِي، وَأُزَيِّنُ بَيْتَ جَمَالِي».
يمكن ملاحظة الدلالات الرمزيّة التي تشير إلى مدينة يأتي إليها الناس من جميع الأرجاء وتنحر فيها الأضاحي من جمال مدين وعيفة وشبا تشمل الجزء الغربي لشبه الجزيرة العربيّة من خليج العقبة شمالًا حتّى أقصى الجنوب في اليمن بمحاذاة البحر الأحمر أي إقليم الحجاز كاملًا وغنم قيدار، وكباش نبايوت وهما أبناء إسماعيل كما تشير التوراة ، ولعلّ المقصود هنا القبائل العربيّة من نسل قيدار ونبايوت أجداد الرسول صلىاللهعليهوآله، زد على ذلك أنّه ليس لليهود لأن الوصف المذكور خارج النطاق الجغرافي لمنطقة قداستهم وهي أورشليم؛ كذلك بالنسبة للمسيحيّين لأنّهم لا يقدّمون الأضاحي كعادة المسلمين لأنّهم يعتقدون بتضحية المسيح.
(169)
يزعم ميور أنّ تاريخ الكعبة ليس له صلة بنبي الله إبراهيم، لأنّ الكعبة وفق تصوّراته؛ كانت تجسّد مركزًا لعبادة وثنيّة قديمة أسّسها الوثنيّون وسمها: «عبادة الكعبة Worship of Kaaba»، وقد عوّل ميور في رأيه هذا على بعض الذرائع التاريخيّة هي الآتية:
أورد ميور شهادة المؤرخ الإغريقي هيرودوتس، الذي ذكر أنّ: «تبجيل العرب لعبادة الأصنام يرجع في جذوره إلى فترة تاريخيّة مبكرة، فكانت اللات Alilat إحدى الآلهة العربيّة الرئيسة في الجزيرة العربيّة».
لا خلاف على أنّ الجزيرة العربيّة كانت تغص بالوثنيّة، لكن ذلك لا يعني أنّ الكعبة كانت مركزًا لها، أو كونها ليست من بناء إبراهيم وإسماعيل، ولا سيّما وأن شهادة هيرودوتس تُعدّ متأخّرة، إذا أخذ في الحسبان الفارق الزمني بين إبراهيم الذي عاش في القرن التاسع عشر قبل الميلاد وبين هيرودوتس، أي بنحو أربعة عشرة قرنًا، كذلك لم تتضمّن شهادة هيرودوتس إشارة إلى أصول الكعبة أو إشارة إلى مكّة،
ولم تحدّد الأصول الوثنيّة في بلاد العرب أو تاريخها؛ فكانت شهادة هيرودوتس تتمحور بشأن إعجابه باحترام عرب الجزيرة العربيّة لمواثيقهم في معرض حديثه عن حملة قمبيز، لغزو مصر إذ: «أرسل قمبيز إلى العرب لطلب المرور الآمن عبر أراضيهم وقبل العرب رجاءه وتعاهدوا على ذلك، فالعرب قوم يحفظون العهود أكثر من سواهم وصيغة العهد لديهم عندما يتعاهد اثنان على الصداقة يقفان مواجهان بعضهما الآخر وبينهما ثالث ويقوم الثالث بعمل قطع بيد كل منهما من الداخل بالقرب من الأصبع الوسطى ويأخذ قطعة من ثوبيهما ويغمسها بدم كل منهما ويقوم بترطيب سبعة أحجار بالوسط وهو يقوم في أثناء ذلك بالدعاء لباخوس Bacchus وأورانيا Urania، وكانوا يدعون باخوس بلغتهم أوروتالت Urotalt وأورانيا Urania يدعونها اللات Alilat».
زد على ذلك فإن هيرودوتس لم يشرع بزيارة مكّة لكي تكون شهادته موضع احتجاج، إذ يشير هويلاند Hoyland: «إنّ هيرودوس كان قليل العلم باللغة العربيّة ولم يثبُت أنه قام بزيارة إلى الجزيرة العربيّة التي كانت بالنسبة له تمثّل أرض الأساطير وأرض الأفاعي الطائرة ذات الأجنحة والثعابين الخبيثة»، ويشير دلمان Dahlmann إلى إنّ مصادر هيرودوتس عن الجزيرة العربيّة متأتية من مصادر سماعية وليس من المشاهدة العينيّة المجردة، وشدّد دلمان على أن هيرودوتس لم تطأ أقدامه أرض الجزيرة العربيّة كما يبدو من تاريخه، وما يعزّز هذا الرأي أن حملة مصر وقعت في عام 525ق.م، وفي الوقت الذي تجمع أغلب المصادر التاريخيّة على أن هيرودوتس عاش بين الأعوام (484 -425 ق.م) أي بعد قرن من الزمن وهذا ما يعزّز رأي هويلاند ودلمان بشأن عدم زيارة هيرودوتس إلى المنطقة العربيّة.
كما إن إشارة هيرودوت بشأن باخوس «إله الخمر عند الرومان، وأورانيا آلهة الإلهام عند الإغريق، أو أورتوالت التي ترمز إلى عبادة الشمس، واللّات التي ترمز إلى عبادة القمر في لغة السبئيّين، أو كما ذهب إليه رينه ديسو René Dessu إلى أنّها لا تمثّل الشمس وإنّما تمثّل كوكب الزهرة، ترجح أنّ هيرودوتس كان يقصد عبادة اللّات في مناطق تقع إلى الشمال من مكّة، ولعلّها منطقة البتراء؛ إذ لم يُعثر في المصادر على ما يثبت أن قبائل وسط الجزيرة العربيّة كانت تقدّس الآلهة الرومانيّة، التي كانت تقدّس في منطقة الهلال الخصيب وبلاد الشام، وقد ذُكر أن هنالك معبد للإله «ذو الشرى Dushare» بمدينة البتراء، يدعى بيت الرب أو رب البيت وهي التسمية التي أطلقها النبط على إلههم، وقد نعت «رب بيت ذي الشرى» بـ «الذي يفرق الليل عن النهار، يقابل الإله باخوس Bacchus» في رأي الكتبة اليونان واللاتين، وصفوة القول: لا يمكن الاحتجاج بشهادة هيرودوتس لأنّه لم يشرع بزيارة منطقة مكّة أمّا بسبب عدم شروعه برحلة أو أن مشاهداته اقتصرت على الأقسام الشماليّة من الجزيرة العربيّة.
الذريعة الأخرى لميور كانت شهادة ديودورس الصقلي إذ يرى: «أن ديودورس تحدّث عن الجزء الذي غمرته مياه البحر الأحمر من الجزيرة العربيّة؛ فذكر في
ذلك البلد معبدًا كان يبجل بإجلال من جانب العرب، أن عبارة ديودورس تشير حتمًا إلى البيت الحرام في مكّة وحسب علمنا ليس ثمّة معلم آخر دونه توجّهت إليه وجوه المبايعين بمثل هذه العالميّة في الجزيرة العربيّة».
من الناحية التاريخيّة لا يمكن أن يُعول على شهادة ديودورس الصقلي لأنّها تعد متأخّرة جاءت قبل نصف قرن من ولادة المسيح حسب ميور، كما لم يرد في هذا النص إشارة تاريخيّة مباشرة بشأن مكّة أو عن طبيعتها الدينيّة، ما عدا الإشارة إلى الموضع الذي تنظر إليه العرب بإجلال الذي وجد ميور أنّه ينطبق على مكّة، ولدى الاحتكام إلى شهادة ديودورس الأصليّة، يتّضح أنّه لم يشر إلى اسم المعبد ولا مكانه، كما أنّه أطلق على المنطقة تسمية أرض الحملات ووصفها بأنّها: «منطقة غنيّة بينابيع المياه باتت سببًا في نشوء المراعي الخصبة التي تزخر بالنبات الطبيّة ونبات اللوتس الذي يصل طوله إلى حد طول الشخص البالغ؛ هذه المراعي تؤوي ما لا حصر له من الماشية والجمال البريّة والغزلان التي تجذب إليها الحيوانات المفترسة كالأسود والذئاب والفهود وهنالك تنتشر الشعاب الصخريّة، يطلق على سكانها «البينزوميين» Banizomenes الذين يحصلون على قوّتهم من صيد الحيوانات البريّة، وهنالك يوجد المعبد المقدّس الذي ينظر إليه جميع العرب بأعلى مراتب الإجلال وتتّصل هنالك ثلاث جزر مع سواحل الطرق الساحلية المؤديّة إلى هذه المسالك التي تكسوها أشجار الزيتون المنتشرة هنا وهناك وهي أشجار مختلفة عن الأشجار المألوفة».
إن شهادة ديودورس عن جغرافيّة المنطقة تخالف الطبيعة الجغرافيّة لمكّة، لأنّها لا تقع أمام سواحل وثلاث جزر؛ والمعالم الجغرافيّة الواردة ليس فيها سمات المناطق الصحراويّة الداخليّة، فضلًا عن أن نباتات اللوتس والزيتون تنمو في المناطق الرطبة وليست في
المناطق الجافة، وصفوة القول: إنّ هذه المعالم توحي بموضع آخر، ويرجّح الباحث أن ديودروس قدّم وصفًا للأقسام الشماليّة والشماليّة الغربيّة من الجزيرة العربيّة.
أمّا سكان المنطقة الذين وسمهم الصقلي بالبينزوميّين Banizomenes فيرجّح فوستر Forster أنّهم قبيلة بني عمران البحريّة، بسبب التّشابه بين أسمائهم وأسماء سكّان هذه المنطقة التي كانت تقطن الساحل الغربي من الجزيرة العربيّة باتّجاه الشمال من البحر الأحمر، وفي الجبال الواقعة بين العقبة والمويلح، على الساحل الشرقي للبحر الأحمر أو الساحل الشرقي لخليج العقبة، ولعلّ وصف الجزر الثلاث المجاورة، يتطابق تمامًا مع خليج المويلح، والجزر الثلاث قباله إلى الجنوب، وهم قبائل معروفة بشراستها، ومن خلال مطالعة الباحث لكتب الأنساب لم يُعثر على أي قبائل تدعى بنو عمران، تقطن منطقة مكّة أو حتّى إلى جوارها، ويرى جرجي زيدان أنّهم «بني زومين» أو بقايا قبيلة جرهم، ويبدو أن قبيلة بني عمران كانت قبيلة مجهولة الأصل، كانوا يزعمون انحدارهم من سلالة الأشراف، نزحوا من منطقة مصر ولعلّهم كانوا يرتبطون ببني عمران الذين كانوا يستوطنون قرب العقبة، ويبدو من المتعذر أن تطبق شهادة ديودورس على مكّة لأن الموضع الذي يقع فيه المعبد بعيد عن مكّة في منطقة «حسمى» في موضع يدعى روافة أو غوافة.
ويبدو أن وليم ميور سلك منهجًا إسقاطيًّا عندما عدّ هذا المعبد هو الكعبة على أساس أنّه كان يحاط بالقداسة من لدن العرب، متجاهلًا أنّ الجزيرة العربيّة كانت تضمّ عددًا من الكعبات، التي كان ينظر إليها بتبجيل من قبل الوثنيين،
أمّا المعبد الذي انطوت عليه شهادة ديودورس، فقد ورد في هذه المنطقة التي ذكرها معبد الأقيصر الذي أشار له ياقوت الحموي، ولعلّه الكعبة الأرجح موضعًا في محيط المنطقة: «فقد كان لقضاعة ولخم وجذام وعاملة وغطفان صنم في مشارف الشام يقال له الأقيصر وكان حوله تسبيح وتهليل وكانوا يحجون إليه ويحلقون رؤوسهم عنده».
كذلك فإن ديودورس لم يشِر إلى أي مظهر وثني في عبادات البينزوميّين Banizomenes، إذ أورد إشارات تاريخيّة عن طقوس قريبة من بعض عادات الحج المألوفة لدى المسلمين؛ كطقوس النحر وتقديس مياه الآبار قائلًا: «وكانوا يقيمون احتفالًا كل خمس أعوام في بلاد النخيل وكانت القبائل تجتمع فيه من جميع الأصقاع، التي كانت تقوم بنحر الجمال إلى ربّ النّماء، وبعد نهاية الاحتفال كانوا يصطحبون معهم شيئًا من ماء الينابيع التي توجد هناك إلى بلادهم لأنّهم كانوا يتبركون بها وكانت بالنسبة لهم بمثابة علاج»، وفي ذلك يرى هيكل قائلًا: «إنّ ورود إشارات عن العبادات الوثنيّة في شبه الجزيرة العربيّة عند هيرودوتس وثيودورس الصقلي برهان على أن دين إبراهيم لم يستقر فيها طويلًا».
وصفوة القول إنّ شهادة ديودورس الصقلي لا يمكن أن يعوّل عليها أيضًا لعدم ورود أيّة إشارة مباشرة عن مكّة أو محيطها، أو بفعل التّباين بين شهادة الصقلي وبين طبيعة مكّة الصحراويّة، لقد ذهب ميور إلى توظيف النّصوص السابقة لتكون متلائمة مع نظريّته من خلال الربط بين مكانة الكعبة وبين شهادات متأخّرة للجغرافيّين الإغريق متغافلًا عن البون الزمني الواسع بين طرفي نظريّته، الأمر الذي يعدّ خللًا منهجيًّا، نجمت عن محاولة لتسطيح المفاهيم لكي تكون متّسقة مع الموروث الأيديولوجي.
الذريعة الثانية لوليم ميور لإنكار صلة الكعبة بنبيّ الله إبراهيم كانت المنظومة الوثنيّة في الجزيرة العربيّة التي تتألّف من ثلاثة عبادات؛ وهي الآتية:
يرى وليم ميور وجود صلة بين طقوس العبادة الصابئيّة Sabeanism أو عبادة الأجرام السماوية وبين عبادة الكعبة، حيث يقول: «إن انتشار الصابئيّة في بلاد العرب منذ أواخر القرن الرابع الميلادي أدّى إلى انتشار طقوس تقديم الأضاحي إلى الشمس والقمر والنجوم في بلاد اليمن»، ويرى أيضًا: «أنّ عدد مرات الطواف السبعة حول الكعبة تمثّل تجسيدًا لعدد دورات الأجسام السماويّة»، فالعدد سبعة من منظار ميور: «خرافة مقدّسة تُجسّد عدد مرات الطواف حول الكعبة وعدد مرات السعي بين الصفا والمروة»، ويرى: «أن الحجر الأسود الذي يقدّسه المسلمون خلال شعائر الحج يمكن أن يكون نيزكًا»، ويفترض: «أنّ هذه الطقوس نَشأتْ في الجزيرة العربيّة لبواعث خارجيّة مرتبطة بمنظومة لعبادةِ الأصنام التي كانت سائدة في جنوب شبهِ الجزيرة العربيّة جلبتها معها القبائل المهاجرة مِنْ اليمن نحو مكّة» وصفوة القول: إنّ طقوس الحج التي أرساها إبراهيم، والتي غدت لاحقًا ركنًا من أركان الإسلام، تمثّل جزءًا من عبادة نجميّة أو عبادة وثنيّة يمنيّة قديمة لا تمتّ إلى إبراهيم بصلة في رؤية ميور.
لا شكّ في أنّ تقديس العرب للكواكب والنجوم والشمس والقمر حقيقة ثابتة
بنص قرآني: (وَأَنَّهُ هُوَ رَبُّ الشِّعْرَىٰ) (سورة النجم: الآية 49) التي يقول عنها المفسّرون أن المقصود بها «الكوكب الذي خلف الجوزاء» وقد نهاهم القرآن عن السجود لهذه الأجرام السماويّة وأمرهم بالسّجود لله تعالى وحده: ( وَمِنْ آيَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ ۚ لَا تَسْجُدُوا لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَمَرِ وَاسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَهُنَّ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ) (سورة فصلت: الآية 37)، لكن عدّ هذه العبادة حجّة على الأصل الوثني للكعبة بدعوى الصلة بين شعائر الحج وبين هذه العبادة النجميّة يعد أمرًا مختلفًا، إذ يشير بينوك Pinnock أنّ كلمة Sabeanism تمثّل أقدم ديانة وثنيّة معروفة عنيت بعبادة الأجرام السماويّة ترجع ممارستها إلى القبائل العربيّة، ولدى الرجوع إلى معنى الكلمة نلمس أنّها ذات أصول سامية zaba abost كانت تستخدم للتعبير عن الجذور الأولى للشرك أو للتدليل على توجّه الإنسان لعبادة الشمس والقمر والنجوم التي كانت تدعى مضايف السماء، وتوارث النّاس هذه العبادة عبر أحفاد نوح، وتتمحور أفكارها حول دور الشمس في النهار والقمر في الليل وحول سطوة النور الكبرى للشمس وسطوة النور الصغرى للقمر التي اعتقدت العقول البدائية بألوهيّتها وأنّ لها التأثير الشامل على مخلوقاتها، إذ نشأت الصابئية أوّل الأمر عند الأكديّين وسرعان ما عرفها المصريّون ومنهم انتقلت إلى الإغريق، وكما كان السومريّون يرفعون الصروح لرصد الكواكب واستطلاع الطريق وكانت هياكلهم ترصد الأرباب السماويّة ونصب فيها التماثيل بأسمائها، وأشهر الكواكب التي عبدت بعد الشمس والقمر كوكب الزهرة عشتار وكوكب المريخ مردوخ.
ويرى باركرز Parkes أن عبادة الكواكب والنجوم ديانة عالميّة انتشرت بنحو
خاص بين المصريين والهنود القدامى، وكانت الموضوع الأوّل الذي عرفه الكلدانيّون والبابليّون الذين عبدوا الشمس بمسميات بيل Bel ومثرى Mithra، ويعتقد فليبس Phillips أنّها ظهرت في الجزيرة العربيّة على يد سبأ saba الذي أطلق على نفسه خادم الشمس، لكن فيلبس لم يفصل في دلالة سبأ ومدى صلته بمملكة سبأ (1300-1000ق.م)، في حين يشير محمّد مهر علي إلى أن الصابئيّة مشتقة من السبئيّين Sabeans سكان مملكة سبأ القديمة التي ظهرت في جنوب الجزيرة العربيّة، التي أظهرت الدراسات التاريخيّة أنّهم نزلوا على مكّة في وقت لاحق.
وثمّة رأي آخر مؤدّاه أنّهم طائفة وثنيّة تنتسب إلى «صابي بن سث» الذي كان يدعو إلى نشر تعاليم ديانة أبيه وأنّه كان عنده كتابها باللغة السيريانيّة، ويشير كاربنتر Carpenter بأن عبادة الأجرام السماويّة سبقت عبادة الأصنام بدلالة أن الاعتقاد كان بحصول حالة تكريم الإنسان بعد موته بالالتحاق بآلهة الشمس والقمر والنجوم. إن عبادة الأجرام السماويّة انتشرت بين الإغريق أكثر من غيرهم من الشعوب، وإن مفهوم الصابئيّة هي ظاهرة محاكاة لديانة يونانيّة ظهرت في جنوب جزيرة العرب.
ولعلّ ما أشكل على ميور التميّز بين عبادة الأجرام السماويّة وبين الديانة الصابئيّة، التي يرى ليمنغ Leeming أنّها «ديانة قديمة ينبغي أن لا يتوهم القارئ بوجود صلة بينها وبين Sabaeanims المشتّقة من سبأ Saba أو Shebaوبين Sabianism أو الجماعة التي ترجع أصولها إلى أتباع يحيى المعمدان بدعوى التّقارب اللغوي بين حرفي الإنكليزية (i) و(e)».
وصفوة القول: إنّ عبادة النجوم والكواكب كانت عبادة عالميّة لم تكن وقفًا على الجزيرة العربيّة، وإذا كانت الكعبة جزءًا من هذه العبادة أو مركزًا لها، فإنّ طقوسها ينبغي أن تكون متماثلة مع طقوس العبادات النجميّة في أدنى تقدير، ولا سيّما وأنّ ميور لم يشِر إلى طقوس العبادات النجميّة ولم يبيّن مدى الصلة بينها وبين الكعبة، ولا سيّما وأن هذا الترادف في طقوس الطواف والنحر وتقبيل الحجر لا يوجد في أي عبادة نجميّة أخرى.
أمّا إذا كان مقصد ميور من كلمة Sabeanism الديانة الصابئيّة، التي تعد من الديانات القديمة إن لم تكن أقدمها، يرى البعض إنّها ديانة توحيديّة ورد ذكرها في القرآن الكريم، ويبدو أنّ ذكر الصابئة في القرآن يدل على أنّ الصابئيّة كانت ديانة مستقلّة كاليهوديّة والنصرانيّة، ولهم كتابهم المقدّس «كنزاربا» ومعناه الكنز العظيم ويعتقدون أنّها صحف آدم، كما يعتقد الصابئة أن سام جدّهم الأعلى وقيل إنّ تعاليم إدريس أو «هرمس» أثمرت وصار له أتباع هناك كانوا يسمّون الصابئة، وقيل إن كلمة صابئة قد أطلقت على الذين حرّفوا تعاليم إدريس واصطنع فريق منهم عبادة الكواكب وفريق عبادة الأصنام.
ولعلّ صابئة حرّان كانوا يعبدون العلامات أو الكواكب السبعة: الشمس والقمر والمريخ والمشتري وزحل وعطارد والزهرة، كما كان الصابئة يؤمنون بالله تعالى وينزّهونه غاية التّنزيه ويصفونه بأروع الصفات ويعتقدون بالملائكة ويسمّونها «الروحانيّات» بأنّهم مخلوقون لله (عزّ وجل) وأنّ مقرهم الكواكب لذلك يعظمون تلك الكواكب والاتجاه نحو القطب في العبادة وممارسة رجال الدين للتنجيم.
وثمّة إشارة على صلة الصابئيّة بسيرة إبراهيم، حيث كانت الفرق في زمان
إبراهيم صنفين: الصابئة والحنفاء، فلما بعث الله إبراهيم كان الناس على دين الصابئة فاستدل إبراهيم عليهم في حدوث الكواكب كما ورد في قوله: «لا أحب الآفلين»، هذه الإشارة تفيد في بيان بعض الغموض الذي يكتنف شعائر العبادة الإبراهيميّة، ولا سيّما وأن ورود اسم إبراهيم في طقوس الصابئة، وثمّة رأي يرى أنّهم فرقة استجابت لدعوة إبراهيم، والنص التالي يدل على هذا الرأي: «من جملة ما يقوله الصابئي في التعميد: أنا فلان بن فلانة تعمّدت بعماد بهرام، إبراهيم الكبير ابن القدرة وعمادي يحرسني لأرتفع إلى العلا، ومن جملة ما يقوله الصابئي في الصلاة السلام عليك يا سيدي إبراهيم العظيم وتتردّد كثيرًا في كتب المندائيّين أن إبراهيم كان على ملّتهم».
ويعتقد الصابئة بوجود برهم الملاك إذ يعنون بإبراهيم الملاك الكبير، ولا يستبعد أن إبراهيم هو الملاك المشترك بين الأديان، ما يدفعنا إلى الاعتقاد بهذا الرأي القواسم التي تجمع ديانة سكان العراق القديم وعقائد الصابئة مثل الاعتقاد بالكواكب.
وصفوة القول: لا يمكن أن نعدّ الكعبة جزءًا من عبادة صابئيّة نجميّة وثنيّة مستقلّة فإذا أخذنا بالحسبان صلة الصابئة بإبراهيم وهذا فرض يخالف فرض ميور ولا سيّما أن المشهور عن الصابئة توقيرهم الكعبة واعتقادهم أنّها من بناء إدريس وأنّهم يعرفون الكعبة قبل أن يهبط على أرضها أحد من البشر من سلالة إسماعيل وهذا يدل على قدم الكعبة قبل العرب وأنّها ليست من صنع العرب، كما أنّهم يحسبون الكعبة من البيوت السبعة التي تناظر الكواكب السبعة ويقولون أنّها بيت أشرفها «دارا» زحل وستبقى في الأرض ما بقي زحل في السماء، لكنّ المسعودي
خالف هذا الرأي قائلًا: «إنّ عبادة زحل كانت عند أصحاب الفكر والوهم من ديانة البراهمة، لقد عبدت الصابئة زحل وبنت له هيكلًا وبناؤه مسدس الشكل أسود الحجارة»، والكعبة كما هو معروف للجميع مكعبة الشكل ويبدو أن خلطًا حدث بين الكعبة وبين معبد آخر للصابئة.
أمّا عن رمزيّة الرقم سبعة فإنّها لم تكن وقفًا على المثيولوجيّة العربيّة بل تتجاوز ذلك لتغدو موروثًا عالميًّا ظهرت رمزيّته في شعائر أمم وشعوب وحضارات قديمة حتّى غدى جزءً من منظومة ميثولوجيّة عالميّة ولا سيّما في عبادات السامين ، أمّا عن تصريح ميور بشأن الدورات السبعة حول الكعبة؛ فيبدو أنّه لا يملك حجّة على هذه القضيّة لأنّه ساق الموضوع بمنهج افتراضي، وليس من دليل أو إشارة تفيد بأن الصابئة اعتادت القيام بسبع دورات حول أي حرم؛ بوصفها جزءًا من عبادة نجميّة وليس من المعقول الافتراض أنّ المكيّين القدماء كانوا ملمّين بنظام دوران الأجرام السماويّة، وعلى فرض أنّهم كانوا على هذا التّطور الفلكي فإنّهم لم يقوموا بعباده تلك الأجرام السماويّة بتاتًا.
أمّا طقوس الأضاحي فلا ريب أنّها ترتبط بقصة تقديم إبراهيم ولده قربانًا التي وردت في التوراة والقرآن فهذه الشعيرة تمثّل امتدادًا للعقيدة التي سنّها إبراهيم إحياءً لهذه التضحية، وقد أقرّ ميور بصلة هذه الشعيرة بذكرى إبراهيم في المخيّلة العربيّة: «إنّ الأسطورة الإبراهيميّة طعمت مع العبادة الأصليّة بنحو طبيعي وحينها قدّمت طقوس الأضاحي ونحوها من طقوس مكّة على أنّها مرتبطة بذكرى إبراهيم»، ولعلّ هذا التصريح يناقض رأيه بشان صلة الطقوس القربانيّة بعبادة الأجرام السماويّة.
إنّ العرب الوثنيّين اعتادوا على تقديم القرابين الحيوانيّة للعديد من المعابد في منى خلال موسم الحج، ولم يكن في منى أو عرفات صنم تقدّم إليه الأضاحي بل كانوا ينحرون هذه الأضاحي للبيت الحرام، وأنّه من غير المفهوم أن تقدّم الأضاحي في اليمن للشمس والقمر والنجوم وتكون لها صله بعباده مكة؟ فلا شكّ أنّ مشركي مكّة قدّموا الأضاحي لأصنامهم لكنّهم لم يقوموا بذلك قربانًا للشمس أو القمر أو النجوم. إنّ طقوس التّضحية بالحيوانات أو حتّى بالبشر انتشرت بين الشعوب القديمة قبل عهد إبراهيم الذي قدم ولده قربانًا لله تعالى لكن ليس لأحد أن يَفترض أن هذه القرابين قُدّمت في مكّة بدعوى عبادة الأجرام السماويّة.
أمّا عن صلة طقوس الكعبة بقبائل اليمن، فإنّ جميع ما حشده ميور من قرائن بشأن وثنيّة الكعبة تعود إلى القرن الخامس قبل الميلاد أي تاريخ هجرة عرب اليمن إلى الشمال وفق أرجح الروايات، ولم يتمكّن ميور من إثبات أن الكعبة قد بنيت قبل هذا التاريخ، ولم يقدّم أي حجة على أن الكعبة ترجع في أصولها إلى الأقوام اليمنيّة ولا سيّما وأن إثبات هذه القضيّة يتطلّب دراسة مستفيضة للحالة الدينيّة لهذه القبائل، وعلى فرض أن الكعبة أسّست على غرار عبادات يمنيّة قديمة نقلها المهاجرون معهم إلى مكّة، فحري بنا أن نعثر على إشارات للمعبد الأصلي، وينبغي أن يكون لهذا المعبد من الوقار والتبجيل ما يسمو على منزلة الكعبة، لكن الدراسات الأثريّة لم تشِر إلى أي معبد أقدم من الكعبة، وهذا يرجح أن الكعبات الأخرى أُسّست تقليدًا لكعبة مكّة، وقد ورد أنّ معبد اللّات بنته ثقيف محاكاة للكعبة لجلب العرب إليها للحجّ مثلما كانت العرب تحج كعبة مكة، وقصد ثقيف من وراء ذلك المنفعة الاقتصاديّة لما يجري من أيام الحج من تجارة وأسواق عامرة، وقد وردت إشارة في سياق حديث ميور ترى: «أن عددًا من المعابد الوثنيّة
القديمة المتناثرة من اليمن حتّى الدوما وتتعدّاها إلى الحيرة بعضها تتبع الكعبة من حيث التّماثل في طقوسها»وليس العكس، وإلى ذلك يشير المستشرق سكاف Schaff قائلًا: «إنّ الكعبة هي المعبد الأكثر قدمًا وأصالة من بين معابد الجزيرة العربيّة شيّدها إبراهيم وإسماعيل في القرن الثاني والأربعون بعد الطوفان أو القرن التاسع عشر قبل الميلاد».
إنّ المعلومات عن هذه القضيّة لا تزال بحاجة إلى دراسات معمّقة، ولولا بعثة الرّسول صلىاللهعليهوآله وتأكيد القرآن الكريم لم يكن بالإمكان أن نحيط بصلة إبراهيم بتاريخ الكعبة.
لقد ذكرت الدراسات الآثاريّة أنّ أهل اليمن كانوا يهتمون ببناء معابدهم على قمم الجبال لاعتقادهم بقربهم إلى السماء فتسمع دعاءهم وتستجيب لهم بسرعة أكثر من المعابد على السهول، وفي هذا الافتراض مخالفة للموضع الذي أقيمت فيه الكعبة في واد منخفض، كما إن معابد اليمن كانت على أشكال متعدّدة مثل «محرم بلقيس» في اليمن الذي يعود بنائه إلى القرن الثامن ق.م الذي يعد مثالًا للبناء البيضوي، والكعبة هي ذات شكل مكعب.
ويبدو أن أهل اليمن لا يخلقون لغير بلادهم قداسة تعفى على شأنها بين الشعوب الأخرى وقد حدث منهم غير مرة أنّهم نظروا إلى الكعبة نظرتهم إلى منافس خطر فهمّوا بهدمها، فإن كانت الكعبة من أصول يمانيّة كما يدعي ميور لتمكّن أهل اليمن من استمالة أفئدة الأقوام نحو الموضع الأول الذي خرجت منه أديان العرب الأولى ومنها جاءت قدسيّة الكعبة، لكن يبدو أن العقيدة التي حملت الأقوام لزيارة الكعبة لا تمت بأيّ صلة لعقيدة أهل اليمن الأولى بسبب عدم اندثار
منزلة الكعبة بالمقابلة مع أي معبد مواز لها في الجزيرة العربيّة، ولعلّ الكعبة كانت تمثّل موضعًا لأكثر من 360 صنمًا تمثّل أديان العرب في الجاهليّة، وضمّت أيضًا تماثيل لمريم العذراء وهي تحمل المسيح، ما يحملنا على أنّها كانت تجسّد متحفًا للأديان القديمة، ولنا أن نسأل ما الذي جعل من الكعبة مركزًا للوثنيّة دون سواها من محجات الجاهلية؟ وكيف اكتسبت هذه المركزيّة حتّى تحمل الوثنيّين إلى طي القفار لبلوغ موضع يقبع في صحراء لاهبة، فقط لزيارة معبوده، فحري به أن يحج إليه في أي محجة تتاخم بلاده، على فرض أن لكل صنم معبد خاص به، كما كان الأنباط يحجّون إلى مكّة، كذلك عرب سيناء كانوا يحجون إلى «نسر» أحد الأصنام الموجودة حول الكعبة.
إنّ عبادة الأصنام كانت شائعة في البلدان المحيطة بمكّة منذ فترات سحيقة لكن بغية إثبات أنّ الكعبة قد بنيت أصلًا لتكون معبدًا وثنيًّا يتطلّب أدلّة تاريخيّة وأثريّة، على غرار النقوش المكتشفة في المعابد وليس على أساس التقوّلات والفرضيّات.
يذكر ميور: «أنّ الميزّة الأكثر تفرّدًا في المنظومة الوثنيّة للجزيرة العربيّة كَانتْ تبجيل الأحجار عديمة الشكل، إنّ تبجيل الحجارة من قبل الإسماعيليّين كانت ممارسة شائعة ارتبطت بعبادة الكعبة على حدّ قول ابن إسحاق ومستوحاة في الأصل من تقليد اعتادت العرب عليه عند شروعهم بالتّرحال إذ كانوا يصطحبون معهم أحجارًا من جوار مكّة تيمّنًا بالكعبة وكانوا يقومون بالطواف حول تلك الحجارة أينما حلّوا كما اعتادوا الطواف حول الكعبة، حتّى بلغ بهم المطاف إلى
عبادة أي إله من حجر يصادفونه أمامهم متغافلين عن ديانتهم الأصليّة، مبدلين بذلك ديانة إبراهيم وإسماعيل».
لقد أقام ميور هذا الرأي على نصّ ابن إسحاق الذي أورد فيه: «إنّ أَوّلُ عِبَادَةِ الْحِجَارَةِ كَانَتْ فِي بَنِي إسْمَاعِيلَ وأَنّهُ كَانَ لَا يَظْعَنُ مِنْ مكّة ظَاعِنٌ مِنْهُمْ حَيْن ضَاقَتْ عَلَيْهِمْ وَالْتَمَسُوا الفَسَحَ فِي الْبِلَادِ إلّا حَمَلَ مَعَهُ حَجَرًا مِنْ حِجَارَةِ الْحَرَمِ تَعْظِيمًا لِلْحَرَمِ فَحَيْثُمَا نَزَلُوا وَضَعُوهُ فَطَافُوا بِهِ كَطَوَافِهِمْ بِالْكَعْبَةِ حتّى سَلَخَ ذَلِكَ بِهِمْ إلى أَنْ كَانُوا يَعْبُدُونَ مَا اسْتَحْسَنُوا مِنْ الْحِجَارَةِ وَأَعْجَبَهُمْ حتّى خَلَفَ الْخُلُوفُ وَنَسُوا مَا كَانُوا عَلَيْهِ وَاسْتَبْدَلُوا بِدِينِ إبراهيم وَإِسْمَاعِيلَ غَيْرَهُ فَعَبَدُوا الْأَوْثَانَ وَصَارُوا إلى مَا كَانَتْ عَلَيْهِ الْأُمَمُ قَبْلَهُمْ مِنْ الضّلَالَاتِ وَفِيهِمْ عَلَى ذَلِكَ بَقَايَا مِنْ عَهْدِ إبراهيم يَتَمَسّكُونَ بِهَا، مِنْ تَعْظِيمِ الْبَيْتِ وَالطّوَافِ بِهِ وَالْحَجّ وَالْعُمْرَةِ وَالْوُقُوفِ عَلَى عَرَفَةَ».
إنّ عبادة الأحجار Fetishism أو عبادة الأرواح التي يزعم المتعبدون لها أنّها حالّة في تلك الأحجار، ولا سيّما الأحجار الغريبة التي لم تصقلها الأيدي، والتي عبدت على هيئتها كما وجدت في الطبيعة، وتعدّ من العبادات الدونيّة بالنسبة إلى عبادة الصور والتماثيل والأصنام، انتشرت في بلاد العرب بعد أن ساد الاعتقاد بأنّ الجن والأرواح كانت تسكن الأحجار، ويشير ابن الكلبي كان للعرب حجارة غير منصوبة وكانوا يطوفون حولها كطوافهم بالبيت ويعترون عندها يسمّونها الأنصاب.
والسؤال هنا إلى أيّ مدى يمكن أن ترتبط عبادة الأحجار أو الأنصاب بنظريّة ميور بِشأن وثنيّة الكعبة؟
ويبدو أنّ ميور تعامل مع نصّ ابن إسحاق بمنهج اجتزائي شرع فيه إلى بتر القسم الذي يذكر بقاء جزء من شعائر ديانة إبراهيم في طقوس الوثنيّين في رواية ابن إسحاق الذي يرجّح الأصل الإبراهيمي للكعبة، معوّلًا على القسم الذي يشير إلى قداسة الحجارة عند الإسماعيليّين، الأمر الذي يُعدّ خللًا منهجيًّا من خلال اجتزاء النصّ وتوظيفه ولا سيّما أنّ العرب لم يقدّسوا كل حجر يوجد في أرضهم فهنالك حجر في منى يرجم، في الوقت الذي يقبل فيه الحجر الأسود، فلو كان الأمر أمر حجر لَقُدّست جميع الحجارة في بلاد العرب، ولم يشِر ميور إلى أيّ حجّة تاريخيّة تقطع باتّصال عبادة الحجارة بعبادة وثنيّة تمثّل الكعبة مركزًا لها عدا ما أورده في رواية ابن اسحاق التي توحي بأنّ قداسة الأحجار في التصوّرات البدائيّة للعرب جاءت من قداسة الكعبة التي اقترنت بتاريخ إبراهيم وإسماعيل؛ كما أنّه لم يحدّد زمن ظهور عبادة الحجارة لدى العرب ويظهر من سياق رواية ابن اسحاق أنّ تقديس العرب للحجارة جاء في مرحلة لاحقة من تاريخ بنائها، أي في عهد أحفاد إسماعيل.
وإلى ذلك يشير بروكلمان: «إنّ الحياة الدينيّة كانت عند العرب في مستوى بدائي إلى أبعد الحدود، فلقد اعتقد العرب الجاهليّون أنّ الطبيعة من حولهم مشحونة بقوى أعظم من قوى الإنسان لكن بالإمكان تسخيرها لخدمته بطرائق خاصة حتّى اذا ارتقى المستوى الديني عند العرب بعض الشيء تمثّلوا هذه القوى روحًا بشريّة ذات طاقات خطيرة فأصبحت في عرفهم شياطين، والواقع أنّ الساميّين عدّوا الحجارة مأهولة بالأرواح ومن هنا قدّس العرب القدماء ضروبًا من الحجارة»، ويذكر ابن الكلبي: «إنّ الرّجل إذا سافر فنزل منزلًا، أخذ أربعة أحجار، فنظر إلى أحسنها فاتخذه ربًّا، فإذا ارتحل تركه، فإذا نزل منزلًا آخر، فعل مثل ذلك»، ولعلّ ذلك يماثل ما ذهب إليه المفسّرون لقوله تعالى: (أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاهُ) (سورة الجاثية: الآية 23) أي، كان من بين الجاهليّين من يختار الأحجار الغريبة فيتعبّد لها، فإذا رأوا حجرًا
أحسن وأعجب تركوا الحجارة القديمة وأخذوا الحجارة الجديدة، ويقول سعيد بن جبير: «كان أحدهم يعبد الحجر فإذا رأى ما هو أحسن منه رمى به».
وصفوة القول: إنّ تقديس الحجارة ارتبط بالتصوّرات المثيولوجية عن القوى التي تسكن الحجارة، بنحو اعتباطي وليس من دليل على عدّ هذه العبادة ذات صلة بالكعبة، وإلى ذلك يشير هيكل، بقوله: «إنّ النّاس كانت أقصر من أن يحيط ذهنها بمعنى الألوهيّة السامي فقد اتّخذوا من النجوم آلهة، وكانت بعض الأحجار البركانيّة يخال للناس أنّها ساقطة من السماء منحدرة لذلك من بعض النجوم ومن ثمّ اتّخذت أوّل أمرها مظاهر لهذه الآلهة الرفيعة وقدّست بهذه الصفة ثم كانت عبادة الأحجار، ثم بلغ من إجلالها أن كان العربي لا يكفيه أن يعبد الحجر الأسود بالكعبة بل كان يأخذ معه في أسفاره أي حجر من أحجار الكعبة يُصلّي إليه ويستأذنه في الإقامة ويؤدّي إليه كل ما يؤدّى للنجوم وخالق النجوم من أوضاع العبادة وعلى هذا النحو استقرت الوثنيّة» .
إنّ الاعتقاد بأنّ الآلهة تسكن الاحجار انتشر عالميًّا ولا سيّما عند الإغريق والرومان الذين قدّموا الأضاحي للأحجار، ويبدو أنّ عبادة الأحجار عديمة الشكل انتشرت بين الأمم القديمة لأنّ فكرة الألوهيّة تجسّدت في الحجارة الخشنة أو الأحجار النيزكيّة التي أحيطت بهالة من القداسة والتبجيل منذ أن عُدّ حجر الإله أفسيوس Ephesus هابطًا من السماء، وقد نصبت الأعمدة الحجريّة المفردة في الأزمنة الغابرة لتجسّد القوّة الكامنة لكواكب المشتري، والزهرة، وعطارد؛ علاوة على ذلك فإنّ المجموعات الحجريّة الحلقية عُبدت على امتداد منطقة المحيط الهادي والعالم القديم في اليابان والصين والهند وفارس والجزيرة العربيّة،كما حازت هذه العبادة على اهتمام القبائل
السامية. إنّ عبادة الأحجار المقدّسة تُعدّ من أقدم أشكال العبادات العالميّة التي لم تحظَ باهتمام أمّة كما حظيت باهتمام القبائل السامية التي تعد ديانة البدو في سوريا والبلاد العربيّة، فقد ذكر في العهد القديم أنّ عبادة الأنصاب انتشرت في أرض الكنعانيّين وقد أكّد هيرودوت أنّ معبد ملكرد في صور كان يضمّ أنصابًا حجريّة، فضلًا عن وجود مثل هذه الأنصاب في قبرص وكذلك عثر عليها على مدخل المعبد المقدّس لمدينة البتراء . وصفوة القول: إنّ هنالك شبه إجماع على أنّ الإسماعيليّين لم يكونوا الأكثر تفرّدًا بهذه العبادة كما يرى ميور الأمر الذي يُضعّف من عدّ الكعبة مصدرًا لمثل هذه التصوّرات لدى العرب.
تعرّض وليم ميور إلى قضيّة الحجر الأسود في مواضع متفرّقة من خطابه إذ يرى: «أنّ عبادة الأحجار نشأت عن خرافة الكعبة مع حجارتها السوداء» ويرى أيضًا: «أنّ الحجر الأسود الذي يعكف المسلمون على تقبيله خلال شعائر الحج يمكن أن يكون حجرًا نيزكيًّا قدّسته العرب لاتّصاله بعبادة النجوم والكواكب»، وقد أشار درنغهام Dermenghem إلى هذا الرأي مبيّنًا أنّه حجر يعوم في الماء .
ويرى وليم ميور أيضًا أنّ الرّسول صلىاللهعليهوآله جرّد الكعبة لاحقًا من مظاهرها الوثنيّة القديمة كافة، عدا تقبيل الحجر الأسود.
إنّ قدسيّة الحجر الأسود تتأتّى من ذكرى إبراهيم وإسماعيل برفعهما قواعد البيت،
فلمّا شرع إبراهيم بوضع أساس البيت بمعيّة إسماعيل، وارتفع البناء حتّى انتهيا إلى موضع الركن جعل الحجر الأسود علامة يبدأ الطواف منه، ولأنّ الكعبة المشرّفة جُدّد بناؤها مرارًا قبل البعثة وبعده فالحجر الأسود يذكرنا بالنشأة الأولى للتوحيد، وورد عن الرّسول صلىاللهعليهوآله قوله: «قِفُوا عَلَى مَشَاعِرِكُمْ، فَإِنَّكُمْ عَلَى إِرْثٍ مِنْ إِرْثِ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ».
أمّا التّقبيل فلا يعني العبادة مطلقًا لأنّ المرء إذا قبّل يد والده فليس هذا يعني أنّه يعبده بل التقبيل يدلّ على الإجلال والاحترام، فلو كان للحجر الأسود جذور وثنيّة لما أعطى الرّسول صلىاللهعليهوآله للحجر الأسود مثل هذه الخصوصيّة، كما أنّ موسى والأنبياء كانوا يكرمون تابوت العهد ويبخّرونه كما جاء في العهد القديم، والمسيحيّون يقبّلون الصور وتماثيل المسيح والعذراء ومنهم من يسجد لهذه الصور والتّماثيل فضلًا عن تقبيلهم للصلبان كي ينالوا البركة، ومنهم من يقول إنّ الصور والأحجار لا تضرّ ولا تنفع وإكرامها عائد لله سبحانه وتعالى.
لقد شهد إبراهيم عصر الكوارث والرجوم من مدن فلسطين الجنوبيّة، وبقيت آثار البتراء إلى اليوم وفيها أنصاب من هذه الرّجوم في أماكن العبادة حفظوها تذكيرًا لأنفسهم بقضاء الله تعالى لأنّها هبطت من السماء عقابًا للمذنبين، ولم يذكر أيّ مصدر أنّ إبراهيم كان يحمل معه حجرًا من هذه الأحجار، ولكنّه إذا تعمّد أن يقيم موضعًا باقيًا للعبادة على طريقته، فالحجر من النيازك أحقّ أن يحتفظ به من سائر الحجارة، والتفسيرات تذهب إلى أنّ الحجر الأسود نقل من البتراء عند بناء الكعبة، وقد ظهر بعد ذلك أنّهم نقلوا كثيرًا من الأحجار عن طريق البتراء بعد اتّخاذ الكعبة بيتًا للأصنام قبل البعثة ببضعة أجيال.
وقد ورد في العهد القديم أنّ إبراهيم أقام موضعًا لعبادة الله تعالى في كل
موضع خاطب فيه الله تعالى، ويبدو أنّ إسحاق سار على نهج أبيه الخليل في إقامة هذه السُنَّة، وعندما كان يعقوب في طريقه إلى حاران رأى رؤيا، وبعد أن أفاق أخذ الحجر الذي توسّده وسكب عليه زيتًا، وسمّى المكان بيت إيل أي بيت الله، وأقام الحجر عمودًا هناك وعاد لزيارة ذلك الحجر بعد عشرين عامًا، وأطلق عليه اسم «مصفاة» وأصبحت هذه المصفاة مكانًا للعبادة والمجالس العامّة في تاريخ بني اسرائيل.
وعندما شرع موسى بكتابة الألواح أقام َاثْنَي عَشَرَ عمودًا حجريًّا، وحجر المعونة الذي أقامه صموئيل ليكون شاهدًا على معونة الرب، وحجر الشهادة الذي أقامه يشوع ليكون شاهدًا على ندم بني إسرائيل ، كذلك الحجر الكبير الذي وضع عليه تابوت العهد ليكون شاهدًا لعمل الله ورعاياته، والاثني عشر حجرًا التي أقامها إيليا لتكون معبدًا لله، وحجر الزاحفة الذي بنى فيه أدونيا بن داوود مذبحه.
ويرى سيد أحمد خان أنّ هذه المواضع كانت تقام من خلال نصب مجموعة من الأحجار بشكل شاقولي يشبه العمود يطلق عليه بيت إيل، وهي بمثابة دور للعبادة على غرار دور العبادة في أيّامنا.
إنّ الحجر الاسود موجود مع وجود الكعبة ولم يتّجه إليه أحد من العرب
بالعبادة ولم يعرف ضمن الأصنام ولا الأوثان التي كانت العرب يعبدونها، ومن أجل ذلك لم يأمر النبي صلىاللهعليهوآله بتحطيمه كما حطّمت الأصنام لأنه لم يخطر على بال أحد من العرب أن يعبد كما تعبد الأصنام، كما أنّ الحجر الأسود كان يمثّل مرتكزًا قدسيًّا غير عبادي في تصوّرات العرب بسبب خصوصيّته، وهذا انعكس في رواية التّنازع بين قبائل قريش في حيازة شرف حمله والتي فصل فيها الرسول صلىاللهعليهوآله.
وصفوة القول: إنّ إبراهيم وإسحاق ويعقوب وموسى وصموئيل ويشوع وإيليا لم يُقدِموا على عبادة الأحجار لكن الدلالة واضحة، فنصب الأحجار كان من آيات الشكر لله تعالى وهي سنّة اتّبعها الأنبياء لإقامة شعائر عبادة التوحيد ولتكون شاهدًا على فضل الله (عزّ وجل) على البشر في موضع هذا الحجر، فليس غريبًا أن يقوم إبراهيم بوضع الحجر الأسود ليكون شاهدًا على منّة الله تعالى عليه وعلى ذريّته في الموضع الذي جعله الله سبحانه قبلة للعالمين.
ذهب ميور في نظريّته عن المنظومة الوثنيّة إلى أنّ العرب لم يكونوا موحّدين في أيّ عهد من العهود، من خلال عقد الصلة بين العقيدة الوثنيّة للجزيرة العربيّة الموغلة في القدم وبين الكعبة التي عدّها مركزًا لهذه العبادة، متجاهلًا النظرة التي تجعل من الكعبة النواة الأولى للتوحيد في الجزيرة العربيّة، فذريعته الأخرى بِشأن الجذور الوثنيّة للكعبة تتعلّق بتاريخ الشروع بعبادة الأصنام والتي ذكر فيها: «أن قصّة عمرو بن لحي زعيم قبيلة خزاعة الذي عاش في سنة 200 ميلاديّة،
وعدّه أوّل من تجرّأ على استبدال دين إسماعيل بعبادة الأصنام التي جلبها من سوريا ليست سوى أوهام إسلاميّة، لأنّ عبادة الأصنام انتشرت على نطاق واسع في عموم شبه الجزيرة العربيّة منذ عهود بعيدة، ولدينا سجلّ موثّق لمزارات وثنيّة منتشرة من اليمن وصولًا إلى الحيرة، وهكذا فإنّ هذا النظام انتشر وكان منظّمًا تمامًا، ولعلّه كان موجودًا في الجزيرة العربيّة منذ فترات طويلة سبقت عمرو بن لحي وسرعان ما تنامى مع تنامي المستوطنين الأصليّين لمكّة»، ويرى أيضًا: «أنّ المستوطنين الأوائل لمكّة من قضاعة وجرهم وخزاعة، الذين ترجع أصولهم إلى اليمن حافظوا على صلتهم بلدهم الأم، ودون أن يخامرنا أدنى شك فإنّهم جلبوا معهم عبادة الكواكب والنجوم وعبادة الأوثان والأصنام وعقدوا الصلة بينها وبين بئر زمزم مبعث ازدهارهم، وأقاموا إلى جواره معبدهم بطقوسه التي ترمز لعبادة الأجرام السماويّة الذي يحتوي على الحجر الأسود الغامض».
لقد ذكرت المصادر أنّ سلطة بني إسماعيل بدأت تضمحلّ تدريجيًّا بعد موت نابت بن إسماعيل الذي تولّى أمر البيت من بعده جدّه من أمّه مضاض بن عمرو رئيس قبيلة جُرهم، فسيطر الجراهمة على شؤون الكعبة، ولعلّ جُرهمًا أو العماليق استغلّوا قرابتهم من بني إسماعيل، فسيطروا على أوضاع مكّة، وعلى شؤون الكعبة، ما جعلهم عرضة للنزاع مع القبائل الأخرى بغية الاستحواذ على مكّة، حتّى ضاعت هيبة الكعبة، وبدأت تأخذ الوثنيّة مأخذها بعد ابتعاد بني إسماعيل عنها بالقوّة، أو بحثًا عن مكان للعيش، أو بعد أن غدت مكّة لا تستوعب هذه الأعداد الكبيرة، نتيجة الهجرات أو التكاثر والتناسل.
لكن الجرهميين استخفوا بأمر البيت الحرام، فظلموا من جاء إلى مكّة حاجًّا، ومن جاء يلتمس بيع سلعته، أو مرتغبًا في أن يسكن مكّة، وسرقوا ما كان يُهدى
للكعبة، وبلغ من طغيان جُرهم، أنّهم مارسوا الفجور في حرم الكعبة، هذه أفعال المشينة حملت خزاعة على الإفادة من أخطاء جرهم فحشدت المعارضين، وتمكّنت من أن تخلع جرهما.
لقد شهدت مكّة تغيّرًا إبّان حكم خزاعة فعمل زعيمها عمرو بن لحي، على تنشيط الحج إلى الكعبة وأخذ يقيم موائد الطعام في موسم الحج وجلب الماء من الآبار المنبثّة حول مكّة فنال منزلة كبيرة بين قومه وبين العرب ولما كانت القبائل العربيّة البعيدة لا تفقه شيئًا عن دين إبراهيم عمل عمرو على جلب الأصنام من الجهات المختلفة وإقامتها حول الكعبة حتّى يُرغب القبائل ولا سيّما قبائل الشمال في الحج إلى بيت مكّة للتقرّب لأصنامها، وقد وجد استجابة لفعله بين القبائل القريبة والبعيدة وبذلك استحكم الشرك في مكّة.
ويبدو أنّ دين إبراهيم ضعف أمره حتّى بين أولاد إسماعيل أنفسهم، فذكر أنّ إياس بن مضر كان أوّل من أنكر على بني إسماعيل ما غيّروا من سنن آبائهم وظهرت منه أمور جميلة حتّى رضوا به رضا لم يرضوه بأحد من ولد إسماعيل بعد «أدد» فردّهم إلى سنن آبائهم.
ويبدو أنّ عمرو بن لحي وجد أنّ جمع العرب يقتضي هذه الخطوة التي بموجبها يصبح بيت الله مجمعًا لآلهة العرب وتتعايش الحنيفيّة مع آلهة العرب تحت هذه الخيمة، وهوأمر فعّال في اجتذاب الأقوام العربيّة إلى مكّة لما كانت تظهره من التقدير لهذه الآلهة والحج إليها؛ بمعنى آخر أنّه كان يهدف إلى جمع الصلات الدينيّة مع الصلات الاقتصاديّة، وإكثار القواسم المشتركة بين العرب على اختلاف آلهتهم ومعبوداتهم من أجل توسيع حجم الحج إلى مكّة وهو أمر يصب
في زيادة النذور فيوفر ظروفًا حياتيّة لأهل مكّة ويؤدّي إلى نشاط التجارة واستهلاك البضائع.
إنّ المنهجيّة السليمة تلزم الباحث أن لا يقف عند حدود نفي النظريّات بل يجب أن يتعدّاها إلى تقديم بدائل تقوم على البراهين العقلائيّة، لقد حملت المتون التاريخيّة بين طيّاتها شهادة عن أسباب انتشار الوثنيّة في مكّة خلافًا لما أورده ميور الذي أقام المسألة برمّتها على سبيل الفرض والإسقاط الإيديولوجي ودون أيّ سند أو أيّ حجّة تاريخيّة، إنّ تغيير عمرو بن لحي لديانة إبراهيم يكتنفها بعض الغموض ولا سيّما مع غياب الفواعل التي حملت العرب على تقبل فكرة عبادة الأصنام فالأمر لا ينتهي عند جلب الأصنام إلى مكّة، فمن الناحية الزمنية أشار ميور إلى أن عمرو بن لحي عاش في سنة 200 ميلادية، ويغلب الظن أن إبراهيم عاش في القرن التاسع عشر ق.م أوفي رأي آخر عام 2367 ق.م، لتكون المدّة الزمنيّة التي تفصل بين بناء الكعبة وبين عمرو بن لحي بنحو (2200-2500 سنة)، ولعلّها فترة طويلة تجعل من احتماليّة حدوث تغيّرات على الذهنيّة العربيّة أمرًا راجحًا.
إنّ العرب وعلى الرغم من انحرافهم نحو الوثنيّة لم يفقدوا نظرتهم إلى الله سبحانه وإنّ عبادة الأصنام في مكّة لم تبلغ درجة تختفي معها كل معالم التوحيد من تعظيم بيت اللّه، وإقامة مراسم الحج، حتّى أنّهم كانوا يردّدون أثناء الطواف شعار التّقديس للّه ولأوثانهم، ويعترفون بأن اللّه هو المالك الحقيقي الذي تستمدّ منه أصنامهم قوّتها، إلا أنّهم كانوا يشركون في عبادته سبحانه، قال ابن إسحاق: «واستبدلوا دين إبراهيم وإسماعيل غيره فعبدوا الأوثان وصاروا إلى ما كانت عليه الأمم قبلهم من الضّلالات وفيهم على ذلك بقايا من عهد إبراهيم يتمسّكون بها
من تعظيم البيت والطواف به والحج، والعمرة والوقوف على عرفات والمزدلفة وهدي البدن والإهلال بالحج والعمرة مع إدخالهم فيه ما ليس منه فكانت كنانة وقريش إذا أهلّوا قالوا: «لبّيك اللهم لبّيك لبّيك لا شريك لك إلّا شريكًا هولك تملكه وما ملك» فيوحّدونه بالتلبية، ثم يدخلون معه أصنامهم، ويجعلون ملكها بيده يقول الله تعالى لمحمّد صلىاللهعليهوآله (وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُم بِاللَّهِ إِلَّا وَهُم مُّشْرِكُونَ) (سورة يوسف: الآية 106) أي ما يوحدونني لمعرفة حقّي إلّا جعلوا معي شريكًا من خلقي».
لقد كان الله سبحانه الإله الرئيس لوثنيّي جزيرة العرب، وكان المقصود بالعبادة بدرجات متفاوتة على الأرض الممتدّة من الطرف الأقصى لجنوب شبه الجزيرة العربيّة وحتّى تخوم البحر الأبيض المتوسط فعرف بـ «إل IL» عند البابليّين ثم الكنعانيّين ثم بعد ذلك عرف بـ «إيل EL» عند بني إسرائيل أمّا العرب الجنوبيّون فقد عرّفوه باسم «إله ILAH-»، وقد عبده البدو الأعراب تحت اسم «الإله AL-ILAH»، ومع قدوم محمّد صلىاللهعليهوآله أصبح يدعى «الله ALLAH»، الأمر الذي يعزّز نظريّة أنّ الكعبة ذات جذور توحيديّة نظرًا لأنّ معرفة الله قديمة، كما ينقطع إجماع المؤرخين على أن الكعبة أطلق عليها في جميع العصور تسمية «بيت الله» في الوقت الذي كانت جميع المعابد الأخرى تسمّى تبعًا لمعبوداتها مثل «معبد العزى» و«معبد اللّات» ونحوها لم ترد أيّ إشارة تاريخيّة على أن الكعبة كانت تدعى بيت لصنم عبر التاريخ ولا حتّى تبعًا لمعبود قريش الأساسي «هبل»، وعلى فرض أن الكعبة قد بنيت في المقام الأوّل لعبادة الأصنام فلا مناص إذا من بقاء اسم ذلك الصنم شاهدًا عليه ويكون اسمه مقترنًا بهذا البيت.
إنّ الحالة الدينيّة لدى العرب كانت تحمل بعدًا جوهريًّا ثابتًا يجعل من الله تعالى المحور في المنظومة الوثنيّة الدينيّة أمّا الأجرام السماويّة والأصنام فما هي إلّا وسائط فرعية تنامت رمزيّتها القيميّة لتحمل تجليّات حسّيّة جاءت بفعل ميل
الإنسان نحو الخطيئة لتسويغ رغباته التي تتعارض مع القيم المثاليّة التي يجسّدها مفهوم الله في عقل الانسان، وبفعل التراكمات الزمنيّة والحواضن الاجتماعيّة التي أسهمت في صيرورتها والارتقاء بمستوى هذه الوسائط من حالة الدونيّة نحو العلويّة في القدرة والمشاركة، بل وأبعد من ذلك لتبلغ حالة الإنكار المطلق لوجود الله تعالى الذي عبّر عنها القرآن الكريم في قوله سبحانه: ﱫ (وَقَالُوا مَا هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا يُهْلِكُنَا إِلَّا الدَّهْرُ ۚ وَمَا لَهُم بِذَٰلِكَ مِنْ عِلْمٍ ۖ إِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ) (سورة الجاثية: الآية 24) هذه الآية نزلت بحقّ الذين أنكروا أن يكون لهم رب يفنيهم ويهلكهم.
يزعم ميور: «أنّه لم يتمكّن من تعقّب أيّ صلة بين طقوس الكعبة وبين ديانة إبراهيم»، إن مثل هذا التّعليل غير كافٍ لنفي واقعة تاريخيّة، فوثنيّة العرب بعد موت إبراهيم وإسماعيل بقرون كثيرة لا تدلّ على أنّهم كانوا كذلك حين جاء إبراهيم وإسماعيل إلى الحجاز ويبدو أنّ دعوتهم للعرب لم تفلح وبقي العرب على عبادة الأوثان، وهذه ليس من شانه أن يُدحض واقعة تاريخيّة انعقد الإجماع على وثاقتها.
إنّ شعائر الإبراهيميّة تمثّل تجسيدًا لحياة إبراهيم وحياة أسرته، فعن عبد الله بن عمرو، عن النبي صلىاللهعليهوآله قال: «أتى جبريل إبراهيم يوم التروية فراح به إلى منى، فصلّى به الظهر والعصر والمغرب والعشاء الآخرة والفجر بمنى، ثمّ عدا به إلى عرفات، فصلّى به الصلاتين جميعًا: الظهر والعصر، ثم وقف به حتّى إذا كان كأعجل ما يصلّي أحد من النّاس المغرب أفاض حتّى أتى به جمعًا، فصلّى به الصلاتين جميعًا: المغرب والعشاء، ثم أقام حتّى إذا كان كأعجل ما يصلّي أحد من النّاس الفجر صلّى
به، ثمّ وقف حتّى إذا كان كأبطأ ما يصلّي أحد من المسلمين الفجر أفاض به إلى منى، فرمى الجمرة، ثم ذبح وحلّق، ثم أفاض إلى البيت، ثم أوحى الله تعالى إلى محمّد صلىاللهعليهوآله: ﱫ (ثُمَّ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ أَنِ اتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا ۖ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ) (سورة النحل: الآية 123) وقد حجّ إبراهيم بالنّاس وفق هذه المناسك».
إلى جانب النحر وتقبيل الحجر الأسود، تأتي شعيرة التلبية التي ذكرها ابن حجر بأنّها إجابة لدعوة إبراهيم حين أذّن في النّاس بالحج؛ فلمّا فرغ إبراهيم من بناء البيت، قيل له أذّن في النّاس بالحج، قال ربّ وما يبلغ صوتي، قال أذّن وعليَّ البلاغ، قال فنادى إبراهيم: «يا أيّها النّاس كُتب عليكم الحج إلى البيت العتيق فسمعه من بين السماء والأرض».
أمّا السعي بين الصفا والمروة فقد ورد في صحيح البخاري: «أنّ إبراهيم ما إن ترك هاجر وإسماعيل بمكّة، إذا نفذ ما في السقاء عطشت وعطش ابنها، وجعلت تنظر إليه يتلوّى، فانطلقت كراهيّة أن تنظر إليه، فوجدت الصفا أقرب جبل في الأرض يليها، فقامت عليه، ثمّ استقبلت الوادي تنظر هل ترى أحدًا فلم تر أحدًا فهبطت من الصفا حتّى إذا بلغت الوادي رفعت طرف ذراعها، ثمّ سعت سعي الإنسان المجهود حتّى إذا جاوزت الوادي، ثم أتت المروة فقامت عليها ونظرت هل ترى أحدًا فلم تر أحدًا، ففعلت مثل ذلك سبع مرات قال ابن عباس: قال النبي صلىاللهعليهوآله فلذلك سعى النّاس بينهما».
لقد انقطع الإجماع على أنّ ديانة إبراهيم كانت الديانة الحنيفيّة؛ والجذر «ح ن ف» يدل على المائل من شرٍّ إلى خير؛ أو من أسلم في أمر الله فلم يَلْتو في شيء، فكان عبدة الأوثان في الجاهليّة يقولون: نحن حنفاء على دين إبراهيم، فلمّا جاء الإسلام سمّوا المسلم حنيفًا، «فهم أعداد متفرّقة من النّاس مالوا عن
الوثنيّة وعبادة الأصنام إلى التوحيد، ولم تنتظمهم بعد ذلك شريعة واحدة، بل كان ظهورهم في أماكن مختلفة، وفي أزمان متباعدة فبقوا محافظين على شيء من تراث إبراهيم من دعوة إلى الوحدانيّة ونبذ لعبادة الأصنام، والإقرار بالبعث والنشور، والابتعاد عن الخمر ووأد البنات وسيِّئ الأخلاق»، وكان يقال في الجاهليّة من أُختُتِن وحجّ البيت حنيف، لأنّ العرب لم تتمسّك في الجاهليّة بشيء من دين إبراهيم غير الختان وحج البيت، وكان منهم بالجزيرة العربيّة رهط غير قليل يقيمون الصلاة عدّة مرات في اليوم؛ بوصفها فرضًا إجباريًّا للإيمان يقومون فيها ويركعون ويتوضّؤون قبلها ويغتسلون من الجنابة ولهم قواعد في نواقض الوضوء.
ويبدو على منهج ميور إغفاله لعلاقة الدوال التي تحملها هذه المعبودات الوثنيّة بمدلولاتها في المخيّلة العربيّة التي حفظت شيئًا من عبادة التوحيد بين ثناياها، وهذا يدلّ على أنّه عالج تاريخ الإسلام بمنهج سطحي افتقر إلى النظرة المعمّقة، ولا سيّما مع إقراره: «بأنّ الكعبة وطقوسها تمثّل تراث شعبي متداول عند أهل مكّة ولفترات طويلة خلت قبل ولادة الرّسول صلىاللهعليهوآله ولم تكن خيالًا من وحي المسلمين»، ولعلّ ذلك يدلّ على قدم الكعبة وطقوسها، وكونها تراثًا شعبيًّا متداولًا يقضي بنحو لا يرقى إليه الشكّ بأنّها ظلّت محفوظة ومتداولة في ذاكرة الأجيال جيلًا بعد آخر، إذ لا يمكن الاختلاف في جذورها الإبراهيميّة؛ فلو كانت المسألة خرافة وثنيّة قديمة، لظهرت تأويلات متباينة بشأنها من وحي الميثولوجيا العربيّة، لكن مكمن ذلك في إجماع العرب في جميع العصور على الجذور الإبراهيميّة للكعبة وشعائرها على الرغم من حالة الوثنيّة التي اكتنفت المخيّلة العربيّة، فلم تظهر رواية واحدة أو نصّ شعري أو إشارة بسيطة تذهب إلى عكس ذلك.
كما يُلمس من هذه الشهادة حالة الاضطراب لدى ميور في رؤيته لتاريخ الكعبة؛
فتارة يرى بأنّها خرافة وتارة يَعدّها تراثًا شعبيًّا في موضع آخر، ولعلّ التّباين حاضر بينهما لأنّ الخرافات والعادات ذات طابع محلّي لكن مكّة وقداستها كانت محجّة تتمركز في مساحة نصف قطرها إلى الألف ميل من القداسة والتّبجيل حسب رأي ميور.
وثمّة شاهد آثاري على صلة الكعبة بإبراهيم يكمن في مقاييس الكعبة، إذ أنّها بنيت مرّات كما هو معلوم، وقد حاول البناة أن يحافظوا على معالمها القديمة في كل مرّة، بيد أنّه تعذّر عليهم المحافظة على أبعاد جوانبها، لكنّهم تمكّنوا من الإبقاء على ارتفاعها كما جاء في أكثر الروايات، وارتفاعها الآن سبع وعشرون ذراعًا أو خمسة عشر مترًا، ولن تكون الخمسة عشر مترًا تساوي سبعة وعشرين ذراعا إلّا إذا كان الذراع بمقياس قوم إبراهيم مثلما حقّقه جريفس Greaves الخبير المتخصّص في المقاييس الأثرية.
لم يدّخر ميور جهدًا لإنكار المكانة التوحيديّة للكعبة، وفي معرض حديثه عن حادثة أصحاب الفيل التي تعدّ شاهدًا على العناية الإلهيّة بالبيت الحرام لدى العرب، يرى أنّها: «مجرّد أسطورة دينيّة. كان سبب الدّمار الذي حلّ بجيش أبرهة تفشّي مرض الجدري أو بعض الآفات المماثلة... ولعلّ الإسراف في هذه الرواية بلغ حدّ إيراد تفاصيل عن نوع الطيور، وحجم الأحجار، التي ضربت الأحباش، ونوعها، ولا ريب أنّ هذه الأحداث لُوّنت بصبغة أسطوريّة صارخة بغية إضفاء مسحة إعجازيّة على قضيّة انسحاب أبرهة».
إنّ قصّة أصحاب الفيل لم تكن حدثًا عابرًا في تاريخ الجزيرة العربيّة بل كان العرب يؤرخون بتلك الحادثة، ولم تكن قضيّة خلافيّة، كما أن أحداثها لم تجرِ في
عهود خلت، بل وقعت في عام 570م، أي بعد شهرين من ولادة الرسول صلىاللهعليهوآله وفقًا لحسابات وليم ميور، والفيل من السّور المكّيّة ، نزلت على الرسول صلىاللهعليهوآله وعمره بين الأربعين والثالثة والخمسين، ولعلّها مدّة قريبة جدًّا أدركها الكثيرون في عصر النبوّة، وقد ذكر ابن عباس أنّه أدرك عند أم هانئ نحو قفتين من هذه الحجارة فلو كانت تفصيلات القصّة ذات طابع أسطوري لكانت محل استهزاء المخالفين للنبوّة، ودليلًا في يدهم لمحاججة القرآن، فلا مناص من القول إنّ سكوتهم بمثابة اعتراف بمصداقيّة القصّة التي وردت في سورة الفيل.
ومن خلال مطالعة أحداث القصّة تبيّن لنا أنّ ميور أنكر الجزء المتعلّق بالطيور وتبنّى الجزء المتعلّق بإصابة جيش أبرهة بالجدري، التي أشارت لها بعض المصادر وذكرت أنّه أوّل يوم رُؤى فيه الجدريّ ، وقد ذكرت أن أبرهة مات من جرّاء هذا الوباء، وقال كثير من أهل السير إنّ الحصبة والجدري أوّل ما رؤيا في العرب بعد الفيل، على الرغم من أن هذه المصادر لم تنكر إصابة جيش أبرهة بالحجارة التي ألقتها طير الأبابيل.
لقد تعامل ميور بنظرة اجتزائيّة تدلّ على إنكار للأثر الذي تركته هذه الحادثة في الذهنيّة العربيّة، لأنّ جوهر القضيّة معقود على مقولة عبد المطلب بن هاشم الشهيرة «للبيت ربّ يحميه».
لم يفلح ميور في طمس الدلالة الإعجازيّة التي حملتها هذه الحادثة للأذهان ولا سيّما إذا أخذنا بالحسبان عدم حدوث حوادث مماثلة عبر التاريخ، فقد عكف ميور على إنكار المنزلة التي اكتسبتها الكعبة إبّان هذه الحادثة؛ ويبدو الاختلاف العقديّ يدفعه إلى تبنّي هذا الرأي.
ولعلّه تغافل عن سؤال مهم، لماذا لم ينتشر الوباء في جزيرة العرب يومها؟ ولماذا لم يصب به سوى جيش أبرهة؟ علمًا أن المصادر لم تذهب إلى تفشّي هذا المرض بين العرب بل ذكرت أنّهم رأوه لأوّل مرّة، وقد أغفل ميور هذه النقطة أيضًا.
وصفوة القول إنّ نظريّة ميور بشأن عدّ الكعبة مركزًا لعبادة نجميّة ليست سوى سقط متاع تفتقر للحجج التاريخيّة ولا تعدو أن تكون إلّا محاولة إقحام للأسانيد ولّي للنّصوص لإثبات رؤية أيديولوجيّة مسبقة. إنّ الموروث التاريخي بِشأن صلة إبراهيم بالكعبة قائم على موروث عتيد ولأجيال طويلة، ولم يكن يومًا قضيّة خلافيّة حسب علم الباحث، لذا يتطلّب تحطيم هذا الموروث من ميور أن يأتي بحجج دامغة وأن لا يعوّل على فرضيّات اعتباطيّة لا تمتّ للكعبة بصلة مباشرة، قائمة على القياس والتأويل الأيديولوجي.
(202)
يذكر ميور: «أنّ أحفاد إسماعيل، النباطيّين Nabatheans أو النبيت الذين ينحدرون من إبراهيم استقرّوا في مكّة بعد أن جذبتهم آبارها وموقعها المميّز»، ويرى أنّهم: «نقلوا معهم الأساطير الدينيّة ذات الأصول الإبراهيميّة وعمدوا إلى مزاوجتها مع الأساطير الوثنيّة المحلّيّة بفعل ارتباطهم بعلاقة مصاهرة مع سكّان مكّة ذوي الأصول اليمنيّة وتبعًا لذلك المركب نشأت عبادة الكعبة في مكّة».
كذلك عوّل ميور على أثر اليهود في تعريف العرب بتاريخ إبراهيم قائلًا: «حَمل اليهود الذين نزحوا جنوبًا نحو وسط الجزيرة العربيّة التراث الإبراهيمي إلى مستوطناتِهم الجديدةِ، وأعادَوا إنتاجه بين البدو الذين نَظرواَ إلى دينهم وكُتُبِهم المقدّسةِ نظرة احترام وتبجيلَ، و«إنّ الموروث الإبراهيمي انتقل إلى مكّة بفعل اليهود وحافظ على ديمومته من خلال التماس المباشر والمستمر معهم»، «فالأسطورة الإبراهيميّة بمجملها من ابتداع العقل اليهودي بغية عقد الصلة بينهم وبين العرب في مسألة النسب المشترك من إبراهيم، فإن كان إسحاق أبًا لليهود وأخوه إسماعيل أبًا العرب فعندها يتوجّب على العرب حسن معاملة اليهود النازلين بينهم ومن ثم تيسير تجارتهم في شبه الجزيرة العربيّة»، «فعندما تمتزج خرافة مكّة مع المفهوم الواهن الذي يقطع بأن إبراهيم وإسماعيل هما الأسلاف العظماء لهذا العرق، سيحظى بالمصادقة ويلقى مثل هذا الرواج ويغدو حينها التّراث اليهودي مرحَّب به وبشغف».
إن هذه الرؤية يتمخض عنها سؤال مؤدّاه: إلى أي مدى يمكن أن يكون تأثير
النبطيّون واليهود في توجيه التصوّرات العربيّة نحو تبنّي فكرة الجذور الإبراهيميّة للقضيّة؟ فإذا كانت سيرة إبراهيم لا تمتّ بصلة إلى تاريخ مكّة وكعبتها حسب رأي ميور، كيف يكون لإبراهيم مثل هذه المكانة في تصوّرات البدو الوثنيّين؟ وهل يمكن أن يكون للمهاجرين من النبطيّين واليهود مثل هذا التأثير، لدرجة إزاحة الجذور الحقيقيّة لهذا الموروث وتأصيله بسيرة إبراهيم وإسماعيل؟ وعلى فرض حدوث ذلك كم المدّة الزمنيّة التي اقتضت لحدوث هذا التأثير؟ وبغية الإجابة ينبغي الوقوف على تاريخ هذه الهجرات وبيان مقدار التباين الفكري بين القبائل الإبراهيميّة المهاجرة والسكّان المحلّين على الرغم من إغفال ميور لذلك.
أورد وليم ميور أنّ أحفاد إسماعيل انقسموا إلى قسمين: الأوّل، النبطيّون أو النبط كما شاعت تسميتهم نسبة إلى نبايوت بن إسماعيل الذين خلفوا العماليق على منطقة البتراء، والفرع الآخر، القيداريّون نسبة إلى قيدار بن إسماعيل المشهور بين أسلافه العرب، وقد ورد في العهد القديم أن تسمية الإشماعيليون جاءت نسبة إلى إسماعيل، ومعنى الاسم «يسمع إلهي»، وقد أطلق بعض المؤرخين الكلاسيكيّون لفظة الإشماعيليّين على الأقوام الذين كانوا يقطنون البراري في «قادش» وفي بريّة «فاران»، أو مدين حيث «جبل حوريب»، يرى بعض علماء التوراة أنّ كلمة «عرب» مرادفة عندهم لكلمة «إشماعيليين أي قبائل بدوية تتنقل من مكان إلى مكان، طلبًا للمرعى وللماء وكانت تسكن أيضًا في المناطق التي سكنها الأعراب، أي أهل البادية، يذكر ستوب Stubbe أنّ الجزيرة العربيّة اكتسبت تسميتها تبعًا لمدينة عربة التي تقع قرب المدينة المنورة الحالية التي كان إسماعيل أوّل من سكنها، وانتشرت هذه التسمية لتشمل جميع أجزاء الجزيرة.
على الرغم من أنّ بداية تاريخ الإسماعيليّين في القرن 19ق.م لكن ليس من أخبارهم القديمة ما يعوّل عليه، والغالب أنّهم كانوا أقوامًا خاملي الذكر، ورد أوّل ذكرهم في التوراة في قصّة يوسف في القرن 18ق.م، وكانوا يحملون التجارة إلى مصر وكانوا هم الذين اشتروا يوسف وباعوه بمصر، ثمّ جاء ذكرهم في سفر القضاة ويسمّون هناك بني المشرق وتطوّر إلى الإسماعيليين وبعد ذلك بخمسة قرون أُخر ذُكروا في سفر أشعيا باسم القيداريّين، وقيدار ابن إسماعيل في التوراة، وأصبحت الإسماعيليّة في عرف التوراة من ذلك الحين قبيلتين قيدار ونبيت.
ورد في التوراة أنّ إسماعيل كان له اثنا عشر ولدًا، أمّهم رعلة بنت مضاض بن عمرو الجرهمي، أو رعلة بنت يشجب بن يعرب حسب ما أورده ابن الكلبي، كما ذكر أنّ لإسماعيل امرأة من العماليق.
وذهب اليعقوبي إلى أنّ قيدار الولد البكر لإسماعيل من زوجته الحنفاء بنت الحارث الجرهمية، ويدعى أحيانًا أبو العرب، وقد زعم بعضهم أنّه كان نبيًّا، بينما إشارة التوراة إلى أنّ أولاده كانوا قبائل بدو وكان موطنهم الصحراء، وكانوا يزاولون حرفة الرعي وكان لهم قوّة وعددًا ضخمًا، فيهم جماعة مهرت برمي السهام، وحياتهم كانت حياة غزو، كما أشارت أيضًا إلى مملكة قيدار التي عصفت بها جيوش بابل.
وقد وردت أقدم الإشارات الأثريّة بشأن قيدار ونبايوت في النّصوص الآشوريّة إذ تشير الدراسات الأثريّة أنّ مملكة قيدار كانت من أقدم الممالك المعروفة اتّخذت من أدوماتو «دومة الجندل» عاصمة لها، وبدأ ذكرهم يظهر لأوّل مرة في المدوّنات الآشوريّة خلال القرن التاسع ق.م إبّان عهد شلمنصر الثالث (858-824 ق.م).
أمّا النبيت فمن الباحثين من قرنهم بلفظ النبياتيين الوارد في مدوّنات «تغلات بلاصر الثالث 745 – 727ق.م»، ومدوّنات اسرحدون واشور بانيبال، ويبدو أن اللفظة تشير إلى قبيلة أرامية التي كانت تعيش في القرن الثامن ق.م على ضفاف الفرات ولعلّها القبيلة التي ثارت على أشور بانيبال، ومن الباحثين من قرن بينها وبين لفظ نبايوت التي وردت في التوراة التي أفادت بأنّهم أبناء «نبايوت» ابن إسماعيل، ويظهر أنّهم كانوا أقوياء كثيري العدد، ويدل ورود اسمهم مع قيدار في النّصوص الآشوريّة على أنّهم كانوا متجاورين، لكنّ المسعودي أشار إلى أن أصولهم ترجع إلى نبيط بن ماش بن إرم ابن سام بن نوح.
ويرى جواد علي أنّ النّبط من أهل جزيرة العرب في الأصل، نزحوا من البوادي إلى أعالي الحجاز فأقاموا بها، وسرعان ما استقرّوا، فأقاموا لهم مستوطنات زراعيّة واستقرّوا في المدن والقرى، محترفين بمختلف الحرف وفي طليعتها التجارة فجمعوا من ذلك مالًا وثراءً، وقد ذهب بعضهم إلى أنّ أصلهم من العربيّة الجنوبيّة، وأن عرقهم هذا هو الذي جعلهم يشتغلون بالزراعة وبالعمارة وبالحرف التي كانت مألوفة عند العرب الجنوبيّين منذ العهود القديمة، وهم أقرب إلى قريش وإلى القبائل الحجازيّة التي أدركت الإسلام من العرب الذين يعرفون بـ «العرب الجنوبيّين»، والنّبط يشاركون قريشًا في أكثر أسماء الأشخاص، وخطّ النّبط قريب جدًّا من خط كتبة الوحي، وقد ورد ذكرهم في خبر مرفوع عن ابن عباس أو عن الإمام علي: «نحن معاشر قريش من النّبط من أهل كوثى ريا، وقيل: إنّ إبراهيم ولد بها، وكان النّبط سكّانها»لذلك يمكن أن نعدّ شهادة ابن عباس تأكيدًا على الدلالة التوراتيّة أصل نبايوت بن إسماعيل.
تمكّن النّبط من تأسيس دولة بعد أن كانوا أعرابًا يعيشون عيشة ساذجة في منتصف الألف الأولى قبل الميلاد في المنطقة الشماليّة الغربيّة من جزيرة العرب، في المكان الذي عرف باسم البتراء Petraea عند اليونان والرومان، لكن العرب سرعان ما تبرأت منهم، وعيّروا بهم، وأبعدوا أنفسهم عنهم، وعابوا عليهم لهجتهم، حتّى جعلوا لغتهم من لغات العجم، وقالوا إنّهم نبط، وإنّ في لسان من استعرب منهم رطانة، وسبب ذلك غلبة الآرامية عليهم؛ ولأنّهم فضلًا عن ذلك خالفوا سواد العرب باشتغالهم بالزراعة وبالرعي وباحترافهم للحرف والصناعات اليدويّة، وهي حرف يزدريها العربي الصميم، ويُعيّر من يقوم بها ويحترفها.
وتذكر المكتشفات الفرنسيّة للنقوش النبطيّة أنّهم كانوا إحدى الشعوب التي هاجرت من الجزيرة العربيّة واستقرّت في بادية الشام استنادًا إلى الدلالات السياسيّة في هذه النقوش التي تشير إلى أنّهم كانوا يمثّلون نظامًا سياسيًّا لا يخرج في مجمله عن النظم المعروفة عند العرب في شتّى مراحل تاريخهم ولا سيّما في التماثل في أسماء ملوكهم مع الأسماء العربيّة مثل الحارث وماليكو.
أمّا بقيّة أولاد إسماعيل فيشير فوستر إلى «ادبئيل» سكن إلى جوار «نبايوت»، أمّا «مبسام»، فلا توجد إشارات عنه، و«مشماع» استوطن في منطقة تتاخم نجد، أمّا «دوما» فقد استوطن في أوّل الأمر في تهامة ولمّا ضاقت بهم الأرض انتقلوا إلى الأرض التي سمّيت إثرهم «دومة الجندل»، أمّا «ميسا» فيذهب فوستر إلى أنّهم نزحوا نحو بلاد النهرين، بينما اتّجه «حدر أو حداد» جنوبًا نحو اليمن، واستوطن «تيما» وأولاده في الفسحة الممتدة بين نجد والخليج العربي، واستوطن «يطور» في «شرق جبيل» أمّا «نافيش»، فلا يرد عنه شيء، وسكن «قيدماه» في محيط اليمن،
وبذلك يبدو كيفيّة انتشار أبناء إسماعيل بين «شور= سوريا» «واليمن= حويلة» كما أشار العهد القديم.
لقد ظهر بعد مراجعة النصوص الواردة بشأن الأوضاع الدينيّة للقيداريّين أنّ أحد آلهتهم كان يدعى «ابيريلو» الذي يرمز إلى عقيدة التّوحيد، علاوة على ذلك لم نقف على أي نصّ يفيد بأنّ الإسماعيليّين شرعوا بالهجرة والاستيطان إلى مكّة بفعل فواعل الجذب الاقتصادي، بل على العكس فإن أغلب الإشارات المتوفّرة في هذا الصدد تُجمع على أنّهم قبائل تنحدر من الجزيرة العربيّة، ويبدو من هذا التّقارب أن بعض القبائل الإسماعيليّة نزحت من مكّة إلى موطن جدها إبراهيم في الشمال، إذ تشير المصادر إلى أن مكّة ضاقت بأبناء إسماعيل بعد وفاته فانتشروا في البلاد، ولعلّهم تمكّنوا من تأسيس مستوطنات زراعيّة في حدود القرن التاسع قبل الميلاد أوقبلها، ومن ثمّ تحوّلت هذه الأقوام بمرور الزمن من حياة البداوة إلى حياة الحضارة والزراعة، ومن المستبعد أن يكون خطّ هجرة القبائل الإسماعيليّة باتّجاه الصحراء جنوبًا، والراجح أنّ الفكر الإبراهيمي ظلّ متأصّلًا في مكّة بسبب من بقي من أولاد إسماعيل، ومن ثمّ نستبعد أن تقوم هذه القبائل بهجرات عكسيّة إلى مكّة بفعل عوامل الجذب الاقتصادي كما اعتقد ميور.
وقد ذكرت التوراة أنّ إبراهيم تزوّج مرّة ثالثة بامرأة اسمها قطورة فَوَلَدَتْ لَهُ ستة أولاد، نزحوا جميعهم من أرض كنعان إلى الجزيرة العربيّة في الأراضي المتاخمة للخليج العربي، ولعلّ ميور قد وقع في خلط بينهم وبين أبناء إسماعيل لأنّهم القبائل الإبراهيميّة الوحيدة التي يتوفّر عنها إشارات بشأن وفادتها إلى الحجاز خلافًا لما افترضه ميور بشأن القيداريّين والنّبط، فلعلّ الإشماعليّين جاؤوا كناية عن اختلاط قبائل الإسماعيلية مع الأقوام الإبراهيمية الأخرى من أبناء قطورة.
أمّا بِشأن التراث الإبراهيمي وعدّه منصهرًا من الموروث الوثني والتراث الإسماعيلي الوافد؛ فذلك أمر غير منطقي يتعارض تمامًا مع ما ذهب إليه سابقًا بشأن عراقة الكعبة ومسألة تبجيل العرب لها منذ عهود موغلة في القدم فإن كانت العرب قد اعتنقت دين الكعبة الوثنيّة منذ فترات بائدة فما الدّاعي إلى إضفاء اسم إبراهيم على ذلك المعبد لاحقًا بدعوى أن الإسماعيليّين أضافوا اسم جدّهم إبراهيم إلى الكعبة؟
وعلى فرض صحّة هذا الزعم فهل ستتقبّل الأقوام التي تبجّل الكعبة مثل هذا التغيير؟ إنّ هذه المحاولة ستلقى رفضًا واسعًا حتمًا من قبل وثني مكّة.
وإذا كانت الكعبة معبدًا وثنيًّا للإله قد تمّ محواسمه بعد هجرة الإسماعيليّين إلى مكّة فإنّ حدوث هذا التّركيب للمفاهيم سيجعل اسم ذلك الإله مقترنًا مع اسم الله تعالى الذي نقله الإسماعيليّون، لكن لم يعثر على إشارة لأي صنم اقترن ذكره بتاريخ الكعبة.
وبغية الوقوف على حقيقة فرضيّة ميور عن صلة اليهود بهذا التراث ينبغي أن نتتبّع تاريخ وجودهم في شبه الجزيرة العربيّة للوقوف على أثرهم المحتمل في التصوّرات الوثنيّة العربيّة.
إنَّ المَعْنَى الشَّائِعَ لِمُصْطَلَح «يَهُودِيٍّ» دِينِيٌّ فِي المَقَامِ الأَوَّلِ، فاليَهُودُ أُمَّةُ مُوسَى، وكِتَابُهُمُ التَّوْرَاةُ، اخْتَلَفَ البَاحِثُونَ بشأن أَصْولهم، فقَالُوا، جَاءَتْ بَعْدَ عِبَادَةِ بَنِي
إِسْرَائِيل للعِجْلِ (إِنَّا هُدْنَا إِلَيْكَ) (سورة الأَعْرَافِ: الآية 156) أَيْ تُبْنَا فَسُمُّوا بْاليَهُودِ التَّائِبِينَ، أو تَرْجِعُ إلى يَهُوذَا أَكْبَرُ أبناء يَعْقُوبَ، فَقَلَبَتِ العَرَبُ الِذَالَ دَالا، أو إنَّهُمْ سُمُّوا باليَهُودِ لإِطْلاقِهُمْ اسْمَ يَاهُوة Yhwa عَلَى اللهِ سبحانه فَسُمُّوا بِاليَهُودِ لأَنَّهُمُ أَتْبَاعُ الرَّبِّ يَاهُوة، إلهِ آبائِهِمْ إبراهيم وَبَنِيهِ، ثُمَّ عُرِفَ بِهَذَا الاسْمِ أَحَدُ الأَسْبَاطِ الاثني عَشَرَ التِي تَكَوَّنَ مِنْهَا شَعْبُ إِسْرَائِيلَ، ويَرَى غَيْرُهُم بِأَنَّهُم سُمُّوا بِهِ لأنَّهُم كَانُوا كُلَمَّا جَاءَهُم نَبِيٌّ هَادُوا إلى مَلِكِهِم وَدَلُّوا عَلَيْهِ لِيَقْتُلُوهُ، فَيكُونُ لَفْظُ اليَهُودِ خَاصًّا بِالمُنْحَرِفِينَ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيل، ظهرت هذه التسمية بعد نفي اليهود إلى بابل عام 587ق.م فقد سمّي المنفيّون باليهود، ويفضِّلُ البَاحِثُونَ إطلاق تسمية بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى المَرْحَلَةِ المُمْتَدَّةِ مِنْ يَعْقُوبَ عليهالسلام وَأَحْفَادِهِ حتّى رَحِيلِ بَنِي إِسْرَائِيلَ إلى مِصْر، أمّا لَفْظُ المُوسَوِيِّينَ فنسبة إلى مُوسَى وتُطلق عَلَى بَنِي إِسْرَائِيل أثناء وُجُودِهِم فِي مِصْر وفِلَسْطِينَ، ومنذ عام 515ق.م ترك ذكر الأسباط وسُمّي الإسرائيليّون يهودًا، ودُعيت بلادهم اليهوديّة.
ظهر بنو إسرائيل في التاريخ بعد أن خرجوا من مصر في عهد موسى الذي عاش في حدود الأعوام 1250-1350 ق.م حسب أرجح التّقديرات، ولم يكن لهم قبل ذلك وجود ملحوظ في الأحداث التاريخيّة.
ويصعب تحديد زمن هجرتهم إلى الحجاز بدقّة، فمن المحتمل أن تكون هجرتهم قد حدثت خلال السبي البابلي إبّان عهد نبوخذ نصر عقب إنزاله الهزيمة بمملكة يهوذا عام 586 ق.م؛ وقد يجوز أن يكون قوم منهم قد جاؤوا مع نبونيد ملك بابل 539-556 ق.م إلى تيماء حينما اتّخذها عاصمة له.
وقد ذكرت بعض المصادر اليهوديّة أنّ اليهود ظهروا في الحجاز بعد ميلاد المسيح، وقد تمكّنوا من الاستيلاء على يثرب وفدك وتبوك وخيبر ووادي القرى، ويرجح أن يكون بنو قينقاع أوّل القبائل التي غزت يثرب من بقايا العرب اللحيانين، ولعبت دورًا في هجرة قبيلتي قريظة والنضير لاحقًا، ومن ثم إقامة الحصون للتحصن من هجمات البدو، ولعلّ اليهود غادروا فلسطين باتّجاه الحجاز في المدّة الواقعة بين تدمير معبد الهيكل على أيدي القيصر تيتوس Titus عام 70م وبين تنكيل الإمبراطور الروماني هدريان Hadrian باليهود عام 132م أو ربّما نزحوا بجموعٍ غفيرةٍ إلى مختلف الأرجاء في البلدان المجاورة، وقد حلّ عدد منهم في خيبر ومناطق أخرى من الحجاز، في أعقاب حملة الرومان الأخيرة، ويلفت ولفنسون إلى هجرة عناصر يهوديّة من فلسطين نحو الأقاليم العربيّة في عصور مختلفة ولأسباب شتّى، غير أنّها بادت كما بادت قبائل عربيّة كثيرة.
تختلف المصادر الإسلاميّة في تحديد أصول اليهود في جزيرة العرب، فمن الإخباريّين من ينكر صلتهم بيهود فلسطين ويعدّهم من العرب المتهوّدين؛ من خلال عقد الصلة بين نسلهم وبين جيش موسى الذي قاتل العماليق، والبعض يذهب إلى أنّ يهود اليمن من العرب المتهوّدين ويرجع زمن اعتناقهم لليهوديّة إلى القرن الخامس ق.م أو أنّ قبائل اليهوديّة كانت تسكن بلاد العرب منذ عهد بعيد جدًّا، على أساس أنّ هزيمة العماليق في الحجاز حدثت على يد بني إسرائيل الذين أرسلهم موسى، لكن يهود الحجاز وسّعوا هذه القصّة ونقلوا حرب موسى
مع العمالقة إلى الحجاز؛ ليرجعوا زمان استيطانهم في الحجاز إلى ذلك العهد.
ويرتاب ولفنسون من هذا النوع من الأخبار وَيعدّها أساطير شائعة لا يعوّل عليها ويرى في ذلك قوله: «واذا لم يتمكن مؤرخو العرب من بلوغ أخبار ثابتة موثوق بها عن اليهود في بلاد العرب فكيف يستطيعون أن يصلوا إلى أخبار حقيقيّة عن طوائف إسرائيليّة قديمة اندثرت»، ويذكر أيضًا: «لقد أخذ أهل الأخبار ما رووه عن دخول بني قينقاع إلى يثرب في أيام موسى وجيشه، ثم ما رووه عن سكنهم القديم في أطراف المدينة وفي أعالي الحجاز من التوراة، كذلك لا يمكن الاطمئنان إلى الأخبار القليلة التي نصّت عليها صحف العهد القديم بطريقة غير مباشرة عن وصول جموعٍ إسرائيليّة إلى الجزيرة العربيّة، ولا نستطيع أن نثبت هذه الأخبار إثباتًا حقيقيًّا».
ولعلّ ملابسات اعتناق بعض العرب لليهوديّة يلفّها الغموض فاليهود يَعُدّون اليهودية وقفًا عليهم لأنّهم شعب الله المختار ولا يجوز أن يعتنقها غيرهم، وهناك من يرى أنّ بني قريظة وبني النضير فرعان من قبيلة بني جذام العربيّة، وأن كثيرًا من يهود الحجاز من أصول عربيّة، لكن الراجح أنّ قبائل قينقاع وقريضة والنضير كانت من اليهود الخلص، وكانوا يعتزون بنسلهم كما كان الشاعر كعب بن سعد القرظي يفاخر بنسبه إلى الكاهنين «هارون وعازار»، كما أنّ القرآن الكريم خاطب اليهود على أنّهم بنو إسرائيل؛ ما يوحي بأنّه يعدّهم السلالة الصحيحة لبني اسرائيل.
ويبدو أنّ المدّة التي بلغت فيها الهجرات اليهوديّة إلى الحجاز كانت قريبة من تاريخ ظهور الوثنيّة في مكّة المقترن بعمرو بن لحي الخزاعي، في حدود عام 200م؛
بحسب شهادة ميور، ولعلّ هذه المدّة القصيرة لا تكفي لإحداث مثل هذا الأثر على التصوّرات العربيّة، في ظل علاقة احتقار متبادل بين العرب واليهود، فكان اليهود يعتقدون بتفوّقهم على العرب لأنّهم ليسوا كتابيّين واعتقادهم بأفضليّتهم على العالمين؛ بصفتهم أولياء لله ونظرتهم إلى العرب على أنّهم أبناء الجارية «سراقيّين Saraceni»، وفي يثرب كان العرب قلّة عندما غزاها اليهود في القرن الأوّل أو القرن الثاني الميلادي وقتلوا عددًا منهم وكانت الغلبة لهم حتّى بعد نزوح قبيلتي الأوس والخزرج إلى يثرب، ما بين القرنين الرابع والسادس الميلادي، فقد عامل اليهود العرب أسوأ معاملة، بالاستيلاء على أراضيهم وسلب أموالهم والتضييق عليهم في العيش وإلزامهم بأداء الخراج، وبلغ الأمر حدَّ أنّ أحد ملوكهم يدعى «الفطيون»، كانت له في الأوس والخزرج سُنّة ألّا يُتزوّج بامرأة منهم إلّا افتضّها قبل زوجها، فبلغ ذلك «أبا جبيلة» أحد ملوك الشام فقصد المدينة مظهرًا أنّه يريد اليمن، ثم أرسل إلى وجوه اليهود أن يحضروا طعامه، فأتاه وجوههم وأشرافهم، لماّ تكاملوا أدخلهم في خيامه وقتلهم عن آخرهم فصارت الأوس والخزرج من يومئذ أعزّ أهل المدينة وقمعوا اليهود وسار ذكرهم وصار لهم الأموال والآطام.
ويبدو أنّ المراجع اليهوديّة التزمت جانب الصمت في سرد حوادث اليهود في الجزيرة العربيّة، وهذا يدلّ على أنّ اليهود في جزيرة العرب كانوا منقطعين تمامًا عن بقيّة أبناء جلدتهم في بقية جهات العالم ومنذ القرن الأوّل بعد الميلاد واليهود يهاجرون إلى الواحات ليصبحوا فيها من ذوي الثراء وعلى الرغم من شدّة الحاجة إلى خدماتهم كفلّاحين وتجّار وصاغة فقد كان البدو لا يثقون بهم ومن هنا لم
تستطع اليهوديّة أن تؤثّر في حياة العرب الدينيّة تأثيرًا أكبر من الذي كان لها في الواقع .
وهل يعقل أن يكون لمجموعة نازحة دور فاعل في إزاحة مفاهيم جوهريّة على غرار الكعبة والنسب؟ «إنّ البيئة الجديدة شلّت قوى اليهود الروحيّة، فغلبت عليهم النزعة البدويّة حتّى صارت صاحبة السلطان على أفكارهم ونفسيّتهم، ولم يظهر شيء من النبوغ والعبقريّة في يهود بلاد العرب مطلقًا ولم تشتهر بينهم شخصيّة واحدة في كل عصورها بالرقي الفكري فهناك شهادات من يهود مدينة دمشق وحلب في القرن الثالث الميلادي؛ كانوا ينكرون وجود اليهود في الجزيرة العربيّة ويقولون إنّ الذين يعدّون أنفسهم من اليهود في جهات خيبر ليسوا بيهود حقّا إذ لم يحافظوا على الديانة التوحيديّة ولم يخضعوا لقوانين التلمود خضوعًا تامًّا، ولم يلبث اليهود أن تخلقوا بأخلاق العرب وسلكوا سبيلهم في النظم والتقاليد الاجتماعيّة حتّى غَدَوا كأن لم يكونوا من جنس آخر غير الجنس العربي، ولا يعلم من تاريخ اليهود القديم إقليمًا تأثّر فيه اليهود بأخلاق وعادات وتقاليد أبنائه إلى هذا الحدّ سوى إقليم الجزيرة العربيّة.
لقد بلغ تأثير العرب في اليهود إلى حد أنّهم أصبحوا يتكلّمون اللغة العربيّة على الرغم من أنّها كانت مشوبة بالرطانة العبريّة، وهذا الرأي يخالف ما ذهب إليه ميور في إمكانية التأثير اليهودي العميقة على المخيّلة العربيّة، فإذا كان اليهود بهذه الحال فكيف لهم أن يقرنوا بين اسم إبراهيم وبين جذور الكعبة؟ ألا يخالف ذلك النظرة المعروفة لليهود تجاه إسماعيل حتّى لو كان باعثهم لذلك كسب ودّ العرب لتيسير تجارتهم، وهل يعقل أن يكون اليهود أصحاب الفضل في بلوغ العرب لهذه المنزلة الرفيعة في الجاهليّة؟ فإن كانت هنالك نظرة تبجيل من لدن
العرب إلى موروث اليهود فمردّه إلى العقليّة المثيولجيّة العربيّة ولا سيّما في القضايا الغيبيّة، لأنّ التوراة حملت بين دفّتيها تنبؤات رسّخت تصوّرات غيبيّة وأعطتها دفعة إلى الأمام بعد أن تحوّلت الكلمات التي كان يتلفّظ بها المتنبّئون بالحوادث وكهنة المعابد إلى نصوص مقدّسة، وبعد أن أخذت ترد مسندة إلى أنبياء لهم اتّصال بالسماء على الرغم من سلفهم من الذين عوّلوا على اِتّباع السحر والكهانة في معرفة تلك الحوادث، ذلك كلّه جعل من اليهود في نظر العرب أمّة ذات علم وآرائهم تتّسم بجانب من الوثاقة، لكن ذلك لا يعني أن معرفة العرب قامت على أسس يهوديّة ولا سيّما وأن موروث إبراهيم في مكّة قائم على موروث تاريخي راسخ في المخيّلة العربيّة.
إنّ الروايات الحيّة تنتقل من جيل إلى آخر من خلال الذاكرة الشعبيّة وليس من خلال الذاكرة الفرديّة لقبيلة محدّدة، فمن غير الصواب أن تكون القبائل العربيّة استعارت نسبها إلى إبراهيم من ذاكرة اليهود لأنّه لا يوجد شعب ينسى أصوله ويتبنّى أصول قوم آخرين بدعوى أنّهم يشاركونهم الجدّ نفسه، وعلى فرض أنّ اليهود قد نبّهوا العرب إلى الأصل المشترك الذي يجمعهم بإبراهيم فلا بدّ أنّ اليهود قد أخبروا العرب عن جدّهم إبراهيم وأنّه على دين التّوحيد وأنّ طقوس مكّة لا تمتّ إلى إبراهيم بأيّ صلة، والحصيلة أنّ القبائل العربيّة لن تربط بين اسم إبراهيم وطقوس الكعبة، ولا سيّما بعد أن أقرّ ميور بأنّ القبائل العربيّة تربط بين الكعبة وبين إبراهيم منذ عهد بعيد قبل البعثة المحمّديّة.
زد على ذلك فإنّ المصادر التاريخيّة لم تذكر أن الهجرات اليهوديّة توجّهت صوب مكّة، على الرغم من بعض الإشارات، ولعلّ هذا الوجود كان مقترنًا بالنشاط التجاري، أو بسبب تجارة العبيد؛ ولا يخرج عن كونه صورةً من صور الإقامة
الفرديّة. وصفوة القول: من العسير أن تكون لهذه الأقليّة دور في زحزحة المفاهيم المتداولة في مكّة عن أصول الكعبة وشجرة الأنساب، ويبدو أن المخيّلة الدينيّة العربيّة كانت عصيّة على المؤثّرات اليهوديّة، ولا سيّما بعد فشل أغلب محاولات تهويد العرب باعتراف منصف أدلى به ميور في معرض حديثه عن أحوال يثرب عشيّة المبعث المحمّدي قائلًا: «لقد انتشرت عقيدة الإيمان من بيت إلى بيت ومن قبيلة إلى أخرى وقد اعترت الدهشة وجوه اليهود الذي طالما حاولوا ولأجيال خلت إخراج العرب من حالة الوثنيّة المدقعة لكن دون جدوى، وفجأة نبذوا أصنامهم وأعلنوا إيمانهم بعقيدة الإله الواحد»، لذا نستبعد أن يكون لموروث اليهود تأثير على العرب بقدر ما أثّرت البيئة العربيّة على اليهود تبعًا لهذا الإقرار.
(219)
ذهب وليم ميور إلى إنكار النبوّة في إسماعيل وفي ذرّيته قائلًا: «إنّ القاعدة التي ننطلق منها لخوض هذا الجدل؛ الوعد الذي واعد به الربّ إبراهيم في جعل النبوّة في ذريّته، فقد وعد الربّ أن يورث الازدهار الدنيوي في ذريّة إسماعيل وقد حقّق الربّ وعده، فأولاده الاثنا عشرَ أصبحوا اثني عشرَ أميرًا على قبائلهم، وزاولوا مهنة التجارة وباتوا بعد ذلك من ذوي القوّة والثراء»، «أمّا النبوّة والكتاب فإرث خاص ببني إسرائيل وإنّ إسماعيل نجل الخادمة لم يكن أبدًا هِبَة الربّ مثل إسحاق ولم يكن يومًا نبيًّا ولا سلفًا لنبي».
لا ريب أنّ ميور لا يرمي إلى تكرار الرؤية التوراتيّة بِشأن إنكار نبوّة إسماعيل فحسب؛ بل يبدو إنّ ضالّته الرئيسة كانت عزل الرّسول صلىاللهعليهوآله عن هذا الخطّ، ولا سيّما مع ارتيابه من مسألة نسب الرّسول صلىاللهعليهوآله إلى إبراهيم، وبغية الوقوف على ملابسات هذه القضيّة يتحتّم أن يُقدّم بيانٌ لمفهوم النبوّة وحيثيّاتها تبعًا للمرتكزات الكتابيّة التي أقام ميور عليها رؤيته.
النبوّة لغةً: من نبأ، والنَبأُ الْخَبَرُ، وَالْجَمْعُ أَنباءٌ، وإنَّ لِفُلَانٍ نَبَا؛ أي خَبَرًا والنبيُّ مَنْ أَنْبَأَ عَنِ اللَّهِ وَقِيلَ: النَّبيُّ مُشْتَقٌّ مِنَ النَّبَاوةِ، أو الشيءُ المُرتفِعُ، والنبوّة اصطلاحًا؛ سِفارَةٌ بَين اللَّهِ وَبَين ذَوِي العُقولِ الزَّكِيَّة لإِزَاحَةِ عِلَلِهَا، ولعلّ جوهر القضيّة يرتكز على إجماع التوراة والقرآن في أن الله جعل النبوّة في إبراهيم ونسله، فيؤسّس أهل التوراة على نص العهد القديم: «أمّا أَنَا فَهُوَذَا عَهْدِي مَعَكَ، وَتَكُونُ أَبًا لِجُمْهُورٍ مِنَ
الأُمَمِ، فَلاَ يُدْعَى اسْمُكَ بَعْدُ أَبْرَامَ بَلْ يَكُونُ اسْمُكَ إِبْرَاهِيمَ، لأَنِّي أَجْعَلُكَ أَبًا لِجُمْهُورٍ مِنَ الأُمَمِ. وَأُثْمِرُكَ كَثِيرًا جِدًّا، وَأَجْعَلُكَ أُمَمًا، وَمُلُوكٌ مِنْكَ يَخْرُجُونَ. وَأُقِيمُ عَهْدِي بَيْنِي وَبَيْنَكَ، وَبَيْنَ نَسْلِكَ مِنْ بَعْدِكَ فِي أَجْيَالِهِمْ، عَهْدًا أَبَدِيًّا، لأَكُونَ إِلهًا لَكَ وَلِنَسْلِكَ مِنْ بَعْدِكَ. وَأُعْطِي لَكَ وَلِنَسْلِكَ مِنْ بَعْدِكَ أَرْضَ غُرْبَتِكَ، كُلَّ أَرْضِ كَنْعَانَ مُلْكًا أَبَدِيًّا. وَأَكُونُ إِلهَهُمْ».
أمّا الرؤية القرآنية فجاءت في قوله تعالى: (وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِ النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ) (سورة العنكبوت: الآية 27) والإشارة إلى إبراهيم، أي إن الله تعالى لم يبعث نبيًّا بعد إبراهيم إلّا من نسله، وإنّ أكثر الأنبياء من ذريّة إبراهيم، وعلى ذريّته أنزل الله تعالى التوراة والإنجيل والزبور والفرقان.
ويعلّق القدّيس أوغسطين Saint Augustine (354-430م) على نصّ العهد القديم قائلًا: «إنّ إبراهيم قد نال من الوعد الإلهي شيئين، الأوّل وراثة نسله لأرض كنعان، كما ورد: «أجعلك أمّة عظيمة»، أمّا الثاني فهو ليس بالوعد الجسدي بل هو وعد روحي، يكون إبراهيم من خلاله أبا للأمّة الإسرائيليّة، و«لكلّ الأمم» التي تقتفي أثر إيمانه بدلالة «وَتَتَبَارَكُ فِيكَ جَمِيعُ قَبَائِلِ الأَرْضِ»، وبذلك يظهر أن الوعد لإبراهيم له من الشموليّة بحيث يتجاوز دائرة الاحتكار في ذريّة إسحاق، وقد أظهر العهد القديم أنّ الله تعالى جعل هذا العهد في نسل إبراهيم دون استثناء وجعل له علامة له ولنسله وهي الختان: «وَأَمَّا أَنْتَ فَتَحْفَظُ عَهْدِي، أَنْتَ وَنَسْلُكَ مِنْ بَعْدِكَ فِي أَجْيَالِهِمْ. هذَا هُو عَهْدِي الَّذِي تَحْفَظُونَهُ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ، وَبَيْنَ نَسْلِكَ مِنْ بَعْدِكَ: يُخْتَنُ مِنْكُمْ كُلُّ ذَكَرٍ، فَتُخْتَنُونَ فِي لَحْمِ غُرْلَتِكُمْ، فَيَكُونُ عَلاَمَةَ عَهْدٍ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ».
وإلى ذلك يشير القسّ منيس عبد النور قائلًا: «إنّ الختان لم يكن شيئًا جديدًا رسمه الله لإبراهيم، فقد كان معروفًا من قبل، لكنّ الله جعل للختان معنىً مغايرًا، عندما طلب أن يكون الختان علامة العهد، وهذا يماثل قوس قزح الذي اتّخذ منه الله علامة عهد بينه وبين نوح بعد الطوفان فالختان علامة طاعة الله يضع ثقته فيه، وجعل علامة هذا الفرز والتخصيص في لحم من يرضى أن يدخل في العهد معه».
يبدو أنّ محاكمات وليم ميور تنبع من روح توراتيّة مُصمتة قطعت بأنّ العهد مع الله سرعان ما تحوّل من نسل إبراهيم عامّة إلى نسل إسحاق بنحو خاص بعد أن جاءت البشرى بمولد إسحاق في السنة التالية لتكون النبوّة وقفًا على إسحاق ونسله؛ أمّا بركة النسل والكثرة فحلّت في إسماعيل ونسله: «وَقَالَ إبراهيم للهِ لَيْتَ إسماعيل يَعِيشُ أَمَامَكَ فَقَالَ اللهُ: بَلْ سَارَةُ امْرَأَتُكَ تَلِدُ لَكَ ابْنًا وَتَدْعُو اسْمَهُ إِسْحَاقَ وَأُقِيمُ عَهْدِي مَعَهُ عَهْدًا أَبَدِيًّا لِنَسْلِهِ مِنْ بَعْدِهِ وَأَمَّا إسماعيل فَقَدْ سَمِعْتُ لَكَ فِيهِ هَا أَنَا أُبَارِكُهُ وَأُثْمِرُهُ وَأُكَثِّرُهُ كَثِيرًا جِدًّا اِثْنَيْ عَشَرَ رَئِيسًا يَلِدُ، وَأَجْعَلُهُ أُمَّةً كَبِيرَةً. وَلكِنْ عَهْدِي أُقِيمُهُ مَعَ إِسْحَاقَ الَّذِي تَلِدُهُ لَكَ سَارَةُ فِي هذَا الْوَقْتِ فِي السَّنَةِ الآتِيَةِ».
ولعلّ هذا النصّ بمثابة الأساس الأيديولوجي الذي كان أهل الكتاب يُشيعون أفكارهم بين العرب في احتكارهم النبوّة، في إطار نظرة فوقيّة لا يمكن لابن الأَمَة أن يكون نبيًّا في وسط يؤمن بدونيّته أمام ابن السيدة، ولعلّ هذه النبرة كانت حاضرة في رؤية ميور عندما أشار إلى إسماعيل «نجل الخادمة»؛ ما يوحي أنّه لم يتحرّر من هذه النظرة الفوقيّة.
إنّ النبوّة في التوراة تتمحور حول كلمة «العهد» كما ورد في النصوص السابقة.
والعَهْد لغةَ، المَوْثِق، أو الالتقاء والإلمام، والعَهْدُ جمع العَهْدَةِ وهو الميثاقُ واليَمِينُ التي تَسْتَوثِقُ بها ممّن يُعاهِدُكَ، وكلمة «عهد» في العبريّة هي «بريت» التي تعني اتّفاقًا أو ترتيبًا ولعلّها مشتقّة من الكلمة العبريّة «بارًا» أي «أكلوا خبزًا معًا»؛ ما يوحي بأنّ الأطراف المتعاقدة كانوا يأكلون خبزًا معًا عند توقيع الاتّفاق، أو لعلّها مشتقّة من الكلمة الأكدية «بيرتو» التي تعني «قيدًا» التي تدلّ على «تقيّد» الأطراف بالمعاهدة، فالعهد اتّفاق بين طرفين أو أكثر، بشكل ميثاق، يعقد بين طرفين، بناء على رضاهما، وأهم العهود في الكتاب المقدّس عهد الله للبشر.
والعهود بين الله والإنسان، يمكن أن تكون عهودًا من طرف واحد، مثل العهد لإبراهيم، لكن حتّى العهود أحاديّة الطرف لا تخلو من الشروط في ما يتعلّق بجانب الإنسان، والنتائج إمّا مواعيد بالبركة متى حفظ العهد، أو إنذارات بالعقاب، إذا نقض العهد، كذلك كان هناك وعد بالأرض، والشهرة، والنجاح العظيم وكانت هذه الحقائق نبويّة وأكيدة.
ويذكر وليم باركلي: «إنّ العهود التي قطعها الله عزّ وجلّ مع اليهود تصف كلمة معاهدة أو الفائدة المتبادلة بين الأمم باستمرار الصداقة، وقد دخل الله في عهود خاصة مع إسرائيل كرّرها عبر تاريخهم كما في عهده مع إبراهيم وإسحاق ويعقوب، وعهده على جبل سيناء عندما أعطي موسى الوصايا، فهناك أربع مناسبات عظيمة لدخول الله في عهد مع الناس: العهد الأول كان مع نوح بعد الطوفان، وعلامته قوس قزح تعهّد الله فيه أن لا يعود بغرق الأرض، والعهد الثاني كان مع إبراهيم وعلامته الختان، والعهد الثالث دخلت فيه الأمّة عند جبل سيناء، أمّا العهد الرابع فهو العهد الجديد بالمسيح».
وبعد هذه البيان للرؤية الكتابيّة لقضيّة العهد تستوقف الباحث نقطة مؤداها: لماذا ينسخ الربّ التوراتي عهده بالبركة لإبراهيم ونسله دون استثناء بعهد جديد تصبح فيه النبوّة وقفًا على إسحاق ونسله قبل ولادته بعام؛ ليطرد إسماعيل من العهد الجديد بالبركة على الرغم من رغبة إبراهيم في ذلك، ودون أدنى جريرة من جانب إسماعيل ويومها كان ولده الوحيد؟
إنّ الصبغة التحيّزيّة تظهر في هذا الجزء من العهد القديم في استبعاد نسل هاجر من ميراث العهد، إنّ القصّة كما أظهرت أبحاث علماء الدراسات التوراتية، تمّ جمعها من ستّة مصادر مختلفة بعضها كان مكتوبًا والبعض الآخر كان متداولًا شفويًّا وتمّ جمع هذه الروايات وتدوينها للمرة الأولى في بابل خلال القرن السادس قبل الميلاد، وبعد مرور ثمانية قرون على وفاة موسى وبينما كان إبراهيم الشخصيّة الأساس في هذه الروايات، ويبدو أنّ أحد هذه المصادر جعل سارة محور روايته، وإلى ذلك يشير المستشرق لين Lien: «إنّ تصريح المسيحيّين بأنّ مخلّص العالم سيأتي من ذرية إسحاق وليس من ذرية إسماعيل وهم يعلمون تمامًا بأنّ إسماعيل وإسحاق هما أبناء إبراهيم من أمّهات شرعيّات يعد تصريحًا متحيّزًا».
لقد وُسمت التوراة بالعهد القديم لأنّها تعني النبوّة واحتكار الوحي عليهم ومن ثمّ احتكار المرجعيّة بين بني إسرائيل دون غيرهم والأمر برمّته يمثّل تصوّر اليهود عن النبوّة وليس بالضرورة أن يكون صحيحًا، فثمّة تفسير مسيحي يرى أن العهد لإبراهيم لم يأتِ بمعنى النبوّة الخاصّة لإسحاق وأبنائه لأن العهد لإبراهيم يحمل بين طياته تصورًا لمجيء المسيح، وتبعًا لذلك فإنّ دلالة النسل في العهد القديم تشمل نسل إبراهيم دون استثناء ومنها تكون البشرى بالمسيح أي «نسل إسحاق=العهد=المسيح».
والسؤال هنا ما هي دلالة النسل بالنسبة إلى إسماعيل؟ ألا يؤذن ذلك بوعد بالنبوّة من جانب ذريّة إسماعيل، ولا سيّما وأنّ النسل يأتي من جهة الأب، والمسيح ليس له أب بشري؟
زد على ذلك إنّ إبراهيم شرع بختان إسماعيل قبل البشارة بإسحاق تماشيًا مع العهد؛ بالتّالي لم يستثن إسماعيل من علامة العهد الإلهي: «فَأَخَذَ إبراهيم إسماعيل ابْنَهُ، وَجَمِيعَ وِلْدَانِ بَيْتِهِ، وَجَمِيعَ الْمُبْتَاعِينَ بِفِضَّتِهِ، كُلَّ ذَكَرٍ مِنْ أَهْلِ بَيْتِ إِبْرَاهِيمَ، وَخَتَنَ لَحْمَ غُرْلَتِهِمْ فِي ذلِكَ الْيَوْمِ عَيْنِهِ كَمَا كَلَّمَهُ اللهُ. وَكَانَ إبراهيم ابْنَ تِسْعٍ وَتِسْعِينَ سَنَةً حِينَ خُتِنَ فِي لَحْمِ غُرْلَتِهِ، وَكَانَ إسماعيل ابْنُهُ ابْنَ ثَلاَثَ عَشَرَةَ سَنَةً حِينَ خُتِنَ فِي لَحْمِ غُرْلَتِهِ».
أمّا بشأن العهد مع إسحاق، فلا مناص من أنّ البركة ظهرت مع إسحاق، لكنّ ذلك لا يعني أن يطرد إسماعيل من الوعد والنبوّة، فكانت شهادة سارة خير دليل على ذلك: «ابْنَ الْجَارِيَةِ لا يَرِثَ مَعَ ابْنِي إسحق هو قول قد قبح جدًا في نفس إبراهيم».
ولنا أن نسأل عن أي إرث كان معرض حديث سارة؟ فلو كان الإرث مالًا أو أرضًا فهل ستشفع التوراة حديثها: «وابْنِ الْجَارِيَةِ أَيْضًا سأجعله أُمّة لأَنَّهُ نسلك»؟، ولعلّ حديث الربّ لإبراهيم جاء ردًّا على حديث سارة بمعنى أن إسماعيل سيرث النبوّة مع إسحاق أيضًا.
لقد تعاملت التوراة مع قضيّة علاقة العهد بإسماعيل بنحو يحمل إلى الريبة؛ فقد ذكرت أنّ إسماعيل سيصبح «أمّة عظيمة» في أكثر من موضع: «وَابْنُ الْجَارِيَةِ أَيْضًا سَأَجْعَلُهُ أُمَّةً لأَنَّهُ نَسْلُكَ»، «مَا لَكِ يَا هَاجَرُ؟ لاَ تَخَافِي، لأن اللهَ قَدْ سَمِعَ
لِصَوْتِ الْغُلاَمِ حَيْثُ هُو قُومِي احْمِلِي الْغُلاَمَ وَشُدِّي يَدَكِ بِهِ، لأَنِّي سَأَجْعَلُهُ أُمَّةً عَظِيمَةً»، وورد أيضًا: «وَأَمَّا إسماعيل فَقَدْ سَمِعْتُ لَكَ فِيهِ هَا أَنَا أُبَارِكُهُ وَأُثْمِرُهُ وَأُكَثِّرُهُ كَثِيرًا جِدًّا. اِثْنَيْ عَشَرَ رَئِيسًا يَلِدُ، وَأَجْعَلُهُ أُمَّةً كَبِيرَةً».
ولعلّ سؤال إبراهيم لربّه كان جلِيّ البيان: «لَيْتَ إسماعيل يَعِيشُ أَمَامَكَ»، الذي يبدو أنّه يحمل دلالة واضحة على رغبة إبراهيم في توريث النبوّة في ذرية إسماعيل، لكنّ الرب التوراتي يصرفه عن ذلك ويعده بإسحاق الذي سيصبح وقفًا عليه وعلى ذرّيّته!
وعلى الرغم من ذلك يذهب شرّاح التوراة إلى بيان هذا النصّ بنحو مغاير فيرى القسّ فكري: «إنّ هذا ينطوي على معنيين: الأوّل، أنا يا ربّ مكتف بإسماعيل الذي أعطيتني ولا أطلب المزيد، فلتحفظه ليحيا في طاعتك؛ والثاني إذا كنت ستعطيني ابنًا آخر، فهذا لا تحرمه من بركاتك».
ألم يكن إسماعيل البُشرى الأولى والأعظم في حياة إبراهيم والاستجابة لدعواته بعد أن أمسك عن الإنجاب لستة وثمانين عامًا؟، ألا يمثّل ذلك تحقيقًا للوعد ولا سيّما وأنّ وقع البهجة التي عاشها إبراهيم بولده إسماعيل البكر، يماثل بهجة سارة ببشرى ولدها البكر إسحاق، زد على ذلك أنّ الوعد جاء في سفر التكوين لإسماعيل بالترتيب التالي: «أُبَارِكُهُ وَأُثْمِرُهُ»، و«أُكَثِّرُهُ كَثِيرًا جِدًّا»، «وَأَجْعَلُهُ أُمَّةً كَبِيرَةً»، ولو كانت دلالة الأمّة دلالة تختص بالكثرة العدديّة كما أجمع شراح التوراة لكانت دلالة «المباركة-الإثمار-الإكثار- كَثِيرًا جِدًّا»، كافية للدلالة على المباركة العدديّة في النسل، ولا ضرورة لتأكيد ذلك بعبارات على شاكلة «أمّة كبيرة» و«أمّة عظيمة»
إلّا إذا كانت هذه المقولة تحمل بين دفتيها بُعدًا آخر غير البعد الظاهري للنص، ولا سيّما وأن إسماعيل لم يكن من اختصّ لوحده بوعد الأمّة؛ فقد ذكرت التوراة أنّ إبراهيم وُعد بأنّه سيصبح أمّة، ويرى أنطونيوس فكري: «أنّ الوعد لإبراهيم أجعلك أمّة عظيمة تحقّق والوعد بالبركة لكل العالم صار فيه إبراهيم أبًا لكلّ المؤمنين الذين يتشبّهون به ويؤمنون».كذلك فإنّ النبي يعقوب وعدته التوراة بأنّه سيصبح أمّة عظيمة عندما عزم اللّحاق بولده يوسف في مصر.
ويبسط تادرس يعقوب في بيانه لهذا الوعد قائلًا: «أظن أنّ النّص يخفي فيه سرًّا أعمق من الحرف الظاهر»، فعبارة «أجعلك أمّة عظيمة» تجتذبني، هذه الأمّة العظيمة هي جماعة الفضائل وكثرة البرّ التي يقول عنها الكتاب المقدّس «إن القدّيسين ينمون فيها ويتزايدون».
ويبدو أنّ الكلمة المشتركة في جميع هذه العهود؛ «الأمّة» ومعناها العام الجماعة، وسياق الحديث يُحدِّد عددها، مثلًا: أمّة الشعراء أي: جماعة الشعراء، وقد تكون الأمّة جماعة قليلة العدد، كما في قوله تعالى: (وَلَمَّا وَرَدَ مَاءَ مَدْيَنَ وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةً مِّنَ النَّاسِ يَسْقُونَ) (سورة القصص: الآية 23) فسمّي جماعة من الرعاة أمّة لأنّهم خرجوا لغرض واحد، سَقْي دوابهم، وتُطلَق الأمّة على جنس في مكان، كأمّة الفرس، وأمّة الروم، وقد تُطلِق على جماعة تتّبع نبيًّا من الأنبياء، كما قال تعالى: (وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ) (سورة فاطر: الآية 24) وحين نتوسَّع في المعنى نلمسها في رسالة محمّد صلىاللهعليهوآله لتشمل جميع الأمم؛ لأنه أُرسِل للناس كافّة، وجمع الأمم في أمّة واحدة، كما قال تعالى: (إِنَّ هَٰذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً) (سورة الأنبياء: الآية 92) ومعنى أمّة واحدة أي: جامعة لكلّ الأمم.
فإذا كانت كلمة الأمّة تحمل بين طيّاتها هذه المزايا لماذا يستثنى إسماعيل من دلالاتها لتقف المسألة على دلالة الأمّة العدديّة وليست الأمّة المفاهيميّة؟ لقد ذكر القرآن: (نَّ إِبْرَاهِيمَ كَانَ أُمَّةً قَانِتًا لِّلَّهِ حَنِيفًا) (سورة النحل: الآية 120)، أي كان عند إبراهيم من الخير ما كان عند أمّة أي الجماعة الكثيرة، فإطلاقها عليه لاستجماعه كمالات لا تكاد توجد إلا متفرّقة في أمّة جمّة، والأمّة، معلم الخير، أي: إنّ إبراهيم كان معلّمًا للخير اجتمعت فيه من الخصال الحميدة ما يجتمع في أمّة.
ويبدو أن القرآن الكريم يذهب إلى المعنى نفسه الذي اشتمل عليه معنى الأمّة في التوراة وليس ثمّة أي دلالة للتغاير في السياق، فأعطى الله تعالى لإسماعيل كما تنصّ التوراة بركة ووعودًا عظيمة لا تقلّ أهميّة عن الوعود التي قطعها لإسحاق، وإنّ إسماعيل تميّز بأنّ الله تعالى قد سمع صوته فهو ابن الدعاء «لاَ تَخَافِي، لأن اللهَ قَدْ سَمِعَ لِصَوْتِ الْغُلاَمِ حَيْثُ هُوَ» و«سَمِعْتُ لَكَ فِيهِ»، أي وعد الله بحفظه «كَانَ اللهُ مَعَ الْغُلاَمِ» وواعده بالبركة والثمرة «هَا أَنَا أُبَارِكُهُ وأُثْمِرُه» والوعد بسكنى الأرض الموعودة «أَمَامَ جَمِيعِ إِخْوَتِهِ يَسْكُن»، الوعد بالعيش في طاعة الله ورعايته «لَيْتَ إسماعيل يَعِيشُ أَمَامَكَ»، زيادة على الوعد بالنسل والكثرة «وَأُكَثِّرُهُ كَثِيرًا جِدًّا» أيضًا «أُكَثِّرُ نَسْلَكِ فَلاَ يُعَدُّ مِنَ الْكَثْرَةِ، زد على ذلك فهنالك تشابه بين اليهود نسل يعقوب والعرب نسل إسماعيل، فاليهود اثنا عشر سبطًا، ونسل إسماعيل اثنا عشر رئيسًا، واليهود لهم علامة الختان، والعرب لهم علامة الختان
تعلّموه كلاهما من إبراهيم، وصفوة القول: لقد أراد الله تعالى أن يظلّ اسم إبراهيم مباركًا إلى الأبد وأن يكون العهد بالنبوّة والبركة، إرثًا في ولديه إسماعيل وإسحاق.
ثمّة إلماع يتعلّق بموقف التوراة من هاجر إذ أورد العهد القديم أنّ ملاك الربّ ظهر مرتين لهاجر كانت المرة الأولى عند عين الماء في البريّة على طريق شور لمّا كانت هاربة من سارة، فأخبرها ملاك الربّ أنّ الله تعالى سمع لها وبشرها بإسماعيل، والمرّة الثانية ظهر لها وكانت عطشى مع وليدها في البرّيّة بعد أن هجرها إبراهيم فكشف لها عن نبع الماء، والسؤال هنا إذا كانت هاجر ذات المنزلة التوراتيّة الدنيا، لماذا يكلّمها ملاك الربّ مرتين وهو لا يتحدّث مع البشر إلّا في بضع مواضع كما تحدّث لمرتين مع إبراهيم، ومرة مع يعقوب، ومرة مع داود، ومرة مع إيليا النبي، ومرة مع زكريا عند تبشيره بمولد يحيى، وتبشيره لمريم العذراء بمولد المسيح، في الوقت الذي لم يخاطب سارة أو نبيّات بني اسرائيل، في أي موضع في التوراة، ولعلّ إصرار ملاك الربّ على الظهور في طريق هاجر ومواساتها كلّما عصفت بها النوازل يحمل دلالة رمزيّة من نوع ما، ولا سيّما وأن ملاك الرب
يجسد حالة الظهور الإلهي للإنسان وفق المنظور التوراتي: «ملاك الرب الوارد في العهد القديم أو «ملاك الله» أو «ملاك حضرته» هو واحد من الملائكة، أو هو أحد ظهورات الله نفسه.
لعلّ هذه المسألة تشير إلى وعد بالمباركة لإسماعيل لكن من جهة هاجر، ولا سيّما إذا أخذنا بالحسبان أنّ ملاك الرب لا يظهر إلا لمخاطبة الأنبياء والصالحين؛ فيلوح أن ثمّة رمزيّة تشدّد على نبوّة إسماعيل من جهة الأم أيضًا ولا سيّما وأنّ البشارات بالذريّة في الكتاب المقدّس جاءت بالأنبياء كما بشر الله تعالى هاجر بإسماعيل، ويبدو أنّ هاجر أنيطت لها مهمّة التحضير لنبوّة إسماعيل لنشر عقيدة التوحيد في أرض الحجاز لأنّها لم تنفصل عن إسماعيل، فأوكل لها مهمّة تأمين المحيط الذي سينشأ فيه إسماعيل وأوّل مستلزمات التأمين الماء الذي استخدم في المساومة مع جرهم مقابل تأمين الأمن والأُنسة لها ولابنها.
أفرد ميور في كتابه «منارة الحقّ» محورًا وسمه «نصوص من القرآن، تبرز أنّ النبوّة والوحي حكرٌ على بني إسرائيل»، قائلًا: «يتّفق القرآن مع الكلمة التي جلبتها التوراة بشأن إسحاق تمامًا لأنّه الابن الذي واعد به الرّب إبراهيم، وحريّ بالأمم جميعًا أن تبارك له ولذريّته»، وشرع من خلال كتابه إلى تطويع بعض النّصوص القرآنيّة لإثبات نظريّته بهذا الشأن، وضمن ثلاثة محاور:
يذكر ميور أنّ القرآن أكّد اختصاص النبوّة في إسحاق وذريّته دون إسماعيل مستشهدًا بقوله تعالى:(فَلَمَّا اعْتَزَلَهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ وَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ ۖ وَكُلًّا جَعَلْنَا نَبِيًّا ﴿٤٩﴾ وَوَهَبْنَا لَهُم مِّن رَّحْمَتِنَا وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيًّا) (سورة مريم: الآيتان 49-50) (وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِ النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ وَآتَيْنَاهُ أَجْرَهُ فِي الدُّنْيَا ۖ وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ) (سورة العنكبوت: الآية 27) (وَنَجَّيْنَاهُ وَلُوطًا إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَ ﴿71﴾ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ نَافِلَةً ۖ وَكُلًّا جَعَلْنَا صَالِحِينَ ﴿72﴾ وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ ۖ وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ) (سورة الأنبياء: الآيات 71-73)، (وَاذْكُرْ عِبَادَنَا إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ أُولِي الْأَيْدِي وَالْأَبْصَارِ ﴿٤٥﴾ إِنَّا أَخْلَصْنَاهُم بِخَالِصَةٍ ذِكْرَى الدَّارِ ﴿46﴾ وَإِنَّهُمْ عِندَنَا لَمِنَ الْمُصْطَفَيْنَ الْأَخْيَارِ ﴿47﴾ وَاذْكُرْ إِسْمَاعِيلَ وَالْيَسَعَ وَذَا الْكِفْلِ ۖ وَكُلٌّ مِّنَ الْأَخْيَارِ) (سورة ص: الآيات 45-48)».
إنّ القرآن المكّي ظلّ يذكرُ إبراهيم وإسحق ويعقوب معًا دون إسماعيل وظلّ يَذكر إسماعيل منفردًا عنهم، لكن عدم تأكيد القرآن أو جمعه معهم دائمًا في الآيات المكّيّة يعني أنه لم تكن هناك مشكلة مطروحة في أذهان العرب بهذا الشأن كي يردّ عليها؛ فلم تكن المشكلة في إثبات نبوة إسماعيل لإبراهيم بل إنّ المشكلة التي واجهها تتمثّل بالشكّ في نبوّة إسماعيل، إنّ الطرح القرآني جاء في سياق سرد القصة آنذاك ولا تعني المباركة الحكريّة عليهم، بدلالة أنّ القرآن نفسه يؤكّد على نبوّة إسماعيل لكسر احتكار أهل الكتاب للنبوّة كما جاء في قوله تعالى: (وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ ۚ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَّبِيًّا) (سورة مريم: الآية 54)، والتأكيد أنّه من الأنبياء الموحى إليهم:( إِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَىٰ نُوحٍ وَالنَّبِيِّينَ مِن بَعْدِهِ ۚ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَعِيسَىٰ وَأَيُّوبَ
وَيُونُسَ وَهَارُونَ وَسُلَيْمَانَ ۚ وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا) (سورة النساء: الآية 63)، والمنزل عليهم: (قُولُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنزِلَ إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَمَا أُوتِيَ مُوسَىٰ وَعِيسَىٰ وَمَا أُوتِيَ النَّبِيُّونَ مِن رَّبِّهِمْ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ) (سورة البقرة: الآية 136).
وقد دأب القرآن الكريم على تحطيم عقيدة أهل الكتاب التي تروّج لحكر النبوّة في بني إسرائيل، وذلك بطرح الأبوّة من إبراهيم دينيًّا وعرقيًّا على حدّ سواء؛ تمهيدًا لمشروعيّة ظهور النبوّة في أرض العرب، وللردّ على المشركين العرب وعلى أهل الكتاب. ولعلّ ميور وقع تحت سطوة منهج تقليدي عمد فيه إلى سلخ النّصوص القرآنيّة من سياقاتها وتوظيفها إيديولوجيًّا لم يشأ فيها الرجوع إلى المعاجم اللغويّة والتفسيريّة لبيان معاني الآيات القرآنيّة، أو اعتماد أسلوب القراءة السياقيّة للنّصوص القرآنيّة، مع عدم مراعاته أسباب التنزيل وطبيعة التّمايز في الخطاب القرآني بين المكّي المدني، متعاملًا مع النّصوص القرآنيّة وفقًا لنظرة سطحيّة جامدة تفتقر إلى الشموليّة في فهم الرؤية القرآنيّة عن إسماعيل.
ويبدو أنّ ميور نظر إلى هذه القضيّة بعين واحدة متغافلًا عن بقيّة النّصوص القرآنيّة التي وردت بحق إسماعيل وعُدّ فيها من الأنبياء والرسل: (وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ ۚ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَّبِيًّا) (سورة مريم: الآية 54)، وذكره بأنّه ( مِّنَ الْأَخْيَارِ) (سورة ص: الآية 48)، (مِّنَ الصَّابِرِينَ) (سورة الأنبياء: الآية 85) ومن المفضلين على العالمين (سورة الأنعام: الآية 86)؛ ويبدو أنّ المقصد الرئيس من الآيات القرآنيّة تحطيم الموروث التوراتي السائد تجاه إسماعيل، وتقديم إسماعيل المناظر لأخيه إسحاق في النبوّة، بيد أنّ ميور أخذ على عاتقه أن يستخرج من القرآن آراء جديدة لم يسبقه إليها أحد، وهو ليس على معرفة كاملة بمناهج القرآن، ولا سيّما وأنّه يحشد الآيات حشدًا.
استشهد ميور بنص قرآني يرى أنّه: «نصّ فريد من سورة مريم يذكر نبوّة إسماعيل لكنه لم يقطع بأنّ إسماعيل من ذريّة إبراهيم أو يرتبط به بأيّة صلة، لأنّ ذكره جاء منفصلًا عن إبراهيم بين موسى وإدريس، ولم يرد فيه أنه هبة الربّ لإبراهيم على غرار إسحاق ويعقوب».
ويرى أيضًا: «أنّها حقًّا معضلة لدارسي القرآن، فمن المؤكّد أنّ إسماعيل غاب عن الأفق وبُتِر من خطّ النبوّة»، ويعطف على ذلك بجملة من التساؤلات: «لماذا لم يذكر إسماعيل مع إسحاق ويعقوب وذكر في مواضع أخرى بارتباط مغاير مع أنبياء آخرين؟ ولو سلّمنا أنّه من أبناء إبراهيم لماذا لم يذكره القرآن في ذات النسق الذي أورد فيه أخوه إسحاق ويعقوب؟... وكيف يعظ الرب محمّدًا بتذكيره بفضائل وحكمة إبراهيم وإسحاق ويعقوب دون أن يشير بكلمة عن سلفه إسماعيل الذي ذكره وكأنه ينتمي إلى جيل آخر؟»، ويخلص إلى أنّ: «إسحاق ويعقوب هما الابنان الموعودان بالنبوّة من ذريّة إبراهيم وفيهما وضع الله النبوّة والكتاب، وأنّ إسماعيل وضع بمعزل عن هذا الخط».
ثمّة علامة تعجّب لافتة على خطاب ميور؛ فقد أقام هذا الرؤية وفقًا لمرتكزات توراتيّة تقطع بأنّ إسماعيل جاء من صلب إبراهيم؛ لكنّ الباحث يلمس إصرارًا من جانب ميور على عدّ إسماعيل ينتمي إلى زمن لاحق من زمن إبراهيم وأنّه رفع من السلسلة النبويّة بدعوى أنّ النّصوص القرآنيّة أقرّت بذلك، ولعلّ الغاية من وراء ذلك؛ البرهنة على أنّ النبوّة في إسماعيل وذريّته ليست قطعية في الإسلام.
لقد طرح القرآن الكريم مسألة انتماء إسماعيل وإسحاق سويًّا امتدادًا نسبيًّا
لإبراهيم في ستّ آيات؛ هي:
(أَمْ كُنتُمْ شُهَدَاءَ إِذْ حَضَرَ يَعْقُوبَ الْمَوْتُ إِذْ قَالَ لِبَنِيهِ مَا تَعْبُدُونَ مِن بَعْدِي قَالُوا نَعْبُدُ إِلَٰهَكَ وَإِلَٰهَ آبَائِكَ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ إِلَٰهًا وَاحِدًا وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ) (سورة البقرة: الآية 133).
(أَمْ تَقُولُونَ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطَ كَانُوا هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ ۗ قُلْ أَأَنتُمْ أَعْلَمُ أَمِ اللَّهُ ۗ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن كَتَمَ شَهَادَةً عِندَهُ مِنَ اللَّهِ ۗ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ ) (سورة البقرة: الآية 140).
(قُلْ آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا وَمَا أُنزِلَ عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَمَا أُوتِيَ مُوسَىٰ وَعِيسَىٰ وَالنَّبِيُّونَ مِن رَّبِّهِمْ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ) (سورة آل عمران: الآية 84).
(قُولُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنزِلَ إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَمَا أُوتِيَ مُوسَىٰ وَعِيسَىٰ وَمَا أُوتِيَ النَّبِيُّونَ مِن رَّبِّهِمْ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ) (سورة البقرة: الآية 136).
(إِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَىٰ نُوحٍ وَالنَّبِيِّينَ مِن بَعْدِهِ ۚ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَعِيسَىٰ وَأَيُّوبَ وَيُونُسَ وَهَارُونَ وَسُلَيْمَانَ ۚ وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا ﴿١٦٣﴾ وَرُسُلًا قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ مِن قَبْلُ وَرُسُلًا لَّمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ ۚ وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا) (سورة النساء: الآيتان 163-164).
(الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي وَهَبَ لِي عَلَى الْكِبَرِ إِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ ۚ إِنَّ رَبِّي لَسَمِيعُ الدُّعَاءِ) (سورة إبراهيم: الآية 39).
زد على ذلك أنّ إسماعيل ورد ذكره بعد إبراهيم مباشرة دون أدنى إشارة إلى إسحاق في قصّة بناء الكعبة وفي موضعين من سورة البقرة: (وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِّلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى ۖ وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن
طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ) (سورة البقرة: الآية 125)، (وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا ۖ إِنَّكَ أَنتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ) (سورة البقرة: الآية 127).
أمّا عن مسألة ورود إسماعيل منفصلًا عن إبراهيم في سورة مريم فلا يمكن الاحتجاج بذلك؛ لأنّ الثابت تاريخيًّا أنّ إبراهيم بعث بعد إدريس، وفي الآية السالفة تقدّم ذكر إبراهيم على إدريس، ومن ثمّ فإنّ ترتيب الأنبياء في هذه السياق ليس زمنيًّا، كذلك ما ورد في سورة الأنبياء الآيات (47-92)، إذ ورد ذكر موسى وهارون قبل إبراهيم والثابت أن موسى من أحفاد ابراهيم، كذلك ذكر نوح بعد إبراهيم وهو من ذريّة نوح، كما ورد في سورة الأنعام الآيات (73-86) تأخّر ذكر لوط في آخر سلسلة الأنبياء التي تصدرها إبراهيم على الرغم من أنّ لوطًا كان يعاصر إبراهيم، والثابت تاريخيًّا أنّ التوظيف القرآني لقصص الأنبياء جاء استجابة لمتطلّبات تغيّر الواقع آنذاك إذ لم يعنَ القرآن بذكر جميع قصص الأنبياء، فهناك قصص لأنبياء كثر لم يشِر لهم القرآن: (وَرُسُلًا قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ مِن قَبْلُ وَرُسُلًا لَّمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ ۚ وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا) (سورة النساء: الآية 164)، فالقرآن ليس كتابًا يعنى بالسرد التاريخي لقصص الأنبياء الواحد تلو الآخر على غرار التوراة، ويذهب الطوسي في بيان قوله تعالى: (وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِ النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ وَآتَيْنَاهُ أَجْرَهُ فِي الدُّنْيَا ۖ وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ) (سورة العنكبوت: الآية 27) إلى أنّ إسماعيل لم يذكر مع أنّه نبي، لكنّه دلّ عليه بقوله: (وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِ النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ) ﱪ فترك ذكر اسمه لأنّه يكفي فيه الدلالة عليه لشهرته وعظم شأنه.
في المحور الأخير يذكر ميور: «أنّ الرب رفع بني إسرائيل منزلة وجعل لهم
الفضل على جميع النّاس، واصطفى من ذريّتهم الأنبياء والرسل، كما جعل في ذريّتهم الحكم على جميع الخلق»، مستشهدًا بقوله تعالى: (يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ اذْكُرُوا نِعْمَتِيَ الَّتِي أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ) (سورة البقرة: الآية 47) ويرى أيضًا: «لو أنّ محمّدًا نهض بنبوّته من ذريّة إسماعيل سيكون ذا منزلة أرفع شأنًا من ذريّة إسرائيل، فكيف إذن يخاطب القرآن بني إسرائيل بأنّي فضلتكم على العالمين بمنْ فيهم ذريّة إسماعيل؟».
لم يكن بنو إسرائيل وحدهم من فضّلهم الله تعالى بالنعم فقد فضّل الله تعالى من قبلهم آل إبراهيم بالنبوّة والحكمة والملك العظيم، وآل إبراهيم تشمل ذرية إسماعيل وإسحاق، وقد فضّل الله تعالى بعض الأنبياء على العالمين ومنهم إسماعيل وَالْيَسَعَ وَيُونُسَ وَلُوطًا، وقد فنّد القرآن الكريم زعم اليهود بأنّهم أبناء الله وأحبّاؤه، كما أجمع المفسّرون على أن ما ورد في قوله تعالى: (وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ) (سورة البقرة: الآية 47)، ليس على مطلق النّاس، وإنّما فضّلهم الله على عالمهم ولكلّ زمان عالم لأن بني إسرائيل عاشوا في زمن ساد فيه الكفر والوثنيّة، وكانوا أهلَ كتاب يؤمنون بالله، فكانوا أفضلَ ممَّنْ عاصرهم، لذلك لا يلزم أن يكونوا أفضل من أمّة محمّد صلىاللهعليهوآله ، التي خاطبها بأنّها خير الأمم التي أخرجت للناس، وأمّة محمّد صلىاللهعليهوآله ما كانت موجودة في ذلك الوقت، فلا يلزم من كون بني إسرائيل أفضل العالمين في ذلك الوقت أنّهم أفضل من الأمّة المحمّديّة، ونقل عن رسول الله صلىاللهعليهوآله: «أنتم تُوفُونَ سبعين أمّة، أنتم خيرها وأكرمها على الله».
ويزيد الطبري على ذلك قائلًا: «ألا ترى أنّ الله جعل المقتصد منهم أعلاهم منزلة إذ قال: (مِّنْهُمْ أُمَّةٌ مُّقْتَصِدَةٌ ۖ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ سَاءَ مَا يَعْمَلُونَ) (سورة المائدة: الآية 66)؛ وجعل في هذه الأمّة درجة أعلى من درجة المقتصدة وهي درجة السابق بالخيرات إذ قال تعالى: (وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ ) (سورة فاطر: الآية 32)».
ويبدو أنّ ميور ذهب إلى ترسيخ النظرة الفوقيّة لليهود على العرب من خلال القرآن، متغاضيًا عن تأكيد الآيات القرآنيّة على أنّ إسرائيل وإسماعيل أولاد إبراهيم وأنّ إبراهيم لم يكن يهوديًّا ولا نصرانيًّا.
إنّ النّص القرآني بشأن تفضيل اليهود يحمل خطابا تأنيبيًّا لليهود فليس الغاية منه تكريس أفضليّتهم على العالمين، بل للإشارة إلى تمرّدهم ومخالفتهم للإرادة الإلهيّة على الرغم من تفضيلهم بالنعم التي حباهم الله بها؛ وهذا عين ما أرادته الآيات القرآنيّة، فحقيقة هذا التّفضيل كانت بكثرة الرسل الأنبياء والمصلحين وكثرة ما أنزل عليهم من الكتب، وإعزاز مقامهم بعد الذل والمهانة والاستحياء وإنقاذهم من فرعون، وإغداق النعم عليهم، ولعلّ في ذلك إشارة لسلبيّتهم؛ فلو كانوا ملتزمين بالشرائع لما أرسل إليهم هذا العدد من الأنبياء مقارنة بغيرهم من الشعوب: (فَبِمَا نَقْضِهِم مِّيثَاقَهُمْ وَكُفْرِهِم بِآيَاتِ اللَّهِ وَقَتْلِهِمُ الْأَنبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ وَقَوْلِهِمْ قُلُوبُنَا غُلْفٌ ۚ بَلْ طَبَعَ اللَّهُ عَلَيْهَا بِكُفْرِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا) (سورة النساء: الآية 155).
ولعلّ هذا التفضيل ليس مطلقًا إذ جاء مقرونًا بحفظ العهد مع الله تعالى وبخلاف ذلك سيحيق بهم الغضب، وقد سجّل القرآن الكريم هذه المواثيق،
فالآيات والمعجزات التي أنزلها الله تعالى عليهم تعدّ الفيصل بين حصول التفضيل لهم وحصول الضلال لهم، لكن الأمّة المصطفاة سرعان ما لعنت وتحوّلت إلى أمّة ضالّة بعد أن نقضت ميثاقها مع الله تعالى.
لم يكتفِ ميور في حكر بركة النبوّة على الفرع الإسرائيلي من إبراهيم وإنكارها على الفرع الإسماعيلي بل ذهب أبعد من ذلك من خلال طرحه لإشكاليّة التّشكيك في نسب الرّسول صلىاللهعليهوآله إلى إبراهيم عن طريق إسماعيل والغاية من وراء ذلك إزاحة أي تصوّر يتعلّق بشمول محمّد صلىاللهعليهوآله ببركة الوعد التوراتي بالنبوّة في نسل إبراهيم المشار إليه سابقًا؛ وإلى ذلك يشير قائلًا: «يزعم محمّدًا أنّه سليل إسماعيل»، ويرى: «أنّ ثمة 2000 عام تفصل بين ولادة محمّد وبين إسماعيل مرورًا بعدنان الذي عاش لفترة وجيزة قبل المسيح، إنّها أسطورة فارغة». و«أنّه لم يجهد لتتبّع نسبه لأبعد من عدنان وقد صرّح بأنّ من يسعى لتتبّع النسب لأبعد من عدنان مذنب بالكذب والتلفيق، وقد نقل ابن سعد قوله: «لا يعلم النسب ما بعد عدنان إلا الله وكذب النّسّابون».
لقد استند ميور إلى سلسلة النّسب التي أوردها ابن سعد والتي اشتملت على أربعين اسمًا تصل بين عدنان وإسماعيل قائلًا: «إنّ هذه السلسلة مستقاة بجميع الأحوال من مصادر عبريّة باعتراف منصف أدلى به ابن سعد: ولم أر بينهم اختلافًا أنّ معد من أولاد قيدار بن إسماعيل وهذا الاختلاف في نسبه يدلّ على أنّه لم يحفظ وإنّما أخذ من أهل الكتاب وترجموه لهم فاختلفوا فيه ولو صحّ ذلك كان رسول الله أعلم النّاس به فالأمر عندنا على الانتهاء إلى معد بن عدنان ثم الإمساك عمّا وراء ذلك إلى إسماعيل بن إبراهيم».
ويعتقد ميور: «إنّ شهادة ابن سعد تُعدّ دليلًا على إن نسب محمّد إلى عدنان محلّي مأخوذ من الأصول العربيّة المتداولة، لكن نسبه لما بعد عدنان مأخوذ عن اليهود».
لقد ذكر ميور أنّ الرّسول صلىاللهعليهوآله كان يدّعي نسبه من إسماعيل، والادّعاء لغة يعني «التَمَنَّى أوالتظاهر أوزَعَمْه لِه حَقًّا كَانَ أو بَاطِلًا والادعاء فِي النَّسَبِ؛ أَن ينْتَسب الإِنسان إلى غَيْرِ أَبيه وَعَشِيرَتِهِ».
فلم ترد أيّ إشارة على أنّ الرّسول صلىاللهعليهوآله كان يدّعي النسب لأنّه ينحدر من قريش، ونسبها إلى إسماعيل لم يكن محل خلاف بين العرب، فقد ذكر الرّسول صلىاللهعليهوآله: «إنّ الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل واصطفى قريشًا من كنانة واصطفى من قريش بني هاشم واصطفاني من بني هاشم» وهذا تشديد على سلسلة نسبه، وقد روي أنّ حسّان بن ثابت استأذن الرّسول صلىاللهعليهوآله في أن يهجو قريشًا، فقال له: «فكيف وقرابتي فيهم؛ فقال حسّان: لأسلنك منهم سلّ الشعرة من العجين».
كانت عراقة نسبه الشريف أمرًا لا ينكره حتّى خصومه فهذا أبو سفيان بن حرب لمّا كان حاضرًا في بلاط هرقل ملك الروم، أجاب عن سؤال هرقل عن نسب النبي قائلًا: «هو-أي الرّسول صلىاللهعليهوآله- فينا ذو نسب، فقال هرقل: فكذلك الرسل تُبْعَث في نسب قومها»، وعندما دار الحوار بين جعفر والنجاشي لفت جعفر إلى قضيّة نسب محمّد قائلًا: «بَعَثَ الله إِلَيْنَا رَسُولًا مِنَّا نَعْرِفُ نَسَبَهُ» وكان عمرو بن العاص حاضرًا ولم يظهر أي اعتراض بشأن هذه القضيّة ويومها كان منتدبًا لتشويه صورة الإسلام في مجلس النجاشي.
وقد أكّد الرّسول صلىاللهعليهوآله بنوّته من إبراهيم في أكثر من مناسبة خلافًا لما ذهب إليه ميور الذي توهّم بأنه لم يجهد لتتبّع نسبه، ومنها قوله: «إِنَّ لِكُلِّ نَبِيٍّ وُلاةً مِنَ النَّبِيِّينَ، وَإِنَّ وَلِيِّي مِنْهُمْ أَبِي وَخَلِيلُ رَبِّي تعالى، ثُمَّ قَرَأَ (إِنَّ أَوْلَى النَّاسِ بِإِبْرَاهِيمَ لَلَّذِينَ اتَّبَعُوهُ وَهَٰذَا النَّبِيُّ وَالَّذِينَ آمَنُوا ۗ وَاللَّهُ وَلِيُّ الْمُؤْمِنِينَ) (سورة آل عمران: الآية 68)»؛ وقوله صلىاللهعليهوآله: «كل العرب من ولد إسماعيل بن إبراهيم»، وقوله صلىاللهعليهوآله أيضًا: «أنا دعوة أبي إبراهيم».
وأورد ابن عبد البرّ نقلًا عن رسول الله صلىاللهعليهوآله: «معد بن عدنان بن أدد بن زيد بن براء بن أعراق الثرى، فقالت أم سلمة: فزيد هو الهميسع وبراء هو نبت «نبايوت» وأعراق الثرى؛ إسماعيل بن إبراهيم وقيل إنّه سمي كذلك لأن إبراهيم لم تأكله النار كما أنّها لا تأكل الأرض» وكان رسول الله صلىاللهعليهوآله يتكلّم في الأنساب فقال: «نحن بنو النضر بن كنانة وذكر أفخاذ الأنصار إذ فاضل بينهم فقدم بني النجار ثم بني عبد الأشهل، ثم بني الحارث بن الخزرج، ثم بني تميم، وأخبر أن بني العنبر بن عمرو بن تميم من ولد إسماعيل، ونادى قريشًا بطنًا بطنًا، إذ أنزل الله تعالى عليه: (وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ) (سورة الشعراء: الآية 214)، وهذا كلّه علم نسب، يبطل ما روى من كراهية الرفع في النسب إلى الآباء من أهل الجاهليّة لأنّ هؤلاء الذين ذكر النبي آباءٌ جاهليّون وقد قال صلىاللهعليهوآله:
أمّا حديث «كذب النسّابون» الذي اقتبسه ميور، عن ابن سعد ونصّه: «أَنَّ النَّبِيَّ صلىاللهعليهوآله كَانَ إِذَا انْتَسَبَ لَمْ يُجَاوِزْ فِي نَسَبِهِ مَعَدَّ بْنَ عَدْنَانَ بْنِ أُدَدَ ثُمَّ يُمْسِكُ وَيَقُولُ: «كَذَبَ النَّسَّابُونَ». قَالَ اللَّهُ تعالى (وَقُرُونًا بَيْنَ ذَٰلِكَ كَثِيرًا) (سورة الفرقان: الآية 38) قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: لَو شَاءَ رَسُولُ اللَّهِ صلىاللهعليهوآله أَنْ يُعَلِّمَهُ لَعَلَّمَهُ».
وقد ضعّفه ابن عبد البر وعدّه «ليس هذا الإسناد بالقوي»، وقال آخرون «لم يتجاوز النّبي في النسب النضر بن كنانة، وكان قوم إذا تلوا (وَالَّذِينَ مِن بَعْدِهِمْ ۛ لَا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا اللَّهُ) ، قالوا كذب النسّابون ومعنى هذا على غير ما ذهبوا إليه والمعنى فيها والله أعلم تكذيب من أراد إحصاء بني آدم فإنّه لا يحصيهم إلا الذي خلقهم فإنّه هو الذي أحصاهم وحده لا شريك له».
ولعلّ الصّحيح ما أخرجه السيوطي عن إسناده: «وعادًا وثمودًا والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله، قال: كذب النسّابون، فقال رجل للإمام علي بن أبي طالب: أنا أنسب النّاس قال: إنّك لا تنسب النّاس قال: بلى فقال له علي أرأيت قوله: (وَعَادًا وَثَمُودَ وَأَصْحَابَ الرَّسِّ وَقُرُونًا بَيْنَ ذَٰلِكَ كَثِيرًا) ، قال: أنا أنسب ذلك الكثير قال: أرأيت قوله: (أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَبَأُ الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ قَوْمِ نُوحٍ وَعَادٍ وَثَمُودَ ۛ وَالَّذِينَ مِن بَعْدِهِمْ ۛ لَا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا اللَّه) فسكت».
وذكر ابن خلدون: «أنّ وجه قوله صلىاللهعليهوآله في ما بعد عدنان من ها هنا كذب النسّابون لأنها أحقاب متطاولة ومعالم دارسة لا تثلج الصدور باليقين في شيء منها مع أنّ علمها لا ينفع وجهلها لا يضرّ».
ويعزو ابن سعد سبب الخلاف بين النّسّابين إلى الفروقات اللغويّة بين اللغتين العبريّة والعربيّة في الصفحة نفسها، التي اقتبس منها ميور: «وكان رجل من مسلمة بني إسرائيل قد قرأ من كتبهم وعلم علمهم فذكر أنّ باروخ بن ناريا كاتب أرميا النبي أثبت نسب معد بن عدنان عنده ووضعه في كتبه وأنّه معروف عند أحبار أهل الكتاب وعلمائهم ومثبت في أسفارهم وهو مقارب لهذه الأسماء، ولعلّ
خلاف ما بينهم من قبل اللغة لأنّ هذه الأسماء ترجمت من العبرانية» فإذا كان الاختلاف في اللغة والترجمة، سيكون الاتّفاق حاضرًا في شجرة النسب بنحو حتمي وهذا ما ذهب إليه ابن سعد.
أمّا عن مدى كون اعتراف ابن سعد منصفًا أم لا بشأن نسب الرّسول وصلته بأهل الكتاب، فيظهر جليًّا أنّ ابن سعد عرض للقضيّة من منظور استنتاجي وليس من حجج ثابتة، فالاختلاف في عدد حلقات النسب حمل ابن سعد على الاعتقاد بأنّها أخذت عن أهل الكتاب كما ورد في سياق الرواية.
ويبدو أنّ ابن سعد عرض لهذه القضيّة من أكثر من زاوية لكنّ ميور وجد أن يتعامل مع هذه القضيّة بمنهج اجتزائي عمد إلى بتر الشطر الثاني من الرواية: «لو شاء رسول الله صلىاللهعليهوآله أن يعلمه لعلمه»، ولعلّه توجّس حدوث التّعارض من هذه العبارة مع القسم الآخر: «فاختلفوا فيه ولو صحّ ذلك كان رسول الله أعلم الناس به»، حتّى يوحي للقارئ أنّ النبي كان لا يحيط علمًا بنسبه! كما شرع بتوظيف رؤية ابن سعد في بيان حالة الجدل بشأن النسب الأعلى من عدنان لإصدار تعميمات تنطوي على المبالغة منها: «إنّ جميع سلاسل الأنساب المرتبطة بإبراهيم مقتبسة من التوراة والأساطير اليهوديّة لا تستند في مرجعيّتها إلى أي أساس محلّي ولا حتّى إلى الأساطير العربيّة» ولعلّه خلص إلى هذه التعميمات دون أن يملك وثيقة أو دليلًا أبعد من توظيفه لرواية ابن سعد؛ الذي لم يشكّك في نسب الرّسول صلىاللهعليهوآله إلى إسماعيل قدر رغبته في بيان حالة الجدل بشأن عدد حلقات السلسلة.
زد على ذلك فإذا سلّمنا بصحّة الفرض الذي قدّمه ابن سعد وأقامه ميور بشأن صلة باروخ بن ناريا كاتب أرميا بنسب معد بن عدنان، فقد ذكرت معظم المصادر
التاريخيّة أنّ باروخ بن ناريا اتّصل بمعد بن عدنان، في حملة بختنصر لغزو بلاد العرب وأنّه كتب نسبه وحفظه في خزانة أرمياء على الرغم من الغموض الذي يلفّ هذه الرواية؛ لكن وصول بخت نصر إلى الحجاز بعد أن استولى جيشه على فلسطين يعد ممكنًا.
وصفوة القول: إن سلّمنا بهذا الرأي فإنّ السلسلة التي ذكرها ابن سعد استقاها باروخ بن ناريا عن معد بن عدنان، أي أنّ أهل الكتاب أخذوا معرفتهم بنسب بني إسماعيل من العرب مباشرة ومع الزمن غدا ذلك جزءً من موروثهم الكتابي؛ فالتوراة حكت نسبًا كان يجمع شمل القبائل العربيّة وصل خبره إلى اليهود فسجّله كتبة التوراة في الأسفار، مع أنساب الشعوب كما أنّ اليهود أخذوا من العرب نسب الإسماعيليين على نحو ما كان معروفًا يومئذ .
إنّ المصادر اليهوديّة لعبت دور الحافظة لتراث العرب بفعل امتيازهم بالتدوين التاريخي ولو سلّمنا بأنّ العرب رجعوا إلى اليهود في إزاحة الغموض عن نسبهم إلى إبراهيم، فإنّهم استرجعوا ما فُقد من تاريخهم.
أمّا الخلاف الذي ظهر بين النّسّابين والذي أشار له ابن سعد، فلعلّه حدث في مرحلة لاحقة، الأمر الذي حملهم على الاستعانة باليهود، فلم ترد إشارة عن وجود مؤثّرات يهوديّة في علم الأنساب إبّان حياة الرّسول صلىاللهعليهوآله وفي هذه الحقبة كان عقيل بن أبي طالب أعلم العرب بالأنساب قاطبة، وكان الرّسول صلىاللهعليهوآله يشاطره سني صباه وشبوته في دار أبي طالب فكان أقرب النّاس إليه، ولم يرد أنّ عقيلًا استقى علمه بالنسب عن اليهود، ولو صحّ ذلك لكان الرّسول صلىاللهعليهوآله أعلم الناس، ولم تكن للمسلمين اليهود في المدينة أيّ شهرة في الأيام الأولى من الإسلام؛ كما أنّ الروايات المنقولة عنهم
قليلة جدًّا، وعلى الرغم من ذلك فإنّ ذرّيّتهم حافظت على أخبار اليهود في الجاهليّة لما كانوا ملمين من أيام اليهود في الديار العربية، ومن المعلوم أنّهم تقدّموا بالروايات والأخبار إلى ابن إسحاق والواقدي في النصف الأول من القرن (2ه/ 8م).
إنّ نسب الرّسول صلىاللهعليهوآله إلى إسماعيل لم يكن نقطة خلافيّة، فقد ذكرت التوراة موطن الإسماعيليّين، وذكرت أنّهم قوم رحّل اشتهروا بمزاولة التجارة، وعرفوا بمهارتهم في قيادة الجمال وسكنهم الخيام وبراعتهم في استعمال القوس، وليس في أمم الأرض من تنطبق عليه هذه العلامات أكثر من أمّة محمّد صلىاللهعليهوآله، وقد نقل عن الرّسول صلىاللهعليهوآله أنّه مَرَّ عَلَى نَفَرٍ مِنْ قبيلة أَسْلَمَ فَقَالَ لهم: «ارْمُوا بَنِي إسماعيل، فإن أَبَاكُمْ كَانَ رَامِيًا»، وقد شهد القرآن الكريم لأبوّة إبراهيم وإسماعيل للعرب قائلًا: (وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ ۚ مِّلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ) (سورة الحج: الآية 78) بنحو عمومي، وبما أنّ الرّسول صلىاللهعليهوآله من العرب فإذن ينتسب لإسماعيل بغضّ النّظر عمّا إذا كانت كتب الأنساب قد حفظت النسب أم لا لذا جاء حديث النبي في سياق أنّ أمّة العرب شفاهيّة الثقافة ولم تكن كتابيّة حتّى ظهور الإسلام، فإذا لم يكن الرّسول صلىاللهعليهوآله ينتسب لإسماعيل فلمن ينتسب إذن؟ وهذا ما لم يقدّم له ميور جوابًا.
ويبدو أنّ وليم ميور يقف وحيدًا بين الباحثين الغربين في ريبته في الأصول الإسماعيليّة للرسول صلىاللهعليهوآله ، إذ يرى المستشرق بوش: Bush «ثمّة دليل على انتساب العرب إلى إسماعيل، إذ أنّهم يمارسون طقس الختان منذ زمن قديم غير محدّد، وأنّ اليهود والعرب مشهورون بهذه العادة منذ زمن قديم لا نستطيع تحديد بداياته، فعندما بلغت سارة التّسعين وبلغ إبراهيم المائة أنجبا إسحاق، فختناه في اليوم
الثامن من ميلاده، ومن هنا أخذ اليهود عادة ختن أولادهم في اليوم الثامن من ميلادهم، ولكن العرب يمارسون الختان في سنّ الثالثة عشر، لأن إسماعيل مؤسّس أمّتهم ابن إبراهيم من جاريته قد اختتن في هذا العمر» ويمكننا أن نعد شهادة بوش ردًّا على سؤال ورد بين ثنايا خطاب ميور: «هل كان إبراهيم أبا للعرب فضلًا عن كونه أبًا لبني إسرائيل؟».
كما يبدو، أنّ ماثيوبارسيس Matthew Paris’s قدّم قائمة من 28 أبًا للرسول صلىاللهعليهوآله تنتهي عند إبراهيم، وقد ذكر الرّسول صلىاللهعليهوآله قائلًا: «أمّا محمّد الإسماعيلي فتولّى رعايته شخص يدعى عبد مناف بعد موت أبيه».
وذهب روس Rose إلى أنّ محمّدًا صلىاللهعليهوآله عربي ينحدر من إسماعيل وهاجر، وذكر جيبون Gibbon: «إنّ هنالك إجماع على أنّ محمّدًا ينحدر من إسماعيل، بشهادة ثيوفانس Theophanes أقدم مؤرخي الإغريق، وشهادة جانيه Gagnier في كتابه حياة محمّد مشيرًا إلى سلسلة النسب التي تفصل بين محمّد وإسماعيل، لكن الخلاف كان في تسلسل الأجيال ويذهب لورنت داريفو Laurent D’arvieux إلى الاعتقاد بأن ثمّة 2500 عام تفصل بين محمّد وإسماعيل، أي بنحو75 جيلًا، خلافًا لما ذهب إليه النسابة العرب أي بنحو30 جيلا».
ويذكر أيضًا: «لقد تعرّضت الأصول البسيطة لمحمّد إلى افتراءات غير صحيحة من المسيحيّين وبدلًا من قيامهم بالحطّ من مكانة غريمهم ارتقوا بها،... لقد انحدر محمّد من قريش وتحديدًا من أسرة هاشم الأشهر بين العرب وأمراء مكّة وسدنة الكعبة وحراسها».
ويرى سيل Sale: «ليس ثمّة شكّ أنّ أبناء إسماعيل العرب الخلّص؛ شرّع لاحقًا بعقد الحلف مع الجراهمة من خلال الاقتران بإحدى نسائهم، وسرعان ما تأقلم مع حياتهم وعيشهم ولغتهم وانصهر أحفاده مع هؤلاء الجراهمة في أمّة واحدة، والخلاف في تسلسل الأجيال بين إسماعيل وعدنان سبب عدم اهتمام العرب بتعقب نسبهم أعلى من عدنان».
ويرى فوستر Foster: «هناك روايات قديمة تفيد بأن قيدار وذريّته سكنوا الحجاز أصلًا وقد خرجت من هذا الفرع قبيلة قريش أسياد مكّة وسدنة الكعبة الذين أظهروا اعتزازهم بأصلهم، زد على ذلك أنّ محمّد عبّر عن أصله الرفيع وشرفه في القرآن ولا سيّما أن قيدار من سلالة إسماعيل».
أمّا كرجتون Crichton فقد أشاد بعناية العرب بنسب الرّسول صلىاللهعليهوآله قائلًا: «لقد بلغت عناية العرب بنسب نبيهم حدًّا غير اعتياديّ من العناية والتبجيل فقد كانوا يباهون بنسبه إلى إبراهيم بذات القدر الذي كانت تباهي فيه اليهود أنّهم من سلالة إسرائيل».
كان العرب يتداولون أنسابهم ويتوارثونها عبر الذاكرة الشفهيّة وبصورة نثرية، وليس من أمّة لها عناية بالأنساب كما للعرب حتّى عدّ ذاكرة العرب ذات قدرة إعجازيّة ورأى: «إن الحقائق القوميّة والتاريخيّة للعرب حُفظت في سلاسل النسب على مدى خمسة أوستة قرون باستخدام الذاكرة فقط، وهذه ظاهرة رائعة في تاريخ الجزيرة العربيّة، فالأبيات الشعريّة التي يناقلها حتّى الأطفال، حفظت أسماء الزعماء مآثرهم وأمجادهم التي لا تضاهى وحفظت أسماء السلالات النبيلة للجمال والخيول»، ويرى: «أنّ ولع المحمديّين بعلم النسب بلغ حد الشغف، وأن
سلاسل الأنساب المتداولة لديهم يفوق عددها تلك الموجودة في جميع العالم»، ويرى أيضًا: «قام علماء الأنساب بعمل هائل، فلم يكتفوا بتتبّع كل ملاحظة أو إشارة لآباء محمّد وأتباعه في القبائل العربيّة بل أنّهم نسبوا كل قبيلة إلى جذرها الصحيح مُتَتبعين حلقات السلسلة حلقة بحلقة إلى أصول فرديّة أو إلى قبائل عريقة في عموم الجزيرة العربيّة أنّها بمثابة شبكة واسعة من سلاسل أنساب نُسجت في مرحلة مبكرة، لكن لا يعول على وثاقتها».
وصفوة القول: إنّ نسب الرّسول صلىاللهعليهوآله إلى إسماعيل لم يكن جزءًا من خرافة فارغة كما يرى وليم ميور الذي تبنّى موقفًا تعسفيًّا من هذه القضية وأظهر إصرارًا على الرغم من إقراره ببراعة العرب بالأنساب، وإنّ الأنساب كانت محفوظة ضمن الذاكرة الشعبيّة وليس من شك أنّ الأمم التي تحوز على مقدرة لحفظ سلالات إبلها وخيولها على مدى ستّة قرون تستطيع الإحاطة بتاريخها لفترات أطول.
(249)
(251)
حصدت رؤية ميور بِشأن الوحي صدى واسعًا لدى كتَّاب القرن 13ه/ 19م والعقد الأول من القرن 14ه/ 20م، وعلى الرغم من أن ميور لم يقدّم بيانًا دقيقًا لمفهوم الوحي، لكنّه عبّر عنه بصيغ لغويّة مختلفة تحمل دلالات متباينة مثل: صيغة Inspiration؛ وصيغة Revelation؛ وصيغة Oracle، ولدى المقارنة بين مرادفات كلمة الوحي في الترجمات الإنكليزيّة في القرآن، يظهر أنّ كلمة Inspiration وردت في القواميس الإنكليزية بمعنى: «تحفيز العقل والمشاعر لنشاط من نوع خاص وما يترتب على فكرة من فعل ما»، أمّا صيغة Revelation، فتعني: «كشف الرب عن ذاته للإنسان من خلال كلام الإنسان من خلال وسيط»، ولعلّ التّعريف الأول لا يفي بالمدلول السماوي للكلمة لكنّه يتماشى مع آراء وليم ميور بهذا الصدد.
ويبدو أنّ ميور عوّل على صيغة الوحي inspiration في أغلب متونه التي غالبًا ما عطف عليها بلاحقة مثل pretended المزعوم، أو عبّر عنها بصيغة the idea of inspiration فكرة الوحي، أو كما ترد في عبارة The Belief of Mahomet in his own Inspiration إيمان محمّد بوحيه الذاتي، وجميع هذه المعاني تحمل بين جنباتها دلالة ثابتة على أنّ الوحي يجسّد فكرة منبثقة من ذات محمّد صلىاللهعليهوآله وليست رسالة سماويّة متلقاه من لدن الله تعالى، وعلى الرغم من ذلك فقد استخدم ميور أيضًا التعبير الدقيق لكلمة Revelation لبيان طبيعة الوحي وتجلّياته المتخيّلة حسب تعبيره.
ولعلّ التباين اللغوي لا يشكّل فرقًا لدى ميور لأنّ المصدريّة في كلتا الحالتين ليست إلهيّة، ولعلّه يرمي من خلال اعتماده لصيغة Revelation إلى محاكاة الصيغ التاريخيّة في المصادر الإسلاميّة التي اعتمدها؛ أمّا عن مدلول Inspiration فيبدو أنّ ميور عوّل عليه بنحو رئيس في مؤلّفاته للإشارة إلى أنّ الوحي من نتاج المخيّلة المحمديّة.
يُضاف إلى ذلك اعتماده لكلمة أخرى مرادفة «Oracle» ذات الأصل اللاتيني التي غالبًا ما كان يشار بها إلى الكهنة الذين يبصرون بالتنبّؤات، وقد تعني أيضًا أنّ الآلهة تتكلّم مباشرة إلى الإنسان ولعلّه استخدم هذه المرادفة للتدليل على الوحي الشفهي، فيرى: «أنّ وحي محمّد كان يظهر بنحو اعتراضيّ للفصل في القضايا السياسيّة والاجتماعيّة»، ولعلّ مبعث التباين في التعابير اللغويّة يرتدّ إلى سعيه «لتتبّع تنامي فكرة الوحي والرسالة الإلهيّة في ذهنيّة محمّد».
ذكرت المعاجم اللغوية أنّ الوحي، هو الْكِتَابُ وهو إعلام في خفاء، وأَصْلُ الوَحي الإشارَةُ السَّريعَةُ وذلكَ يكونُ بالكَلامِ على سَبيلِ الرَّمْز والتَّعْرِيضِ، ويكونُ بصَوْتٍ مُجرَّدٍ عَن التّرْكيبِ، ويقالُ للكَلِمَةِ الإلهيةِ الَّتِي تُلْقى إلى أَنْبيائِه وأَوْليائِه وَحْيٌ، وذلكَ إمَّا برَسُولٍ مُشاهِد تُرى ذَاته ويُسْمع كَلامه كتَبْلِيغ جِبْريل فِي صُورَةٍ مُعَيَّنة، وإمَّا بِسَمَاع كَلام مِن غَيْر مُعاينةٍ كسماعِ موسَى لكلام الله تعالى، وإمَّا بنزوع فطري نَحْو: (وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ)، أو بتَسْخيرٍ نَحْو: (وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ).
أمّا الإلهام فيعتمد على التفكير في الاستنباط، والتأرجح بين الشكّ واليقين، والوحي حالة فريدة لا تنحصر تحت طراز ولا تخضع إلى التفكير ولا مجال معها للشك؛ كما أنّ الإلهام لا شعوري ولا إرادي، لكنّ الوحي ظاهرة شعوريّة تتّسم بالوعي والإدراك التامّين، لأنّه خارجي المصدر نابع عن استعداد النفس للنبوّة غير متأثّر بنفسهِ الداخليّة وغير ملتزم بالحدود الطبيعيّة للعقل البشري، ينقل للإنسان حقائق تتجاوز نطاق إدراكه العقلي.
الوحي عرفان يجده الشخص من نفسه مع اليقين بأنّه من قبل الله بواسطة أو بغير واسطة، الأول بصوت يتمثّل لسمعه أو بغير صوت، والإلهام وجدان تستيقنه النفس وتنساق إلى ما يطلب من غير شعور منها؛ أشبه بوجدان الجوع والعطش والحزن والسرور ليشمل أنواع الوحي الثلاثة الواردة فى قول تعالى: (وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِن وَرَاءِ حِجَابٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا فَيُوحِيَ بِإِذْنِهِ مَا يَشَاءُ ۚ إِنَّهُ عَلِيٌّ حَكِيمٌ) ، فالوحي إلقاء المعنى في القلب، وقد يعبّر عنه بالنفث في الرّوع والقلب والخلد والخاطر، والكلام من وراء حجاب أي أن يسمع كلام الله من حيث لا يراه كما سمع موسى عليهالسلام النداء من وراء الشجرة، وأما ما يلقيه ملك الوحي المرسل من الله إلى رسول الله فيراه متمثّلًا بصورة رجل، أو غير متمثّل، ويسمعه منه أو يعيه بقلبه، فالوحي ظاهرة ربانيّة المنشأ ملائكيّة النقل بشريّة التبليغ.
وردت لفظة الوحي واشتقاقاتها في القرآن بنحو ثمان وسبعين مرّة، وقد بيّن القرآن الكريم صورة متكاملة عن دلالة لفظ الوحي على الرغم من عدم وجود مرادف لها في اللغات الأخرى، وفصّل في مسألة التباين بين معنى الإلهام؛ بما يعني
الإبداع الذي يفيض عن الذات الواعية وغير الواعية بوحي من الله تعالى، وهذا يماثل من حيث المعنى عبارة Inspiration إن صحّ البيان، وبين الوحي الرسولي الذي يحمل أوامر السماء إلى البشر عبر الأنبياء، الذي يطابق صيغة Revelation.
ومدار الحديث بشأن حالة خاصة من الوحي بمعناه المصدري أي الإعلام والتفهيم بالتصويت شيئًا بعد شيء، والمراد كيفيّة تلقّي الرّسول صلىاللهعليهوآله لألفاظه، إذ أنّ الإقراء ينافي الإلهام منافاة لغويّة ومفاهيميّة، فالوحي تَلَقٍّ مأخوذ من الإلقاء، كما في قوله تعالى: (فَأَلْقَوْا إِلَيْهِمُ الْقَوْلَ إِنَّكُمْ لَكَاذِبُونَ) (سورة النحل: الآية 86)، كذلك من المُتَلقّي، كما في قوله تعالى: (إِذْ تَلَقَّوْنَهُ بِأَلْسِنَتِكُمْ) (سورة النور: الآية 15)، ويستعمل إلقاء القول استعمالًا لغويًّا خاصًّا في التعليم، وتلقّيه في التعلّم، والتّواصل، وهما حسّيّان، ومنه قوله تعالى: (وَلَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الصَّابِرُونَ) (سورة القصص: الآية 80)، أي ما يعلمها، ولا يُنبّهُ عليها، ومنه قوله تعالى: (فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَّبِّهِ كَلِمَاتٍ) (سورة البقرة: الآية 37) هذه المعاني كلّها تجتمع في تلقي الرّسول صلىاللهعليهوآله، لأنّه إلقاء وتلقٍّ محسوسين، بين جهتين اعتمدتا القول، يعتمد الأخذ بينهما على القول لا غيره من أنواع الإيحاء، مطبقَينِ في ذلك ضوابط العمليّة التعليميّة والتعلُّميّة ويظهر ذلك بيّنًا بلا خفاء عند الجمع بين الوصف العام لأخذ النبي صلىاللهعليهوآله ألفاظ القرآن الكريم من جبريل بأنّه تعلّم كما في قوله تعالى: (عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوَىٰ) (سورة النجم: الآية 5)، وبين الوصف الخاص لذلك بأنّه تلقٍّ كما في قوله تعالى: (وَإِنَّكَ لَتُلَقَّى الْقُرْآنَ مِن لَّدُنْ حَكِيمٍ عَلِيمٍ) (سورة النمل: الآية 6) وآيات القرآن الكريم موصوفًا بالأمر العام، وهو التعليم في قوله تعالى: (عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوَىٰ) (سورة النجم: الآية 5)، وموصوفًا بالأمر الخاص (التلقي) كما في قوله تعالى:(وَإِنَّكَ لَتُلَقَّى الْقُرْآنَ مِن لَّدُنْ حَكِيمٍ عَلِيمٍ) (سورة النمل: الآية 6)، لغاياتٍ نفي الإلهام، وإثبات المشافهة لأنّه تعليم مباشر «تلقين» وليس إلهامًا.
لقد أكّد القرآن تلقّي الوحي في أوّل لقاء لجبريل بالرسول صلىاللهعليهوآله في غار حراء؛ إذ أقرأه ولم يُلْهِمْه، وأكّد له الإقراء بضمّه إليه: (اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ) ومثله: (سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنسَىٰ) (سورة الأعلى: الآية 6)، وقوله تعالى: (فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ) (سورة القيامة: الآية 18)؛ ففيها الأمر بالاستماع والإنصات؛ والاستماع والإنصات ينافيان الإلهام الذي يقع في النفس دون استماع لأحد.
فالوحي المباشر يختلف عن الإلهام الغريزي أو الفطري، فالإلهام قد يكون نابعًا من الذات، وقد يخطئ الإنسان فيه أو يصيب ولا يعرف مصدره، بخلاف الوحي المباشر فإنه أمر خارجي تتلقّاه النفس البشريّة، وتعرف جيّدًا مصدره، فلا يلتبس الأمر عليها، لأنه خاص بالأنبياء، ولا يكون لغير الأنبياء، بخلاف الإلهام الفطري فقد يكون لغير الأنبياء، وقد يكون إلهام خير أو إلهام شر، ويختلف مصدره، أضف إلى أنّ القرآن الكريم ظَّل ينزل على الرّسول صلىاللهعليهوآله قرابة الثلاثة والعشرين عامًا، فلا يعقل أن يلازم الحدس أو الإلهام طوال هذهِ السنين ويكون معه في كل ما مرَّ من أحداث صغيرة وكبيرة شهدها الإسلام؟.
ذكر ميور: «أنّ محمّدًا كان يترقّب الوحي ليبدّد الظلمة الحالكة التي كانت تخيّم على قومه، فالحيرة والمصير الغامض للإنسان وفشل الإيحاء المتكرّر جعلته يعتقد بأن جبريل سيزوره كما زار زكريا وزار مريم من قبل ليعلن بدء عهد جديد».
ولم يذكر الإخباريون وأهل السيرة أيّ إشارة عن هذه القضيّة كما كان لأمية
بن أبى الصلت، الذي كان يترقّب في نفسه الارتقاء نحو الاصطفائيّة بفعل التّسامي العقلي والنضج الروحي الذي استشعره بنفسه بفعل كثرة أسفاره أو بفعل مطالعاته وتأملاته المعمّقة، لكن الأمر يختلف تمامًا في قضيّة الرّسول صلىاللهعليهوآله، لأنّ استشرافه للوحي والنبوة لم يكن حالة تأمليّة جاءت بفعل طفرات عقليّة، بل كان استشرافًا يقينيًّا بحتميّة الاصطفائيّة، وقد حوت مدوّنات السيرة على حوادث استثنائيّة قبل سنّ الأربعين عُدّت بشارات على نبوّته لاحقًا، ومنها بشارة سيف بن ذي يزن لعبد المطلب، وتساقط الأصنام في الكعبة وارتجاس إِيَوانُ كِسْرَى، ونَارُ فَارِسَ التي خمدت، وفيضان بُحَيْرَةُ سَاوَةَ عند ولادته، وخبر عبد المُطلب عندما شعر بدنو أجله أوصى أبا طالب بتكفّل رسول الله صلىاللهعليهوآله من بعده وسقاية زمزم وقال له: «قد خلفت في أيديكم الشرف العظيم الذي تطأون به رقاب العرب»، وبشارة بحيرة الراهب وسواها من المرويّات السيريّة وإذ عوّلنا على هذا النوع من المرويّات فذلك يعد برهانًا على أنّ الاصطفائيّة متحقّقة في شخصيّة محمّد صلىاللهعليهوآله، في تصوّرات المحيطين به على أدنى تقدير، الأمر الذي يتعارض مع رؤية ميور الذي يرى باعتباطية الاستشراف، وصلتها بالطفرة العقليّة، فعندما سُئِل الرّسول صلىاللهعليهوآله عن بداية نبوّته قال: «كُنْتُ نَبِيًّا وَآدَمُ بَيْنَ الرُّوحِ وَالْجَسَدِ»، ويبدو أنّ الرّسول صلىاللهعليهوآله لم يكن مدركًا لحيثيّات الاصطفائيّة وزمكانيّة خط شروعه بالمهمّة النبويّة، ولا سيّما وقد تطرّق القرآن إلى هذه المسـألة في قوله تعالى: (وَمَا كُنتَ تَرْجُو أَن يُلْقَىٰ
إِلَيْكَ الْكِتَابُ إِلَّا رَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ ۖ فَلَا تَكُونَنَّ ظَهِيرًا لِّلْكَافِرِينَ) (سورة القصص: الآية 86)، والذي يرى فيه الطبري: «وَمَا كُنْت تَرْجُو يَا محمّد أَنْ يُنَزَّل عَلَيْك هَذَا القرآن، فَتَعْلَم الْأَنْبَاء وَالْأَخْبَار عَنْ الْمَاضِينَ قَبْلك، أو ما كنت تظن قبل إنزال الوحي إليك أن الوحي ينزل عليك»، ويرى الطبرسي أنّ معنى ذلك: «وما كنت يا محمّد ترجو في ما مضى أن يوحي الله إليك ويشرفك بإنزال القرآن عليك إلا رحمة من ربك».
ورغم ذلك ثمّة رأي آخر حملته مصادر السيرة بين دفتيها ويتقاطع مع رؤية ميور لهذه القضيّة، مؤدّاه أنّ الرّسول صلىاللهعليهوآله كان غافلًا عن أمر الوحي، ولم يفكّر فيه أو يبحث عنه، ولو كان الأمر كما يرى ميور، ما كان له أن يشعر بالخوف عندما رأى جبريل وسمع صوته حتّى إنه قطع خلوته، وعاد إلى بيته مسرعًا ولم تجد زوجته خديجة عليهاالسلام حسبما ورد أمامها من وسيلة لتهدّئ من روعه سوى أن تذكِّره بما سلف من عمله الصالح، وخلقه الطيب، فقالت: «كلا والله لا يخزيك الله أبدًا، إنك لتصل الرحم، وتحمل الكَلَّ، وتُكْسِب المعدوم، وتُقري الضيف، وتُعين على نوائب الحق»، وقد أقرّ رودنسون Rodinson: «أنّ محمّدًا أظهر شكًّا طويلًا قبل أن يطمئن إلى أن الذي يأتيه وحي من عند الله وهذا الشكّ برهان قويّ على أنّه لم يكن يتطلّع قبل الوحي أن يكون رسولًا».
ولعلّ ميور قد طالع في سيرة الرّسول صلىاللهعليهوآله فوجده كان يتحنّث في غار حراء فظنّ أنّه كان يترقّب الوحي، ولعلّ الصحيح ما أورده ابن حجر في أنّه لم يكن مبتدعًا للتحنّث في قريش، بل كانت تلك عادة مستحكمة فيهم، لم ينازعوا الرّسول صلىاللهعليهوآله في غار حراء، مع مزيد الفضل فيه على غيره، لأن جدّه عبد المطلب كان أوّل من يخلو فيه من قريش، وكانوا يعظّمونه لجلالته، وكبر سنّه، فكان صلىاللهعليهوآله يخلو بمكان جدّه، وسلّم له ذلك أعمامه لكرامته عليهم.
إنّ اكتشاف الحقيقة الجوهريّة ومعرفة الله تعالى ليست العلم الديني كله، فبأيّ إلهام استطاع الرّسول صلىاللهعليهوآله أن يكتشف صفات الله العديدة والمصير الذي ينتظر الإنسان بعد الموت؟ لا شكّ في أن العقل مهما بلغ من الصفاء والقوّة لا يستطيع أن يخطو خطوة واحدة في هذا السبيل وبمثل هذه الثقة ما لم يكن له عون من تعاليم إيجابيّة خارج نطاق البشر.
إنّ ما يثير التساؤل: أنّى لوليم ميور أن يعلم أن الرّسول صلىاللهعليهوآله كان يترقّب الوحي؟ وأنّى له أن يفترض هذه المحاورة التي حدّدت حتميّة نزول الوحي عليه إسوة بزكريّا ومريم؟
لقد عوّل ميور على الافتراضات التخمينيّة في بناء تصوّراته عن الوحي كما عكف على زجّ هذه التصوّرات في سياق الأحداث، وهذا يعدّ خروجًا عن قواعد البحث التاريخي، إنّ التحقيق في حال الرّسول صلىاللهعليهوآله من أول نشأته، وإعداد الله تعالى إيّاه لنبوّته أنّه خلقه كامل الفطرة، كامل العقل الاستقلالي ليبعثه بدين العقل المستقل والنظر العلمي، وأنّه كمل بمعالي الأخلاق، ليبعثه متمّمًا لمكارم الأخلاق، وأنّه بغّض إليه الوثنيّة وخرافات أهلها من صغر سنه، وحبّب إليه العزلة حتّى لا تأنس نفسه بشيء يتنافسون فيه من الشهوات، أو منكرات القوّة الوحشيّة، كسفك الدماء، والبغي على النّاس، أو المطامع الدنيئة كأكل أموال الناس بالباطل ليبعثه مصلحًا لما فسد من أنفس الناس، ومزكيًّا له بالتأسى به، وجعله المثل البشري الأعلى، لتنفيذ ما يوحيه إليه من الشرع الأعلى. إنّ باب النبوّة ليس مفتوحًا لكل أحد مهما عظم الإشراق أو سمَتْ نفُسه، وإلى ذلك يشير دي كاستري قائلًا: «إنّ محمّدًا خلقه الله ذا نفس تمحصّت للدّين ومن أجل ذلك آثر العزلة عن النّاس لكي يهرب من عبادة الأوثان ومذهب تعدّد الآلهة».
يصل ميور إلى هذه المرحلة من نظريّته بشأن الوحي بإنكاره حدوث اتصال الرّسول صلىاللهعليهوآله مع جبريل زاعمًا: «أنّ مخيّلة الرّسول المترقّبة للوحي صوّرت له أن شاهد جبريل، عندما كان جالسًا يتأمّل في جبل حراء غارقًا في أحلام اليقظة وفي لحظة أدرك بمشاعره المتحمّسة بعد أن جسّدت له مخيّلته أنّه شاهد جبريل رسول الربّ الذي طالما استحكم على وجدانه بشكل مبهم، فظهر له في السّماء يحمل له تفويض النبوّة في السّورة السادسة والتسعين «سورة العلق».
إنّ معالجة واقعة تمتدّ جذورها إلى الماورائيّات، وترتبط أسبابها بالسماء، لا يمكن بحال أن تُعامل كما تُعامل الجزئيّات والذرّات والعناصر في مختبر للكيميّاء أو كما تعامل الخطوط والزوايا في المساحات على تصاميم المهندسين، بل ولا كما تعامل الوقائع التاريخيّة التي لا ترتبط بأيّ بعد دينيّ أصيل. إنّنا هنا بمواجهة تجربة من نوع خاص، وشبكة من الفواعل والمؤثّرات تستعصي على التحليل المنطقيّ الاعتياديّ المألوف، فأيّ محاولة لقسرها على الخضوع لمقولات العقل الصّرف ومعطيات المنطق المتوارثة لا بدّ أن يقود إلى نتائج خاطئة كما في محاولة تفحّص الجسد البشري؛ كما لو كان في حالة سكون مطلق بعيدًا عن تأثيرات الروح. إنّ الدّين، والغيب، والروح، لهي عصب السيرة النبويّة وسداها وليس بمقدور الحسّ أو العقل أن يدلي بكلمته فيها إلّا بمقدار، وتبقى المساحات الأكثر عمقًا وامتدادًا بعيدة عن حدود عمل الحواس وتحليلات العقل والمنطق.
لقد بيّن الله تعالى أنّ الوحي ليس نابعًا من داخل محمّد صلىاللهعليهوآله بل حمله إليه جبريل، رسول كريم من الله تعالى ذكره القرآن بأنّه روح القدس، والأمين،
والروح، فهو كائن أظهر الله تعالى صفاته بأنّه: (إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ ﴿١٩﴾ ذِي قُوَّةٍ عِندَ ذِي الْعَرْشِ مَكِينٍ ﴿٢٠﴾ مُّطَاعٍ ثَمَّ أَمِينٍ) ، وليس خيالًا دينيًّا لأنّه رسول الله إلى الأنبياء والصالحين ومنهم زكريّا ومريم كما أقرّ ميور.
أمّا أحلام اليقظة، فتمثّل حالة من حالات الاضطراب العقلي التي تظهر على شكل تخيّلات خلال فترة الصحوة يعتقد صاحبها أنّه يرى ويسمع أو يذوق ويشمّ أو يلمس أشياء ليس لها وجود، وترتد هذه الخيالات إلى ذكريات قديمة في اللاوعي، وهذا أبعد ما يكون عن حالة الرّسول صلىاللهعليهوآله الذي لا يمكن له أن يتخيّل رؤية جبريل في المرة الأولى لاستحالة إرجاعها إلى ذكرى قديمة كونه لم يشاهد ملكًا من قبل، ولعلّ الأشخاص الأسوياء إن أصابتهم هلوسة، غالبًا ما يتحقّقون أنّها هلوسة في الحال بخلاف المختلّين، فلو كان ما يرآه وما يسمعه من الوحي من قبيل التخيّل فإنّه سينتبه فورًا لعدم صحّة ذلك، كذلك فإن ما يعرف بأسباب النزول القرآني ينفي إمكانيّة الهلوسة، فالنازل من الوحي مناسب لوقائع حدثت لا مجرّد خيالات لا تتّصل بالواقع كما في حالات الهلوسة.
إنّ اتزان الرّسول العقلي والنفسي ثابت بكل المقاييس وبشهادة المستشرقين أنفسهم ومنهم رودنسون الذي أقرّ له بالاتّزان والثقة وقدرته على استحواذ إعجاب من حوله، وإلّا فكيف يا ترى نجح في دعوته؟.
إنّ بشريّة الرسول، وملكيّة جبريل اقتضت أن يُهيّأ النبي لإمكانيّة لقاء الرّسول
الملك في أي وقت، من حيث اختلاف الطبيعة في كل منهما، وبُدِئ بذلك ليكون تمهيدًا، وتوطئة لليقظة من ثم مَهّد له في اليقظة أيضًا برؤية الضوء، وسماع الصوت، فكان جبريل يأتيه في الرؤيا كنوع من التّدرج في اعتياد الطبيعة البشريّة لمحمّد صلىاللهعليهوآله ، وقد ورد في حديث بدء الوحي: «أوّل ما بدئ به رسول الله الرؤيا الصادقة كفلق الصبح على أن الذي كان يراه جبريل، ولفظه: أنّه قال لخديجة عليهاالسلام بعد أن أقرأه جبريل اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ: أرأيتك الذي كنت أحدّثك أنّي رأيته في المنام فإنه جبريل استعلن»، وكان أَكْثَرُ الأنبياء ابْتُدِئَ بِالْوَحْيِ فِي الْمَنَامِ ثُمَّ رَقُوا إلى الْوَحْيِ فِي الْيَقَظَةِ حتّى تهدأ قلوبهم فَهَذَا بَيَانُ مُنَاسَبَةِ تَشْبِيهِ الْمَنَامِ الصَّادِقِ بِالنُّبُوَّةِ فكانت مُدَّةَ وَحْيِ الْمَنَامِ إلى نَبِيِّنَا صلىاللهعليهوآله سِتَّةَ أَشْهُرٍ.
لقد أكّد القرآن الكريم وقوع الاتّصال الحسي بين جبريل والرسول صلىاللهعليهوآله في قوله تعالى: (مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَأَىٰ ﴿١١﴾ أَفَتُمَارُونَهُ عَلَىٰ مَا يَرَىٰ) (سورة النجم: الآيتان 11-12)، ولعلّ ميور ردّد ما كانت تقذفه ألسنة قريش، ولا سيّما أنّ كلمة تُمَارُونَهُ مِنَ المِراء أي المجادلة، فالأظهر في قوله تعالى: ( مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَأَىٰ ) (سورة النجم: الآية 11) أن يكون تأكيدًا لمضمون: (فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ) (سورة النجم: الآية 9) لرفع احتمال المجاز في تشبيه العرب، أي قربٌ حسيٌ، وليس مجرّد اتصالٍ روحانيّ، حتّى يكون الاستفهام في «أفَتُمَارُونَهُ» مستعملًا في الفرض، والتقدير، «أفستكذبونه فيما يرى بعينيه»، كما كذبتموه في ما بلغكم عن الله تعالى، وهذا يؤكّد تلقّي الرّسول صلىاللهعليهوآله عن جبريل تلقي رؤيةٍ، لا رؤية قلبٍ وعين فحسب، وخصّ الفؤاد، لأن رؤية الفؤاد لا يتأتى معها تخيّل، بخلاف رؤية العين التي قد تخدع خداع نظر، وأن رؤية الرّسول لجبريل وسماعه له حال إلقاء الوحي يكون متّصلًا بمركز السّمع والبصر في الفؤاد مباشرة.
كما شدّد القرآن على رؤية الرّسول صلىاللهعليهوآله لجبريل في صورته التي خلقه الله عليها عيانًا: (وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ ) (سورة النجم: الآية 13) (وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ) (سورة التكوير: الآية 23)، أي إن كنتم تجحدون رؤيته لجبريل في الأرض، فلقد رآه رؤية أعظم حين يأتي إليه للوحي إذ رآه في العالم العلوي وشدّد على ذلك بالقسم، فضمير الرفع في رآه عائد إلى صاحبكم، وضمير النصب عائد إلى جبريل، وأكّد ذلك قائلًا: (مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغَىٰ) (سورة النجم: الآية 17)، أي: رأى جبريل رؤية لا خطأ فيها، ولا زيادة على وصف، أي لا مبالغة فيها ومن حكم رؤية النبي لجبريل في هيئته التي خلق عليها أن يَطْمَئِنَّ في نفسه إلى ملائكية جبريل فرآه على هيئته الحقيقيّة مرتين، وشدّد على ذلك بالقسم، إذ اللام في قوله (وَلَقَد) مُوَطّئةٌ للقسم، أي: وبالله لقد رآه، والمعنى: رآه بعينه، وعرفه بقلبه، ولم يشك في أن ما رآه حق، فالمرة الأولى: بالأُفق المبين بعد أمر غار حراء، والمرة الأخرى عند سدرة المنتهى، وتكرار الرؤية للتأكيد؛ لئلا يكون للوهم سبيل إلى نفسه وسائر من بلغ من الخلق أجمعين، وقد كانت الأخرى في مكانٍ لا يُشَكُّ فيه، ولا يزيغ البصر عنده، ولا يطغى.
لقد نعت القرآن الكريم جبريل بأنّه «ذو قوّة» فلا شي يدل على أنّه استعمل القوّة إزاء محمّد بل هو رسول كريم، ففي الرؤية الأولى لسورة النجم دنا منه، فكأنّه الهمس، أمّا في الرؤية الثانية للسورة نفسها فقد انكشف أمامه. إنّ المقطع القرآني السّابق يبيّن بكل نصاعة لحظة تجلّي المخارق لمحمّدصلىاللهعليهوآله التي تلتها فورًا لحظة الوحي، لتتلوها رؤية ثانية وهنا استعمل كلمة (رؤية) بدل (رؤيا) لأنّه اتّضح أنّ القرآن لا يقصد رؤيا في المنام ولا حتّى في حالة خاصّة من انخطاف وغير ذلك بل رؤية بالبصر يصدقها العقل.
ويخلص ابن خلدون: «إنّ الموحى إليهم وهم الأنبياء جعل الله لهم الانسلاخ
من البشريّة في جسمانيّتها وروحانيّتها إلى الملائكة من الأفق الأعلى... فتارة يسمع أحدهم دويًّا كأنّه رمز من الكلام يأخذ منه المعنى الّذي ألقي إليه فلا ينقضي الدّويّ إلّا وقد وعاه وفهمه، وتارة يتمثّل له الملك الّذي يلقي إليه رجلا فيكلّمه ويعي ما يقوله والتّلقّي من الملك والرّجوع إلى المدارك البشريّة وفهمه ما ألقي عليه كلّه كأنّه في لحظة واحدة بل أقرب من لمح البصر لأنّه ليس في زمان بل كلّها تقع جميعًا فيظهر كأنّها سريعة ولذلك سمّيت وحيًا لأنّ الوحي في اللّغة الإسراع».
لقد شارك الرّسول صلىاللهعليهوآله النّاس في البشريّة من حيث الصورة وباينهم من حيث المعنى، لاستعداد بشريّته لقبول الوحي: (قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ) (سورة الكهف: الآية 110)، وأشار إلى طرف المشابهة من حيث الصورة: (يُوحَىٰ إِلَيَّ) (سورة الكهف: الآية 110)، وهنا أشار إلى طرف المباينة من حيث المعنى، فضلًا عن أنّ الملائكة قادرة على التشكّل بأشكال شتّى، وقد يتمثّل بهيئة البشر، كما زارت الملائكة إبراهيم وزوجه ولم يقربًا لطعامه، وكما ظهر لمريم بنت عمران بصورة بشريّة، وكما كان يظهر أحيانًا لمحمّد صلىاللهعليهوآله في صورة دحية بن خليفة الكلبي.
وفي عصرنا يمكن للإنسان أن يسمع إنسانًا، ويرى آخر دون أن يشترك معه غيره من المحيطين به في زمان التكلّم والرؤية إذا توافر الجهاز المرسِل عند من يتكلّم، والمستقبِل عند من يسمع، وهكذا نقرّر بأنّ الله تعالى قد هيّأ القدرة لجبريل للاتّصال برسوله، وهيّأ الرّسول بمستقبلات لما يُوحى إليه، تُدرك آثارها، ولا تُرى حقيقتها وكيفيّتها.
تُعدّ شبهة إصابة الرّسول صلىاللهعليهوآله بالصرع من أقدم المفتريات على السيرة، إذ ورد أقدم إشارة لها في كتابات البيزنطي ثيوفانيس Theophanes (144-204ه/ 760-818م)، فمن النّدرة أن تجد كاتبًا غربيًّا لم يتعرّض لهذه الشبهة، لكن أنّى للغرب الإحاطة بمعرفة ذلك في الوقت الذي لم يعاين الرّسول أيّ طبيب كتابيّ خلال حياته؟.
ويبدو أنّ ميور لم يخالف شرعة أسلافه، فزعم أن تخيّل الوحي لم يأتِ من فراغ لأنّه يمثّل تجلٍّ لحالة مرضيّة وعقليّة مضطربة لازمت الرّسول صلىاللهعليهوآله منذ صغره كانت بدايتها نوبات صرع، وقد أورد في ذلك قوله: «في سنّ الرابعة ولما كان وديعة عند بني سعد عند مرضعته حليمة السعديّة حدثت للرضيع حادثة غريبة عصفت بقلب مرضعته بشدّة ولعلّها كانت نوبة صرع»، ويرى في موضع آخر: «وسرعان ما تكرّرت أعراض الصرع التي انتابت وديعتها؛ ما حملها إلى التخلّي عنه بعد عام»، ويرى أيضًا: «ولا نجافي الصواب اذا عددنا تلك النوبات التي أقلقتْ حليمة، نوبات صرعية، تمثلّت في بنيان محمّد بأعراض طبيعية وحالات هياج وإغماء مصحوب بنشوة، صور لعقله إنّ هذه النوبات ذات صلة بفكرة الوحي التي عكف أتباعه على عدّها برهانًا على ذلك دون أدنى ريبة».
لقد أسّس ميور هذه القضيّة على رواية ابن سعد، في معرض حديثه عن حادثة
شقّ الصدر، وعلى فرض صحّة هذه النصوص، من الناحية الطبيّة لا توجد علاقة بين الصرع وشقّ الصدر، كذلك يبدو أنّ ميور أقام هذه القضيّة وفق رؤية تخمينيّة، إذ وردت صيغة «probably a fit of epilepsy» من المحتمل أنّها نوبة صرع في سياق حديثه الذي يتعارض مع المنحى الثبوتي الذي شدّد على أنّها نوبات صرع تكرّر حدوثها، حتّى غدت سببًا لإرجاعه إلى أمّه،كما أنّه خالف سياق رواية ابن سعد الأصليّة، الذي أشار إلى أنّ الرّسول كان منتقع اللون أي متَغَيَّرَ اللون إمّا منْ خَوْفٍ، وإمّا منْ مَرَضٍ، لم يشِر إلى أي من أعراض الصرع، كما أنّ هذه الحادثة لم تكن سببًا في إرجاعه إلى أمّه بنحو نهائي لأنّ الذي حملها إلى التخلّي عن حضانته نهائيًّا قصّة الغمامة، وليس كما يرى ميور بسبب تكرار نوبة الصرع، وهذا يدلّ على أنّ قراءته لرواية ابن سعد قراءة إسقاطيه، فضلًا عن أنّ مصادر السيرة لم تذكر حدوث أعراض صرعيّة على النبي صلىاللهعليهوآله لما كان في سنّ الرّابعة من عمره حتّى ينخلع قلب مرضعته!
كما أقدم ميور على تحريف كلمة «أصيب» التي وردت على لسان زوج حليمة والتي أوردها باللّغة العربيّة بصيغة «أميب» مجهولة المعنى وشرع بترجمتها إلى الإنكليزيّة بـ «نوبة» had a fit.
وقد تحرّى الباحث عن أصل الكلمة ودون جدوى، فلم يرِد لها في سيرة ابن هشام أو في أيّ مصدر آخر من كتب السيرة أو أيّ من معاجم اللغة العربيّة معنى أو دلالة مماثلة، لكن السيّد خان يذهب إلى أنّ هذه الكلمة كانت تحمل دلالة
عند العرب عن الشخص الذي تسكنه الأرواح الشرّيرة وقضيّة الصرع معقودة برمّتها على خرافات يونانيّة تعزو فيه العوارض المرضيّة للمصروع إلى حلول أرواح شريرة فيه.
وليس في نصّ ابن هشام أيّ دلالة على إصابة الرّسول صلىاللهعليهوآله بطائف من الشيطان، بقدر ما حاول ابن هشام أن يبيّن حالة الدهشة التي باتت عليها أسرته وهو يقصّ عليهم حكايته مع الغرباء كما أنّ سياق الرواية يدلّ على أنّ زوج حليمة كان مرتابًا من أمره ولم يتثبّت من إصابته بطائف من الشيطان كما أورد «فَأَلْحِقِيهِ بِأَهْلِهِ قَبْلَ أَنْ يَظْهَرَ ذَلِكَ بِهِ»، كما أنّ جواب السيّدة آمنة بنت وهب لحليمة يدلّ على أنّها كانت مطمئنّة لسلامته من أيّ مسّ شيطاني فلم يظهر عليها علامات القلق حال رؤيته قافلًا إليها مع مرضعته، ولا غرو في أنّ وليم ميور يتأوّل النّصوص وفقًا لما يريد من أجل أن يربط بين هذه الحادثة في مرحلة الطفولة واستمرار تأثير الشيطان في مرحلة الأربعين.
لقد عمد وليم ميور إلى التعميم التعسّفي الافتراضي، وإلّا، أنّى له هذا التأكيد في الوقت الذي يقرّ بأن: «محمّدًا لما كان في عمر السنتين كان طفلًا صحيحًا وحجمه كان ضعف عمره ولم تظهر عليه أيّة علامة مرضيّة حتّى أنّ أمّه آمنة كانت مسرورة به وطلبت من حليمة أن ترجعه معها إلى البادية»؟.
ويظهر مبلغ التّهافت لدى ميور بنحو جليّ عندما يُقرّ بأنّ الرّسول صلىاللهعليهوآله: «عاش صحيحًا حتّى سنّ الأربعين وعندها أصاب عقله المرض»، وهذا يناقض مقولته السابقة بشأن المرحلة المرضيّة المبكّرة وإقراره بأنّه كان تامّ الصحة حتّى سنّ الأربعين ولم تبدأ العوارض إلّا عند تقبّل الوحي؛ فلا يعقل أنّه كان مصابًا بحالة مرضيّة ولم تظهر عليه طوال 36 عامًا، ولا سيّما وقد أشار مارغليوث إلى: «أنّ
أعراض الصرع ألصقت بمحمّد عمدًا وهذه الأعراض لا صلة لها بالوحي، فكان يأتيه الوحي وهو يتناول الطعام أحيانًا، أو على المنبر، ولم يحدث له أي أعراض شخير، أو احمرار للوجه، أو دخوله في غيبوبة، أو سماعه لأصوات أجراس في أذنه، أو خروج رغوة من فمه، أو عضّ لسانه، وهذه أعراض الصرع التي تودّي إلى ضعف دماغي تدريجي».
ويرى المستشرق الهولندي دي غويه أنّ الحافظة لدى المصروعين تكون معطّلة على حين، غير أنّ حافظة محمد صلىاللهعليهوآله كانت غاية في الجودة، ويفيد بودلي: «أنّ المصاب بالصرع، لا يُفِيق منه إلا وقد ذخر عقلُه بأفكار لامعة، وأنّه لا يصاب بالصرع مَن كان في مثل الصحّة التي يتمتَّع بها محمّد حتّى قبل مماتِه بأسبوعٍ واحد، وما كان الصرع يجعل من أحد نبيًّا أو مشرِّعًا، وما رفع الصرع أحدًا إلى مركز التقدير والسلطان يومًا، فكان مَن تنتابه مثلُ هذه الحالات في الأزمنة الغابرة يُعد مجنونًا أو به مسٌّ من الجنّ، ولو كان هناك مَن يوصف بالعقل ورجاحته، فهو محمّد دون أدنى ريب».
ولا أدلّ على أن هذه القضيّة قائمة برمّتها على التقوّلات القروسطيّة الواهية من إقرار أدلى به ميور قائلًا: «ثمّة حقبة عدّ فيها الكتّاب المسيحيّون الأوائل حالات الحماسة التي كان تنتاب محمّد، التي كان لها شكل غيبوبة، ولا يعرف عنها سوى القليل بأنّها نوبات صرع، وقد ألحقت بأعراض لوحظت عليه بطفولته»، إنّ هذا الاعتراف يُعدّ برهانًا على أنّ أصل القضيّة لا يستند إلى ثوابت علميّة، ما عدا القياس الافتراضي، ولنا أن نسأل أنّى لميور أن يصوّر مثل هذه التّفصيلات الدقيقة عن حالة الرّسول العقليّة مع إقراره بأنّ المعرفة عن هذه القضيّة قليلة؟
يذكر ميور: «عاش محمّد في سلام لكن سرعان ما أصاب عقله المرض لما بلغ سنّ الأربعين»، وذكر أيضًا: «انتابت محمّد حالات من الاكتئاب والارتياب والاعتقاد في أوقات كان يعاني من حالات تشتّت عقليّ شديدة»، ويرى أيضًا: «عانى محمّد من حالات انفعال وإغماء مصحوبة بنشوة، في لحظات الوحي أو الاتّصال بالزائرين غير المرئيّين»، ويقول أيضًا: «أقنع محمّد نفسه ليؤمن على أن وحيه أملته عليه العناية الإلهيّة»، واللافت أنّ وليم ميور أورد هذه الآراء دون إحالة إلى المصادر الإسلاميّة التي تشدّق باعتمادها، ولعلّ هذه الآراء تمثّل إسقاطاته الأيديولوجيّة، أو تدرّجات نظرته إلى الرّسول صلىاللهعليهوآله التي عكف على مزاوجتها مع مادّة السيرة، إذ لم تشِر المصادر أنّ الرّسول صلىاللهعليهوآله واجه ظروفًا نفسيّة عصيبة، ما عدا بعض الإشارات التي عُدّت استهلالًا للوحي مثل ما ورد عن الرؤيا الصادقة وسماع الأصوات، ولعلّه استوحى هذه الصورة من موقف زعماء قريش الذين قذفوا رسول الله صلىاللهعليهوآله بشبهة الجنون، أو ربّما شرع بتوظيف ما أوردته كتب الصّحاح من العوارض المصاحبة للوحي ومنها: «أنّه إذا نزل عليه الوحي كرب لذلك وتربّد وجهه»، أو «يسمع مثل صلصلة الجرس وكان هذا أشقّ صور الوحي عليه»، أو كان إذا نزل عليه الوحي: «ثقل وتحدّر جبينه عرقًا، وإن
كان في البرد»، وإذا أوحي إليه على ناقته وضعت جِرانها أي ثقلت فلم تستطع أن تتحرّك» وكل ذلك مجرّد استنتاج.
وإن سلّمنا بحدوث هذه العوارض من قبيل الفرض، فهي لا تحمل دلالة على حالة مرضيّة، بل هي تجسّد لعوارض متلازمة لظاهرة الوحي ولا سيّما أنّه ليس في هذه العلامات ما يسوغ لميور عدّ هذا النوع من المرويّات برهانًا على حالة مرضيّة تقاس بالمعطيات الطبيّة المعاصرة، فالتلازم بين ظاهرة روحيّة وحالة عضويّة يمثّل الطابع الخارجي المميّز للوحي. وصفوة القول: لقد اتّبع ميور منهجًا إسقاطيًّا جنح فيه لإسقاط عوارض مرضيّة ليس لها مرادف في مصادر السيرة، على ظاهرة الوحي، فكان الأجدى أن يقدّم بيانًا بهذه العوارض من الناحية العلميّة ومن ثمّ مضاهاتها مع ما ورد من إشارات بشأن هذه العوارض في المرويّات الإسلاميّة.
جهد ميور في تصوير النبوّة المحمّديّة على أنّها ظاهرة عقليّة نشأت من مخاض تصوّري شاقّ وليست اصطفاء إلهي شأنه في ذلك شأن النبوّات السابقة، إذ لم يتوانَ عن اقتناص النّصوص المتهافتة التي عَلقت بين طيّات كتب السّير بفعل غياب النزعة العلميّة، ومن بينها قصة الشروع بالانتحار التي نقلها ميور عن ابن سعد عن الواقدي، التي يرى فيها أنّه: «لم يبلغ محمّد الاعتقاد بكونه ملهمًا من لدن
الربّ إلّا بعد مخاض عقلي، فكانت المحنة شاقّة عليه لدرجة أنّه شرع بالانتحار»، ويعزو ميور ذلك إلى: «المدّة التي انقطع فيها الوحي فلبث دون رؤية جبريل فخيّم عليه إحساس بالضّيق البالغ حمله إلى التوجّه إلى جبل إلى جوار حراء وهمّ بإلقاء نفسه لكنّ هاتفًا اعترضه من السّماء وحال بينه وبين الإقدام على ذلك».
والغريب أنّ ميور قدّم رواية أخرى علّل فيها سبب إقدام الرّسول صلىاللهعليهوآله على الانتحار المزعوم، لم نلمس لها أيّ إشارة في كتب الصحاح أو كتب السيرة جاء نصّها: «لمّا تعرّض لعبارات التهكّم من قبل البعض بعد مصابه بموت ولديه، والتي عُدّت علامة على استياء الآلهة، وعلى الرغم من عبارات المواساة التي حملتها السورة الثامنة بعد المائة بحق محمّد، إلّا أنّ حزنه كان أعظم من أن يحتمل لذلك أقدم على الانتحار مرارًا».
أمّا عن سند الرواية الأولى فواهٍ جدًّا، وهو إسناد موضوع؛ لأنّ الواقدي متروك الحديث، متّهم بالوضع وبالكذب على علمه بالمغازي والسير، يركّب الأسانيد، وقد نقل عشرين ألف حديث لم يُسمع بها، وقال عنه أَحْمد بن حَنْبَل: الواقدي كَانَ يقلب الْأَحَادِيث، وَقَالَ عنه البُخَارِيّ والرازي وَالنَّسَائِيّ مَتْرُوك الحَدِيث وَذكره الرَّازِيّ وَالنَّسَائِيّ أَنه كَانَ يضع الحَدِيث وَقَالَ الدراقطني فِيهِ ضعف وَقَالَ ابْن عدي أَحَادِيثه غير مَحْفُوظَة.
على الرغم من ورود الرواية في صحيح البخاري ومسند أحمد، لكنّها ترد بعنوان «البلاغات» يعني أنّه بلغه هذا الخبر مجرّد بلاغ، ومعروف أنّ البلاغات
في مصطلح علماء الحديث: إنّما مجرّد أخبار وليست أحاديث صحيحة السند أو المتن، وقد ذكر ابن حجر: «أنّ القائل بلّغنا كذا هو الزهري، وعنه حكى البخاري هذا البلاغ، وليس هذا البلاغ موصولًا برسول الله صلىاللهعليهوآله».
أمّا عن الرواية الثانية فأوردها ميور مجهولة السند ولم نعثر لها على أصل في مصنّفات السيرة. كذلك ولم يُعثر على إشارة تربط بينهما وبين وفاة أبنائه، ولم يُعثر أيضًا على وشيجة تقرن بين أسباب نزول سورة الكوثر وبين قضيّة الانتحار في تفاسير المسلمين، لكن ميور عمد إلى ليّ عنق الحقيقة وخلط النّصوص ببعضها من خلال تصويره دهشة الرّسول صلىاللهعليهوآله برؤية الوحي على أنّه مصاب بحالة من الاضطراب العقلي حملته لاحقًا إلى الشروع بالانتحار بعد أن تأخّر عنه الوحي.
ويبدو أنّ ميور أسّس هذه الصورة مشوّهة على رواية شاذّة وردت في كتاب الطبقات أظهر من خلالها أن الرّسول صلىاللهعليهوآله كان صاحب ميول انتحاريّة ولا سيّما استخدامه صيغة «محاولات متكرّرة للانتحار»، ولعلّ مطالعة سيرة الرّسول صلىاللهعليهوآله ومواقفه من التحدّيات التي واجهها خلال ثلاثة وعشرين سنة من المعارضة الشرسة والمقاطعة في شعاب أبي طالب وفقدان النصرة بعد وفاة أبي طالب وخديجة في مكّة؛ والصراعات الداخليّة مع (اليهود والمنافقين) والصراعات الخارجيّة مع (قريش وحلفائها)، في المدينة مُتمّمًا رسالته على أكمل وجه، لها دلالة واضحة على أنّ الرّسول صلىاللهعليهوآله لم يكن صاحب شخصيّة انهزاميّة أو مضطربة.
ولعلّ تأخّر الوحي لم يكن أصعب المواقف التي واجهها بالمقارنة ما واجهه من مصاعب لاحقة، وقد ذكر الرّسول صلىاللهعليهوآله لعائشة(رض) حينما سألته عن أيّ يوم كان أشدّ عليه من يوم أحد فأجابها: «لقد لقيت من قومك ما لقيت، وكان أشدّ ما لقيت
منهم يوم العقبة، إذ عرضت نفسي على ابن عبد ياليل بن عبد كُلال، فلم يجبني إلى ما أردت، فانطلقت وأنا مهموم على وجهي فلم أستفق إلا وأنا بقرن الثعالب»، ويذكر ابن حجر أنّه اليوم الذي عرض الرّسول صلىاللهعليهوآله الإسلام على أهل الطائف وعلى الرغم من هذه الإشارات الواردة في حالة الرّسول صلىاللهعليهوآله النفسيّة؛ إلّا أنّه لم يقدم على الانتحار.
ويبدو أنّ سياق رواية الانتحار يتناقض مع سياق الرواية الأصليّة للوحي التي أجمعت المصادر على أن جبريل أعلن لمحمّد صلىاللهعليهوآله أنّه رسول الله في غار حراء، من ثمّ نزل إلى أهله مذعورًا من هول البشرى أو رهبة اللّقاء وقد حصل على التّأكيد والاطمئنان من زوجه وابن عمها ورقة، فما من سبب يحمل جبريل ليأتي مرة أخرى ليؤكّد له أنّه رسول الله وأنّه جبريل أو ليمنعه من الانتحار وفقًا لرواية ابن سعد.
ولنا أن نتساءل مرّة أخرى ما الذي يحمله على الانتحار بعد أن أدرك حقيقة نبوّته؟ ما يؤكّد ذلك ما نصّت عليه سورة الضحى بعد أن ظن أنّ الله تعالى قلاه أو تركه، والخطاب الإلهي للمشكّكين لأنّ الرّسالة مستمرّة لكن ظاهر النص يوحي بأنّ ثمّة هواجس لدى الرّسول صلىاللهعليهوآله بفعل التّرقّب، ولعلّ تأخّر الوحي كان لحكمة أو لاختبار له، أو من قبيل التّحضير للمستقبل، فلو سلّمنا بأنّ الرّسول صلىاللهعليهوآله قد آيس حتّى أقدم على الانتحار فيكون قد أخفق في هذا الاختبار، وسياق أحداث السيرة تدلّ على تجاوزه لذلك فجاءه الوحي بكلمات تحمل بين طيّاتها نبرة الطمأنينة بأنّ العناية الإلهيّة لم تغفل عنه.
زيادة على ذلك، إنّ القرآن الكريم الذي أتى على بيان تفصيلات دقيقة عن سيرة الرّسول صلىاللهعليهوآله لم يذكر أيّ إلماح عن هذه المسألة الخطيرة ولا سيّما أنّ العناية الإلهيّة
قد تدخّلت لإنقاذه في وقت حرج. وصفوة القول: إنّ هذه الرواية لا تصحّ نقلًا وَلا بيانًا.
وهنالك قضيّة أخرى لا يمكن إغفالها تتعلّق بكيفيّة تقبّل الإخباريّين المسلمين أو من أخذوا منهم أو من نقل عنهم مثل هذا النوع من الروايات التي تتعارض مع الشخصيّة المحمّديّة. إن حيثيّات رواية الانتحار تحمل بين جنباتها بعدًا قصصيًّا، أقرب إلى كونها عقدة دراميّة من كونها رواية تاريخيّة ولا سيّما لحظة تدخّل الوحي لإنقاذ الرّسول صلىاللهعليهوآله في اللحظة الأخيرة، ويبدو أنّ واضع هذه الرواية حاول أن يهوّل على المتلقي حالة الرّسول صلىاللهعليهوآله مصوّرًا له أنّ أمر الوحي وانقطاعه ترك حملًا يتجاوز مقدرة النبي صلىاللهعليهوآله على الاحتمال، فربّما كان مصيره الانتحار لولا تدخل العناية الإلهيّة، أو ربّما أراد التهويل على أنّ الأمر لم يكن يسيرًا حتّى على الرّسول صلىاللهعليهوآله.
إنّ وجود مثل هذا النوع من الروايات في تراثنا يشير إلى وجود محاولات للقدح بعصمة الرّسول صلىاللهعليهوآله من خلال التّشديد على الصورة البشريّة التقليديّة التي يظهر من خلالها العجز الإنساني عن تحمّل الضغوط الشديدة، ويبدو أنّ مبعث تقبّل المسلمين الأوائل مثل هذا النوع من الروايات يرتد إلى غياب التمحيص النقدي، فروايات الإخباريّين المسلمين ليست كتبًا سماويّة، ولا سيّما وأنّها تشتمل على الكثير من المغالط حسب رأي ميور الذي أورد قائلًا: «بعد سنوات من التّمحيص تم اعتماد 4000 حديث موثوق لدى البخاري من أصل 600,000 نقلها في صحيحه، كذلك الحال مع ابن داوود في سننه الذي قال إنّه جمع حديث 500,000 رواية وقد أهمل 496000 حديث واعتمد فقط 4000»، ليس ذلك فحسب، بل أقرّ ميور بوجود خلل في قضيّة الرواة بقوله: «يمكن أن نستعلم من البخاري أنّ ثمّة 40,000 راويًا تمّ حصرهم من توارثوا الحديث ليس منهم سوى 2000 يُقرّ بوثاقتهم، لكن مسلم يرى أنّه ليس منهم سوى 226 يؤتمن بحديثه»، والغريب أنّ ميور قد شخّص سبب ظهور مثل هذا النوع من الروايات في المصنّفات الإسلاميّة بقوله:
«من العسير أن نحدّد، أيّ جزء من القصص الخارقة يرجع إلى محمّد نفسه أو نالت تأييده ولا سيّما أن المخيّلة المتحمّسة لاتّباعه قلّما تجنّبت التشويه أو التلوين للروايات الخرافيّة المبهرجة بألوان زائفة وإضاءات خياليّة، لتمتزج مع الصورة الحقيقيّة وتصبح تفاصيلها خارج مدى التحليل النقدي»، ومردّ ذلك حسب رأيه: «التحيّز الفردي والمصالح الشخصيّة اللّذان يسبّبان المبالغة، والتّلوين الزائف، وحتّى ابتكار، الذي يتأصّل في طموح الراوي الذي يحاول أن يقرن اسمه بمحمّد»، ويخلص إلى أنّ: «الأساطير سيقت على لسان النبيّ باستخدام الحديث».
ولكن وتبعًا لذلك أنّى لوليم ميور أن يصوّر ملامح الشخصيّة المحمّديّة بنحو موضوعي مع إقراره بوجود هذا الزخم من الروايات المكذوبة؟ ألا يمثّل هذا تعمّدًا في توظيف نصوص تاريخيّة أقرّ بصعوبة التّمييز بين غثّها وسمينها وحتّى لم يخضعها لمناهج التحقيق والنقد الموضوعيّ المتّسق مع سياق شخصيّة الرّسول صلىاللهعليهوآله؟
يذكر ميور: «إنّ غياب الرؤية الروحيّة للنبوّة وفرص الحصول عليها سوّغ هذا الخداع الرائع للذات»، وفي هذا الصدد تتّفق معظم المعاجم النفسيّة على أنّ خداع الذات يمثّل: «حالة الإخفاق في وضع حدود لقدرات الإنسان الشخصيّة، أو التطور الزائف لمفهوم الذات غير الواقعيّة، والخادع لذاته يعتقد أنّه يمكن أن يفعل كل ما يريد»، إنّ المدلولات التي ينطوي عليها هذا التّعريف تتعارض تمامًا مع سيرة الرّسول صلىاللهعليهوآله الذي شهد له القرآن بالصدق، لأنّه الأمين، وبشهادة ميور، وقد بلغ من الصّدق مبلغًا أنّه قال لقومه: «أَرَأَيْتَكُمْ لَو أَخْبَرْتُكُمْ أَنَّ خَيْلًا بِالوَادِي تُرِيدُ
أَنْ تُغِيرَ عَلَيْكُمْ، أَكُنْتُمْ مُصَدِّقِيَّ؟ «قَالُوا: نَعَمْ، مَا جَرَّبْنَا عَلَيْكَ إِلَّا صِدْقًا»، وقد أقرّ له بعض المستشرقين بذلك ومنهم كارليل الذي أورد قائلًا: «إنّ محمّد النبي الأصدق على الإطلاق»، إنّ صدقه مع ذاته ومع محيطه كان الباعث لإيمان الناس به لدرجه أنّه حدّد قدراته ضمن إطار ما يوحى إليه دون أن يتجاوز حدود بشريّته كما يرد في قوله عزّ وجل: (قُل لَّا أَقُولُ لَكُمْ عِندِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي مَلَكٌ ۖ إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَىٰ) (سورة الأنعام: الآية 50)، ولما طالبته قريش بالخوارق؛ كآيات تكرههم على أن يؤمنوا له، أو يسألونه أن يفجّر لهم من الأرض ينبوعًا أو ينشئ لنفسه جنّة من نخيل وأعناب، أو يفجّر الأنهار خلالها أو يسقط السماء عليهم كسفًا أو يأتي بالله والملائكة قبيلًا أو يبتكر لنفسه بيتًا من زخرف أو يرقى في السماء فيأتيهم منها بكتاب يقرؤونه، لكن الله أمره أن يجيب على هذا التحدّي بهذه الجملة الواقعيّة اليسيرة: (سُبْحَانَ رَبِّي هَلْ كُنتُ إِلَّا بَشَرًا رَّسُولًا ) (سورة الإسراء: الآية 93)، ولا أدلّ من قوله تعالى: (قُل لَّا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ ۚ وَلَوْ كُنتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ ۚ إِنْ أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ) (سورة الأعراف: الآية 188).
إنّ خداع الذات ينطبق على الحالمين، الذين ليس لهم من فواعل النجاح إلّا ما يحقّقونه في مخيّلتهم وليس لهم رصيد من النجاح في الواقع، على عكس الرّسول صلىاللهعليهوآله الذي كان متفانيًا لإحداث التغيير فقد أتمّ دوره التاريخي على أكمل وجه، وبإقرار ميور نفسه: «إنّنا نقر لمحمّد بأنّه أزاح العديد من الجوانب المظلمة والخرافية التي كنفت شبه الجزيرة العربيّة ولعصور، فقد مُحيت الوثنيّة أمام معارك الإسلام المدويّة، وغدت صفات الوحدانيّة والكمال والعناية الإلهيّة مبادئ حيّة في قلوب أتباع محمّد، وذلك بالإقرار والإذعان لمشيئة الربّ تحت مسمّى الإسلام، لتغدو
أول متطلّبات هذا الدّين وليس كما كان للفضائل الاجتماعيّة، لقد طُبعت المحبّة الأخويّة دائرة الإيمان، وقدّمت الحماية للأيتام، واحترم العبيد، وحُظر شرب السموم، وغدت المحمّديّة تفتخر بأنّها العقيدة الأكثر اعتدالًا بين العقائد»، ولو اُفترض من قبيل الجدل أنّه أقنع ذاته بالنبوّة والوحي تمام الإقناع، فكيف له أن يقنع أمّة بأكملها بهذا الدّين ويؤسّس لها عوامل الدّيمومة والاستمرار؟ وأيّ خداع للذات يأتي بمثل هذا اليقين؟ وصفوة القول: إنّ جميع ما ورد من بيان ينفي تمامًا ما زعم به ميور من ريبة الرّسول صلىاللهعليهوآله وحزنه ممّا أصابه وفكرة الانتحار، فلا يكون لصاحب عقل مضطرب أن يصوّر وحيًا له بِمثِل هذه التجليّات طوال ثلاثة وعشرين عامًا.
(278)
(279)
تُعد نظريّة التأثير الشيطاني من المفتريات القديمة في تفسير جذور الإسلام؛ التي توارثها الكتّاب الغربيّون جيلًا بعد جيل، وقد لمس الباحث من خلال تتبّع خيوط هذه القضية أن وليم ميور كان أول باحث في الاستشراق البريطاني أعاد صياغة هذه النظريّة في القرن 13ه/ 19م على أسس منهجيّة حديثة من خلال السعي إلى تأصيلها بالاعتماد على المصادر والمرويّات الإسلاميّة، لافتًا إلى ذلك: «إنّ التأثير الشيطاني يعدّ ممكنًا في تفسير إيمان محمّد بفكرة وحيه، ونحن ملزمون أن نأخذ بالحسبان وجهة النظر المسيحيّة التي تحملنا على التفكير بأنّ الشيطان لن يكون راضيًا دون إشارة إلى سطوته المخيفة التي كانت سببًا في سقوط محمّد»، ويرى أيضًا: «أنّ محمّدًا كان تحت تأثير روح شريرة منذ صغره»، «فكانت لديه مخاوف من أن يكون تحت تأثير شيطاني قبل أن يشرع بنبوّته»، ويرى: «أنّ بدايات الوحي كانت بتأثير روح شريرة أو مسّ من الجن»؛ و«أنّ ظهور الشيطان على مسرح الأحداث القرآنيّة يرتدّ إلى وجود سطوة للشيطان على محمّد» كما ذكر: «أنّ محمّدًا عاش في قناعة راسخة بأنّه تحت تأثير الشيطان وأعوانه، ومردّ ذلك إلى قبوله إغراء الشيطان الذي رفضه المسيح»، ويخلص بالقول: «ماذا لو كان كل ذلك الوحي والنبوّة محاكاة للقدرة الإلهيّة قام بها الشيطان بإرسال أحد
أعوانه؟»، ويشفع هذه النّصوص برأي آخر مفاده: «إنّ لدى الشيطان وأعوانه السطوة لتحريض العصاة على ارتكاب الشرّ في منظومة محمّد بل إنّ لهم القدرة على الإيحاء بارتكاب الخطيئة تجاه الخير، فكلمة الوسواس الواردة في السورة الرابعة عشرة بعد المائة تعني الشيطان».
لقد عكف وليم ميور إلى الالتفاف على الروايات الإسلاميّة والتقوّل عليها بإخراجها من مدلولاتها اللغوية، لتلائم هذه النظريّة، ولا سيّما في حادثة شقّ الصدر، أو في ما نقله ابن هشام من الحوارات التي جرت بين الرّسول صلىاللهعليهوآله وبين خديجة عليهاالسلام أول الوحي وهي تبادله البهجة بشرف هذه المهمّة في قولها: «يَا بن عَمِّ، اثْبتْ وأبشر، فوالله إنَّهُ لَمَلَكٌ وَمَا هَذَا بِشَيْطَانٍ»، فمثل هذا اللقاء النادر سيترك شعورًا مهيبًا في عقل الإنسان، هذا الشعور الذي اختبره إبراهيم عند لقائه الملائكة، وأيضًا لوط، وداود عندما تسوّر الملَكان محرابه، وموسى عندما كلمه الله (عزّ وجل).
ولعلّ الأساس الذي زعم ميور باعتماده المصادر الإسلاميّة، لكنه على الرغم من ذلك أقرّ بالتزام الرؤية المسيحيّة، التي تنطوي على خطاب مناوئ للإسلام عدّه أحد الأسباب الرئيسة في إخفاق أنشطته التبشيريّة، ولم يطالعنا ميور على سبب يستوجب هذا الالتزام؛ ما يؤشّر خروجًا عن المنهج الذي تشدّق باتّباعه.
لقد عرض ميور لهذه القضيّة وفق صيغ تخمينيّة من جنس possible explanation «التفسير الاحتمالي» أو «possibly المحتمل»، من ثم يخلص إلى
نتائج مؤكّدة «Assuredly»، خلافًا لقواعد الاستقراء المنهجي التي تأتي بالنتائج المفترضة وفقًا للمعطيات المؤكّدة، ودون أدنى ريب دأب ميور إلى تكرار اتّهامات قريش بهذا الشأن، التي أنكرها القرآن الكريم، وأكّد استحالة أن يكون هذا القرآن من عند الشياطي، ولا سيّما عندما أبطأ جبريل على الرّسول صلىاللهعليهوآله فجَزِعَ جَزَعًا شَدِيدًا، وقيل إنّ أم جميل زوجة أبي لهب قالت له: ودّع الشيطان محمّدًا، فأنزل الله عليه: (مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ) .
إنّ إشارة ميور بشأن الرؤية المسيحيّة توحي بأنّه عوّل على بعض الشروحات الكتابيّة لهذه القضيّة؛ التي تعتقد: «بأنّ الشيطان يضع المؤمنين المزيّفين، وهؤلاء مجمع الشيطان؛ فالشيطان كثيرًا ما يغيّر شكله إلى شبه ملاك نور فيجعل خدامه في شكل خدّام الحقّ، الذين يسلّمون أنفسهم للشرّ ويصيرون خدّامًا للشيطان في إغراء الآخرين على فعل الشرّ».
ويبدو أنّ المسألة برمّتها معقودة على قدرة الشيطان على التجسّد بصورة الوحي الحقيقي في التصوّرات المسيحيّة الكلاسيكيّة، ولا ريب أن وليم ميور استند إلى جنس هذه النصوص في محاكماته للوحي المحمّدي؛ وعلى فرض أن هذه النظريّة حقيقيّة. هل حقّقت البعثة المحمديّة غايات الشيطان؟
لقد تعرّضت نظريّة ميور للعديد من الانتقادات من الكتّاب الغربيّين المعاصرين لَهُ؛ ومنهم المستشرق البريطاني بوسورث سميث Bosworth Smith، الذي يقول: «إنّ اقتراح السيد وليم ميور وإيمانه بأنّ وحي محمّد شيطاني الأصل باستناده إلى
مقارنة بينه وبين المسيح في قضيّة الإغراءات التي عرضت على المسيح في مستهلّ مهمّته لهي نقطة تدعو للاستغراب؛ إنّ الأمر برمّته يفتقر إلى الدّليل فإذا كانت روح الشرّ قد اقترحت على محمّد فكرة النبوّة؛ فلم يكن ليخدع نفسه نظرًا لأنّ العدو والصّديق يدرك تمامًا أنّه كان منقادًا بفعل قدرة خارقة غدت سببًا في تحقيق جميع إنجازاته وبدونها لانتهى أمره أن يعيش غير معرف لفترة قصيرة كشخص من بين آلاف العرب الأمناء لكنّه استطاع بفعل هذه القدرة أن يخلق أمّة وأن يوقظ ثلث سكّان العالم يومها من سباتهم».
كما يقرّ المستشرق ويري Wherry أيضًا: «لا شكّ أنّ الوثنيّة حصن الشيطان المنيع وليس من سبب يدعونا لأن نصدّق أنّ الشيطان كان له دور في المنجزات التي حقّقها محمّد، فليس ثمّة أفضل من أن يتمكّن الإنسان من إقامة دين يحطّم قلوب الرجال، ويراق من خلاله دماء الكفر التي تعدّ مكمنًا لسطوة الشيطان الوحيدة».
أمّا عن الدور المزعوم للشيطان في المنظومة القرآنيّة، فيبدو أنّ ميور أغفل سطوة الشيطان في المنظومة الكتابيّة التي أسّس عليها نظريّته التي أعطت للشيطان دورًا عظيمًا: «إنّ الشيطان بسماح من الله اكتسب بعض السلطان على عناصر العالم الهيولية، التي يستخدمها لمقاصده الخبيثة، فقد أخضع كلّ جنسنا تحت صولته الظالمة، وكان دخول الشياطين في النّاس أمرًا حقيقيًّا، ظهر على هيئة أمراض جسديّة وعقليّة كالخرس والعمي والصّرع والجنون، وهو الذي ينزع الزرع الجيّد متى زرع كأسد زائر يجول دائمًا ملتمسًا من يبتلعه، إنّ لإبليس قوّة على إعطاء الأرواح النّجسة سلطة على البشر... كما أنّه يعوق العاملين بين القدّيسين، وإنّه يعمل بلا كلل لإحباط عمل الله وتتملّكه رغبة عارمة في أن يكون موضع العبادة مثل الله، وقد بدت هذه الرغبة الطاغية في عرضه على المسيح أن يعطيه السلطة على كل ممالك العالم إن سجد له».
لكنّ الصورة تختلف في النظرة القرآنيّة التي يستثني المؤمنين من سلطانه، ويذهب إلى محدوديّته المقصورة على التأثير بالوسوسة والنسيان، أو بالجنون، أو النزغ بين الناس بمعنى الإفساد في ما بينهم، أو تزيين أعمال الشر، وليس المقام لعقد المقارنة بين الحيثيّات الكتابيّة والقرآنيّة بشأن الدور الماورائي للشيطان عبر التاريخ؛ بقدر تعلّق القضيّة بإثبات استقلاليّة الوحي المحمّدي عن هذا المؤثّر الميثولوجي؛ لقد قدّم الخطاب القرآني صورة متكاملة عن دور الشيطان في هذا العالم ولم يكن لأيّ أن يحيط بها إلّا الله (عزّ وجل)؛ بدءً من استكباره عن طاعة أوامر الله سبحانه واتّخاذه الإنسان عدوًّا له، وجدليّة علاقته بالإنسان حتّى يأتي يوم الحساب ومن ثمّ تبرؤه من الإنسان الذي ركن إليه بسبب غوايته، كما حمل الخطاب القرآني بين جنباته تحذيرًا شديد اللّهجة من أشراكه ودعا الإنسان لاتّخاذه عدوًّا. وصفوة القول: إنّ الشيطان لم يكن ليكشف عن ذاته بهذه الجزالة لكي لا يتعارض مع خطّته للعالم ولا سيّما أن دوره معقود على التواري خلف كواليس التّاريخ؛ لكنّ القرآن الكريم جاء ليكشف عن حيثيّات خطّته، وإلى ذلك يشير الشاعر الفرنسي شارل بودلير Charles Baudelaire: «إنّ أعظم انتصارات الشيطان أنّه أقنع العالم بأنه غير موجود».
إنّ القوّة التي كانت تتّصل بالنفس المحمّديّة كانت خارجيّة لأنّها لا تتّصل به إلّا حينًا بعد حين ولا محالة لأنّها قوّة عالمة توحي إليه علمًا، وهي قوّة أعلى من قوّته، قوّة خيّرة معصومة لا توحي إلّا الحقّ ولا تأمر إلّا بالرشد فما للجنّ والشياطين وعلم الغيب، وما عسى أن تكون هذه القوّة إلّا قوّة ملك كريم، فإن كان للشيطان مثل هذه السّطوة كما يرى ميور كيف له أن يلعن ذاته على لسان الله (عزّ وجل)، لقد حملت الرؤية المسيحيّة بيانًا مؤدّاه أنّ الشيطان يكره كلمة الله ويحاول بكل قواه أن يخطفها من قلوب غير المخلصين، فكيف يكون للشيطان أثر في القرآن مع تكرار لفظ الجلالة «الله» (2699) مرّة، والتذكير بأهوال الآخرة (115) مرّة وبالنار (126) مرّة والتحذير من الشياطين (68) مرّة ومن إبليس (11) مرّة؟ فهل يمكن للشيطان أن يوحي إلى اتباعه بمثل ذلك؟ وفي ذلك تعارض مع رؤية ميور بشأن سطوة الشيطان في المنظومة القرآنيّة، هذه الرؤية تؤشّر خللًا متعمدًا في إحاطة ميور بحيثيّات الخطاب القرآني ودليلًا على عقليّة دينيّة قروسطيّة في عصر يضجّ بالتحوّلات التاريخيّة والمنهجيّة.
بغية تعضيد النظريّة الشيطانيّة لم يتورّع ميور من إيراد حادثة الغرانيق في رؤية جديدة، نقلًا عن ابن سعد والطبري برواية الواقدي، بعنوان «قصة الزلة The story of the lapse» قائلًا: «تاق محمّد إلى تسوية مع قومه باعترافه بآلهتهم في منظومته وعدّهم شفعاء عند الإله الأعلى، وبينما كانت قريش تحيط بالكعبة، بدا محمّد يتلو عليهم الآيات من السورة الثالثة والخمسين «أفرأيتم اللّات والعزّى
ومناة الثالثة الأخرى تلك الغرانيق العلا وشفاعتهن لتُرتجى»، ولما فرغ شعر الملأ بالتنازل وخرّوا ساجدين لإله محمّد لكن قلبه عصف ولم يلبث حتّى نزل عليه جبريل وأخبره أنّه نطق بالآيتين البغيضتين تحت تأثير الشيطان فاستبدلتا بالإدانة فصارت: (أَفَرَأَيْتُمُ اللَّاتَ وَالْعُزَّىٰ ﴿١٩﴾ وَمَنَاةَ الثَّالِثَةَ الْأُخْرَىٰ ﴿٢٠﴾ أَلَكُمُ الذَّكَرُ وَلَهُ الْأُنثَىٰ ﴿٢١﴾ تِلْكَ إِذًا قِسْمَةٌ ضِيزَىٰ ﴿٢٢﴾ إِنْ هِيَ إِلَّا أَسْمَاءٌ سَمَّيْتُمُوهَا أَنتُمْ وَآبَاؤُكُم) تمت مواساته محمّدًا بالآيتين 53 و54 من السورة الثانية والعشرين، التي ذكرت أنّ جميع الأنبياء تعرّضوا لمثل هذا الإيحاء الشيطاني. إنّ هذه الزّلّة لم تكن حادثًا مفاجئًا سرعان ما تمّ تداركه، بل كان تنازلًا مبيتًا جاء بفعل عداء أهل مكّة المستحكم».
ويخلص ميور: «لم يمض وقت طويل لكي يدرك محمّد أنّه تعرّض لخيانة الوثنيّين، فكان طوق نجاته الوحيد معقودًا على تنصّله من هذا التنازل بدعوى تعرّضه لخداع الشيطان وإنّ عبارات التسوية لم تكن إلهيّة المصدر حتّى يوارى هذه الزّلّة».
عرفت هذه الحادثة في الأوساط الاستشراقيّة «بالآيات الشيطانيّة» التي وجد المستشرقون فيها فرصة مؤاتية لإثبات بشريّة القرآن الكريم والبرهنة على الاختلاط الحاصل فيه والتدليل على معضلة النسخ التي تعدّ وسيلة يراجع فيها الرّسول صلىاللهعليهوآله بعض الأحكام التي لا تتماشى ومقتضيات الأحوال التي يشرع لها، ولعلّ هذه الرواية تعد من أكثر الروايات التي قابلها أهل السِّيَر بالدحض والتفنيد حتّى أنّ بعض المستشرقين، ومنهم المستشرق الإيطالي كايتاني، قد رفضوا قبول هذه الرواية، فليس لقصة الغرانيق أصل صحيح سَنَدًا ومتنًا.
فمن الناحية العقليّة انعقد الإجماع على عصمة الرّسول صلىاللهعليهوآله في ما يبلّغه عن ربّه من أي الذكر الحكيم ولا يتصوّر عقل أن يلقي الشيطان على لسانه آيات مزوّرة افتراءًا على الله، إذ لو كان الأمر ممكنًا بهذه الصّورة لأصبح الشكّ في القرآن ذاته وَلانهارت دعائم الدّعوة من أساسها ولاعتقد الجميع أنّ هناك آيات كثيرة وضعت عليها.
إن تأكيد القرآن الكريم بالقسم على عصمة الرّسول في مستهل سورة النجم: (وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ ﴿١﴾ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ ﴿٢﴾ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ ﴿٣﴾ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ) (سورة النجم: الآيات 1-4)، يتعارض مع سياق نص الغرانيق فكيف يطمئن السامعون إلى هذا التناقض وهم أهل اللسان، وقد ذَكَرَ الْمُفَسِّرُونَ مَا لَا يَجُوزُ وُقُوعُهُ مِنْ آحَادِ الْمُؤْمِنِينَ مَنْسُوبًا إلى الْمَعْصُومِ صلىاللهعليهوآله، وَأَطَالُوا فِي ذَلِكَ وَفِي تَقْرِيرِهِ سُؤَالًا وعندما سُئِلَ عَنْهَا محمّد بْنُ إِسْحَاقَ جَامِعُ السِّيرَةِ َقَالَ: «هَذَا مِنْ وَضْعِ الزَّنَادِقَةِ»،كما حكى عن الإمام البيهقي قوله: «هذه القصّة غير ثابتة من جهة النقل، ثم أخذ يتكلّم في أنّ رواة هذه القصة مطعون فيهم».
ولو عدنا إلى كتب الصّحاح أو إلى سيرة بن إسحاق، أو سيرة ابن هشام سوف لن نجد لقصّة الغرانيق أثرًا، ولا سيّما أن ابن إسحق سابق للواقدي بأكثر من خمسين سنة وسابق للطبري بنحو مائة وخمسين سنة أو تزيد، أمّا البخاري وابن هشام فكانا معاصرين للواقدي، وعلى الرغم من ذلك لم يذكرا هذه القصّة، ثمّ أن الواقدي مشهور بوضع الاحاديث كما أسلفنا.
كما أنّ القصّة وردت في ثَلَاثَةَ أَسَانِيدَ جميعها مرسلة لا يَجُوزُ الحمل عَلَى ظَاهِرِهِا لِأنّه يَسْتَحِيلُ عَلَيْهِ صلىاللهعليهوآله أَنْ يَزِيدَ فِي القرآن عَمْدًا مَا لَيْسَ مِنْهُ وَكَذَا سَهْوًا إِذَا كَانَ مُغَايِرًا لِمَا جَاءَ بِهِ مِنَ التَّوْحِيدِ لِمَكَانِ.
ويذهب ابن حجر إلى: «أنَّه لَمَّا وَصَلَ إلى قَوْله وَمَنَاة الثَّالِثَة الْأُخْرَى خَشِيَ الْمُشْرِكُونَ أَنْ يَأْتِيَ بَعْدَهَا بِشَيْءٍ يَذُمُّ آلِهَتَهُمْ بِهِ فَبَادَرُوا إلى ذَلِكَ الْكَلَامِ فَخَلَطُوهُ فِي تِلَاوَةِ النَّبِيِّ صلىاللهعليهوآله عَلَى عَادَتِهِمْ فِي قَوْلِهِمْ لَا تَسْمَعُوا لِهَذَا القرآن والغوا فِيهِ وَنُسِبَ ذَلِكَ لِلشَّيْطَانِ لِكَوْنِهِ الْحَامِلُ لَهُمْ عَلَى ذَلِكَ أو الْمُرَادُ بِالشَّيْطَانِ شَيْطَانُ الْإِنْسِ».
ويبدو أنّ معاداة قريش للرسول صلىاللهعليهوآله واستحكام خلافها معه وفشل جميع التّسويات الودّيّة التي حاولت إبرامها معه تجعل من هذه القصّة مستحيلة الوقوع إذ لا يكفي للملأ من قريش سماع هذه العبارة حتّى يخرّوا سجّدا فالنّزاع بين الطرفين أعمق من هذا بكثير، يضاف إلى ذلك استحالة انتشار نبأ القصّة بتلك السرعة في ذلك العصر الذي يتميّز ببطء الاتّصالات إلى الحبشة لكي تعتقد الجماعة المهاجرة هناك أنّ الإسلام قد انتشر في مكّة فتعود أدراجها دون أن تتحقّق من صحّة الخبر وهي التي لم تغادر دار مقامها إلّا ثلاثة أشهر قبل حصول هذه الواقعة.
إنّ القول بذلك حديث خرافة ولقد شعر الذين اخترعوها بسهولة افتضاحها فأرادوا مواراة سوءتها بقولهم: إنّ الرّسول صلىاللهعليهوآله ما كاد يسمع كلام قريش. إذ جعل لآلهتهم نصيبًا في الشّفاعة حتّى كبر ذلك عليه وحتى رجع إلى الله تائبًا أوّل ما أمسى وجاء جبريل فيه لكن هذا الستر أحرى أن يفضحها فما دام الأمر كبر على محمّد منذ سمع مقالة قريش فما كان أحراه أن يراجع الوحي لساعته وما كان أحراه أن يجري الوحي الصواب على لسانه، وإذًا فلا أصل لمسألة الغرانيق إلا الوضع والاختراع.
لقد ذكر ابن سائب الكلبي في كتاب الأصنام أنّ قريش كانت تطوف بالكعبة وتقول: واللّات والعزى ومناة والثالثة الأخرى فإنهن الغرانيق العلى وإنّ شفاعتهن
لترتجى، وأنّها كانت تعتقد أنّهن بنات الله وأنّهن يشفعن إليه فلما بعث الله رسوله أنزل عليه «أفرأيتم اللّات والعزى»، ويبدو أنّ هذا هو الأشبه بأن يكون الصواب ويبدو أن الزنادقة أخذوا هذه الرواية وحرّفوها واضعين كلام قريش في أصنامها على لسان الرّسول صلىاللهعليهوآله.
أمّا مبعث عودة المهاجرين من الحبشة إلى مكّة فمردّه إلى سببين الأوّل: إسلام حمزة بن عبد المطّلب وعمر بن الخطّاب، إذ خشيت قريش من اندلاع حرب أهليّة ولا سيّما عندما أسلم من قبائلها وبيوتاتها رجال تثور لقتل أيّ واحد منهم قبيلته وإن كانت على غير دينه فهادنت المسلمين ولم تنل أحدًا منهم بأذى وقد وصل هذا الخبر إلى المهاجرين بالحبشة، ودعاهم إلى التّفكير في العودة إلى مكّة؛ وثانيهما: نشوب ثورة على النجاشي في الحبشة الذي كان يتعاطف معهم، ويمنع قريش عنهم فخاف المهاجرون من نتيجة هذه الثورة، وفضّلوا العودة إلى بلادهم تفاديًا للفتنة.
ويبدو أنّ وليم ميور جهد لتوظيف هذه الرواية توظيفًا مزدوجًا وبنحو متعارض، عمد فيها إلى خلط المفاهيم؛ فالتّفسير الأوّل وعلى سبيل الفرض يوحي باستلاب إرادة الرّسول صلىاللهعليهوآله تحت تأثير الشيطان؛ أمّا التفسير الثاني فيحمل دلالة واضحة على أنّ النيّة كانت مبيّتة للتّسوية مع قريش بما يقرّر استقلاليّة إرادته، إنّ التّوفيق بين هذين التّفسيرين يعدّ أمرًا غير منطقيّ لأنّ التّفسير الثاني يأتي على نظريّة التّأثر الشيطاني من جذورها بوقوع الإرادة في التصرّف، وهذا يدلّ على تعثّر منهجي وقراءة اعتباطية غير احترافيّة لأحداث السيرة دون تحكيم للمعاير المنطقيّة بفعل الإفراط في التأويل الأيديولوجي.
كما أنّ إفراطه في إيراد تفصيلات خياليّة ولاسيّما في فترة ما بعد التّسوية المزعومة التي لم يُشر لها ابن سعد أو الطبري، والتي تثير حولها الريبة، إذ أشار ابن سعد إلى
أنّ الوحي نزل عشيّة ليلة التّسوية ليخبر الرّسول صلىاللهعليهوآله بآيات الغرانيق ولم يمض على المسألة من الزّمن سوى ساعات، وهذا يتعارض تمامًا مع الرواية الطويلة التي ساقها ميور بشأن التّحضير المسبق وخيانة قريش وهواجس الشك التي ساورت أصحابه وعودة المهاجرين بعد تلقيهم الخبر.
إنّ الأمر برمّته تقوّل واختلاق، فقد دأب ميور أن يجعل هذا النوع من الرّوايات الضعيفة سَنَدًا لنظريّة تاريخيّة، إنّ هذه القضيّة لو كان لها أدنى رصيد في الواقع لما توانت قريش وجمع المعارضين عن استخدامها ذريعةً لتشكيك المسلمين بمصداقية نبيّهم ولا سيّما وأنّهم في حالة من الريبة لعمدوا إلى تكذيبه وعدم الهجرة معه في سبيل الله تاركين أموالهم في مكّة، أو على أقل تقدير سجّل التاريخ أنّ شخصًا واحدًا رجع عن اِتّباعه في الوقت الذي حمل مهاجرو الحبشة إلى الرجوع مرّة أخرى بسبب بطش قريش تبعًا لشهادة ميور؟
ولعلّ ورود هذا النّوع من الروايات الشاذّة في كتب السيرة، لا توحي بالانطباع نفسه الذي صوّره ميور فهذه المصادر مع ما يفترض أنّها صنّفت لبيان عظمة النبوّة في المقام الأوّل، وليس الحطّ منها، إلّا أنّها اشتملت على نصوص منقادة لتوجّهات مذهبيّة أعطت فرصة سانحة لنظريّة الأثر الشيطاني، ولقد عمد ميور إلى توظيف هذه النصوص لإثبات مشروعيّة التّأثير الشيطاني على الرّسول صلىاللهعليهوآله؛ بما يدلّ على تحايل منهجي والتفاف حول النّصوص لتحقيق غايات إيديولوجيّة.
أمّا عن الآيتين اللتين وردتا في سورة الحج: (وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ وَلَا نَبِيٍّ إِلَّا إِذَا تَمَنَّىٰ أَلْقَى الشَّيْطَانُ فِي أُمْنِيَّتِهِ فَيَنسَخُ اللَّهُ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ ثُمَّ يُحْكِمُ اللَّهُ آيَاتِهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿٥٢﴾ لِّيَجْعَلَ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ فِتْنَةً لِّلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم) (سورة الحج: الآيتان 52-53)، فيذهب
بعض المفسّرين إلى عدّ كلمة «تمنّى» بمعنى «قرأ» ويفسّرها الآخرون بمعنى الأمنية المعروفة، وهذا احتجاج متهافت يكفي أن نذكر من الآيات المكّيّة الأولى قوله تعالى: (وَلَوْلَا أَن ثَبَّتْنَاكَ لَقَدْ كِدتَّ تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا ﴿٧٤﴾ إِذًا لَّأَذَقْنَاكَ ضِعْفَ الْحَيَاةِ وَضِعْفَ الْمَمَاتِ ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ عَلَيْنَا نَصِيرًا) (سورة الإسراء: الآيتان 74-75) إذًا فالاحتجاج بهذه الآيات مقلوب فقصّة الغرانيق تجري في أنّ محمّد صلىاللهعليهوآله ركن إلى قريش وأنّ قريشًا فتنته بالفعل فقال على الله (عزّ وجل) ما لم يقلّ لكنّ الآيات هنا تفيد بأنّ الله (عزّ وجل) ثبّته فلم يفعل، وإنّ كتب التّفسير وأسباب النزول جعلت لهذه لآيات موضعًا غير مسألة الغرانيق والاحتجاج بها في مسألة تتنافى مع عصمة الرّسل في تبليغ رسالاتهم وتتنافى مع تاريخ محمّد كلّه، احتجاج متهافت سقيم.
كما لا يجوز الاحتجاج بالآيتين 52-53 من سورة الحج فليس لأيّ منهما صلة برواية الغرانيق إطلاقًا، بسبب التّباعد بين سورة النجم وترتيب نزولها (41) وفق تصنيف ميور الكرونولوجي لسور القرآن وبين ترتيب نزول سورة الحج (85)، وبالتالي لا يمكن الجمع بين سورتين متباعدتين من حيث النزول زمنيًّا في تفسير حادثة تاريخيّة واحدة وقعت بحسب ميور استنادًا لمؤرخيّ السيرة بعيد هجرة المسلمين للحبشة أي بعد المبعث بخمسة أعوام؟
ويذكر الطبرسي في بيان هاتين الآيتين قائلًا: «إنّ من أرسل قبلك من الرّسل كان إذا تَلَا مَا يُؤدّيه إلى قومه حرَّفوا عليه وزادوا فيما يقوله ونقصوا كما فعلت اليهود وأضاف ذلك إلى الشيطان لأنّه يقع بغروره (فَيَنسَخُ اللَّهُ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ) (سورة الحج: الآية 52)، أي يزيله ويدحضه بظهور حججه وخرج هذا على وجه التسلية للنبي صلىاللهعليهوآله لمّا كَذِبَ المشركون عليه وأضافوا إلى تلاوته من مدح آلهتهم ما لم يكن فيها وإن كان المراد تمنّي القلب فالوجه أنّ الرّسول متى تمنّى بقلبه بعض ما يتمنّاه من الأمور وسوس إليه الشيطان بالباطل يدعوه إليه وينسخ الله ذلك ويبطله بما يرشده إليه من مخالفة الشيطان وترك استماع غروره».
وصفوة القول: فإذا كان للشيطان مثل هذه السطوة على الأنبياء فما هو مصير باقي البشر؟ مع وجود التأكيد القرآني على عدم وجود سلطان للشيطان إلّا على الذين يتولّونه ولعلّ عدم الإشارة إلى حالات مماثلة في سيرة الرّسول صلىاللهعليهوآله يشدّد على أنّ هذه الحادثة من المفتريات التي تبنّاها ميور في خطابه الديني المتحامل.
أمّا قضيّة إغراء الشيطان للرسول صلىاللهعليهوآله فالقضيّة ليست سوى تصوّرات من الميثولوجيا المسيحيّة الكلاسيكيّة، مستوحاة من نصوص إنجيلية مؤداها أنّ الشيطان أغرى المسيح فرفض عرضه، فشرع ميور بتطبيقها على حياة الرّسول صلىاللهعليهوآله ضمن رؤيته الإسقاطيّة فلا يمكن بأيّ حال من حيث المنهج والسياق أن يُسْلخ نصٌّ من الإنجيل ليطبّق على حياة الرّسول صلىاللهعليهوآله، ولعلّ ميور عمد إلى اتّباع المنهج القصصي في نسج صور خياليّة لا تمتّ لسياقات الأحداث التاريخيّة القائمة على السند التاريخي بصلة، والحق أن ميور في هذا الباب تقمّص شخصيّة راهب قروسطي في محاكمته لأحداث السيرة فلم يكن للرسول صلىاللهعليهوآله ليبرم اتّفاقًا مع الشيطان لأنّ بعثته الشريفة تعدّ سببًا في تعثّر خطّة الشيطان في هذا العالم تبعًا لشروط النبوّة الصادقة في الكتاب المقدّس وما يأتي:
بعد هذا البيان، يبدو جليًّا أنّ محاكمات وليم ميور لقضيّة النبوّة المحمّديّة جاءت من منظور كتابي يرى بأنّ هنالك نوعين من النبوّات في الكتاب المقدّس: نبوّات صادقة وأخرى كاذبة، تحدث تحت تأثير الشيطان والأرواح الشرّيرة: «إنّ النبوّات الكاذبة هي التي تحرّكها قوّة شيطانيّة ويحذّر العهد القديم من الأنبياء الكذبة وأنّهم مسوقون بالأرواح الشريرة»، وقد بيّن الكتاب المقدّس شروطا أو
مرتكزات لتمييز النبوّات الصادقة عن النبوّات الشيطانيّة الكاذبة؛ وتحقّق هذه المرتكزات يعدّ دليلًا على صدق النبوّة، وبغية الوقوف على بطلان رؤية ميور بشأن النظريّة الشيطانيّة ظهرت الحاجة إلى تطبيق هذه المرتكزات على نبوّة الرّسول صلىاللهعليهوآله وكما يأتي:
«إنّ النبّي هو من يتكلّم بما يُوحى به إليه من الله (عزّ وجل) والنبّي هُـو الرّائي في الوقت نفسه الذي يري أمورًا لا تقع في دائرة البصر الطبيعي، ويسمع أشياء لا تستطيع الأذن الطبيعيّة أن تسمعها فكلمتا النبي والرّائي مترادفتان»، وهذا الشرط متحقّق كما أسلفنا في أنّ الرّسول صلىاللهعليهوآله كان يتّصل بجبريل اِتّصالًا حسيًّا.
«أقوال النبي ليست من بنات أفكاره، ولكنّها من مصدر أسمى، أمّا من يتكلّمون برؤيا قلبهم لا عن فم الربّ فمن تلقاء ذواتهم، الذّاهبون وراء روحهم، ولم يروا شيئًا فهم أنبياء كذبة» و«الربّ لم يرسلهم» فالأنبياء الحقيقيّون إنّما يتكلّمون بما يضعه الله في أفواههم، أو يكشفه لبصائرهم الروحيّة، ولكن الأمر الأساسي هو أن يكون قادرًا تمامًا على التمييز بين صوت الله وصوت قلبه أو أفكاره الذاتيّة فبهذا وحده يستطيع أن يقول إنّه يتكلّم باسم الربّ».
القرآن وحي من عند الله (عزّ وجل) وليس من تأليف محمد صلىاللهعليهوآله، إنّ الوحي القرآني والأحاديث النبويّة يمثّلان أسلوبين لكل منهما طابعه وصياغته الخاصّة فالعبارة القرآنيّة لها نسق وجرس تعرفه الأذن ولها هيئة تركيبيّة وألفاظ خاصّة، والفارق كبير بين النص القرآني «الكلام الإلهي» وبين الكلام النبوي، إن كلاهما
تلقّاهما المسلمون مباشرةً من النبي صلىاللهعليهوآله، فكيف للمرء مهما بلغت إمكانيّاتهُ التعبيريّة أن ينطق في وقتٍ واحد بأسلوبين مختلفين، وكيف يتسنّى لهُ التّمييز والتّفريق بين نوعين من الكلام لكلّ منهما طابعهُ المميّز وصياغتهُ الخاصة؟.
قال الزرقاني بينًا وتوضيحًا لهذين الأسلوبين: «حتى كلام رسول الله صلىاللهعليهوآله الذي أوتي جوامع الكلم، وأشرقت نفسه بنور النبوّة والوحي، وصِيغَ على أكمل ما خلق الله، فإنّه مع تحليقه في سماءِ البيان وسُمُوِّه على كلّ إنسان لا يزالُ هناك بَونٌ بينه وبين القرآن»، وقد لمس المستشرق وات ذلك وعلّق عليه قائلًا: «إنّنا لا نتخيّله يدخل آيات من تأليفه بين الآيات التي تنزل عليه من مصدر مستقل عن معرفته كما كان يعتقد».
«إنّ القوّة الإلهيّة التي تحلّ على كائن بشري، وتجبره على رؤية أو سماع أشياء، تظلّ بدون ذلك مخفية عنه، هذه القوّة هي التي يعبّر عنها بالوحي، فيقال مثلًا: فكان عليه روح الله، أو حلّ عليه روح الله ولكن لم يكن الوحي يلغي وَعْيَ من يتلّقاه، أو شخصيّته، فيصبح مجرّد آلة تسجيل، بل يكون متلقّي الوحي في كامل وعيه، ويستطيع في ما بعد أن يصف كلّ ما حدث وصفًا دقيقًا، فالله هو الذي أعدّ النبيّ لتلقّي الوحي، وزوّده بكل المواهب والقدرات والخبرات اللّازمة لنقل أقوال الله، وتدوينها كما وصلت إليه بكلّ أمانة ودقّة».
والشرط الثالث متحقّق ولا سيّما وأنّ الرّسول صلىاللهعليهوآله في ساعات الوحي كانت تَتَنبَّهُ حواسُّه المدركة في تلك الأثناء تنبّهًا لا عهد للنّاس به وكان يذكر ما يتلقّاه وما يتلوه من القرآن الذي أعجز العقول بعد ذلك على أصحابه ثم إنّ نزول الوحي لم يكن يقترن حتمًا بالغيبوبة الجسميّة مع تنبّه الإدراك الروحي غاية التنبّه بل كان كثيرًا
ما يحدث والنبّي في تمام اليقظة العادية كما حدث في نزول سورة الفتح على النبيّ وهو قافل إلى المدينة بعد إبرام صلح الحديبيّة.
«إنّ الأحلام يستخدمها الله لمقاصد ملكوته وقد أرسلت العناية الإلهيّة من هذه الأحلام توجيهات نبويّة فقد أرسلت الإعلانات الإلهيّة في أحلام يعقوب، وإلى يوسف، وإلى دانيال، وأكثر ما يستخدم العهد القديم كلمة «حلم» باعتباره وسيلة لتبليغ رسالة من الله (عزّ وجل): «إن كان منكم نبيّ للرب، فبالرؤيا استعلن له في الحلم أكلمه»؛ ويقول يعقوب: «قال لي ملاك الله في الحلم»، ونقرأ في نبوّة إرميا عن الفرق الواضح بين هذين الأمرين، فيقول الربّ لإرميا: «قد سمعتُ ما قالته الأنبياء الذين تنبّأوا باسمى بالكذب قائلين: حلمت حلمت فالفرق بين الأحلام والوحي هو كالفرق بين التبن والحنطة».
والشرط الرابع متحقّق بإقرار ميور الذي يذكر: «كان محمّد يستشرف بالطوالع المستقاة من الأحلام ويعدّها تنويهات لأوامر إلهيّة»، فكان الرّسول أوّل ما بدئ به الرؤيا الصادقة، التي كان يراها كفلق الصبح، وقوله: (لَّقَدْ صَدَقَ اللَّهُ رَسُولَهُ الرُّؤْيَا بِالْحَقِّ ۖ لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِن شَاءَ اللَّهُ آمِنِينَ مُحَلِّقِينَ رُءُوسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ لَا تَخَافُونَ ۖ فَعَلِمَ مَا لَمْ تَعْلَمُوا فَجَعَلَ مِن دُونِ ذَٰلِكَ فَتْحًا قَرِيبًا) (سورة الفتح: الآية 27) وهي بشرى للرّسول بفتح مكّة، قال قتادة: كان رسول الله صلىاللهعليهوآله، رأى في المنام، أنّه يدخل مكّة على هذه الصفة، كما أنّ مشروعيّة الوحي خلال النّوم للأنبياء قائمة في الإسلام كما في قصّة إبراهيم الذي عزم
أمره بذبح ولده في الوقت الذي لم يشِر العهد القديم إلى الكيفيّة التي تحدّث بها الله إلى إبراهيم.
«لروح الله مطلق الحرّية في اختيار أدواته حسبما يشاء من كلّ مكان أو عمر أو جنس، فهو غير مقيّد بطبقة كهنوتيّة أو بهيئة معيّنة ولكن النبوّة كانت على الدّوام موهبة خاصة، يهبها الله لمن يشاء بسلطانه المطلق ويعلن عاموس النبيّ هذه الحقيقة بكلّ قوة: «لست أنا نبيًّا ولا أنا ابن نبيّ، بل أنا راع فأخذني الربّ من وراء الضأن، وقال لي الربّ: إذهب تنبّأ لشعبي إسرائيل»، وفي الوقت ذاته نلمس أنّ بعض الأنبياء كانوا ينتمون للسلك الكهنوتي مثل إرميا، وحزقيال وغيرهما ولكن من الحقّ أيضًا أنّ عددًا أكبر لم يكونوا ينتمون لهذا السلك. ثم إنّ العمر لم يقف حائلًا دون دعوة الله للنبي، فصموئيل دعاه الله لذلك العمل في صباه المبكّر، بل حدث في بعض الأحيان أن حلّ روح الله استثناء على أشخاص لم تكن لهم علاقة قلبيّة صحيحة بالله، مثلما حدث مع شاول الملك».
ويبدو أنّ هذا النصّ يحمل دلالة واضحة على أن حقّ الاصطفاء لله (عزّ وجل) وحده فالنبوّة مسألة إلهيّة محضة وليست حكرًا على أحد، وقد شدّد القرآن على هذه الحقيقة، فقد كان الرّسول صلىاللهعليهوآله رجلًا كريمًا في قومه ليس له من أمارات الجاهليّة فقالت قريش: هَلَّا كَانَ إِنْزَالُ هَذَا القرآن عَلَى رَجُلٍ عَظِيمٍ كَبِيرٍ فِي أَعْيُنِهِمْ مِنَ الْقَرْيَتَيْنِ يَعْنُونَ مكّة وَالطَّائِفَ.
«أرسل الله الأنبياء ليعلنوا مشيئته وليصلحوا الأوضاع الاجتماعيّة والدينيّة وكان لهم أثر كبير في توجيه الشعب نحو الحقّ»، أمّا الإصلاح فليس في كتب السيرة أدلّ من جواب جعفر بن أبي طالب للنجاشي عندما سأله عن هذا الدين الذي باتوا عليه، وفارقوا قومهم لأجله، ولم يدخلوا في يهوديّة ولا نصرانيّة فقال جعفر: «أيّها الملك كنّا قومًا على الشّرك: نعبد الأوثان، ونأكل الميتة، ونسيء الجوار، ونستحلّ المحارم بعضنا من بعض في سفك الدماء وغيرها، لا نحلّ شيئًا ولا نحرّمه، فبعث الله إلينا نبيًّا من أنفسنا نعرف وفاءه وصدقه وأمانته فدعانا إلى أن نعبد الله وحده لا شريك له، ونصل الرحم، ونحسن الجوار، ونصلّي ونصوم،ولا نعبد غيره».
«لم يكن النبيّ يتكلّم بالوحي في كل وقت، فقد تكلّم ناثان النبي مؤيّدًا فكرة داود الملك في بناء بيت للربّ، لكنّه اضطرّ للعودة إلى داود ليسحب كلامه الذي تكلّم به من نفسه. ويشرح إرميا كيف استقبل كلام الرب، فقد وجد ذلك للفرح في البداية، ولكنّه بعد ذلك فقد لذّته في الحياة وتمنى لوأنّه لم ينطق بما قال، وهو ما لم يكن في استطاعته»، أمّا في القرآن الكريم فقد ورد قوله تعالى: (وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِن قَبْلِ أَن يُقْضَىٰ إِلَيْكَ وَحْيُهُ ۖ وَقُل رَّبِّ زِدْنِي عِلْمًا) (سورة طه: الآية 114)، ويشير الطبري أنّ الرّسول صلىاللهعليهوآله قد عوتب على إكتابه وإملائه ما كان الله ينزله عليه من كتابه من كان يكتبه ذلك من قبل أن يبيّن له معانيه، وقيل: «لا تَتْلُه على أحد، ولا تُمْله عليه حتّى نبيّنه لك»، وهذا يقضي بأنّ الرّسول صلىاللهعليهوآله لا يتكلّم بأمر الوحي بمشيئته، ولا في كل وقت.
«كان الأنبياء يعلمون تمامًا أنّ نبوّاتهم لم تكن من بنات أفكارهم، فقد تكلّموا
بأمور تقع خارج آفاق قدراتهم الطبيعيّة، لقد كانوا رقباء وحرّاسًا، وكان عليهم تحذير الأمّة، كما كان الأنبياء يفسّرون الأمور الجارية، كما يكشفون أسباب الأحداث وعلاقتها بتدبيرات العناية الإلهيّة وهذا يعطي للنبوّة وحدة قويّة رغم الفوارق الكبيرة في الأوقات والظروف المحيطة».
أكّد القرآن الكريم هذه المسألة وأكّد على أنّ معرفة الغيب معقودة على رهط من النّاس من الذين يصطفيهم الله (عزّ وجل): (عَالِمُ الْغَيْبِ فَلَا يُظْهِرُ عَلَىٰ غَيْبِهِ أَحَدًا ﴿٢٦﴾ إِلَّا مَنِ ارْتَضَىٰ مِن رَّسُولٍ فَإِنَّهُ يَسْلُكُ مِن بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ رَصَدًا) (سورة الجن: الآيتان 26-27)، لقد حملت نبوّة محمّد صلىاللهعليهوآله نبوءات وتحذيرات منها ما جاء به القرآن الكريم ومنها ما غدا لاحقًا جزءًا من الحديث النبوي، فقد رَوى عن ابن عباس قوله: «كان المسلمون يحبّون أن يظهر الرّوم على فارس لأنّهم أهل كتاب، وكان المشركون يحبّون أن تظهر فارس على الرّوم لأنّهم أهل أوثان فغلبت فارس الروم فسر بذلك المشركون وقالوا للمسلمين إنّكم تزعمون أنّكم ستغلبوننا لأنّكم أهل كتاب، فأخبر رسول الله صلىاللهعليهوآله بذلك فساءه فأنزل الله هاتين الآيتين وَقال: (الم ﴿١﴾ غُلِبَتِ الرُّومُ ﴿٢﴾ فِي أَدْنَى الْأَرْضِ وَهُم مِّن بَعْدِ غَلَبِهِمْ سَيَغْلِبُونَ) (سورة الروم: الآيات 1-3) فأظفر الله الروم بفارس تصديقًا لخبره في التّقدير ولرسوله.
إنّ المتنبّئ يتّخذ من تجاربه الماضية مصباحًا يكشف بضع خطوات من مجرى الحوادث المقبلة، جاعلًا الشاهد من هذه مقياسًا للغائب من تلك، ثم يصدر فيها حكمه محاطًا بكل تحفظ وحذر، قائلًا: «ذلك ما تقضي به طبيعة الحوادث لو سارت الأمور على طبيعتها ولم يقع ما ليس في الحسبان، ويحدّده تحديدًا حتّى في ما لا تدل عليه مقدّمة من المقدّمات العلميّة، ولا تلوح منه أمارة من الأمارات الظنّيّة العاديّة، فذلك ما لا يفعله إلا أحد رجلين: إمّا رجل مجازف لا يبالي أن يقول النّاس فيه صدقًا أو كذبًا، وذلك دأب جهلاء المتنبئين؛ وإمّا رجل اتّخذ عند الله عهدًا فلن يخلف الله عهده، وتلك هي سنّة الأنبياء والمرسلين».
أمّا عن سورة المسد التي نزلت بحق أبي لهب، فنقل سعيد ابْن جُبَير، عَن ابْن عَبَّاس أَنّ النَّبِي صلىاللهعليهوآله جمع عشيرته فقال: «فَإِنِّي نَذِير لكم بَين يَدي عَذَاب شَدِيد» فَقَالَ أَبُو لَهب: تَبًّا لَك، أَلِهَذَا دَعوتنَا جَمِيعًا فَأنْزل الله تعالى: (تَبَّتْ يَدَا أَبِي لَهَبٍ وَتَبَّ ﴿١﴾ مَا أَغْنَىٰ عَنْهُ مَالُهُ وَمَا كَسَبَ) (سورة المسد: الآيتان 1-2)، ويبدو أن الله أنْبَأَ رسوله علم الغيب عندما بين المصير الذي سيكون عليه أبي لهب فلو أنّ أبا لهب أسلم بعد هذه السورة لنسف مصداقيّة القرآن الكريم.
النبوّة الحقيقيّة حسب المفهوم الكتابي لا بدّ أنْ تتمّ، فهذا الإتمام يعدّ الدّليل القاطع على أصالة النبوّة، «فإن لم تتحقّق النبوّة، فإنها تسقط إلى الأرض، وتصبح مجرّد كلمات خاوية من كل معنى، ولا قيمة لها، ويكون قائلها كاذبًا غير أهل للثقة، ففي الكلمة التي ينطق بها النبي تكمن قوّة إلهيّة، وفي اللّحظة التي ينطق بها، تصبح أمرًا واقعًا، وإن كان الناس لم يروها بعد فبمعنى ما، النبيّ الحقيقي هو الذي بكلمته يقلع ويهدم، ويهلك وينقض، ويبنى ويغرس، ويمكن للمعاصرين الحكم على صحّة النبوّة بالمعنى الوارد في سفر التثنية، عندما يحدث الإتمام بعد وقت قصير، وتكون النبوّة في تلك الحالة علامة واضحة عن صدق النبي، أمّا في الحالات الأخرى فإنّ الأجيال المتأخّرة هي التي تقدر أن تحكم على إتمام النبوّات.
ولا أدلّ على تحقّق هذا الشرط من الأثر الذي تركه الإسلام على أمّة من البدو والأعراب اعتادت تناول لحوم الآفات وتأكل الربا وتَئِد الإناث، إلى أمّة متفكّرة، لها شريعة وكتاب، لقد منّ الله (عزّ وجل) على عباده بأن أتمّ نعمته عليهم برسالة محمّد الخاتمة، وإلى ذلك يشير مايكل هارت Michael Hart: «إنّ اختياري محمّدًا، ليكون الأول في أهمّ أكثر رجال التاريخ تأثيرًا، قد يدهش القرّاء، ولكنّه الرجل الوحيد في التاريخ كلّه الذي نجح أعلى نجاح على المستويين: الدينيّ
والدنيويّ وقد دعا إلى دين الإسلام ونشره كواحد من أعظم الدّيانات، وأصبح قائدًا سياسيًّا وعسكريًّا ودينيًّا وبعد 13 قرنًا من وفاته فإنّ أثره لا زال قويًّا ومتجدّدًا».
أعلن الرّسول صلىاللهعليهوآله نبوّته ليعلن عن بدء عهد جديد من التّوحيد ونبذ الشرك بالله وعبادة الأصنام، التي نهت الشريعة الموسويّة عنها نهيًا جازمًا، فجاء في وصيّتين من الوصايا العشر: «لا يكن لك آلهة أخرى أمامي، لا تصنع لك تمثالًا منحوتًا وَلَا صورة ممّا ما في السّماء من فوق وما في الأرض من تحت، وَما في المَاءِ من تحت الأرض لا تسجد لهنّ وَلَا تعبدهن»، «وكانت عبادة الأصنام تعدّ خيانة لله الحيّ الحقيقيّ وعقوبتها الرّجم حتّى الموت، لأنّها فلسفة زائفة تغضّ من مجد الله، وتعطي التّعظيم الذي لا يليق إلا بالله لغير الله».
لقد تحمّل الرّسول صلىاللهعليهوآله مشقّة الدعوة وسط قوم يعبدون الأصنام لثلاثة عشر عامًا، من ثمّ هاجر بدينه إلى أرض يتقبّل أهلها فكرة التوحيد، أسوة بإبراهيم الذي عاش في عالم يعبد الأوثان، وكان سبب ارتحاله غربًا، أن يبتعد عن أور الكلدانيّين الوثنيّة، وأن يبحث عن موطن جديد يعبد فيه الله، لقد دأب الرّسول صلىاللهعليهوآله على حثّ قومه على نبذ هذه العبادة، كما فعل ذلك النبي صموئيل بتوليه القضاء لإسرائيل فوجد لزامًا عليه أن يحثّهم على نزع الآلهة الغريبة من وسطهم.
لا ريب في أنّ ميور عمد إلى استثناء الرّسول صلىاللهعليهوآله من شروط الكتابية للنبوّات الصّادقة فلم يكن ليقيم مثل هذه المقارنات حتّى لا يخرج بنتائج تخالف توجّهاته، لكن لنا أن نسأل هل يمكن للشيطان أن يحاكي كل هذه الحيثيّات الإلهيّة لنبوّة مثل نبوّة محمّد صلىاللهعليهوآله؟ وكيف لميور أن يثبت تجسّد الوحي ضمن حدود العقل البشري ماديًّا أو
مفاهيمًا عبر التاريخ؟ وهل له أن يثبت صدق الحوارات التي دارت بين الوحي وبين أنبياء بني إسرائيل على طول الكتاب المقدّس؟ هل سمعهم؟ هل عاصرهم؟ هل رآهم؟ وهل ثمّة نزوع يمكن الأخذ به لبيان صدق الموحى إليه من عدمه؟ وإلّا كان السبيل سالكًا لكل أفّاك أشرّ، فالأجدى به أن يضع مثل هذه الحيثيّات بين ثنايا خطابه ويقارنها مع قضيّة الرّسول صلىاللهعليهوآله قبل أن يشرع بإنكار صلة الرّسول صلىاللهعليهوآله بالوحي بناءً على منهج لا يتّسق مع مثل هذه المقولات. فلو اقتفينا منهج المستشرقين في إثبات الظواهر الغيبيّة كالوحي والملائكة والجنّ لكان يمكن أن ننفي رسالات الأنبياء السابقين الذي يؤمن بهم المسيحيّون واليهود إيماننا بهم وحيًا من الله، لكن على الرغم من ذلك حاول ميور أن يخفّف من حدّة النبرة القروسطيّة للخطاب بإيراد شهادات موضوعيّة؛ ولعلّ هذا ما يطلق عليه بعض المتضلّعين منهج «الهدم والبناء» الذي يمثّل أحد أسلحة الاستشراق الحديثة ولا أدلّ على ذلك من شهادة المستشرق الألماني فايل Dr. Weil التي نقلها ميور في كتابه القرآن قائلًا: «كان محمّد أهل لاعترافنا وإعجابنا التّامّين، فهو عربي تمكّن من إماطة اللّثام عن عيوب اليهوديّة والمسيحيّة المهيمنتين، لقد خاطر بحياته لتدمير الشرك وغرس مذهب خلود الرّوح في نفوس شعبه فهو لا يستحق مكانًا إلى جانب الرّجال العظام في التاريخ فحسب بل يستحق أكثر من ذلك اسم نبي».
وصفوة القول: لا يمكن لهذا المنهج أن يفسّر حقيقة الوحي فالكهرباء لا تُلمس ولا تُسمع ولا تُرى إلّا من خلال تجليّاتها؛ كذلك الوحي الصادق لا يمكن أن يُدرك إلّا من خلال تجليّاته، وليس لأيّ إنسان أن يثبت عدم حدوث هذه الحوارات الثنائيّة التي جرت بين الوحي والأنبياء عبر التاريخ تبعًا للمنهج العقليّ المادّي.
إنّ رؤية ميور لهذه القضيّة تبدو ذات صبغة ازدواجيّة؛ فمن جانب كان ميور مسيحيًّا مؤمنًا يلزمه إيمانه أن يكون ذا نزعة روحيّة ماورائيّة؛ ومن جانب آخر يصبح ديكارتيًّا عند محاكماته للأديان الأخرى، ولعلّ ذلك مؤشِّرٌ على النزعة التوظيفيّة للمنهج العقليّ للأغراض الدينيّة والأيديولوجيّة.
يذكر ميور: «أنّ محمّدًا مؤلف الإسلام؛ والقرآن كان الأداة التي حقّق من خلالها النجاح»، لقد عكف ميور على إنكار المصدر الإلهيّ للقرآن الكريم، وتماشيًا مع نظريّته بشأن الوحي والإلهام العقلي فإنّه يرى بأنّ القرآن لم يكن إلّا تجليًّا لصيرورة التطوّرات العقليّة لمحمّد صلىاللهعليهوآله التي سرعان ما ظهرت على شكل شذرات شعرية بقوله: «استحوذت على محمّد الرغبة المنبثقة عن الحقيقة الدينيّة بسبب إطالة النظر في أحوال أهل مكّة المنغمسين في خرافاتهم وملذّاتهم الدنيويّة؛ وفي غمرة حيرته وتطلّعاته لمعت ومضات روحيّة غير مؤكّدة بدأت تتحرّر في صيغة شذرات شعريّة حماسيّة خصبة أكسبها الاندفاع التّلقائي للبلاغة شكلًا ومضمونًا لخطاب سماوي يتّسق مع تطلّعات حبيسة في صدره، خرجت على أنَّها من لَدُن الربّ نفسه»، ويرى: «أنّ فصاحة محمّد شكّلت فاعلًا مهمًّا في نجاحه؛ فغدت لغته النقيّة ولهجته الرشيقة معلمًا أساسًا للمرحلة؛ إنّ عبقريّته الشعريّة جسّدت صورًا طبيعيّة في توضيح الصور الروحيّة». وخلص إلى: «أن جميع ذلك كان تلفيقًا من وحي مخيّلته [أي مخيّلة الرسول صلىاللهعليهوآله] وانتحالًا بدعوى التّقوى من لَدن الربّ أمام أتباعه».
يذكر مارغليوث: «أنّ جميع الأبطال في العالم يظهرون نتيجة استجابة لأحداث تعصف بأممهم، ومن ثمّ يكون لهم دور في صيرورة تلك الأحداث، باستثناء محمّد الذي عاش في مكّة لسنين عديدة إنسانًا محترمًا وتاجرًا غير مميّز حتّى بلغ الأربعين؛ فلم يكن من الذين يميلون إلى المجادلات والمناظرات العلنيّة حتّى تلقّى أمرًا إلهيًّا لاحقًا عندها، بدأ دعوته باتّباع الأساليب الحكيمة قبل أن يشرع بمواجهة الأمور الجسام».
لقد عدّ وليم ميور رسول الله صلىاللهعليهوآله واحدًا من الشعراء أصحاب العبقريّات الشعريّة، ولعلّ هذا الافتراء لم يكن جديدًا لأنّه ظهر أول الأمر على لسان زعماء قريش، وقد ردّ عليهم القرآن الكريم قائلًا: (وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرٍ ۚ قَلِيلًا مَّا تُؤْمِنُونَ) (سورة الحاقة: الآية 41)، فكانوا يزعمون أنّ للشاعر شيطانًا يملي عليه الشعر فسمّوه «الرّئيّ»، كما ورد على لسان عتبة بن ربيعة عندما عرض على الرّسول صلىاللهعليهوآله يد العون على الشفاء؛ بالنيابة عن قريش: «وإن كان هذا الذي يأتيك رَئيًّا تراه ولا تستطيع أن تردّه عن نفسك طلبنا لك الطبّ، وبذلنا فيه أموالنا حتّى نبرئك منه فإنّه ربّما غلَب التّابع على الرجل حتّى يُداوى منه»، ولأنّ الرّسول صلىاللهعليهوآله لا يحسن الشعر، فتقوّلوا ذلك شعرًا، وقيل لعائشة: «هل كان رسول الله صلىاللهعليهوآله يتمثّل بشيء من الشعر؟ قالت:كان أبغض الحديث إليه، غير أنّه كان يتمثّل ببيت أخي بني قيس، فيجعل آخره أوّله، وأوّله آخره، فقال له أبو بكر: إنّه ليس هكذا، فقال نبي الله: إنّي والله ما أنا بشاعر، ولا ينبغي لي»، وقوله تعالى: (وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنبَغِي لَهُ ۚ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ وَقُرْآنٌ مُّبِينٌ) (سورة يس: الآية 69) أي إنّ الشعر ليس في طبعه، فلا يحسنه ولا يحبّه، ولهذا ورد أنّه صلىاللهعليهوآله كان لا يحفظ بيتًا على وزن منتظم، فقال أبو زرعة الرّازي عن إسناده: ما ولد عبد المطلب ذكرًا ولا أنثى إلّا يقول الشعر إلّا رسول الله صلىاللهعليهوآله .
لقد ميّز الله تعالى بين رسوله وبين الشعراء قائلًا: (وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ ﴿٢٢٤﴾ أَلَمْ تَرَ أَنَّهُمْ فِي كُلِّ وَادٍ يَهِيمُونَ ﴿٢٢٥﴾ وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ) (سورة الشعراء: الآيات 224-226)، والغاوي: المتّصف بالغيّ والغواية تعني الضلالة الشديدة، في قوله: «يتّبعهم الغاوون» خبر، وفيه كناية عن تنزيه النبيّ صلىاللهعليهوآله أن يكون
منهم فإنّ أتباعه ليس فيهم أحد من الغاوين، وقيل: هم الشعراء الذين إذا غضبوا سبّوا وإذا قالوا كذبوا وإنّما صار الأغلب عليهم الغيّ فالشاعر يصدر كلامه بالتشبيب، ثم يمدح للصلة، ويهجو على حميّة الجاهليّة فيدعوه ذلك إلى الكذب ووصف الإنسان بما ليس فيه من الفضائل والرذائل؛ وهم في كل واد يذهبون، كالهائم على وجهه على غير قصد، جائرًا على الحقّ وقصد السبيل، وإنّما هذا مثل ضربه الله لهم في افتنانهم في الوجوه التي يفتنون فيها بغير حقّ، فيمدحون بالباطل قومًا ويهجون آخرين كذلك بالكذب والزور، وكانت هذه الآية نفيًا للشعر أن يكون من خلق النبي صلىاللهعليهوآله وذمًّا للشعراء الذين تصدوا لهجائه.
«فالشعراء لم يكن منهم إلّا إثارة كامن العواطف، وتنبيه النائم من الأفكار، أو إحداث لذة، أو ألم في النفوس، ولا ينتظر منهم أن يحلّوا معضلات الحياة الإنسانيّة وسبب ذلك أنّهم في سيرتهم وأعمالهم لا يقدّمون للناس المثل التي تحتذى، وقد سجّل القرآن الحكيم على الشعراء أنّهم لا يؤثّرون بشعرهم اللطيف الحلو على المجتمع البشري؛ لأنهم يهيمون في أودية الأفكار والعواطف».
أمّا القرآن فليس بشعر، لأن الشّعر كلام موزون مقفّى له معان مناسبة لأغراضه فأين نظم الشعراء من نظمه، وأساليبهم من أساليبه فما بني عليه أسلوب القرآن من تساوي الفواصل لا يجعلها موازية للقوافي كما يعلمه أهل الصناعة، والغريب أنّ ميور لم يَعِ أنّ القرآن لو كان ضربًا من الشّعر لما آمنت به فلذات أكباد العرب من الشعراء، ولم يثبت في حينه في مخيّلة البلغاء من العرب وهم الأدرى بضروب الشعر، ولوكان القرآن شعرًا لسهل عليهم أن يحاكوه، ومع الوقت لبطل واضمحل، وينبني عَلى هذا الرأي خبر أنيس بن جنادة أخي أبي ذر الغفاري، إذ نقل البخاري
قول أبي ذر لأخيه: «اركب إلى هذا الوادي فاعلم لي علم هذا الرجل الذي يزعم أنّه نبي يأتيه الخبر من السماء واستمع من قوله ثم ائتني، فانطلق الأخ حتّى قدِم وسمع من قوله، ثم رجع إلى أبي ذر فقال له: رأيته يأمر بمكارم الأخلاق وكلامًا ما هو بالشعر قال أبو ذر: فما يقول النّاس؟ قال: يقولون شاعر، كاهن، ساحر وكان أنيس أحد الشعراء، قال أنيس: لقد سمعت قول الكهنة فما هو بقولهم، ولقد وضعت قوله على أقراء الشعر فما يلتئم على لسان أحد بعدي أنه شعر، والله إنّه لصادق وإنّهم لكاذبون ثم اقتصّ الخبر عن إسلام أبي ذر، ويظهر أنّ ذلك كان في أوّل البعثة» .
ومثله خبر الوليد بن المغيرة الذي جمع قريشًا ليتشاوروا في أمر النبي صلىاللهعليهوآله فقال لهم: «ما هو بشاعر، قد عرفت الشعر كلّه رجزه وهزجه وقريضه ومبسوطه ومقبوضه، وما هو بشاعر».
وما إسلام لبيد بن ربيعة، إلّا برهانًا على الأسلوب البلاغي الذي تفرّد به القرآن الكريم عن سواه، فقد كانت هناك قصيدةٌ شعرية للبيد تُعَدُّ من أعظم ما قيل من الروائع في عهد محمّد صلىاللهعليهوآله، لم يجرؤ أحدٌ من الشعراء على منافستها حتّى علقت بجانبها بعض آياتٍ من القرآن الكريم، فأسلم لبيد في الحال وقال قولته: «إن كلامًا كهذا ليس من قول البشر، وإنّه لا شك وحيٌ إلهي».
علاوة على ذلك فإنّ الرّسول صلىاللهعليهوآله لم يكن شاعرًا في الجاهليّة، ولو كانت لديه هذه الجزالة لبات معروفًا لدى العرب، وفي ذلك يرى رودنسون: «إنّ ما سمعه الرّسول وتلقّاه من وحي كان يشابه من حيث الشكل سجع الكهان فالجمل متقطّعة لاهثة والنّغم متتابع مسجوع والآيات مليئة بالقَسَم بالظّواهر الكونيّة المختلفة والملموسة فالنبيّ لم يأتِ بجديد من حيث الشكل ولكن المحتوى كان شيئا آخر إنّه
جديد كل الجدّة ولا علاقة له بسجع الكهّان وهمساتهم وتمتماتهم إنّه شيء آخر أعلى من هذه التمتمات انبثق غنيًّا مفعمًا حيًّا من لا شعوره».
«لقد كان أوّل شيء أحسّته تلك الأذن العربيّة في نظم القرآن ذلك النظام الصوتي البديع الذي قسّمت فيه الحركة والسكون تقسيمًا منوعًا يجدّد نشاط السّامع لسماعه، ووزّعت في تضاعيفه حروف المدّ والغنّة توزيعًا بالقسط الذي يساعد على ترجيع الصوت به وتهادي النفس به آنًا بعد آن، إلى أن يصل إلى الفاصلة الأخرى فيجد عندها راحته العظمى، وهذا النحو من التّنظيم الصّوتي إن كانت العرب قد عمدت إلى شيء منه في أشعارها فذهبت فيها إلى حدّ الإسراف في الاستهواء، ثمّ إلى حدّ الإملال في التكرير فإنّها ما كانت تعهده قط ولا كان يتهيّأ لها بتلك السّهولة في منثور كلامها سواء منه المرسل والمسجوع، بل كان يقع لها في أجود نثرها عيوب تغض من سلاسة تركيبه، ولا يمكن معها إجادة ترتيله إلّا بإدخال شيء عليه أو حذف شيء منه، فلا عجب إذًا أن يكون أدنى الألقاب إلى القرآن في خيال العرب أنه شعر، لأنّها وجدت في توقيعه هزّة لا تجد شيئًا منها إلّا في الشعر».
إنّ القرآن هو المعجزة الكبرى، فهو كلامٌ لم تسمع العربُ مثلَه، قبل أن يتلوه النبي، فهو في صورته الظاهرة، ليس شعرًا، لأنّه لم يجرِ في الأوزان والقوافي، والخيال، على ما جرى عليه الشِّعر، ثمّ لم يُشارك الشِّعرَ، في قليلٍ أو كثيرٍ من موضوعاته ومعانيه؛ فهو لا يصف الأطلال والربوع، ولا يصف الحنين إلى الأحبَّة، ولا يصف الإبل في أسفارها الطوال والقصار وليس فيه غزلٌ، ولا فخر، ولا مدحٌ، ولا هجاءٌ، ولا رثاءٌ، فهو لا يصف الحرب... ولا يعرض من هذا كلّه لشيءٍ، وإنّما يتحدّث إلى النّاس عن أشياءَ، لم يتحدّث إليهم بها أحدٌ من قبله، يتحدث عن التوحيد، فيحمده ويدعو إليه، ويتحدث عن الشِّرك، فيذمّه، وينهَى عنه، ويتحدّث عن الله، فيُعظّمه، ويصف قدرته التي لا حدَّ لها .
منذ القرن 13ه/ 19م برزت بين المستشرقين محاولات لترتيب سور القرآن الكريم بنسق كرونولوجي Chronological order أي وفقًا لترتيب النزول؛ لتتبّع التطوّر التدريجي للوحي في ذهنيّة محمّد صلىاللهعليهوآله، وعذر الغربيّين في هذه الدعوة إلى أنّ طبيعة عصرهم كانت تجنح إلى التنظيم الكمّي والنوعي ومنطق الإحصاء والتبويب؛ لكن ضالتهم الرئيس كانت رغبتهم في تمزيق الهيكل القرآني ليجعلوا منه أبوابًا منوّعة لركام نوعي، ولعلّ ميور كان رائد الاستشراق البريطاني بهذا الشأن، عندما عكف على إعادة ترتيب القرآن الكريم من خلال تقسيمه إلى ستّة عهود وفق الآتي:
1. العهد الأول أو مرحلة ما قبل الوحي: «وتشمل السّور التي نظّمت قبل أن يكون لمحمّد تصوّر أنّه مدعو للتبليغ باسم الربّ أو نزول الوحي عليه مباشرة من السّماء؛ وليس لأي منها صيغة رسالة من لدن الرب فتتمثّل في بعض القطع الحماسيّة القصيرة من القرآن التي تتألّف من سطر أو اثنين وعددها «(18 سورة)، وهي على الأغلب من نسج محمّد» ويرى ميور أنّ هذا العهد يتّسم بالجموح والعاطفية.
2. العهد الثاني مرحلة ما بعد الوحي، ويتّسم بالنثريّة والقصّة ليشمل العهود الخمسة المتبقّية، «فالعهد الثاني «عهد استهلال النبوّة» الذي يتألّف من «4 سور» تبدأ بسورة العلق 96 المتضمّنة أمر التبليغ (اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ) أوّل السور تنزل كما تخبرنا الروايات بعد انقضاء الفترة انقطاع الوحي؛ تليها
سورة الفلق 113 التي تبدأ بصيغة {قل}، ولهذا ينبغي أن تكون بعدما افترض محمّد أنّه ملهم مباشرة من الله».
3. أمّا العهد الثالث: «يمتدّ من شروع محمّد بإعلان النبوّة العامّة حتّى الهجرة إلى الحبشة ويتألّف من 19 سورة اشتملت بشكل رئيس على تصوير مشاهد البعث والجنّة والنّار مع الإشارات إلى معارضة قريش المتزايدة».
4. العهد الرابع: «يبدأ من السنة السادسة حتّى السنة العاشرة من نبوّة محمّد» وعدد سوره 22 سورة، ويقول ميور: «إنّ العهد الخطابي الثالث؛ عهد السلطويّة، وفيه بدأت ترد القصص من الكتب اليهوديّة والأساطير العربيّة وفي هذا العهد ذكرت التسوية المؤقتة مع الوثنيّة المرتبطة بسورة النجم 53».
5. العهد الخامس: «من السنة العاشرة لنبوّة محمّد في فترة إزالة المقاطعة عن المسلمين إلى الهجرة من مكة، ويشتمل على 30 سورة، ضمّت بعض القصص الإنجيليّة؛ وفيها فرضت طقوس الحجّ وفنّدت اعتراضات قريش وبراهين وحدانيّة وتدابير الربّ».
6. العهد السادس: فيمثّل «السور المنزلة في يثرب وعددها 21 سورة، وتمثّل السّور الطوال التي تتعلّق باليهود والمسيحيّين والتشريعات العامّة ووصف للمعركتين بدر وأُحد كما جاء في سورة رقم 3 آل عمران، فضلًا عن أوامر تقسيم الغنائم التي وردت في سورة 8 الأنفال، وقد حملت هذه الحقبة أوامر الحرب، وأن تأخذ صلاة الجمعة الأسبقية في الشؤون الدينيّة، وفي هذا العهد وردت سورة 59 الحشر التي تروي حصار بني النضير؛ وسورة النساء 4 التي خُصّ قسم كبير منها لكيفيّة معاملة الزوجات وأحكام المواريث والأحوال العامّة؛ وأحكام الطلاق في سورة رقم 58 المجادلة، وسورة الفتح 48 التي تتضمّن هدنة
الحديبيّة 6ه، وتختتم هذه الحقبة بسورة التوبة 9 التي تعالج حملة تبوك لتواصل معلنة براءة الإسلام وعداءه للأديان الأخرى».
لقد أسّس ميور نظريّة التّرتيب الزمني للقرآن على أساس فروض تخمينيّة وقاصرة عن إدراك الواقع، في الوقت الذي يشكّك بالنتائج التي بلغها الإخباريّون المسلمون أصحاب الشأن، وإلى ذلك يشير قائلًا: «ومن الضروريّ أن أكرّر هنا أنّ أيّ محاولة لتنظيم السّور القرآنيّة على وفق الترتيب الكرونولوجي، يجب، أن يكون تخمينيًّا وقاصرًا إلى حدّ كبير، وما نقله لنا الرواة في هذا الموضوع ليس سوى مادّة هزيلة ومضلّلة، والقوائم الكرونولوجيّة التي قدّمها المصنّفون المحمديّون تستند إلى مثل هذه الروايات ولا يمكن الوثوق بها»، ويبدو أنّ محاولات الكتّاب المسلمين لترتيب سور القرآن بنحو زمني لم تكن ترمي إلى تقديم نسخة جديدة مرتّبة حسب النزول كي يقرأها النّاس، بقدر ما تهدف إلى فهم مراحل انتشار الدعوة ورصد معالم نجاحها وتطوّرها من دعوة إلى دولة؛ على خلاف وليم ميور، الذي حاول أن يصوّر القرآن بأنّه وحدة تأليفه مضطربة، كما ذهب إلى ذلك قائلًا: «ليس في القرآن فواصل وفراغات فحسب، بل إنّ الآيات جمعت ببساطة ساذجة فلدينا هذه الكتلة المتشابكة كفسيفساء من الأجزاء المبعثرة جمعت بنحو بدائي واتفاقي، حتّى غدا التّصميم مشوّهًا لا يمكن فهمه في عمل امتدّ على مدى سنوات قائم على أحداث يوميّة متغيّرة تحمل بين طيّاته تأثيرات العقل الحيّ بنحو جليّ».
ويرى أيضًا: «أنّ مكوّنات كل سورة مختلّة السّياق من حيث الزمن أو الموضوع فالسّور تتوالى بدون قاعدة باستثناء الطّول، إذ وضعت السّور الأطول في البدء ثم الأقصر، وبما أن السّور الأقصر تعود إلى الحقبة المبكّرة من نبوّة محمّد والأطول تعود إلى الحقب المتأخرة؛ فانّ التّرتيب عكس مباشر للطبيعي لدرجة أنّ القارئ سوف يحصل على تصوّر أكثر دقّة عن تعاليم محمّد إذا قرأ القرآن من النهاية نحو البداية».
ويرى أيضًا: «أنّ من الخطأ أن نَصِفَ محمّدًا بأنّه كان يحوز على نسق لمنهج دينيّ، لأنّ عقيدته تطوّرت تبعًا للظروف والمقتضيات اليوميّة»، و«أنّ تعاليم القرآن غير منطوية على أيّة خلاصة أو نسق منهجيّ».
وقد تعرّض المستشرق الألمانيّ نولدكه إلى بعض آراء ميور بهذا الصدد قائلًا: «ولعلّ ما أشكل على ميور في هذا التقسيم أنّه يسعى إلى ترتيب السّورة الواحدة ترتيبًا زمنيًّا ويؤشّر عليه، فهو يقرّ بأنّه لم يبلغ هدفه تمامًا، لأن ّهذا الهدف يستحيل بلوغه بنحو فعلي؛ زد على ذلك فميور لا يعير القدر الكافي من الاهتمام لتقسيم السّور المؤلّفة من أجزاء مختلفة ويعير قدرًا مبالغًا به من الأهميّة لطول السّور، ما لا يستحق الاهتمام نفسه الذي يستحقه طول الآيات».
ويعترف نولدكه بمشقّة تتبّع السّوَر زمنيًّا قائلًا: «كلّما طالت دراستي للقرآن وتعمّقت، تبيّن لي بوضوح أكبر أنّ من بين السّور المكّيّة مجموعات متفرّقة لا يمكن الفصل بينها، وذلك مع انعدام إمكانيّة القيام بأيّ ترتيب تأريخي دقيق للسور، وكم من دليل وجدته من قبل مناسبًا لهذا الغرض بدا لي لاحقًا غير موثوق به، وكم من زعم أبديته قبلًا بقدر كبير من الثقة، بدا لي من بعد فحص متكرّر وأدقّ إنّه زعم غير أكيد» ويرى عبد الرحمن بدوي: «أنّ الخطأ الذي وقع فيه وليم ميور يتعلّق بزعمه تحديد ترتيب نزول السّور في كل مرحلة، بينما يعترف بنفسه أنّه لم ينجح بصورة تامّة في هذه المحاولة، وفي الواقع إنّه حين قسّم العهد المكّي كلّه إلى مراحل بدلًا من ثلاث فترات صغرى فإنّه قد زاد المشكلة تعقيدًا».
ويبدو أنّ ميور قد أخفق في تتبّعه التاريخي لآيات القرآن، ولا سيّما في مسألة اعتقاده بأنّ ثمّة سور سبقت سورة العلق، «لقد عرض وليم ميور نظريّة غريبة
بشأن وجود 18 سورة نزلت في مرحلة ما قبل الوحي سبقت سورة العلق (96)، فالسّور التي يتكلّم فيها محمّد ضد أعداء الدين والخصوم الذين يكذّبون به، رافعًا بالمقابل من شأن المؤمنين، لا يمكن أن تكون قد نشأت في وقت لم يكن فيه على بيّنة من أمره، ولم يتأكّد بعد من أنّه نبي الله، ويدعو إلى الدّين الجديد، فسورة العصر (103) التي يعدّها ميور أقدم السور القرآنيّة، لأنّها بشكلها الحالي أقصرها، تتناول أعداء الرّسول صلىاللهعليهوآله وأتباعه المؤمنين الذي يدعو بعضهم بعضًا إلى الصبر تجاه الاضطهادات: (إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ) (سورة العصر: الآية 3)، فهذه السورة لا يمكن إذا أن تكون قد نشأت إلّا بعد أن جهر محمّد صلىاللهعليهوآله بدعوته وكثيرًا ما توجد مواضع مماثلة في سور المرحلة الأولى التي يسمّيها ميور القطع الشعريّة مثل:(كَلَّا بَلْ تُكَذِّبُونَ بِالدِّينِ) (سورة الإنفطار: الآية 9)؛ وفي قوله:(فَمَا لَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿٢٠﴾ وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لَا يَسْجُدُونَ ۩) (سورة الإنشقاق: الآيتان 20-21)؛ تضاف إلى ذلك المواضع التي يتكلّم فيها محمد صلىاللهعليهوآله عن اندثار أعداء الله في الأزمنة الغابرة كمن ينذر به خصومه: (أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِعَادٍ) (سورة الفجر: الآية 6)، (كَذَّبَتْ ثَمُودُ بِطَغْوَاهَا ﴿١١﴾ إِذِ انبَعَثَ أَشْقَاهَا ﴿١٢﴾ فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ نَاقَةَ اللَّهِ وَسُقْيَاهَا ﴿١٣﴾ فَكَذَّبُوهُ فَعَقَرُوهَا فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُم بِذَنبِهِمْ فَسَوَّاهَا) (سورة الشمس: الآيات 11-14)، وكذلك سورة الفيل».
ويرى نولدكه أيضًا: «وليس صحيحًا أنّ الله لا يظهر أبدًا في سور المرحلة الأولى متكلّمًا، فحتى لو وافقنا ميور على أنّ المواضع التي يخاطب فيها محمّد لا تحمل إلّا مناجاته لنفسه، ولم نهتم لصيغ الأفعال التي تتحوّل من خلال تغيير التنقيط من صيغة المتكلّم إلى صيغة أخرى مثلًا «تفعل» بدل «نفعل» إلخ لتبقت المواضع التالية التي تشير إلى ظهور الله (عزّ وجل): (وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ) (سورة البلد: الآية 10)؛ (وَوَضَعْنَا عَنكَ وِزْرَكَ) (سورة الإنشراح: الآية 2)؛ (إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ
الْكَوْثَرَ) (سورة الكوثر: الآية 1) (لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ ﴿٤﴾ ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ)(سورة التين: الآيتان 4– 5)».
إنّ تاريخ الوحي القرآني يبدأ بعد القرآن وليس قبله وذلك ما يوحيه قوله تعالى: (وَمَا كُنتَ تَتْلُو مِن قَبْلِهِ مِن كِتَابٍ وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ ۖ إِذًا لَّارْتَابَ الْمُبْطِلُونَ) (سورة العنكبوت: الآية 48)، ويعطف نولدكه على ذلك قائلًا: «لا يجوز أن ننجرّ إلى طروحات لا يمكن تقديم برهان عليها، وذلك فقط بسبب الميل إلى فرضيّة، لا تدعمها حجّة راسخة، لهذا السبب لا نلمس في رأي ميور على الأقل، ما قد يدفعنا عن التخلّي عن الرواية المتعارف عليها لدى المسلمين، ومؤداها أنّ سورة العلق أبكر ما في القرآن وأنّها تتضمّن أوّل دعوة تلقّاها محمّد للنبوّة.
لقد عرض ميور آراءه باقتضاب دون إفاضة في سرد التفصيلات؛ ومن دون أن يأتي بجديد، رتّب السّور المدنيّة ومن دون أن يُخفي أنّ هذا التّرتيب إنّما يمثّل ترتيبًا تقريبيًّا فقط.
ومن الأخطاء التي سجّلت على التّرتيب الكرونولوجي لوليم ميور، في سورة الإخلاص (112) التي يرى الكثيرون فيها ردّ الرّسول صلىاللهعليهوآله على سؤال اليهود عن طبيعة الله تعالى التي ينسبها ميور إلى المرحلة الأولى، واضعًا إيّاها مباشرة مع سورة العلق 96، كذلك في سورة النصر التي تعدّ السّورة الأخيرة من القرآن؛ ونزلت بعد سورة التوبة بعد أن منّ الله تعالى على نبيّه صلىاللهعليهوآله بالنصر لكن ميور يضعها ضمن العهد المكي الثالث وينبغي أن تكون في العهد السادس؛ كذلك ويبدو أن ميور اتّبع معيار طول السور في ترتيبه لسور القرآن، ولا سيّما في سورة طه التي يضعها في المرحلة الأخيرة بسبب
طولها، وسورة الطور 52 التي يصنّفها على أساس الطول ضمن المرحلة الرابعة، لكنّه أخطأ بتصنيفه السورة 6 الأنعام، والسورة 7 الأعراف ضمن العهد الخامس لأنّهما من السور الطوال، فحريّ به أن يضعهما ضمن العهد السادس.
واذا أخذنا بالحسبان شهادة مارغليوث الذي ذكر أنّ الصرع يؤدّي بالمصروع إلى الضعف الدماغي تدريجيًّا، فإنّ ترتيب ميور يخالف ذلك ولا سيّما أنّ إصابته المزعومة بالصرع في سنّ الرابعة من ثمّ تعرّضه إلى الاضطرابات العقليّة في سن الأربعين؛ هذا الخطّ البياني المرضي المتصاعد يتعارض تمامًا مع حالة التطوّر والاتّساع في حيثيّات الخطاب القرآني، من الآيات القصار ذات الصبغة الشعريّة المتحمّسة مرورًا بالآيات الطوال التي اشتملت عليها الأحكام العامّة في الإسلام حسب زعمه؟
لقد اقتضت الحكمة الإلهيّة ترتيب الآيات بحسب المناسبات البلاغية وأسرار الإعجاز وليس بحساب النزول، إنّ عمليّة إعادة ترتيب الآيات والسور وفق المعيار الزمني يضع القارئ أمام معضلة تفـتيت الوحدة والانسجام النصي القرآني؛ وبالتالي يظهر النص القرآني نصًّا خاليًّا من الإعجاز غير مترابط الأفكار.
لقد انعقد الإجماع على أن ترتيب آيات القرآن الكريم على هذا النمط كان بتوقيف من النبي صلىاللهعليهوآله عن الله (عزّ وجل) وأنّه لا مجال للرأي والاجتهاد فيه بل كان جبريل ينزل بالآيات على الرّسول صلىاللهعليهوآله ويرشده إلى موضع كل آية من سورتها ثم يقرؤها النبي صلىاللهعليهوآله على أصحابه، ويأمر كتّاب الوحي بكتابتها معيّنًا لهم السورة التي تكون فيها الآية وموضع الآية من هذه السورة وكان يتلوه عليهم مرارًا وتكرارًا في صلاته وعظاته وفي حكمه وأحكامه، وقد نقل السيوطي: «إنّ تَرْتِيبُ السُّوَرِ وَوَضْعُ الْآيَاتِ مَوَاضِعَهَا إِنَّمَا كَانَ بِالْوَحْيِ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلىاللهعليهوآله يَقُولُ: ضَعُوا آيَةَ كَذَا
فِي مَوْضِعِ كَذَا وَقَدْ حَصَلَ الْيَقِينُ مِنَ النَّقْلِ الْمُتَوَاتِرِ بِهَذَا التَّرْتِيبِ مِنْ تِلَاوَةِ رَسُولِ اللَّهِ صلىاللهعليهوآله وَمِمَّا أَجْمَعَ الصَّحَابَةُ عَلَى وَضْعِهِ هَكَذَا في المصحف».
ويضيف أيضًا: «إنّ الله (عزّ وجل) أنزل القرآن كلَّه إلى السماء الدنيا، ثمّ فرّقه في بضع وعشرين سنة، فكانت السورة تنزل لأمر ينزل، والآية جوابًا لمستخبر، ويوقف جبريلُ النبيَّ صلىاللهعليهوآله على موضع الآية والسورة، فاتّساق السور كاتّساق الآيات والحروف كلّه عن النبي صلىاللهعليهوآله فمن قدّم سورة أوأخّرها فقد أفسد نظم القرآن، فترتيب السور هكذا عند الله في اللوح المحفوظ على هذا الترتيب، وكان يعرض النبي صلىاللهعليهوآله على جبريل ما اجتمع لديه منه، وعرضه صلىاللهعليهوآله في السنة التي توفّي فيها مرتين».
«إنّ القرآن الكريم تقرؤه من أولّه إلى آخره فإذا هو محكم السّرد دقيق السّبك متين الأسلوب قويّ الاتّصال آخذ بعضه برقاب بعض في سورة وآياته كلّه من ألفه إلى يائه كأنه سبيكة واحدة ولا يكاد يوجد بين أجزائه تفكّك ولا تخاذل كأنّه حلقة مفرغة أوكأنّه سمط وحيد وعقد فريد يأخذ بالأبصار نظّمت حروفه وكلماته ونسّقت جمله وآياته وجاء آخره مساوقًا لأوّله وبدا أوّله مؤاتيًا لآخره».
لا يمكن أن يكون القرآن من دون نسق لأنّه غير متناقض، إذ يذكر الطبري في تفسيره لقوله (عزّ وجل): (أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ ۚ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِندِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا) (سورة النساء: الآية 82)؛ بمعنى «أنّ الذي أتيتهم به من التّنزيل من عند ربّهم، لاتّساق معانيه، وائتلاف أحكامه، وتأييد بعضه بعضًا بالتّصديق، وشهادة بعضه لبعض بالتّحقيق، فإنّ ذلك لو كان من عند غير الله لاختلفت أحكامه، وتناقضت معانيه، وأبان بعضه عن فساد بعض»، ويرى ابن كثير: «لو كان مفتعلًا مختلقًا، كما يقوله جهلة المشركين والمنافقين في بواطنهم «لوجدوا فيه اختلافًا كثيرًا» أي اضطرابًا وتضادًّا كثيرًا وهذا سالم من الاختلاف، لأنّه
من عند الله (عزّ وجل) إنّ القرآن لم ينزل يكذّب بعضه بعضًا، بل يصدّق بعضه بعضًا، فما عرفتم منه فاعملوا به، وما جهلتم منه فردّوه إلى عالمه».
فلا يوجد أيّ كتاب في الأدب أو أيّ مجال آخر، يمكن أن يكون قد تمّ تأليفه على هذا النحو أو في مثل هذه الظروف، فكان القرآن قطعًا متفرّقة ومرقّمة من بناء قديم، كان يراد إعادة بنائه في مكان آخر على نفس هيئته السابقة، وإلّا فكيف يمكن تفسير هذا التّرتيب الفوريّ والمنهجيّ؟.
لقد أراد ميور بهذا التقسيم أن يخلق حالة من التّماثل بين القرآن وبين الكتاب المقدّس الذي ينطوي على عهدين، كما يرى عبد الرحمن بدوي أنّ: «ميور شرع بقراءة القرآن قراءة مسيحيّة».
ويبدو أنّ ميور شرع بتطبيق المنهج الفليلوجي في تصنيف سور المرحلة الأولى تبعًا للإيقاع السياقي اللغوي والصوتي للسّور القرآنيّة وطبيعة الخطاب القرآني، بناءً على قراءة سطحيّة غير معمقة لسور القرآن تنطوي على قدر كبير من التّداخل بين الصور البلاغيّة اللغويّة والأحكام التشريعيّة والصور التاريخيّة وسرد لتفصيلات معاصرة؛ كعلاقة الرّسول صلىاللهعليهوآله بأهل الكتاب فضلًا عن أحداث ووقائع تجدها تارة مرتّبة بنسق زماني وتارة أخرى بنسق مفاهيمي بنحو لا يمكن تصنيفه تبعًا لنسق «سُوري» إن صحّ التّعبير.
لقد كان نزول القرآن منجّمًا مفرّقًا خلال 23 عامًّا على حسب حاجات النفوس من الإصلاح والتعليم وروعيت في ذلك حكمة التدرّج والترقّي في التشريع على أحسن الوجوه وأكملها ولكن هذه النجوم في الوقت نفسه لم تترك مبعثرة منعزلة بعضها عن بعض بل أريد لها أن تكون فصولًا من أبواب اسمها السور، وأن تكون هذه الأبواب أجزاء من ديوان اسمه القرآن، فكان لا بدّ من أن يراعى مواقعها من
هذا البنيان معنى آخر غير ترتيبها الزماني بحيث يأتلف من كل مجموعة منها باب ويأتلف من جملة الأبواب كتاب ولا يكون ذلك إلّا إذا ألّفت على وجه هندسي منطقي بليغ، تبرّر بها وحدتها البيانيّة في مظهر لا يقل جمالًا وأحكامًا عنها في وضعها الإفرادي التعليمي، فكانت الآية الكبرى في أمر هذا التأليف القرآني أنّه كان يتم في كل نجم فور نزوله،فكان يوضع هذا النجم توًّا في سورة ما، وفي مكان ما، من تلك السورة، وكذلك كان يفعل بسائر النجوم فَتُفَرّق فور نزولها على السّور؛ ما يدلّ على أنّه كانت هناك خطّة مرسومة حتمًا، ونظام سابق محدّد لا لكل سورة وحدها بل لمجموعة السور كلّها.
إنّ الوحدة الموضوعيّة لكل سورة معقودة للتكلّم عن موضوع معيّن مع كبر بعض السور وامتداد نزولها كما في سورة البقرة التي نزلت على مدار تسع سنوات، إلّا أنّ هذه الوحدة لم تنخرم ولم تتبدّل وكانت في غاية الإحكام، مثل ذلك؛ كقصر مبني في السماء ثم ينزل الله منه كل يوم قطعة فمرة ينزل النافذة ومرة ينزل السقف... ويأمر الله تعالى نبيّه بأن يضع الجزء كذا في مكان كذا فيفعل وهو لا يدري لماذا، فلا ينتهي التّنزيل إلّا ويتّضح للجميع مدى توافق هذا البنيان وأحكامه ودقّة تصميمه.
ويبدو أنّ ميور لم يكن على قدر تامّ من المعرفة ليميّز بين النّصوص المفتوحة التي تبعث على التأمّل وبين النّصوص المغلقة لغلبة النظرة الكلاسيكيّة عليه، كما أنّه أغفل أسباب التّنزيل التي كان له أن يطّلع عليها للخروج بترتيب زمنيّ مقارب لأحداث السيرة.
يذكر ميور: «أنّ التكرار في التّعبير النمطيّ والجهد المتواصل لرسم تماثل بين محمّد وبين الأنبياء السابقين بوضعه خطاب عصره على ألسنتهم أو على ألسنة فرقائهم المزعومين يصيب متصفّح القرآن الصبور بالوهن».
التّكرار تجديد لدلالات الألفاظ بطرائق متعدّدة تتبع تناسبها مع سياقاتها المتنوّعة، وأهم ما يلحظ على ظاهرة التّكرار اقترابها من ظاهرة التوكيد اللفظي، لقد جاء القرآن الكريم بمظاهر عديدة من التّكرار منها ما هو قائم على الاختلاف في الألفاظ بين الآيات، ومنها ما هو مؤسَّس على التباين في التعبير مرة بالتقديم والتأخير وأخرى بالحذف والإثبات ومنها ما هو قائم على الاستعمال المختلف لأدوات الأساليب العربيّة ومنها ما يقوم على تكرار المتشابه للآية في السورة الواحدة بعدة سياقات مختلفة.
إنّ القصور المنهجي لوليم ميور قاده إلى نتائج مضلّلة، إذ لم يدرك أنّ ثمّة قصدًا من وراء تكرار قصص الأنبياء أو تكرار مضمون بعض الآيات بحسب الموقف ومتطلباته؛ التي قد تستدعي تكرارًا للمضمون، فالتّكرار دال على الاهتمام بالوعظ لإيقاظ العقول والاعتبار وفائدة تطرئة المواعظ وتشديدها لأن منها ما يحثّ على الطاعة والإيمان، ومنها ما يزجر عن الكفر والعصيان، كذلك فإنّ تكرير الوعد والوعيد وذكر الأحكام وتكرير المدح والذم وما يترتّب على المأمورات والمنهيّات من المؤكّدات المذكورات يدلّ على الاهتمام بترك المخالفات ترهيبًا من عقابها فكانت العرب لا تؤكّد إلّا ما تهتم به فإنّ من اهتم بشيء أكثَرَ من ذِكْرِه.
فالحكمة من ذكر موسى، ستَّ وثلاثين ومائة مرّة في القرآن الكريم لأنّ فرعون
نسب الألوهيّة لنفسه؛ وطغى في الأرض بغير الحق، وهذا ليس تكرارًا بل تنويعًا في العرض، لأنّ القرآن يضيف الجديد في كلّ مرّة يعيد فيها ذكر الآية أو العبارة، ولنأخذ على ذلك مثالًا من سورة الرحمن؛ فقد ذكرت: (فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ) في الآية 16 مرتبطة بما قبلها التي تتحدّث عن خلق الإنس والجنّ؛ أمّا في الآية 18 فذكرت بغية التذكير بملك الله لكل ما في الكون.
أمّا عن خطاب عصر النبوّة المحمّديّة وصلته بالأنبياء، فلم يكن لرسول الله صلىاللهعليهوآله خطاب مستقلّ حتّى يضعه على لسان غيره من الأنبياء لأنّ خطابه لم يكن خطاب عصره فحسب بل كان خطاب جميع العصور، فجميع الأنبياء كانوا يشتركون في معركة التوحيد ضد الشرك والوثنيّة ومواجهة المكذّبين والعتاة من أقوامهم، وما القرآن إلّا خطاب من الله (عزّ وجل) يذكّر العالمين بذلك: (كُلَّمَا جَاءَهُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَىٰ أَنفُسُهُمْ فَرِيقًا كَذَّبُوا وَفَرِيقًا يَقْتُلُونَ) (سورة المائدة: الآية 70)، (يُرِيدُ اللَّهُ لِيُبَيِّنَ لَكُمْ وَيَهْدِيَكُمْ سُنَنَ الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ وَيَتُوبَ عَلَيْكُمْ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ) (سورة النساء: الآية 26).
أمّا عن الوهن الذي يصيب القارئ بفعل هذا التّكرار حسب زعم ميور، «فالقرآن الكريم مع كونه أكثر الكلام افتنانًا وتنويعًا في الموضوعات، والأسلوب؛ لا يستمرّ طويلًا على نمط واحد من التعبير، ولا على هدف واحد من المعاني، ألا تراه كما يتنقل في السورة الواحدة من معنى إلى معنى بين إنشاء وإخبار، وإظهار وإضمار، واسميّة وفعليّة، ومضي وحضور واستقبال وتكلّم وغيبيّة وخطاب، إلى غير ذلك من طرق الأداء، على نحو من السرعة لا عهد لك بمثله ولا بما يقرب منه في كلام غيره قطّ ومع هذه التحوّلات السريعة المستمرّة التي هي مظنّة الاختلاج والاضطراب، في داخل الموضوع أو في الخروج منه، تراه لا يضطرب ولا يتعثر، بل يحتفظ بتلك الطبقة العليا من متانة النظم وجود السبك حتّى يصوغ من هذه الأفانين الكثيرة
منظرًا مؤتلفًا فلا ينتقل من خطوة إلى خطوة إلا استعرض في الخطوة التالية من مذاهب المعنى وألوان الأسلوب جديدًا إثر جديد فكيف يعرف الملل سبيلًا إلى قلبه مع دوام هذه النظرة والتجديد؟».
ولنا أن نسأل هل بلغ وليم ميور من البلاغة وجودة الصناعة في لغة العرب حتّى يتذوّق سمات القرآن البلاغيّة؟ أو يكون له مثل هذه الأحكام على كتاب أعجز البلغاء من العرب، إنّ ميول ميور جذبته إلى نتائج مضلّلة توهّم من خلال فرضيّات بسيطة وسطحيّة أن يخرج بصورة تمثّل النسق القرآني؛ ولعلّ محاولته في ترتيب القرآن كانت متواضعة ومغمورة لم تسلم حتّى من نقد مستشرقي عصره.
يذكر ميور: «أنّ محمّدًا لم يكن له معجزات تدلّ على نبوّته في أيّ جزء من سيرة حياته، ولم يتظاهر حتّى بأدائها»، «ولا يمكن أن يلقى اللوم على قريش الذين باتوا يرفضونه بسبب عجزه عن الإتيان بمعجزة أسوة بمعجزات موسى والمسيح»، «فلا يوجد دليل لإثبات صحّة بعثته، سوى اعتقاده بأنّه مكلّف بالتّفويض الإلهي بالنبوّة»، أمّا عن المعجزات الحسّيّة التي وردت في كتب الحديث والسيرة فيرى: «أنّها أساطير وحكايات خرافيّة وطفوليّة وضتعها أقلام أهل السيرة لتمجيد صورة النبي».
وفي كتابه منارة الحق أفرد ميور عنوانًا جاء نصّه: «نصوص من القرآن تشير بأنّ محمّدًا لم يؤيّد بآية أو معجزة» وقد استشهد ميور بقوله تعالى: (وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَّبِّهِ ۚ قُلْ إِنَّ اللَّهَ قَادِرٌ عَلَىٰ أَن يُنَزِّلَ آيَةً وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ) (سورة الإنعام:
الآية 37)؛ كذلك: (وَمَا مَنَعَنَا أَن نُّرْسِلَ بِالْآيَاتِ إِلَّا أَن كَذَّبَ بِهَا الْأَوَّلُونَ) (سورة الإسراء: الآية 59)؛ كذلك: (وَقَالُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَاتٌ مِّن رَّبِّهِ ۖ قُلْ إِنَّمَا الْآيَاتُ عِندَ اللَّهِ وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُّبِينٌ) (سورة العنكبوت: الآية 50).
أمّا القرآن فيرى ميور: «أنّه ليس معجزة، لأنّ لدى العرب إحاطة مميّزة بالتراكيب الرائعة في أشعارهم وخطبهم، وعلى الرغم من أنّه ليس هنالك من يناظرهم في جمال أسفارهم إلّا أنّهم لم يقيّموها على أنّها معجزات، فلا يحوز مُحَمّد عَلَى معجزة فعليّة على غرار معجزة إحياء الموتى ومعجزة شقّ البحر وهكذا دواليك، كيف له أن يقدّم انعكاسًا مماثلًا للحكمة الإلهيًة؟».
يعتقد ميور: «أنّ ليس للعرب مثل هذا الادّعاء باحتكار البلاغة وقوّة العارضة الأدبيّة لأنّ لكلّ أمّة وجه بلاغة خاص يتّسق مع ذوقها ولغتها، خذ مثلًا شواهد من اليهود والإغريق وكيف تتجلّى كتاباتهم الرائعة بين أيدينا»، ويرى أيضًا: «أنّ نبوّة موسى والمسيح قامت على أساس المعجزات، وكان يتعيّن على محمّد من باب أولى أن يقدّم معجزات أرفع منزلة من معجزات من قبله كونه جاء بديانة جديدة تنسخ ما قبلها من الشرائع».
إنّ المعجزة في اللغة اسم فاعل مؤنّث من الفعل الرباعي أعجز، والتاء فيها تاء التأنيث، وليست «هاء» المبالغة كما قال بعض العلماء، وذكر إنّها سمّيت بذلك لعجز الناس وقصورهم عن الإتيان بمثلها، والمعجزة أمر خارق للعادة من ترك أو فعل مقرون بالتحدّي مع عدم المعارضة، وهي ما يدلّ على تصديق الله (عزّ وجل) للمدّعي في دعواه الرسالة، أو تمثّل تأييد الله لمدعي النبوّة بما يؤيّد دعواه
ليصدّقه المرسل إليهم، ومن الباحثين من يعدّ أصل الكلمة من «العجز» التي تحمل معنيين متضادين: العجز والقدرة كما في أعجاز النخل التي تمثّل أواخرها وهي أقوى جزء فيها.
ولا يكاد يخلو مصنّف من مصنّفات الروّاد أو المحدثين من الإشارة إلى معجزات الرّسول صلىاللهعليهوآله وكراماته أو إنبائه بأحداث غيبيّة، إلّا أنّ نبوّته صلىاللهعليهوآله لا تقف على هذه المسألة، لأنّما جاء به الرّسول صلىاللهعليهوآله من أمر النبوّة أرفع من أن يستظهر بروايات أهل الحديث والسّيرة.
وعلى الرغم من إصدار ميور لأحكامه النابعة من منهجه المادّي إلّا أن ما يعنينا مناقشة آرائِه في ضوء الدعامة الكتابيّة التي أقام حجّته عليها؛ فالمعجزة في الكتاب المقدّس أو«العجيبة» تعني: «ما يدعو إلى العجب والانبهار، وهي عمل أو ظاهرة خارقة للطبيعة، في لحظة حاسمة أو مرحلة فاصلة في التاريخ، سمّيت المعجزات لأن الإنسان يعجز من ذاته عن الإتيان بمثلها، والمعجزات الحقيقيّة، من فعل الله، لتأييد كلامه على فم أنبيائه ورسله، فهي آيات أو علامات على تدخّل الله في مجريات الأمور».
إنّ أفضل سبيل لتناول هذا الموضوع، دراسة الوقائع الفعليّة للمعجزة، «فالمعجزات علامات ورموز يعلن الربّ من خلالها عن ذاته، ليبرهن على حقيقته، تنسجم مع حقائق الدين وتأتي في فرصة مناسبة فالله (عزّ وجل) لا يصنع عجائبه إلا لأسباب مهمّة وغايات مقدّسة؛ فالمعجزات دليل إعلان عن النبوّة وقيمة المعجزات أنّها براهين على صدق الوحي الإلهي، ولا يمكن أن يكون هناك إعلان حقيقي بدون معجزات، فالمعجزات ليست مجرّد أدلة على صدق الإعلان، ولكنها الإعلان نفسه، تستلزم لإجرائها قوّة تفوق قدرة الإنسان ودليل واضح على قدرة الله غير المحدودة
التي لا يمكن إدراكها إلا بملاحظة هذه المعجزات، التي تكشف عن طبيعة قوة عليا خارقة للطبيعة قد تدخّلت لذلك يصفها الكتّاب بالقول: «عجائب وقوّات وآيات»، وهناك سمة هامّة أخرى في هذه المعجزات، هي أنّها تحدث نتيجة استجابة لصلاة الشخص الذي تُنسب إليه المعجزة».
ومن خلال هذا العرض يتبيّن أنّ المعجزة ليس بالضرورة أن تكون من جنس الظواهر الماديّة لأنّها حالة فريدة يكشف فيها الله (عزّ وجل) عن قدرته العظيمة للإنسان عن طريق أنبيائه، وتبعًا لذلك يبدو أنّ للمعجزة شروطًا لا بدّ أن تتحقّق: الأوّل أن تكون المعجزة فعلًا من الله سبحانه ذلكم لأنّ المعجزة تصديق للرسول؛ والثاني: أن يكون هذا الأمر خارقًا للعادة وخارجة عن المألوف؛ والثالث: أن تكون معارضتها غير ممكنة، بمعنى أنّ النّاس لا يقدرون أن يأتوا بمثلها؛ الرابع: أن تظهر هذه المعجزة على يد من ادّعى النبوّة؛ والخامس: أن يكون موافقة لما ادّعاه النبي، والسادس: أن تكون المعجزة بعد ادّعاء النبوّة.
إنّ طريقة عرض ميور لهذا الموضوع تؤشّر على عقليّة تجسيديّة نظر من خلالها إلى الوحي والنبوّة المحمديّة من منظار حسي، أسوة بزعماء المشركين الذين كانوا يطالبون بمثل ما يطالب به ميور على الرغم من الاختلاف الزمكاني.
إنّ معجزة الرّسول هي القرآن نفسه وليست معجزات حسّيّة، لأنّ المعجزات لم تكن الفيصل بالنسبة لزعماء المشركين في تقبّل الدعوة أو رفضها، فما هي إلّا وسيلة لتعجيز الرّسول صلىاللهعليهوآله أمام الرأي العام آنذاك: (أَوَلَمْ يَكْفِهِمْ أَنَّا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ يُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَرَحْمَةً وَذِكْرَىٰ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ) (سورة العنكبوت: الآية 51)، فإن ّكل مقدار من مقادير إعجازه آية على صدقه بحيث لا يختصّ بإدراك إعجازه فريق خاصّ في زمن خاصّ شأن المعجزات المشهودة مثل عصا موسى وناقة صالح، فهو يتلى، ومن ضمن تلاوته الآيات التي تحدّت
النّاس بمعارضته وسجّلت عليهم عجزهم عن المعارضة من قبل محاولتهم إيّاها، فكانت معجزة باقية والمعجزات الأخرى معجزات زائلة.
لقد طالب ميور مثلما طالب زعماء المشركين بالمعجزات الذين لجّوا في تعنّتهم وطلبهم آيات ترشدهم إلى أنّ محمّدًا رسول الله كما جاء صالح بناقته، قال الله تعالى «قل» يا محمّد إنما أمر ذلك إلى الله، فإنّه لو علم أنّكم تهتدون لأجابكم إلى سؤالكم؛ لأنّ ذلك يسير لديه ولكنّه يعلم أنّما قصدكم التعنّت والامتحان، فلا يجيبكم إلى ذلك.
ويبدو أن ميور تغافل أنّ لكل عصر وزمن متطلّباته من حيث نوعية المعجزة المطلوبة وأنّ العناية الإلهيّة هي التي تحدّد ذلك: (وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَن يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ ۗ لِكُلِّ أَجَلٍ كِتَابٌ) (سورة الرعد: الآية 38)، وبما أن ميور لا يؤمن بنبوّة محمّد صلىاللهعليهوآله فهو غير مقتنع من الأساس بمثل هذه التّفسيرات القرآنيّة على الرغم من احتكامه إلى القرآن الكريم في مواضع شتّى، لكن غياب الرؤية الشموليّة للآيات المتعلّقة بهذا الموضوع وإجتزاءه للنّصوص تعدّ من السلبيّات التي تؤشّر على معالجته لهذه القضيّة.
كما يظهر أنّ ميور قد ناقض نفسه في مسألة اشتراط الأَمَارات الإعجازيّة؛ كبرهان على بعثة الأنبياء؛ ولا سيّما مع إقراره: «بأن هنالك أنبياء أرسلهم الربّ بدون معجزات مثل أرميا ويونس».
لقد جرت سنة الله تعالى أن تكون معجزة كل نبيّ من جنس ما عرف به قومه في زمنه، فاذا كانت غاية المعجزة أن يرى النّاس فيها صدق الرسول، وقيام الدليل على صحّة دعواه، كان لا بدّ أن تكون هذه المعجزة جارية مع تفكيرهم،
فمعجزة صالح كانت الناقة، لأنّ قومه ثمود كانوا يعنون بشأن الإبل ويعيشون في مكان يحتاجون فيه إلى الماء، كذلك معجزة موسى العصا الجافّة التي ألقاها باسم الله فاذا هي حيّة، تشبه السحر، لأنّ الأمّة التي تحدّاها تفوّقت بالسحر؛ ومعجزة عيسى كانت منسجمة مع بيئته لأنّ في عصره طغت المادّة على بني إسرائيل، فكانت معجزته تقويضًا للمادة رأسًا على عقب، هذه المعجزات كانت معجزات ماديّة غير دائمة تنقضي بنهاية حقبة النبيّ الذي جاء بها، وربّما تنتهي في حياته .
وقد أقرّ الحاخام اليهودي نتنئيل الفيومي أحد الكتّاب اليهود في العصور الوسطى في كتابه «صديقة العقول» إنّ نظريّة نزول الوحي يمكن تسميتها التسامحيّة أو التكيفيّة؛ بمعنى أنّ الله (عزّ وجل) يتجلّى لعباده بطرق مختلفة من خلال نزول أو تجلٍّ مختلفٍ يتطابق مع عادات وتقاليد حضاريّة لكلّ أمّة من الأمم المختلفة.
والغريب أنّ ميور يقر أن الرّسول صلىاللهعليهوآله لم يُجَرّب افتعال المعجزات: «لو أراد أن يظهر معجزة لاتّخذ من مسألة الكسوف التي تزامن مع فقدانه لولده ذريعة لكي يظنّ النّاس أنّ ثمّة ما يربط بينهما فأيّ منتحل وضيع سوف يتقبّل ويؤكّد هذا الوهم لكنّ محمّدًا رفض الفكرة مشيرًا إلى أنّ الشمس والقمر من آيات الربّ ولا يحلّ بهما الكسوف لموت أحد ما».
إنّ القرآن الكريم المعجزة الكبرى التي أتاها الله رسوله الكريم، لأنّه كلام لم تسمع العرب مثله قبل أن يتلوه الرسول صلىاللهعليهوآله، فعندما رموه بأنّه شاعر يستبين لهم أنّه لا ينشدهم شعرًا؛ ولما يقولون إنّه كاهن يتبيّن لهم أنه لا يسجع لهم سجع الكهان؛ ويقولون إنّه ساحر ثم يستبين لهم أنّه ليس من السّحر في شيء وإنّما هو رجل مثلهم لا يملك لنفسه نفعًا ولا ضرًّا يسعى في الأرض، ويقولون إنّه مجنون ولكن هذا لا يريحهم فهم يقولون له ويسمعون منه ويرقبونه مصبحين وممسين فلا ينكرون
منه شيئًا، أخذ في تلاوته فجأة ذات يوم بعد أن بلغ الأربعين وأنفق ثلثيّ عمره في الدنيا يحيا كما يحيا غيره من قريش فلا غرابة في أن يبهر قريشًا وسائر العرب بهذا البيان الذي جاءه فجأة: (قُل لَّوْ شَاءَ اللَّهُ مَا تَلَوْتُهُ عَلَيْكُمْ وَلَا أَدْرَاكُم بِهِ ۖ فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمُرًا مِّن قَبْلِهِ ۚ أَفَلَا تَعْقِلُونَ) (سورة يونس: الآية 16)؛ فلا غرابة في أن يعجزهم هذا كلّه، فهم في حيرة من أمرهم فيما يتلى عليهم من آيات، فإنّ هذا القرآن إن لم يكن معجزة ما آمن المؤمنون الأوائل بغير سواه.
لقد بعث محمّدًا صلىاللهعليهوآله في زمن الفصحاء والبلغاء، فأتاهم بكتاب من الله تعالى لا يستطيعون أن يأتوا بمثله لو اجتمعت الإنس والجن على ذلك، أو حتّى بعشر سور، أو بسورة من مثله أو بحديث مثله أو بسورة من مثله، حتّى لا يبقى لهم حجّة على النبّي ولو كان بعضهم لبعض ظهيرًا، وحِكمة هذا التحدّي، أن يشهد التاريخ في كل عصر بعجز العرب عنه وهم الخُطباء اللُّدُّ، والفصحاء اللُّسن، حتّى لا يجيءَ بعد ذلك في ما يجيءُ من الزمنِ مولد، أو أعجمي كاذب، فيزعمُ أنّ العرب كانوا قادرين على مثله وأنّه غير معجز، لأنّهم لو منعوا من الاستعانة بالآخرين لقالوا: «لو اتّحدنا لانتصرنا ولجئنا بمثل القرآن، إلّا أنّهم لمّا سمح لهم بأن يستعينوا بمن شاؤوا ثم فشلوا وعجزوا لم يبق لهم عذر أو حجّة يحتجون بها فهزيمتهم وفشلهم وهم في صف واحد أقوى من هزيمتهم وحدهم وهذا ما قرّره القرآن الكريم»، وإلى ذلك يشير سيد قطب: «والتّحدي هنا عجيب والجزم بعدم إمكانه أعجب، ولو كان في الطاقة تكذيبه ما توانوا عنه لحظة، وما من شك أن تقرير القرآن الكريم أنّهم لن يفعلوا وتحقّق هذا كما قرّره، هو بذاته معجزة لا سبيل إلى المماراة فيها».
فالقرآن مع كونه معجزة دالة على صدق الرّسول صلىاللهعليهوآله ومرشدة إلى تصديقه مثل غيره من المعجزات فهو وسيلة أيضًا وعلم وتشريع وآداب للمتلو عليهم، وبذلك فُضِّل على غيره من المعجزات التي لا تفيد إلا تصديق الرّسول الآتي بها، ولكون القرآن ممّا يتلى، فإنّ ذلك أرفع من كون المعجزات الأخرى أحوالًا مرئيّة، لأنّ إدراك المتلو إدراك عقلي فكري، وذلك أعلى من المدركات الحسّيّة، فكانت معجزة القرآن أليق بما يستقبل من عصور العلم التي تهيّأت إليها الإنسانيّة.
فالقرآن معجزة عقليّة خالدة، واضحة ليس فيها غموض، عامّة لا تقتصر على مكان دون آخر، أو شعب دون شعب، باقية لا تخصّ زمنًا دون آخر، أمّا معجزات سائر الرّسل فمحدودة العدد، قصيرة الأمد، ذهبت بذهابهم وماتت بموتهم أمّا وجوه الإعجاز فكثيرة ومتنوّعة، منها ما استأثر الله (عزّ وجل) بعلمه ولا سيّما الإعجـاز البياني لأنّه جاء متناهيًا بأفصح الألفاظ، وأروع النظم، وأحسن البلاغة، وأدقّ الترتيب، متضمّنًا أصحّ المعاني وأغزرها وفي أجمل الأصوات، على وفق قواعد النحو العربيّ، والإعجاز التشريعي جاءَ ربانيًّا وكاملًا وشاملًا ومتوازنًا وميسورًا وصالحًا وساميًا، كذلك الإعجاز الغيبي فالقرآن معجز بما تضمّنه من أخبار الماضي والحاضر، والمستقبل والإعجاز العلمي بما تضمّنه القرآن أو أشار إليه من حقائق علميّة كونيّة ودنيويّة، لم تكتشف قبل نزوله أو أثناءه، وإنّما اكتشف بعضها بعد أحقاب.
لقد حاجج القرآن الكريم معاصري محمّد صلىاللهعليهوآله بأنّه لم يكن يتلو من كتاب ولا خطّه بيمينه ولا اطّلع على كتب السابقين، وأكّد على أنّهم يشهدون بذلك لأنّه سلخ حياته بينهم، وهنا يكمن الإعجاز أنّ النبي صلىاللهعليهوآله طرف أسماع العرب بنبأ
جديد عن أنباء الأمم السالفة بلغتهم بنحو تفصيلي لم يكن له ولا قومه أن يحيطوا بها علمًا فهم لم يكونوا يعرفون شيئًا عن كفالة زكريا للسيّدة مريم بعد ولادتها.
ويبدو أنّ ميور حاكم نصوص القرآن محاكمة ظاهريّة نابعة من حكم مسبق مؤدّاه أنّ القرآن حتّى لو بلغ أعلى منازل البلاغة، لأنّها ليست سوى نصوص أدبيّة لا تجاري معجزات الأنبياء الأقدمين، وهذا ما حمله إلى مقارنة نصوص القرآن بالقطع الأدبيّة لليهود والإغريق، وهو ما يؤشّر إلى عجز ميور عن تمثّل الثقافة واللغة العربيّة على الرغم من إجادته لطرف منها، متغافلًا عن قضيّة مهمّة؛ هي استجابة العرب لهذه القضيّة ليس لأنّ زمنهم كان زمن الشعر والمعلّقات فحسب، بل مبعث الإعجاز في لغة الخطاب القرآني من حيث الاتّساق والتّركيب وقوّة الأثر على النفوس التي جعلت قرائحهم اللغويّة عاجزة أمام مجاراته أو توصيفه. وهنا عين المشكلة المنبثقة من الإفراط في تطبيق المناهج الماديّة على موضوع الوحي، وفي ذلك يرى هنري دي كاستري Cte.H.de Castries: «أنّ العقل يحار كيف يتأتّى أن تصدر تلك الآيات عن رجل أمّيّ وقد أقرّ الشرق قاطبة بأنّها آيات يعجز فكر بني الإنسان عن الإتيان بمثلها لفظًا ومعنى، آيات لما سمعها عتبة بن ربيعة حار في جمالها، وفاضت عينا نجاشيّ الحبشة بالدموع لما تلا عليه جعفر بن أبي طالب سورة مريم».
كما يرى المستشرق جورج بوش: «ليس من السّهل ترجمة القرآن بالنسبة للذين تعرّفوا عليه في لغته الأصليّة، فهناك إقرار عالمي بأنّه يتّسم بامتياز لا حدّ له، لدرجة أنّه لا يمكن ترجمته لأيّة لغة أخرى، إنّه أنموذج يحتذيه اللسان العربي، مكتوب في معظمه بأسلوب أنيق».
ولعلّ هذا ما أكّده موريس بوكاي Maurice Bucaille قائلًا: «لو كان مؤلّف القرآن إنسانًا كيف استطاع في القرن السابع من العصر المسيحي أن يكتب ما اتّضح أنّه يتّفق اليوم مع العلوم الحديثة؟ ليس هناك أيّ مجال للشكّ، فنصّ القرآن الذي
نملك اليوم هو النصّ الأوّل نفسه، ومن ذا الذي كان في عصر نزوله يستطيع أن يملك ثقافة علميّة تسبق بحوالي عشرة قرون ثقافتنا العلميّة؟ إنّ في إشارات القرآن قضايا ذات صبغة علميّة تثير الدهشة».
وكما ترى لورا فاغليري Laura Vagliere: «إنّ القرآن، قد أثبت أنّه ممتنع على التقليد والمحاكاة حتّى في مادّته فنحن نقرأ فيه إلى جانب أشياء أخرى كثيرة، تَنَبُّؤًا ببعض أحداث المستقبل، ووصفًا لوقائع حدثت منذ قرون ولكنّها كانت مجهولة على وجه عام؛ ثمّة إشارات كثيرة إلى نواميس الطبيعة، وإلى علوم مختلفة، دينيّة ودنيويّة، إنّنا نقف على ذخائر واسعة من المعرفة تُعجز أكثر الناس ذكاءً، وأعظم الفلاسفة، وأقدر رجال السياسة؛ ولهذه الأسباب كلّها لا يمكن للقرآن أن يكون من عمل رجل قضى حياته كلّها وسط مجتمع جافّ بعيدًا عن أصحاب العلم والدين، رجل أصرّ دائمًا على أنّه ليس إلّا مثل سائر الرجال لأنّه عاجز عن اجتراح المعجزات ما لم يساعده على ذلك ربّه كلّي القدرة؛ إنّ القرآن لا يعقل أن ينبثق عن غير الذات التي وسع علمها كلّ شيء في السماء والأرض»، فأيّ إرث يوناني أو إسرائيلي حمل بين دفتيه مثل هذا البيان؟
ولعلّ ميور لمس الخصوصيّة التي تفرّد بها دين الإسلام خلال مقارنته بين الأثر الذي تركته بعثة المسيح وبين أثر بعثة محمّد قائلًا: «لدى المقارنة بين حياة المسيح وحياة محمّد نلمس أن الاضطهاد والرفض كان مصير كليهما لكنّ محمّد أحدث خلال ثلاثة عشر عاما من نبوّته تغييرًا واضحًا للعيان أكثر بكثير من حياة المسيح بكاملها»، ويرى أيضًا أنّه: «يظهر جليًّا للعيان لدى المقارنة مع جهود المسيحيّة الأولى أنّ ما أحرزته المحمّديّة في عشرة أو عشرين عامًا سلخ من معتقد يسوع قرونًا طويلة لتحقيقه»، ويرى أيضًا: «لقد فرّ الحواريّون عند أول خطر أحدق
بهم، فلم يتركوا منازلهم بشكل عفوي ليهاجروا بالمئات كما فعل المسلمون الأوائل أو نهجوا مثل أولئك الذين اعتنقوا الإسلام وهم سكان مدينة غريبة عنه انبروا للدفاع عن النبيّ بدمائهم».
ويقرّ أيضًا: «لقد ظهر المسيح في وسط اليهود الذين لم تكن شريعتهم بحاجة إلى إزالة؛ بل كانت تستدعي تقويم الاعوجاج، وعلى الرغم من ذلك لم ترد إشارات عن حدوث مثل هذا التأثير، أمّا محمّد فقد ظهر وسط أمّة وثنيّة غارقة في الظلمة والرذيلة تحتّم عليه أن يزيح منظومتها بالكامل وأن يقلبها رأسًا على عقب من وسط البعض مؤمنين به فمضى قدمًا بكل جرأة وأظهر انسجامًا نحو أحداث هذه القطيعة».
ألا تحمل هذه الشهادات إقرارًا من ميور بتدخّل القدرة الإلهيّة في تحريك مجريات الأحداث التي هي إحدى أهم الحيثيّات الكتابيّة في المعجزة؟، ولعلّ معجزة الرّسول صلىاللهعليهوآله كانت إلى جانب القرآن هي النبوّة ذاتها، فعندما تتجلّى العناية الإلهيّة بأعظم صورها لتغيير الواقع الديني والاجتماعي والاقتصادي والفكري لأقوام بدويّة متشرذمة ليغدو التوحيد هويّة لهذه الأصقاع في23 عامًا، بالمقارنة مع نوح الذي لبث في قومه 950 عامًا يدعو قومه دون جدوى، كذلك مع أنبياء بني إسرائيل الذين ظلّ اليهود بعدهم بشهادة المسيح: «لم أرسل إلّا إلى خراف بيت إسرائيل الضالّة»، ولعلّ ما يُستغرب له إنكار ميور لتجلّيات القدرة الإلهيّة وراء أحداث السيرة النبويّة على الرغم من إقراره بمدى التغيير العظيم الذي أحدثه الرّسول صلىاللهعليهوآله في مجريات التاريخ وفق معطيات زمكانيّة بسيطة، رهط من المهاجرين الذين استضعفوا في مكّة، وعشرة أعوام في المدينة المنوّرة التي كانت قبل الرّسول صلىاللهعليهوآله مثخنة بجراح الصراعات القبليّة الدامية.
يُعدّ المستشرق وليم ميور أوّل باحث في التّاريخ الحديث قدّم نظريّة متكاملة بشأن المصادر البشريّة للوحي وأثر المسيحيّة واليهوديّة في الإسلام، وقد زعم: «أنّ وحي الإسلام بتعاليمه وكتابه مقتبس عن شرائع اليهود بنحو رئيس وشرائع المسيحيّين بنحو جزئي بعد أن طعّمت هذه الشعائر بعبادة الجزيرة العربيّة الأم وتراثها»، لقد بلغ اهتمام ميور بهذه القضيّة حدًّا عدّها منطلقًا رئيسًا لمنافحه الإسلام والحطّ من منزلته كما جاء في قوله: «الآن اذا تتبّعنا أنّ أغلب ما ينطوي عليه القرآن مصادر بشريّة تحيط بالنبيّ في كلّ يوم، حينها سيهوي الإسلام أرضًا»؛ ويبدو أنّ لغة المجادل المسيحي تظهر جليّة في خطابه السّابق؛ بما يؤشّر على منهج غير حياديّ يسعى من خلاله إلى تفكيك المعطيات العقائديّة للإسلام للبحث عن ثغرات ينفث فيها معتقداته الأيديولوجيّة.
لقد خالف الباحث التّرتيب التّاريخي للمؤثّرات الدينيّة تبعًا لرؤية ميور بشأن أسبقيّة هذه المؤثّرات على عقليّة الرّسول صلىاللهعليهوآله لذلك أثرنا مناقشة مصادر البيئة العربيّة الوثنيّة على المؤثّرات الكتابيّة؛ وفق الآتي:
لم يستثنِ ميور البيئة الجاهليّة وعباداتها من كونها مصدرًا وضعيّا للوحي والنبوّة، قائلًا: «تمكّن محمّد من إقامة معبر على ذلك الخليج الذي يفصل بين
فجاجة المعتقدات الوثنيّة العربيّة وبين نقاء الإيمان بالله عند بني إسرائيل، عندما وقف على أرضيّة مشتركة يدعو قومه إلى منظومته الروحيّة الجديدة بلهجة يذعن لها جميع من في الجزيرة العربيّة»، ولتحقيق ذلك اعتقد ميور: «أنّ محمّدًا رأى أنّ الأمل كبير في حدوث تحوّل ديني شامل إذا أخذ بالحسبان الفائدة التي ستتحقّق من تسويغ اتّخاذ طقوس الكعبة الوثنيّة كجزء من منظومته الدينيّة، ليقطع بذلك نصف المسافة نحو غايته»، كذلك قوله: «أبقى محمّد على شعائر الكعبة بعد أن جرّدها من مظاهرها الوثنيّة كافّة عدا تقبيل الحجر الأسود».
وعلى فرض أنّ الإسلام يمثّل عقيدة توفيقيّة بين الأديان السماويّة وبين وثنيّة العرب حسب ميور، فإنّ الأطراف في الجزيرة العربيّة لم تتقبّل هذا المركب، ولم تذعن له إلّا بعد مرور عقدين من الدعوة السلمية والاحتراب المسلّح، وعندما حدث هذا الإذعان لم يكن إذعانًا لمركب ميور المزعوم، بل كان إيمانًا بدين مستقل له من مقوّمات الأصالة والوحدة المفاهيميّة والروحيّة.
لقد قرّع القرآن الكريم الديانتين اليهوديّة والنصرانيّة؛ بوصفهما ديانتين مشوبتين بمظاهر شركيّة، فلا يستقيم قول ميور في عدّ الإسلام معبرًا بين الوثنيّة وبين هذه الأديان، لأنّ المعبر الحقيقي الذي أقامه رسول الله صلىاللهعليهوآله كان جسرًا للتوحيد الخالص على خليج العقائد الشركيّة؛ يربط بين الإسلام وبين جذوره الأولى التي أرساها إبراهيم، معلنًا براءة إبراهيم من جميع هذه العقائد.
لقد كان العرب يحتفظون في عاداتهم ببعض الآثار من ديانة إبراهيم وإسماعيل مثل الحجّ ولكن هذه الآثار ذاتها كانت تختلط بأخطاء وأوهام كثيرة، ونظرًا
لوجود تراث حقيقي وآخر مشوّه فلا عجب من أنّ الرّسول صلىاللهعليهوآله عكف على تطهير شعائر الحج من براثن الوثنيّة كما يرى ميور، أما مسألة إبقائه على تقبيل الحجر الأسود فهي سنة قد سبق عرضها تفصيلًا.
«إنّ الصورة الحقيقيّة للحياة العربيّة في هذه الحقبة من الزمان نلمسها في القرآن الكريم، فقد كانت صلاة المشركين عند المسجد الحرام خليطًا من الصفير والتصفيق، كان العرب يطمسون التوحيد تحت ركام من الخرافات والأساطير، أمّا عن الجانب الخلقي والاجتماعي فلم يكن أسعد من ذلك حالًا: وأد الأطفال والبغاء وزنا المحارم وابتزاز المهور وإرث نساء الأقارب كرهًا وظلم اليتامى والجشع وإهمال الفقراء وازدراء الضعفاء، وكان الطابع الغالب، الإسراف والمباهاة والرياء، وكانت حياتهم حياة الضلال المبين وزمانهم زمان الجاهليّة».
وصفوة القول: إنّ عصر الجاهليّة لا يقدّم تفسيرًا سليمًا عن مضمون القرآن، ولو كان الأمر كما يدّعيه ميور لأبقى الإسلام على جميع أعراف الجاهليّة وتقاليدها، ولما حرّم بعضها وأباح البعض الآخر.
-----------------------
لكن يبدو أنّ إحاطة العرب ببعض الأديان السابقة جعلهم يطلبوا من الرّسول صلىاللهعليهوآله أن يأتي بآيات تشبه الآيات التي جاء بها المرسلون من قبل، فعندما أراد النضر بن الحارث مناقشة القصص القرآني شرع يقصّ أساطير ملوك فارس مثل رستم وإسفنديار بدلًا من قصص الأنبياء، بيد أن كلّ ما يمكن أن ينسب إلى هذا الشعب الأمّيّ ينبغي أن لا يتعدّى بعض المعارف المبهمة والبدائيّة التي لا تهدي عن مصدر الحقائق القرآنيّة.
لو أنّ هذا القَصص كان معلومًا عند العرب، لما استدلّ القرآن على ربّانيّته بما رواه عن الأنبياء السابقين، فكيف يستدلّ القرآن بما يعلمه العرب لإثبات نبوّة محمّد صلىاللهعليهوآله؟ ولا سيّما وأنّ التفاصيل الكثيرة والدقيقة التي وافق فيها القرآن الكريم الأسفار الكتابيّة لا يمكن أن تنتقل إلى الرسول صلىاللهعليهوآله من خلال أمّة لا تعرف عن أهل الكتاب إلا مجموعة عناوين عائمة.
ويبدو أنّ وليم ميور لم يميّز وجود مفهومين للموروث الإبراهيمي في الذهنيّة العربيّة: المفهوم الأول الموروث التوحيدي الضائع الذي كان بمثابة ضالة الحنفاء المنشودة ولا أدل على ضياع هذا الموروث من مقولة زيد بن عمرو بن نفيل الذي أفنى حياته يتحرّى عن دين إبراهيم الأوّل حتّى غدا شيخًا كبيرًا: «يَا مَعْشَرَ قُرَيْشٍ، وَاَلَّذِي نَفْسُ زَيْدِ بِيَدِهِ، مَا أَصْبَحَ مِنْكُمْ أَحَدٌ عَلَى دِينِ إبراهيم غَيْرِي، ثُمَّ يَقُولُ: اللَّهمّ لَو أَنِّي أَعْلَمُ أي الْوُجُوهِ أَحَبَّ إلَيْكَ عَبَدتكَ بِهِ، وَلَكِنِّي لَا أَعْلَمُهُ، ثُمَّ يَسْجُدُ عَلَى رَاحَتِهِ».
والصنف الثاني؛ الموروث الوثني المحرّف الذي كانت العرب عليه عشيّة البعثة النبويّة الذي عكف الرّسول صلىاللهعليهوآله نسفه وتحطيم مقوّماته، وصفة التّعارض بينهما
صفة قائمة والحجّة في ذلك إنكار قريش للنبوّة التي تدعو لإقامة المفهوم الأوّل وبذلك لا يستقيم الزعم أنّ الرّسول صلىاللهعليهوآله أسّس نصف دينه على الموروث السائد.
ذهب ميور إلى بيان بعض المؤثّرات الجاهليّة، مفترضًا تأثيرها في صيرورة الوحي والنبوّة وفق الآتي:
يذكر ميور: «أنّ محمّدًا اعتاد على ارتياد سوق عكاظ، منذ أن كان في سنّ الثانية عشرة وحتى بلوغه سنّ الخامسة والثلاثين»؛ «وفي عكاظ استحوذت على اهتمامه المناظرات التي تركت لديه أثرًا أبلغ من أثر المعارك المسلّحة، وفي غمرة هذه المشاهد تنامى لديه الحسّ القوميّ وتملّكته الرغبة بدافع التميّز الذي حفّزته أجواء المنافسة الحماسيّة، فكانت لديه فرصة نادرة لتخصيب عبقريّته لتعلّم فنّ الشعر وقوّة المعارضة على يد أعظم المعلّمين والنماذج الأكثر مثاليّة»، «كانت عكاظ يومذاك تضجّ بمناجزات الأديان، وعلى الرغم من العداء المتبادل بين اليهود والمسيحيّين إلّا أنّ ثمّة وحي إلهي يقرّ به كلا الطرفين، يشجب الوثنيّة ويدعو إلى عبادة إله واحد ويومها كان كلا الفريقين يردّدان اسم إبراهيم باني كعبتها وواضع معتقداتها ومناسكها بتبجيل، الأمر الذي أجفل إحساس محمّد وضجّ عميقًا في روحه».
وحسب ميور فإنّ المؤثّر المسيحي الأبرز في سوق عكاظ كان قس بن ساعدة: «كان محمّد ولدًا عندما كان يصغي إلى قس بن ساعدة أسقف نجران وممثّل المسيحيّة في عكاظ؛ كان يبشّر بالعقيدة الأنقى في مكّة بلهجة حملت بين ثناياها الحجّة الأعمق؛ وكانت نظرة اليهود حادّة تجاه المسيحيّة لكنّه كان يخاطبهم بلغة
تصدّق ذاتها على قلب محمّد كونها الحقّ لكنّهم كانوا يقابلون كلماته بالاحتقار ويشجبون حديثه عن تواضع المسيح ووداعته».
إنّ عدّ سوق عكاظ مصدر لخبرة وثقافة الرّسول صلىاللهعليهوآله أمر لا يمكن تجاهله فكل مصادر المسلمين تقول به، حتّى أنّ الرّسول صلىاللهعليهوآله كان يعرض نفسه على القبائل ويدعوهم إلى الإيمان بالإسلام في سوق عكاظ، ولكنّ السوق كان يجمع بين جنباته أفكارًا متنوّعة منها توحيديّة وأخرى وثنيّة ساهمت في تحفيز الرّسول صلىاللهعليهوآله ونافلة القول: إنّ عكاظًا كان وسيلة تحفيز ومصدر ثقافة وليس مصدر وحي.
أمّا عن الحسّ القومي الذي أشار إليه ميور، فقد جاء الرّسول بديانة عالميّة، تحمل سمة الشموليّة لتستوعب البشريّة وتتجاوز كل الاعتبارات القوميّة والقبليّة الضيّقة، ويكون فيها الأتقى الأكرم مقامًا، وهذا أمر يتعارض مع روح القوميّة القائمة على نعرة العرق.
أمّا أمر البلاغة والشعر فكان الرّسول صلىاللهعليهوآله ولا شكّ واحدًا من الذين يرتادون هذا السوق وهذا لا يعني أنّه تعلّم في عكاظ صنعة القرآن كما يعتقد ميور فلو كان ذلك حقًّا فحريّ بأعظم المعلّمين والنماذج الأكثر مثاليّة من الشعراء الذين لم يشِر ميور إلى أسمائهم أن يأتوا بمثل ما جاء به الرّسول صلىاللهعليهوآله من البيان.
ولعلّ ميور عوّل على إشارة وردت في صحاح اللغة ولسان العرب بشأن نصرانيّة قس بن ساعدة وكونه أسقفا لنجران، لكنّ ميور لم يشر إلى هذه الروايات، التي
ضعّفها جواد علي؛ ورأى إنّها تحتاج إلى سند موثوق لاعتمادها، فلو كان قس بن ساعدة أسقفا لشاع أمر ذلك في مصادر المسلمين، ولا سيّما مع كونه من المعمّرين؛ ويبدو أنّه حصل على هذه التسمية لأنّه كان يلازم العبادة في كعبة نجران فقيل له قس نجران، وليس بسبب اعتناقه النصرانيّة.
ويبدو أنّ قس بن ساعدة لم يكن نصرانيًّا بل تحنّف في الجاهليّة، وَلمّا قدم وفد بَكْر بْن وائل على الرّسول صلىاللهعليهوآله قَالَ لَهُ رَجُل منهم: هَل تعرف قس بن ساعدة فَقَالَ رَسُول الله صلىاللهعليهوآله: «لَيْسَ هُو منكم هذا رَجُل مِن إياد تحنّف فِي الجاهلية»، واللافت أنّ وليم ميور وقع في إشكاليّة التّناقض عندما رجّح رواية ابن سعد على جميع ما ورد في الأثر ويقرّر أنّ الرّسول صلىاللهعليهوآله لم يكن مستمعًا لقس بن ساعدة؛ بل إنّه سمع عنه وذلك يأتي على نظريّته من أساسها بقوله: «إنّ الرواية الوحيدة الأصيلة ذات الصلة بالموضوع لا تبرهن على أنّ محمّدًا كان مستمعًا لقس بل حدث الإشارة له في وفد بني بكر بن وائل إلى النبي في المدينة كما أوردها كاتب الواقدي».
ولم ترد في مؤلّفات السيرة المبكرة إشارة بشأن اتّصال الرسول صلىاللهعليهوآله، بقس لكن ورد في بعض مصادر السيرة المتأخّرة أنّ الرّسول صلىاللهعليهوآله شاهد قس بن ساعدة مرّة عابرة يخطب في سوق عكاظ، وأنّه صلىاللهعليهوآله قال لوفد بكر بن وائل: «لَقَدْ شَهِدْتُهُ يَوْمًا بِسُوقِ عُكَاظٍ عَلَى جَمَلٍ أَحْمَرَ يَتَكَلَّمُ بِكَلَامٍ مُعْجِبٍ مُونِقٍ لَا أَجِدُنِي أَحْفَظُهُ»، حتّى أنّه صلىاللهعليهوآله ترحّم عليه ودعا له: «يرحم اللَّه قسًّا، إنّي لأرجو أن يبعثه اللَّه يوم القيامة أمّة وحده»، ولعلّ هذه الروايات تقطع بعدم اتّصال الرّسول صلىاللهعليهوآله بقسّ بن ساعدة عدا سماعه مرة في عكاظ لخطبته التي نبّه النّاس فيها إلى ضلالهم وبشّرهم بقرب
ظهور النبوّة، ولو سلّمنا بما جاء في الروايات الأخرى دون رواية ابن سعد التي عضدها وليم ميور؛ فلا يمكن عدّ قسّ بن ساعدة صاحب أثر على الرّسول صلىاللهعليهوآله الذي لم يكن يحفظ خطبته كما أشار إلى ذلك ابن كثير، حتّى لو سلّم الباحث من قبيل الجدل بوجود تأثير لقس بن ساعدة، فالبون شاسع جدًّا بين شعر قسّ أو خطبه وبين السور القرآنيّة المبكّرة، الأمر الذي يقطع ببطلان مزاعم ميور.
لقد أفرط ميور في بيان أثر سوق عكاظ وشخصيّة قسّ بن ساعدة على الرّسول صلىاللهعليهوآله، التي لم يرد لها إشارة في كتب السيرة النبويّة، ولعلّ المسحة القصصيّة الخياليّة لا تخلو منها متون وليم ميور، ولا سيّما وقد ذهب إلى تصوير شخصيّة قسّ بن ساعدة في هيئة أحد رجال الكنيسة متبّعًا بذلك منهج الاختلاق القائم على بعض الإشارات في المصادر الإسلاميّة لكنّ التفصيلات والنتائج لا تتّسق معها، وهذا ما يمكن أن ندعوه منهج التحايل على النصّ، فلم يُلمس في المصادر إشارة إلى أن قسّ بن ساعدة بشّر بالمسيحيّة في مكّة حسب ميور، ولم يرد في تصوير حالة التنابذ بين المسيحيّين واليهود من المبالغة التي بسط إليها ميور، ولا سيّما وأنّ الحاضرين في سوق عكاظ كانوا لا يتناظرون في الدين وإنّما في المفاخر الدنيويّة وكانت كل قبيلة تستعرض عبقريّتها الأدبيّة ومغامراتها في الفروسيّة ومفاخر الآباء والأجداد ولا نكاد نلمس أثرًا للفكر الدينيّ في أشهر القصائد المعروفة بالمعلّقات الذهبيّة.
يزعم ميور بأنّ هنالك تأثيرًا لبعض الحنفاء أو (المتحرّون) حسب تعبيره على صيرورة العقليّة النبوية، ويرد في ذلك قوله: «كان لعثمان بن حويرث تأثير على محمّد، فهو ابن عمّ خديجة اعتنق المسيحيّة في القسطنطينيّة ومن ثمّ شرّع
بمحاولة فاشلة للاستيلاء على مكّة»، كذلك ورقة بن نوفل: «ابن عم خديجة الآخر الذي قيل إنّه اعتنق المسيحيّة، وكان يتعبّد كل عام في كهف قرب مكّة، وقد أسهم في إرضاء عقليّة محمّد في أنّه صاحب بعثة إلهيّة»، «ودون شك كان له أثر كبير على النبي الذي اعتاد ارتياد الموضع عينه من أجل الهدوء والعزلة»، أمّا المتحرّي الثالث فعبيد الله بن جحش، والرابع زيد بن عمرو «الذي زعم بأنّه ميّز محمّد النبي الموعود»، ويرى ميور: «لا ريب أنّ محمّدًا أظهر تعاطفًا عميقًا معهم من خلال محاورتهم بشأن ظلمة الوثنيّة التي تخيّم على العرب وعن الحاجة إلى معتقد روحي من أجل إحلال التجديد».
ويبدو أنّ ميور وضع جميع الحنفاء في سلّة واحدة معوّلًا على ما يشبه الأثر الجمعي في صيرورة العقليّة النبويّة، لكن هل حدثت لقاءات فعليّة بين الرّسول صلىاللهعليهوآله وبين الحنفاء؟ وإن افترض حدوثها فهل كانت لدواع تعليميّة؟
كانت شريحة الحنفاء فئة ثائرة على الرأي العام متمرّدة على عصرها تطلّعت إلى دين صحيح حاولوا التماسه خارج محيطهم ولم يكن عندهم عنه أيّ فكرة دقيقة قادرة على أن تنبئ عن دعوة القرآن ولو من بعيد، كان الحنفاء يقول بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ: «تعلَّموا وَاَللَّهِ مَا قَوْمُكُمْ عَلَى شَيْءٍ لَقَدْ أَخْطَؤوا دِينَ أَبِيهِمْ إبْرَاهِيمَ، مَا حَجَرٌ نُطِيفُ بِهِ، لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ، وَلَا يَضُرُّ وَلَا يَنْفَعُ يَا قَوْمِ التمسوا لأنفسكم، فَإِنَّكُمْ وَاَللَّهِ مَا أَنْتُمْ عَلَى شَيْءٍ» لذلك تَفَرَّقُوا في البلدان يلتمسون، دين إبراهيم.
فأمّا عن عثمان بن حويرث فلم يرد في ترجمته أيّ اشارة عن اتّصاله بالرسول صلىاللهعليهوآله عدا أنّه مات على دين النصرانيّة بعد أن قام بمحاولة سياسيّة فاشلة لامتلاك مكّة
كما أورد ميور، والغريب أن ميور لم يحدّد زمان اللقاء ومكانه ولم يحدّد طبيعة التّأثير المزعوم، ولم نلمس أنّه كان معاصرًا للرسول صلىاللهعليهوآله، كما أن سياق الأحداث تبرز أن ابن الحويرث كان شخصيّة غير مرغوب بها في مكّة، بالتالي فإنّ أي اتّصال بينه وبين الرّسول صلىاللهعليهوآله يعدّ مستبعدًا، والراجح أنّه قام بهذه الحركة السياسيّة في مرحلة مبكّرة من حياة الرّسول صلىاللهعليهوآله كما أشار ابْن هشامٍ فِي معرض حديثه عن حرب الفجار.
أمّا عن ورقة بن نوفل فلم يرد في المصادر التاريخيّة أنّه كان يتّصل بالرسول صلىاللهعليهوآله عدا أنّه: «لما قَدِمَتْ به حليمة السَّعْدِيَّةَ إلى مكّة أَضَلَّهَا وَهِيَ مقْبِلَة بِهِ نَحْو أَهْلهِ، فَالْتَمَسَتْهُ فَلَمْ تَجِدْهُ، فَيَزْعُمُونَ أَنَّهُ وجَدَهُ ورَقة بْن نَوفَل بْن أَسد، وَرجُل آخرُ مِنْ قرَيش، فأَتيا بِه عَبْدَ الْمطلِبِ، وكان يومها ابن أربع أعوام عندما أرجعته حليمة إلى أمّه».
أمّا الإشارة الثانية فكانت في فرضية حضوره مع أم المؤمنين خديجة عليهاالسلام للقاء ورقة بن نوفل لسؤاله عن أمر الوحي، فقد ذكر ابن هشام أنّ خديجة عليهاالسلام ذهبت بمفردها ولم يكن الرّسول صلىاللهعليهوآله بمعيّتها وعندما عرضت الأمر على ورقة فقال: «لَئِنْ كُنْتِ صدَّقْتينِي يا خَديجة لَقَدْ جَاءَهُ النَّامُوسُ الْأَكبَر الَّذِي كَانَ يَأْتي موسى، وَإِنَّهُ لَنَبِي هَذِهِ الْأُمةِ، فَقولي لَهُ: فَليَثبت».
أمّا بشأن لقائه بورقة حسب ما جاء في كتب السيرة، فكان عند الكعبة فردّد له ورقة ما قاله لخديجة من قبل ووعده بالنصرة وحذّره من مغبة ما سيلاقيه من التكذيب من لدن قومه وقد ختم لقائه معه بتقبيل رأسه، ويضيف ابن سعد أنّه
لم يحدث أيّ لقاء بين خديجة وبين ورقة بن نوفل قبل أمر الوحي، وهذا من شأنه أن يدحض أيّ نظريّة تقول بتأثير ورقة بن نوفل على عقليّة الرّسول صلىاللهعليهوآله بالاتّصال المباشر أو غير المباشر من خلال خديجة.
كما دلّت النّصوص على عدم وجود صلة سابقة بين الرّسول صلىاللهعليهوآله وبين ورقة، وعلى فرض صحّة النّصوص السابقة التي حاولت إيجاد دور للسيّدة خديجة في التحثيث على نبوّة الرسول صلىاللهعليهوآله، لكن فكرة الاتصال بورقة لم تطرأ على بال الرّسول صلىاللهعليهوآله سعيًا لإزالة الإشكال عن نفسه بل كانت من وحي خديجة، فلو كان ثمّة صلة سابقة لتبادرت إلى ذهن الرّسول صلىاللهعليهوآله سريعًا فكرة استفتاء ورقة، ولعلّ الباعث الذي حملها إلى لقائه أنّ ورقة كان على اطّلاع على الكتب السماويّة التي حملت بين دفّتيها إشارات عن علامات النبوّة القادمة التي كان لدى أهل الكتاب إحاطة بها، وهذا ما أشار إليه القرآن الكريم لاحقًا، بالتالي لا يستقيم زعم ميور في أنّ ورقة بن نوفل أسهم في غرس فكرة الوحي في مخيّلة الرّسول صلىاللهعليهوآله.
أمّا التحنّث فلم يكن لورقة أيّ أثر فيها على الرّسول صلىاللهعليهوآله لأنّها كانت عادة لدى القريشيّين ولا مجال للزعم أنّها حالة تفرّد بها ورقة بن نوفل وغدت حجّة على أثر ورقة بن نوفل على عقليّة الرسول صلىاللهعليهوآله، والجدير بالإشارة أنّهُ ثبت في الأثر أنّ ورقة قد أسلم، واتّبع الرّسول صلىاللهعليهوآله وبالتالي ليس من العقل أن يتّبع الأستاذ تلميذه؟
أمّا عبيد الله بن جحش، فقد عاصر الرّسول صلىاللهعليهوآله وأسلم ثم ظلّ مسلمًا إلى أن هاجر إلى الحبشة، وهناك تَنَصّر ومات على دين النصرانيّة، ولو كان سمع أو شهد محمّدًا صلىاللهعليهوآله لما آمن به في البداية أو لفضحه في بلاط النجاشي.
أمّا زيد بن عمرو بن نفيل فقد عكف على اتّباع دين إبراهيم معتزلًا الأوثان والميتة والقرابين ونهى عن قتل الموؤودة ولم يدخل في يهوديّة ولا نصرانيّة، وقد نقل ابن سعد أن زيدًا لم يكن معاصرًا للرسول صلىاللهعليهوآله ولم يدرك بعثته الشريفة وكان يقول: «أَنَا أَنْتَظِرُ نَبِيًّا مِنْ وَلَدِ إِسْمَاعِيلَ ثُمَّ مِنْ بَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ وَلا أراني أدركه وأنا أؤمن بِهِ وَأُصَدِّقُهُ وَأَشْهَدُ أَنَّهُ نَبِيٌّ فإن طَالَتْ بِكَ مُدَّةٌ فَرَأَيْتَهُ فَأَقْرِئْهُ السَّلامَ»، فلا ريب أنّ رأي ميور في حدوث أثر لعمرو بن نفيل أمر عار عن الموضوعيّة ويخالف السياق الزمني للأحداث؛ زد ذلك فإنّ ابنه سعيد بن زيد اعتنق الإسلام، فلو أن سعيدًا هذا أحسّ أنّ محمّدًا صلىاللهعليهوآله قد أخذ العلم من أبيه أو لو أن أباه صارحه بشيء من ذلك لما أسلم البتة.
أمّا عن مبعث استغراب ميور من أمر زيد الذي ميّز النبي القادم صفاته ونسبه، فإنّ هناك عدّة مئات من النبوّات في العهد القديم تبشر بقدوم المسيح وفي ذلك يقول أرثر.ت.بيرسون في كتابه «براهين كثيرة لا تدحض»: «إنّ هناك 332 إشارة إلى المسيح في العهد القديم، يقتبسها كتبة العهد الجديد، سواء نبوّات قد تمّت في حياته، أو كرؤية مسبقة لشخصيّته وبناء على قانون الاحتمالات الرياضيّة هناك فرصة واحدة في كل 84 وإلى يمينها 98 صفرًا، لحدوث هذه النبوّات كلّها في حياة شخص واحد، فما أعجب أن تتحقّق جميعها على أروع ما يكون في شخص واحد، فهذا من أقوى الأدلّة على مصدرها الإلهي، فهو وحده الذي يقدر أن يوحي لرجاله الأمناء بهذه النبوّات ويتمّمها في حينه»، وما دامت دعوة محمّد صلىاللهعليهوآله ذات مصدر إلهي فلا عجب من ظهور مثل هذه العلامات على لسان رجال من جنس زيد الذي اطّلع على النّصوص القديمة وقضى حياته يبحث عن الدين الحقّ.
واللافت في منهج ميور أنّه لم يبيّن طبيعة التأثير المزعوم للحنفاء لأنّ التأثّر يعني أن الرّسول صلىاللهعليهوآله كان مطّلعًا على نمط تفكيرهم والقضايا التي تهمّهم لكن ميور قصر الأمر على حدوث مداولات معهم إبّان عهد الجاهليّة، وهذا أمر عام لا يمكن أن يعدّ أثرًا في توجيه دفة النبوّة، ولا سيّما وأنّ الرّسول صلىاللهعليهوآله لم يكن على اتّصال بهؤلاء المتحرّين الأربعة، ويبدو أن رأي ميور مبنيّ على القياس والافتراض ولا يستند إلى قاعدة علميّة.
أورد ميور مصدرًا آخرًا للنبوّة: «طبقة العبيد المسيحيّين الجهلة، الذين أخذ عنهم معرفته بالمسيحيّة بفعل ما حملوه معهم من قصص الكتاب المقدّس»، «ومن هؤلاء صهيب بن سنان الرومي الذي يبدو أنّ محمّدًا تعلّم منه المسيحيّة ويحتمل أنّ الآية 103 من السورة 61 نزلت بحقّه»، كما يفترض ميور: «أنّ محمّدًا أخذ عن هؤلاء العبيد في مكّة أو جوارها أخبار النبوءة التي تستهلّها السورة الثلاثون التي سوّغت الأحداث التي نهض فيها هرقل من سباته وقيامه بحملة دحر فيها الفرس في النهاية».
إنّ ما يدعو إلى الاستغراب أنّ ميور ردّد الاتّهامات القديمة التي جرت على ألسنة زعماء قريش من جنس أنّ ما جاء به الرّسول صلىاللهعليهوآله من العلم من تعليم بشري درسه على يد قوم أو كانوا يملونه أو كان يَكْتَتبه منهم، وقد ردّ القرآن الكريم
عليها بقوله تعالى: (وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بَشَرٌ ۗ لِّسَانُ الَّذِي يُلْحِدُونَ إِلَيْهِ أَعْجَمِيٌّ وَهَٰذَا لِسَانٌ عَرَبِيٌّ مُّبِينٌ) (سورة النحل: الآية 103)، «والأعَجَمِيُّ؛ المَنسوبُ إلى الْعَجَمِ الَّذِي لَا يُفْصِحُ سَوَاءٌ كَانَ مِنَ الْعَرَبِ أو مِنَ الْعَجَمِ، أو الْمَنْسُوبُ إلى الْعَجَمِ وَإِنْ كَانَ فَصِيحًا وَهذا لِسانٌ عَرَبِيٌّ مُبِينٌ والْإِشَارَةُ إلى القرآن وأَرَادَ بِاللِّسَانِ الْبَلَاغَةَ، فَكَأَنَّهُ قَالَ: وَهَذَا القرآن ذُو بَلَاغَةٍ عَرَبِيَّةٍ وَبَيَانٍ وَاضِحٍ، فَكَيْفَ تَزْعُمُونَ أَنَّ بَشَرًا يُعَلِّمُهُ مِنَ الْعَجَمِ وَقَدْ عَجَزْتُمْ أَنْتُمْ عَنْ مُعَارَضَةِ سُورَةٍ مِنْهُ، وَأَنْتُمْ أَهْلُ اللِّسَانِ الْعَرَبِيِّ وَرِجَالُ الْفَصَاحَةِ وَقَادَةُ الْبَلَاغَةِ».
إنّ اللافت في أمر ميور أنّه أخذ عن ابن سعد سيرة صهيب الرومي بحذافيرها، لكنّه ذيّل على أنّ الرّسول صلىاللهعليهوآله أخذ عن صهيب بعض النصرانيّة، خلافًا لما أجمعت عليه أمّهات التّفاسير من أنّ الآية التي نسبها ميور لصهيب نزلت في حقّ بعض العبيد المستضعفين في مكّة التي اخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ فِي تَعْيِينِ هَذَا الْبَشَرِ الَّذِي زَعَمُوا عَلَيْهِ مَا زَعَمُوا، فقالُوا: إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ جَبْرٌ وَقِيلَ: اسْمُهُ يَعِيشُ، عَبْدٌ لِبَنِي الْحَضْرَمِي، وَكَانَ يَقْرَأُ الْكُتُبَ الْأَعْجَمِيّةَ وَقِيلَ:كان غلَام لِبَنِي عَامِرِ بْنِ لُؤَي، وَقِيلَ هما غلامان اسم أحدهما يسار، واسم الآخر جبر، وكانا يَعْمَلَانِ السيُوفَ وَقِيلَ عَنَوْا رَجُلًا نَصْرَانِيًّا كَانَ اسْمُهُ أَبَا مَيْسَرَةَ يَتَكَلَّمُ بِالرُّومِيَّةِ، وَفِي رِوَايَةٍ أخرى أنّ اسْمُهُ عَدَّاسٌ، ولم يرد في المصادر أن قريشًا نفسها اتّهمت الرّسول بأنّه انتحل من صهيب الرومي! فأنّى لميور هذا الرأي!.
كما نقل عن ابن سعد أنّ صهيبًا هرب من الروم حين بلغ وعقل فقدم مكّة فحالف عبد الله ابن جدْعان وأقام معه إلى أن هلك فقال عنه محمّد بْنَ سِيرِينَ صُهَيْبٌ مِنَ الْعَرَبِ مِنَ النَّمِرِ بْنِ قَاسِطٍ، وقال عنه الرسول صلىاللهعليهوآله «صُهَيْبٌ سَابِقُ الرُّومِ» وقد كنّاه أبا يحيى وبالتالي فإنّ هذه الرواية تنفي أن يكون صهيبًا من الروم
المسيحيّين الذين تحجّج ميور بأثرهم على الرّسول صلىاللهعليهوآله كما أنّ المصادر التاريخيّة لم تشر إلى نصرانيّته في أيّ موضع، زد على ذلك أنّ صهيبا كان من أوائل المؤمنين برسول الله صلىاللهعليهوآله وقد آمن بمعية عمار بن ياسر، فليس من المنطق أن يكون مصدرًا من مصادر المعرفة النبويّة ويؤمن برسالته بَعْدَ بِضْعَةٍ وَثَلاثِينَ رَجُلًا.
فلو كان صهيب الرومي معلّم الرّسول صلىاللهعليهوآله لما توانى عن إعلان ذلك أمام قريش، لينتفع من وراء ذلك لكن صهيبًا أظهر العكس فعندما خرج مهاجرًا في سبيل الله (عزّ وجل) مع أبي ذر الغفاري لحقهم المشركون، فأمّا أبو ذر فانفلت منهم، وأمّا صهيب فأخذوه أهله، فنزل فيه قوله تعالى: (وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ) (سورة البقرة: الآية 207).
كما إنّ هذا المصدر لو كان صالحًا بالفعل لأخذت منه قريش ولحاججوا به الرّسول صلىاللهعليهوآله بدلًا من أن يكلّفوا أنفسهم عناء السفر إلى المدينة بحثًا عن حجج من اليهود؟، فلو كان هذا الغلام مرجعًا علميًّا، فما الذي منع قريشًا من أن تأخذ عنه كما أخذ صاحبهم؟ ولماذا لم ينسبوا تلك العلوم الغريبة عنهم إلى أهلها الموسومين بها من الربّانيّين والأحبار في المدينة أو من القسّيسين والرهبان في الشام، أولئك الذين أفنوا أعمارهم في دراستها وتعليمها؟ أليس ذلك لو كان ممكنًا أو شبيهًا بالممكن أحسن تلفيقًا وأجود سبكًا وأدنى إلى الرواج وأبعد عن الإحالة من نسبتها إلى عبيد مكّة؟.
ولعلّ ما دفع ميور إلى اعتماد أثر العبيد على الرّسول صلىاللهعليهوآله هو نفس ما حمل المشركين الذين كانوا ينكرون نبوّة محمّد صلىاللهعليهوآله فلا مفرّ للقوم من أن ينسبوا شرف تعليم هذا الرجل إلى من حاز علمًا بتلك الأخبار، ولا أقرب إلى فكر المعاند من علماء أهل الكتاب، ولكن أنّى لهم ذاك، وليس في مكّة علماء، فلم يعد عند أهل
مكّة من سبيل لتمرير هذا البهتان غير نسبة هذا العلم والتعليم إلى غلام نصراني اجتمع فيه شرطان، الأوّل: أن يكون من سكان مكّة حتّى يقال إنه كان يلاقي محمّدًا صلىاللهعليهوآله ويملي عليه بكرة وأصيلًا، والثاني: أن يكون من غير جلدتهم وملّتهم لينسبوا إليه من العلم ما لا يعلمون.
والغريب في أمر ميور إغفاله لحقيقة إيمان هؤلاء الموالي بنبوّة محمّد صلىاللهعليهوآله فلو كانوا معلّمين له كيف لهم أن يتّبعوا دينه، وَذَكَرَ القرطبي: «أَنَّ الفاكه بن المغيرة مَوْلَى جَبْرٍ كَانَ يَضْرِبُهُ وَيَقُولُ لَهُ: أَنْتَ تُعَلِّمُ مُحَمَّدًا، فَيَقُولُ: لَا وَاللَّهِ، بَلْ هُو يُعَلِّمُنِي وَيَهْدِينِي».
أمّا عن سورة الروم التي يعرض لها ميور على أنّها خبر نقله الرّسول صلىاللهعليهوآله عن المسيحيّين وليست نبوءة أخبر بها الله تعالى نبيّه تحقّقت في حياته وقد اقترنت بحادثة انقطع عليها الإجماع، عندما غلبت فارس الروم، وفرح المشركون وشمتوا، فنزلت فقال لهم أبو بكر: لا يقرّ الله أعينكم، فوالله لتظهرنّ الروم على فارس بعد بضع سنين فقال له أُبي بن خلف كذبت يا أبا فصيل، اجعل بيننا أجلًا أُناحبك عليه، على مائة قلوص إلى تسع سنين، ومات أُبي بن خلف وظهرت الروم على فارس يوم الحديبيّة، وذلك عند رأس سبع سنين فأخذ أبو بكر الخطر من ذرية أُبي، وجاء به إلى رسول الله صلىاللهعليهوآله فقال: «تصدّق به» وهذه الآية من الآيات البيّنة الشاهدة على صدق النبوّة، وأنّ القرآن من عند الله لأنها إنباء عن علم الغيب الذي لا يعلمه إلا الله، ولا يظهر في سياق الروايات إشارات للعبيد أو لأيّ كتابي، كما أنّ الحدث كان معاصرًا ومن الممكن الحصول عليه من العرب أنفسهم لأنّهم كانوا يكثرون المتاجرة مع الشام، فلا مسوّغ لحصر هذه الحادثة في نطاق تأثير العبيد المسيحيّين.
(353)
يؤمن وليم ميور أنّ الرّسول صلىاللهعليهوآله صبّ اهتمامًا بالغًا بالمسيحيّة إلى درجة اعتقاده أنّه: «إن لم تكن المدينة مَلَاذَ لجوئه الأخير في أرض العرب لكانت وجهته التالية إلى بلاد الحبشة المسيحيّة، ولو حدث ذلك لتضاءلت المحمّديّة وربّما كانت ستتلاشى كما تلاشت المونتانية التي غدت بدعة مسيحيّة عابرة». إنّ المماثلة بين المونتانيّة والإسلام تؤكّد على أنّ ميور نظر إلى الإسلام على أنّه عقيدة وضعيّة منشقّة وجدت طريقها نحو الرواج بفعل توفر الحاضنة الملائمة أي «المدينة»، لقد زعم ميور وجود طائفة من المؤثّرات المسيحيّة التي كان لها دور في صيرورة العقليّة النبويّة؛ ومزاعمه على النحو الآتي:
يزعم ميور: «أنّ المصادر السوريّة كانت الأبرز في صيرورة معارف محمّد»، هذه المعارف التي اكتسبها من خلال رحلتين إلى سوريا، «الأولى حينما كان في سن الثانية عشرة بمعيّة عمّه أبي طالب، وبلغ فيها بصرى أو ربّما أبعد شمالًا، وقد تهيّأت له فيها فرصة الاطّلاع على عبادات وخرافات الكنيسة السوريّة، التي أشبعت تساؤلات مخيّلته اللمّاحة»، أمّا عن الرحلة الثانية فيقول: «سلك محمّد فيها طريق بصرى عينه قبل ثلاثة عشرة عامًا، وكان لها أثر بالغ في تعميق انطباعات الطفولة»، «وخلال مدّة مكوثه في بصرى انتهز الفرصة ليتحقّق من ممارسات
الكنيسة السوريّة ومعتقداتها فحاور الرهبان ورجال الكنيسة الذين صادفهم في طريقه».
ولنا أن نسأل هل يمكن اكتساب مثل هذا الأثر الفردي خلال رحلتين متباعدتين من الناحية الزمنيّة؛ وفي مثل هذه السنّ المبكرة، ومن ثم استيعاب ديانة بكاملها في لقاء عابر؟ كما أنّ الرّسول صلىاللهعليهوآله لم يكن وحيدًا في هذه الأسفار بل كان بمعيّة العديد من الرجال؛ ولو سلّمنا بحدوث هذا التأثير لماذا نستبعد أن لا يكون تأثيرًا جمعيًّا يشمل الباقين، وحينها سيكون هنالك من هم أفقه منه، ولا سيّما بالنسبة للرجال الذين امتهنوا السفر إلى الشام.
إنّ نظريّة ميور توحي بأنّ غاية الرّسول صلىاللهعليهوآله الأولى من سفراته إلى الشام؛ كانت تقصّي أمر المسيحيّة وليس التجارة، وهذا ما يبدو من سياق حديثه عن المحاورات المزعومة مع الرهبان التي توحي بأنّه كان ينفصل عن القافلة لملاقاتهم، الأمر الذي لم يرد له أدنى ذكر في المصادر الأصليّة.
إنّه من المحال في مجرى العادة أن يُتمّ إنسان على وجه الأرض تعليمه وثقافته، ثم ينضج النضج الخارق للمعهود في ما تعلم وتثقف، ليصبح أستاذًا للبشريّة كلّها، لمجرّد أنّه لقي مصادفةً راهبًا من الرهبان، فقد كان هذا التلميذ مشتغلًا عن التعليم بالتجارة، وكان صغيرًا تابعًا لعمّه في المرّة الأولى، وكان حاملًا لأمانة ثقيلة في عنقه فلا بدّ أن يؤدّيها في المرّة الثانية.
فالبعض يشكّك في هذا نظرًا لعدم وجود أيّة إشارة قرآنيّة عن المظاهر الخارجيّة للمسيحيّة، بينما يتكلّم بتوسّع عن أعماق العقيدة المسيحيّة الشرقيّة؛ بما يتناقض تمامًا مع مسلك الشعراء العرب المعاصرين للرّسول الذين زاروا هذه البلاد، وظهرت مثل هذه الإشارات في قصيدهم، فهناك كتاب آخرون اكثر اقترابًا من الحقيقة إذ
يؤكّدون أن رحلات القوافل التجاريّة التي صاحبها الرّسول صلىاللهعليهوآله لم تبلغ أبعد من سوق حباشا بتهامة؛ أو سوق غراش باليمن.
وعلى فرض أنّ الرّسول صلىاللهعليهوآله اتّصل بالمسيحيّة وحصل على مبتغاه؛ فهل كان سيجد أنموذجًا دينيًّا أو أخلاقيًّا صالحًا يمكن أن يؤسّس عليه نظامه الإصلاحي؟
لقد أقرّ جورج. سيل في كتابه «ملاحظات عن الإسلام» باهتراء نسيج المسيحيّة إبّان عصر الرّسول صلىاللهعليهوآله بقوله: «إذا قرأنا التاريخ الكنسي بعناية سنلمس أنّ العالم المسيحي قد تعرّض منذ القرن الثالث الميلادي لمسخ صورته بسبب أطماع رجال الدين والانشقاق بينهم والخلاف على أتفه المسائل والمشاجرات التي لا تنتهي التي كان الانقسام يتزايد بشأنها، وكان المسيحيّون في تحفّزهم لإرضاء شهواتهم واستخدام شتّى أنواع الخبث والحقد والقسوة؛ وقد انتهوا إلى طرد المسيحيّة ذاتها من الوجود بفعل جدالهم المستمر بشأن طريقة فهمها وفي هذه العصور المظلمة بالذات ظهرت بل وثبتت أغلب أنواع الخرافات والفساد».
كما أقرّ ميور بأنّ: «الكنيسة السوريّة كانت تشوبها الخرافات ويومها كانت تستخدم الصور والأيقونات»، كما يرى أيضًا: «أنّ الشّلل كان يدبّ في أوصال الكنيسة المسيحيّة بفعل الانقسام الديني؛ حتّى أنّ الفرقاء كانوا على استعداد لاستقبال أيّ دخيل يخلصهم من خصومهم يومها»، والأغرب أنّ تعبير «سيل» و«ميور» عن حالة الكنيسة يماثل التّصور القرآني عن وضع المسيحيّة عشيّة البعثة النبويّة، فكيف يمكن أن تعدّ الكنيسة السوريّة مصدرًا مؤثّرًا في العقليّة المحمّديّة بعد ذلك؟
كما أنّ مسلك العرب الذين تنصّروا لم يكن أحسن حالًا من مسلك المسيحيّين أنفسهم، فعلى الرغم من تنصّر قبائل العرب في سوريا في الجاهليّة فقد احتفظوا بعاداتهم الوثنيّة القديمة.
ولعلّ ميور وقع في حالة التّناقض مرّة أخرى بإقراره أن: «لا وجود لتأثير مسيحي عملي في التّكوين العقدي والشعائري في الإسلام، على الرغم من عدم وجود بون زمني واسع بين الإسلام والمسيحيّة».
حاول ميور أن يخرج بنظريّة متكاملة عن الأثر السوري المسيحي على العقليّة المحمّديّة؛ وبسط في بيان حيثيّات هذا الاتّصال، وخلص إلى أن هذه الرّحلات تركت الآثار الآتية في مسار الأحداث:
يقول ميور: «شهد محمّد تعاليم المسيحيّة ونقاء طقوسها وشرائعها، وبعد أن تسنّت له فرصة الاطّلاع على الإصلاح والتجديد، لا يمكننا أن نشكّك في إخلاصه في بحثه المبكر عن الحقيقة، ولعلّه اعتنق المسيحيّة ببساطة وأصبح تابعًا مؤمنًا لمعتقد المسيح؛ لكن المفجع حقًّا لم يظهر قساوسة ورهبان سوريا لهذا المتحرّي المخلص سوى نزرًا يسيرًا من هيئة المسيحيّة الجميلة»؛ ويرى أيضًا: «أنّ محمّد كان ملتزمًا بمعتقداته المبكرة مقتفيًا خطى الحق لدى اليهود والمسيحيّين، لذلك غرس في نفوس أتباعه التّعاليم البسيطة؛ فحينها كان القدّيس محمّد واضع الحجر الأساس للكنيسة العربيّة».
إنّ هذا التّصريح يثير الدهشة فلا نعلم له مصدرًا ولا نعلم من أين أتى به ميور، ويبدو أنّه تَرَسّم خُطى الكتّاب القروسطيّين الذين كانوا يتقوّلون على السيرة بلا حرج، ولا سيّما أنّ المبشّرين كانوا يطلقوا لقب مسيحي على كل من يروق في نظرهم وإن لم يرد له ذكر في كتابهم، وإلى ذلك يرى هوارت Huart: «أنّه مهما كان إغراء الفكرة التي تقول بأن تفكير محمّد قد تأثّر بقوّة عندما شهد تطبيق الديانة المسيحيّة بسوريا فإنّه يتحتّم استبعادها نظرًا لضعف الوثائق والأسس التاريخيّة الصحيحة».
ويؤكّد توماس كارلايل ذلك قوله: «نحن سمينا عقيدة محمّد ضربًا من المسيحيّة، لكن لو نظرنا حقًّا إلى ما كان من جدّيته وسرعة محمّد إلى القلوب، لأيقنّا أنّه كان خيرًا من تلك الطوائف السوريّة التي استحكمت فيها الفوضى».
إنّ ما يدعو للدّهشة أن يؤمن شخص بعقيدة يجهلها، وحسب ميور فإن الرّسول صلىاللهعليهوآله: «كان يجهل الإنجيل لدرجة حملته إلى الافتراض بأنّ الإنجيل؛ الشريعة التي تلقّاها المسيح من السّماء التي علّمها لحوارييه الذين شرّعوا بتوثيقها ولعلّ ذلك يعدّ حقيقة ناصعة على أنّه لم يتأثّر بحكمة».
وإذا كان محمّد صلىاللهعليهوآله في مرحلة من حياته معجبًا بالمسيحيّة حدّ اعتناقها، كان حريًّا أن نلمس إشارة لطقوس مسيحيّة في الإسلام، بيد أنّ ميور وعلى الرغم من موقفه، يقرّ بعدم وجود أثر مسيحي على الإسلام: «لم نلمس أدنى أثر لطقس أو شعيرة مسيحيّة في الإسلام أوحتّى من قبيل التلاقح».
أمّا عن مشروع إقامة الكنيسة العربيّة فهذا الرأي ليس إلا سقط متاع ليس له رصيد منطقي، وغير مسند بدليل، لم يرد ذكره في كتب السيرة، ولعلّ ميور تبنّى
الرؤية الكلاسيكيّة التي تَعُدّ الرّسول صلىاللهعليهوآله مسيحيًّا انشقّ عن المسيحيّة وشرع ببناء كنيسته، لكن برؤية جديدة تجعل منه تلميذًا نجيبًا وليس راهبًا منشقًّا، وهنا مكمن خطورة ميور الذي عمد إلى الموائمة بين النظرة المعاصرة وبين إعادة إحياء النظرة القروسطيّة وزجّها بين النّصوص بدعوى أنّها من مصادر إسلاميّة أصليّة.
إنّ إيمان الرّسول صلىاللهعليهوآله بالمسيحيّة بأيّ شكل من الأشكال تعني إيمانه بعقيدة الثالوث، وعقيدة الأبوّة، وعقيدة الصّلب، التي قابلها القرآن الكريم بالإنكار؛ وفق الآتي:
الثالوث في الرؤية المسيحيّة يعني: «إنّ طبيعة الإله الواحد تظهر في ثلاثة خواص في صورة أقانيم متساوية: الأب والابن والروح القدس، بإله واحد، وجوهر واحد، متساوين في القدرة والمجد».
إنّ جوهر الإسلام تمثّله عقيدة الوحدانية المطلقة لله (عزّ وجل) التي أكّدها القرآن الكريم في قولهل تعالى:(قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ﴿١﴾ اللَّهُ الصَّمَدُ ﴿٢﴾ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ ﴿٣﴾ وَلَمْ يَكُن لَّهُ كُفُوًا أَحَدٌ) (سورة الإخلاص الآيات 1-4)، وإنكار ما سواه من المعتقدات فالثالوث يعني أنّ الله مكوّن من ثلاث كينونات منفصلة الأب والابن والروح القدس فاذا كان الله هو الأب وهو الابن فإنّه سيكون أبًا لنفسه وابنًا لنفسه وهذا ليس منطقيًّا.
إنّ عقيدة الألوهيّة في الأناجيل تعني أنّ عيسى ابن اللّه، وكلمة اللّه تحوّلت إلى جسد، وقد فهم اليهود من قول المسيح أنّ «الله أبوه» أنّه يعادل نفسه بالله ولم يكن المسيح الابن الوحيد لله في الكتاب المقدّس، بل أشار العهد القديم إلى آدم، وداود، وإلى سليمان، وتؤمن المسيحيّة بأنّ الله خلق الإنسان ليكون ابنًا له: «أبونا الذي في السموات» و«الله أبو ربّنا يسوع المسيح»، ولكن حالت دون ذلك خطيئة آدم.
لقد جاء القرآن الكريم لينسف هذا التصوّر مُبَيّنًا أنّ الله (عزّ وجل) يتنزّه أن يكون له صاحبة أو ولد، مشدّدًا على بشريّة المسيح وأنّه ليس سوى رسول لله وعبد من عباده المصطفين، جعله الله تعالى حجّة على العالمين بخلقه كما خلق آدم بدون أب بشريّ؛ كما أن مفهوم الأبوة ينطوي على معان تجسيديّة توحي بالجنس والنوع ومعان تشبيهيّة يردّ عليها القرآن: (لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ) (سورة الشورى: الآية 11)؛ تتعارض مع الوحدانيّة المطلقة وتنطوي على إعلان صارخ بالأقانيم الثلاثة، زد على ذلك أنّ الكتاب المقدّس لم يخاطب الإنسان إلّا بصيغة «قال الرب» ولم نلمس صيغة تدل على أبوّة الله للبشر مثل: «قال الأب» مثلًا، أمّا القرآن فقد حدّد مرتبة الانسان بأنّه عبد لربّه، والعبوديّة تنطوي على
معانٍ أسمى تحدّد رتبة المخلوق من سمو خالقه (وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ۖ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ) (سورة الجاثية: الآية 37). جاء الخطاب الإلهي بصيغة (يَا عِبَادِيَ) (سورة العنكبوت: الآية 56)، «وأَصل العُبودِيَّة الخُضوع والتذلُّل؛ كما نقل عن الرسول صلىاللهعليهوآله : لَا يَقُل أَحدكم لِمَمْلُوكِهِ عَبْدي وأَمَتي وَلْيَقُلْ فتايَ وَفَتَاتِي؛ هَذَا عَلَى نَفْيِ الِاسْتِكْبَارِ عَلَيْهِمْ وأَنْ يَنْسُب عُبُودِيَّتَهُمْ إِليه، فإن الْمُسْتَحِقَّ لِذَلِكَ اللَّهُ هُو رَبُّ الْعِبَادِ والعَبيد وَقَوْلُه (عزّ وجل): (وَقَوْمُهُمَا لَنَا عَابِدُونَ) (سورة المؤمنون: الآية 47) أَي دَائِنُونَ. وكلُّ مَنْ دانَ لِمَلِكٍ فَهُو عَابِدٌ لَهُ. فُلَانٌ عَابِدٌ وَهُو الْخَاضِعُ لِرَبِّهِ الْمُسْتَسْلِمُ المُنْقاد لأَمره، وَقَوْلُهُ تعالى: (اعْبُدُوا رَبَّكُمُ) (سورة البقرة: الآية 21)؛ أَي أَطيعوا رَبَّكُمْ، وَالْمُتَعَبِّدُ: الْمُنْفَرِدُ بِالْعِبَادَةِ؛ والمُعَبَّد: المُكَرَّم المُعَظَّم كأَنه يُعْبَد»، أمّا المعنى التوراتي للمحبّة، الرغبة المتلهفة لأجل خير المحبوب والاهتمام العظيم برفاهته، وقد فصّل القرآن الكريم في هذه المسألة في قوله تعالى: (وَقَالَتِ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَىٰ نَحْنُ أَبْنَاءُ اللَّهِ وَأَحِبَّاؤُهُ ۚ قُلْ فَلِمَ يُعَذِّبُكُم بِذُنُوبِكُم ۖ بَلْ أَنتُم بَشَرٌ مِّمَّنْ خَلَقَ) (سورة المائدة: الآية 18)، فلو كانوا أبناء الله وأحبّاءه لما عذّبهم بذنوبهم، وشأن المحبّ أن لا يعذّب حبيبه وشأن الأب أن لا يعذّب أبناءه.
ورد في دائرة المعارف الكتابيّة في بيان صلب المسيح: «أنّ يسوع المسيح مات لأجل خطايانا»، فكلمة الصليب تعني كلّ عمل الفداء الذي أكمله يسوع المسيح بموته، أمّا معتقد «الغفران» فينصّ على أنّ المسيح قاسى ومات على الصليب من أجل أن يخلّص الإنسان من نير الخطيئة.
وقد قوّض الرّسول صلىاللهعليهوآله بنصّ القرآن موت المسيح صلبًا أو قتلًا أو بأي طريقة،
وقد أنكر القرآن أن يكون في صلب المسيح فداء للبشريّة مشدّدًا على أنّ النفس لا تحمل حَمْلَ أُخرى، ولا تُؤخذ نفس بإثم غيرها بقوله تعالى: ( أَلَّا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ ﴿٣٨﴾ وَأَن لَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ ﴿٣٩﴾ وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَىٰ ﴿٤٠﴾ ثُمَّ يُجْزَاهُ الْجَزَاءَ الْأَوْفَىٰ ) (سورة النجم: الآيات 38-41).
أمّا المعلم الثاني من معالم التأثيرات السوريّة فيذكر ميور: «أنّ شعور محمّد بالامتنان لطائفة الرهبان والقساوسة السوريّين الذين أظهروا له العطف وحسن الوفادة، جعله يتحدّث عنهم لاحقًا باحترام في القرآن ويذكرهم بصيغة المدح».
إنّ ما يدعو للدهشة أنّ ميور لم يذكر اسم قسّ أو راهب واحد كان له لقاء ولو من قبيل المصادفة، على الرغم من عدم اقتناعه برواية إرجاع أبي طالب للنبيّ بعد نصيحة بحيرا الراهب بدعوى: «أنّ هذه الرواية غير واقعيّة وأنّها خرافة ملئى بالسخافات» كما أنّه لم يشِر إلى أيّ مصدر إسلامي أو مسيحي يحفظ هذه المحاورات المزعومة مع الرهبان، مع الأخذ بالحسبان إشارته إلى أنّ الرّسول صلىاللهعليهوآله لم يظهر تعاطفًا مع معتقداتهم.
أمّا مديح القرآن لهم فيبدو أنّ ميور عمد إلى خلط المفاهيم؛ إذ لم يرد في القرآن الكريم صيغة مديح بحق الرهبان والقساوسة ما عدا مرة واحدة في الآية 82 من سورة المائدة، وهي من السور المدنيّة، فلو افترض جدلًا أنّ إقرار الرّسول صلىاللهعليهوآله بالامتنان لهؤلاء الرهبان حمله على الثناء عليهم، فالأجدى به أن يذكرهم في السور المكّيّة الأولى، ولعلّ إجماع المفسّرين يكاد ينقطع على أنّ هذه الآية نزلت بحقّ وفد من الرهبان النصارى الذين بعثهم النجاشي إلى الرّسول صلىاللهعليهوآله بعد إيمانهم بنبوّته.
ويبدو أنّ ميور وقع في التناقض بإقراره في موضع آخر بعدم حدوث اتّصال بين الرّسول صلىاللهعليهوآله وبين هؤلاء الرهبان: «لم يحصل اتّصال بين محمّد وبين علماء الإنجيل في أيّ مدّة من حياته، ومن المشكوك فيه ما إذا كان لديه أيّ تصوّر واضح يقود إلى معتقدات يسوع». ولعلّ هذا الرأي يعدّ علامة على حالة من التحوّلات الأيديولوجيّة في خطابه حيال قضيّة الوحي والنبوّة.
يذكر ميور أنّ الرحلات السوريّة طبعت في مخيّلة الرّسول صلىاللهعليهوآله مشاهدات جغرافيّة انعكست لاحقًا في القرآن فيرى: «أنّ السفن التي تنزلق على المياه بمثابة الجبال، تدلّ على صنف أكبر من السفن المعروفة في البحر الأحمر وبالتالي فإنها تشير إلى صورة البحر المتوسط، التي ترسّخت في مخيّلته بفعل سفراته إلى غزّة، تلك الصور الحيّة للعواصف البحريّة والمستمدّة من طبيعة الأمواج والزوابع تعدّ من أفضل المشاهدات البحريّة التي صُورت في القرآن».
لقد تعامل مع هذه القضيّة وفق منهج تخمينيّ يدلّ على محدوديّته في الإحاطة بالمفاهيم الجغرافيّة القرآنيّة، ولا سيّما قصره الإشارة على السفن الكبيرة، لأنّ تصوير القرآن للمشاهد البحريّة لا تدلّ على المشاهدات الشاطئيّة بل كانت أقرب إلى انطباعات ملاح محترف سلخ حياته في أعالي البحار ولا سيّما في تصوير صوت السفن وهي تبحر في المياه: (وَتَرَى الْفُلْكَ مَوَاخِرَ فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِن فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ) (سورة النحل: الآية 14)، أو خلال العواصف البحريّة: ( أَوْ كَظُلُمَاتٍ فِي بَحْرٍ لُّجِّيٍّ يَغْشَاهُ مَوْجٌ مِّن فَوْقِهِ مَوْجٌ مِّن فَوْقِهِ سَحَابٌ ۚ ظُلُمَاتٌ بَعْضُهَا فَوْقَ بَعْضٍ إِذَا أَخْرَجَ يَدَهُ لَمْ يَكَدْ يَرَاهَا) (سورة النور: الآية 40)، (وَإِذَا غَشِيَهُم مَّوْجٌ كَالظُّلَلِ) (سورة لقمان: الآية 32)، فمن البديهيّ أنّ هذا الرأي عار عن
الصحّة لأنّ الذي غاب عن خلد ميور أنّ القوافل المكّيّة كانت تبلغ الشام في فصل الصيف، والعواصف البحريّة الهوجاء في البحر المتوسط تحدث في فصل الشتاء، كما أنّ الجزالة التي يعرض فيها القرآن الكريم للظواهر الجغرافيّة والكونيّة لا تدلّ على صبغة بشريّة، فلو كانت معرفة اعتباطيّة تأتّت من مشاهدات عينيّة أومن مصادر شفاهيّة لتهاوت أمام التطوّرات العلميّة؛ وفي ذلك يرى كراتشكوفسكي: «أنّ المادّة الجغرافيّة في القرآن لا يمكن عدّها انعكاسًا لمادّة عربيّة بحتة دائمًا، وما يزيد في صعوبة تحليل المادّة الجغرافيّة أنّ مغزى القصّة الواردة في القرآن لم يكن واضحًا حتّى لمحمّد نفسه»، وإذا أسّسنا على نظريّة الأثر والتأثّر بشأن أثر البحر المتوسط على النصّ القرآني، أنّى للرسول صلىاللهعليهوآله أن يحيط بمثل هذه المقولات الجغرافيّة المبهمة عن المسارات الفلكيّة للأجرام السماويّة، والإشارة إلى السماوات التي شيّدت بعضها فوق البعض، وهي على هيئة مسالك أو تقف دون عمد، والإشارة إلى المشرقين والمغربين، ووظيفة الجبال التي تجعل الأرض تثبت في حالة من التوازن التي يعدّها كراتشكوفسكي من الآيات الغامضة.
كما أنّ مدينة غزة كانت إحدى المحطّات التجاريّة المهمّة لقوافل مكّة، ولا سيّما وقد دفن فيها هاشم بن عبد مناف وزارها عبد الله بن عبد المطلب، بيد أنّ المصنّفات الإسلاميّة لم تشِر إلى أنّ الرّسول صلىاللهعليهوآله قد بلغها، انطلاقًا من إشارة ابن سعد
الذي عوّل عليه ميور؛ الذي ذكر أن أَسْقُفُ غَزَّةَ جاء إلى النَّبِيِّ صلىاللهعليهوآله بِتَبُوكَ فَقَالَ: «يَا رَسُولَ اللَّهِ هَلَكَ عندي هاشم وعبد شمس وَهُمَا تَاجِرَانِ وَهَذِهِ أَمْوَالُهُمَا قَالَ فَدَعَا النَّبِيُّ عَبَّاسًا فَقَالَ: اقْسِمْ مَالَ هَاشِمٍ عَلَى كُبَرَاءِ بَنِي هَاشِمٍ وَدَعَا أَبَا سُفْيَانَ بْنَ حَرْبٍ فَقَالَ اقْسِمْ مَالَ عبد شمس على كبراء ولد عَبْد شمس».
يعتقد ميور بأنّ الأثر الغنّوصي يمثّل أحد المؤثّرات السوريّة غير المباشرة على العقليّة المحمّديّة إذ يقول في ذلك: «إنّ ثمّة تماثلًا بين ما ذكر في القرآن في نفي صلب المسيح، وكونه مجرّد بشر طبيعي ولد بطريقة عجائبيّة، وبين بعض الهرطقات المسيحيّة المبكّرة ما يحملنا على التخمين أنّ محمدا اكتسب معرفة بالمسيحيّة من معلم غنّوصي، فمن الممكن أنّ بعض الخيالات الغريبّة من جنس هذه الهرطقات حفظت في التراث السوري، بلغته عبر معلّميه»، وعلى الرغم من التّماثل بين ما ورد في القرآن الكريم والأناجيل الغنوصيّة في إنكار صلب المسيح، لكن الغنوصيّة ردّت الصلب لأنّ المسيح من وجهة نظرها لم يكن له جسد، وأنّه كان مجرّد مظهر تُبصِرُه العين دون كيان ماديّ على الحقيقة، كما ذهبت فرق غنوصيّة أخرى إلى ردّ الصلب من باب التمييز بين «يسوع البشر» و«المسيح الإله»، إذ لما صُلب «يسوع البشر» كان «المسيح الإلهي» يشهد الحدث كمتفرّج.
لقد أكّد القرآن الكريم على طبيعة المسيح البشريّة المادّيّة والحسّيّة، ولم يشِر إلى وجود طبيعة ثنائيّة له وصوره في نطاق المنزلة الدنيا من الذات الإلهيّة العليا، وهذا يتعارض تمامًا مع المفاهيم الغنوصيّة، زيادة على أنّ طرح ميور للقضيّة احتمالي ومتناقض إلى حد كبير، ولا سيّما بإقراره: «أنّ الغنوصيّة اضمحلّت من مصر قبل القرن السادس الميلادي وليس هنالك سبب يدعو للافتراض أن يكون لها موطئ قدم في الجزيرة العربيّة في زمن محمد، وبالتالي ليس ثمّة أساس للاعتقاد بأنّ التّعاليم الغنوصيّة تبلورت في ذهن محمد»، ويبدو أنّ هذا الاعتقاد لم يكن من قبيل السذاجة قدر تعلّق الأمر بحالة من الاضطراب بين اعتقاده بالمماثلة بين طقوس الإسلام والغنوصيّة، وبين النتائج التي توصّل لها بشأن عدم وجود تأثير غنوصي في عصر الرّسول صلىاللهعليهوآله لذلك لم يجد سوى أن يخمن بأنّ هذا التراث حفظ في السجلات السوريّة، ولعلّ الفرق الغنوصيّة لم تكن ذات جاذبيّة في القرن السابع الميلادي، فليس هناك مبرّر للاقتباس منها، وقد انتشر في كتب آباء الكنيسة التحذير المركّز من هذه الفرق والتشويه المتعمّد لمقولاتها الدينيّة، زد على ذلك، كان النصارى العرب قلّة ويقطنون في أماكن بعيدة عن مكّة وجلّهم في الشام، كما إنّ الغنوصيّين نزّاعون إلى الانعزال والعيش في منأى عن الناس، وكان لهم ميلٌ صوب التفكير الفلسفي المجرّد بما لا يتّفق مع الطبائع الحياتيّة والعقليّة والعقائديّة لعرب الجزيرة، لذلك فإنّ اعتماد فكرة اتّصال الرّسول صلىاللهعليهوآله بمعلم غنوصي غير موضوعيّة.
يقول ميور: «إذا تتبّعنا قصص القرآن المسيحيّة؛ لا شكّ أنّنا سنلمس أنّ محمدا تمكّن من الاطّلاع والاستعارة من الأناجيل الأبوكريفية، على نطاق واسع وذلك لأنّ القسم الأكبر ممّا ورد من تفاصيل هذه الأناجيل يتطابق دون أيّ وجه حكمة مع ما جاء في القرآن».
كما يرى أنّ من بين هذه الأناجيل، إنجيل برنابا The Gospel of Barnabas، ويقول: «إنّ الانتحال من إنجيل برنابا ليس غريبًا، ومتوقّعًا كونه من الأسفار الحديثة، صُنِفَ من لدن المرتدّين المسيحيّين إلى الاسلام، أمّا إنجيل توما Gospel of St. Thomas الذي يشتمل على كتابات قبطيّة فلدينا منه قصّة نزول المائدة من السماء التي اقتبست بلا شك عن مائدة العشاء الربّاني؛ كذلك هرطقة الباسليديين Heretic Basilides الذي اقتبس منه قصّة قتل شبيه المسيح».
لقد ورد في دائرة المعارف الكتابيّة: «من السهل إعطاء قائمة طويلة بأسماء الأناجيل الأبوكريفيّة، ولكن لا يعلم غير القليل عن محتوياتها، وهذا القليل لا يسمح لنا بأن ننسب لها أيّ قيمة تاريخيّة، فالكثير منها لا نعرف عنه سوى عناوينها مثل إنجيل الباسليديّين، وإنجيل كيرنثوس وإنجيل أبلس، وإنجيل متياس، وإنجيل
برنابا غير الإنجيل الموجود حاليًا»، «ولعلّ السّمة البارزة في الأعمال الأبوكريفيّة ظهور المسيح بأشكال متعدّدة، فمرّة يظهر في هيئة رجل عجوز، ومرّة في هيئة فتى، ومرّة أخرى في هيئة طفل، والأغلب أن يظهر في صورة هذا الرّسول، زد على أنّ الأعمال الأبوكريفيّة لا تخلو من هرطقات، فهي تمثل فكرًا دوسيتيا أي إنّ حياة المسيح على الأرض لم تكن إلّا خيالًا غير حقيقيّ».
وخلافًا لما تفيد به هذه الأناجيل فإنّ القرآن شدّد على بشريّة المسيح ، وكونه رسول لله أسوة ببقيّة الانبياء، كما أنّ القرآن الكريم لم يأتِ على تفصيل مراحل المسيح العمريّة ما عدا الإشارة إلى طفولته من خلال معجزاته.
كما أنّ جميع أسفار الأبوكريفيّة تتخلّلها فكرة الامتناع عن الزواج وعدّها أسمى شرط للدخول إلى الحياة الفضلى وربح السماء، في الوقت الذي يتعارض القرآن مع هذه الحيثيّات ويقرّر مبدأ تعدّد الزوجات، ويرفض الرهبانيّة: ( ثُمَّ قَفَّيْنَا عَلَىٰ آثَارِهِم بِرُسُلِنَا وَقَفَّيْنَا بِعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ وَآتَيْنَاهُ الْإِنجِيلَ وَجَعَلْنَا فِي قُلُوبِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ رَأْفَةً وَرَحْمَةً وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ إِلَّا ابْتِغَاءَ رِضْوَانِ اللَّهِ فَمَا رَعَوْهَا حَقَّ رِعَايَتِهَا ۖ فَآتَيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا مِنْهُمْ أَجْرَهُمْ ۖ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ) (سورة الحديد: الآية 27).
أمّا إنجيل برنابا: «لا يُعلم عنه شيء أكثر من ذلك فلم يتم العثور عليه
حتّى الآن ممّا يحمل على الشكّ في وجوده أصلًا، أمّا إنجيل برنابا المتداول فيعود إلى القرن الرابع عشر، وهو واضح التزييف كتبه أحد المرتدّين عن المسيحيّة في الأندلس، ولا توجد مخطوطاته إلّا في أسبانيا وإيطاليا»، ولعلّ هذه الشهادة تعدّ دليلًا على أنّ إنجيل برنابا لم يكن متداولًا إبّان عصر الرّسول صلىاللهعليهوآله، زد على ذلك أنّه ينطوي على أخطاء كثيرة تجعله مخالفًا للطرح القرآني، بالتالي لا يمكن أن يكون مصدرًا للقرآن، أمّا بشأن الزعم باقتباس النبي صلىاللهعليهوآله من إنجيل توما، وقصّة العشاء الربّاني فإنّ الإشارات التي تفيد بأنّ ما ورد في إنجيل توما عن العشاء الربّاني لا يخرج عمّا ورد في الأناجيل القانونيّة الأربعة: متى -مرقص- لوقا- يوحنا؛ عدا أنّه وصف إقامة فريضة العشاء الرباني (بالخبز فقط دون الخمر)، كما أنّ العهد الجديد لم يشِر إلى أنّ تلاميذ المسيح الذين طلبوا منه آية من السماء كما ورد في سورة المائدة، والقصّة برمّتها في الكتاب المقدّس تتحدّث عن كرامة المسيح، الذي أشبع بطون خمسة آلاف شخص من أتباعه بخمسة خبزات وسمكتين، فلا يمكن الاحتجاج بهذا الرأي بسبب البون الشاسع بين الرؤية الإنجيليّة والرؤية القرآنيّة.
أمّا عن إنجيل الباسليديّين فنسبة إلى باسليدس Basilides، وقد انقطع
الإجماع على أنّ نسخه فقدت جميعها ولم يبقَ منها الآن سوى عناوين، وقد أشارت الموسوعة الكاثوليكيّة أنّ باسليدس يعتقد بأنّ المسيح لم يكن من تعذّب بل كان سمعان القيرواني الذي أكره على حمل الصّليب، وصلب بالخطأ بدلًا من المسيح بعد أن صارت له هيئة المسيح ثمّ وقف المسيح جانبًا هازئًا بهم.
إنّ وجود حالة من التّماثل مع القرآن في هذه القضيّة لا يعني الاقتباس، لأنّ ما جاء به القرآن قطع دابر الخلاف بين المذاهب المسيحيّة بنحو جازم وقرّر عدم حدوث الصلب ليس من قبيل التحيّز لإنجيل الباسليديّين بل لكشف الحقيقة مُبَيّنًا أنّ من اعتقدوا بقتله لم يتيّقنوا من ذلك واتّبعوا فيه الظن، وفي ذلك حجّة دامغة على أصالة المصدر الإلهي للوحي المحمّدي.
لكن كيف وصلت محتويات هذه الأناجيل إلى الرّسول صلىاللهعليهوآله، ولا سيّما أنّ حدوث الأثر يحتّم الاطّلاع على هذه المصادر ومن ثم الاقتباس منها؟، وإذا كان الأحبار والرهبان أنفسهم لا يعلمون عن هذه الأناجيل إلّا شذرات نزرة، فأنّى للرّسول صلىاللهعليهوآله أن يطّلع عليها ولا سيّما وأنّ الإشارات تفيد بأنّ الجزء الأعظم منها كتبت باللغة اليونانيّة أو بالعبريّة أو بالآراميّة، ومن ثمّ ترجمت إلى اللغة اليونانيّة، ولم يترجم أيّ سفر من الأسفار الكتابيّة إلى اللغة العربيّة إلّا بعد انتشار الإسلام وتحديدًا من النّصف الأوّل من القرن 2ه/ 8م، وهناك رأي مؤدّاه أنّ أقدم ترجمة للكتاب المقدّس تعود إلى عام 19ه/ 639م عندما طلب عمر بن سعد بن أبي وقّاص من البطريق يعقوبي يوحنا أن يضع ترجمة للإنجيل، وفي عام 134ه/ 750م ترجم الأسقف يوحنّا الكتاب المقدّس بعهديه في مدينة إشبيليّة، كما ترجم الكتاب المقدّس في عام 254ه/ 867م من اللغة السريانيّة إلى العربيّة وتسمّى هذه النسخة بالتّرجمة السينائيّة.
ويرجّح شبرنجر احتماليّة ترجمة العرب للكتاب المقدّس قبل الإسلام، لكن ليس هنالك أيّ أدلّة علميّة دامغة تؤكّد أنّ القصص الواردة في التوراة والإنجيل نقلت إلى العرب قبل الإسلام لأنّ المصادر قد أُخذت من قصص كعب الأحبار ووهب بن منبّه وغيرهما من علماء اليهود الذين أسلموا وأسهموا في إدخال الإسرائيليّات إلى التّفاسير القرآنيّة.
ويتساءل المستشرق بوش: «من هو القادر في تلك المرحلة الحالكة على وضع نصّ كهذا فهذا الوحي المدّعى استقلاليّته عن كتبنا المقدّسة يضمّ على الرغم من هذا فقرات وآيات أرقى كثيرًا من أيّة بقايا أدبيّة تعود للقرن السابع، فستظلّ مسألة حقيقة القرآن مسألة لا حلّ لها إلى الأبد، فليس لدينا أدلّة حاسمة على تاريخ وضع القرآن، ولا نعرف إلى أيّ مدى كان محمّد عارفًا بالكتب المسيحيّة المقدّسة».
أمّا مونتغمري وات فيرى: «ثمّة العديد من الأسباب تحملنا للاعتقاد بأنّ محمدًا لم يكن قد قرأ الكتاب المقدّس أبدًا، أو أيّ كتاب آخر، فلو صحّ وجود نسخة من الإنجيل في مكّة وجب أن تكون نسخة سيريانيّة، على الرغم من أنّ بعض الباحثين الغربيّين جنحوا إلى اعتماد مسألة ترجمته إلى العربيّة، وهذا مستحيل من الناحية العمليّة لأنّ ذلك العهد لم يشهد تناميًا لأدب نثري من أيّ طراز، وإذا كان رجل كورقة أو أيّ معلم مزعوم لمحمّد قد قرأ هذه النّصوص ستكون على الأرجح بالسريانيّة».
ويرى تسديل Tisdall: «أنّ أسلوب اللغة العربيّة لبعض الأناجيل الأبوكريفيّة لا يدع لنا مجالًا للشكّ أنّها تُرجمت من لغتها القبطيّة الأصليّة إلى العربيّة، ومن العسير أن نؤمن بأنّها تعود إلى المرحلة التي عاصرها محمد»، ولا ريب في أنّ هذا الرأي حجّة على عدم توفّر نصوص الأسفار الأبوكريفيّة باللغة العربيّة.
أمّا رودويل Rodwell فيقطع هذا الجدل بقوله: «ليس لدينا في الحقيقة أيّة سلطة تاريخيّة لنفترض أنّ التّعاليم الهرطقيّة كانت تُعلّم في شبه الجزيرة العربيّة إطلاقًا، من جهة أخرى فمن المؤكّد أنّ الباسيليدين والطوائف الغنوصيّة قد تلاشت منذ منتصف القرن الخامس، وقد تلاشت من مصر قبل القرن السادس»، ويبدو أنّ ثمّة إفراط من جانب وليم ميور في تضخيم إحاطة الرّسول صلىاللهعليهوآله بالنّصوص الكتابيّة والأسفار الأبوكريفيّة، في عصر قد تلاشت فيه هذه الهرطقات.
إنّ كثرة هذه الأسفار المدّعى مصدريّتها، وتنوّع أصولها: قبطي، سرياني، يوناني، ولاتيني، يدعو إلى الدّهشة والتّساؤل بشأن قدرة الرسول صلىاللهعليهوآله على الإحاطة بها، مع ما افتُرض أيضًا من إحاطته بما جاء في الأناجيل الرسميّة التي لم تعرف لها أيضًا ترجمة عربيّة في زمانه، فلو أنّ تلك الأسفار كانت مشتهرة في البيئة العربيّة إبّان القرن 1ه/ 7م لكان المسيحيّون الأوائل الذين عاشوا داخل الدولة الإسلاميّة وكتبوا مؤلّفاتهم في السرّ وصنّفوا كتاباتهم ضدّ الإسلام بدعم من الباباوات والأباطرة، أول من ادّعى ذلك لكنّهم لم يفعلوا .
وَالذي يدعو للدّهشة النتيجة التي توصّل إليها ميور من دراسته لهذه القضيّة بقوله: «أنا أرفض فكرة حيازة محمّد على فرصة الولوج إلى الأناجيل الأبوكريفيّة لكن ثمّة مصادفة ملحوظة بأنّ ثمّة قاسمًا مشتركًا بين الأناجيل والمصادر التي استقى محمّد معارفه منها وهذه المصادر كما أعتقد هو التّراث الدّارج في جنوب سوريا».
إنّ عرض ميور لهذه القضيّة يدلّ على عدم حيازة لأيّ قرينة تاريخيّة، والأمر برمّته معقود على المصادفة وافتراض التشابه بين مصادر النبيّ المزعومة وبين هذه الأناجيل، هذا الرأي الذي يتعارض مع المدخل الذي عرض له للموضوع وتثبته من مسألة اطّلاع النبيّ على المصادر؟ ولعلّ هذا يعدّ دليلًا دامغًا على أنّ ميور يكيل الأمور بمكيالين وفق منهج متضارب يخلو من الوحدة الموضوعيّة.
نقل ميور عن المستشرق شبرنجر Springer قوله: «ورد في التّرجمة الفارسيّة لكتاب الطبري أنّ خديجة كانت تقرأ النّصوص المقدّسة، ولم يرد ذلك في النسخة الأصليّة العربيّة»، كما عوّل ميور على مسيحيّة زيد بن حارثة من خلال اعتقاده بانتشار المسيحيّة في القبائل التي ينحدر منها زيد بن حارثة من جهة الأب والأم: «ولما كان زيد قد اقتطع من موطنه في مرحلة مبكّرة من حياته، وحمل معه بالتالي بعض الانطباعات عن تعاليم المسيحيّة أو بعض القطع المتناثرة من حقيقة أو أسطورة المسيحيّة، فذلك ربّما شكّل موضوعات للتحاور بينه وبين والده بالتبنّي الذي كان عقله يبحث في شتّى الاتّجاهات عن الحقيقة الدينيّة»، ويرى ميور أنّ «لمارية القبطيّة أثر ظهر في القرآن ولا سيّما في قصص المسيح والتكلّم بالمهد وهبة الحياة إلى طير مصنوع من الطين».
أمّا رواية النّسخة الفارسيّة للطبري فيبدو أنّ الغاية من إيراد هذه المداخلة التاريخيّة الإشارة إلى إمكانيّة عدّ خديجة عليهاالسلام عنصرًا مؤثّرًا آخر في صيرورة المعارف الكتابيّة للوحي، فيبدو من سياق الجملة أنّ ميور يعرض لهذا الفرض بمنطق خجول لتيّقنه من ضعفه لكنه لا يدّخر وسعًا في إيراد أيّ نصّ يقيم عليه حجّته حتّى لو كان لا يستند إلى دليل، فلا يمكن التّسليم بهذا الفرض بسبب ضعف المصدر ولعلّ سيرة أمّ المؤمنين خديجة عليهاالسلام معروفة للجميع ولم تكن موضع خلاف تاريخي فلو صحّ هذا النّص لبات خبرًا شائعًا في كتب السيرة، ولو كانت محيطة بهذا التّراث، فلماذا أقدمت على أخذ المشورة من ورقة بن نوفل بشأن الوحي.
ولعلّ القاعدة الأولى التي حملت ميور على تبنّي فكرة تأثّر الرّسول بمسيحيّة زيد
بن حارثة، رواية ابن سعد التي أشار فيها إلى أنّ زيدًا كان يصغر الرّسول صلىاللهعليهوآله بعشر سنوات، وبالتالي يكون مجال التأثّر جائزًا، لكن هذا الاستنتاج ليس منطقيًّا، لأنّ الرّسول صلىاللهعليهوآله تبنّى زيدًا كابن له بعد أن اختار أن يبقى بصحبته بدل اللّحاق بأبيه، بعد أن خيّره الرّسول صلىاللهعليهوآله بين اللحاق بأبيه وبين البقاء عنده وقال في حقّه «يا من حضر اشهدوا أن زيدًا ابني أرثه ويرثني»، فَدُعي زَيْد بْن محمّد حتّى جاء الله بالإسلام، وبالتالي لو صحّ هذا التّقارب العمري لكانت الأخوة عنوانًا للرابطة الجديدة، وما يؤكّد أنّ زيدًا كان غلامًا صغيرًا عندما وهبته أم المؤمنين خديجة إلى الرّسول صلىاللهعليهوآله كما ذكر ابن هشام: «إنّ حَكِيمُ بْنُ حِزَامِ بْنِ خُوَيْلِدٍ قَدِمَ مِنْ الشَّامِ بِرَقِيقٍ، فِيهِمْ زَيْدُ بْنُ حَارِثَةَ وَصِيفٌ فَدَخَلَتْ عَلَيْهِ عَمَّتُهُ خَدِيجَةُ بِنْتُ خُوَيْلِدٍ، وَهِيَ يَوْمئِذٍ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صلىاللهعليهوآله، فَقَالَ لَهَا: اخْتَارِي يَا عَمَّةُ أيّ هَؤُلَاءِ الْغِلْمَانِ شِئْتِ فَهُولَكَ، فَاخْتَارَتْ زَيْدًا فَأَخَذَتْهُ، فَرَآهُ رَسُولُ اللَّهِ صلىاللهعليهوآله عِنْدَهَا، فَاسْتَوْهَبَهُ مِنْهَا، فَوَهَبَتْهُ لَهُ، فَأَعْتَقَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلىاللهعليهوآله وَتَبَنَّاهُ».
القاعدة الثانية افتراضه أنّ زيدًا كان يحمل معتقدات مسيحيّة نظرًا لانتشار المسيحيّة في قبيلته، فهذا الرأي ليس سوى إسراف في منهج الأثر والتأثّر، لأنّ جميع مصادر السيرة لم تذكر عقيدة زيد قبل تبنّيه ولم تشِر إلى أنّه كان مسيحيًّا أو كان له اطّلاع على المسيحيّة، على الرغم من أن قبيلته (قضاعة-كلب) كانت من القبائل التي اعتنقت المسيحيّة، ولعلّ ذلك يرتدّ إلى أنّه كان غلامًا صغيرًا كما أورد ابن هشام، ولو افترضنا جدلًا أنّ قبيلة زيد تأثّرت بالنصرانيّة فذلك لا يعني أنّ المسيحيّة قد استحكمت فيها ولا سيّما وأنّ ميور أقرّ في موضع سابق بأن نطاق التّأثير المسيحي كان محدودًا على العرب، وكما لم يرد أيّ دليل تاريخي على اعتناق فرد من أفراد أسرة زيد الديانة النصرانيّة؛ ما يقطع بعدم صحّة هذه الافتراضات.
ويرى ساسي: «أنّ مسألة تأثير زيد بن حارثة على الرّسول صلىاللهعليهوآله ما هو إلّا افتراض تعسّفي خال من كل منطق سليم أو دليل علميّ سائغ والمبنيّة على سوء نيّة مبيّتة لنفي كل أصالة عن الديانة الإسلاميّة وكتابها المقدّس، وإلّا كيف يعقل أنّ طفلًا صغيرًا من قبيلة كلب القاطنة في أطراف الصحراء العربيّة التي يشتغل أفرادها برعي الأغنام أو كأدلّاء للقوافل التجاريّة أن يتبحّر في الديانة المسيحيّة وأن يستوعبها من مظانّها وأن يتشرّب تعاليمها ليستقي منه الرّسول صلىاللهعليهوآله معارفه ومعلوماته عن الديانة المسيحيّة ومذاهبها وعقائدها وطقوسها وتعاليمها التي يعجز عنها المتخصّصون؟ ثمّ لو كان الأمر كذلك لما سكتت قريش عن التّنديد بهذه العلاقة الثقافيّة المزعومة وقد فعلت ذلك بالنسبة إلى الآخرين الذين افترضت أنّ الرّسول كان يستقي معارفه منهم».
كذلك لا يجوز الاحتجاج بوجود أثر لمارية القبطيّة على الرّسول صلىاللهعليهوآله، لأنّ قصّة مارية ينقطع عليها إجماع أهل السيرة، إذ كانت هبة المقوقس إلى الرّسول صلىاللهعليهوآله في مرحلة متأخّرة من البعثة النبويّة وتحديدًا في السنة 7ه/ 629م، حينما كان الرّسول صلىاللهعليهوآله يدعو الملوك والحكّام إلى الإسلام، ولو فُرض جدلًا أنّ مارية تركت أثرًا على وحي الرّسول صلىاللهعليهوآله سيكون الادّعاء ممكنًا إذا اقتصر الأمر على ما ورد في سورة المائدة المدنيّة من ذكر لحديث المهد وقصة الطير، لكن هذا الزعم لا يستقيم لأنّ الإشارة الأولى عن حديث المهد، وردت في القرآن الكريم في سورة مريم المكّيّة أي قبل تسري النبي صلىاللهعليهوآله بمارية، وقد تكرّرت هذه القصص في سورة آل عمران، من ثمّ
وردت تباعًا في سورة المائدة والمشهور، عند جمهور المسلمين أنّ سورة آل عمران نزلت قبل السنة 7ه/ 629م وفقًا لرأي ميور الذي يرى أنّ هذه السورة أتت على ذكر معارك المسلمين الأولى بدر وبدر الثانية ومعركة أحد.
كذلك فإنّ قصّة المهد وحادثة الطير لم تكن من الأسرار التاريخيّة حتّى تكون معرفتها وقفًا على مارية دون أهل الكتاب في المدينة، زد على ذلك لم يرد في ترجمتها أنّها كانت بمستوى كهنوتي يجعلها تحيط بمثل هذا التّأثير لكي نلمس ذلك على مخيّلة الرّسول صلىاللهعليهوآله الذي تصدّى إلى جهابذة علماء اليهود في المدينة؟ إنّ هذا الرأي يفتقر للمعايير الواقعيّة والمنهجيّة جاء نتيجة إسراف بمنهج الأثر والتأثّر؛ ما جعله يستشعر أنّ كلّ شيء مسيحي كان في محيط محمّد صلىاللهعليهوآله ترك أثرًا على عقليّته النبويّة.
يذهب ميور إلى وجود مستوطنات مسيحيّة في قلب الجزيرة العربيّة، سلخ أفرادها وقتهم في تداول الخرافات «وكان النبّي وقتها يستمع لأحاديثهم بسرور حتّى غدت مصدرًا لكثير ممّا لمسناه في القرآن»، «فلدينا قصّة الكهف الخياليّة مع النيام السبعة الذين رقدوا لمدّة طويلة، وهناك قصص لا حصر لها عن مريم العذراء في القرآن تنطوي على تفصيلات عن حنّا أم مريم، وعن طفولتها لما كانت الملائكة تأتيها بالطعام في المعبد».
إنّ اللافت في الأمر، الثقة التي يتحدّث بها ميور في عرض هذه القضيّة وعن صلة الرّسول صلىاللهعليهوآله بالقبائل المسيحيّة، وكيفيّة استماعه لخرافاتهم فكأنّه يقتبس مادّته من
وثائق أصيلة، ولو كان بحوزته ما يثبت ذلك لما تردّد في الإشارة إليها، لكن افتراضاته ليس لها أي رصيد علميّ، لقد أفاضت مصادر السيرة في بيان حياة الرّسول صلىاللهعليهوآله ولم تشِر إلى أنّه كان يتّصل بأي قبيلة مسيحيّة، فلا يمكن أن تكون هذه القبائل موردًا لوحي الرّسول صلىاللهعليهوآله، وذلك لندرة القبائل المسيحيّة في محيط مكّة وتناثرها في محيط بعيد نسبيًّا عن مسقط رأسه مكّة على الرغم من أنّ تاريخ وصول المسيحيّة إلى الحجاز يرجع إلى بعثة الرّسول برتلماوس أو «ابن تلما» أحد رسل السيد المسيح، لكن تأثير المسيحيّة لم يكن يذكر، وقد أقرّ ميور بذلك قائلًا: «بعد خمس قرون من التبشير بالمسيحيّة، بالكاد يمكن الإشارة إلى بعض المتنصّرين هنا وهناك من بني الحارث في نجران، وبني حنيفة في اليمامة، ورهط من بني طيء في تيماء».
لا ريب في أنّ شهادة ميور تدل على عدم تأثّر مدينة مكّة بالمسيحيّة على الرغم من اعتقاد بعض المستشرقين ومنهم جب Gibb بأنّ القوافل التجاريّة التي كانت تنقل التوابل بين اليمن وبين مكّة حملت كذلك مؤثّرات مسيحيّة واضحة إلى مكّة.
لقد تضافرت جملة من الفواعل كانت وراء دخول الديانة المسيحيّة إلى الجزيرة العربيّة كان أبرزها التّبشير المسيحي، وذلك بدخول بعض الرهبان إليها، الذين تمكّنوا من نشر المسيحيّة بعد اكتساب قلوب بعض القبائل عن طريق إتقانهم بعض المعارف الطبيّة والمنطقيّة، كما دخلت عن طريق التّجارة ولا سيّما تجارة الرقيق، وكان للأديرة المقامة في أطراف الصحراء تأثير مهمّ في تعريف التّجار العرب والأعراب بالنصرانيّة، فقد وجد التّجّار في أكثر هذه الأديرة ملاجئ يرتاحون فيها.
لقد كانت المسيحيّة التي ظهرت في الجزيرة العربيّة عشيّة عصر ظهور الرّسول صلىاللهعليهوآله
تؤمن بعقيدة التّثليث، والتّجسّد، والإيمان بالأناجيل الأربعة القانونيّة، الأمر الذي يقطع بعدم وجود أثر مسيحي على النصّ القرآني الذي أقام دعائمه على عقيدة الوحدانيّة المطلقة، وأحلّ التّنزيه بدل التّجسيد، واستبدل الأناجيل بكتاب واحد.
ويرى ريتشارد بيل Richard Bell: «على الرغم من وجود روايات تفيد باكتشاف صورة للسيد المسيح رسمت على أحد أعمدة الكعبة، بيد أنّه لا توجد حجّة قويّة على انتشار المسيحيّة في الحجاز أو في مكان جوار مكّة أو حتّى المدينة».
لقد كانت هنالك ثلاث جماعات تحمل لواء المسيحيّة العربيّة زمن ظهور الإسلام، وهم: الغساسنة ومقرّهم في الشام على مسافة بعيدة عن مكّة وقد كانوا يعيشون حالة من عدم الاستقرار، إبّان البعثة النبويّة، بعد هدم الفرس لدولتهم عام 614م، وأهل نجران في شمال اليمن، ولا يعرف لهم سلطان أدبي أو ديني على أهل مكّة، والمناذرة، وقد عاشوا في الحيرة في العراق، وكان تنصّرهم في آخر القرن السادس ميلادي، علاوة على أنّ المذهب اليعقوبي لم يكن معروفًا عند أهل مكّة.
أمّا عن يثرب فإنّ النّصارى كانوا يسكنون في موضع يقال له: سوق النّبط الذي كان ينزل فيه نبط الشام الذين يقصدون المدينة للاتّجار في الحبوب، فصارت موضعًا لسكنى هؤلاء النصارى، ونسب إليهم، فذلك شاهد على انعزال المسيحيّين عن المجتمع اليثربي الأمر الذي يوحي بعدم وجود مؤثّرات مسيحيّة حقيقيّة.
إنّ دعوى اقتباس القرآن من النصرانيّة لا تقوم على أسس حقيقيّة وليس أدلّ من شهادة الكاتب البريطاني إسحاق تايلور Isaac Taylor عن أحوال المسيحيّة في جزيرة العرب عشيّة البعثة المحمّديّة وما تلاها بقوله: «إنّ ما أسّس له
محمّد وخلفاؤه في كل اتّجاه حيثما حلّت سيوفهم المعقوفة قطعوا الطريق على خرافات منفرّة، ووثنيّة منحطّة ومخجلة وكنيسيّة مغرورة، وطقوسًا دينيّة منحلّة وصبيانيّة».
ويبدو أنّ ما أشار إليه ميور في هذه القضيّة ليس سوى كلام عام ودعائي، لأنّ وجود القصص في القرآن لا يبرهن على أنّ الرّسول صلىاللهعليهوآله أخذها من النصارى، كما أنّ القرآن الكريم لم يشِر إلى والدة مريم إلا في مسألة نذرها لله (عزّ وجل)، وقد أخبر عنها بصيغة امرأة عمران ولم يسمها بحنّا، أمّا عن مريم فلم يشِر القرآن إلى أيّ تفصيلات مسهبة عن حياتها كما يزعم ميور ما عدا ما ورد في سورة آل عمران في قضيّة ولادتها أنثى على غير ما كانت ترجو والدتها، وكفالة زكريا لها، ورزقها الذي كان يأتيها من عند الله تعالى، والموضع الثاني ورد في قصّة حملها وولادتها للمسيح وحوارها مع الروح القدس.
أمّا قصّة النيام أو أصحاب الكهف فلا يمكن الاحتجاج بأنّ الرّسول صلىاللهعليهوآله أخذها عن قبائل المسيحيّة، لأنّ هذه السورة تحديدًا تصنّف من بين السور القليلة التي نزلت على الرّسول لإلجام الأفواه المتحدّية من قريش، إذ نقل السيوطي عن ابن عباس قوله: «بعثت قريش إلى أحبار اليهود بالمدينة... فسألوا أحبار اليهود عن رسول الله صلىاللهعليهوآله ووصفوا لهم أمره وبعض قوله فقالوا لهم: سلوه عن ثلاث فإن أخبركم بهن فهو نبي مرسل وإن لم يفعل فالرجل متقوّل، سلوه عن فتية ذهبوا في الدّهر الأوّل ما كان أمرهم فإنه كان لهم أمر عجيب وسلوه عن رجل طواف بلغ مشارق الأرض ومغاربها ما كان نبؤه، وسلوه عن الروح ما هو... فجاءوا رسول الله صلىاللهعليهوآله فسألوه فقال: أخبركم غدًا بما سألتم عنه، فانصرفوا ومكث رسول الله صلىاللهعليهوآله خمس عشرة ليلة لا يحدث الله في ذلك إليه وحيًا ولا يأتيه جبريل حتّى أرجف أهل مكّة حتّى أحزن
رسول الله صلىاللهعليهوآله مكث الوحي عنه وشقّ عليه ما يتكلّم به أهل مكّة ثم جاءه جبريل من الله بسورة أصحاب الكهف فيها معاتبته إيّاه على حزنه عليهم وخبر ما سألوه عنه من أمر الفتية والرجل الطواف وقول الله ويسألونك عن الروح».
ويبدو من سياق الرواية أنّ قصّة أصحاب الكهف كانت من بين الحوادث التاريخيّة التي يحتكرها أحبار اليهود ولم تكن معلومة متداولة بين أوساط الكتابيّين وإلا لما استخدمت أحجيةً لامتحان الرّسول صلىاللهعليهوآله.
ودون أدنى ريب فإن حادثة نزول هذه السورة تعدّ حجّة دامغة على أنّ الوحي ليس ابتداعًا محمديًّا بل هو وحي من عند الله تعالى، فلو كان من عند الرّسول صلىاللهعليهوآله لما تريّث كل هذه المدّة حتّى أرجفت القلوب.
إن إسراف ميور في الافتراضات حمله بعيدًا عن الموضوعيّة فاختياره لهذه الذريعة التاريخيّة يدلّ على محدوديّته في الإحاطة بالبعد الظرفي لآيات القران والذي انعقد عليه اتّفاق أهل السيرة.
ولعلّ ما جرى بين الرّسول صلىاللهعليهوآله وبين وفد نجران وأمر المباهلة التي دعاهم إليها الرّسول صلىاللهعليهوآله، دليل على ضعف رؤية ميور؛ فلو كان للقبائل المسيحيّة كقبيلة نجران أو سواها تأثير على صيرورة النبوّة أو أنّه انتحل منها أو من غيرها، لما توانوا عن كشف ذلك أمام الملأ، وما كانوا قد انسحبوا من المباهلة أو كما أعرضوا عن دفع الجزية؟
(383)
قلّما تحدّث مستشرق عن القرآن فأغفل أنه مستقى من اليهوديّة، حتّى عُدّ الإسلام يهوديّةً مهذّبةً، لقد عكف ميور على صياغة نظريّة عن الأثر اليهودي في صيرورة العقليّة النبويّة منذ فترة مبكرة من حياة الرّسول صلىاللهعليهوآله قائلًا: «كان محمّد في صغره يمعن النظر في يهود المدينة، ويسمع من كنيسهم، وقد تعلّم أن يحترمهم كأناس يخشون الرب»، ويرى: «أنّ محمدًا كانت تجمعه صلة باليهود منذ فترات مبكّرة من حياته حتّى غدت سببًا في إحاطته بتاريخهم، بل إنّ ما يظهر في القرآن من تفصيلات دليل على اضطلاعه بصلة وثيقة مع بعض الأعلام اليهود ولا سيّما في مرحلة ما قبل الهجرة»، ويرى أيضًا: «وتحت إغراء الإسلام تمكّن محمّد من استمالة العديد من اليهود إلى صفة من الذين كانت لهم إحاطه بالنّصوص المقدّسة، التي عكفوا على تزييفها من أجله»، و«كانت لهم معرفة بسيطة لكنّها على قدر من الشموليّة للإحاطة بالتّاريخ اليهودي المحرّف، وبفعل بعض الخرافات الرهبانيّة، التي نمّقتها مخيّلة النبيّ لتغدو قسمًا رئيسيًّا من القرآن»، ويرى أيضًا: «أنّ المنحرفين عن الديانة اليهوديّة من أصحابه كان لهم فضل في تعريفه بنبوءات النبي القادم»، «وتأكيد قائمة النّسب التي أوردتها نصوص التوراة والتراث العبري في محاولة للتوفيق بين التراث العبري في التوراة والأفكار المغروسة في الذهنيّة العربيّة».
إنّ السّمة الطاغية على منهج ميور في هذه القضيّة ظهور عبارات أيديولوجيّة
غريبة عن الوقائع التاريخيّة ولا سيّما في سياق حديثه عن أثر اليهوديّة على مخيّلته التي يقطع بها بصيغة: «لا شك في التّأثير العميق عليه أو العبارة الأغرب: «تعلم احترام اليهود كأناس يخشون الرب».
إنّ السّياق الذي يعرض فيه ميور هذه القضيّة يصوّر الرّسول صلىاللهعليهوآله معجبًا بالتّراث اليهودي ورجاله بسبب مشاهداته العينيّة وسماعه وتعلّمه احترامهم، لكنّ الحوادث التاريخيّة أظهرت أنّ العلاقة بين العرب واليهود في يثرب كانت علاقة احتقار وتنازع متأصّل بين الطرفين كما تمّت الإشارة إلى ذلك سالفًا، ولو كانت النظرة إلى اليهود كما يزعم ميور نظرة قوم يخشون الله تعالى لكان الأثر اليهودي الديني على العرب ملموسًا، وقد أقرّ ميور بعجزهم عن التّأثير الديني في القبائل العربيّة في يثرب.
ولعلّ التّأثيرات اليهوديّة على البيئة المكّيّة والبيئة العربيّة كانت محدودة بنحو عام، فالقرآن الكريم يقول عن قسم من أهل الكتاب: (وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِيَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ) (سورة البقرة: الآية 78)، ويعززه قول ابن خلدون: «إنّ أهل التّوراة الذين بين العرب يومئذ بادية مثلهم ولا يعرفون من ذلك إلّا ما تعرفه العامّة من أهل الكتاب»، فلا غرو أنّ قومًا مستواهم الفكري بمثل هذه الضآلة لا يمكنهم أن يؤثّروا في الإسلام هذا التّأثير كلّه.
لقد انقطع إجماع أهل السيرة على أنّ هناك رحلة وحيدة قام بها الرّسول صلىاللهعليهوآله إلى يثرب في صغره قبل الهجرة بمعيّة أمّه السيّدة آمنة بنت وهب وأم أيمن لزيارة قبر أبيه وزيارة أخواله بني عدي بن النجار وهو ابن ست سنوات وقد استمرّت شهرًا واحدًا، ولم يرد عن الرّسول صلىاللهعليهوآله أنّه شاهد كنيسًا يهوديًّا أو عبادة يهوديّة خلالها عدا
ذكريات طفولة تتلاءم مع عمره الطبيعي يومذاك، وليس كما يذهب ميور إلى تصوير مشاهداته أنّها مشاهدات شخص باحث عن حقيقة دينيّة، إلّا إذا كان قد زار هذه المعابد في سن يسمح له بالتأمّل الروحي، وهذا غير وارد في الأثر، كما أنّ اليهود كانوا يقيمون في أطراف المدينة في حصونهم وآطامهم بمعزل عن العرب، وكان أخواله بنو عديّ بن النجار من قبائل الخزرج التي كانت تقطن مركز المدينة وإلى الغرب والجنوب منها، ولو افترضنا صحّة ما ذهب إليه ميور فينبغي على الرّسول صلىاللهعليهوآله أن يشرع بزيارة خاصّة إلى هذه الكنائس، وبالتالي فإنّ كلام ميور اختلاق ليس له رصيد واقعي.
فليس من مسوّغ من جانب ميور لتعليل هذا الزّخم من التّفصيلات التاريخيّة عن اليهود في القرآن سوى أنّها مستوحاة عن مصادر بشريّة يهوديّة مقرّبة من الرسول صلىاللهعليهوآله، بالتالي فإنّ جزءًا كبيرًا من نظريّة ميور بشأن الأثر اليهوديّ تعدّ خلاصات غير موضوعيّة تجلّت عندما بلغ المنهج المادي منتهاه لدى ميور في سعيه لتفسير ظاهرة الوحي، من خلال تسطيح المتون التاريخيّة كي تكون متّسقة مع طروحاته.
كما أنّ المصادر التاريخيّة لم تذكر أنّ الرّسول صلىاللهعليهوآله كانت له رفقة مقرّبة من اليهود لهم إحاطة بمثل هذه المعارف والتّفصيلات؛ كما أنّ الأمانة العلميّة تحتّم على ميور أن يذكر أسماء هؤلاء الأصحاب، ولو صحّ ذلك لما توانت قريش عن استخدام ذلك لتكذيب نبوّته ولا سيّما أنّها كانت تبعث إلى اليهود ليأتوا بأمور تعجيزيّة يطرحونها عليه.
إنّ اتّصال الرّسول صلىاللهعليهوآله باليهود لم يحدث بنحو مباشر إلّا في يثرب، أمّا في مكّة، فلم
يكن لليهود فيها شأن يذكر، فلم يكن لأهل مكّة إحاطة بتعاليم اليهوديّة، إذ نقل عن ابن عباس، عن الرّسول صلىاللهعليهوآله قوله: «قدم النبي صلىاللهعليهوآله المدينة فرأى اليهود تصوم يوم عاشوراء، فقال: ما هذا؟ قالوا: هذا يوم صالح، هذا يوم نجّى الله بني إسرائيل من عدوّهم فصامه موسى، قال: فأنا أحقّ بموسى منكم فصامه وأمر بصيامه»، ولعلّ هذا برهان على أنّ الاحتكاك باليهود كان في المدينة وليس بمكّة.
ولم يتنزّل من القرآن في العهد المدني غير 28 سورة بعد أن نزل بمكّة قبل الهجرة 86 سورة ولعلّ المتأمّل في النّص القرآني يلمس أنّ السور المكّيّة تعرض أطول قصص التوراة بتفاصيلها الدقيقة، ولم تترك للسور المدنيّة سوى فرصة استخلاص الدروس منها، وغالبًا في تلميحات موجزة، بالتالي فلو صحّ نطاق التّأثير اليهودي على القرآن لكان بارزًا في العهد المدنيّ وليس في الفترة المكّيّة.
كما أنّ قرآن المرحلة المكّيّة طالب أهل الكتاب بالإدلاء بشهادتهم، واتّهامهم بأنّهم يبترون الكتب تارة فيظهرون بعضها ويخفون بعضها، وفي مقابل هذا احتفظ القرآن في المدينة بموقفه من العلماء الذين يستشهد بهم ويؤكّد أنّ عددًا منهم لا يرغب في أداء الشهادة وهم يعرفوه كما يعرفون أبنائهم، وهكذا يفرّق القرآن في الحالتين بين الكتب المقدّسة وبين العلماء الذين يتبعونها بإخلاص وبين هؤلاء الذين يسمّون أنفسهم يهودًا أو نصارى وهم يتّبعون أهواءهم.
فإذا كان الفضل بإيراد تفصيلات التاريخ اليهودي في القرآن يرتَدّ إلى الأصدقاء اليهود فكيف يحمل القرآن مثل هذه التّقريعات تجاههم ولا سيّما في المرحلة المكّيّة التي لم يحدث فيها الصدام المباشر معهم، ثم كيف يفسّر سكوت اليهود
على اقتباس النبيّ صلىاللهعليهوآله منهم في الأمور الدينيّة والدنيويّة بينما الجدل الذي احتدم بين الطرفين إبّان فترة الصراع الفكري يدلّ على التّناقض في العقيدة، كما أنّ مناقشة الإسلام للديانة اليهوديّة أدّى إلى زيادة الشقاق بينهما الذي وصل إلى نهايته الحتميّة بانتصار أحدهما على الآخر.
إنّ القرآن الكريم يرشدنا في هذا الشأن إلى فئتين من اليهود الغالبيّة العظمى كانت تعادي الإسلام حتّى قبل أن يطأ الرّسول صلىاللهعليهوآله أرض المدينة وكانت تخفي علمها عنه، وحاولت خداعه في مناسبات عديدة وبثّ المكائد في طريقه لكن دون جدوى، وكانوا أحيانًا يلقون عليه عن طريق المشركين أسئلة تعجيزيّة؛ كسؤالهم عن الروح وأحيانًا يطالبونه بأن ينزل عليهم من السّماء كتابًا مدوّنًا، وأحيانًا ينكرون نصوصًا أكّد الرّسول صلىاللهعليهوآله وجودها في كتبهم ولا يعترفون بها إلّا بعد تحديهم وإثبات غشّهم، لذلك فإن هؤلاء كانوا بعيدين كل البعد عن موقف الملقّن المتّصف بالترحيب.
وقد ذكر الزمخشري أنّ سورة يوسف نزلت رَدًّا على تحدّي المشركين واليهود الذين قالوا لكبراء المشركين: «سلوا محمدًا عن قصّة يوسف ولِمَ انتقل آل يعقوب من الشام إلى مصر»؟، فقد كانت أحبار يهود يسْأَلون رسول اللَّه صلىاللهعليهوآله ويتعَنتونه، وَيأْتونه بِاللّبس، ليُلبسوا الْحقّ بالباطل، فكان القرآن ينزل فيهم فيما يسأَلون عنه.
وفي ذلك الوقت لم تكن قد وجدت بعد توراة ولا إنجيل باللغة العربيّة ووجود هذه الوثائق بلغات أجنبيّة جعلها حكرًا على بعض الفقهاء المتحدّثين بأكثر من لغة الذين حفظوها بعناية، الذين وصفهم القرآن الكريم بالشحّ بما عندهم من
العلم بحيث إنّهم لم يكونوا يتنازلون عن بعض أوراق من التوراة إلّا مع حرصهم على إخفاء الجزء الأكبر(تَجْعَلُونَهُ قَرَاطِيسَ تُبْدُونَهَا وَتُخْفُونَ كَثِيرًا) (سورة الإنعام: الآية 91)، كما أشار القرآن إلى أن إحدى مهمّات الرّسول صلىاللهعليهوآله في نبوّته كشف ما دأب أهل الكتاب على إخفائه.
ولم ينبّئنا التاريخ عن أي اتّصال بين النبيّ صلىاللهعليهوآله وبين علماء اليهود قبل الهجرة، فلا شكّ في أنّه يمكن افتراض وجود مثل هذه العلاقة وذلك بإتاحة الفرصة لكل حدس وخيال أمّا عندما نطالب بالتّحديد فإنّه يحدث التناقض والتخبّط في الحال.
لقد وقف الرّسول صلىاللهعليهوآله من العلماء اليهود موقف المصحّح لِمَا حرّفوا، الكاشف لما كَتَموا فليس في العلماء يومئذ من يصلح أن تكون له على محمد صلىاللهعليهوآله وقرآنه تلك اليد العلميّة.
أمّا الرّهط القليل من اليهود الذين آمنوا برسول الله صلىاللهعليهوآله الذين وسمهم ميور بأنّهم منحرفين عن اليهوديّة وقاموا بتزييف النّصوص للرّسول تحت إغراء الإسلام، فنلمس أنّ القرآن الكريم يصفهم بعبارات لا توحي بأنّهم كانوا متزلفين أو مداهنين للنبي صلىاللهعليهوآله أو أشخاصًا قدّموا خدمات لقاء عطاء كما صوّر ميور، بل ذكرهم بأنّهم الرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ الذين تغمرهم الفرحة بِمَا ينزل على الرّسول من السماء، فهم قوم ضاقوا ذرعًا بادّعاءات أبناء جلدتهم؛ فحضروا إلى الرّسول صلىاللهعليهوآله ليستمعوا إلى تعاليمه ويتفحصّوا وجهه، وعندما تعرّفوا عليه في الحال بناءً على بعض العلامات الموجودة في كتبهم، شهدوا له بصدق رسالته، وأشهر شخصيّة في هذا الفريق
عبد الله بن سلام، وظروف إسلامه لها دلالة عظيمة، فقد كان اليهود يعدّونه خيرهم وأفضلهم قبل إسلامه مباشرة، فلمّا أعلن إسلامه أنكروا عليه ذلك كلّه، وغدا أشرّ القوم في نظرهم وفي الجلسة نفسها التي أعلن فيها إسلامه.
ويرد أيضًا شخصيّة «مخيريق» الذي كان حبرًا عالمًا، ورجلًا غنيًّا كثير الأموال من النخل، وكان يعرف رسول الله صلىاللهعليهوآله بصفته، وما يجد في علمه، وغلب عليه إلف دينه، فلم يزل على ذلك حتّى إذا كان يوم أحد، وكان يوم أحد يوم السبت، قال: يا معشر يهود، والله إنّكم لتعلمون أنّ نصر محمد صلىاللهعليهوآله عليكم لحق، قالوا: إنّ اليوم يوم السبت، قال: «لا سبت لكم ثمّ أخذ سلاحه، فخرج حتّى أتى رسول الله صلىاللهعليهوآله بأحد، وعهد إلى من وراءه من قومه: إن قتلت هذا اليوم فأموالي لمحمد صلىاللهعليهوآله يصنع فيها ما أراه الله، فلما اقتتل النّاس قاتل حتّى قتل، فكان رسول الله صلىاللهعليهوآله فيما بلغني يقول: مخيريق خير يهود، وقبض رسول الله صلىاللهعليهوآله أمواله، فعامة صدقات رسول الله صلىاللهعليهوآله بالمدينة منها».
إنّ الصورة التي صوّرها ميور عن هذه الشريحة من اليهود تتعارض تمامًا مع الوقائع التاريخيّة، فإذا كانت هذه الثلّة من اليهود تزيّف النّصوص كما يزعم ميور كيف لهم أن يتّبعوه ويخرجوا عن دين قومهم؟، وإن كان إسلامهم بدواعي المنفعة لاعتنق الإسلام نفر كبير من اليهود.
وقد ورد في الصحاح عن الرّسول صلىاللهعليهوآله إنّ أهل الكتاب كانوا يقرؤون التوراة بالعبرانيّة ويفسّرونها بالعربيّة لأهل الإسلام فقال رسول الله صلىاللهعليهوآله: «لا تصدّقوا أهل الكتاب ولا تكذّبوهم وقولوا آمنّا بالله وما أنزل إلينا الآية»، فكيف ينهى الرّسول أتباعه من قضيّة الأخذ عن اليهود ومن ثمّ يَتّخذ منهم بطانة لتسويغ نبوّته وتأكيد نسبه؟ فإذا افترضنا أنّ سكوت اليهود كان بدافع المنفعة فكيف يسكت المهاجرون والأنصار عن هذا الأثر الذي يأتي على استقلاليّة الوحي الإلهي من جذوره الإلهية.
وإنّ إدراك هذه الشريحة من اليهود لنبوّة الرّسول صلىاللهعليهوآله التي ظهرت تباشيرها في صحائفهم كان الباعث الوحيد لإيمانهم بدعوته وتصديقه، فقد ورد عَنِ عبد الله ابْنِ سَلَامٍ، أَنَّهُ قال: «إِنَّ صِفَةَ رَسُولِ اللَّهِ صلىاللهعليهوآله فِي التَّوْرَاة» وكان يميّز الرّسول صلىاللهعليهوآله كما يميّز أبناءه، وكان كَعْبَ الْأَحْبَارِ يَقُولُ مِثْلَ مَا قَالَ ابْنُ سَلَامٍ.
ولم يكن رسول الله صلىاللهعليهوآله سلطانًا يتّكئ على كنوز الأرض كي يغدق العطاء، وحسبنا إقرار وليم ميور في هذه الشأن: «إنّ حياة البذخ والدّعة في نواحي بغداد ودمشق تدعو للدهشة في ضوء حياة نبيّهم الذي كان يخصف نعليه بيده»، وقوله أيضًا: «كانت حصّة محمّد من الأعشار توزّع على فقراء البلاد».
لقد أشارت كتب السّير إلى طائفة من اليهود حملها النّفاق إلى اِعتناق الإسلام بغية إثارة الخلاف في صفوف المسلمين وليس باعث الطّمع فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَيْفٍ، وَعَدِيُّ بْنُ زَيْدٍ، وَالْحَارِثُ بْنُ عَوْفٍ، بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ وهم من اليهود: «تَعَالَوْا نُؤْمِنْ بِمَا أُنْزِلَ عَلَى محمّد وَأَصْحَابِهِ غُدْوَةً، وَنَكْفُرْ بِهِ عَشِيَّةً، حتّى نَلْبِسَ عَلَيْهِمْ دِينَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَصْنَعُونَ كَمَا نَصْنَعُ، وَيَرْجِعُونَ عَنْ دِينِهِ فَأَنْزَلَ اللَّهُ تعالى فِيهِمْ قوله: (يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَأَنتُمْ تَشْهَدُونَ ﴿٧٠﴾ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تَلْبِسُونَ الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٧١﴾ وَقَالَت طَّائِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ آمِنُوا بِالَّذِي أُنزِلَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَجْهَ النَّهَارِ وَاكْفُرُوا آخِرَهُ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ) (سورة آل عمران: الآيات 70-72).
والغريب في أمر ميور اعتقاده أنّ الرّسول صلىاللهعليهوآله استظهر باليهود لتأكيد سلسلة نسبه إلى إسماعيل، فلو افترضنا أن أحدًا لم يؤمن من اليهود، كيف لمحمد صلىاللهعليهوآله أن يؤكّد نسبه
الإبراهيمي؟، ولو كان ما يذهب إليه ميور حقيقة من أمر بشريّة القرآن والانتحال من التوراة وحاجته لبطانة اليهود لتأكيد سلسلة نسبه كان حريًّا به أن يوثق هذه السلسلة المستقاة من اليهود بين ثنايا سور القرآن تبعًا لفرضيّة ميور.
إنّ ما يدّعيه وليم ميور من إفادة الرّسول من حاشية اليهوديّة والمسيحيّة الذين أسلموا وكانوا في صحبته محض افتراء لأنّ إسلامهم حجّة قائمة على صدق ما جاء به الوحي المحمّدي ولو تبيّن لهم أنّه كان يتتلمذ لهم في خفاء ليتلقّى عنهم ما كان يدعو إليه لانفضّوا من حوله ولعادوا إلى يهوديّتهم ولم تكن لهم تلك المنزلة في الإسلام.
يقول وليم ميور: «لا يمكن أن نشكّك في أنّ محمدًا استعار من اليهود تاريخهم وأساطيرهم على نطاق واسع حتّى غدت اليهوديّة تضفي بألوانها على نظام الإسلام برمّته وإعارته الهيئة والمضمون، لقد كانت غاية محمّد الرئيسة أن يستوحي من اليهود جميع قوانينهم وطقوسهم وأعيادهم، وصيامهم»، «وعندما أدرك أن لم يتمكّن من استمالة اليهود أو يحدث انصهارًا بين اليهوديّة وبين الإسلام في ديانة واحدة فقدت التّعاليم قيمتها وحينها قرّر الانسلاخ عن اليهوديّة».
ويرى أيضًا: «وعند وصول محمّد إلى يثرب مارس طقس الصلاة المسبوق بالوضوء ذا السّمة اليهوديّة»، «والواضح أنّ فكرة الصيام اُستعيرت من اليهود، فبعد انقضاء شهرين أو ثلاثة على وصوله إلى المدينة لاحظ أنّ اليهود يصومون يوم الغفران العظيم في العاشر من شهرهم السابع لمدّة أربعة وعشرين ساعة من
الشروق حتّى شروق اليوم التالي فيحظرون على أنفسهم جميع المباهج في اليوم والليلة خلال الشهر، فصار محمّد والمسلمون الأوائل يصومون أسوة باليهود في اليوم العاشر من محرم ، لكنّه أحلّ صيام شهر رمضان محلّ هذا الصيام عندما عزم الانفصال عن اليهوديّة»، «كما أنّه استعار منهم الوضوء» والأذان عندما أعطى أوامره باستخدام البوق الذي كان مناسبًا تمامًا خلال فترة علاقته الأولى باليهود، ولاحقًا رغب عن هذه الفكرة وأعطى أوامره بإنشاء ناقوس من الخشب ولمّا كان يُنْحت حَسَم حلمُ عبد الله المسألة بإقامة الأذان.
«أمّا القبلة فكان بيت المقدّس القبلة الأولى لمحمّد تبعًا لمنهج اليهود، فكان يصلّي وأتباعه ووجوههم نحو هيكل سليمان في هذه المرحلة المبكرة، ولعلّ بعض اليهود قد ارتادوا كلًّا من الكنيس والمسجد، لكن بعد انسلاخ عام ونصف العام على وصول محمّد إلى المدينة حدث تغيير جعل من العسير على اليهودي المؤمن أن يغيّر قبلته أو مشاركة المسلمين لعباداتهم، ولما تعمّق الخلاف مع اليهود وجد أنّه لم يعد ممكنًا أن ينابزهم على طريق واحد لذلك شرع بتحويل قبلته إلى مكّة بعد أن استعار فكرة القبلة من اليهود».
وشدّد كذلك على: «أنّه رغب في أن يميّز الإسلام بيوم مقدّس أسوة باليهوديّة والمسيحيّة فحدّد يوم الجمعة، موعدًا للصلاة العامّة، على غرار عبادة يوم السّبت عند اليهود، وبدلًا من يوم الأحد عند المسيحيّين حاول أن يحاكي حضور اليهود في مراسمه العامّة التي عقدها كما يفعلون من حيث الصلاة وتلاوة النصوص المقدّسة».
أمّا طقس الأضاحي: «فمرّت مناسبة نحر الأضاحي في المدينة دون ملاحظة في
السنة الأولى للهجرة، إذ استمرّت طقوس تقديم القرابين اليهوديّة في يوم الغفران، وبغية اكساب التنائي عن اليهوديّة مزيدًا من التّمايز والتّقرب أكثر من عبادة مكّة،لوحظت أنّ مراسم نحر الأضاحي في المدينة كانت تصادف اليوم نفسه الذي تقام فيه شعيرة منى، كبديل عن شعيرة الأضاحي اليهوديّة».
«كما أنّ محمدًا أخذ الصدقات عنهم، فكانت الأعشار تدعى صدقات، أو زكاة والواضح أنّ هذه الممارسة استعيرت من اليهود أيضًا، الذين أطلقوا على زكاتهم التّسمية عينها، الصدقات».
لقد صوّر ميور أنّ الرّسول صلىاللهعليهوآله أسس عقيدة اقتبس مضمونها وطقوسها من اليهوديّة ومن ثمّ عكف على إزاحتها وتذويبها بين ثنايا عقيدته المقلّدة -الإسلام- وَلمّا تعذّر عليه ذلك قرّر أن ينسلخ عن العقيدة الأم بعد أن أفرغ في عقيدته جماع شرائعها وطقوسها ليداهن الأمّة الجاهليّة التي نابذته العداء مصوّرًا الرّسول صلىاللهعليهوآله تصويرًا خارقًا حتّى يتمكّن من اقتباس عقيدة غير مجهولة للعرب بحكم التعايش مع اليهود في ظل علاقة احتقار تاريخي متبادل منذ أمد طويل، ليقنعنهم بأنّها تجليّات لوحي جديد؟
لا غرو من وجود تماثل في العبادات والطقوس لأنّ الأرضية مشتركة بين اليهوديّة والمسيحيّة والإسلام فالمصدر الإلهي واحد: (إِنَّ هَٰذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُونِ) (سورة الأنبياء: الآية 92)، وقال صلىاللهعليهوآله: «أنا أولى النّاس بعيسى ابن مريم في الدّنيا والأخرة، والأنبياء إخوة لعلاّت أمّهاتهم شتّى ودينهم واحد».
وهذا ما ترسّخ في عقل كل من اتّبع محمدًا صلىاللهعليهوآله من العرب الذين أدركوا أن الشرائع والطقوس لم تكن ابتداعًا محمديًّا بل كانت سننًا إلهيّة جرت عليها الأمم السابقة، والهوية في الاختلاف بين الدّيانات السّماويّة، فالأفكار التي تبدو متشابهة ومتماثلة في الحضارات الإنسانيّة وأديانها لا تدلّ بالضرورة على الاقتباس، ومع ذلك وعلى الرغم من
وجود تشابه ضئيل بين الإسلام من جهة وبين الديانتين اليهوديّة والمسيحيّة من جهةٍ أُخرى، فإنّ ثمّة فوارق جوهريّة في عبادات كل ديانة منهما عن الإسلام.
وما يعنينا في هذا المقام هو أنّ هذا التّشابه وبصرف النظر عن حجمهِ يجب أن لا يفسّر إلّا تحت علّية وحدة المصدر الإلهي لهذهِ الأديان، ولعلّ إقرار وليم ميور بدلالة التّغاير بين يوم السبت اليهودي وبين يوم الجمعة لدى المسلمين حجّة على هذا الرأي بقوله: «ليس ثمّة أيّ تماثل صحيح بين يوم السبت اليهودي والجمعة لدى المسلمين فلا ينطوي الأخير على تقديس لما تبقّى من اليوم بعد الصلاة كما في اليهوديّة، أو تكريس لخدمة الربّ كما في المسيحيّة حيث يحثّ النّاس على الرجوع إلى أعمالهم بعد الفراغ من طقس العبادة العامّة».
إنّ نفس محمد صلىاللهعليهوآله كانت متأثّرة بما تأثّرت به نفوس الأنبياء من بني إسرائيل، وكان يعبد الله الذي عبدوه فلا عجب أن تشابهت ألفاظ التضرّعات وتجانست أصوات الدعاء.
ولعلّ وليم ميور ترسّم خطى بعض الباحثين الذين عزوا حفظ يوم السبت عند اليهود إلى حفظ البابليين له، فقد كان هؤلاء يحفظون اليوم السابع والرابع عشر والحادي والعشرين والثامن والعشرين من كل شهر، مهما كان اسم اليوم، وكانت شرائعهم تقضي بأنّ الملك لا يأكل اللحم المطبوخ في هذه الأيام، ولا يلبس ثيابًا نظيفة، ولا يُقيم ذبيحته، ولا يركب في عربة، ولا يتكلّم في قضيّة، ولا يجوز للرّائي في هذه الأيام أن يُقدّم للنّاس ما يرى، ولا يجوز للطبيب أن يضع يده على جسد إنسان، وعند المساء يأتي الملك بتقدّماته للآلهة؛ لكن علماء التوراة يؤمنون بأنّ حفظ يوم السبت عند اليهود ليس تقليدًا للبابليّين بل كان أمرًا إلهيًّا وإعلانًا سماويًّا، فلا علاقة أساسيّة بين الغرض من تقديس يوم الله ويوم بابل، وكذلك شرع الله لدين الإسلام الاجتماع لعبادته يوم الجمعة.
أمّا الصلاة، فقد أشار علماء الأديان أنّ الشعوب القديمة حتّى البربريّة منها، كانت تقوم بأداء فروض دينيه يصحّ أن نطلق عليها لفظة «الصلاة» ومن بين ما عثر عليه الآثاريّون، بعض النّصوص القديمة التي كان يقرؤها الآشوريّون والبابليّون في صلواتهم، وقد اعتقدت الديانات القديمة أنّ المرء متى أحسن أداء الصلاة، وقرأ النّصوص التي لا بدّ منها كما هي مكتوبة أو محفوظة، وقام بجميع أركان الصلاة، وناجى آلهته في صلاته الصحيحة المقرّرة، فإنّ الآلهة تلبّي طلب المصلّي لا محالة، وتجبر إذا ما صلّى وكرّر الكلمات المقدّسة في صلاته، فإنّ صلاته هذه تفيده في طرد الأرواح الخبيثة والمخلوقات الشرّيرة عنه.
وقد وجدت في كل الرسالات السماويّة أوامر الله (عزّ وجل) بإقامتها، وكلمة «صلاة» ليست يهوديّة بل آراميّة في الأصل أخذت من أصل «ص ل ا» «صلا» ومعناها ركع وانحنى ثم استعملها اليهود فأصبحت لفظة آراميّة عبرانيّة واستعمل اليهود هذه الكلمة «صلوته» في الأزمنة المتأخّرة من عهد التوراة، ولفظتي صلاة وزكاة، ولم تكتبا على الشكل الذي ندوّنهما في الزمن الحاضر،وإنّما كتبتا بحروف الواو في صدر الإسلام: «صلوه» و«زكوه» وقد رجعوا ذلك إلى الأثر الآرامي في أصل الكلمة، كما أنّ الصّلاة عرفت في مكّة، فقد وردت في سورة مريم عندما احتّج بها جعفر بن أبي طالب في بلاط النجاشي، وقد انقطع الإجماع على أنّها فرضت بمكّة ليلة الإسراء والمعراج قبل الهجرة بثمانية عشر شهرًا، ولعلّ ذلك حجّة على عدم اقتباسها من اليهود، علاوة على البون الواسع بين طقس الصلاة اليهوديّة وبين صلاة المسلمين، فصلاة اليهود كانت تعني في أصلها الإرهاق، أو تعذيب الذّات وإظهار الخضوع بتقديم
القرابين والدماء أو الابتهال والدعاء في المناسبات، حسبما يرى الآباء والقادة الدينيّين في كل عصر.
أمّا الأذان فعندما ظهرت الحاجة إليه شاور رسول الله صلىاللهعليهوآله أصحابه فقيل له: اُنصب راية عند حضور الصّلاة فإذا رآها الناس آذن بعضهم بعضها فلم يعجبه ذلك، فذكر له بوق اليهود، أو القرن الذي يدعون به لصلاتهم، فقال إنّه من أمر اليهود فَكَرِهَهُ، وَذُكِرَ النَّاقُوسُ الذي يدعو به النصارى لصلاتهم فَكَرِهَهُ حتّى أُرِيَ بالأَذَانَ من رَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارِ يُقَالُ لَهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ زَيْدٍ، وما قبل ذلك، كان المسلمون ينادون إلى الصلاة بعبارة «الصلاة جامعة»، أو كانوا ينادون بها حين وقوع الصلاة «إلى الصلاة» أو«هلمّ إلى الصلاة».
ولعلّ ذلك حجّة صريحة إلى نيّة الرّسول صلىاللهعليهوآله في عدم الاقتباس من اليهود والنصارى، فاعتماد طريقة مغايرة في الإعلان عن الصلاة بنحو يخالف ما فطر عليه اليهود والنصارى دلالة واضحة على خصوصيّة الإسلام واستقلاليّته عن معتقداتهم كما أنّه حجّة تدحض رؤية ميور في نيّة المصاهرة مع اليهوديّة.
أمّا القبلة فإنّ ميور يميل إلى تبسيط قضيّتها، معتقدًا أنّ القضيّة مجرّد انتحال، لكن المسألة تمثّل صراعًا على المرجعيّة، وتأصيل الكعبة قبلةً للمسلمين يمثّل تأصيلًا لبيت الله؛ بصفته أقدم قبلة، ذكرها القرآن الكريم بالبيت العتيق، وهذا إفصاح عن هويّة الإسلام الحقيقيّة؛ بصفته امتدادًا لدين إبراهيم الحنيف والإعلان عن أصالته واختلافه مع الرؤية التاريخيّة للتوراة، وعلامة الاستفهام الوحيدة التي
يضعها البعض ومنهم ميور على مبعث التريّث في هذا الاعلان، كان منهج التدرّج الذي اتّبعه الرّسول صلىاللهعليهوآله في نَفَاذِ الأحكام الإلهية.
وقد ذكرت المصادر أنّ الرّسول صلىاللهعليهوآله عيّن قبلته الأولى في مكّة قبل هجرته إلى المدينة، فكان يولّي وجهه إلى الكعبة طوال مكوثه بها، إذ نقل أنّ الرسول صلىاللهعليهوآله : «أوّل ما صلّى إلى الكعبة، ثم صُرف إلى بيت المقدس، فصلّت الأنصار نحو بيت المقدس، قبل قدومه بثلاث حجج، وصلّى بعد قدومه ستة عشر شهرًا، ثم ولّاه الله تعالى إلى الكعبة». أي إنّه لم يكن يتوجّه في صلاته نحو بيت المقدس فلمّا فرضت الصلوات الخمس، وجّه نفسه نحو بيت المقدس.
ويرى صاحب الاستذكار أَنّ الرّسول صلىاللهعليهوآله كَانَ يَسْتَقْبِلُ بِمَكَّةَ الْكَعْبَةَ لِصَلَاتِهِ عَلَى مَا كَانَتْ عَلَيْهِ صَلَاةُ إبراهيم وَإِسْمَاعِيلَ فَلَمَّا قَدِمَ الْمَدِينَةَ اسْتَقْبَلَ بَيْتَ الْمَقْدِسِ سِتَّةَ عَشَرَ أو سَبْعَةَ عَشَرَ شَهْرًا ثُمَّ وَجَّهَهُ اللَّهُ إلى الْكَعْبَةِ فكَانَ أَوَّلَ مَا نَسَخَ اللَّهُ مِنَ القرآن الْقِبْلَةُ وَذَلِكَ أَنَّ النَّبِيَّ صلىاللهعليهوآله لَمَّا هَاجَرَ إلى الْمَدِينَةِ وَكَانَ أَكْثَرَ أَهْلِهَا الْيَهُودُ أَمَرَهُ اللَّهُ أَنْ يَسْتَقْبِلَ بَيْتَ الْمَقْدِسِ فَفَرِحَتِ الْيَهُودُ فَاسْتَقْبَلَهَا رَسُولُ اللَّهِ بِضْعَةَ عَشَرَ شَهْرًا وَكَانَ يُحِبُّ قِبْلَةَ إبراهيم وَكَانَ يَدْعُو اللَّهَ وَيَنْظُرُ إِلَيْهَا فَأَنْزَلَ اللَّهُ تعالى: (قَدْ نَرَىٰ تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ ۖ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا) إلى قَوْلِهِ تعالى: (فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ) (سورة البقرة: الآية 144) يَعْنِي نَحْوَهُ فَارْتَابَ مِنْ ذَلِكَ الْيَهُودُ وَقَالُوا مَا وَلَّاهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا فَأَنْزَلَ اللَّهُ تعالى: (قُل لِّلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ) (سورة البقرة: الآية 142) وَقَالَ: (فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّه) (سورة البقرة: الآية 115)، وَقَالَ: (وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّن يَنقَلِبُ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ) (سورة البقرة: الآية 143).
أمّا بشأن ادّعاء ميور بأنّ تغيير القبلة نحو الكعبة كان نتيجة معاداة اليهود للإسلام أو أنّه حدث بعد أن آيس الرّسول صلىاللهعليهوآله من إحداث الانصهار بين الإسلام واليهوديّة فهذا كلام غير سليم لأنّ الصّراع العقدي قائم منذ إعلان الوحي المحمّدي، ثم لا ضير أن يبحث الإسلام عن هويّة متميّزة عن اليهوديّة والنصرانيّة وقد يكون العداء اليهودي حافزًا لتشكيلها، فالمنطق يفرض أن قيمة الأشياء لا تتحدّد بذاتها بل بعلاقتها بغيرها، لأن جزءًا كبيرًا من الأمر مرهون بالآخر، والدليل امتعاض اليهود من تغيير القبلة نحو الكعبة؛ بوصفها علامة لا يمكن أن تفهم إلّا في ضوء صراع الأديان، بين علامة مرجعيّة (القدس) أو دين قديم/ اليهوديّة؛ وبين علامة دين جديد/ الإسلام (الكعبة).
والخطأ الآخر الذي وقع فيه ميور افتراضه أنّ الرّسول صلىاللهعليهوآله بتحويله القبلة رام التقرّب من قريش أو محاباتهم، فإذا افترضنا صحّة ذلك فالتقرّب سيكون للعرب قاطبة لما تمثّله الكعبة من قدسيّة في نظرهم، لكن هذا أمر برمّته مخالف للوقائع التاريخيّة، في هذه المرحلة التي انتقل فيها الرّسول صلىاللهعليهوآله إلى حالة الدفاع العسكري عن الدعوة، كما أن نظرة زعماء قريش إلى النبوّة لم تكن مرهونة بقضيّة القبلة لأنّ عداء زعماء قريش للنبي كان مستحكمًا منذ أن صدح بنبوّته وبالتالي فمن غير المنطقي أن ينحو الرّسول صلىاللهعليهوآله إلى استمالتهم في المدينة بعد ثلاثة عشرة سنة من العداء في مكّة.
أمّا الغسل أو تطهير الجسم من الأدران والأرواح الشرّيرة فيعدّ من العادات القديمة المعروفة عند العرب وعند الساميّين، وذلك لاعتقادهم أنّ الطهارة تطرد تلك الأرواح وتبعدها عن الجسم، كما أنّ الأمر بالوضوء نزل مع نزول الأمر بالصلاة، كما أنّ ميور يرى أنّ الوضوء اعتمد في المرحلة المكّيّة.
أمّا عن مسألة الارتياد المشترك للمسجد أو المعبد اليهودي التي أرجعها إلى سيرة ابن هشام وكتاب حياة محمّد لفايل، فلم يلمس الباحث لها أثرًا في سيرة ابن هشام
طبعة جوتنجن 1858م، التي تعدّ النسخة الأقدم، والأرجح أنّ ميور عوّل على رأي غوستاف فايل في هذه القضيّة.
والمريب أنّ ميور يقرّ بأنّ الرّسول صلىاللهعليهوآله زار المعبد اليهودي مرّة واحدة، ليس لإقامة الشعائر الموحّدة بل لدعوتهم إلى الإسلام وإقامة الحجّة عليهم: «لم يقم محمّد بزيارة المعبد اليهودي سوى مرّة واحدة يحذرهم ويدعوهم إلى اعتناق الإسلام وعندها سألوه عن أمر دينه فردّ عليهم أنّه دين إبراهيم فأجابوه بأنّ إبراهيم كان يهوديًّا، فأنكر محمّد ذلك وأخبرهم أنّ إبراهيم سابق لليهوديّة وقال لهم ائتوني بالتوراة ليحكم بيننا في ذلك».
فإذا اُفترض صحّة هذه المحادثة فإنّها برهان آخر على أنّ الرّسول صلىاللهعليهوآله لم يذهب إلى مجاراة اليهود في أيّ فترة كما زعم ميور، فكيف له أن يقتبس منهم أو يجاريهم وفي الوقت نفسه يحاكمهم من كتابهم؟ وإذا كان الرّسول صلىاللهعليهوآله قد زار المعبد اليهودي مرّة واحدة حسب زعم ميور لدعوتهم لاعتناق الإسلام وليس إقامة الصلاة، فكيف يرتاد المسلمون المعبد اليهودي أو يحدث العكس وفريضة الصلاة حينها كانت جامعة بإمامة الرسول صلىاللهعليهوآله، فلا يعقل أنّ المسلمين كانوا يُصَلّون فرادى في معبد يهودي وإن سلّمنا من قبيل الفرض بصحّة ذلك فلعلّ مبعث ذلك رغبة الرّسول صلىاللهعليهوآله في إجلال بيوت الله على اختلاف الديانة، وليس كما ذهب إليه ميور من أمر الانتحال والمحاكاة الدينيّة.
وجدير بالإشارة أنّ الباحث لم يعثر في سيرة اِبن هشام أو في كتب السيرة على إشارة لزيارة الرّسول صلىاللهعليهوآله لأيّ معبد يهودي والرواية التي أشار إليها ميور كانت عن محاججة الرّسول صلىاللهعليهوآله لليهود في أمر يهوديّة إبراهيم التي أوردها ابن هشام في معرض حديثه عن أَحْبَارُ يَهُودَ وَنَصَارَى نَجْرَانَ، حَيْنَ اجْتَمَعُوا عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صلىاللهعليهوآله فَتَنَازَعُوا فَأَنْزَلَ اللَّهُ تعالى فِيهِمْ: ( يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تُحَاجُّونَ فِي إِبْرَاهِيمَ
وَمَا أُنزِلَتِ التَّوْرَاةُ وَالْإِنجِيلُ إِلَّا مِن بَعْدِهِ ۚ أَفَلَا تَعْقِلُونَ) (سورة آل عمران: الآية 65).
ويبدو أنّ ميور لم ينفكّ عن تحريف النّصوص لرسم انطباع زائف عن علاقة الرّسول صلىاللهعليهوآله باليهوديّة، ولعلّ تشدّقه في استعراض الآراء والنّصوص المتنوّعة حمله على الخروج عن رؤيته العامّة وبلوغ حدّ التّعارض وعدم الاتّزان المفاهيمي والمنطقي، وعلى الرغم من كل ما يحوزه من ركام النّصوص التاريخيّة لكن منهجه ظلّ يشعر القارئ بالإرباك فتارة يجرح وتارة يداوي على هذا النسق المتضارب.
أمّا الصيام فقد ذكر القرآن تشريعه لدى الأمم السابقة على اختلاف الأصل أو الكيفيّة، وفي قصّة صوم يوم عاشوراء المشار إليها سابقًا؛ حثّ الرّسول صلىاللهعليهوآله أصحابه على مخالفة اليهود عندما شرع لهم صيام اليوم الذي قبله أو اليوم الذي يليه، وهذا خلاف ما ذهب إليه ميور في مزاعمه بشأن رغبة الرّسول صلىاللهعليهوآله في محاكاتهم طمعًا في استمالتهم، وقد تجاهل أنّ الشعائر الدينيّة؛ كالصلاة والصيام والحجّ التي زعم أنّها مستوحاة من اليهوديّة ليست وقفًا على الديانة اليهوديّة، فشعيرة الصيام كانت مهمّة في ديانات كثيرة، وقد عرفت منذ زمن بعيد حتّى أنّ الصابئة القدماء كانوا يمارسون الصيام لمدّة ثلاثين يومًا من كل سنة وكان صيامهم حتّى غروب الشمس حتّى أنّ بعض المستشرقين ذهب إلى اقتباس الرّسول صلىاللهعليهوآله لشعيرة الصوم من الصابئة، ولعلّهم طائفة أقدم ظهورًا من اليهود.
أمّا الصدقات فلم ترد هذه كلمة في العهد القديم خلافًا لمزاعم ميور بل كثرت الإشارة إلى وجوب فعل الرحمة والسّخاء في الطعام؛ ما أوجب على بني إسرائيل
ترك بقايا المواسم والحصاد في زوايا الحقل ليلتقطها الفقراء وقد ورد أنّ فرض العشر في موارد الإنسان قديم جدًّا، ولعلّه يرجع إلى عهد إبراهيم الذي أعطى العشر من غنائمه التي غنمها في حربه ضدّ الملوك «لملكي صادق الكاهن».
أمّا الزكاة فلم ترد في الكتاب المقدّس إلّا مرّة واحدة عندما أمر الربّ موسى قائلًا: «ارفع زكاة للربّ من رجال الحرب الخارجين إلى القتال واحدة نفسًا من كل خمس مئة من النّاس والبقر والحمير والغنم»، فلا مناص من القول إنّ معنى الزكاة في اليهوديّة اقترن بمغانم الحرب وليس بالإحسان أو الإنفاق كما ورد في معنى الزكاة في الإسلام، فالزكاة في التّشريع اليهودي غير الزكاة التي فرضها الله تعالى ليتعبّد بها الناس، ولتؤدّي دورًا عظيمًا في أحداث التّكافل بين أفراد المجتمع، فالفقراء واليتامى والأرامل والغرباء كان يُخصَّص لهم عُشَرٌ من التّسعة أعشار الباقية بعد عشر، إنّ مصارف الزكاة في الشريعة الموسويّة كانت محصورة في الكهنة اللّاويون من أبناء لاوي بن يعقوب وكان لهم عُشر خاص، لأنّهم منقطعون لخدمة الربّ، وكانوا يأكلون هذا العشر في أيّ مكان، «إنّ عشور بني اسرائيل التي يرفعونها للربّ رفيعة قد أعطيتها للّاويّين نصيبًا»، ويقول ول ديوارنت إنّ الكهنة طبقة مغلقة، لا يستطيع أحد أن ينتمي إليها إلّا اللّاوين، وبناء على هذا امتلأت بطون الكهنة ونمت ثرواتهم نماء فاحشًا، وشاع الفقر وكثر المتسوّلون في بني إسرائيل.
ثمّ إنّ الإسلام حدّد مصارف الزكاة في ثمانية مصارف، كما خفّف من خلالها
غلواء اليهوديّة، وقرّر أنّ الله «لا يقبل إلّا الطيّب»، كما نَظّم الإسلام عملية صرف الزكاة تنظيمًا يحفظ للفقير والمسكين ماء وجهه، بمنحى لا تحمل الفقراء على اِلتقاط الفتات من زوايا الحقول.
أمّا عن مسألة اقتباس شعيرة النحر تيّمنًا بيوم الغفران اليهودي، فهذه القضيّة عارية عن الصحّة، فالأضاحي أو القرابين كانت وما تزال شعيرة دينيّة منذ القدم وليست تقليدًا توراتيًّا، وقد ذكرت التوراة أن «قايين قدم من أثمار الأرض قربانًا للربّ، وقدّم هابيل من أبكار غنمه من سمانها، ثم عبادة نوح الذي خرج من الفلك وبنى مذبحًا للربّ وأصعد عليه محرقات من كل البهائم ومن كل الطيور الطّاهرة» وكان ربّ العائلة يقوم بتقديم الذّبيحة والمحرقة عنه وعن عائلته مثل إبراهيم وأيوب الذي كان يصعد محرقات على عدد أولاده» وإن إفترضنا أنّ الرّسول صلىاللهعليهوآله حاكى اليهود في تقديم الأضاحي جريًا على الشعيرة اليهوديّة، أليس الأجدى به أن يقيم هذه الشعيرة بتمامها، ولا سيّما وأن الاحتفاء بهذا اليوم يقضي حظر العمل، وإشعال النار، وحضر الكتابة وتناول الطعام والشرب، والاغتسال والاستحمام، واستخدام الطيب والمشي بالأحذية الجلديّة، وحظر ممارسة الجنس.
ولعلّ ميور يتعامل مع هذا الموضوع وكأنّ إبراهيم خاص باليهود أو حكرًا على بني إسرائيل بينما كان عليه أن يضع بالحسبان أنّ تقديم الأضاحي كان موجودًا في
شعائر العرب قبل الإسلام وأنّه امتداد لتقليد إبراهيمي بهذا الشأن، وموسم الحج العربي يخضع للتّقويم القمري في حين أنّ السّنة العبريّة شمسيّة وشهورها قمريّة.
إنّ مزاعم ميور تتعارض مع حقيقه مؤدّاها أنّ الديانة اليهوديّة تأثّرت لاحقًا بالديانة الإسلاميّة؛ فقد أدّى احتكاك هذه الديانة مع التيّارات الإسلاميّة من مئات السنين إلى ثورة روحيّة من اليهود المقيمين في الأصقاع العربيّة، ولقد أجمل الكاتب اليهودي نفتالي فيدر Nafphtali Wieder هذه المؤثّرات في بحثه باللغة العبريّة في عام 1947 الموسوم «المؤثّرات الإسلاميّة على الديانة اليهوديّة Islamic influence on the Jewish worship» التي استعرض من خلالها بعض المؤثّرات من جملتها غسل الرجلين، واغتسال المجنب، والسّجود، واستقبال القبلة أثناء السجود، وبسط اليدين، والاصطفاف، ولعلّ هذا برهانًا على أصالة واستقلاليّة الطقوس الإسلاميّة.
لقد أقام ميور بعدًا أيديولوجيًّا خطيرًا للتأثيرات اليهوديّة في الحالة الفكريّة والاجتماعيّة لدى العرب مفترضًا أنّ التّأثيرات اليهوديّة كانت حاضرة في سويداء الموروث العربي والعقيدة الإسلامية، ويبدو جليًّا أنّ ميور سعى إلى إفراغ الموروث العربي من محتواه وتصويره بصورة غير موضوعيّة من خلال نفي أصالته واعتباره موروثًا هجينًا باتّباعه منهج الأثر والتأثّر وخلوصه لتعميمات لا تستند إلى قرائن كافية.
يعتقد ميور بوجود تطابق بين القرآن والكتاب المقدّس ويعدّ ذلك دليلًا على الانتحال من خلال عرضه لقصص الأنبياء التي يرى: «لكلّ أولئك الذين لم يدرسوا وحي محمد، قد يكون من المفيد إيراد أمثلة توضح التّطابق مع الكتب المقدّسة اليهوديّة، والانحرافات الغريبة والخياليّة عنها، لا سيّما في قصّة آدم، وقصّة هابيل وقابيل، وقصّة إبراهيم، وقصّة يوسف ويعقوب وقصص سليمان، وملكة سبأ».
إنّ اللافت في منهج ميور، تصنيفاته لهذه القضيّة؛ فنقاط التّشابه يراها مستقاة من اليهود، أمّا نقاط الاختلاف فيعدها انحرافًا ولعلّ ذلك يعدّ مؤشرًا على قراءة أيديولوجيّة تنطلق من نظرة قبلية أو ثوابت فكريّة مسبقة لا تضع بالحسبان دلالة التّغاير بين خطاب الكتاب المقدّس والخطاب القرآني، ويبتعد بالقرآن عن سرّ تأثيره ولا يتعامل معه؛ بصفته ترسانة معرفيّة حملت خطابًا أزاح الترسانة المعرفيّة السائدة آنذاك، أو التصوّر الوثني، هذا من جهة، ومن جهة ثانية، ليس غاية القرآن الكريم سرد قصص الأنبياء كاملةً أو العناية كثيرًا بتفاصيلها إلّا بحسب ما تمليه ظروف الدعوة وما تحتاجه مقتضياتها لذا لا يُلمس باستثناء قصّة يوسف قصصًا وردت في مكان واحد وإنّما معظمها متفرقة.
ويرى الفرنسي بوكاي: «إنّنا نلمس فيما يخصّ الموضوعات الواردة في التوراة والقرآن فروقًا شديدة تدحض كل ما قيل من مزاعم عن نقل محمّد للتوراة ودون أدنى دليل، إنّ صحّة القرآن التي لا تقبل الجدل تعطي النصّ مكانة خاصة بين كتب التنزيل، ولا يشترك مع نص القرآن في هذه الصحة، لا العهد القديم ولا العهد الجديد».
إنّ التّأثيرات اليهوديّة والنصرانيّة في الوحي المحمّدي تقتضي أن يحاكم وفقًا
لمنهج الأثر والتأثّر؛ أي بين العامل المؤثّر وبين العقليّة المتلقّية، ولعلّ مقتضى التأثّر يمثّل إقرارًا بوجود تفاعل تاريخي بينهما في ظرف تاريخي معيّن، ولن يكون لمعطيات المقارنة بين الأناجيل والقرآن دلالة تأثير وتأثّر ما لم يثبت التّفاعل التاريخي، ولا سيّما أنّ التّشابه لا يعني بالضرورة النقل والانتحال، فقد يكون له مصدر آخر.
ولا شكّ في وجود توافق بين القرآن وبين كتب العهدين في بعض الجوانب، وليس لهذا الوفاق في نظر ميور سوى مظهر من مظاهر التأثير المسيحي واليهودي في الإسلام، والناظر فيما جاء في كتب العهدين وما جاء في القرآن الكريم، لا يعجزه أن يقف على بطلان رأي وليم ميور، ففي قصّة آدم، تشير التوراة أن حواء هي من أغوت آدم ليأكل من الشجرة بعدما أغوتها الحيّة، بينما لا يُلمس الوضوح نفسه في الطرح القرآني وربّما نسب الإغواء لآدم وحواء معًا.
وفي قصّة قابيل وهابيل، أضاف القرآن إلى القصّة التوراتيّة أنّ قابيل بعد أن قتل أخاه هابيل، أراه الغراب كيف يوارى سوءة أخيه، وهذا غير موجود في العهد القديم، وفي قصّة نوح خالف القرآن التوراة في أنّ أحد أبناءه أعرض عن صعود السفينة فغرق في الطوفان، في حين أرشد العهد القديم أنّ جميع أولاد نوح الثلاثة دخلوا الفلك معه ونجوا من الطوفان، كما يخالف القرآن التوراة في موضع الذي رست عليه السفينة فذكر أنّها رست على جبل الْجُودِيِّ، بينما تذكر التوراة أنّها رست على جبل أراراط.
وفي قصّة إبراهيم، اختصّ القرآن بإيراد معجزة إبراهيم عندما ألقي في النّار
فأصبحت بردًا وسلامًا عليه، لكن التوراة لم تأتِ على ذكرها، مع ظهور جملة من التّعارضات، فقد ذكر القرآن أنّ إبراهيم كان له ابنان، من زوجتيه سارة وهاجر، بينما تذكر التّوراة أنّ أبناءه كانوا ثمانية من ثلاث زوجات؛ كما يذكر القرآن أنّ إبراهيم أسكن ذريّته فى وادى مكّة، بينما تذهب التوراة إلى أنّهم عاشوا فى حبرون، فضلًا عمّا ورد في الفصل السابق من أنّ القرآن انفرد دون التوراة في إيراد قصّة بناء إبراهيم للكعبة، بينما لا يوجد أيّ إشارة إليها في التوراة، وقد ذكر الكتاب المقدّس أنّ الملائكة أكلت الطعام عند نبي الله إبراهيم، بينما ينزّه القرآن الملائكة عن صفة الأكل ويصور ذعر إبراهيم من عدم استساغة حفاوته من لدن ضيوفه.
وفي قصّة موسى يذكر القرآن الكريم أنّ زوجة فرعون كانت من تبنّت موسى، بينما تذكر التوراة أنّها كانت ابنة فرعون، كما يرد في القرآن أنّ هامان عاش في مصر إبّان زمن موسى، بينما يقول الكتاب المقدّس أنّه عاش فى بلاد فارس إبّان حكم ملك أحشويروش.
وفي قصّة يوسف تذكر التوراة أنّ يوسف قصّ رؤياه على أبيه وعلى إخوته، بينما يخبرنا القرآن بأنّ يعقوب حذّره من الإقدام على إخبار إخوته، كما يقرّر
الكتاب المقدّس أنّ يعقوب طلب من يوسف أن يذهب إلى إخوته الذين كانوا يرعون فمكر به إخوته، بينما يرد في القرآن رواية مختلفة تمامًا إذ أنّ إخوة يوسف مكروا عند أبيهم وطلبوا من أبيهم أن يرسل يوسف معهم فمكروا به. كما يشير الكتاب المقدّس أنّ فرعون طلب من يوسف يجعله على خزائن مصر بينما نلمس في القرآن أنّ يوسف كان المبادر بهذا الطلب من فرعون أن يجعله على خزائن مصر.
كذلك فإنّ البون شاسع بين الرواية القرآنيّة وبين الرواية الكتابيّة في قصّة سليمان مع ملكة سبأ، إذ ورد في إنجيل متّى أنّ المسيح كان يدعو ملكة سبأ ملكة التّيْمَنِ، أي ملكة الجنوب، ويرد في الكتاب المقدّس أنّ ملكة سبأ عندما سمعت عن حكمة سليمان انطلقت برحلة طويلة وشاقّة ومكلفة نحو أورشليم، لِتَمْتَحِنَهُ بِمَسَائِلَ؛ أو لعلّها أَرادت أنْ تعقد معه اتّفاقًا تجاريًّا، إذ كان سليمان يسيطر على طرق التجارة الرئيسيّة، فكانت القوافل التجاريّة من أهم مصادر الدخل لسبأ، وقد خالف القرآن الكريم تفصيلات التوراة بدءًا من مملكة سليمان التي سخر له الله (عزّ وجل) فيها مُلكًا وجعل له السلطان على جميع المخلوقات، كذلك الإشارة إلى دور طائر الهدهد الذي أخبره بعبادة أهل سبأ للشمس كيف صار رسوله إلى ملكتهم، واستدعاء سليمان لهم خلافًا لما ورد في سفر الملوك، وتقرّر القصّة مبدأ الشورى في الحكم وإمكانية تدارك دخول العدو المحارب الغالب البلاد عنوة لخطورته، لذا يتلافى الأمر بالمصالحة، وتلبيتها لدعوة سليمان بالحضور إلى الشام وتقرير أنّ سليمان كان يستخدم الجنّ وأنّهم يخدمونه في أصعب الأمور، بيّنت حصافة بلقيس بعد أن فوجئت بوصول عرشها قبلها، واستجابة الله (عزّ وجل) لسليمان بعد أن أحضر له العرش من مسافة
شهرين أي من اليمن إلى الشام قبل ارتداد طرف الناظر إذا فتح عينه ينظر، والإشارة إلى تطوّر الطّرز المعماريّة إبّان عهد سليمان.
ولو كان القرآن قد اقتبس من الكتاب المقدّس جزءًا من الأحداث أو اقتبس الأحداث كلّها، وَلَو مع صياغة جديدة لما تغيّر من المعنى شيئًا، ولكان لدعوى الاقتباس هذه ما يؤيّدها من الواقع القرآني نفسه، ولما تردّد في تصديقها أحد؛ لكن القرآن الكريم يقتبس جزءًا من الواقعة، لا الواقعة كلّها، بل استدرك كثيرًا من الأخطاء إمّا بالسكوت أو بالنصّ؛ وهذا لا يتأتّى من مقتبس ليس له مصدر سوى ما اقتبس منه، وإنّما يتأتّى ممّن له مصدره ووسائله وسلطانه المتفوّق، بحيث يتخطّى كلّ الحواجز، ويسجّل الواقعة من مسرحها كما رآها وعقلها؛ لأنّه الوحي الصادق، وليس ما سجّله الأحبار والكهان.
لقد ترفّع القرآن الكريم عن ذكر الصّور القاتمة للأنبياء في كتب العهدين، فلم يأتِ إلى ذِكْره بما يشينه ويحطّ من قدره، كما ورد في سفر التكوين، بل قدّمه بصورة الكريم الذي يعرض ابنتيه على قومه ليحفظ شرف ضيوفه، ولم يشِر إلى كفر سليمان في أواخر أيّامه باتّباعه آلهة غير الله محاباة لنسائه اللواتي أملن قلبه، بل بَرَّأَ القرآن ساحته لينسف عنه تهمة الكفر، كما أزاح عن هارون بن عمران تهمة صناعة العجل المقدّس، ليحمل وزرها السامري، كما أنّ القرآن تسامى بالأنبياء الذين جعلت منهم التوراة لصوصًا، وصوّرهم بأرفع الدرجات، وليس
ذلك فحسب بل وعلى الرغم من الاتّفاق بين التوراة والقرآن على عفّة يوسف من تهمة المراودة لزوجة العزيز، إلّا أنّ رواية التّوراة تحمل بين جنباتها إدانة صريحة ليوسف ولا سيّما بعد أن ترك ثوبه معها بنحو يتنافى مع عفّته القرآنيّة التي جاءت فيها إدانة صريحة لامرأة العزيز، وبراءة كاملة ليوسف وبشهادة شاهد. وصفوة القول: إنّ القرآن استدرك على الرؤية الكتابيّة ولم يصبه منها صفة الانتحال.
لقد أعطت عناصر القصّة القرآنية معنى جديدًا، لتسدّ فراغًا موجودًا، وتقف عقبة أمام سؤال التّأثير والتأثّر، فإذا كان القرآن ناقلًا أو منتحلًا فلِم يقع الخلاف في عناصر أساسيّة تعطي القصّة القرآنيّة خصوصيّة مَعَانٍ لا توجد في الكتاب المقدّس، إنّ أوجه التباين تدحض فكرة التوافق الكامل وتدحض معه فكرة النقل الكامل، ويثبت أنّ المقارنة المتوسل بها اهتمت ببعض العناصر السرديّة وأغفلت بقيّة مكوّنات القصّة ومراميها وسياقات إيرادها التي تعطيها معانٍ جديدة ودلالات عديدة لا توجد في كتب العهدين.
ولعلّ اللافت في كتب العهدين ندرة الحوارات بين الأنبياء وبين فرقائهم فلا تُلمس أي تفصيلات عن سيرة الأنبياء مع أقوامهم ولا تظهر نزعة المواجهة بين الأنبياء والمعارضين خلافًا لما يرد في القرآن في ذلك من حوارات مفصّلة تجلو فيها نبرة الحجاج، خذ مثلًا حياة إبراهيم فلو طالعناها على طول العهد القديم سوف لا نلمس خطابًا واحدًا على لسانه يدعو فيه النّاس إلى عبادة الله ما عدا قيامه ببناء معابد للربّ، خلافًا لما جاء في القرآن الكريم الذي بيّن خطابه مع أبيه، ومع قومه، ورفضه لعبادة الأصنام.
زد على ذلك فإنّ الخطاب القرآني لم يكن مخصّصًا إلى شعب واحد كما في
التوراة، لأنّه خطاب عام للبشريّة قاطبة جاء موجّهًا إلى بني آدم أو العالمين أو النّاس، ويبدو أنّ ميور أدرك هذه السّمة التي امتاز بها القرآن الكريم عن كتب العهدين فزعم أنّ الرّسول صلىاللهعليهوآله تكلّم بلغة عصره على لسان الأنبياء السابقين، وهذا غير منطقي لتعارض ذلك مع دلالة التغاير التي تشتمل عليها تفصيلات كل قصّة عن سواها من هذه القصص.
فلو كان هذا القرآن من عند محمّد صلىاللهعليهوآله فإمّا يكون قد درسه أو تعلّمه، فلا يُعقل أن يأتي بهذا البيان المتكامل من دون أي تناقض من خلال الروايات الشفويّة لأن الرواة لا بدّ من أن يتضاربوا في نقل هذه الروايات ويتناقضوا في إيراد الشرائع والعقائد المنقولة شفاهيًّا. إنّ الوحي لا يمكن أن يكون نتاجًا بسيطًا للمؤثّرات الخارجيّة لأنّ المصدر الأوّل والوحيد للقرآن هو الله (عزّ وجل) وحده دون سواه.
وإلى ذلك يشير المستشرق كراك Cragg: «إنّ القصص التوراتيّة أعيدت صياغتها في السياق القرآني بنحو مختلف يحمل على الاعتقاد بأنّ المعرفة الشفاهيّة لم تكن مبعث المعرفة المباشرة بذلك»، ويرى أيضًا: «إن مدى التأثير الشفاهي على محمّد ونوعيته غير كافية لتمكّنه من الإحاطة بمعرفة تامّة عن الأديان».
ومهما بذل ميور من محاولات لتجميع نقاط التّشابه بين النّصوص القرآنية والنّصوص الكتابيّة فذلك معناه اصطناع أسلحة تدعم المبادئ القرآنيّة، ولعلّ شهادة علماء بني اسرائيل دليل كاف على صدقها، فالاتّفاق شيء والاقتباس شيء آخر والبون شاسع بينهما.
لم تكن الأفكار الرائجة في هذا المجتمع الديني الكبير اتّجاه واحد بل كان لكلّ من المشركين والصابئين والفرس واليهود والنّصارى أسلوبهم الخاص في عرض الحقيقية ففي أيّ فريق من هؤلاء كان الرّسول صلىاللهعليهوآله يستطيع أن يضع ثقته وعلى أيّ دعوة من هذه المتناقضات يعتمد وهب أنّه حرص على أن يقصّ علينا عقيدة كل طائفة فأيّ خليط مخيف سينطوي عليه القرآن؟.
فحيثما اتّجه الرّسول صلىاللهعليهوآله وجد ضلالًا يحتاج إلى هداية وانحرافًا يتطلّب التقويم ولم يجد أنموذجًا أخلاقيًّا ودينيًّا يصلح لأن ينقله محمّد أو يبني عليه نظامه الإصلاحي فلا شكّ أن المواد التي صادفها حتّى الآن قد تجمّعت في بناء يصلح للهدم ولم يكن فيها ما يصلح ليقيم عليه بناءه الجديد.
يذكر ميور: «أن التّماثل بين القرآن والكتاب المقدّس لم يقف عند الموضوعات بل بلغ حدّ المشابهة في النسق»، ويرى أيضًا: «أن القرآن يقسّم إلى ثلاثين جزءًا كما في المزامير لدواعي الملاءمة، وباستخدام أجزاء بحسب الأيام، وتتم قراءتها طول الشهر»، أمّا البسملة فيرى: «أنّها تتطابق مع صيغة إنجيليّة».
إنّ الجديد في لغة القرآن أنّه في كل شأن يتناوله من شؤون القول يتخيّر له أشرف المواد، وأمسّها رحمًا بالمعنى المراد، وأجمعها للشوارد، وأقبلها للامتزاج، ويضع كل مثقال ذرّة في موضعها، بحيث لا يجد المعنى في لفظه إلا مرآته النّاصعة، وصورته الكاملة، ولا يجد اللّفظ في معناه إلّا وطنه الأمين ولعلّ المسحة البشريّة الحسّيّة
تظهر جليّة في الكتاب المقدّس الذي يغصّ بالتعبيرات الجنسيّة الصاخبة، خلافًا لنسق القرآن الكريم الذي يضع الأحداث ضمن أقيستها العقلائيّة، فلو تجاوزنا سمة البلاغة القرآنيّة وترجمنا القرآن إلى أيّ لغة بنحو غير احترافي، فهل سيكون السياق القرآني مماثلًا لما جاء في الكتاب المقدّس من حيث الصبغة التجسيديّة وتصوير الأحداث التاريخيّة على صورة أخيلة جنسيّة صاخبة على غرار ما يرد في سفر نشيد الإنشاد.
لقد وضع ميور في دراسة القرآن الكريم أكثر من مصنّف فهل وجد حالة مماثلة من جنس هذه التّشبيهات، ومبلغ التّباين يظهر جليًّا بين القرآن الكريم والكتاب المقدّس من جهة الأسلوب في بيان القصص، فالقرآن يُبَيّن ما هو عبرة لأولي العقول، والقرآن الكريم في قصصه لم يسلك مسلك التوراة، ولم يقصّ أخبار الأنبياء والمرسلين كما قصّت هي وإنّما اختار بعضهم ليقصّ قصصهم وأعرض عن الباقي كما في قولهِ تعالى: (وَرُسُلًا قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ مِن قَبْلُ وَرُسُلًا لَّمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ) (سورة النساء: الآية 164)، ومن هنا فإن ذلك الاختيار من الأخبار كان يتّفق مع حالة الدّعوة ومخاطبة الرّسول صلىاللهعليهوآله لقومهِ، لذلك لم تأت تلك الأخبار على التفصيل الموجود في التوراة، كما أنّ القرآن الكريم لم يعمد إلى الزمن فيجعله العامل الأساس في ترتيب هذه القصص كما عمدت التوراة؛ ما يدلّ على الفارق الأكبر بين قصص القرآن الكريم وبين قصص التوراة التي قصدت المنحى التاريخي، أمّا القرآن فقصد المنحى الإرشادي إن صحّ البيان.
أمّا البسملة فقد أورد ميور هذا الرأي بصيغة افتراضيّة غير جازمة بعبارة «ربّما أخذت من صيغة مسيحيّة»؛ بما يوحي بعدم حيازته على دليل على صحّة هذا الفرض، والنقطة الأخرى أنّه أشار إلى هذه المسألة من دون أن يشير إلى هذه النّصوص المسيحيّة، أو طبيعة هذا الاقتباس ودلالاته وهذه نقطة السلبيّة تسجّل
على منهج ميور وتوحي بأنّه اقتبس هذا الرأي وضمّنه في مصنّفاته دون مناقشة ودون إحالة إلى مصدره؛ وبالعودة إلى نصوص العهدين لا نلمس سوى إشارات مثل «باسم الرب» ولعلّ ميور عوّل على قراءة شاذّة لعبارة «ثيو θεου أو بسم الله» الواردة في مخطوطة بيزا، إحدى مخطوطات العهد الجديد التي تعود إلى القرن الخامس الميلادي؛ ووردت أيضًا بصيغة «باسم الهنا» وهي في الأصل العبري «בשם-יהוהאלהינו بشيم يهوه إلوهينو» أي «باسم يهوه إلهنا».
إنّ البداءة بالبسملة معروفة في الكتابات الدينيّة القديمة المدّعى لها القداسة، إذ هي إعلان لافتتاح قراءة، ولا تُماثل دلالة البسملة في الإسلام من حيث الموضع في فواتح السّور أو من حيث البيان، فقد روي عن الإمام الصادق أنّه قال: «البسملة تيجان السّور»، والبسملة ليست الابتداء باسم الله ذي الرحمة الواسعة، الراحم لخلقه، في قراءة القرآن الكريم طلبًا للبركة فحسب بل تنطوي على معان عقديّة وروحيّة في الإسلام لا توجد لها معان مُمَاثلة في أي عقيدة أخرى.
لقد أشار القرآن إلى أنّ البسملة كانت تتصدّر الرسائل في زمن سليمان، كما أنّ العرب كانت تجهل بيان بسم الله الرحمن الرحيم، وكانت تستفتح بعبارة «باسمك اللهم» كما ورد في خبر الحديبيّة وحديث سهيل بن عمر، وإن فرضنا من قبيل الجدل مقاربة في الجذور فيبدو أنّ القرآن اتّجه صوب نظرة توحيديّة صارمة، ينأى من خلالها بقوّة عن المسيحيّة ويتّخذ موقف إنكار من مماهاة الله
بالمسيح، فمفهوم الرحمن هنا يلعب دوره ولا سيّما وأنّ الرّسول صلىاللهعليهوآله يعتمده لمماهاة إلهه بالخالق الأصلي مع إنكار لأيّ تجسيد وأيّ بنوة لأنّ الإسلام رجوع إلى الإله الأصلي المتعالي من فوق المسيحيّة فلم يكن القرشيّون يعرفون الرحمن، فيقولون وما الرحمن، إنّما يعرفون الله الإله السماوي العالي إذ هو من تراثهم العتيق، فالقرآن أراد المماهاة بين مفهوم الله الواحد ومفهوم الرحمن المسيحي، أي تجاوز التّصورات عن الله القرشي الذي له جذور وثنيّة، وبالتالي ربط الصلة مع المسيحيّة مع إنكار التجسيد.
ومن الملاحظ أنّ عبارات البداءة الكتابية حملت بين طيّاتها معان متباينة، على سبيل البيان ارتبط معنى «اسم الرب» في إنجيل متّى (23:39) بالفهم الكنسي المتعلّق بعودة المسيح في آخر الزمان، وبمفهوم الخلاص الذي يقدّمه المسيح.
ويبدو أنّ ميور لم يكن أوّل من تقوّل بذلك، إذ يظهر أنّ الألماني نولدكه سبقه إلى هذا الرأي وكان لعبد الرحمن بدوي وقفة مع هذه المسألة نورد طرفًا منها: ولكنّي عبثًا بحثت في العهد القديم فلم أجد عن صيغة «بسم ياوا أو يهوة»؛ صيغة للصلاة ومناجاة الله؛ كمعنى البسملة في القرآن وفي الحقيقة إنّ «بسم يهوة» مستعملة في النّسخة العبريّة من العهد القديم في (سفر الملوك الإصحاح 18)، الآية 24: «ثم تدعون باسم آلهتكم وأنا أدعو باسم الرب يهوة» ومن الواضح أنّه ليس هناك أي تشابه مع البسملة، كل ما يقال هنا ادع إلهك وأنا سأدعو إلهي، إنّه من السذاجة أن نلمس في هذه الآية التوراتيّة على أصل البسملة التي تقول بسم الله الرحمن الرحيم... وهناك آية توراتية أخرى استعمل فيها التعبير يهوة «Yahwa Bishm» بالعبريّة ولكن ليس بمعنى النّداء، وإنّما فقط بمعنى: «بعون يهوة»، في الآية (46) من (سفر صموئيل الأوّل الإصحاح 17) فَقَالَ دَاوُدُ لِلْفِلِسْطِينِيِّ: «أَنْتَ تَأْتِي إِلَيَّ بِسَيْفٍ وَبِرُمْحٍ وَبِتُرْسٍ، وَأَنَا آتِي إِلَيْكَ بِاسْمِ رَبِّ الْجُنُودِ».
أمّا في ما يتعلّق بالعهد الجديد، فإنّ افتراض نولدكه أقلّ موضوعيّة لأنّه يرجُع البسملة إلى الآية 17 من الإصحاح الثالث من رسالة القديس بولس إلى أهل كورنثا إذ يقول: «وكل ما عملتم بقول أو فعل فاعملوا الكل باسم الرب يسوع شاكرين لله والأب به» فليس هناك أيّ علاقة فالآية تسير في اتّجاه معاكس لمعنى البسملة.
لقد أقرّ كثير من الباحثين بأنّ التّناقضات وعدم التجانس في نصوص التوراة تؤكّد حقيقة أنّ الأناجيل تنطوي على فصول من نتاج الخيال البشري، جاءت من خلال فكر الكنيسة وآراء المؤلّفين وفي ذلك يقول جراهام سكروجي: «إنّ الكتاب المقدّس بشري، وهذه الكتب المقدّسة قد مرّت عبر عقول الناس، فهي مكتوبة بلغة النّاس، وخطّت بأقلام النّاس وأيديهم تحمل في أساليبها خصائص البشر».
أمّا عن ذريعة التّماثل بين القرآن والمزامير، فالأخيرة تعدّ مجموعة من الأشعار الدينيّة الملحّنة وغرضها تمجيد الله وشكره كانت ترنّم على صوت المزمار وغيره من الآلات الموسيقية، وبلغت 150 مزمورًا، استمرّ تأليفها نحو ألف سنة، من أيّام موسى إلى العودة من السبي البابلي، أو حتّى بعدها بقليل في أيام النبي عزرا غير أنّ أكثرها كتب في أيّام داود وسليمان وينسب 73 مزمورًا منها لداود حسب عناوينها وهو أشهر المؤلّفين ورئيس المهتمّين لذلك كثيرًا ما سمّيت؛ كمجموع «مزامير داود» ويُطلَق عليه في الإسلام «الزبور»، وتقسّم هذه المزامير إلى خمسة كتب، تنتهي كل منها بتسبيحة وتكرار لفظة آمين مرتين، أضافها جامعو الكتاب لا مؤلّفو المزامير ولعلّ هذا التّقسيم الخماسي يرمز إلى الأسفار الموسويّة الخمسة، ويتضمّن الكتاب الأول: 41 مزمورًا، أمّا الكتاب الثاني فيتضمن: 31 مزمورًا، والكتاب الثالث: 7 مزامير، والكتاب الرابع: 17 مزمورًا أيضًا، والكتاب الخامس: 44 مزمورًا.
أمّا مسألة تبويب القرآن إلى 30 جزءًا، فلم تحدث على عهد الرّسول صلىاللهعليهوآله بل حدثت على عهد الصحابة بناءً على ما تعلّموه منه، فعن أوس بن حذيفة قال:
«قدمنا على رسول الله صلىاللهعليهوآله وفد ثقيف إلى أن قال: فأبطأ علينا ذات ليلة فأطال فقلنا: يا رسول الله أبطأت علينا فقال: «إنه طرأ علي حزب من القرآن فكرهت أن أخرج حتّى أقضيه»، فسألنا أصحاب رسول الله صلىاللهعليهوآله كيف كان صلىاللهعليهوآله يحزّب القرآن فقالوا: كان يحزّبه ثلاثًا وخمسًا وسبعًا وتسعًا وإحدى عشرة وثلاث عشرة وحزب المفصل» وهذا يدلّ على أنّهم قد اكتسبوا التحزيب من الرّسول صلىاللهعليهوآله تعلّمًا.
ووفقًا لما وردنا من رواية أوس بن حذيفة ظهر من الرواية السّابقة أنّ النبي صلىاللهعليهوآله كان يقسّم القرآن إلى سبعة أحزاب، وكلّ حزب مذكور إنّما هو منزل واحد من سبع منازل، وأمّا ما اصطلح عليه المتأخّرون من تقسيم القرآن إلى ثلاثين حزبًا وسمّوها أجزاء، ونحو ذلك كان في زمن الحجّاج وما بعده، وروى أن الحجّاج أمر بذلك ومن العراق فشا ذلك، ولم يكن أهل المدينة يعرفون ذلك.
فلا ريب أنّ ميور جنح إلى تسطيح المفاهيم دون تفصيل لتوافق رؤيته ولعلّه عوّل على التّقارب الوحيد في محتوى الكتاب الثاني من المزامير الذي ينطوي على 31 مزمورًا التي تمثّل الأسفار (42-72) من سفر المزامير الكلّي وعدها حجّة على صدق مزاعمه، والصحيح أن هذا الزعم لا يستقيم بسبب تعارض التبويب الشمولي بين القرآن وسفر المزامير الذي ينطوي على 150 مزمورًا، بينما يتألّف القرآن من 30 جزءًا، ولو فرضنا جدلًا حدوث الاقتباس حري أن يكون تقسيم القرآن على خمسة أجزاء ليقابل عدد الكتب الكلية أو يكون على 150 جزءًا وهي عدد المزامير الكلية وليس 114 سورة، زد على ذلك أنّ المزامير أو الكتاب المقدّس بصفة عامّة لا تنطوي على نسق رقمي متساو أو تقسيم ثلاثيني، بالتالي لا تستقيم حجة اقتباس. وصفوة القول: إنّ التّناغم بين عدد أجزاء القرآن الثلاثين وبين الكتاب المقدّس غير حاصل، فالكتاب المقدّس يتألّف من عهدين، العهد القديم الذي يتألّف من 46 سفرًا والعهد الجديد يتألف من 27 سفرًا.
ويلاحظ في المزامير أنّ اليهود والمسيحيّين مؤمنين بأنّ محتوى هذه المزامير من عبارات الشكر والثّناء والتعظيم دليل على أنّها من عند الله أوحاها إلى قلب الإنسان، كذلك الأمر بالنسبة إلى نصوص القرآن الكريم التي تزخر بعبارات تمجيد الله وتعظيمه فعبارات التّسبيح تتكرّر 89 مرّة وعبارات الحمد 50 مرّة والشكر 62 مرّة والتوبة 60 مرّة، فضلًا عن عبارات المناجاة لله، والبشرى والمواساة والحثّ على الصبر ونحوها، وعلى الرغم من ذلك فإنّ ميور لا يقيم هذه الحيثيّات أدلّة على المصدريّة الإلهيّة للقرآن.
إنّ رؤية ميور في هذه القضيّة تقف على أرض رخوة لأنّه لم يقدّم نظريّة ذات أركان موضوعيّة معوّلًا على نزر من المتقاربات في الأنسقة القصصيّة والسياقيّة التي لا تحمل بين طيّاتها دليلًا على الانتحال بقدر ما تمثّل حالة من التفرّد والخصوصيّة، ولا سيّما أنّ الخطاب التوراتي يختصّ بنظريّة الشعب المختار والخطاب الإنجيلي يختصّ بالمسيح، أمّا الخطاب القرآني فهو خطاب شامل لا يرد في ظاهرة خصوصيّة لفرد أو جماعة، فالحجج التي يقدّمها ميور غير مقنعة لإزاحة صفة الأصالة عن القرآن ولا سيّما وأنّ النسق القرآني أعظم من أن يقف عند حدود التقسيم الثلاثيني أو البسملة.
من خلال تتبّع الباحث لرؤية المستشرق وليم ميور في القضايا الإسلاميّة والقرآنيّة، ولا سيّما قضيّتا الوحي والنبوّة، يتبيّن الآتي:
1. تعدّ رؤية المستشرق البريطاني وليم ميور من أخطر النظريّات التي ظهرت في العصر الحديث في تفسير جذور الإسلام إذ تمثّل تأصيلًا للموروث القروسطي المتحامل، لكن بصبغة المتغيّرات المنهجيّة والمفاهيميّة للقرن التاسع عشر، إذ لم يرعوِ ميور عن استخدام عبارات خطابيّة حادّة اللّهجة، دون أدنى اعتبار للمكانة الروحيّة والرمزيّة للنبوّة المحمّديّة في التّاريخ البشري قاطبة وما أحدثته من تغيّرات أخلاقيّة وإنسانيّة ودون أن يقيم اعتبارًا لمشاعر المسلمين؛ فالوحي المحمّدي من منظور وليم ميور يمثّل حالة من الاضطرابات المرضيّة العقليّة المزعومة، ظهرت على الرّسول صلىاللهعليهوآله منذ الطفولة المبكّرة بفعل التّأثير الماورائي الشيطاني والرغبة العارمة في لقاء الوحي الذي بلغ منتهاه حدّ خداع ذاته بفعل الإسراف في أحلام اليقظة؛ لكن الوحي المتخيّل في تصوّر ميور ليس وحي السماء، بل ألمح إلى كونه أحد أتباع الشيطان الذي كانت له السطوة على مكنون الرّسول صلىاللهعليهوآله العقلي مقابل الصفقة التي أبرمها معه لإحكام قبضته على العالم، التي عرضت على المسيح فرفضها.
أمّا النبوّة في رؤية ميور فتمثّل تجلٍّ لتلك الرؤى ظهرت في مرحلة صارت الحاجة ملحّة إلى التغيّر بفعل جاهليّة العرب أو بفعل التشظّي الديني لدى اليهود والنصارى؛ فزعم ميور أنّ الرّسول صلىاللهعليهوآله عكف على دراسة حيثيّات اليهوديّة والنصرانيّة والمفاهيم الدينيّة لدى عرب الجاهليّة وجزئيّاتها؛ والخروج بمنصهر هجين أو نبوّة اصطبغت بطابع إصلاحي كي يتسنّى للرسول صلىاللهعليهوآله إحداث التغيّر بإزاحة مراكز القوّة الدينيّة القديمة ويكون له السطوة على الجميع.
أمّا القرآن، فيرى ميور أنّه وحدة تأليفيّة بشريّة إبداعيّة تجسّد مراحل تطوّر
(423)فكرة الوحي في العقليّة المحمّديّة، من التأمّليّة الاعتباطيّة المتّشحة بالمسحة الشعريّة الحماسيّة نحو النبوّة اليقينيّة النثريّة والنزعة الخطابيّة السلطويّة، في إطار آليّة استلال مزدوجة من الموروثات البيئويّة والكتابيّة.
2. من خلال تتبّع وتحليل مضامين الخطاب التاريخي البريطاني تجاه مادّة الإسلام، وجد الباحث، أنّه ينطوي على مركب ينطوي على ثلاثة مضامين: الأوّل، يمثّل المضمون المثيولوجي أو الخرافي، والثاني يمثّل المضمون التدويني المنهجي، أمّا الثالث فيمثّل المضمون الشعبي الفلكلوري، ويبدو أنّ هذا الخطاب حمل بين طيّاته انعكاسًا لتطوّر العقليّة الاستشراقيّة البريطانيّة بفعل إرهاصات عصر التنوير وظهور حركات التجديد والأنشطة الاستعماريّة، من خلال تقليل حدة النّبرة الهجوميّة الدعائيّة مقابل التحوّلات المنهجيّة ذات الوقع الأعمق.
3. تمثّل رؤية ميور لقضيّة الوحي والنبوّة طيفًا تاريخيًّا لأهم الإرهاصات الفكريّة القديمة للاستشراق البريطاني، إذ شرع باستحضار نظريّة الإلهام الشيطاني والوحي المتخيّل، فضلًا عن نظريّة الانتحال من الكتاب المقدّس، التي ذاعت في الأروقة المسيحيّة منذ العهد البيزنطي، مرورًا برؤية بطرس المـبجل Petrus Vernailes (1059-1156م) الذي وظّف الكتابة في ميدان الإسلام لتنصير المسلمين وجذبهم إلى فلك الكنيسة، ولا سيّما بعد أن حذا ميور حذوه في ترجمة «رسالة الكندي» ذات الصبغة الجدليّة المتحاملة لتكون أداة ناجعة للتنصير، كذلك لم يخالف ميور رؤية روجر بيكون (1214-1294م)، الذي أدرك أنّ الصراع العسكري مع الإسلام لا يكفي لمقارعته، وينبغي التوغّل في مضامينه بنحو معمق للكشف عن نقاط ضعفه وضرب إرادته وإثارة ريبة المسلمين في حيثيّاته ومن ثمّ استمالتهم نحو المسيحيّة.
4. ظهر للباحث أنّ الخطاب الاستشراقي لدى المستشرق وليم ميور كان موجّهًا إلى شريحتين يمثّلان جذبين متناقضين؛ الشريحة الأولى: شريحة المبشّرين المسيحيّين ونحوهم، لتكون آراؤه حججًا بحوزتهم لمناكفة المسلمين في معركة
التّبشير أو التّنصير إن صحّ البيان، والشريحة الثانية: شريحة المسلمين لدعوتهم إلى إعادة النّظر في موروثهم الدّيني، الأمر الذي يوحي بأن ميور أحدث نقلة نوعية في الخطاب الاستشراقي الذي غدا ذا تأثير مزدوج، ولا سيّما في مرحلة ما بعد الهند من حياة ميور بعد أن كان خطابًا أحادي يُوجّه إلى فئة دون أخرى، وبذلك تبلورت على يد ميور ملامح منهج خطابي جديد يمكن أن ندعوه (السيرة أداة التنصير).
5. يمثّل ميور أنموذجًا نادرًا للسياسي والمبشّر، إذ أهلّته عقليّته المتشدّدة للنصرانيّة إلى المزاوجة بين المنهج التاريخي والمنهج الجدلي اللاهوتي الذي يتّبعه المنصرون بمنتهى البراعة، ولعلّ ذلك كان سببًا لانتدابه للعمل مع مجموعة المبشّر بفاندر، علاوة على مكانته السياسيّة الرفيعة في حكومة الهند، لتكون كتاباته جزءًا من مرحلة سياسيّة تفضي بتحقيق غايات سياسيّة استعماريّة عن طريق الأنشطة التنصيريّة.
6. أظهرت الدراسة أنّ إيحائية النص (التوراتي- الإنجيلي- القرآني- السِيَري) كان لها أثر في صيرورة الخطاب التقويضي لدى ميور، فوحي التوراة ألهمه إنكار المكانة الروحية للفرع الإسماعيلي من إبراهيم؛ أمّا وحي الإنجيل فقد عزّز لديه موروثاته الكنسية الميثولوجيّة وأوحى له بنظريّة الصفقة الميكافيليّة مع الشيطان؛ بوصفه عنوانًا للجانب الماورائي للنبوّة المحمّديّة؛ أمّا القرآن فلعلّه استوحى منه التّعليلات التي تفسّر الحيثيّات المنهجيّة والخطابيّة والآليّات التّطوريّة لصيرورة النبوّة المحمّديّة، أمّا النص السِيَري فيظهر أن ميور قد رسم من خلاله ملامح الشخصيّة النبويّة (المتأمّلة والحالمة والمتشكّكة والمضطربة والميكافيليّة والمتقلّبة فضلًا عن الشخصيّة الوجدانيّة).
7. إنّ نظريّة الوحي الشيطاني التي ألزم ميور نفسه باعتمادها ليست سوى صورة خياليّة من الموروث القروسطي للكنيسة من جنس حكايات الجن والعفاريت وليست موضوعًا قائمًا على المنطق والسبب والنتيجة، أو التجلّي
القيمي، عمد ميور إلى إعادة صياغتها وفقًا لمعايير منهجيّة وسعى لإعطائها بعدًا تاريخيًّا، الأمر الذي يُعدّ دليل على اعتناقه فكرًا غيبيًّا ماورائيًّا ويؤكّد تأثّره العميق بالفكر الميثولوجي للكنيسة.
8. شرّع ميور إلى استبدال مصطلح المنتحل imposter الذي ذاع في الموروث الاستشراقي إلى مصطلح self-deception خداع الذات، واعتماد النظريّات المرضيّة وليّ النصوص لتكون متّسقة مع الموروث الأيديولوجي للكنيسة ونظرتها للإسلام في عصره.
9. تبنّى ميور فلسفة مزدوجة (مثالية-ماديّة) في قراءة حيثيّات الوحي والنبوّة، فتارة يحتكم إلى التوراة لتصديق فروضه حول نفي صلة إبراهيم بمكّة، وتارة يذهب إلى عقلنة كل ما هو غيبي في الإسلام، وقد ظهر للباحث غياب النظرة الموضوعيّة للتاريخ عند ميور، من خلال أحكامه المتعارضة أحيانًا، أو الكيل بمكيالين، ولا سيّما وأنّ التشابه من وجهة نظره مأخوذ من التوراة أو الإنجيل، بينما الفرادة، فَتُعدّ انحرافًا في معرض حديثه عن العلاقة بين القرآن الكريم والكتاب المقدّس.
10. حملت متون ميور بين طيّاتها صورة مضطربة لشخصيّة الباحث لديه، فتارة يصور الرّسول صلىاللهعليهوآله بأنّه شخص لديه سجل مرضيّ اضطرابي، وتارة أخرى يصوّره على أنّه إصلاحي ثوري برع في تغيير خارطة الوثنيّة في شبه جزيرة العرب نحو التوحيد، ولعلّ ذلك يرتد إلى حالة تأرجح بين موروثه الديني؛ بصفته مبشّرًا مسيحيًّا وبين النتائج المنطقيّة التي خلص لها؛ بصفته باحثًا تاريخيًّا ورجلَ حرب لا يؤمن إلّا بمعطيات الميدان، أو لعلّه أعجب بشخصيّة الرّسول صلىاللهعليهوآله؛ بوصفه إنسانًا له إمكانيّات عقليّة فذّة أهّلته كي يقود حركة الإصلاح أو التغيير الديني دون إقرار بنبوّته.
11. يُعدّ وليم ميور رائد الاستشراق البريطاني في تحديد رؤية تعليليّة لأسباب الإخفاقات التي منيت بها الكنيسة في حربها مع غريمها «الإسلام» حسب ميور،
التي كانت أبرزها النبرة العدائيّة الحماسيّة في الكتابات الأوروبيّة، لافتًا إلى أهميّة اعتماد المصادر الإسلاميّة؛ بوصفها سلاحًا فاعلًا لكسب هذه الحرب، ولا سيّما أن ميور يعد أول كاتب بريطاني استخدم هذه المصادر في الكتابة عن تاريخ الإسلام، من خلال توظيفها في بناء أيديولوجي متحيّز يميط اللّثام من خلاله عن مواطن الضعف في البنية النصيّة الإسلاميّة، أو من خلال محاولته إظهار ما يعرف بالرواية المذهبيّة في السيرة التي تعدّ من المحاولات الجديدة في الميدان الاستشراقي، ولا سيّما أنّه قد أظهر ميلًا نحو التّشكيك في الرّواية العلويّة، ومردّ ذلك إلى المواجهة مع المجتهدين الشيعة، وميله نحو جماعة أهل الحديث.
12. إنّ قراءة ميور لجزئيّات تاريخ الوحي والنبوّة ومحاولة ترتيبه السّور القرآنيّة وفق منهج زمني يوحي بأنّه كان مولعًا بالتاريخ الإسلامي ومدار اهتمامه بميدان السّيرة النبويّة يتجاوز حدود التّكليف الرسمي بل يتعدّاه إلى وجود ميول ذاتيّة نحو مادّة الإسلام، فضلًا عن الفواعل الاجتماعيّة والسياسيّة والتنصيريّة والأكاديميّة، وكذلك الأسباب الموضوعيّة المتعلّقة بمنهج الكنيسة وسياسة الحكومة البريطانيّة.
13. يعدّ ميور رائد الاستشراق البريطاني في تأصيل الجذور التاريخيّة للنبوّة المحمّديّة، ولا سيّما في قضيّة مكّة والكعبة وطقوسها وإنكار إبراهيميتهما وإنكار مشروعيّة النبوّة في ذرية إسماعيل، بناءً على تأويلات كتابيّة أو محاولات أيديولوجيّة لتوظيف الحالة الدينيّة للعرب قبل البعثة، أو من خلال إقحام شهادات تاريخيّة متأخّرة، أو بناءً على فرضيّات غير مسندة بأدلّة قطعيّة، ودون أن يقدّم البديل في قضيّة جوهريّة لها مثل هذا العمق في الذاكرة العربيّة، حازت على مصادقة الوحي في الإسلام.
14. اعتمد ميور منهجًا انتقائيًّا عوّل فيه على فرضيّات واحتمالات غير مسندة ووجهات نظر خاصّة، أو على الأخبار الضعيفة في المصادر الإسلاميّة من خلال
البحث المعمّق في المسائل الخلافيّة وتقصّي الضعيف والمنحول من الأخبار والروايات التي لم تخضع للفحص العلمي وتخالف الحيثيّات المنطقيّة لسياق أحداث السّيرة؛ مثل: رواية الانتحار التي تعدّ من أخطر المفتريات التي ظهرت في تاريخ الإسلام بغية التّشكيك بنبوّة الرّسول صلىاللهعليهوآله وعصمته، ولا سيّما أن مصادر السّيرة ليست كتبًا منزّهة واحتماليّة الدسّ والتّحريف فيها قائمة في إطار الأزمات السياسيّة التي عصفت بالتّاريخ الإسلامي، هذه المدوّنات التي لم يكشف عنها النّقاب إلّا في القرن 13ه/ 19م، ولعلّ في ذلك دلالة على تعرّض موروث السّيرة إلى التّشتت، إنّ وجود مثل هذا الطراز الغثّ من الروايات والمبثوث بين ثنايا مورثنا الفكري أعطى فرصة سانحة لميور وسواه من المستشرقين لاعتمادها ذرائع في بناء أيديولوجي مناهض للإسلام.
15. ظهر للباحث العديد من المآخذ المنهجيّة التي وقع فيها وليم ميور، ولا سيّما وقد انطلق في بيان هذه القضيّة من حيثيّات قبليّة يأتي بالنتائج والأحكام التاريخيّة والمفاهيميّة سلفًا ومن ثمّ يسعى إلى سرد المتون بغية إثباتها وليس العكس وهذا يمكن أن ندعوه المنهج العكسي.
16. ظهر للباحث أنّ الجانب الأيديولوجي كان الأكثر حضورًا في طروحات ميور بالمقارنة مع الجانب العلمي على الرغم من غزارة التأليف في حقل الاسلام، لذلك عوّل على اتّباع منهج القراءة الاجتزائيّة السلبيّة للنّصوص التي تتوافق مع توجّهاته، وعمد إلى توظيف اعتباطيّة الرموز أو من خلال التّحريف والتقوّل أو الالتفاف على النّصوص لتكون متناغمة مع الرؤية القروسطيّة عن الوحي الشيطاني المزعوم، ولا سيّما في إشارته إلى كلمة «أصيب» الواردة في رواية ابن هشام.
17. إن معالجات ميور جاءت ضمن منهج طابعه الشك والافتراض والرؤية المربكة والتّناقض والمحاولات المغلفة بالعلميّة والمنهجيّة فضلًا عن اتّباعه منهجًا خطابيًّا تعسفيًّا في التّفسير والاستنتاج والخضوع لهوى النّفس والبعد عن التجرّد العلمي.
18. إسراف ميور في تطبيق المنهج المادّي على موضوع ذي حيثيّات ماورائيّة التي كان يتحتّم عليه النظر إليها نظرة اعتدال من خلال التمعّن في تجليّاتها الأخلاقيّة والمفاهيميّة.
19. إسرافه في اتّباع منهج الأثر والتأثّر من خلال اختلاق مسرح المؤثّرات الكتابيّة في كل بقعة زارها الرّسول صلىاللهعليهوآله أو في كل شخص في محيطه، له صلة بالنصرانيّة واليهوديّة من قريب أو بعيد، حتّى صوّر أن الرّسول صلىاللهعليهوآله قد تلقّى دروسًا بعلم النبوّة إن صحّ البيان طوال سني عمره الأربعين قبل إعلانه عن الوحي.
20. إفراط ميور في الأثر اليهودي على الحياة الدينيّة والاجتماعيّة في الجزيرة العربيّة، فعدّهم مصدرًا لمعرفة العرب بإبراهيم من خلال تراثهم أو سلاسل أنسابهم وأنّهم أحد مصادر المعارف المحمّديّة عن الوحي، فضلًا عن استغراقه، في قضيّة التّأثير المسيحي على الرّسول صلىاللهعليهوآله الذي حمله إلى تبنّي نتائج خياليّة لا سيّما في قضية الرّسول صلىاللهعليهوآله وإيمانه المبكر بالمسيحيّة.
21. توظيفه للمنهج الفيلولوجي لإثبات مزاعمه بِشأن انتحال القرآن من الموروث الكتابي، واتّباعه لمنهج القراءة غير السياقيّة والإسقاطية التي يعتمد عليها في نقد مقولات النبوّة والوحي والقرآن، ولا سيّما في قضيّة الأصول المسيحيّة للبسملة، أو علاقة القرآن بالمزامير من حيث التّقسيم الثلاثيني.
هذا فضلًا عن طائفة أخرى من النتائج الضمنيّة التي تمخضت عن قراءة الباحث لحيثيّات هذه القضيّة وهي مبثوثة بين ثنايا الأطروحة.
هناك من يقول بوجوب إهمال دراسة المستشرقين والتركيز على دراسة تراثنا دراسة نقديّة لأنّ العلّة فيها، لقد خرجت هذه الدراسة بتوصيات إلى جميع المهتمين بهذه القضيّة، إلى إعادة النّظر في تراثنا الاسلامي لتشذيبه من الدخيل والغثّ، دون أن نغفل أهميّة الخطاب الاستشراقي الذي يعدّ الباعث الرئيس في صياغة التصوّرات الغربيّة عن الإسلام والمناطق ذات الأغلبيّة المسلمة في العالم، كما توصي أيضًا بضرورة البحث المعمّق في النّصوص الاستشراقيّة عن الآراء والطروحات الموضوعيّة المنصفة للإسلام ورسوله صلىاللهعليهوآله وبلغاتها الأصليّة، التي تعدّ نقطة ضعف في النسيج البنيوي الاستشراقي المخالف للتصوّرات الحقيقيّة عن التاريخ الإسلامي.
(430)
قصيدة (محمّد) للشاعر الإنكليزي صمويل_تايلور_كولريدج Samuel Taylor Cooleridge حملت عبارات تنطوي على مدح للرسول محمّد صلىاللهعليهوآله، المصدر:
Taylor, Samuel, The Poetical Works of S.T. Coleridge, Vol 2, London 1836, p.68
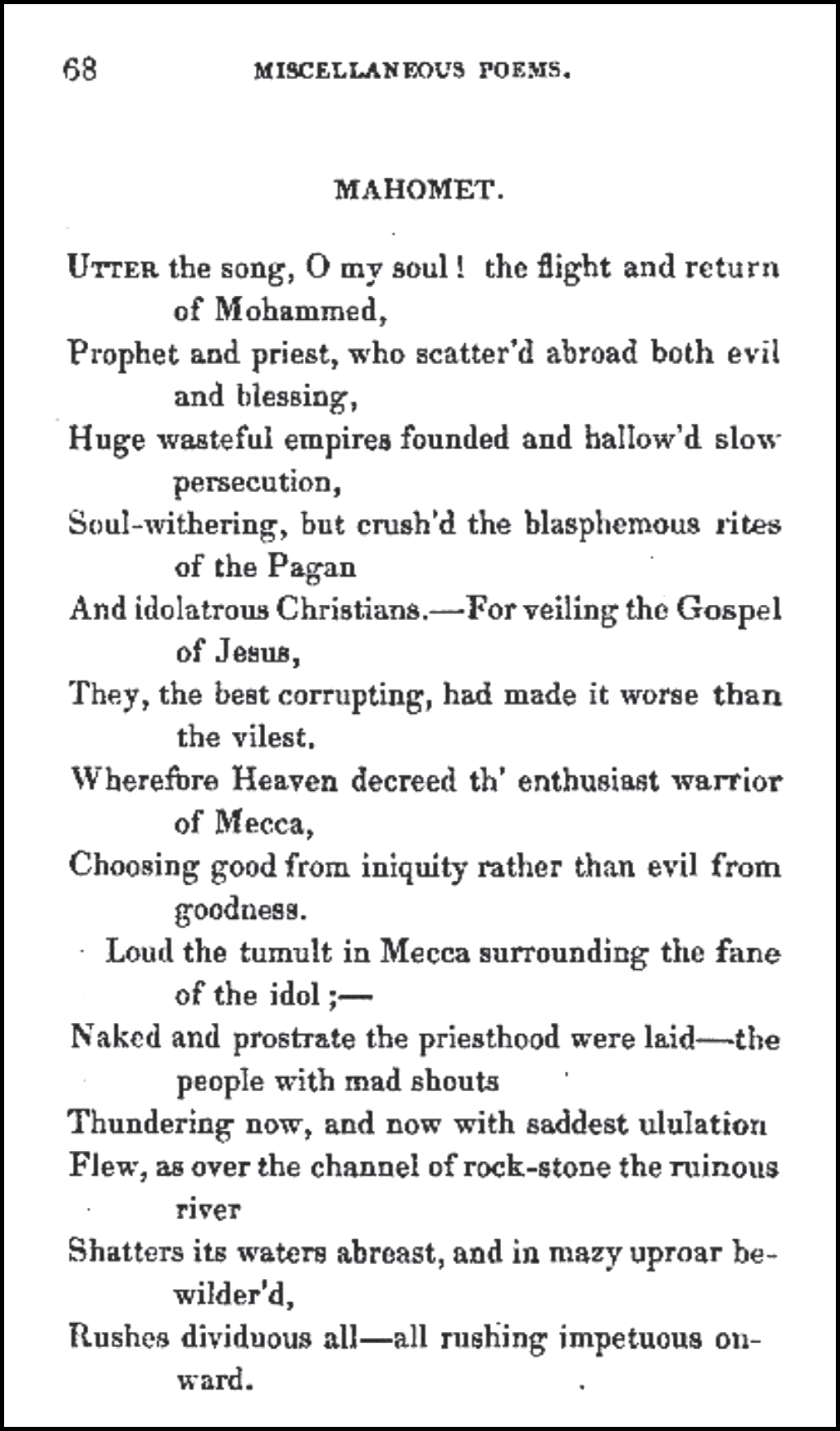
جدول يمثل الصلة بين النشاط التأليفي لميور في حقل الإسلام والتنصير وبين طبيعة المناصب التي اضطلع بها خلال مسيرته المهنية
|
ت |
اسم المصنف |
سنة التأليف |
منصب ميور |
المكان |
|
1 |
مقالات مجلة كلكتا |
1845-1852 |
نائب مستحصل جبايه فيتهابور والسكرتير الأعلى لمجلس الدخل فياگرا |
الهند |
|
2 |
الشهادة التي يحملها القرآن للنصوص اليهوديّة والمسيحيّة |
1856 |
سكرتير الحكومة للمقاطعة الشمالية الغربية في اگرا والله آباد |
الهند |
|
3 |
حياة محمّد |
1858-1861 |
سكرتير الحكومة المقاطعة الشمالية الغربية اگرا والله آباد |
الهند |
|
4 |
القرآن، نظمه وتعاليمه |
1878 |
وزير المالية في حكومة البنغال |
الهند |
|
5 |
تاريخ الكنيسة المسيحيّة |
1878 |
وزير المالية في حكومة البنغال |
الهند |
|
6 |
الشعر العربي القديم أصالته ووثاقته |
1879 |
عضوية مجلس الدولة الهندية |
لندن |
|
7 |
منتخبات من القرآن |
1880 |
عضوية مجلس الدولة الهندية |
لندن |
|
8 |
الخلافة المبكرة ونهوض الإسلام وفي عام |
1881 |
عضوية مجلس الدولة الهندية |
لندن |
|
ت |
اسم المصنف |
سنة التأليف |
منصب ميور |
المكان |
|
9 |
اعتذار الكندي |
1882 |
عضوية مجلس الدولة الهندية |
لندن |
|
10 |
الآية 91 من السورة 5 من القرآن |
1882 |
عضوية مجلس الدولة الهندية |
لندن |
|
11 |
حوليات الخلافة المبكرة |
1883 |
عضوية مجلس الدولة الهندية |
لندن |
|
12 |
الخطبة الافتتاحية لطلبة جامعة أدنبره |
1885 |
رئيس الجمعية الملكية الآسيوية ورئيس جامعة أدنبره |
اسكتلندة |
|
13 |
عشاء الرب شاهد حي على موت المسيح |
1886 |
رئيس جامعة أدنبره |
اسكتلندة |
|
14 |
محمد والإسلام |
1887 |
مستشار في جامعة هايلبوري رئيس جامعة أدنبره |
لندن \ اسكتلندة |
|
15 |
الإسلام نهوضه وانهياره |
1890 |
رئيس جامعة أدنبره |
اسكتلندة |
|
16 |
الخلافة قيامها، انحدارها وانهيارها |
1891 |
رئيس جامعة أدنبره |
اسكتلندة |
|
17 |
الحلوأول القطاف |
1893 |
رئيس جامعة أدنبره |
اسكتلندة |
|
18 |
منارة الحق أوشهادة القرآن على صدق المسيحية |
1894 |
رئيس جامعة أدنبره |
اسكتلندة |
|
19 |
المماليك أومملكة الرقيق في مصر |
1896 |
رئيس جامعة أدنبره |
اسكتلندة |
|
20 |
المبجل جيمس ثومسون |
1897 |
رئيس جامعة أدنبره |
اسكتلندة |
|
21 |
الجدل المحمدي |
1897 |
رئيس جامعة أدنبره |
اسكتلندة |
|
22 |
العهد القديم والعهد الجديد، ودعوة المسلم لمطالعتها |
1899 |
رئيس جامعة أدنبره |
اسكتلندة |
|
23 |
منابع القرآن |
1901 |
رئيس جامعة أدنبره |
اسكتلندة |
وثيقة تبيّن جدول سلّم الرواتب الشهريّة لموظفي الدرجة الأولى والثانية في حكومة الهند، يبيّن مدى التّفاوت بين راتب وليم ميور وبين رواتب موظفين الدرجة الأولى الأعلى وأقرانه من الدرجة الثانية، التي يتصدّر فيها ميور قائمة الموظّفين الأعلى دخلا بـ (8333 روبية) في حكومة الهند متفوّقًا على موظفي الدرجة الأولى الذين خدموا 35 سنة في حكومة الهند: المصدر:
Hart H, G, Colonel, the new army list militia list and Indian civil service list the rank standing and various service every regimental officer in the army serving on full pay include royal marines and Indian stuff Corbs, London ,1870, p.481
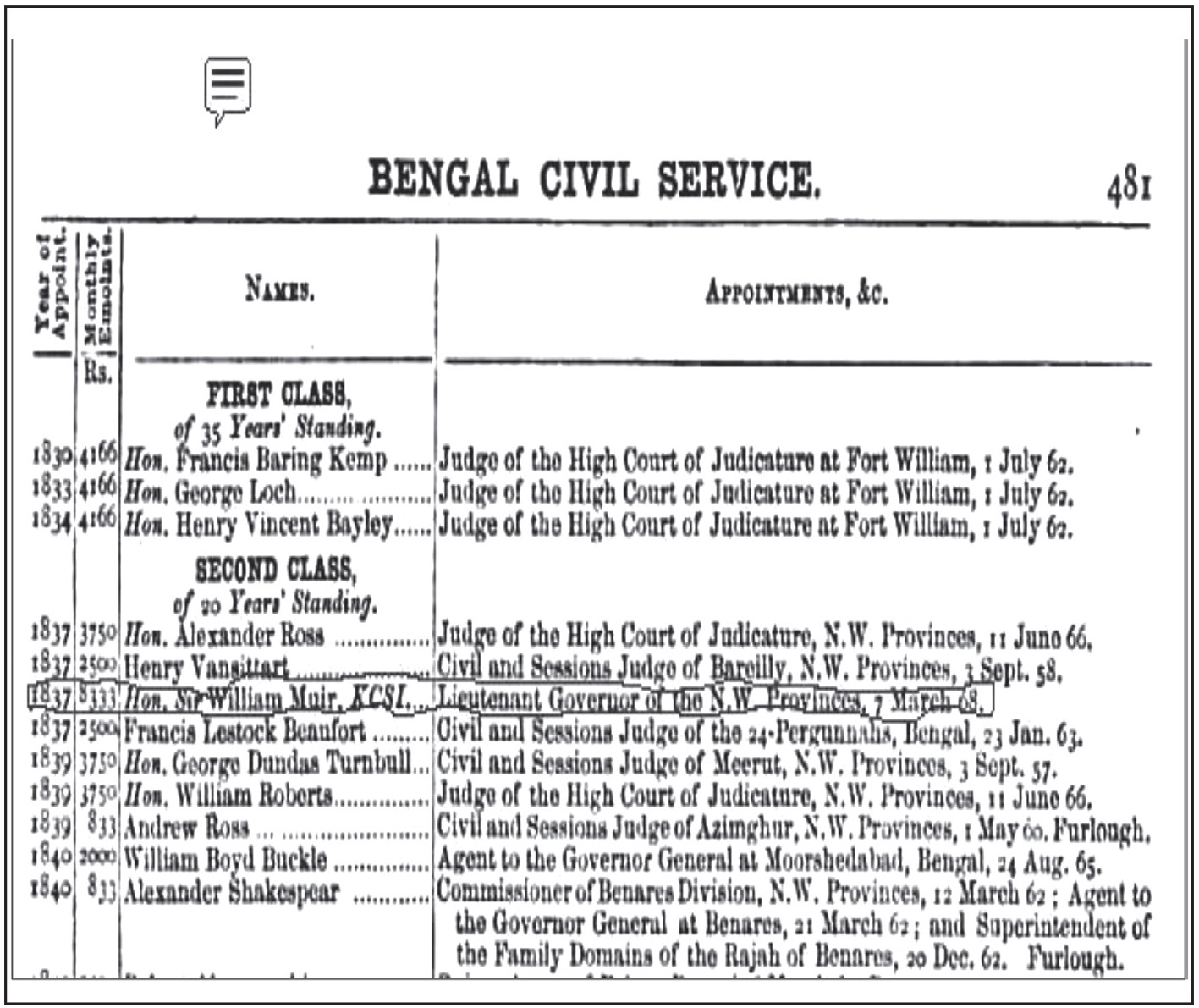
خريطة افتراضيّة لرحلات إبراهيم كما وردت في صحائف البحر الميت تبيّن أنّه لم يكن يتجوّل في أرض غريبة بل في أرض آبائه وعشيرته العرب العاربة الذين انتشروا في الجزيرة العربيّة والتي سكنها أحفاده من هاجر وقطورة، المصدر: كمال، صلاح، الإسلام والمحرفون للكلم، 95
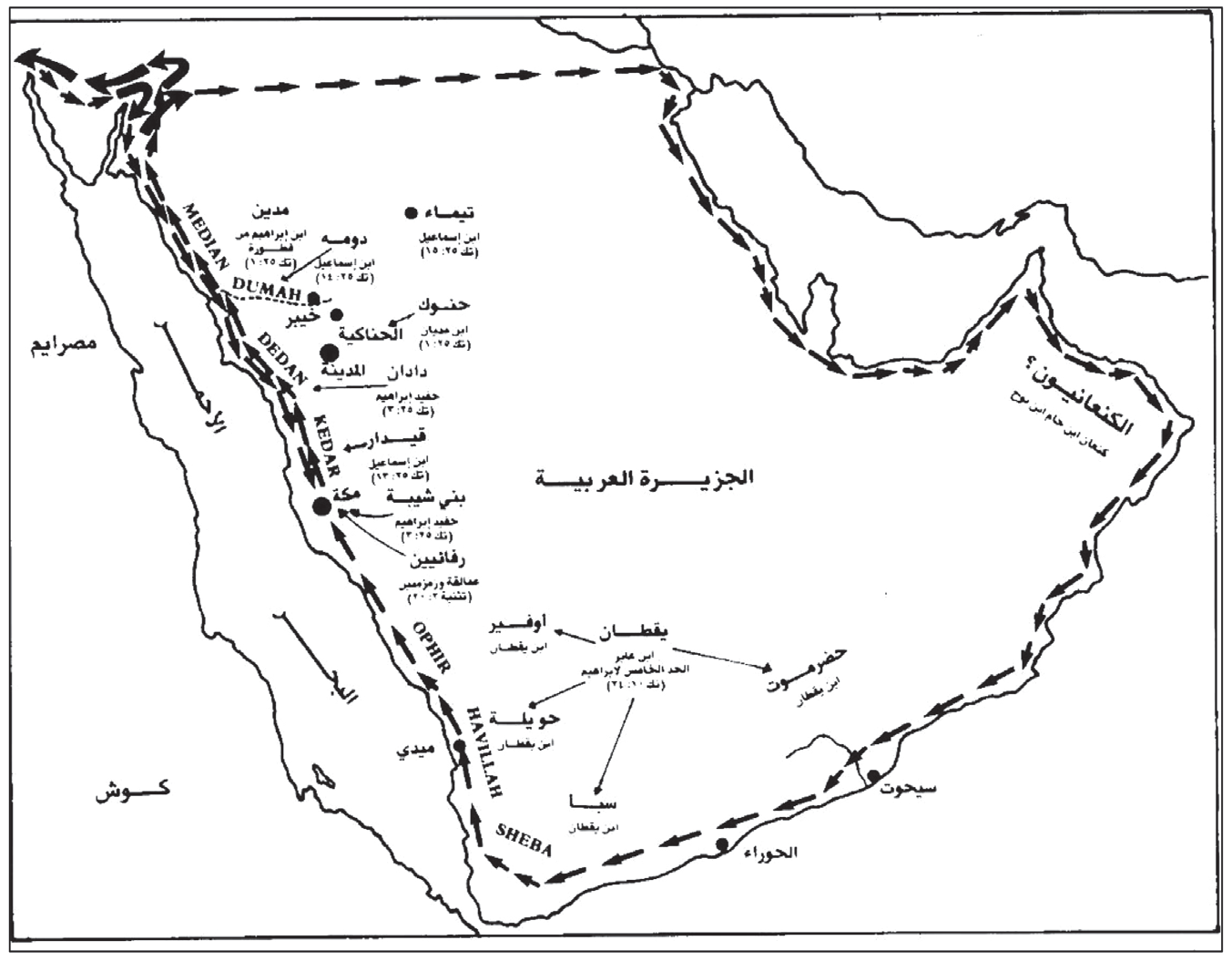
خريطة توضح أسماء المدن في العهد القديم المواضع باللغة العربيّة وفقًا للمنظور الكتابي
المصدر: http://www.christian-dogma.com/vb/showthread.php?t=45578
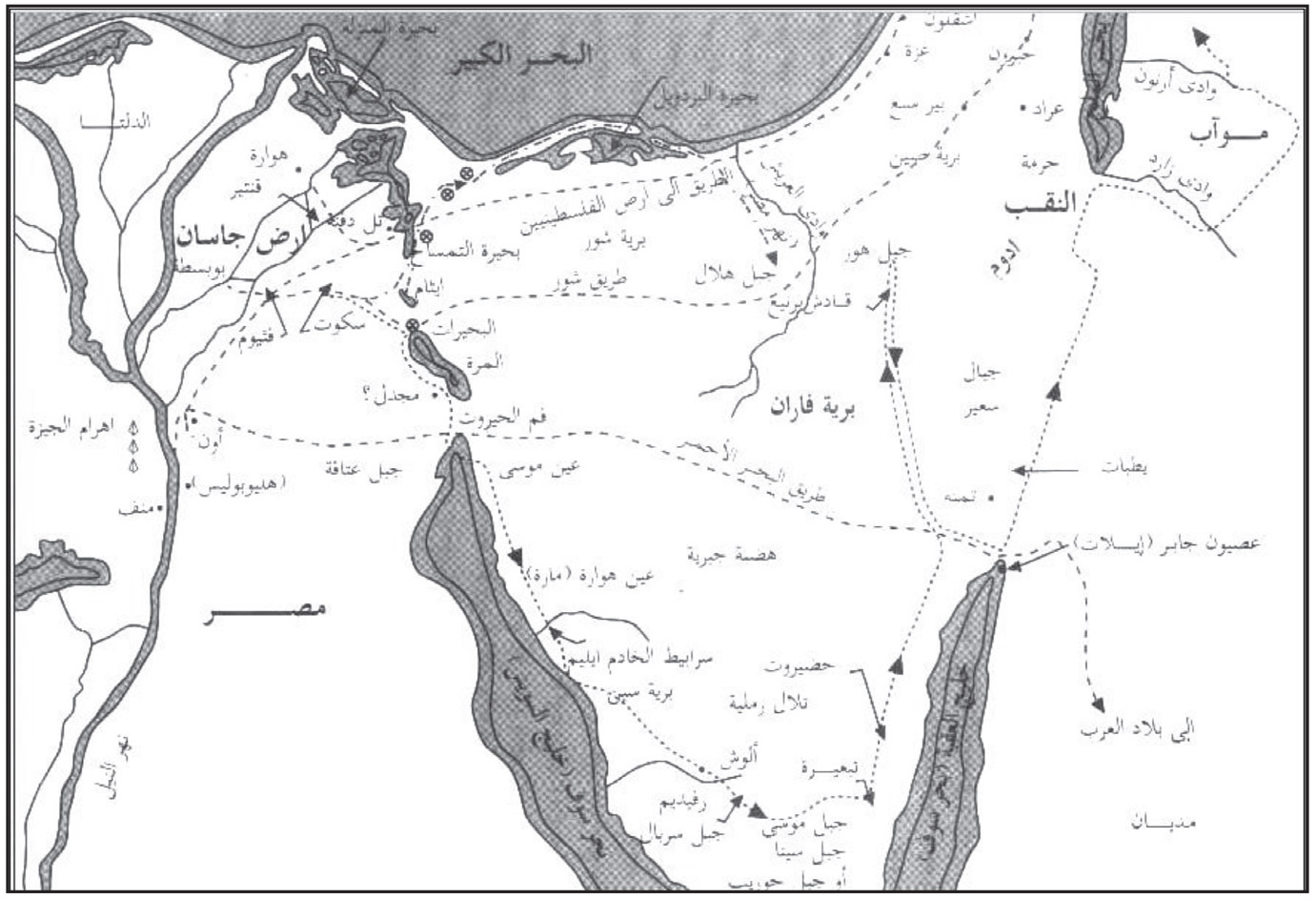
خريطة للجغرافي البلجيكي (أبراهام أورتلس Abraham Ortelius (1527-1598) رسمت في عام 1587 يظهر من خلالها موضع فاران على الجانب الشمالي الشرقي من البحر الأحمر،
المصدر: http://www.bible.ca/archeology
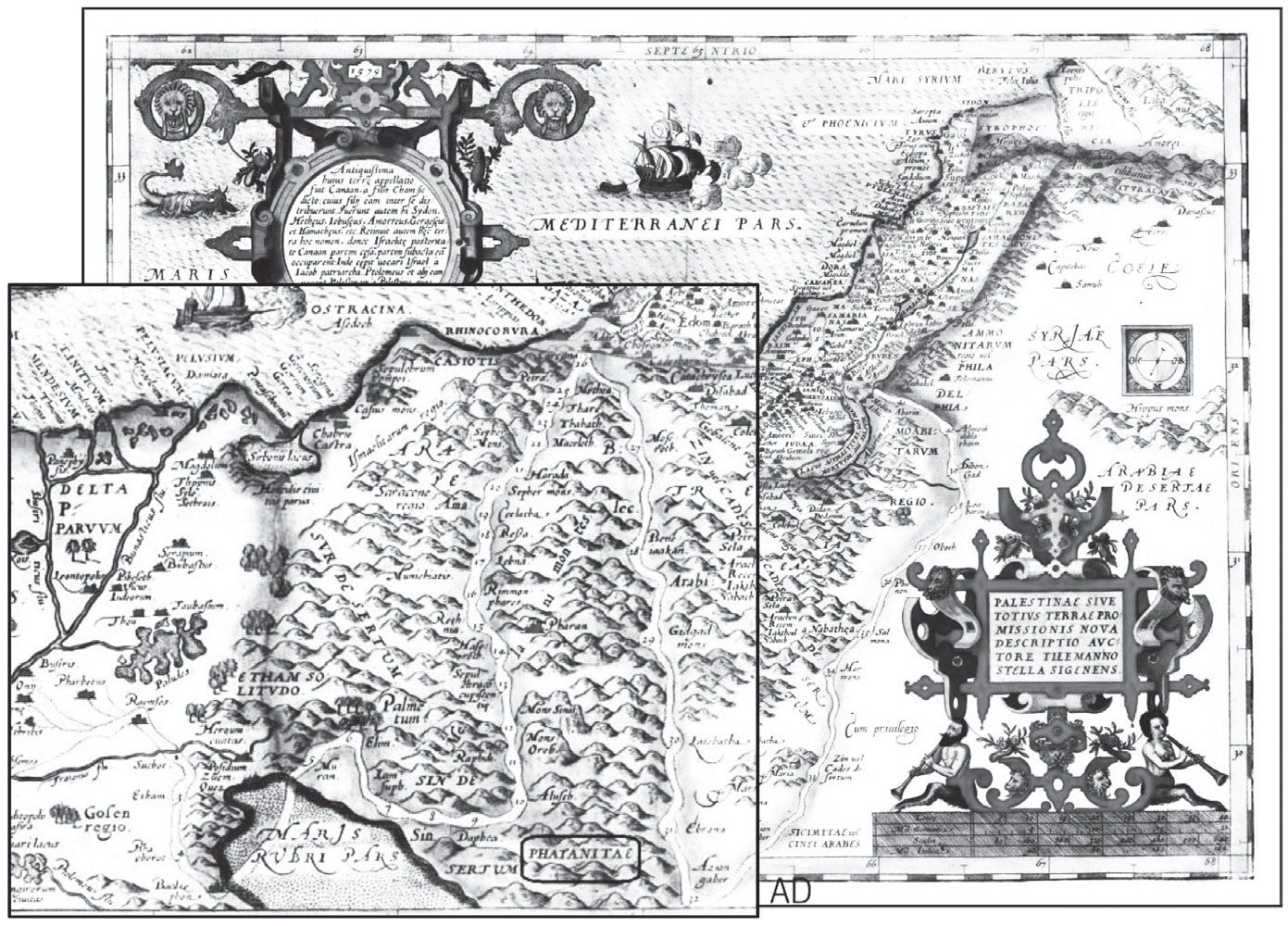
خريطة للجغرافي والفلكي الهولندي (بيتروس بلانشوس Petrus Plancius 1622- 1552) نشرت في عام 1590 يظهر فيها موضعي فاران والعماليق في منطقة الحجاز على الضفة الشرقيّة للبحر الأحمر،
المصدر: http://www.bible.ca/archeology
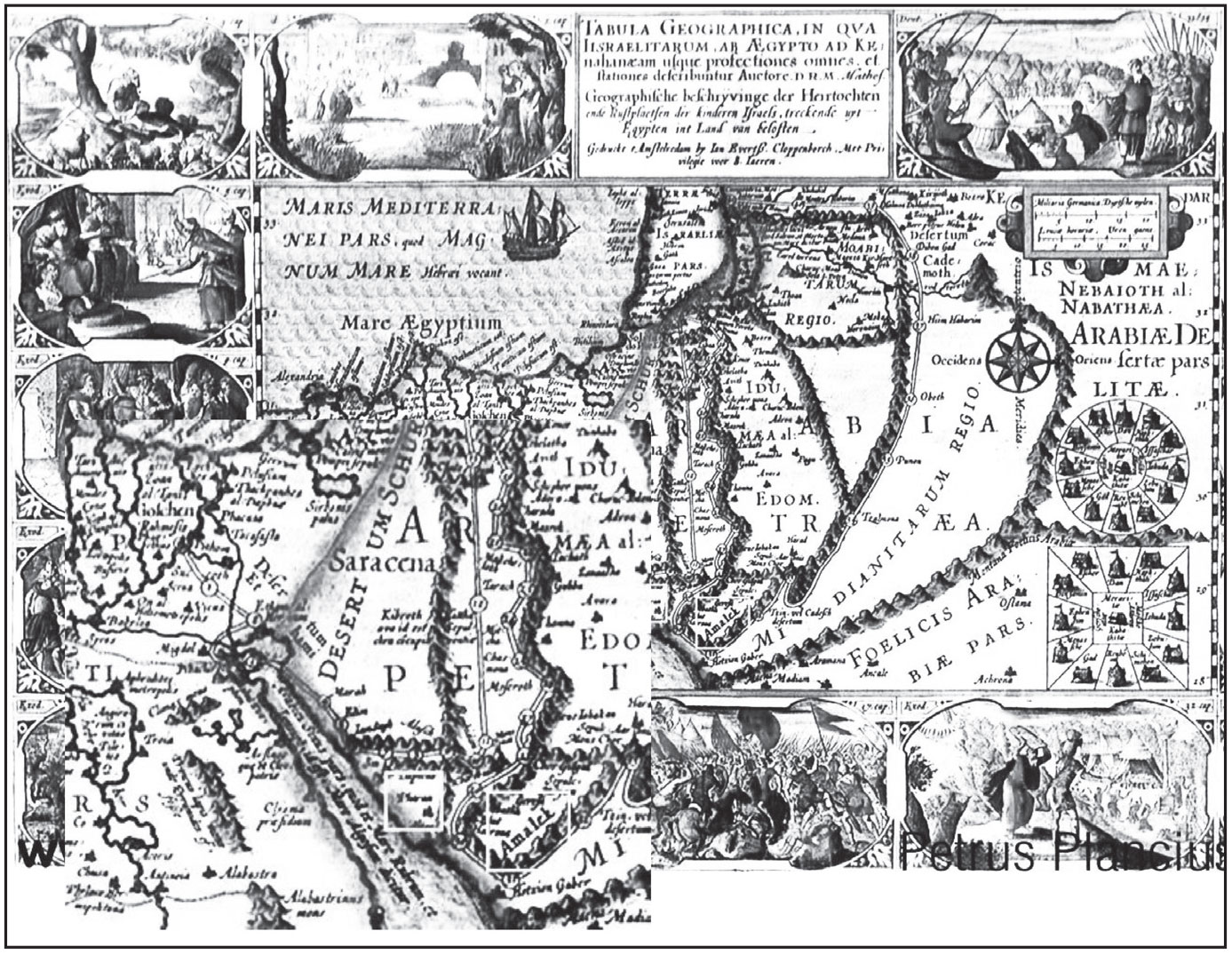
خريطة للجغرافي الألماني (تلمان ستيلا Tilemann Stella 1589- 1529) ظهرت في عام 1595 يظهر من خلالها موضع فاران على الجانب الشمالي الشرقي من البحر الأحمر،
المصدر: http://www.bible.ca/archeology
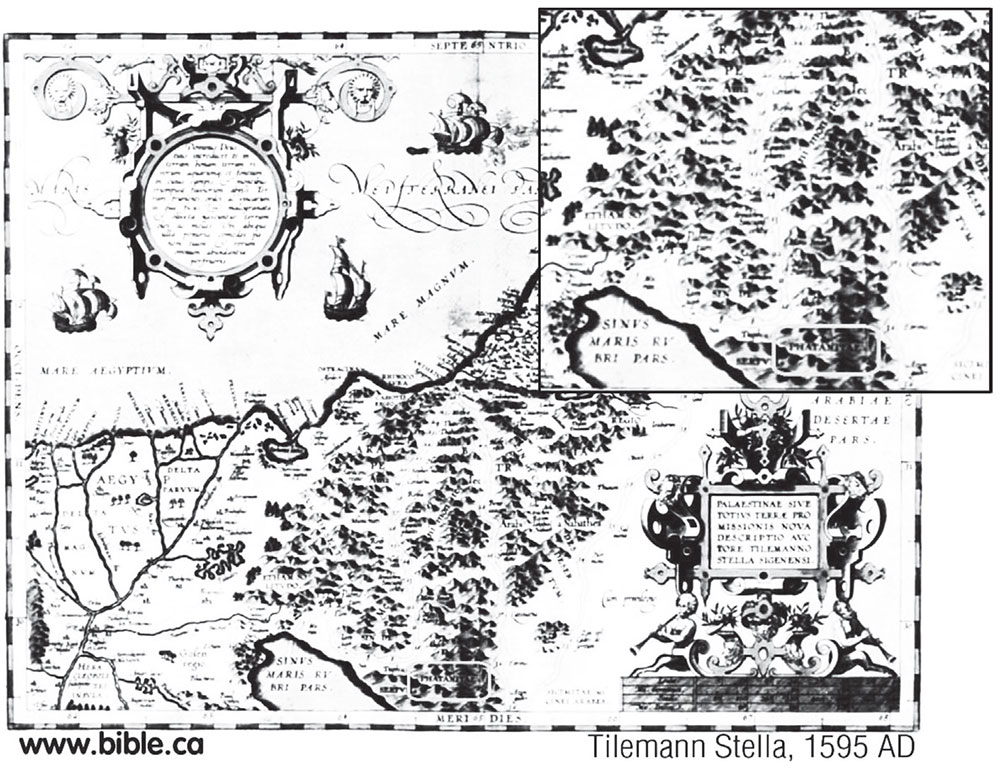
خريطة للدولة العثمانيّة للجغرافي الإنكليزي (جون سبيد John Speed 1629-1552) رسمت في عام 1625 يظهر من خلالها موضع فاران على الطرف الأيمن لموضع الصحراء الرمليّة إلى الشرق من بحر مكّة ويقع إلى جنوبها العربيّة السعيدة (اليمن)،
المصدر: http://www.bible.ca/archeology
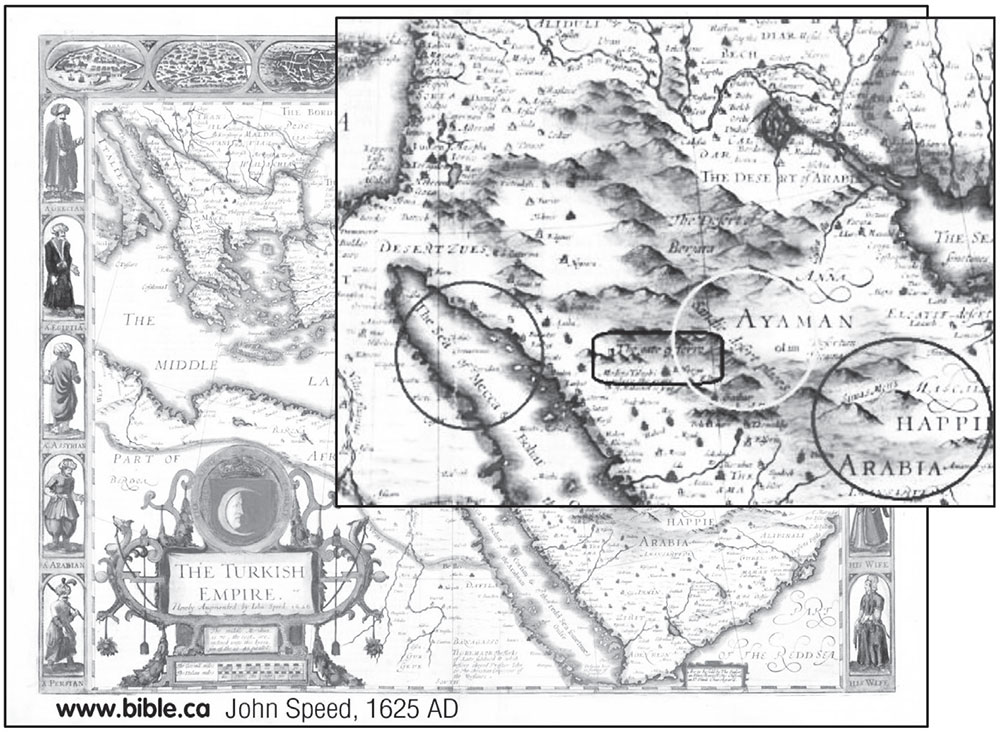
خريطة للجغرافي الفرنسي (فليب دي لارو Philippe De La Rue) رسمت في عام 1651 يظهر من خلالها موضع فاران إلى الجنوب من أرض السراسين (العرب)،
المصدر: http://www.bible.ca/archeology
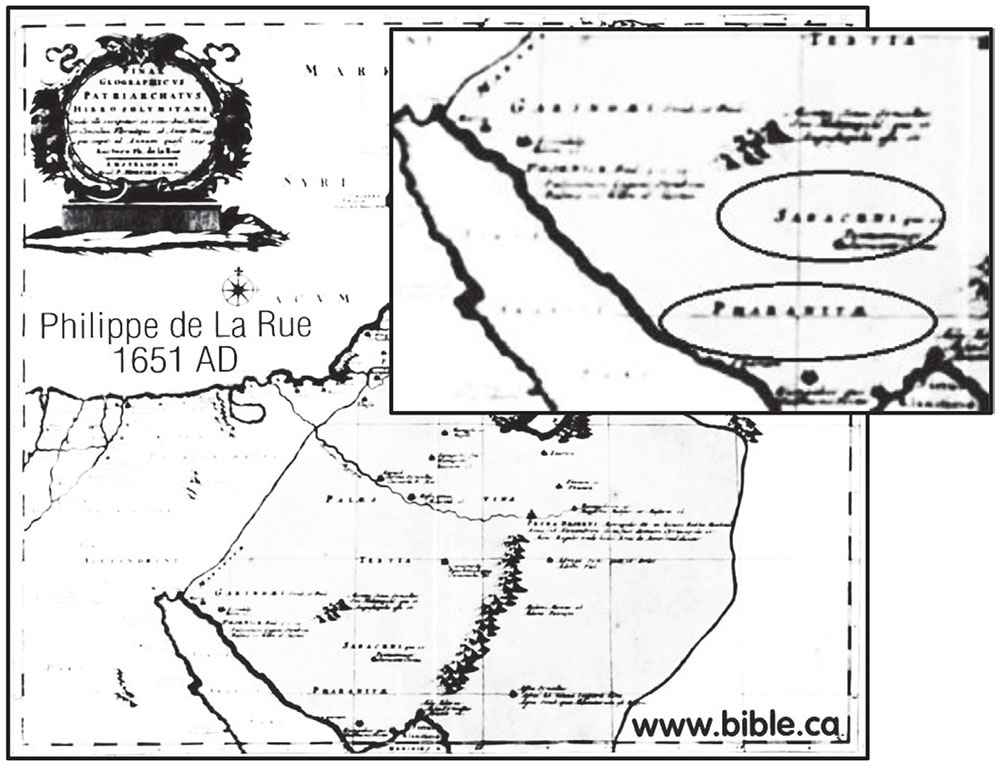
خريطة (الجزيرة العربيّة قديمًا) للجغرافي الفرنسي (مالت الين مانيسون 1630 - 1706 Mallet Alain Manesson) رسمت في عام 1719م يظهر من خلالها موضع فاران شمال المدينة في موضع أقرب إلى مكّة بالنسبة لمدار السرطان، المصدر:
http://www.columbia.edu/itc/mealac/pritchett/00generallinks/mallet/arabia/ancientarabia1700.jpg
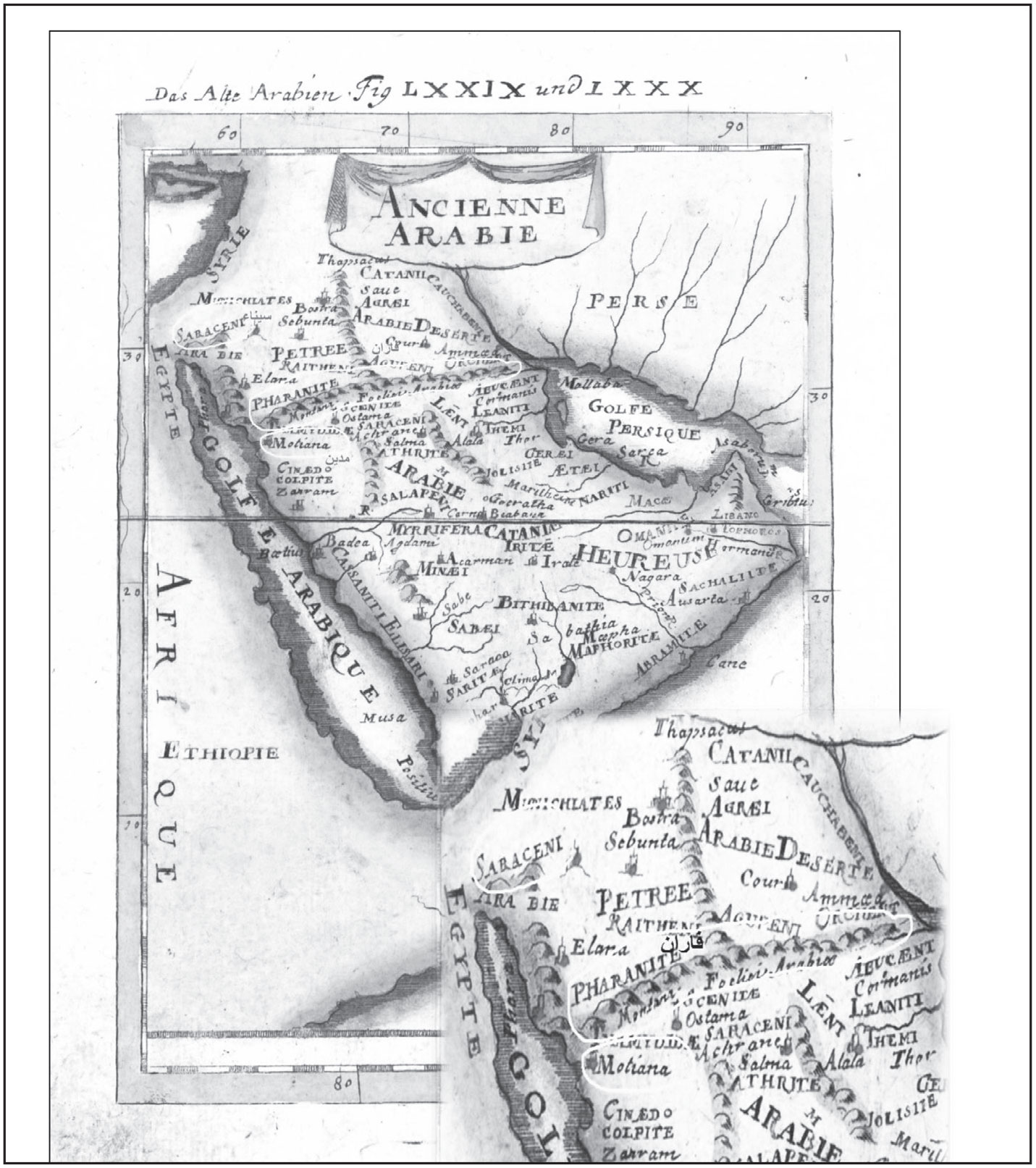
خريطة للجغرافي البلجيكي (كورنيليس دي جو Cornelis de Jode 1568-1600) رسمت في عام 1597 يظهر فيها منطقة الحجاز وامتداد الجزيرة العربيّة،
المصدر: http://www.bible.ca/archeology
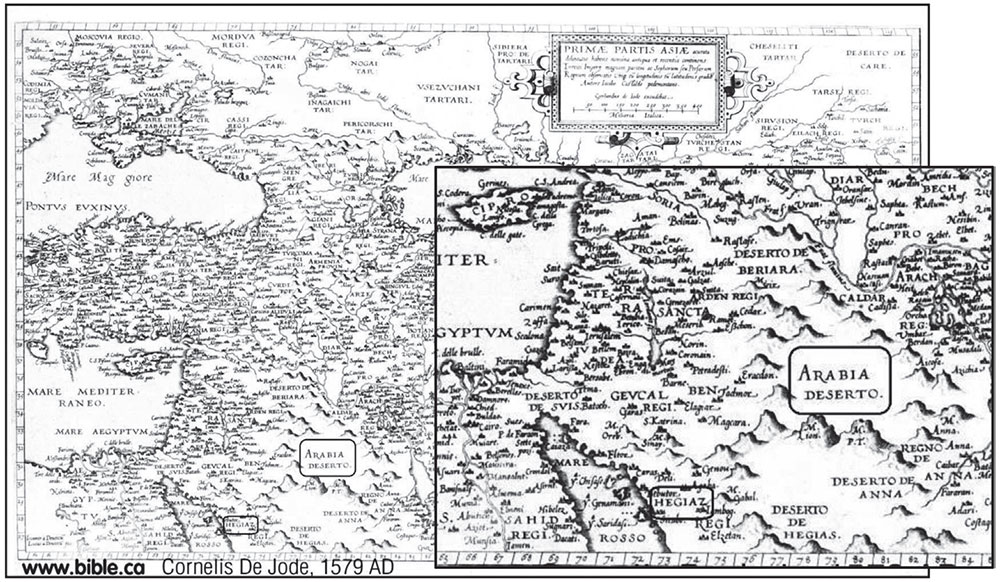
خريطة للجغرافي الألماني (سبستيان مونستر Sebastian Münster 1488- 1552م) نشرت في عام 1588 يظهر فيها منطقة الحجاز وامتداد الجزيرة العربيّة،
المصدر: http://www.bible.ca/archeology
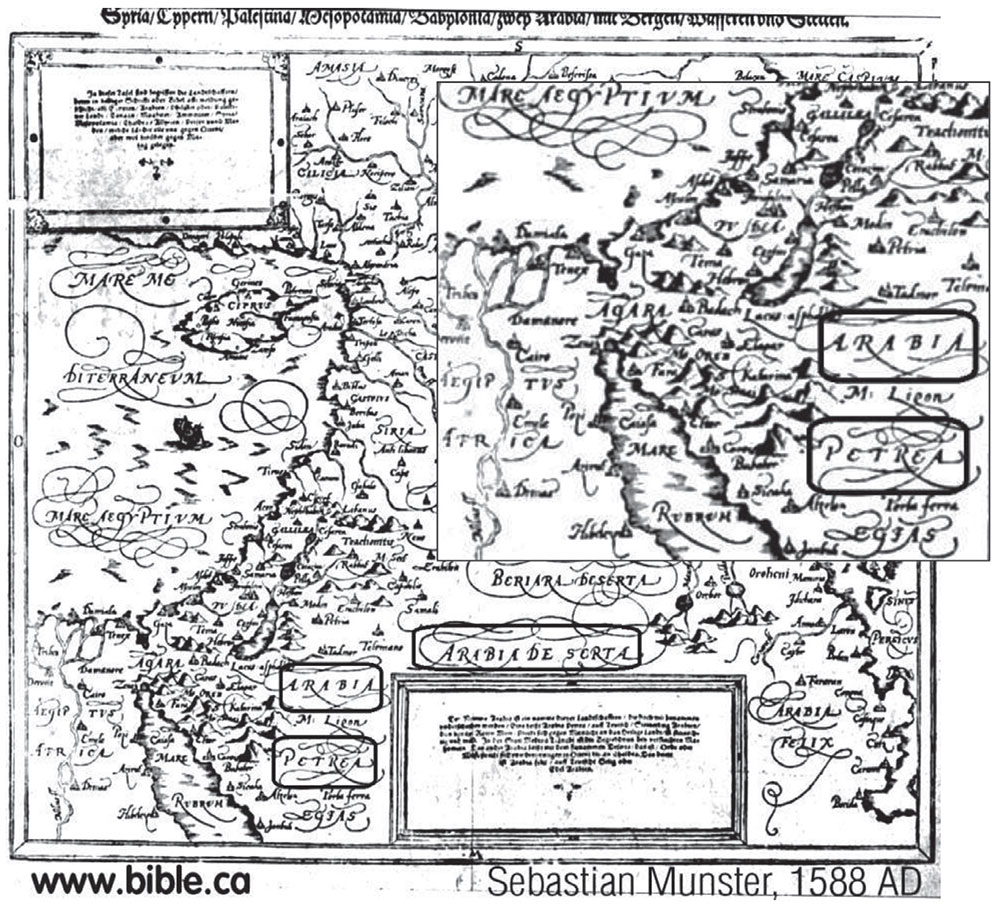
خريطة (الأرض المقدّسة والبلدان القديمة) للجغرافي الإنكليزي (ثوماس بوّن Thomas Bowen 1693- 1767م) ظهرت لاحقًا في عام 1780م يظهر من خلالها موضع الصحراء العربيّة محاذيًا لموضع البتراء مع عدم ظهور شبه جزيرة سيناء،
المصدر: http://www.bible.ca/archeology

خريطة (مصر وبرية وأرض الميعاد) للجمعيّة البريطانيّة للكتاب المقدّس-1899م، والتي تمثّل الموضع السائد لبرية فاران في التصوّرات الكتابيّة المعاصرة ضمن شبه جزيرة سيناء
المصدر:
http://www.hipkiss.org/data/maps/british-and-foreign-bible-society_holy-bible_1899_egypt-the-wilderness-the-promised-land_2303_1594_600.jpg
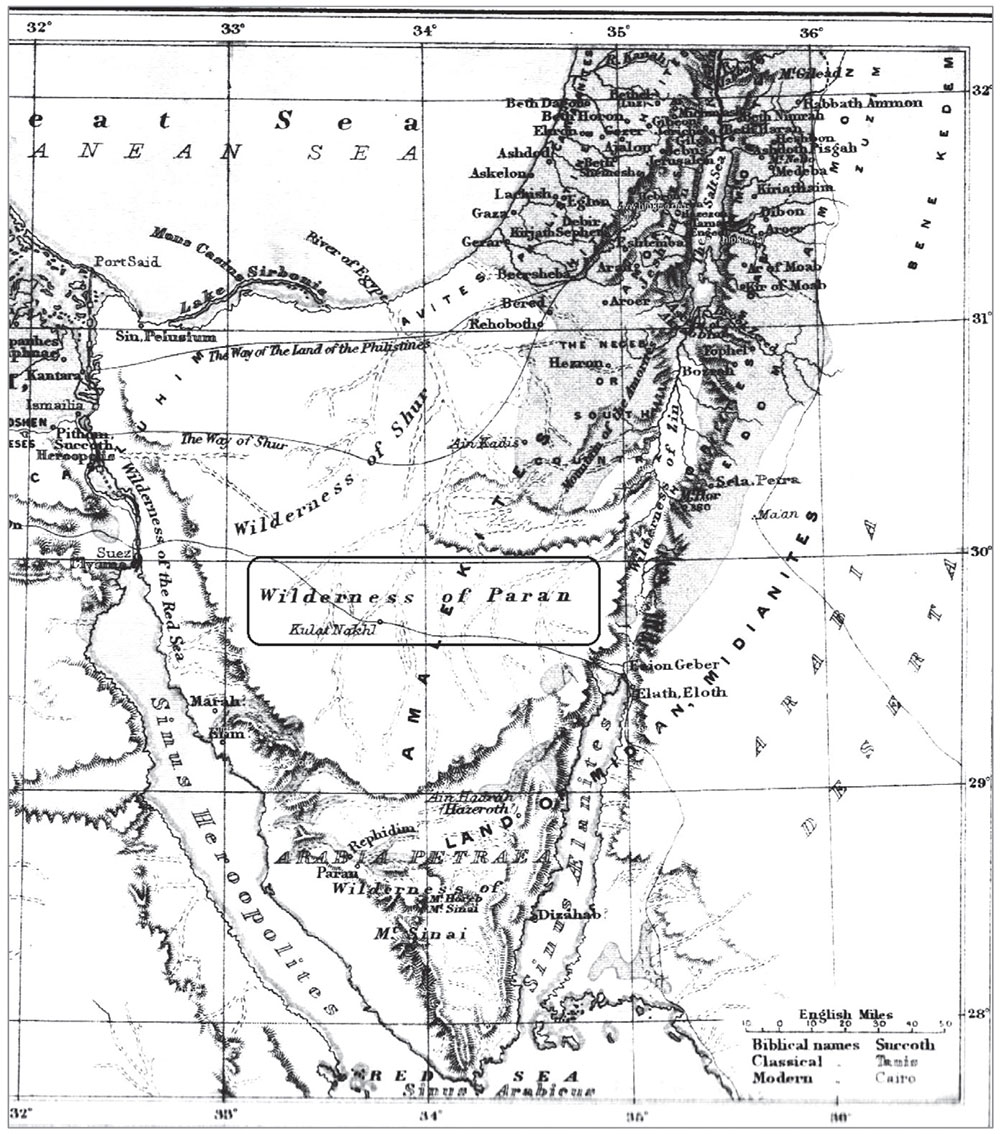
خريطة طريق الخروج أو مسار التّيه الحقيقي لبني اسرائيل التي رسمها (ستيف رودد Steve Rudd) عام 2007 التي يظهر من خلالها موضع برية فاران الوارد في (سفر التكوين 21:21) و(سفر العدد 10: 12؛ 13: 26) خارج شبه جزيرة سيناء من جهة الشرق المصدر:
http://www.bible.ca/archeology/maps-bible-archeology-exodus-route.jpg
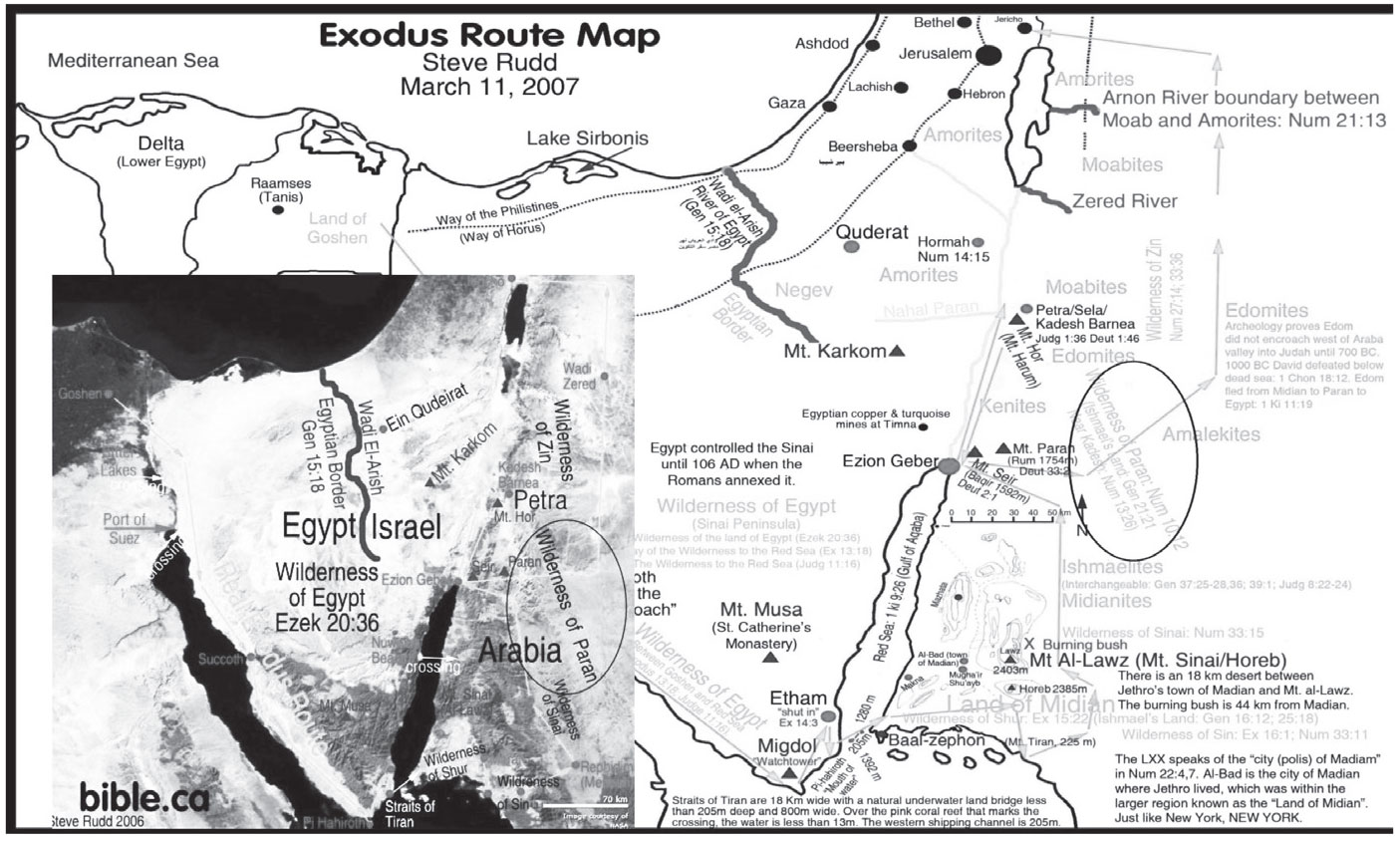
ينطوي على مماثلة بين أسماء مثبتة تاريخيًّا وحضاريًّا بمنطقة الحجاز وأسماء مصوّرة في خرائط الكتاب المقدّس بمنطقة الشام ومعتمدة في كتابات العهد القديم المصدر: صلاح كمال، الإسلام والمحرفون للكلم، 84

يمثّل مماثلة بين أسماء مثبتة تاريخيًّا وحضاريًّا بمنطقة الحجاز وأسماء مصوّرة في خرائط الكتاب المقدّس بمنطقة الشام ومعتمدة في كتابات العهد القديم المصدر: صلاح كمال، الإسلام والمحرفون للكلم، 84

يمثّل نطاق انتشار ذريّة إسماعيل وفقًا لما ورد في العهد القديم المصدر: الشرقاوي، جمال الدين، نبي أرض الجنوب، ص74.

خريطة للجغرافي الفرنسي (غيلس روبرت دي فوغندي 1688-1766م Gilles Robert de Vaugondy) رسمت في عام 1743 يظهر من خلالها موضع استيطان الإسماعيليّين،
المصدر: http://www.bible.ca/archeology

خريطة للجغرافي الهولندي (جان جانسينيوس Jan Janssonius 1664 -1588) رسمت في عام 1630 يظهر من خلالها موضع فاران محاذي لموضع قيدار،
المصدر: http://www.bible.ca/archeology
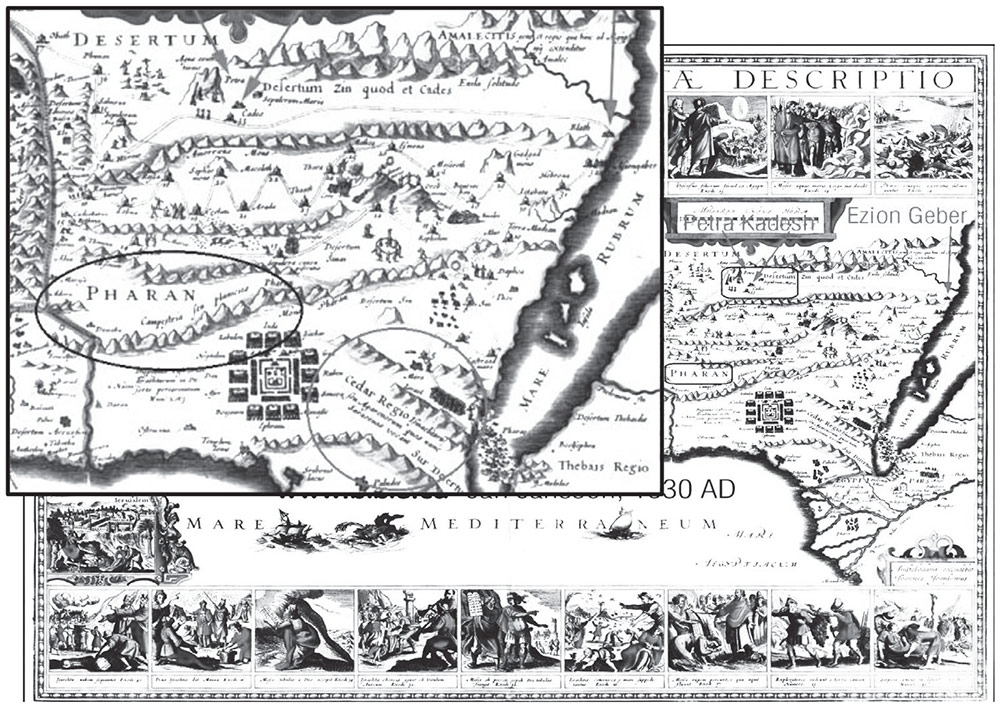
خريطة للجغرافي البلجيكي (أبراهام أورتلس Abraham Ortelius 1598 -1527) رسمت في عام 1598 يظهر من خلالها موضع الإسماعيليّين والقيداريّين في موضع جغرافي مقارب لموضع فاران،
المصدر: http://www.bible.ca/archeology
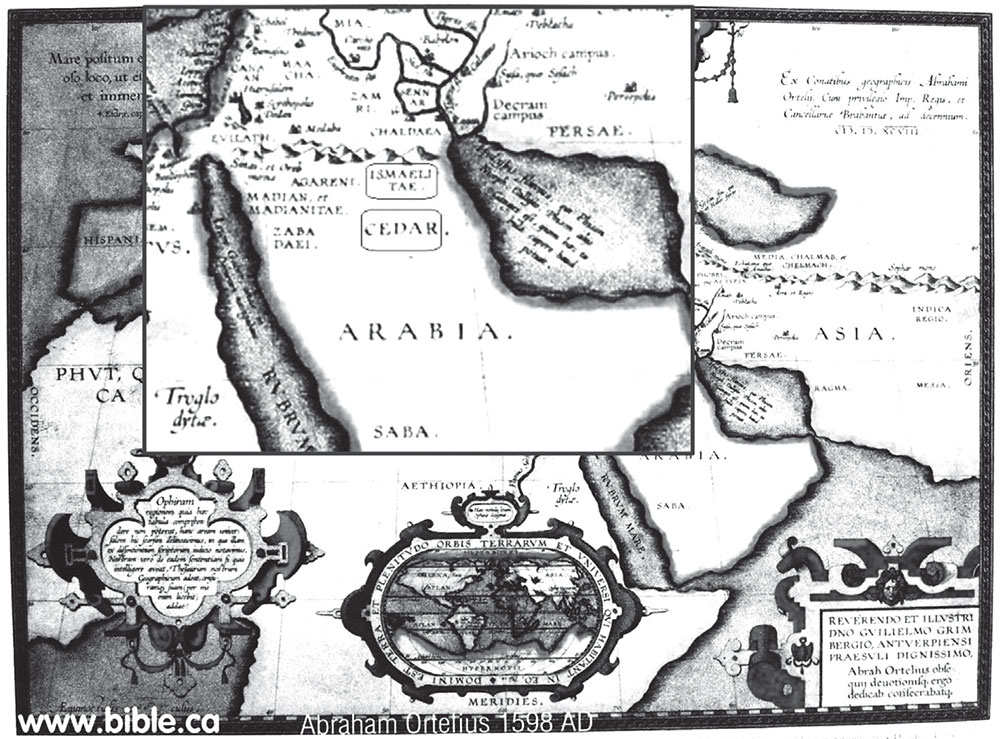
خريطة للمؤرّخ والجغرافي اليوناني أغاثارجيس Agatharchides عام 250ق.م توضح موضع استيطان البنزوميين، ترجمة ستانلي.م.بورستن. 1989
المصدر: http://www.bible.ca/archeology/bible-archeology-maps.htm
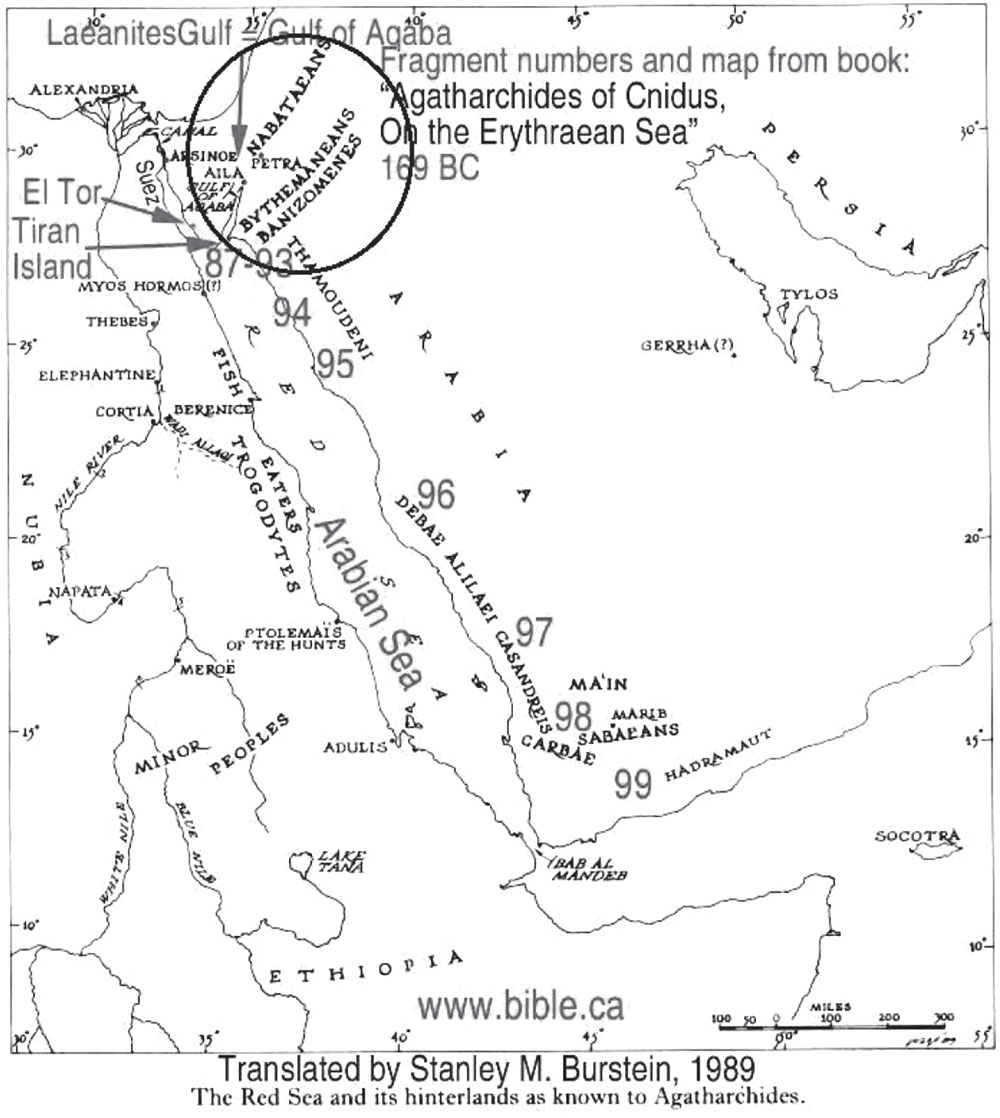
سلاسل نسب الرّسول محمّد بن عبد الله صلىاللهعليهوآله إلى إبراهيم الخليل المصدر:
Khan, Sayed Ahmmad, A series of Essays On The Life Of Mohammad, essay on the pedigree of Mohammed London 1870, vol, p.6 -10
| ت | ابن هشام 1 | ابن هشام 2 | البيهقي | ابن العربي | يارح | باروخ أوابراخيا | ||||
| 1 | ابراهيم | ابراهيم | ابراهيم | ابراهيم | ابراهيم | ابراهيم | 26 | ماحي | 51 | معد |
| 2 | اسماعيل | اسماعيل | اسماعيل | اسماعيل | اسماعيل | اسماعيل | 27 | ناخور | 52 | نزار |
| 3 | نابت | قيدر | نابت | قيدر | قيدار | قيدار | 28 | فاجم | 53 | مضر |
| 4 | يشحب | يامد | يشحب | سلامان | حمل | عوام | 29 | كالح | 54 | الياس |
| 5 | يعرب | سانو | يعرب | نابت | نابت | عوص | 30 | بدلان | 55 | مدركه |
| 6 | سود | الهميسع | يارح | الهميسع | سلامان | مر | 31 | يلدارم | 56 | خزيمه |
| 7 | ناحور | يعرب | ياحور | ادد | الهميسع | سماي | 32 | حرا | 57 | كنانه |
| 8 | ادد | يشحب | المقوم | اد | اليسع | رزاح | 33 | ناسل | 58 | النضر |
| 9 | عدنان | سام | ادد | عدنان | ادد | ناجب | 34 | ابي العوام | 59 | مالك |
| 10 | ادد | عدنان | اد | معصر | 35 | متساويل | 60 | فهر | ||
| 11 | عدنان | عدنان | ايهام | 36 | برو | 61 | غالب | |||
| 12 | افتاد | 37 | عوص | 62 | لؤي | |||||
| 13 | عيسى | 38 | سلامان | 63 | كعب | |||||
| 14 | حسان | 39 | الهميسع | 64 | مره | |||||
| 15 | عنفا | 40 | ادد | 65 | كلاب | |||||
| 16 | ارعوا | 41 | عدنان | 66 | قصي | |||||
| 17 | بلخي | 42 | معد | 67 | عبدمناف | |||||
| 18 | بحري | 43 | حمل | 68 | هاشم | |||||
| 19 | هري | 44 | نابت | 69 | عبد المطلب | |||||
| 20 | يسن | 45 | سلامان | 70 | عبد الله | |||||
| 21 | حمران | 46 | الهميسع | 71 | محمدصلىاللهعليهوآله | |||||
| 22 | الرعا | 47 | اليسع | |||||||
| 23 | عبيد | 48 | ادد | |||||||
| 24 | عنف | 49 | اد | |||||||
| 25 | عسقي | 50 | عدنان | |||||||
السور القرآنيّة وفقًا لترتيب نزولها لدى المستشرق وليم ميور
المصدر: William Muir, life of Mahomet, vol.II,pp318 -320
| اسم السورة | ترتيب نزولها وفقا Muir | رقم ترتيبها في المصحف | ملاحظات ميور وفقًا العهد الزمني |
| العصر | 1 | 103 | العهد الأوّل: السور من (1) إلى (18) وتمثّل المرحلة الشعرية |
| العاديات | 2 | 100 | |
| الزلزلة | 3 | 99 | |
| الشمس | 4 | 91 | |
| قريش | 5 | 106 | |
| الفاتحة | 6 | 1 | |
| القارعة | 7 | 101 | |
| التين | 8 | 95 | |
| التكاثر | 9 | 102 | |
| الهمزة | 10 | 104 | |
| الانفطار | 11 | 82 | |
| الليل | 12 | 92 | |
| الفيل | 13 | 105 | |
| الفجر | 14 | 89 | |
| البلد | 15 | 90 | |
| الضحى | 16 | 93 | |
| الشرح | 17 | 94 | |
| الكوثر | 18 | 108 | |
| العلق | 19 | 96 | العهد الثاني: ويبدأ من السورة (19)والتي تضم أوامر النبوّة |
| الاخلاص | 20 | 112 | |
| المدثر | 21 | 74 | |
| المسد | 22 | 111 | |
| الاعلى | 23 | 87 | العهد الثالث: السور من (23) إلى (41) من إعلان الدعوة العلنية حتّى الهجرة إلى الحبشة |
| القدر | 24 | 97 | |
| الغاشية | 25 | 88 | |
| عبس | 26 | 80 | |
| التكوير | 27 | 81 |
| اسم السورة | ترتيب نزولها وفقا Muir | رقم ترتيبها في المصحف | ملاحظات ميور وفقًا العهد الزمني |
| الانشقاق | 28 | 84 | العهد الثالث: السور من (23) إلى (41) من إعلان الدعوة العلنية حتّى الهجرة إلى الحبشة |
| الطارق | 29 | 86 | |
| النصر | 30 | 110 | |
| البروج | 31 | 85 | |
| المطففين | 32 | 83 | |
| النبأ | 33 | 78 | |
| المرسلات | 34 | 77 | |
| الانسان | 35 | 76 | |
| القيامة | 36 | 75 | |
| المعارج | 37 | 70 | |
| الكافرون | 38 | 109 | |
| الماعون | 39 | 107 | |
| الرحمن | 40 | 55 | |
| الواقعة | 41 | 56 | |
| الملك | 42 | 67 | العهد الرابع: من السور (42) إلى (63) في السنة السادسة إلى السنة العاشرة من البعثة النبوية |
| النجم | 43 | 53 | |
| السجدة | 44 | 32 | |
| الزمر | 45 | 39 | |
| المزمل | 46 | 73 | |
| النازعات | 47 | 79 | |
| القمر | 48 | 54 | |
| سبأ | 49 | 34 | |
| لقمان | 50 | 31 | |
| الحاقة | 51 | 69 | |
| القلم | 52 | 68 | |
| فصلت | 53 | 41 | |
| نوح | 54 | 71 | |
| الطور | 55 | 52 | |
| ق | 56 | 50 | |
| الجاثية | 57 | 45 | |
| الدخان | 58 | 44 | |
| الصافات | 59 | 37 | |
| لروم | 60 | 30 | |
| الشعراء | 61 | 26 | |
| الحجر | 62 | 15 | |
| الذاريات | 63 | 51 | |
| الأحقاف | 64 | 46 |
العهد الخامس: من سورة (64) إلى (94) |
| الجن | 65 | 72 |
| اسم السورة | ترتيب نزولها وفقا Muir | رقم ترتيبها في المصحف | ملاحظات ميور وفقًا العهد الزمني |
| فاطر | 66 | 35 |
العهد الخامس: من سورة (64) إلى (94)
السور (113) و(114) تاريخ ظهورها غير محدد |
| يس | 67 | 36 | |
| مريم | 68 | 19 | |
| الكهف | 69 | 18 | |
| النمل | 70 | 27 | |
| الشورى | 71 | 42 | |
| غافر | 72 | 40 | |
| ص | 73 | 38 | |
| الفرقان | 74 | 25 | |
| طه | 75 | 20 | |
| الزخرف | 76 | 43 | |
| يوسف | 77 | 12 | |
| هود | 78 | 11 | |
| يونس | 79 | 10 | |
| إبراهيم | 80 | 14 | |
| الأنعام | 81 | 6 | |
| التغابن | 82 | 64 | |
| القصص | 83 | 28 | |
| المؤمنون | 84 | 23 | |
| الحج | 85 | 22 | |
| الانبياء | 86 | 21 | |
| الاسراء | 87 | 17 | |
| النحل | 88 | 16 | |
| الرعد | 89 | 13 | |
| العنكبوت | 90 | 29 | |
| الأعراف | 91 | 7 | |
| الفلق | 92 | 113 | |
| الناس | 92 | 114 | |
| البقرة | 94 | 2 | |
| محمد | 95 | 47 | العهد السادس: السور المدنية من (95) إلى (114) ترتيب ال (21) سورة لم يتم التحقق منها من قبل ميور |
| الحديد | 96 | 57 | |
| الأنفال | 97 | 8 | |
| المجادلة | 98 | 58 | |
| الطلاق | 99 | 65 | |
| البينة | 100 | 98 | |
| الجمعة | 101 | 62 | |
| الحشر | 102 | 59 | |
| النور | 103 | 24 |
| اسم السورة | ترتيب نزولها وفقا Muir | رقم ترتيبها في المصحف | ملاحظات ميور وفقًا العهد الزمني |
| المنافقون | 104 | 63 | العهد السادس: السور المدنية من (95) إلى (114) ترتيب ال (21) سورة لم يتم التحقق منها من قبل ميور |
| الفتح | 105 | 48 | |
| الصف | 106 | 61 | |
| النساء | 107 | 4 | |
| آل عمران | 108 | 3 | |
| المائدة | 109 | 5 | |
| الأحزاب | 110 | 33 | |
| الممتحنة | 111 | 60 | |
| التحريم | 112 | 66 | |
| الحجرات | 113 | 49 | |
| التوبة | 114 | 9 |
صورة فوتوغرافية للمستشرق وليم ميور ويومها كان في منصب نائب الحاكم العام لحكومة الهند الشمالية الغربية، المصدر: http://images.is.ed.ac.uk/luna/servlet/detail/UoEgal
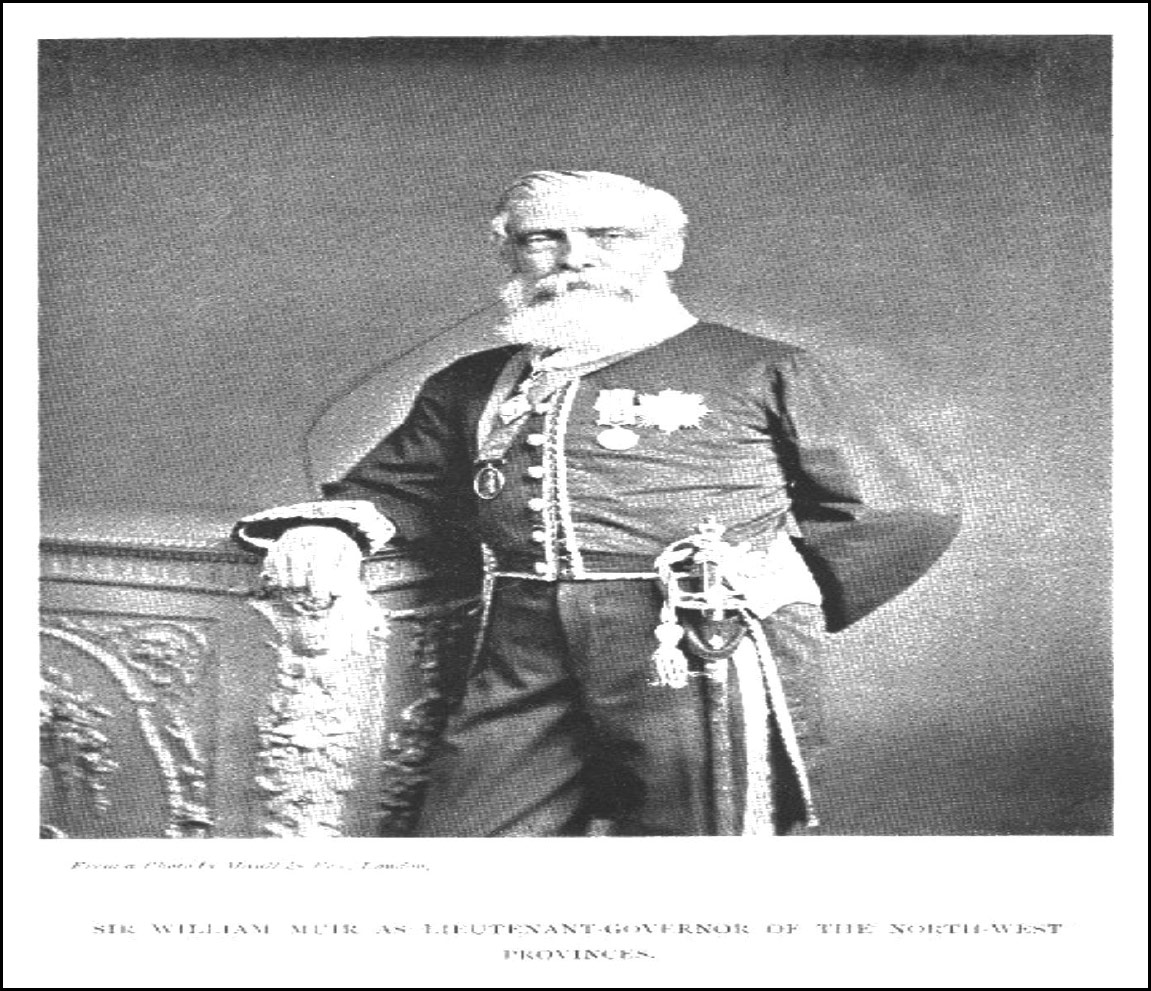
صورة فوتوغرافية للمستشرق وليم ميور عندما كان رئيسًا لجامعة أدنبره University of Edinburgh عام 1896
المصدر: http://images.is.ed.ac.uk/luna/servlet/detail/UoEgal
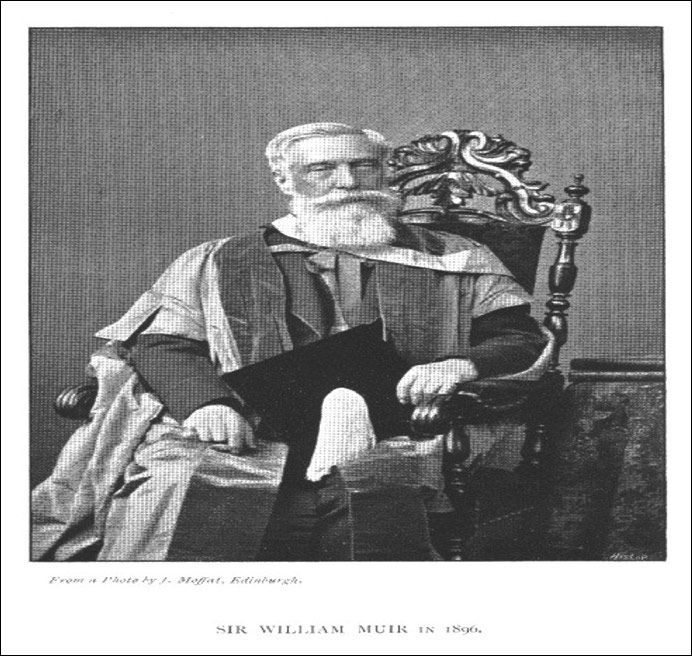
صورة معروضة في قاعة THE M’EWAN HALL NICHES في جامعة أدنبره عنوانها (مديرنا) وهي فانتازيا تمثّل وليم ميور يقف على أرضيّة وهو محمول على أكتاف طلبة يحملون المشاعل وهو باللباس الإسلامي وخلفه محراب إسلامي ويحمل القرآن الكريم بيده اليمنى، ونجمة الهند على صدره. المصدر: http://images.is.ed.ac.uk/luna/servlet/detail/UoEgal

1. القرآن الكريم
2. الكتاب المقدّس ويشمل التوراة المعروف بالعهد القديم والإنجيل المعروف بالعهد الجديد، نسخة جمعيّات الكتاب المقدّس في الشرق، الكتاب المقدّس، ط3، دار المشرق، بيروت، 1986.
3. Fire Bible-NIV-Student Hendrickson Publishers.USA,2007.
4. Holly Bible King James version Zondervan grand rapids, Michigan, USA.
ابن الأثير، عز الدين ابو الحسن علي الجزري (630هـ/ 1238م)
1. أسد الغابة في معرفة الصحابة، تح، محمّد معوض وعادل أحمد عبد الموجود، دار الكتب العلميّة، بيروت، 1994م.
2. الكامل في التاريخ، دار الكتاب العربي، ط1، بيروت، 1997م.
الأزرقي، أبي الوليد محمّد بن عبد الله بن أحمد، (250هـ/ 865م)
3. أخبار مكّة وما جاء فيها من الآثار، تح رشدي الصالح ملحس، دار الأندلس، بيروت، د.ت.
الأصبهاني، أبو نعيم أحمد بن عبد الله بن أحمد (ت: 430هـ/ 1038م)
4. دلائل النبوة، تح، محمد رواس قلعه جي، عبد البر عباس، دار النفائس، ط2، بيروت، 1986م.
الأصفهاني، أبو الفرج علي بن الحسين القرشي (ت356 هـ/ 967م).
5. كتاب الأغاني، ط1، مطبعة دار الكتب المصرية، القاهرة، 1927م.
الأعلم، أبو الحجاج يوسف بن سليمان الشنتمري (ت: 476هـ/ 1083م)
6. أشعار الشعراء الستة الجاهليين، د.م، د.ت.
البخاري، محمد بن إسماعيل أبو عبد الله (ت 256 هـ/ 869م).
7. الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله صلىاللهعليهوآله وسننه وأيامه والمسمّى صحيح البخاري، تح، محمّد زهير بن ناصر الناصر، دار طوق النجاة، د.م،1422هـ.
ابن بطال، أبو الحسن علي بن عبد الملك (ت: 449هـ/ 1105م).
8. شرح صحيح البخاري، تح، أبو تميم ياسر بن إبراهيم، مكتبة الرشد، ط2، الرياض، 2003م.
البغوي، أبو محمّد الحسين بن مسعود (ت: 510هـ/ 1116م)
9. معالم التنزيل في تفسير القرآن، تح، محمد عبد الله النمر وآخرون، دار طيبة للنشر والتوزيع ط4، د.م، 1997.
ابن بكار، الزبير بن عبد الله القرشي (ت: 256هـ/ 869م)
10. جمهرة نسب قريش وأخبارها، تح، محمود محمّد شاكر، مطبعة المدني، د.م، 1381ه.
البَلَاذُري، أحمد بن يحيى بن جابر بن داود (ت: 279هـ/ 892م)
(461)11.أنساب الأشراف، تح، سهيل زكار ورياض الزركلي، دار الفكر، بيروت، 1996م.
12.فتوح البلدان، دار ومكتبة الهلال، بيروت، 1988م.
البيضاوي، ناصر الدين أبوسعيد عبد الله بن عمر (ت: 685هـ/ 1286م).
13. أنوار التنزيل وأسرار التأويل، تح، محمّد عبد الرحمن المرعشلي، دار إحياء التراث العربي، بيروت، 1418 هـ.
البيهقي، أبو بكر أحمد بن الحسين الخراساني (ت: 458هـ/ 1065م).
14.دلائل النبوة، دار الكتب العلمية ط1، بيروت، 1405هـ..
15.السنن الكبرى، تح، محمّد عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية، ط3، بيروت، 2003م.
الثعلبي، أحمد بن محمّد بن إبراهيم، أبو إسحاق (ت:427هـ/ 1035م).
16. الكشف والبيان عن تفسير القرآن، تح، أبي محمّد بن عاشور، دار إحياء التراث العربي، بيروت، ط1، 2002م.
ابن جزي، أبوالقاسم، محمّد بن أحمد (ت: 741هـ/ 1340م).
17. التسهيل لعلوم التنزيل، تح عبد الله الخالدي، ط1، شركة دار الأرقم، بيروت، 1416هـ.
ابن الجوزي، جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن (597هـ/ 1200م)
18. زاد المسير في علم التفسير، تح عبد الرزاق المهدي، دار الكتاب العربي ط1، بيروت، 1422هـ.
19. كشف المشكل من حديث الصحيحين، تح، علي حسين البواب، دار الوطن، الرياض، د.ت.
20. المنتظم في تاريخ الأمم والملوك تح، محمّد ومصطفى عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية، ط1، بيروت، 1992م.
الجوهري، أبو نصر إسماعيل بن حماد (ت: 393هـ/ 1002م).
21. الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية، تح، أحمد العطار، دار العلم للملايين، ط4، بيروت، 1987م.
الحاكم النيسابوري، أبوعبد الله محمّد بن عبد الله (ت 405هـ/ 1014م)
22.المستدرك على الصحيحين، تح، مصطفى عطا، دار الكتب العلمية، ط1، بيروت، 1990م.
ابن حبان، محمد بن أحمد بن معاذ (ت: 354هـ/ 964م)
23. الثقات، دائرة المعارف العثمانية بحيدر آباد الدكن، ط1، الهند، 1973م.
24. السيرة النبويّة وأخبار الخلفاء صحّحه، وتعليق عزيز بك وآخرون، دار الكتب الثقافية، ط3، بيروت، 1417هـ.
25. صحيح ابن حبان، تح، شعيب الأرنؤوط، مؤسسة الرسالة، ط2، بيروت، 1993م.
ابن حبيب، محمد بن أمية بن عمرو الهاشمي (ت: 245هـ/ 859م)
26. المنمق في أخبار قريش تح، خورشيد أحمد فاروق، عالم الكتب، ط1، بيروت، 1985م.
ابن حجر، أبو الفضل أحمد بن علي بن محمّد العسقلاني (ت: 852هـ/ 1448م)
27. الإصابة في تمييز الصحابة، تح عادل أحمد عبد الموجود وعلى محمّد معوض، دار الكتب العلمية، بيروت، 1415هـ.
28. فتح الباري شرح صحيح البخاري، تصحيح، محب الدين الخطيب، دار المعرفة، بيروت، 1379هـ.
ابن حزم، أبو محمّد علي بن أحمد بن سعيد الأندلسي (ت: 456هـ/ 1063م)
29. جمهرة أنساب العرب، تح، لجنة من العلماء، دار الكتب العلمية ط1، بيروت، 1983م.
30. الناسخ والمنسوخ في القرآن الكريم، تح عبد الغفار سليمان البنداري، دار الكتب العلمية، بيروت، 1986هـ.
ابن حنبل، أبو عبد الله أحمد بن محمّد الشيباني (ت: 241هـ/ 855م)
31. مسند الإمام أحمد بن حنبل، تح شعيب الأرنؤوط، عادل مرشد، وآخرون، مؤسسة الرسالة، ط1، 2001 م.
الحِميري، محمّد بن عبد المنعم (ت 900 هـ/ 1495م)
32. الروض المعطار في خبر الأقطار، تح إحسان عباس، بيروت، 1980م.
الخطيب البغدادي، أبوبكر أحمد بن علي بن ثابت (ت: 463هـ/ 1070م).
33. تاريخ بغداد، دراسة وتح، مصطفى عبد القادر عطا دار الكتب العلمية، ط1، بيروت،1417هـ.
ابن خلدون، أبو زيد عبد الرحمن بن محمّد (ت 808هـ/ 1405م)
34. العبر وديوان المبتدأ والخبر... أو المقدمة، تح خليل شحادة، ط3، دار الفكر، بيروت، 1988م.
ابن خياط، أبو عمر بن خليفة العصفري، (ت: 240هـ/ 854م).
35. كتاب الطبقات، تح سهيل زكار، دار الفكر للطباعة والنشر، بيروت-1414هـ.
ابو داود، سليمان بن الأشعث بن إسحاق السِّجِسْتاني (275هـ/ 888م).
36. سنن أبي داود، تح، محمّد محيي الدين عبد الحميد، المكتبة العصرية، صيدا – بيروت د.م.
ابو داود الطيالسي، سليمان بن داود بن الجارود البصرى (ت: 204هـ/ 819م).
37. مسند أبي داود الطيالسي، تح، محمد بن عبد المحسن التركي، دار هجر، مصر، 1999م.
ابن دريد، أبوبكر محمّد بن الحسن بن الأزدي ( 321هـ/ 932م)
38. جمهرة اللغة، تح، رمزي منير بعلبكي، ط1، دار العلم للملايين، بيروت، 1987م.
الذهبي، شمس الدين أبو عبد الله محمّد (ت: 748هـ/ 1347م)
39. سير أعلام النبلاء، تح، مجموعة من المحققين بإشراف شعيب الأرناؤوط، مؤسسة الرسالة، ط3، د.م، 1985م.
الرازي، أبو عبد الله محمّد بن أبي بكر (ت: 666هـ/ 1268م).
40. مختار الصحاح، تح يوسف الشيخ محمّد المكتبة العصرية، ط5، بيروت، 1999م.
ابن راهويه، أبو يعقوب إسحاق بن إبراهيم الحنظلي (ت: 238هـ/ 852م)
41. مسند إسحاق بن راهويه، تح، عبد الغفور البلوشي، مكتبة الإيمان، المدينة المنورة، 1991م.
ابن رجب، زين الدين عبد الرحمن بن أحمد، البغدادي (ت: 795هـ/ 1392).
42. فتح الباري شرح صحيح البخاري، تح، محمود بن شعبان بن وآخرون، مكتب تح دار الحرمين، ط1 القاهرة، 1996م.
الزبيدي، محمّد بن عبد الرزّاق (ت 1205هـ/ 1790م).
43. تاج العروس من جواهر القاموس، دار الهداية، تح، مجموعة من المحققين، الرياض، د.ت.
الزبيري، مصعب بن عبد الله بن مصعب (ت: 236ه/ 850م).
44. نسب قريش، تح، ليفي بروفنسال، دار المعارف، ط3، القاهرة، د.ت.
الزرقاني، أبو عبد الله محمّد المالكي (ت: 1122هـ/1710م)
45. شرح الزرقاني على المواهب اللدنية بالمنح المحمدية، دار الكتب العلمية، د.م 1996م.
الزمخشري، أبو القاسم محمود بن عمرو بن أحمد (ت: 538ه/ 1143م).
46. الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل، دار الكتاب العربي ط3، بيروت 1407هـ.
ابن سعد، أبو عبد الله محمّد بن سعد البصري (ت230هـ/ 844م).
47. الطبقات الكبرى، تح، إحسان عباس، دار صادر، ط1، بيروت، 1968م.
أبو السعود، محمّد بن محمّد بن مصطفى العمادي (ت:982هـ/ 1574).
48. إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم، دار الكتب العلميّة، بيروت، 1999م.
ابن سعيد الأندلسي (ت:685هـ/ 1286).
49. نشوة الطرب في تاريخ جاهلية العرب، تح نصرت عبد الرحمن، مكتبة الأقصى، الأردن، 1982.
السمعاني، أبو المظفر، منصور بن محمّد بن ابن أحمد (ت: 489ه/ 1104م).
50. تفسير القرآن تح، ياسر بن إبراهيم وغنيم بن عباس، دار الوطن، الرياض، السعودية، 1997م.
السمهودي، نور الدين علي بن السيد الشريف، (ت 911 هـ/ 1505م).
51. وفا الوفا بأخبار دار المصطفى، مطبعة الآداب والمؤيد، مصر، 1326هـ.
ابن سيد الناس، أبو الفتح محمّد بن محمّد الربعي، (ت:734هـ/ 1333م).
52.عيون الأثر في فنون المغازي والشمائل والسير، تعليق، إبراهيم محمّد رمضان، دار القلم، ط1، بيروت، 1993م.
السيوطي، جلال الدين عبدالرحمن بن أبي بكر (ت 911هـ/ 1505م)
53. الإتقان في علوم القرآن، تح، محمد أبو الفضل إبراهيم، الهيئة المصرية للكتاب، القاهرة، 1974م.
54. جمع الجوامع (الجامع الكبير)، تح، مختار إبراهيم الهائج وآخرون، الأزهر، مجمع البحوث الإسلامية، ط2، القاهرة، 2005م.
55. الدر المنثور، دار الفكر، بيروت 1993م.
56. الشماريخ في علم التاريخ، تح، محمّد بن إبراهيم الشيباني، الناشر الدار السلفية، الكويت، 1399هـ.
57. لباب النقول في أسباب النزول ضبطه وصححه، أحمد عبد الشافي، دار الكتب العلمية بيروت، لبنان، د.ت
59. المزهر في علوم اللغة وأنواعها، تح فؤاد علي منصور، ط1، دار الكتب العلمية، بيروت، 1998م.
الشهرستاني، محمد بن عبد الكريم (ت 549هـ/ 1154م).
60. الملل والنحل، تح محمّد سيد كيلاني، دار المعرفة، بيروت، 1404هـ.
ابن أبي شيبة، أبو بكر، عبد الله بن محمّد بن إبراهيم بن عثمان (ت: 235هـ/ 849م).
61. الأدب لابن أبي شيبة تح، محمّد رضا القهوجي، دار البشائر الإسلامية، لبنان، 1999م.
62. المصنف في الأحاديث والآثار، تح، كمال يوسف الحوت، مكتبة الرشد، ط1، الرياض، 1409هـ.
الصالحي الشامي، محمد بن يوسف (ت: 942هـ/ 1535م)
63. سبل الهدى والرشاد، تح، عادل أحمد عبد الموجود، علي محمّد معوض، دار الكتب العلمية، ط1 بيروت، 1993 م.
ابن ظهيرة، جمال الدين محمّد جار الله (985هـ/1578م)
64. الجامع اللطيف في فضل مكّة وأهلها وبناء البيت الشريف، دار إحياء الكتب، ط1، مصر، 1921م.
الطبراني، سليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير اللخمي (ت: 360ه/ 790م)
65. مسند الشاميين، تح، حمدي بن عبد المجيد، مؤسسة الرسالة، بيروت، 1984م.
66. المعجم الكبير، تح، حمدي بن عبد المجيد، ط2، القاهرة، د.ت.
الطبرسي، أبو علي الفضل بن الحسن (560هـ/ 1146م).
67. مجمع البيان في تفسير القرآن، تح لجنة من العلماء، تقديم محسن العاملي مؤسسة الأعلمي، ط1، بيروت، 1415هـ.
الطبري، أبو جعفر محمّد بن جرير (ت 310هـ/ 922م)
68. تاريخ الرسل والملوك، دار التراث، ط2، بيروت، 1387هـ.
69. جامع البيان في تأويل القرآن، تح، أحمد محمّد شاكر، مؤسسة الرسالة، ط1، د.م، 2000م.
الطوسي، أبو جعفر محمّد بن الحسن (460هـ/ 1067م)
70. التبيان في تفسير القرآن، تح وتصحيح: أحمد حبيب العاملي، ط1، مكتب الإعلام الإسلامي، د.م، 1409هـ.
ابن عاشور، محمّد الطاهر بن محمّد الطاهر التونسي (ت: 1393هـ/ 1973م).
71. التحرير والتنوير «تحرير المعنى السديد...»، الدار التونسية، تونس، 1984م.
ابن عبد البر، أبو عمر يوسف النمري (ت:463هـ/ 1070م).
72. الاستذكار، تح، سالم محمّد عطا، محمّد علي معوض، دار الكتب العلمية، ط1، بيروت، 2000م.
73. الاستيعاب في معرفة الاصْحاب، تح علي محمّد البجاوي، مطبعة نهضة مصر، القاهرة، د.ت.
74. الإنباه على قبائل الرواة، تح إبراهيم الأبياري دار الكتاب العربي بيروت، ط1، 1985م.
75. القصد والأمم في التعرف بأصول أنساب العرب والعجم، مكتبة القدسي، القاهرة، 1350هـ.
ابن عبد الحق، صفي الدين عبد المؤمن ابن شمائل البغدادي (ت739هـ/ 1339م)
76. مراصد الاطّلاع على أسماء الأمكنة والبقاع، تح علي محمّد البجاوي، دار الجيل، بيروت، 1991م.
العصامي، عبد الملك بن حسين( 1111هـ/ 1700م).
77. سمط النجوم العوالي تح، عادل أحمد عبد الموجود، واخرون، ط1، دار الكتب العلمية بيروت، 1998م.
ابن عطية، أبو محمّد عبد الحق المحاربي (ت: 542هـ/ 1147م).
78. المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز، تح، عبد السلام عبد الشافي، دار الكتب العلمية، بيروت، 1422.
ابن عنبة، جمال الدين أحمد بن علي الحسيني (ت 828هـ/ 1424م).
79. عمدة الطالِب في أنساب آل ابي طالِب، تح، محمّد حسن آل الطالقاني، ط2، المكَتَبة الحيدرية، النجف، 1961م.
العمري، شهاب الدين أحمد بن يحيى بن فضل الله القرشي (749هـ/ 1348م).
80. مسالك الأبصار في ممالك الأمصار، المجمع الثقافي، ط1، أبو ظبي، 1423 هـ.
العياشي، النضر محمّد بن مسعود بن عياش (ت320هـ/ 622م).
81. التفسير العياشي، تح، هاشم الرسولي، المكتبة العلمية الإسلامية، طهران، د.ت.
ابن الغرابيلي، شمس الدين محمّد بن قاسم الغزي، (ت: 918هـ/ 1512م).
82. فتح القريب المجيب في شرح ألفاظ التقريب، دار ابن حزم للطباعة والنشر، ط1، بيروت، 2005م.
الغزالي، أبو حامد محمّد بن محمّد (ت: 505هـ/ 1111م).
83. معارج القدس في مدراج معرفة النفس، دار الآفاق الجديدة، ط2، بيروت، 1975
ابن فارس، أبو الحسين أحمد بن زكريا القزويني (ت: 395هـ/ 1004م).
84. معجم مقاييس اللغة، تح، عبد السلام محمّد هارون، دار الفكر، د.م، 1979م.
الفاسي، أبو الطيب تقي الدين محمّد بن احمد بن علي (ت: 832هـ/ 1228م).
85. شفاء الغرام بأخبار البلد الحرام، دار الكتب العلمية، ط1، د.م، 2000م.
الفاكهي، أبو عبد الله محمّد بن إسحاق بن العباس، (ت: 275هـ/ 888م).
86. أخبار مكّة في قديم الدهر وحديثه، ط2، تح، عبد الملك عبد الله دهيش، دار الخضر، بيروت، 1414هـ.
فخر الدين الرازي، أبو عبد الله محمّد بن عمر (ت: 606هـ/ 1209م).
87. مفاتيح الغيب أو التفسير الكبير، دار إحياء التراث العربي ط3، بيروت، 1420هـ.
أبو الفداء، المؤيد عماد الدين إسماعيل (732هـ/ 1332مـ).
88. المختصر في أخبار البشر، المطبعة الحسينية المصرية، ط 1، القاهرة، د.ت.
الفراهيدي، أبو عبد الرحمن الخليل بن أحمد (ت 175هـ/ 791م).
89. العين، تح، مهدي المخزوي إبراهيم السامرائي، مطبعة الهلال، 1410هـ.
الفيروز آبادى، مجد الدين أبو طاهر محمّد (ت: 817هـ/ 1414مـ).
90. القاموس المحيط، تح، مكتب تح التراث مؤسسة الرسالة، بيروت، ط8، 1426هـ-2005م.
القرشي، عبد الله بن وهب بن مسلم (ت 197هـ/ 812م).
91. الجامع في الحديث، تح، مصطفى حسن حسين أبو الخير، دار ابن الجوزي، السعودية 1996م.
القرطبي، أبو عبد الله محمّد بن أحمد (ت:671هـ/ 1272م).
92. الجامع لأحكام القرآن، تح، أحمد البردوني إبراهيم أطفيش، دار الكتب المصرية ط2، القاهرة، 1964م.
القلقشندي، أبو العباس أحمد (ت821 هـ/ 1418م).
93. صبح الأعشى في صناعة الإنشا دار الكتب العلمية، بيروت، د.ت.
94. نهاية الأرب في معرفة انساب العرب تح، إبراهيم الإبياري، دار الكتاب اللبنانيين ط1، بيروت، 1980م.
ابن كثير، أبو الفداء اسماعيل بن عمر الدمشقي (ت 747 هـ/1346م).
95. البداية والنهاية، تح، علي شيري، ط1 دار إحياء التراث العربي، بيروت، 1988م.
96. تفسير القرآن العظيم، تح محمّد حسين شمس الدين، دار الكتب العلمية، بيروت، 1419هـ.
ابن الكلبي، ابو منذر هشام بن محمّد أبي النضر ابن السائب (ت 204هـ/ 819م).
97. كتاب الأصنام، تح أحمد زكي باشا، دار الكتب المصرية ط4، القاهرة، 2000م.
مالك بن أنس، بن مالك بن عامر الأصبحي المدني (ت 179ه/795م).
98. الموطأ، تح، محمّد مصطفى الأعظمي، مؤسسة زايد، الإمارات، 2004م.
الماوردي، أبوالحسن علي بن محمّد البغدادي، (ت:450هـ/ 1058م)
99. النكت والعيون أوتفسير الماوردي، تح، السيد ابن عبد المقصود، دار الكتب العلمية، بيروت، د.ت.
ابن المجاور، أبو الفتح يوسف بن يعقوب الدمشقي (690هـ/ 1291م)
100. صفة بلاد العرب ومكة وبعض الحجاز المعروف بتأريخ المستبصر، مراجعة وتعليق ممدوح حسن محمد، القاهرة، 1996م.
المزي، يوسف بن عبد الرحمن بن يوسف، القضاعي (ت: 742هـ/ 1341م).
101. تهذيب الكمال في أسماء الرجال، تح، بشار عواد معروف، مؤسسة الرسالة، بيروت، 1980م.
المسعودي، أبو الحسن علي بن الحسين (ت:345هـ/ 956م).
102. مروج الذهب ومعادن الجوهر، تح، أسعد داغر دار الهجرة، قم، 1409هـ.
مسلم، أبو الحسن ابن الحجاج القشيري النيسابوري (ت: 261هـ/ 874م).
103. المسند الصحيح أو"صحيح مسلم"، تح، محمّد فؤاد عبد الباقي دار إحياء التراث العربي، بيروت، د.ت.
المقدسي، المطهر بن طاهر المقدسي (ت:355هـ/ 965م).
104. البدء والتاريخ، مكتبة الثقافة الدينيّة، بورسعيد، د.ت.
المقريزي، أبو العباس الحسيني العبيدي، تقي الدين (ت:845 هـ/ 1442م).
105. المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار، دار الكتب العلمية، ط1، بيروت، 1418هـ.
ابن منظور، محمد بن مكرم الإفريقي، (ت 711هـ/ 1311م).
106. لسان العرب، دار صادر، ط3، بيروت، 1414هـ.
النسائي، أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب (ت: 303هـ/ 915م).
107.السنن الكبرى، تح وتخريج حسن عبد المنعم شلبي وشعيب الأرناؤوط، ط1، مؤسسة الرسالة، بيروت، 2001 م.
108.المجتبى من السنن، تح، عبد الفتاح أبو غدة، مكتب المطبوعات الإسلامية، حلب، 1986م.
ابن نما الحلي، أبو البقاء هبة الله محمّد (6ق هـ/ 12م)
109. المناقب المزيدية في أخبار الملوك الأسدية، تح محمّد عبد القادر، وآخرون مكتبة الرسالة الحديثة، عمان 1984م.
نور الدين الحلبي، علي بن إبراهيم بن أحمد الحلبي (ت: 1044هـ/ 1634م).
110. إنسان العيون في سيرة الأمين المأمون أو السيرة الحلبية، دار الكتب العلمية، ط2، بيروت، 1427هـ.
النووي، أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف (ت: 676هـ/ 1277م).
111. تحرير ألفاظ التنبيه، تح، عبد الغني الدقر، دار القلم، دمشق، 1408.
النيسابوري، نظام الدين الحسن بن محمّد (ت: 850هـ/ 1446م).
112. غرائب القرآن ورغائب الفرقان تح، الشيخ زكريا عميرات، ط1، دار الكتب العلمية، بيروت، 1416 هـ.
ابن هشام، أبو محمّد عبد الملك بن هشام بن أيوب الحميري (ت: 213هـ/ 828م)
113. التيجَان في مُلوك حِمْيَرْ، تح، مركز الدراسات والأبحاث اليمنية، ط1، صنعاء، 1347هـ.
114. السيرة النبوية، تح، مصطفى السقا وآخرون، مطبعة مصطفى البابي، الحلبي وأولاده، ط2، القاهرة، 1955م.
الهمداني، لسان اليمن الحسن بن احمد بن يعقوب (ت:334 هـ/ 945م)
115. صفة جزيرة العرب، مطبعة بريل، ليدن، 1884م.
الهندي، علاء الدين علي بن حسام فوري (ت: 975هـ/ 1567م)
116. كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال، تح، بكري حياني، صفوة السقا، مؤسسة الرسالة، ط5، د.م، 1981م.
الواحدي، ابو الحسن علي بن أحمد، (468هـ/ 1057م)
117. الوسيط في تفسير القرآن المجيد، تح، عادل أحمد عبد الموجود وآخرون، دار الكتب العلمية، ط1، بيروت، 1994م.
الواقدي، محمد بن عمر بن واقد السهمي الأسلمي (ت: 207هـ/ 822م)
118. المغازي، تح، مارسدن جونس، دار الأعلمي، ط3، بيروت، 1989م.
ياقوت الحموي، شهاب الدين بن عبد الله الرومي البغدادي (ت 626هـ/ 1228م)
119. معجم البلدان، دار صادر، ط2، بيروت، 1995م.
اليعقوبي، أحمد بن يعقوب بن جعفر بن وهب (ت:284 هـ/ 897م)
120. تاريخ اليعقوبي، دار صادر، بيروت، د.ت.
1. إبراهيم مصطفى وآخرون، المعجم الوسيط، تح، مجمع اللغة العربية، دار الدعوة، د.ت، د.م.
2. أبو شُهبة، محمد بن محمد، المدخل لدراسة القرآن الكريم، مكتبه السنة، القاهرة، 2003م.
3. أحمد، محمد وقيع الله، الإسلام في المناهج الغربية المعاصرة عرض ونقد، بحث مقدم لنيل جائزة نايف بن عبد العزيز العالمية للسنة النبويّة والدراسات الإسلاميّة المعاصرة، د.م، 2007م.
4. الألباني، أبو عبد الرحمن محمّد ناصر الدين، سلسلة الاحاديث الضعيفة والموضوعة، مكتبة المعارف، الرياض، 1992م.
5. الألباني، نصب المجانيق لنسف قصة الغرانيق، المكتب الإسلامي، ط3، د.م، 1996م.
6. الألوسي، شهاب الدين الحسيني، روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني، تح، علي عبد الباري عطية، ط1، دار الكتب العلمية، بيروت، 1415هـ.
7. أنطونيوس، فكري، تفسير أنطونيوس فكري لسفر زكريا والتكوين، كنيسة العذراء، مصر، 2010م.
8. باسلامه، حسين عبد الله، تاريخ الكعبة المعظمة، ط1، د.م 1354هـ.
9. باقر، طه، مقدمة في تاريخ الحضارات القديمة، بغداد 1973م.
10. بطرس عبد الملك وآخرون، قاموس الكتاب المقدس، تحرير يوسف شماس وآخرون، إشراف رابطة الكنائس الإنجيلية في الشرق الأوسط مكتبة المشعل، بيروت ط6، 1981م.
11. بيضون، إبراهيم، الحجاز والدولة الإسلامية، المؤسسة الجامعية للدارسات والنشر والتوزيع، بيروت، لبنان، 1983م.
12. التركي، هند محمّد، مملكة قيدار، دراسة في التاريخ السياسي والحضاري خلال الألف الأوّل قبل الميلاد، مكتبة الملك فهد الوطنية، الرياض 2011م.
13. التهامي نقرة، القرآن والمستشرقون، بحث منشور في كتاب مناهج المستشرقين في الدراسات العربية الإسلامية، المنظمة العربية للتربية والثقافة والفنون، تونس، 1985م.
14. تيمور، أحمد باشا، التصوير عند العرب قبل الإسلام، جمع زكي محمّد حسن، معهد الآثار الإسلاميّة، القاهرة، 1942م.
15. الجبرتي، عبد المتعال محمد، السيرة النبوية وأوهام المستشرقين، مكتبة وهبة، القاهرة، د.ت.
16. الجزائري، جابر بن موسى، أيسر التفاسير لكلام العلي الكبير، مكتبة العلوم والحكم، ط5، المدينة المنورة، 2003م.
17. جعيط، هشام، تاريخية الدعوة المحمدية في مكة، دار الطليعة للطباعة والنشر، بيروت، 2007م.
18. جعيط، الوحي والقرآن والنبوة، دار الطليعة، بيروت، 1999م.
19. جواد علي، تاريخ الصلاة، مطبعة ضياء، بغداد، د.ت.
20. جواد علي المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام، دار الساقي، ط4، د.م، 2001م.
21. جورافسكي، أليسكي، الإسلام والمسيحية، عالم المعرفة، الكويت، 1997م.
22. جورجي، وهيب، مقدمات العهد القديم ومناقشة الاعتراضات، القاهرة، 1985م.
23. الجوهري، يسري، جغرافية البحر المتوسط، منشاة المعارف، القاهرة، 1984م.
24. جميل، صليبا، المعجم الفلسفي، الشركة العالمية للكتاب، بيروت 1994م.
25. الحفني، عبد المنعم، المعجم الشامل لمصطلحات الفلسفة، مكتبة مدبولي، ط3، القاهرة، 2000م.
26. الخالدي، صلاح عبد الفتاح، إعجاز القرآن البياني ودلائل مصدره الرباني، دار عمار، عمان، 2000.
27. الخالدي، القرآن ونقض مطاعن الرهبان، دار القلم، دمشق2007م.
28. الخربوطلي، علي حسني، تاريخ الكعبة، دار الجيل، ط3، بيروت، 1991م.
29. خلف الله، محمد، الفن القصصي في القرآن الكريم، سينا والانتشار العربي، ط4، لندن، بيروت القاهرة، 1999م.
30. خليل، عماد الدين، المستشرقون والسيرة النبوية، دار ابن كثير للطباعة والنشر، بيروت، 1426هـ.
31. دراز، محمّد عبد الله، النبأ العظيم نظرات جديدة في القرآن الكريم، دار الثقافة، الدوحة، 1985م.
32. الدوري، عبد العزيز، نشأة علم التاريخ عند العرب، مركز زايد للتراث، د.م، 2000م.
33. رستم، سعد الفرق والمذاهب المسيحية منذ ظهور الإسلام حتّى اليوم، دار الأوائل، ط2، دمشق، 2005.
34. رضا، محمد رشيد الحسيني، الوحي المحمدي، دار الكتب العلمية، بيروت، 2005م.
35. رضوان، عمر ابراهيم، آراء المستشرقين حول القرآن وتفسيره دراسة ونقد، الرياض، د.ت.
36. الزرقاني، محمّد عبد العظيم، مناهل العرفان في علوم القرآن، تح فواز أحمد، دار الكتاب العربي، بيروت، 1952م.
37. الزركلي، خير الدين محمود الدمشقي، الأعلام، دار العلم للملايين، ط 15، بيروت، 2002م.
38. زقزوق حقائق الإسلام في مواجهة شبهات المشككين، القاهرة، 2002م.
39. زيدان، جرجي، العرب قبل الإسلام، مطبعة الهلال، ط 1، مصر، 1922م.
40. ساسي، سالم الحاج، نقد الخطاب الاستشراقي، دار المدار الإسلامي، بنغازي-بيروت، 2001م.
41. السامرائي، فاضل صالح، نبوة محمّد صلىاللهعليهوآله من الشك إلى اليقين، مكتبة القدس، ط3، عمان، 2007م.
42. الساموك، سعدون محمود، موسوعة الأديان والمعتقدات القديمة، دار المناهج، ط1، عمان، 2002م.
43. السايح، إبراهيم، مدائن صالح من مملكة الأنباط إلى قبيلة من الفقراء، دار البستاني، القاهرة، 2000م.
44. سمايلوفتش، أحمد، فلسفة الاستشراق وأثرها في الأدب العربي المعاصر، دار المعارف، القاهرة، 1980م.
45. سوسة، أحمد، مفصل العرب واليهود في التاريخ، وزارة الثقافة والإعلام، العراق، 1981م.
46. الشرقاوي، جمال الدين، نبي أرض الجنوب في الأسفار اليهوديّة والمسيحيّة، دار هادف، القاهرة، د.ت.
47. الشريف، احمد إبراهيم، مكّة والمدينة في الجاهلية وعهد الرسول، دار الفكر العربي، القاهرة، 1965م.
48. الشعراوي، محمد متولي، تفسير الشعراوي «الخواطر»، مطابع أخبار اليوم، القاهرة، 1997م.
49. الشوكاني، محمّد بن علي، فتح القدير، دار ابن كثير، دار الكلم الطيب، ط1، دمشق، بيروت، 1414هـ.
50. شيخو، لويس، النصرانية وآدابها بين عرب الجاهلية، دار المشرق، بيروت، 1986م.
51. الصغير، محمد حسين علي، تاريخ القرآن، دار المؤرّخ العربي، بيروت، 1420.
52. طنطاوي، محمد سيد، التفسير الوسيط للقرآن الكريم، دار نهضة، القاهرة، 1998م.
53. طه حسين، مرآة الإسلام، دار المعارف، مصر، 1959م.
54. عامر، يوسف، منهج علماء اللغة الأُرديّة في الرد على المستشرقين، القاهرة، 2009م.
55. عامري، سامي، هل القران الكريم مقتبس من كتب اليهود والنصارى، البحث العلمي لمقارنة الأديان، د.م، 2010م.
56. عباس، إحسان، تاريخ دولة الانباط، دار الشروق للتوزيع والنشر، ط1، عمان، 1987م.
57. عباس، حسن فضل، إعجاز القرآن الكريم، الجامعة الأردنية، عمان، 1991م.
58. عبد الباقي، محمد فؤاد، المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم، مطبعة دار الكتب المصرية، القاهرة، 1364هـ.
59. عبد الحميد، صائب، في مقارنة الأديان، نظرة سريعة في التوراة والإنجيل والقرآن، مركز الرسالة، د.م، 2004م.
60. عبد الرحمن، محمّد عوض، الاختلاف والاتفاق بين إنجيل برنابا والأناجيل الأربعة، دار البشير، القاهرة، 1986م.
61. عبد الرحيم، أحمد السايح، الاستشراق في ميزان نقد الفكر الإسلامي، الدار المصرية اللبنانية، القاهرة، 1996م.
62. عبد النور، منيس، إبراهيم خليل الله، ط1، ألمانيا، 1988م.
63. عبودي، هنري، س، معجم الحضارات السامية، ط2، مطبعة جروس برس، طرابلس، ١٩٩١م.
64. عتر، حسن، وحي الله حقائقه وخصائصه في الكتاب والسنة، دار المكتبي، دمشق، 1999م.
65. عثمان، أحمد، تاريخ اليهود، مكتبة الشروق، القاهرة، د.ت.
66. عرفان، عبد الحميد، فتاح، دراسات في الفكر العربي الإسلامي، دار الجيل الناشر، بيروت، 1991م.
67. العقاد، عباس محمود، إبراهيم أبو الأنبياء، نهضة مصر للطباعة والتوزيع، القاهرة، د.ت.
68. العقاد، موسوعة عباس محمود العقاد الإسلامية، المجلد الرابع، القرآن والإنسان، دار الكتاب العربي، بيروت، 1971.
69. العقيقي، نجيب، موسوعة المستشرقون، دار المعارف، ط3، القاهرة، 1964م.
70. العلوي، عادل، علي المرتضى نقطة باء البسملة، مركز الأبحاث العقائدية د.م، د.ت.
71. علي، عبد الكريم، افتراءات فليب حتي وكارل بروكلمان على التاريخ الإسلامي، ط1، جدة، 1983م.
72. علَيَّان، زياد، الخطاب اليَهودي بَين المَاضي وَالحَاضِر، تقديم، عماد الدين خليل، دار الشهاب، ط1، دمشق، 2001م.
73. عماد، عبد السميع، الإسلام واليهودية دراسة مقارنة من خلال سفر اللاويين، دار الكتب العلمية، بيروت، 2004م.
74. عمايرة، إسماعيل، بحوث في الاستشراق واللغة، دار البشير، عمان، 1996م.
75. عوض، إبراهيم، مصدر القرآن، دراسة لشبهات المستشرقين والمبشرين حول الوحى المحمدي، القاهرة، 1997م.
76. غربال، محمد شفيق، الموسوعة العربية الميسرة، المكتبة العصرية، بيروت، 2010م.
77. الفاروقي، محمد علي، موسوعة كشاف اصطلاحات الفنون، تح، علي دحروج، مكتبة لبنان ط1، بيروت، 1996م.
78. فرحات، عبد الحكيم، إشكالية تأثر القرآن الكريم بالأناجيل في الفكر اللاستشراقي الحديث، د.م، د.ت.
79. القمني، سيد محمود، الحزب الهاشمي وتأسيس الدولة الإسلاميّة، مكتبة مدبولي الصغير، ط4، القاهرة، 1997م.
80. القِنَّوجي، محمد صديق خان الحسيني، فتحُ البيان في مقاصد القرآن، عني بطبعهِ وقدّم له وراجعه، عَبد الله بن إبراهيم الأنصَاري، المَكتبة العصريَّة للطبَاعة والنّشْر، صَيدَا، بَيروت، 1992م.
81. كحالة، عمر بن رضا، معجم قبائل العرب القديمة والحديثة، مؤسسة الرسالة، بيروت، 1994م.
82. كمال، صلاح، الاسلام والمحرفون للكلم، مطبوعات عبد السلام حرب، تورنتو، 1405هـ.
83. الكيرواني، رحمة الله بن خليل الرحمن الهندي، إظهار الحق، تح محمّد أحمد عبد القادر خليل ملكاوي، الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد، ط1، السعودية، 1989م.
84. ماضي، محمود، الوحي القرآني في المنظور الاستشراقي ونقده، دار الدعوة للنشر والتوزيع، الاسكندرية، 1996م.
85. المجدوب، أحمد علي، المستوطنات اليهودية على عهد الرسول، الدار المصرية اللبنانية القاهرة، 1996م.
86. مجموعة من الباحثين، رد افتراءات المنصرين حول الإسلام العظيم، مركز التنوير الإسلامي القاهرة، 2008م.
87. مجموعة من علماء اللاهوت دائرة المعارف الكتابية، دار الثقافة، ط1، القاهرة، د.ت.
88. مجموعة من المؤلفين، المرشد إلى الكتاب المقدس، دار الكتاب المقدس وجمعية الكنائس، بيروت، 2000م.
89. المجيدي، عبد السلام، تلقي النبي صلىاللهعليهوآله ألفاظ القرآن الكريم دراسة تأصيلية، مؤسسة الرسالة، بيروت، 2000م.
90. المجيدي اليمني، إذهاب الحزن وشفاء الصدر السقيم، دار الإيمان ط1، الإسكندرية، 2004م.
91. محمّد عبدة، الأعمال الكاملة، تح محمّد عمارة، دار الشروق، بيروت-القاهرة، 1993م.
92. محمّد علي البار، المدخل لدراسة التوراة والعهد القديم، دار القلم، ط1، دمشق، 1990م.
93. مختار، محمد علي، الحنيفية والحنفاء الجزيرة العربية قبل الإسلام، السعودية، 1984م.
94. مراد وهبة، المعجم الفلسفي، دار قباء الحديثة، القاهرة، 2007م.
95. مراني، ناجية، مفاهيم صابئية مندائية، شركة التايمز للطباعة النشر، ط2، بغداد، 1981م.
96. مشتاق الغزالي، بشير، القرآن الكريم في دراسات المستشرقين، دار النفائس، دمشق-بيروت، 2008م.
97. ملطي، تادرس يعقوب، تفسير سفر التكوين كنيسة الشهيد مار جرجس، باسبورتنج، 1983م.
98. منصور، يسّى، نقد إنجيل برنابا، مخالفته للإسلام والمسيحية واليهودية، دار نشر الثقافة الإسلامية، 1973م.
99. النبهان، محمّد فاروق، المدخل إلى علوم القرآن الكريم، دار عالم القرآن، حلب، 2005م.
100. نخبة من كبار العلماء، موسوعة بيان الإسلام الرد على الإفتراءات، مج5، دار نهضة مصر، القاهرة، 2011م.
101. الندوي، سليمان الحسيني، الرسالة المحمدية، دار ابن كثير، دمشق، 1423هـ.
102. هاشم، زكريا، المستشرقون والإسلام، لجنة التعريف بالإسلام، القاهرة، 1965م.
103. الهوبي، جمال محمّد، مقدمة في إعجاز القرآن العظيم، غزة، 2011م.
104. هيكل، محمد حسنين، حياة محمّد، دار المعارف، ط14، القاهرة، 1977م.
105. وجيه، بن حمد، وقفة مع بعض الترجمات الإنكليزية لمعاني القرآن الكريم، ندوة عناية المملكة العربية السعودية بالقرآن الكريم وعلومه، مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، 1421هـ.
106. وزان، محمد عدنان، صورة الإسلام في الأدب الإنكليزي، دار اشبيلية للطباعة والنشر، ط1، الرياض، 1998م.
107. ولفنسون، إسرائيل، تاريخ اليهود في بلاد العرب في الجاهلية وصدر الإسلام، مطبعة الاعتماد، مصر، 1927م.
108. ولفنسون، إسرائيل، كعب الأحبار، مطبعة الشرق، القدس، 1976م.
رابعًا: المصادر الأجنبيّة المعربة:
1. الكونت، دي كاستري، الإسلام خواطر وسوانح ترجمة أحمد فتحي زغلول، دار طيبة للطباعة، الجيزة، 2008م.
2. باركلي، وليم، تفسير العهد الجديد، رسالة رومية، ترجمة منيس عبد النور، دار الثقافة، القاهرة، 1982م.
3. بدوي، عبد الرحمن، دفاع عن القرآن ضد منتقديه ترجمة كمال جاد الله، الدار العالمية، للكتب والنشر، د.م، د.ت.
4. بدوي، عبد الرحمن، موسوعة المستشرقون، دار العلم للملايين، ط3، بيروت، 1993.
5. براون، بربارا، نظرة عن قرب إلى المسيحية، ترجمة مناف حسين الياسري، كندا، 1993م.
6. بروكلمان، كارل، تاريخ الشعوب الإسلامية، ترجمة، منير بعلبكي ونبيه آمين، ط5، دار العلم للملايين، بيروت، 1968م.
7. بودلي ر.ف، حياة محمد، ترجمة عبد الحميد جوده السحار، محمّد فرج بودلي، مصر، 1945م.
8. خان، محمد عبد المعيد، الأساطير العربية قبل الإسلام، لجنة التأليف والترجمة، القاهرة، 1937م.
9. دراز، مدخل إلى القرآن الكريم، ترجمة محمّد عبد العظيم، دار القلم، الكويت، 1984.
10. ديسو، رنيه، العرب في سوريا، ترجمة، عبد الحميد الدواخلي، محمد زيادة، لجنة التأليف والترجمة والنشر، القاهرة، 1959م.
11. سوذرن، ريتشارد، صورة الإسلام في القرون الوسطى، ترجمة رضوان السيد، دار المدار، بيروت، 2006م.
12. شاحاك، إسرائيل، الديانة اليهودية وموقفها مِنْ غير اليهود، ترجمة، حسن خضر، ابن سينا للنشر، القاهرة، 1994م.
13. شاخت، جوزيف وكليفورد بوزورث، تراث الإسلام، ترجمة محمّد زهير السمهوري، تح، شاكر مصطفى، عالم المعرفة، الكويت 1978م.
14. صليبي، كمال، التوراة جاءت من جزيرة العرب، ط6، ترجمة عفيف الرزاز، مؤسسة الأبحاث العربية، لبنان، 1997م.
15. طاقم التخطيط الإسلامي-اليهودي، اليهودية والإسلام، اتجاهات الحوار والمشاركة والتعارف، بروكسل، 2010م.
16. فاغليري، لورا فيشيا، دفاع عن الإسلام، ترجمة منير البعلبكي، دار العلم للملايين، ط3، بيروت، 1976م.
17. فيدر، نفتالي، التأثيرات الإسلاميّة في العبادة اليهودية، ترجمة محمّد سالم الجرح، القاهرة 2001م.
18. كراتشكوفسكي، يوليانوفيتش، تاريخ الأدب الجغرافي العربي ترجمة صلاح الدين عثمان هاشم، القاهرة، 1963م.
19. مالك بن نبي، مشكلات الحضارة الظاهرة القرآنية، ترجمة عبد الصبور شاهين، تقديم، محمد عبد الله دراز، محمود محمّد شاكر، دار الفكر، دمشق، 2000م.
20. محمّد خليفة، الاستشراق والقرآن العظيم، ترجمة، مروان عبد الصبور شاهين، دار الاعتصام، ط1، القاهرة، 1994م.
21. معدى، حسين حسينى، الرّسول صلىاللهعليهوآله في عيون غربية منصفة، دار الكتاب العربي، دمشق، 1419هـ.
22. نادفي، سيد مظفر الدين، التاريخ الجغرافي للقرآن، ترجمة وتعريب، عبد الشافي غنيم عبد القادر، مراجعة حسن محمّد جوهر، لجنة البيان العربي، القاهرة، 1956م.
23. نولدكه، تيودور، تاريخ القرآن، نقله إلى العربية، جورج تامر وآخرون تعديل، فريديريش شفالي، دار جون المز للنشر، هيلدزايم، زيورخ، نيويورك، 2000م.
1. Abstract of the proceedings of the council of the governor-general of India office of superintendent of government,laws and regulations, Vol.Vii, Calcutta, 1869.
2. Acharya S, Suns of God,Kempton, adventure unlimited press, Pennsylvania. 2004.
3. AlBiruni, The chronology of ancient nations an English version of the Arabic text of the atharul bakiya of, translated and edit by, C. Edward Sachau, London 1879.
4. Almond, C, Philip, Heretic and Hero: Muhammad and the Victorians, Netherland,1989.
5. American tract society, Islam and Christianity, New York, 1901.
6. Anderson.S.Christian, What Every Christian Should Know About IslamMuslim world league, NewYork, 2008.
7. Andrew Crichton, History of Arabia Ancient & Modern., published by harper & brothers, NewYork, 1834.
8. Anglo-Indian evangelization society, Twenty-fifthAnnual report, Edinburgh ,1896.
9. Bebbington, D.W, Evangelicalism in modern Britain, Routledge Group, London, 2005.
10. Beckett, Katharine Scarf, Anglo-Saxon perceptions of the Islamic world ,Cambridge University Press, Cambridge, 2003.
11. Bennett, Clinton, Victorian Images of Islam, Grey Seal Books, London, 1992.
12. Birchwood, Matthew, Staging Islam in England Drama and Culture, Cambridg, 2007.
13. Bosworth’s, Smith, Mohammed & Mohammedanism, rivingtons waterloo place, London, 1874.
14. Brewer’s Dictionary of Phrase And Fable, Harper & Brothers publisher, NewYork, 1890.
15. Browne A, Haji, Bonaparte In Egypt & The Egyptians of To-Day, London, 1907.
16. Bruce L. Shelley, Church History in Plain Language, Word Publishing, Texas, 2008.
17. Buckland C.E. Dictionary of Indian biography, Swan Sonnenschein. Co, London,1906.
18. Bulliet, Richard W, The camel and the wheel, Columbia University press USA ,1990.
19. Bosworth C. E, E. Van Donzel, B. Lewis And Ch. Pellat, The Encyclopedia of Islam, Brill, 2010.
20. Butler, Alban, The lives of the fathers, martyrs, & other principal ,vol 12, London, 1813.
21. Caery,H.C,The unity of law; social, mental, & moralscience. philadelphia, 1872.
22. Carlyle, Thomas, On Heroes, Hero-worship and the Heroic in History, New York, 1840.
23. Cheyne, T.K and others, Encyclopaedia Biblica, New York: Macmillan; Vol. II, London, 1902.
(474)24. Critica Biblica or Depository of sacred literature, Vol.II, London, 1827.
25. Charles G.Edward A.Pace Herbermannthe,Conde B. Pallen, John J. Wynne, Thomas J. Shahan, Catholic Encyclopedia. An international work of reference on the constitution, doctrine, discipline, and history of the catholic church, New York, 1907.
26. Clarke, Adam, The Holy Bible, Containing the Old and New Testaments Vol.1, NewYork, 1833.
27. Collier’s New Encyclopedia, P F. Collier & Son Company, New York. 1921.
28. Conan, Doyle, The Sign of Four,edited by, Shafquat Towheed, canada, 2010.
29. Cragg, Kenneth, The Call of the Minaret, Orbis Books, New York, 1985.
30. Crone, Patricia, Meccan trade and the rise of Islam, Gorgeous press, New jersey, USA ,2004.
31. Cuddon J.A., Dictionary of literary terms and literary theory, revised by C.E. Preston, penguin croup, England, 1998.
32. Curtis, Michael, Orientalism and Islam European Thinkers on Oriental Despotism in the Middle East and India, Cambridge University press, Cambridge, 2009.
33. Dahlmann, Professor, The life of Herodotus drawn out from his book, translated by G.V.Cox, Oxford, 1845.
34. Daniel, Norman, Islam Europe and Empire, Edinburgh University, Edinburgh, 1966.
35. Davenport, John, An Apology For Mohammed and The Koran, London, 1869.
36. David A. Leeming, Kathryn Madden, Stanton Marlan, Encyclopedia of Psychology and Religion, NewYork, 2010.
37. David Laing, The Poems of William Dunbar, Edinburgh, 1834.
38. David R. Blanks and Michael Frassetto, Western Views of Islam in Medieval and Early Modern Europe, Newyork, 1999.
39. David Sacks, Lisa R. Brody, Encyclopedia of the Ancient Greek World, NewYork, 2005.
40. Davidson Thomas, chambers’ twentieth century dictionary of the English language pronouncing, London, Edinburgh, 1903.
41. Dermenghem, Emile, The life of Mahomet, Translate by A.York, London, 1930.
42. Dibdin, Thomas, The London theatre, collection of the most celebrated and dramatic pieces, vol.xvi, London, 1816.
43. Dierk, Lange, Ancient Kingdoms of West Africa, Germany, 2004.
44. Diodorus, Siculus, The historical library of Diodorus the Sicilian, book III Printed byW. M’dwall J, London 1814.
(475)45. Dutt, Romesh, The economic history of India in the Victorian age, London, 1908.
46. Edward. W, Craighead, The concise encyclopedia of psychology and behavioral, 3rd Edition, Canada, 2004.
47. Edward Pococke, Specimen Historiae Arabum, Typographeo Clarendoniano. Oxon, 1806.
48. Edward Storrow, The history of protestant Missions in India, London 1884.
49. Elwood Wherry Morris, A Comprehensive Commentary on the Quran: Comprising Sale’s Translation and preliminary Discourse, vol.2, London 1884.
50. Elzain Elgamri, Islam In The British Broadsheets, the Impact of Orientalism on Representations of Islam in the British Press, Ithaca Press, London 2008.
51. Emma Roberts, Scenes and Characteristics of Hindostan, London, 1837.
52. Encyclopaedia Britannica; Dictionary of arts, sciences, Adam and charles, Edinburgh, 1823.
53. Eugene, stock, Beginnings in India, central board of missions and society for promoting Christian knowledge london, 1917.
54. Eugene, The history of the church missionary society its environment, church missionary society vol.ii, london, 1899.
55. Farah, Caesar E. Islam beliefs and observances, Barrons’s, USA.2003.
56. Flower, Michael Attyah, The seer in ancient Greece, University of California Press, California, 2008.
57. Force, James E. &others, Newton and Religion: Context, Nature, and Influence Kluwer academic publisher, Netherlands, 1999.
58. Forster, Charles, The historical geography of Arabia, London. 1884.
59. Frederick, Charles and others, memorials of old Haileybury college, London, 1894.
60. Garcia Humberto, Islam and the English Enlightenment 1670- 1840,Johns Hopkins University press, Maryland, 2012.
61. George Bush, The Life of Mohammed; Founder of The Religion of Islam, And of The Empire of The Saracens, Harper’s Stereotype Edition. NewYork, 1831.
62. George, Sandy’s, Relation of a journey begun An:Dom Fovre bookes Containing a description of the Turkish Empire, of Ægypt, of the Holy Land, of the remote parts of Italy, and islands adjoining Printed for W. Arrett, London, 1610.
63. Gerald, Anderson H,Biographical dictionary of Christian mission, Wm. B. Eerdmans Publishing., New York, 1998.
(476)64. Gibbon, Edward, The history of the decline and fall of the Roman Empire, vol 9 London, 1789.
65. Gill, John, Commentaries Exposition of the Old and New testaments, the Baptist Standard Bearer, Paris, 1999.
66. Godfrey, Higgins, An apology for the life and character of the celebrated prophet of Arabia, called Mohamed, London, 1829.
67. Graham G.F.I, the life and work of Syed Ahmed Khan, London, 1875.
68. Growse, Frederic Salmon, Mathurá; a district memoir, London 1883.
69. Gibb ,H. A. R, Mohammadanism, A Historical Survey, New York, London, 1961.
70. Hager Alan, Encyclopedia of British Writers, 16th, 17th, &18th Centuries, NewYork, 2005.
71. Hamilton, Alastair, William Bedwell the Arabist 1563- 1632,advansment pure research, Leiden Netherland, 1985.
72. Hardwicke, Philip Yorke، Athenian letters or the epistolary correspondence of an agent of an agent of king of Persia, London, 1798.
73. Harold, Alfred MacMichael, A history of the Arabs in the Sudan and some account of the people who preceded them and of the tribes inhabiting Darfur, Cambridge University Press, Cambridge, 1922.
74. Hart, Michael H. The 100: A Ranking of the Most Influential Persons in History, A Citadel Press Book. New York, 1993.
75. Hart H, G, Colonel, The new army list militia list and Indian civil service list the rank standing and various service every regimental officer in the army serving on full pay include royal marines and Indian stuff Corbs, London, 1870.
76. Hastings, James, A Dictionary of the Bible, Charles Scribner’s sons, New York,1909.
77. Herodotus, Translated by, William Beloe, Henry Colburn & Richard Bentley London, 1830.
78. Henry Bergen, Lydgate’s fall of princes, part III, Books VL-IX. Washington, 1923.
79. Hourani, Albert, Islam in European Thought, Cambridge University, Cambridge, 1989.
80. Hoyland, Robert G, Arabia and the Arabs from the bronze age to the coming of Islam London & New York, 2001.
81. Hughes, Patrick Thomas, A dictionary of Islam, Scribner, Welford, & Co, London, 1885.
82. James A. H, A New English Dictionary on Historical Principles, Oxford, vol M, 1928.
83. James Bonwick, The Irish Druids And Old Irish Religions, London, 1894.
(477)84. James Kennedy, life and work in Benares and Kumaon , London 1884.
85. JamesOrr, John I.Nuelsen, Edgar Y. Mullins, The international standard bible Encyclopedia, Chicago, 1915.
86. John Lowe, Medical missions their place and power, Edinburgh,1895.
87. John Wesley, Wesley’s notes on the bible Grand Rapids, Christian Classics Ethereal Library, Bristol, UK, 1754.
88. Jones, Lewellyn, Rosie, The great uprising in india, 1857- 58, woodbridge, 2007.
89. Jordan, Michael, dictionary of gods and goddesses, New York, 2004.
90. Julius, Richter, A history of missions in India, translated by Sydney h. Moore New York, Chicago, Toronto,1908.
91. Karen L. King, What is Gnosticism?, Cambridge Harvard University Press, Harvard, 2003.
92. Kelly J.N.D, Jerome His Life, Writings, and Controversies, New York, 1998.
93. Kempton , M, Therepentance of Nussooh, London, 1884.
94. Khan, Sayed Ahmmad, A series of Essays on the Life of Mohammad, London, 1870.
95. Kramer, Von Alfred, History of Muhammad’s campaigns by Abo Abd Allah Mohammad ‘bin Omar al-wakidy. Calcutta, 1856.
96. Lee, Sidney, Dictionary of National Biography, Second Supplement, London, 1912.
97. Lewis, Bernard, Islam and the west, Oxford university press, Oxford, 1993.
98. Liu Chat-Lien, a life of Mohammed from Chinese and Arabic sources, Translated by Isaac Mason. Shanghai, 1921.
99. Mansour, Atallah, Narrow Gate Churches, The Christian Presence in the Holy Land Under Muslim, Pasadena, USA, 2004.
100. Margoliouth, David Samuel, Mohammed & the Rise of Islam, New York & London, 1905.
101. Martin, Parsons, Unveiling God Contextualizing Christology for Islamic Culture, Published by William Carey Library, Pasadena, USA. 2005.
102. Marchioness of Duffekin & Ava, Our Viceregal life in India; selections from my journal, 1884- 1888, London 1890.
103. Martin H. Manser, The facts on file dictionary of proverbs, the facts on file, USA, 2007.
104. Martin, Sean, The knights Templar, pocket essentials, Harpenden, UK, 2004.
105. Matthew paris’s, English history, from the year 1285 to 1278, vol. I, London. 1889.
106. Matthew Poole, Annotations Upon the Holy Bible, NewYork 1700.
(478)107. Melrose, Robin, The Druids and King Arthur, A New View of Early Britain, British library, UK, 2011.
108. Mohar, Muhammad Ali, Sirat al Nabi and the orientalists, Madinah, 1997.
109. Mohar, The Qur’an and the orientalists, Ipswich, 2004.
110. Moulana Cheragh Ali, A critical exposition of the popularjihad, Calcutta, 1885.
111. Muhammad Ali Maulana, Alleged atrocities of the prophet, lahore, 1930.
112. Muhammad, Shan, Education and politics from Syed to the present day, NewDelhi, 2002.
113. Muir, William, Extracts from the Coran in the original with English rendering, London, 1880.
114. Muir, The sources of Islam, reviewed & translated by William Muir, center for the study of political Islam, USA, 2011.
115. Muir, J. Murray, H.R. Reynolds, Non-Christian religions of the worldThe Religious Tract Society, London, 1890.
116. Muir, Records of the intelligence department of the government of the north-west provinces of India during the mutiny of 1857, Edinburgh, 1902.
117. Muir, Report on The Settlement of Zillah Humeerpore, Under Regulation Ix, Agra, 1842.
118. Muir, The opium revenue published by the Calcutta government, Westminster, 1875.
119. Muir, Inaugural address to the students of the university of Edinburgh for the session 1885- 6, Edinburgh, 1885.
120. Muir, Annals of the early caliphate from original sources, London, 1883.
121.Muir, The Caliphate, its Rise, Decline and Fall, London,1891.
122. Muir, The Coran: Its Composition and Teaching and the Testimony it bears to the Holy Scriptures, Society for Promoting Christian Knowledge, London, 1878.
123. Muir, The honorable James Thomason lieutenant-governor N.W.P, India, Edinburgh, 1897.
124. Muir, The life of Mahomet with introductory chapters on the original sources for the biography of Mahomet, and on the pre-Islamite history of Arabia, London, 1861.
125. Muir, Mahomet and Islam a sketch of the prophets life from original sources, London, 1887
126. Muir, The Mohammedan controversy and other Indian articles, Edinburgh, 1897.
127. Muir, Sweet first-fruits a tale of the nineteenth century, Edinburgh, 1893.
(479)128. Muir, The beacon of truth testimony of the Coran truth of the Christian religion,London, 1894.
129. Muir, The Mameluke or slave dynasty of Egypt, London, 1896.
130. Muir, The rise and decline of Islam, the religious tract society, London, 1890.
131. Muir, The testimony borne by the Coran to the Jewish and Christian Scriptures, Agra, 1856.
132. Murray. J. Mitchell, Muir, Two old faiths essays on the religions of the Hindus and the Mohammedans NewYork, 1891.
133. Nasr Abu Zayd and others, Reformation of Islamic Thought scientific council for government policy, Amsterdam University Press, Amsterdam, 2006.
134. Neill, Stephen, A History of Christianity in India The Beginnings 1707, Cambridge,1984
135. Netton, Ian Richard, Orientalism revisited, Art, Land & Voyage, NewYork, 2013.
136. Ockley, Simone, History of the Saracens, Cambridge, 1757.
137. Parkes J. David,The star, a complete system of the theoretical astrology, London, 1839.
138. Pearson, Harlan Otto, Islamic Reform and Revival in Nineteenth-century India: The Tarīqah-i-Muhammadīyah, Yoda Press, Islamic renewal, New Delhi, 2008.
139. Phillips, Richard, A million of Facts, London,1835.
140. Pottinger, George, Mayo, Disraeli’s Viceroy, Michael Russell, London, 1990.
141. Powell, Avri, l AScottish Orienlalists and India, The Boyde Press, Woodbridge, 2010.
142. Powell, Muslims and missionaries in pre Mutiny India, London, 2003.
143. Prideaux, Humphrey, The True Nature of Imposture, Oxford, 1723.
144. Quinn, Frederick, The sum of all heresies, oxford University press, London, 2008.
145. Raleigh, Walter, The history of the world, London, 1614.
146. Ray Pritchard, Stealth Attack, Lockman Foundation, Chicago, 2007.
147. Raymond J. Corsini, The Dictionary of Psychology, NewYork. 2002.
148. Regna Darnell, Readings in the History of Anthropology, Harper & Row, New York, 1974.
149. Richard Bell, The Origin of Islam in its Christian Environment; London, 1968.
150. Robert, Watt, Britannica, or a general index to British and foreign, London 1824.
151. Robertson, W. Smith ,Kinship and marriage in early Arabia, London, 1903.
152. Rodwell J. M, The Koran Translated from the Arabic, with an Introduction by G. Margoliouth, The Pennsylvania State University, Pennsylvania, 2004.
(480)153. Ross, Alexander ,Pansebeia, or, A view of all religions in the world...London, 1669.
154. Said, Edward W, Orientalism, First Vintage Books Edition, NewYork, 1979.
155. Saint Augustine, The City of God, translated by Marcus Dods, Hendrickson publishers, Inc,, Book16, chap16, Massachusetts, USA, 2009.
156. Sale, George, The Koran, Commonly Called the Alcoran of Mohammed, London, 1795.
157. Schaf, Philip, History of the Christian church, Vol. iv, New York, 1886.
158. Setton, Kenneth M, Western Hostility to Islam and Prophecies of Turkish doom, American philosophical Society, Phiadilifia. 1992.
159. Shakespeare, William, and others, The plays of William Shakespeare, Romeo and Juliet, Vol 20, London 1813
160. Sharma, Raj, Bahadur, Christian missions in north India, India 1998.
161. Shihab, Alwi, Examining Islam in the West, Indonisia. 2011.
162. Smith, Daniel, Hemsworth, H.W, Cuneorum clavis, The primitive alphabet and language of the ancient ones of the earth, London, 1875.
163. Smith, George, The conversion of India from pantænus to the present time, A.D. 193-1893, Publishers of Evangelical Literature, New York Chicago Toronto, 1894.
164. Smith, George, The life of William Carey, Calcutta, 1885.
165. Smith, William, Dictionary of Greek and Roman biography and mythology, Boston, 1870.
166. Society for the Diffusion of Useful Knowledge, The Penny Cyclopaedia, London. 1833.
167. Steve Silbiger, The Jewish phenomenon, Maryland, 2002.
168. Strong, James, A concise dictionary of the words in the Hebrew Bible, Madison 1890.
169. Stuart, Menteth, Silver question and how to raise exchange, Calcutta 1876.
170. Stubbe, Henry, account of the rise and progress of Mahometanism, London, 1911.
171. Swarup, Ram, Hindu view of Christianity and Islam, voice of India, Newdelhi, 2000.
172. Taylor, Isaac, Ancient Christianity & the doctrines of the Oxford tracts, Philadelphia, 1840.
173. Taylor, Samuel The Poetical Works of S.T. Coleridge, Vol 2, London 1836.
174. The British Controversialist, And Literary Magazine, vol3, London 1860.
175. Thomas, Joseph, The Universal Dictionary of Biography and Mythology, New York 2009.
176. Thomson R.W. Historical, commentary by James Howard-Johnston Assistance The Armenian History, attributed to Sebeos, translated, Liverpool, University Press, Oxford, 1998.
(481)177. Turnerf.s. British opium policy and its results to India, London 1876.
178. Two friends, Panjabi sketches, London, 1899.
179. Tisdall, W.St,The original sources of Quran, society for promoting Christian knowledge, London, 1911.
180. Watt, W. Montgomery, Muhammad at Mecca, Oxford University Press, Oxford 1953.
181. Wessels, Antoine, A Modern Arabic Biography of Muḥammad, Published with financial support from the Netherlands Organization, Brill. Laiden, 1972.
182. Wherry E. M,& others, Lucknow, 1911, the Christian literature, London, 1911.
183. Wherry E. M, Islam and Christianity in India and the Far East, London and Edinburgh, 1907.
184. Weil, Gustav, Mohammed der Prophet: sein Leben und seine Lehre, Stuttgart 1843.
185. William Pinnock, A comprehensive system of modern geography, NewYork, 1935.
186. Wilson, John Laird, John Wycliffe Patriot and Reformer, New York, London, 1884.
187. Zeitlin, Irving M, The Historical Muhammad, polity prees, UK, 2007.
188. ميور، وليم، دعوت اسلام، اله آباد، 1903.
1. بخش، خادم حسين، أثر الفكر الغربي في انحراف المجتمع المسلم في شبه القارة الهندية، أطروحة دكتوراه مقدمة إلى مجلس كلية قسم الشريعة والدراسات الإسلاميّة، جامعة أم القرى، مكّة المكرمة، 1405هـ.
2. الثبيتي، أمل عبيد عواض، السيرة النبويّة في كتابات المستشرقين البريطانيين توماس كارليل توماس أرنولد ألفريد جيوم، رسالة ماجستير غير منشورة، مقدمة إلى مجلس كلية الشريعة والدراسات الإسلامية، جامعة أم القرى، مكّة المكرمة، 1424هـ.
3. جاسم، حنان عيسى، الحج عند العرب قبل الإسلام رسالة ماجستير غير منشورة، كلية التربية جامعة تكريت، 2005م
4. جثير، علي غانم، بيئة الرّسول في القرآن الكريم دراسة تحليلية مقارنة، أطروحة دكتوراه غير منشورة مقدمة إلى مجلس كلية التربية جامعة البصرة، 2006م.
5. الحديثي، أنمار نزار، الديانة الوضعية عند العرب قبل الإسلام، أطروحة دكتوراه غير منشورة مقدمة إلى مجلس كلية الآداب جامعة بغداد، 2003م.
6. حسين، خطاب إسماعيل أحمد، الحج عند عرب ما قبل الإسلام وفي عصر الرسالة، رسالة ماجستير غير منشورة مقدمة إلى مجلس كلية الآداب، جامعة الموصل، 2002م.
7. الشرباتي، نَافزة ناصر، اليهود وَأثرهم في الأدَب العَربِي في الأَندَلس، رسالة ماجستير غير منشورة مقدمة إلى كلية الدراسات العليا، جامعة الخليل، 2007م.
8. عصفور، علي محمّد طارق، الإفتراءات الواردة على الرّسول والقرآن، رسالة ماجستير غير منشورة مقدمة إلى مجلس كلية الدراسات العليا، الجامعة الأردنية، 2008م.
1. Buaben, Jabal Muhammad, The life of Muhammad [s.a.w] in British scholarship, a thesis submitted to the faculty of arts University of Birmingham for the degree of doctor of philosophy department of theology faculty of arts, England, 1995.
2. Guenther, Alan M. The Hadith in Christian-Muslim discourse in British India, 1857- 1888. A thesis submitted to the Faculty of Graduate Studies and Research in partial fulfillment, of the requirements of the degree of Master of Arts Institute of Islamic Studies, McGill University, Montreal, 1997.
3. Malik, Salah-ud din, Mutiny, revolution or Muslim rebellion British public reactions towards the Indian crisis of 1857, a thesis submitted to the faculty of graduate studies and research in partial fulfillment of the requirements for the degree of doctor of philosophy, department of history Mcgill University Montreal, 1966.
4. Skaff. A, Joseph, Christian missionary attitudes towards Islam in India, a thesis submitted to the faculty of graduate studies and research in partial fulfillment of the requirement for the degree of master of arts. institute of Islamic studies McGill University, Montreal, 1971.
5. Wahidur-Rahman, The religious thought of Moulvi Chlràgh Ali, Institute of Islamic Studies, Mcgill University, Montreal, 1982.
1. بهاء الدِّين، محمد حسين، المصادر الخيالية في دراسات المستشرقين للقرآن الكريم، مجلة الشريعة والدراسات الإسلاميّة العدد السادس، الرياض، 2005م.
2. الحسيني، خالد موسى عبد وزيدان خلف هادي الموزاني، ذرية النبي إسماعيل بين النّصوص الدينيّة والتاريخيّة مجلّة كليّة التّربية، واسط، العدد 11، 2012م.
3. دراز، محمّد عبد الله، النقد الفني لمشروع ترتيب القرآن الكريم، مجلة الأزهر، المجلد 22، القاهرة، 1950م.
4. رياض مصطفى أحمد شاهين، النشاط الاقتصادي لليهود بالحجاز في الجاهليّة وفي عصر الرّسول صلىاللهعليهوآله، مجلّة الجامعة الإسلاميّة المجلد الثاني عشر، العدد الثاني، فلسطين، 2004م.
5. زقزوق، محمود حمدي، سيرة الرّسول في تصوّرات الغربيّين فصول مختارة من كتابات المستشرق الألماني جوستاف بفانمولر ترجمها وقدم لها جامعة الأزهر، مجلّة مركز البحوث السنة والسيرة، العدد الثاني، القاهرة، 1987م.
6. زوين، محمد، من مظاهر التّكرار في القرآن الكريم، مجلة مركز دراسات الكوفة، المجلد، العدد 1، 3، 2004م.
7.الضاهر، سليمان أحمد، لاهوت يوحنا الدمشقي، دراسة تحليلية في كتاب (المئة مقالة في الإيمان الأرثوذكسي)، مجلة جامعة دمشق للآداب والعلوم الإنسانية، عدد خاص، دمشق 2009م.
8. علوان، نعمان شعبان، مقدمة في الإعجاز القرآني، مجلة الجامعة الإسلاميّة المجلد 18، العدد الأول، غزة، 2010م.
9. الغامدي، علي عودة، رؤية تاريخية لصفات مكّة عند أهل الكتاب مجلّة جامعة أم القرى للبحوث العلميّة المحكمة، العدد 14، السنة العاشرة مكّة المكرمة، 1996م.
10. فهد، محمد حسين، النبي إبراهيم في العراق بين التوراة والقرآن والآثار، مجلة القادسية في الآداب والعلوم التربوية العددان (1-2) المجلد 7، 2008م.
11. ملكاوي، محمّد أحمد، بشارة سفر المزامير بمكة المكرمة وأثر الرمزية في اختلاف ترجماتها، مجلة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة الإسلامية، العدد 51، محرم، 1432هـ.
12. نصار، عمار عبودي محمّد حسين، أثر التنبؤات اليهوديّة والمسيحيّة في المعتقدات الغيبيّة العربيّة قبل الإسلام، مجلة مركز دراسات الكوفة المجلد 1، العدد 3، جامعة الكوفة، 2004م.
2. Bennett, Clinton, The legacy of Karl Gottlieb Pfander, International Bulletin of Missionary Research, Vol 20 No 2, Newjersy, 1996.
3. Brandreth, Edward Lyall, Journal of the Royal Asiatic Society of Great Britain and Ireland, Cambridge University, Cambridge (Apr. 1908).
4. De Tassy, Garçin, Hindustani language and literature, translate S. Kamal Abdali The Annual of Urdu Studies, University of Wisconsin, Madison, USA, Vol. 26, 2011.
5. Jenkinson, E. J, The Moslem anti-Christ legend, The Muslim World, Vol. 20, Issue 1, (Jan. 1930), Hartford.
6. Journal of the Royal Asiatic Society of Great Britain and Ireland, Notes of the Quarter, Cambridge University, No. 4 Cambridge (Oct. 1922).
7. Journal of the Royal Asiatic Society of Great Britain and Ireland, Notes of the Quarter Cambridge University Press, Cambridge, (April, May, June, 1903)
8. Journal of the Royal Asiatic Society of Great Britain and Ireland,Cambridge University, Cambridge (Jul. 1912) (Oct. 1919).
9. Lyall, C. J. Sir William Muir, Journal of the Royal Asiatic Society of Great Britain and Ireland, Cambridge University Press, Cambridge (Oct, 1905).
10. Muir, Ancient Arabic Poetry; Its Genuineness and Authenticity Journal of the Royal Asiatic Society of Great Britain and Ireland, New Series, Vol.11, No. 1, London (Jan., 1879).
11. Muir, The Apology of Al Kindy. An Essay on Its Age and AuthorshipJournal of the Royal Asiatic Society of Great Britain and Ireland, Cambridge University New Series, Vol. 12, No. 2, London (Apr., 1882).
12. Muir, The Apology of Al Kindy, The Calcutta Review Vol. VIII., Calcutta (July-Dec, 1847).
13. Muir, Sura V,v.91.(The Coran), The Hebrew Student, Vol.1, No.2,USA (May, 1882).
14. Powell, Maulānā Raḥmat Allāh Kairānawī and Muslim-Christian Controversy in India
(484)in the Mid-19th Century, The Journal of the Royal Asiatic Society of Great Britain and Ireland, Cambridge University Press No. 1, Cambridge (1976).
15. Rawlinson H. C., Journal of the Royal Asiatic Society of Great Britain and Ireland, New Series, Vol. XVI, No. 4, Cambridge (Oct, 1884).
16. Shabbir Sajida, Struggle for Muslim Women’s Rights in the British India (1857–1947) Pakistan Vision Vol. 12 No.2.
17. The British medical journal, vol 2, issue 2324, Scotland, (July, 1905).
18. The British medical journal, Special Correspondence, Vol2, Issue 2186, Scotland (22 Nov 1902).
19.The Calcutta review, vol xxII, January-June, Calcutta, 1854.
20. The Calcutta review, vol xxIII, July-December, Calcutta, 1854.
21. The London Gazette: No. 22523. (25 June, 1861).
22. Walter, Emil Kaegi, Initial Byzantine Reactions to the Arab Conquest Cambridge University Press, Vol. 38, No. 2, Cambridge (Jun, 1969).
23. Zwemer Samuel M.Karl Gottlieb Pfander, 1841- 1941, the Muslim world, Vol 31, Issue 3, Hartford, (July, 1941).
http://www.bible.ca/archeology/bible-archeology-maps.htm
http://www.columbia.edu/itc/mealac/pritchett/00generallinks/mallet/arabia/ancientarabia1700.
http://www.ebnmaryam.com/vb/t3389.html.
http://www.eld3wah.net.
http://en.wikipedia.org/wiki/ Hebrew Union College,USA 2004.
http://en.wikipedia.org/wiki/Yom_Kippur.
http://www.hipkiss.org.
http://images.is.ed.ac.uk/luna/servlet/detail/UoEgal.
http://www.jewishencyclopedia.com/articles/14059.
http://www.yabeyrouth.com/pages/index1019c.htm.
(485)This study shed the light to one of poles of British Orientalism in the nineteenth century and early twentieth century, Sir William Muir, whom claimed the wide acclaim for his writings in the field of Islam, which represents the link between the fanatical medieval perception and the outlook objectivity that began to emerge in the nineteenth century by the German Orientalists such as Weil.
The first chapter to state the development oriental British prospective of Islam and prophethood throughout twelve centuries (7th to 19th )This study is to discuss the theory of revelation and prophethood in the British heritage perspective on the history of Mohammed with a statement of the main ideological variables related to the concept of revelation and prophethood in Islam, which occurred in the nineteenth century and its impact on the theory of William Muir with general framework ,We submitted the biography of William Muir and the most prominent political, social and academic positions which he took over, as well as his role in Christian missionary activities in India & the relationship between his writings and the Anglican missionary activities, which we figure out through the study it was the direct Stimulus in crystallizing his perspective on the history of Mohammedn, Amounts to be considered as evangelist rather than been a Political writer or Orientalist, And we shed the light to the Muir’s approach and the method to treat the details of prospective of revelation and prophethood by showing the positive and negative aspects in his writings.
The second chapter of this thesis to stateMuir’s theory about the origin of Mecca and its relationship with the Prophet Abraham and link this heritage with the prophethood of Muhammad, in particular, and that William Muir has launched his judgments on this issue on the biblical foundations, means that the prophethood standing over the sons of Isaac not to Ismail, who did not recognized as a prophet, Also we discussthe doubts of muir about strain ofMohammed to Ismail.
The third chapter to explain the linguistic meaning of the concept of revelation in perspective of Muir, and discuss his impression about the hypothesis of pathological and psychological revelation, and allegation of satanic inspiration, which represented a fanatic classical an old theory re-formulated,by muir based on the Islamic neglected texts included in the Islamic sources which which employed
(486)to prove. especially the book of Ibn Saad Tabqqat, prefered to the rest of the Biographies.
We have adopted to prove the sincerity of the prophethood of Muhammad in the application of the terms sincere prophecies in the Bible, We have discussed the perspective of William Muir about the Koran and its properties and arrangement.
The fourth chapter of the study to discuss allegations of human resources of the revelation (Judaism, Christianity, the era of ignorance) and to state the extent discrepancy between the Koran and the Bible.
Concluded with prominent results that emerged from the study, for Sir William Muir proceeded employ philological criticism to distort facts instead utilize them to discover the true meanings.
He also deep in the application of the Cartesian approach on the theme of revelation, because the subject of revelation and prophethood can not be prosecuted strictly by a mental perspective, He has established for the emergence of independent studies to study the Koran,Hadith, Islamic Manuscripts, Biography, Annals of succession, and could consider Muir’s books beginning of the era of English academic Orientalism, especially since most of the subsequent studies did not come any more than he brought, his writings mainly Source for all workers in the field of islam.
One of results found in this study, that Muir’s speech has gone through different phases in terms of extremism and moderation, especially in his later writings in which phrases used polite had less impact to the feelings of Muslims, contrary to what was followed in the early writings which was marked by hostility and racism, note The dominance of ideological view In assessing the merits of the historical events of the early phase of Islam
Taking into account that William Muir hinted his admiration for the creative mentality of Muhammad and his ability to events such a huge influence in the Arabian Peninsula, but even without faith, such as the assumption that the source of this is the Divine ability.
We also found through this study that Muir was one of the first Orientalists who dealt with Islam, according to the sectarian differences; We believe after reading this biography orientalist William Muir, that his writings in the field of Orientalism Islamic were not productive for one person but was pursuant to an integrated team ,Perhaps his represented a reflection of the British political and ideological attitude of Islam in the nineteenth century.
(487)