

■ الفصل الأول : تعريف الديمقراطيّة وأنواعها | 11
ب ـ الديمقراطيّة الليبرالية | 22
ولادة الليبرالية وأركانها | 34
أنواع الديمقراطية الليبرالية | 39
■ الفصل الثاني: الديمقراطيّة الإسلامية | 47
● المبحث الأول: المخالفة المطلقة للديمقراطيّة | 52
السيد محمّد حسين الطباطبائيّ | 57
● المبحث الثاني: الموافقة المطلقة للديمقراطيّة | 72
الشيخ مهدي الحائري اليزدي | 72
الدكتور محمد عابد الجابري | 84
● المبحث الثالث: الموافقة المشروطة للديمقراطيّة | 100
السيد الخميني (قدّس سره) | 102
الشيخ محمّد تقي مصباح اليزدي | 116
مقدمة المركز7
مقدمة المؤلف9
الفصل الأول : تعريف الديمقراطيّة وأنواعها11
تعريف الديمقراطيّة12
تطورّات الديمقراطية15
أـ ديمقراطية أثينا16
ب ـ الديمقراطيّة الليبرالية22
عوامل النهضة الليبرالية24
ولادة الليبرالية وأركانها34
أنواع الديمقراطية الليبرالية39
الديمقراطيّة الدفاعيّة39
الديمقراطيّة التكامليّة40
الديمقراطيّة الاشتراكيّة42
الفصل الثاني: الديمقراطيّة الإسلامية47
المبحث الأول: المخالفة المطلقة للديمقراطيّة52
سيد قطب52
السيد محمّد حسين الطباطبائيّ57
السيد محمّد باقر الصدر62
المبحث الثاني: الموافقة المطلقة للديمقراطيّة72
الشيخ مهدي الحائري اليزدي72
الدكتور عبد الكريم سروش80
الدكتور محمد عابد الجابري84
الدكتور حسن حنفي90
المبحث الثالث: الموافقة المشروطة للديمقراطيّة100
السيد الخميني (قدّس سره)102
أبو الأعلى المودودي111
الشيخ محمّد تقي مصباح اليزدي116
الشيخ مرتضى المطهّري124
مالك بن نبي128
الفصل الثالث: خلاصة الآراء والرأي المختار135
سيادة اللّه تعالى137
سيادة الناس140
فهرس المصادر157
تدخل هذه السلسلة التي يصدرها المركز الإسلاميّ للدراسات الإستراتيجيّة في سياق منظومة معرفيّة يعكف المركز على تظهيرها، وتهدف إلى درس مفاهيم شكلت ولما تزل تشكّل مرتكزات أساسيّة في فضاء التفكير المعاصر وتأصيلها ونقدها.
وسعياً إلى هذا الهدف وضعت الهيئة المشرفة خارطة برامجيّة شاملة للعناية بالمصطلحات والمفاهيم الأكثر حضوراً وتداولاً وتأثيراً في العلوم الإنسانيّة، ولا سيّما في حقول الفلسفة، وعلم الاجتماع، والفكر السياسيّ، وفلسفة الدين والاقتصاد وتاريخ الحضارات.
أمّا الغاية من هذا المشروع المعرفيّ فيمكن إجمالها على النحو التالي:
أولاً: الوعي بالمفاهيم وأهميّتها المركزيّة في تشكيل المعارف والعلوم الإنسانية وتنميتها وإدراك مبانيها وغاياتها، وبالتالي التعامل معها كضرورة للتواصل مع عالم الأفكار، والتعرّف إلى النظريّات والمناهج التي تتشكّل منها الأنظمة الفكريّة المختلفة.
ثانياً: إزالة الغموض عن الكثير من المصطلحات والمفاهيم التي غالباً ما تستعمل في غير موضعها أو يجري تفسيرها على خلاف المراد منها. لا سيّما وأن كثيراً من الإشكاليات المعرفيّة ناتجة من اضطراب الفهم في تحديد المفاهيم والوقوف على مقاصدها الحقيقيّة.
ثالثاً: بيان حقيقة ما يؤدّيه توظيف المفاهيم في ميادين الاحتدام
(7)الحضاريّ بين الشرق والغرب، وما يترتّب على هذا التوظيف من آثار سلبيّة بفعل العولمة الثقافيّة والقيميّة التي تتعرّض لها المجتمعات العربيّة والإسلاميّة وخصوصاً في الحقبة المعاصرة.
رابعاً: رفد المعاهد الجامعيّة ومراكز الأبحاث والمنتديات الفكريّة بعمل موسوعيّ جديد يحيط بنشأة المفهوم ومعناه ودلالاته الاصطلاحيّة، ومجال استخداماته العلميّة، فضلاً عن صِلاته وارتباطه بالعلوم والمعارف الأخرى. وانطلاقاً من البعد العلميّ والمنهجيّ والتحكيميّ لهذا المشروع فقد حرص لامركز على أن يشارك في إنجازه نخبة من كبار الأكاديميّين والباحثين والمفكّرين من العالمين العربيّ والإسلاميّ.
* * *
تسعى هذه الحلقة في "سلسلة مصطلحات معاصرة" إلى تأصيل مصطلح الديمقراطيّة، بدءًا من جذوره الإغريقيّة وصولاً إلى عصور ما بعد الحداثة في الغرب.
وقد أسّس الباحث السيد هاشم الميلاني عمله هذا على إبراز الكلاسيكيّات القديمة الحديثة التي اعتنت بمفهوم الديمقراطيّة، وأضاءت على تطوُّراته التاريخيّة وخصوصيّاته تبعاً لشروط الحضارات الإنسانيّة المتعددة.
والله وليّ التوفيق
(8)يمتدّ البحث عن الديمقراطية إلى العصور القديمة، وإلى مدينة أثينا في اليونان قبل الميلاد، حيث ولدت هناك أول حكومة شعبيّة أعقبتها تطوّرات ومراحل كثيرة حتى بلغت هذه المرحلة التي نشهدها حيث أصبحت الديمقراطية أمل الشعوب ولعبة الملوك.
لقد تحدّث عنها المفكّرون في كتبهم وأبحاثهم العلميّة، ونظّروا لمضامينها ومقاصدها باعتباره السبيل إلى أي إعطاء دور للشعب في تقرير مصيره السياسي ـ وفي عصر النهضة الأوروبيّة، وتسمّت بمسمّيات مختلفة، فتارة باسم المشروطة كما في إيران 1905، وأخرى باسم الجمهوريّة في فرنسا بعد ثورة، وثالثة باسم الديمقراطيّة وهو درجت عليه أدبيات الحداثة منذ القرن الرابع عشر إلى يومنا هذا.
فالاسم وإن اختلف لكنّ المحتوى كان يعنى تفعيل دور الشعب في انتخاب الحاكم ورقابته واستبدال الطرائق السلميّة به.
في عصر النهضة الأوروبيّة، كان لكتاب «العقد الاجتماعيّ» تأليف جان جاك روسو، التأثير الكبير في توعية الناس، وكذلك ما ذكره سائر المفكّرين أمثال: جان لوك (ت 1704 م) وجيمز مل (ت 1733 م)، وجرمي بنتام (ت 1748 م) وجان استوارت مل (ت 1806م) وغيرهم من المفكّرين المنادين بحريّة الإنسان في اتّخاذ القرار السياسيّ وسيادته على نفسه ومجتمعه.
أمّا في العالم الإسلاميّ فقد ظهرت هذه الأفكار، بعد ما غُزيت البلدان الإسلاميّة من قبل الأوروبيّين ثقافيّاً وعسكريّاً، وشهدت الساحة الفكريّة صراعات عنيفة في هذ المجال، فكان الأمر يدور
(9)بين ما كتبه أمثال علي عبد الرازق في كتابه «الإسلام وأصول الحكم» وكتابات عدد من المفكّرين والعلماء أمثال السيد جمال الدين الأفغاني ومحمد عبده ورشيد رضا والكواكبي والمودودي، دفاعاً عن الأصالة الإسلاميّة في انتخاب الحاكم، وتفعيلاً لدور الشعب من خلال النصوص والتراث الإسلاميّ من قبيل قاعدة الشورى.
ولو راجعنا مجلّة المنار التي كان يصدرها رشيد رضا لرأينا في طيّاتها التنظير المكثّف في هذا المجال، وكذلك ما كتبه المودودي (ت 1979 م) في: «الحكومة الإسلاميّة» و«نظريّة الإسلام السياسيّة» و«الخلافة والملك» و«المسلمون والصراع السياسيّ الراهن» و«الإسلام والمدنية الحديثة».
هذا عند أهل السنة، أمّا في المجال الشيعيّ فكانت فترة النهضة الدستوريّة (المشروطة) هي أوج النشاط السياسيّ نحو الحرية وتفعيل دور الشعب، وقد تصدّى لذلك علماء ومراجع من جملتهم الآخوند الخراساني والميرزا النائيني، وكان لكتاب «تنبيه الأمّة» تأليف الميرزا النائيني دور مهمّ على مستوى التنظير ومناقشة إشكالات المخالفين، ثمّ كانت بعدها الثورة الإسلاميّة في إيران، وما سبقها من تنظير وتوجيه سياسيّ لمشاركة الناس في اتّخاذ القرار السياسيّ، كما رأيناه وسمعناه من مؤسّس الثورة.
ولا يخفى أنّ جدليّة: الله ـ الشعب ـ الحكومة، أثارت تساؤلات ومناقشات كثيرة، وقد استخدمت الأقلام لذلك، فبين من يفصل بين هذه المفردات، وبين من يحاول الجمع بينها مهما أمكن، فظهرت عشرات الكتب بل مئات الكتب والأبحاث في هذا المجال لا يسع المقام ذكرها.
هاشم الميلاني
(10)
إن الديمقراطيّة من أقدم الأنظمة الاجتماعيّة والسياسيّة التي شهدتها البشريّة، والظاهر أنّ أول من وضع هذا الاصطلاح واستعمله على أرض الواقع هم اليونانيّون في مدينة أثينا، ومن بعدهم استمرّ شيئاً فشيئاً تارة بالشدّة وتارة بالضعف إلى أن وصل إلينا وأصبح نظاماً عالميّاً، وذلك بعد ما جرّبت البشرية أنواع النظم السياسيّة.
أما بالنسبة إلى مصطلح الديمقراطيّة فيرى ديفيد هلد أنّها وإن دخلت الإنجليزيّة في القرن السادس عشر عبر كلمة ديمقراطيّ الفرنسيّة، غير أنّ جذورها إغريقيّة، إنها متحدّرة من ديمقراطيا (demokratia) المركّبة من كلمتي ديموس (demos) وكراتوس (kratos) اللتين تعنيان الشعب والحكم على التوالي أي حكم الشعب. فالديمقراطيّة تعني صيغة للحكم تكون فيها السلطة للشعب بدلاً من الملوك والطبقات الارستقراطيّة. شهد هذا المصطلح كسائر المفاهيم والمصطلحات تحوّلات كثيرة، وتزامناً مع هذه التحوّلات صيغت أنواع جديدة من الديمقراطيّة.
يقول أرسطو في هذا الصدد:
«إن وجود أنواع من الديمقراطيّة له علّتان: إحداهما اختلاف سيرة
(12)الناس في حياتهم الاجتماعيّة؛ لأنّ بعض الأقوام يعيش على الزراعة، وبعضها الآخر يتكوّن من عمّال وأرباب عمل، والديمقراطيّات المتولّدة من كلّ قوم من هذه الأقوام ستختلف بالطبع عن الاُخرى، ولو اجتمعت المجموعة الاُولى إلى الثانية وشكّلوا فيما بينهم مجتمعاً ثالثاً، فإنّ الاختلاف بين هذا المجتمع الثالث الجديد لن يكون على شكل اختلاف حكومة ديمقراطيّة أفضل أو أتعس، بل ستكون حكومة ديمقراطيّة من نوع جديد.
وأمّا العلّة الثانية فتتمثّل في أنّ التركيبات المختلفة للمنظمات المختصّة بالديمقراطيّة هي السبب في ولادة أنواع من الديمقراطيّة، لأنّه ربّما يحوز نوعاً من أنواع الديمقراطيّة هذه الخصائص بمقياس أقلّ والآخر بمقياس أكبر، والثالث جامع لجميع تلك الخصوصيّات، وقراءة كلّ واحدة من هذه الخصوصيّات يساعدنا على إيجاد أنواع جديدة من الديمقراطيّة، وكذلك يساعدنا في إصلاح الأنواع الموجودة فعلاً».
وكذلك «آنتوني آربلاستر» يؤيّد هذا ويقول: «إنّ الديمقراطيّة قبل أن تكون حقيقة واقعيّة هي مفهوم من المفاهيم، وبما أنّها مفهوم فليست لها معنى دقيق ومتّفق عليه، فالديمقراطيّة لها معانٍ مختلفة كثيرة، ومفاهيم ضمنيّة متعدّدة في طول تاريخها، وفي هذا العصر هناك أشكال مختلفة للديمقراطيّة ضمن الأنظمة الاجتماعيّة والاقتصاديّة المختلفة».
فمن الصعب إذاً تحديد المعنى الاصطلاحيّ بدقّة، نعم بإمكاننا أن نتكلّم عن الديمقراطيّات الموجودة على أرض الواقع، وتقويمها وتبيين أسسها وأركانها، وهذا العمل سيعيننا في الخروج بقاسم مشترك بين هذه الأنواع المختلفة، وجعله المحور الأساسيّ في تحديد المصطلح.
وأعتقد أنّ هذا المحور المشترك يتكوّن من ركنين أساسيّين:
1 ـ سيادة الناس في نصب الحاكم وعزله.
2 ـ سيادة الناس في التقنين والتشريع.
وأمّا الأمور الأخرى من قبيل: الأحزاب، الانتخابات، فصل سلطات البرلمان، الحريّات المتنوّعة و.. . فهي كلّها فروع وامتدادات للديمقراطيّة، قابلة للزيادة والنقصان حسب الظروف التي تتولّد فيها وتنمو في ضوئها.
وهناك سؤال هامّ يُطرح بجدّ، ويحدّد مسير بحثنا في إمكانيّة الجمع بين الدين والديمقراطيّة أو عدمه، وهو أنّ الديمقراطيّة هل هي نظام ذو أيديولوجيّة وفلسفة معيّنة ماديّة بحيث تتقاطع مع النظرة الإلهيّة للمجتمع ؟ أم هي مجرّد آليّة للعمل السياسيّ لا تحمل في طيّاتها أيّ محتوى فلسفيّ أو أيديولوجيّ يتقاطع مع النظرة الإلهيّة، شأنها شأن سائر الآليّات التي يستخدمها الإنسان لنيل مآربه المختلفة تحمل في طيّاتها الركنين الأساسيّين اللذين ذكرناهما آنفاً.
فإن فسّرنا الديمقراطيّة بما يتوافق مع المنهج الأوّل، فهنا لا نتمكّن من التوفيق بين الدين والديمقراطيّة إلّا بالتنازل عن أحدهما وتحريفه، أمّا لو فسّرناها بالمعنى الثاني، فيمكننا حينئذٍ الكلام عن إمكانيّة الجمع بينهما.
(14)والذي أذهب إليه في هذا البحث، وسأتكلّم عنه بتفصيل أكثر، هو هذا التفسير الثاني أي أخذ الديمقراطيّة كآلية بحتة للعمل السياسيّ، وهي بهذا المعنى لا تحدّد محتوى المجتمع ولا تعطيه نظرة أيديولوجيّة مخالفة للنظرة الإلهيّة، بل تكشف لنا ماعليه المجتمع من تديّن أو تحلّل، فهي كعلم المنطق في كونه آلة تعصم مراعاتها الذهن من الوقوع في الخطأ، فالمنطق يصحّح لنا شكل القياس لا مادّته، وكذلك الديمقراطيّة.
فهي إذاً: «آلة قانونيّة أو سياسيّة تعصم مراعاتها المجتمع من الوقوع في متاهات الاستبداد والدكتاتوريّة». وعلى هذا فهي تأخذ على عاتقها تصحيح شكل المجتمع لا محتواه، فالمحتوى قد يكون دينيّاً وقد يكون إلحاديّاً، ولا دخل لها لمصلحة أحدهما أو ضرره، وهذا المعنى هو المدار في تقويم وتصنيف ومناقشة الآراء الواردة هنا، وهو المعوّل عليه.
لا يقال: على هذا التفسير لا معنى لقولكم «الديمقراطيّة الدينيّة أو الإسلاميّة» لأنّ الوصف سيكون زائداً، لأننّا نقول إنّ الغرض من هذا المصطلح وصف المحتوى، فهو لمّا كان دينيّاً أمكن وصف الشكل بالدينيّ أيضاً تبعاً له، فالديمقراطيّة الدينيّة تعني أن يكون الشكل ديمقراطيّاً والمحتوى دينيّاً لا إلحاديّاً.
وأمّا بالنسبة إلى نشأة الديمقراطيّة وأقسامها، والتطوّرات التي لحقتها والثقافات التي امتزجت معها، فيمكن القول إنّها تنقسم إلى:
(15)أ : ديمقراطيّة أثينا.
ب : الديمقراطيّة الليبراليّة.
ج : الديمقراطيّة الاشتراكيّة.
د: الديمقراطيّة الإسلاميّة.
ونقول في شرحها وتفصيلها:
نبتدئ بحثنا هذا بكلام للمعلّم الأوّل أرسطو حيث يقول: «إنّ على المحقّق أو الباحث الذي يريد أن يتعرّف إلى أفضل شكل من أشكال الحكومة، يجب عليه أولاً أن يعيّن أفضل أسلوب ومنهج في حياة الناس، لأنّه ما دامت هذه الفقرة غامضة فإنّ طبيعة الحكومة الكاملة والمطلوبة أيضاً سوف تكون مبهمة وغير واضحة، فالمفروض أنّ افضل أسلوب لحياة الناس إنّما يتحصّل في ظلّ أفضل حكومة ممكنة، ومن هذا يجب أن نبحث في البداية ما هو أفضل أسلوب في الحياة يمكن أن يختاره الناس من كلّ صَنف وطبقة. . . فيجب ابتداءً التسليم بهذه الحقيقة، وهي أنّ أفضل أسلوب في الحياة سواء على مستوى الأفراد والدول والحكومات هو التحرّك باتّجاه الفضيلة، والمشاركة في الأعمال الخيرة بالوسائل والأدوات الكافية».
فتحصّل إذاً أنّ الحياة الفاضلة مطلوبة لكلّ إنسان صالح، فلا بدّ من أن نعرف كيفيّة حكومة أثينا قبل هذا التحوّل، لنرى أنّ الشعب في ذلك العصر، وفي تلك المدينة لماذا ثار ضدّ حكومته واختار شكلاً آخر لها، وحسب زعمه أفضل ؟ !.
تنقسم منطقة «أثينا» إلى عدّة مناطق صغيرة منفصلة بعضها عن بعض وأحياناً يعادي بعضها بعضاً، وفي كلّ منطقة من هذه المناطق تعيش قبيلة وطائفة كبيرة من الناس، وتدار هذه المناطق على يد شيوخ هذه الطوائف، وبعد مدّة دخلت هذه المناطق في ظلّ حكومة واحدة، فكانت أثينا مركزاً لها، وتدار بواسطة ملك يعتبر رئيساً للجيش أيضاً، ويترأّس كذلك المناسك الدينيّة، ويستعين في إدارة هذه الدولة بمجلس مشكّل من رؤساء وشيوخ الطوائف الكبيرة.
واستمرّ الحال بهذه الحكومة عدّة سنوات، ولكن كانت النزاعات والمخاصمات قائمة على قدم وساق بين السلاطين والملوك وبين رؤساء الطوائف، وبالتدرّج اشتدّت حدّة النزاع إلى أن جرى سلب القدرة والسلطة من يد الملك، ومنذ عام «750» قبل الميلاد جرى القضاء على النظام الملكيّ في أثينا.
ومن ذلك الحين أصبحت إدارة أُمور الشعب في يد تسعة أشخاص من الأمراء، ودامت حكومتهم سنة واحدة، وهؤلاء الأمراء جرى انتخابهم من بين النبلاء من أعضاء الأسر القديمة.
هذه الحكومة عملت على تشديد الضغط على الشعب الذي يتكوّن أفراده من العمّال والفلّاحين، بحيث أصبح أفراد الشعب غالباً مُعطّلين من أعمالهم اليوميّة، واضطرّوا إلى الاقتراض من
(17)الملّاكين المتموّلين يعني أشراف البلد، وبما أنّهم لم يتمكّنوا من أداء ديونهم، فانّهم وفقاً لقوانين وتقاليد ذلك العصر أصبحوا عبيداً للأغنياء وأحياناً يجري بيعهم في السوق، وهذا الحال أدّى في النتيجة إلى زيادة نقمة الناس.
أضف إلى ذلك، تطوّر الصناعة والتجارة وتكاملها بسبب الانفتاح النسبيّ الذي حصل آنذاك، ممّا أدّى إلى ظهور مشاحنات ومشاجرات جديدة بين التجار وبين الأشراف والحكام، ولذلك كانت تقع انتفاضات بين الحين والآخر، إلى أن حدثت إصلاحات «سولون» في عام «594» قبل الميلاد، فتحسّن الوضع المعيشيّ للناس قليلا.
وكان «سولون» الذي يعتبر أعلم الناس في تلك الديار، قد قام بإصلاحات واسعة أهمّها ما كان متعلّقاً بالقروض، وشكّل الحكومة والقضاء، فقد وجد سولون نفسه مضطرّاً إلى تخفيف الضغط عن أكتاف الناس عامّة، ولذلك لم يهتمّ لغضب الأشراف، وأصدر أمراً بإبطال جميع الديون السابقة، وقام كذلك بتحرير المدنيّين الذين أصبحوا عبيداً للأغنياء مقابل ديونهم.
وقد قسّم سولون المواطنين على أساس الثروة أو مالكيتهم للأموال إلى أربع طبقات، بحيث إنّ المناصب السياسيّة التي كانت حكراً على الطبقة العليا سابقاً، قد استطاع أفراد الطبقات الدنيا أن يشغلوا هذه المناصب، ويكونوا في المجلس أو «ايكلسيا» ويشكّلوا لهم هيئة أخذت على عاتقها إصدار الأحكام تجاه الأفراد، وكذلك تجاه أحكام المحكمة، ولم تكن هذه الصلاحيّات واسعة ومفضية إلى زيادة القدرة، ولكنّ التغييرات اللاحقة أدّت الى زيادة هذه القدرة للأشخاص.
(18)وأمّا المصلح الآخر لمدينة أثينا فهو «كليستن» الذي تزعّم البلاد عام «507» قبل الميلاد، وعمل على إيجاد إصلاحات عميقة في جميع مفاصل الحكومة والمجتمع، وفي الواقع كان كليستن قد اسّس أول حكومة عامة وسلّم الشعب زمام الأمور.
والمقصود بالحكومة العامّة هو أنّ الأفراد من أصحاب الحقوق لا يمدّون يد الطاعة لشخص واحد، ولا يقبلون أوامر فئة معيّنة من الناس، بل إنّهم يطيعون القوانين التي وضعوها بأنفسهم، مضافاً إلى أنّ عامّة الناس يشتركون بالسوية في الحكومة.
إنّ أصحاب الحقّ هؤلاء، يعقدون اجتماعات في كلّ ثلاثة أشهر أو أربعة أشهر مرّة واحدة، والهدف من تشكيل هذه الاجتماعات عادة هو وضع القوانين، فكان شخص يقوم بقراءة لائحة معيّنة، ثمّ بعد ذلك يدخل أصحاب الحقوق في مناقشات ومحادثات، وهذه الاجتماعات إضافة إلى وضعها للقوانين، تتكفّل بأمور السياسة الخارجيّة، الحرب والصلح، انتخاب أولياء الأمور، وأخيراً إصلاح الدولة.
وبما أنّ الشعب لم يتوفر له الاجتماع كلّ يوم، ولم تكن الفرصة كافية أيضاً لمطالعة جميع اللوائح والقوانين بدقّة كافية، وكذلك لم يكونوا قادرين على حلّ جميع المسائل فيما بينهم خلال الفواصل التي تفصل بين الاجتماعات، لذلك شكّلوا شورى مركّبة من ذوي الحقوق، وعلى هذا الأساس يُنتخَب خمسمائة شخص بالقرعة، ويقسّمون إلى عشر شعب، وكلّ شعبة تأخذ على عاتقها إدارة الأمور في عُشر السنة، وحين تنتهي السنة تُجدّد الانتخابات مرّة أخرى.
وكان أفراد الشعب يدقّقون جيّداً في أعمال وتصرّفات أولياء
(19)الأمور، وكان لهم حقّ عزل هؤلاء الأشخاص، وكلّ فرد من أفراد الشعب يستطيع أن يقيم الشكوى ضدّهم، وعندما ينتهي دور أولياء الأمور تجري محاسبتهم.
ولم يتسلّم أفراد الشعب زمام الأمور فحسب، بل أخذوا على عاتقهم إحقاق الحقوق أيضاً، ففي كلّ سنة يُنتخَب ستة الآف شخص بالقرعة من أهل النظر وذوي الحقوق لتكفّل منصب القضاء، ثمّ يقسّمون إلى شُعب وأقسام فيكون خمسمائة شخص لكل شُعبة.
ولا يخفى أنّ المواطنين من أصحاب الحقوق في مدينة أثينا كانوا من الرجال البالغين المواطنين فقط، وكانت النساء والعبيد والأجانب محرومين، وعلى كلّ حال فإنّ الخصّيصة الرئيسية لهذه الديمقراطية، تتمثّل في مباشرة الشعب فرداً فرداً ومشاركتهم في تأسيس الدولة وتعيين الحاكم، وتتمثّل هذه المشاركة بشكلين:
فمن جهة كان هناك مجلس أو (ايكلسيا) حيث يستطيع كلّ فرد من أفراد الشعب أن يحضره، وكانت التصميمات والقرارات الأخيرة تؤخذ في هذا المجلس بالنسبة إلى سياسات الحكومة تجاه أهل المدينة، فالمجلس كان بمثابة الهيئة الحاكمة، ويتشكّل من جميع أفراد الشعب.
الشكل الثاني والمهمّ لمثل هذا النظام الشعبي، هي أنّ جميع المناصب الحكومية من التنفيذية، ومقام الإشراف على القوانين، هي بيد المواطنين.
وأفضل وصف بقي من حكومة أثينا هو ما نجده ضمن كلام
(20)لـ«بريكلس» الذي أورده باسم شهداء الحرب لتلك المدينة، حيث نقرأ بعضاً من مقتطفاته:
«إنّ حكومتنا لا تتمنّى حالة ووضع سائر الأقوام والشعوب، هذه الحكومة ستكون أسوة للآخرين ولا تكون مقلّدة لإحدى الحكومات، ويطلق على هذا الوضع «حكومة العامّة» لانّ هدفها إيصال الخير إلى الأكثريّة لا مصلحة فئة قليلة.
وبالنسبة للأمور الشخصيّة فإنّ الجميع سواء أمام القانون، والشخص الذي يكون له شأن ومقام هو من كان يتمتع بفنٍّ ممتاز، فإنّ ما يستوجب علوّ المقام هو اللياقة أكثر من المنزلة الاجتماعيّة. إنّ أفراد الشعب في هذه المدينة يراقبون في آنٍ واحد منافع الدولة، وكذلك يراقبون منافعهم. . . وكلّ شخص من ذوي الحقوق يترك المشاركة في أمر الجمهور فإنَّه لا يكون طالب راحة فقط بل إنّ وجوده سيكون عقيماً وغير مفيد، فنحن نستطيع أن نقرّر ما يناسب حال الدولة بأنفسنا، ونقرّر ذلك بالعقل السليم».
وهكذا استمرّت حكومة أثينا على هذا المنوال إلى أن دبّ فيها الضعف بسبب الفرقة والاختلاف من جهة، وهجوم الأعداء من الدول المنافسة من جهة ثانية، حتّى عام «322» قبل الميلاد حيث جرى إسقاط هذه الحكومة على يد الجيش المقدونيّ.
وطبعاً فإنّ الحدث الّذي وجّه ضربة قاصمة أكثر من أيّ شيء آخر إلى ديمقراطيّة أثينا، هو محاكمة وإعدام سقراط في سنة «399» قبل الميلاد باتّهام الكفر وبأنّه ادّعى ألوهيّة جديدة، ولم يكن يحترم آلهة البلد، وبذلك أخرج الشباب عن دينهم، وهذا أدّى إلى ردود
فعل قويّة عند المفكّرين وعند بعض الناس، حتّى يقال إنّه أحد الأسباب الرئيسيّة في خصومة أفلاطون الحكيم للديمقراطيّة.
هناك عوامل مختلفة أدّت إلى ولادة الديمقراطيّة من جديد، وذلك بعد ما مرّ التاريخ البشريّ بأزمات حقيقيّة، وبعدما شهد المجتمع تطوّرات مختلفة على ساحة الفكر والعقيدة، وسنشير الى بعضها في السطور الآتية.
إنّ اصطلاح الديمقراطيّة الليبراليّة هو من تلفيق اصطلاحين أحدهما جديد والآخر أقدم منه، وهما: الليبراليّة والديمقراطيّة.
الليبراليّة عبارة عن الاعتقاد بأنّ الإنسان جاء إلى الدنيا حرّاً، وهو صاحب حريّة واختيار وإرادة، ويجب أن يسمح له بأن يربّي نفسه بصورة حرّة بأيّ مقدار ممكن، ويكون آمناً من تدخّل الدولة.
أمّا الديمقراطيّة فهي تعني أنّ التصميمات والقرارات السياسيّة تتّخذ بصورة جماعيّة وبالانتخاب الحرّ للأفراد، والجمع بين هذين المصطلحين أفرز نظريّة: الديمقراطيّة الليبراليّة.
الديمقراطيّة الجديدة وليدة الليبراليّة، وأغلب المجتمعات الغربيّة قبل أن تكون ديمقراطيّة كانت ليبراليّة، برغم أنّ هاتين المفردتين لن تكونا ثابتتين في حركة التاريخ، بل شملتهما تغييرات مختلفة لا يسع المجال للحديث عنها مفصّلاً، ولكن على أيّ حال فهاتان النظريتان تجاوزتا مشكلات كثيرة وتغييرات مختلفة حتّى وصلتا إلينا بهذه الصورة الفعليّة.
(22)
ومن أجل أن نتعرّف إلى هذا المنهج من الديمقراطيّة بجميع ما حدث له من تغييرات لا بدّ لنا من إلقاء نظرة مختصرة إلى الليبراليّة لانّ: «وحدة فهم انبثاق التقليد الليبراليّ؛ وجملة الأسئلة التي طرحها حول طبيعة السيادة، سلطة الدولة، الحقوق الفرديّة، وآليات التمثيل؛ من شأنه أن يوفّر إمكانيّة الإمساك بأسس جملة النماذج الديمقراطيّة الليبراليّة التي بدأت تظهر على الساحة في القرنين الثامن عشر والتاسع عشر».
ويوضح «هارولد جي لاسكي» مجموعة التحوّلات التي أدّت إلى الليبراليّة، وأفضت إلى الانتقال من العالم القديم إلى العالم الجديد بهذه الصورة:
1 ـ في الحقوق: حيث أخذت القوانين مكانها بدل التقاليد الطبقيّة.
2 ـ في العقيدة: حيث جرى تبديل المذهب الواحد إلى عقائد مختلفة، بحيث إنّ الشكّاكين أيضاً حانت لهم الفرصة لإظهار رأيهم.
3 ـ في السياسة: فقد استبدلت بالحاكميّة الإلهيّة والحاكميّة الطبيعيّة الحاكميّة الوطنيّة.
4 ـ في الاقتصاد: حيث حلّت الأموال المنقولة مكان الأرض ومالكيتها التي كانت منشأ قدرة الاقطاع والملوك والأمراء المحلّيّين.
5 ـ في الهدف: حيث حلّ الاعتقاد بالتعالي والتقدم في هذه الدنيا على أساس العقل، محلّ الاعتقاد بالعصر الذهبيّ في الزمن السابق، والإثم الذاتيّ، أو الإحساس بالخطيئة.
6 ـ في العمل: حيث حلّ السلوك الفرديّ محلّ السلوكيات والنشاطات الاجتماعيّة.
ثم إنّه يستنتج من ذلك: إنّ الشرائط الماديّة الجديدة أدّت إلى ظهور روابط اجتماعيّة جديدة، وفي النتيجة ظهرت فلسفة أخذت على عاتقها مهمّة توجيه حقانيّة العالم الجديد، وهذه الفلسفة الجديدة هي الليبراليّة.
ولعلّه يمكننا أن نرسم سير التحوّلات التي أدّت إلى الليبراليّة في عدة عوامل أو تيارات، أفضت جميعها إلى الديمقراطيّة الليبراليّة في أوروبا، وهذه العوامل أو الحوادث عبارة عن:
1 ـ الاقتصاد.
2 ـ نهضة الاصلاح الديني.
3 ـ السياسة.
ونحن هنا نشير بشكل مختصر إلى كلّ واحدة من هذه العوامل.
كانت الروابط الاقتصاديّة الحاكمة على المجتمعات الغربيّة في القرون الوسطى هي روابط قائمة على الإقطاع، فالإقطاعيّة نشأت وقويت بعد انحلال الإمبراطوريّة الرومانيّة، وأدّت إلى تأثيرات عميقة في المؤسّسات الاجتماعيّة والسياسيّة في القرون الوسطى.
وطبعاً قد لا يمكننا تعريف الاقطاع في عبارة أو جملة واحدة، والسبب في ذلك هو التنوّع الكبير الذي شهدتها مؤسّسات الاقطاع في نقاط مختلفة من أوروبا، وكذلك الاختلاف والتنوّع في أسلوب وعمل الأنظمة الإقطاعيّة في الأزمنة المختلفة.
ولكن بشكل عامّ فإنّ جذور الإقطاع في الحقيقة يجب أن نبحثها في المراحل التي مرّت بها أوروبا من عدم النظم والفوضى، وانعدام إمكانيّة تشكيل القدرات السياسيّة والاقتصاديّة الكبيرة، ولهذا سعت الحكومات إلى الاقتصار على الحدّ الأدنى من القدرة، وفقاً للموازين الروميّة أو الموازين الجديدة في ذلك العصر.
وفي تلك الحقبة كانت الأرض والمياه هي التي تعتبر محور الثروة والحجر الأساس للتموّل، حيث كانت حياة الأفراد في كلّ طبقة من الناس من الملك الى الجنديّ وسائر الطبقات، مرتبطة مباشرة بمحاصيل الأراضي الزراعيّة، وأمّا إدارة اُمور الأرض والمياه فقد كانت بيد فئة صغيرة من الشعب حيث يحكمها قانون العادة، ووظائف حراسة هذه الفئة الصغيرة كانت بعهدة أفراد القرية أيضاً.
وكانت العلاقات الحكوميّة والاجتماعيّة أساساً تأخذ الشكل المحلّي، ولكن مع وجود حالة الفوضى المستمرّة وبسبب فقدان وسائل الارتباط السريع، والاعتماد على وسائل بدائيّة في النقل والمواصلات، فلم تكن الحكومة المركزيّة قادرة على أداء وظائفها الأوليّة، من قبيل حفظ حياة الناس وأموالهم.
وفي مثل هذا الوضع كان من البداهة أن يقوم المالكون الصغار، أو الأشخاص الذين يتمتعون بقدرة قليلة، في سلوك طريق واحدٍ
(25)فقط لحفظ حياتهم واستمرار معاشهم، وهو عبارة عن الارتباط بشخص مقتدر يمكنه أن يعينهم في تحقيق هذا الهدف.
إذاً، فهذه الحالة كانت بمثابة عملة ذات وجهين: أحدهما الرابطة الشخصيّة، والاخر الرابطة الماليّة والملكيّة، فقد كان الأشخاص الضعفاء يجدون أنفسهم مجبرين على العمل كاُجراء لخدمة الأشخاص المتموّلين والأقوياء، وبإزاء ذلك كانت مهمّة الأقوياء هي حفظهم والدفاع عنهم من الأخطار المحتملة.
وكانت هذه الطريقة هي المعمول بها في المجتمعات الغربيّة حينذاك، حيث أخذ المجتمع شكل معادلة المالك والمملوك، أو السيد والرعيّة.
والأهمّ من ذلك هو انّ السيد الكبير كان له غالباً حقّ التدخّل في دائرة إمارته وحكومته، فنجده يتقمّص دور الأمير والحاكم تارة، ودور القاضي تارة اُخرى، وترجع إليه حلّ النزاعات والخصومات في الوقت نفسه، وكانت له حصانة خاصة أيضاً من تدخّل القوّة العسكريّة للملك ونوّابه في دائرة إمارته، وفي المقابل كان على الأمراء والأشراف وظائف تجاه الملك، من قبيل لزوم إرسال مجموعة من الجنود من إمارتهم إلى الحكومة المركزيّة لخدمة الملك والدولة.
وكان الإقطاعيّون قد أحكموا سلطتهم السياسيّة والاقتصاديّة على المجاميع الاجتماعيّة من خلال الثروة والقدرة والتسلّط السياسي.
وكانت الأيديولوجيات في ذلك الزمان لها دور مهمٌّ في تقوية هذه السلطة وترسيخها واستمرار النظام الإقطاعيّ، حيث كانت أيديولوجيّة الإقطاع المقتبسة أساساً من العقائد المسيحيّة مسخرة لحفظ موقعيّة النبلاء والإقطاعيّين.
(26)والكنيسة أيضاً بدورها تحوّلت إلى إقطاع كبير بالاستفاده من هذه الأيديولوجيّة الاقطاعيّة، وبالوعد بالجنة بعنوان الثواب الإلهي في مقابل الصبر على الألم والمشقّة التي كان يعانيها الفلاحون، بحيث كانت هذه الأيديولوجيّة تصدّهم عن المطالبة بحقوقهم والنهوض أمام الأسياد، فكانت الكنيسة تسعى إلى تعميق روحيّة العبوديّة إلى الأسياد بين الفلاحين، مضافاً إلى أنّ ضعف الملك والحكومة المركزيّة أدّى أيضاً إلى تقوية النظام الإقطاعيّ ودوامه.
النظام الإقطاعيّ الذي نشأ منذ القرن الخامس الميلادي، وبلغ الذروة في القدرة من القرن الحادي عشر حتّى الخامس عشر الميلاديّ، هذا النظام قد أخذ الضعف يدبّ في أوصاله في القرن السابع عشر، وبالتدرّج انحسر ليفسح المجال للنظام البروجوازي والرأسمالي ليحلّ محلّه، وطبعاً كان ذلك بعد انتفاضات ونهضات سياسية كثيرة، من أهمّها حركة أنصار (جان هوس) الكبيرة.
فهذه الحركة أخذت تسميتها من مواطن شجاع باسم «جاك جان هوس»، ففي هذه الانتفاضة التي قامت ضدّ الكنيسة الكاثولوكيّة، والأسياد الإقطاعيّين، وإمبراطور ألمانيا، اشترك فيها طبقات وفئات مختلفة من المجتمع من قبيل الفلاحين، وسكان المدن الفقراء، فكان نضال انصار هوس «الهوسيّة» وسيلة إلى إشعال نيران الحركات الثوريّة في الكثير من الدول الأروبيّة.
وهناك عوامل مختلفة أدّت إلى زوال النظام الإقطاعيّ من قبيل توسعة التجارة، كشف القارات، التقدّم العلميّ ومن ثمّ التقدّم الصناعيّ، زيادة قدرة الملك، قيام المحرومين والمظلومين ضدّ الاقطاع، وجميع هذه العوامل اتفقت وأدّت الى إسقاط هذا النّظام القديم.
(27)وبالتدرّج سرى هذا الفكر في أوصال المجتمعات الغربيّة، وهو أنّ أفضل وسيلة لتحصيل الرفاه في المجتمع هو حرية الابتكار والنشاطات الفرديّة، فعندما يفسح المجال للابتكارات الفرديّة تزول حينئذٍ الأفكار القديمة المتعلّقة بالقرون الوسطى، والقائلة بفكرة الطبقات، وإنّ لكلّ طبقة مهمّة معيّنة ووظيفة خاصّة.
يقول هارولد جي لاسكي: «لقد حلّ مكان هذه العقيدة السائدة في نهضة تبدّل النظام الإقطاعيّ إلى الرأسماليّ ـ وهي أنّ رفاه المجتمع وتقدّمه يحصلان من خلال إشراف المجتمع على أعمال الفرد ـ هذه الفكرة التي راجت وسادت تلك المجتمعات، وهي أنّ تقدّم المجتمع يجب أن يكون من خلال احترام الحريّة الفرديّة ونشاطات الأفراد وابتكاراتهم، وفي النتيجة أدّى هذا التغيير الفكريّ إلى ثورة حصيلتها هو الحريّة الفرديّة».
وقد كان من المسلّم لدى الناس في تلك المجتمعات، أنّه كلّما كانت الأمور بيد الأفراد وأعطيت لهم الحريّة أكثر، فإنّ تطوّر المجتمع والرفاه الاجتماعيّ سيتحقّق أكثر، وبتبع هذه النظريّة كان التصوّر في دائرة الاقتصاد، هو أنّ الفرد يجب أن يكون حراً في الاستفادة من المنابع الطبيعيّة، ومستقلاً عن تدخّل الدولة.
أجل هكذا تولّدت الليبراليّة الاقتصاديّة، وكما يقول «لاسكي»: «إنّ الليبراليّة هي المظهر المنطقي للشرائط التي كانت البرجوازيّة بحاجة إليها لإظهار وجودها وتقدّمها، وفي النتيجة فإنّ كلّ هذه العوامل أدّت إلى وضع اُسس الليبراليّة».
بعد أن أخذت المسيحيّة زمام الأمور في المنتصف من القرن الرابع الميلاديّ خلال حكومة «قسطنطين» عام 323 م، واعترف بهذه الديانة رسمياً، وتولّت المسيحيّة مسؤوليّة دين الناس بشكل رسميّ، بدأت الاختلافات بين الملك والبابا في الظهور، واستمرّت على هذا المنوال وبمرور الزمن آخذة في الشدّة والضعف.
وكلّما اقتربنا من نهاية القرون الوسطى، كانت الخلافات والنزاعات تشتدّ بين الملك من جهة والبابا من جهة اُخرى، وإثر ذلك تزداد جرأة الموالين وأتباع كلّ طرف ضدّ الطرف الآخر.
فكان أتباع الكنيسة والبابا يقولون: إنّ القدرة السياسيّة مصدرها هو الله والمسيح، وإنّ البابا هو نائب المسيح، ومشروعيّة قدرة الملك أيضاً هي من المسيح، في حين أنّ أتباع الملك والحكومة يرون أنّ جميع القدرات مصدرها هو الله تعالى، والسلطة الملكيّة أيضاً من الله وغير قابلة للفسخ، ويقولون: إنّ الملك مسؤول أمام الله فقط.
وكان القديس «توماس آكويناس» يرى أنّ الحكومة يجب أن تؤمّن لأتباعها السعادة الماديّة وكذلك السعادة المعنويّة، ولكنّه كان يرى أنّ الكنيسة وحدها هي التي تدرك سرّ السعادة المعنويّة، ومن ذلك فإنّ من حقّ البابا الإشراف على المواطنين ليرى هل أدّوا ما عليهم من الوظائف والمسؤوليّات في سبيل تحقيق ذلك الهدف أم لا؟ كما يستطيع البابا أن يفتي بطرد وتكفير الأفراد الذين يستخدمون قدراتهم في طرائق غير صحيحة ووسائل غير مشروعة.
(29)ولكنّ قدرة الكنيسة الكاثولوكيّة أخذت في الانحسار والضعف بسبب الفساد، الظلم، التجبّر، جمع الأموال وأمثال ذلك إلى أن فقدت نفوذها بشكل كامل بسبب نهضة الإصلاح الديني.
إنّ أكبر شخصيّة من شخصيّات نهضة الإصلاح الدينيّ وأشهرها «مارتين لوثر»، فقد تهجّم لوثر على الكنيسة في مسألة شراء الجنّة وصكوك الغفران التي كانت تباع من قبل الكنيسة في مقابل المال، وقد نشر رسالته المضادّة للكنيسة والتي تحتوي على «95» سؤالاً من الأسئلة الموجّهة للكنيسة في هذه الموضوعات، وعلّقها على باب كنيسة «ويتنبرغ» في سنة 1517م، وفي سنة 1520م صدر حكم كفره على يد البابا لؤى العاشر، ولكنّه أقدم على حرق بيان البابا أمام الناس.
وكان لوثر يرى أنّ المسيحيّ الواقعيّ هو الذي تربطه رابطة شخصيّة وعلاقة مباشرة بالله تعالى، وبسبب هذه العُلقة يستطيع الشخص أن يفهم كلام الله من خلال التفكّر والتأمّل في الكتب المقدّسة.
وكان يعتقد أنّ جميع أفراد البشر سواء أمام الله تعالى، ويستطيعون فهم كلام الله بصورة متساوية، فعلى هذا الأساس فإنّ موقعيّة رجال الدين لم تفقد معناها بالنسبة إلى الواسطة بين الإنسان والله فحسب، بل إنّ موقعيّة رجال الدين تصدّ الإنسان عن إيجاد رابطة معنويّة صحيحة بينه وبين الله تعالى، وكما يقول «ديفيد هلد»:
«إنّ الصراع الذي أفرزته حركة الإصلاح الدينيّ لم يكن العامل الوحيد الذي مارس تأثيراً باقياً في الفكر السياسيّ. فتعاليم لوثر
(30)وكالفن تضمّنت في العمق والجوهر تصّوراً مقلقاً للشخص بوصفه فرداً. في العقيدة الجديدة، جرى تصور الفرد وحيداً أمام الله بوصفه القاضي صاحب السيادة فيما يخصّ سائر أنواع السلوك والمسؤول المباشر عن تفسير إرادة الله وتفعيلها.
كان هذا مفهوماً ذا عواقب بالغة العمق والديناميكيّة. أدّى أولاً إلى تحرير الفرد من الدعم المؤسّسي المباشر للكنيسة، وساهم في حفز مفهوم كون العنصر الفرديّ سيد مصيره، جوهر جزء من كبير من التأمّلات السياسيّة اللاحقة. يضاف إلى ذلك إنّه أفضى إلى تكريس استقلال النشاط العلماني في سائر الميادين غير المتضاربة تضارباً مباشراً مع الممارسة الاخلأقيّة والدينيّة، وما لبث هذا التطوّر حين اقترن بزخم التّغيير السياسيّ الذي أطلقه الصراع بين القوى الدينيّة ونظيراتها الدنيويّة (العلمانيّة) أن شكّل حافزاً رئيسياً جديداً لإعادة معاينة طبيعة الدّولة والمجتمع، ثمّ اكتسب الحافز قوّة إضافيّة جرّاء وعي متنام في أوروبا لحشد متنوّع من الترتيبات الاجتماعيّة والسياسيّة الممكنة، وهو وعي تحقّقَ غداة اكتشاف العالم غير الاوروبي».
وفي نهاية القرن 16 م أصبحت المسائل المتعلّقة بنظام المجتمع بيد الحكومة، ولم يكن للكنيسة تدخّل فيها، فالحكومة أخذت على عاتقها اختيار الأصول والمناهج التي تتكفل هذا الغرض.
ولا يخفى أنّ نهضة الإصلاح الدينيّ لم تفتح الطريق إلى الليبراليّة، بل كانت في صدد إحياء العيسويّة والمسيحيّة، ولكنّ الليبراليّة
(31)استفادت كثيراً من هذه النهضة بشكل غير مباشر، لانّ كسر طوق الحاكميّة الكنيسيّة ساعد في إيجاد معتقدات وإلهيات جديدة، وهذه الإلهيات ساعدت أولاً على كسر الحقيقة المذهبيّة الواحدة المتمثّلة بالكنيسة، وثانياً: أمّنت الحريّة للتفكير الديني في العالم.
البروتستانت هو المذهب الذي أعطى فرصة للناس لأن يشكّكوا في ادّعاء الكنيسة بوجوب إطاعتها من قبل الجميع بصورة مطلقة، وأعطى لهم الحقّ في التفكير الحرّ والتحقيق والبحث في جميع الموارد، وبهذا حلّ التعقّل الدينيّ في أمور الاعتقادات محلّ مرجعيّة الكنيسة.
يقول هارولد جى لاسكي: «إنّ كلّ من يقرأ كتاب «الحكومة غير الإلهيّة» لمؤلّفه هوكر ـ وهو أحد رجال الدين ـ سوف يلتفت جيداً إلى تغيّر الأفكار.. . يقول هوكر: «إنّ المعيار الطبيعيّ للحكم على الأعمال هو العقل والمنطق، وهذا المعيار هو الذي يعيّن الحقّ من الباطل».. .ولم يكتف هوكر بذلك، بل قرّر أنّ القوانين الإلهيّة أيضاً قابلة للتغيير... إنّ الأحكام الإلهيّة برغم أنّها أمر إلهيّ، ولكنّها بسبب تغيّر الزمان والأفراد، فإنّ هذه الأحكام الّتي صدرت في ظرف خاصّ وغاية معيّنة لا تكفي لتحقيق المقصود الجديد، وسوف تفقد اعتبارها وصلاحيتها».
إنّ رواج العقلانيّة ونفي الجزميّة الدينيّة، والتقدّم العلميّ أدّى إلى إبطال النظريّات الدينيّة في تفسير منظومة الكائنات والقوانين السماويّة، ومن ذلك تحرّر العقل والمنطق من قيود هذا الالتزام
(32)الدينيّ، الذي يحتّم على الفكر أن يوفّق نفسه مع النظرات الموجودة عن القوى الميتافيزيقيّة التي يعتقد بها رجال الدين، وقد استبدل العلماء والمحقّقون بهذه النظرات الرؤية العلميّة الجديدة للعالم والكون، والتي تقضي بقيام العلم والمعرفة البشريّة بوضع أسس هذه المعرفة.
مع انهدام النظام الاقطاعيّ، ونموّ الرأسماليّة، ومع اندحار حاكميّة الكنيسة بعد نهضة الإصلاح الدينيّ، شمل التغيير النظريّات السياسيّة أيضاً.
فالملك بعد أن رأى زوال الإقطاعيّة وضعف الكنيسة، اتّحد مع التّجار والرأسماليين بهدف تقوية حكومته، واستطاع بذلك مدّ سلطانه وحكومته، ولم يجد الناس غضاضة من هذا التغيّر، لأنّهم كانوا يشعرون بالتعب من الفوضى والحروب الدينيّة، فكانوا يرون أنّ من الأفضل إعطاء زمام الأمور لحكومة قويّة وجديرة متمثّلة في شخص الملك، ولكن تدريجيّاً ومع مرور الزمان، وتعدّي الملوك وظلمهم وانتهاكهم للحقوق، تعالت نداءات الحكومة المشروطة وكبح جماح قدرة الملك المطلقة، وكان «جان لاك» المتوفّى عام 1704 م من جملة المنادين الأوائل للحكومة البرلمانيّة.
ويعتقد جان لاك بأنّ المعيار لموجوديّة ومشروعيّة النظام الاجتماعيّ والمدنيّ ليس أكثر من رضى الناس، والحكومة موظّفة بحفظ حريّة الناس في أنفسهم وأموالهم، وفي غير هذه الصورة
(33)فأفراد الشعب لهم الحقّ في عزلها، وطبيعيّ فإنّ مثل هذه القدرة لا تكون مطلقة بل مشروطة برضى أفراد الشعب عنها.
وطبعاً فإنّ البحث عن النظريات السياسيّة في تلك المرحلة واسع جداً، ولا يمكن إيراده في هذا المختصر، ولكنّ محورها هو تحديد قدرة الدولة لمصلحة المواطنين.
وبسبب كلّ هذه التحوّلات، وعلى أثر تغيير النظرة الكونيّة لدى الإنسان، فقد تولّدت الليبراليّة واستمرّت في حياتها في صور وتجلّيات مختلفة باختلاف الزمان والمكان إلى يومنا هذا.
وتهدف الليبراليّة إلى تأمين ذلك حقوق جميع الأفراد ورعايتها مع قطع النظر عن المذهب، القوميّة، الطبقة، العرق، الجنسيّة وأمثال ذلك، فالجميع سواسيّة أمام القانون.
والحقوق الأساسيّة للمواطنين في نظر الليبراليّة عبارة عن: حريّة العقيدة والفكر، حريّة البيان، حريّة الاجتماع، حقّ المالكيّة، حريّة المشاركة في الحياة السياسيّة أعمّ من الانتخاب ونيل المناصب وغير ذلك.
يقول «ديويد هلد» عن الليبراليّة: «من المهمّ التحلّي بالوضوح في معنى الليبراليّة، مع أنّها فكرة مكتسبة مثيرة للجدل، ومعناها شهد تحوّلاً تاريخياً فإنّها مستخدمة هنا للدلالة على المحاولة الراميّة إلى الدفاع عن قيم حريّة الاختيار، العقل والتسامح في مواجهة الطغيان، نظام الاستبداد والتعصّب الدينيّ، متحدّية سلطة الاكليروس والكنيسة، من ناحية، وجملة صلاحيات الأنظمة
(34)الملكيّة الاستبداديّة من الناحية الأخرى، سعت الليبراليّة الى تقييد سلطات الطرفين وتحديد دائرة فريدة بخصوصيتها مستقلة عن كلّ من الكنيسة والدولة.
وفي مركز هذا المشروع كان هدف تحرير الكيان السياسيّ من قبضة الدين وتحرير المجتمع المدنيّ: الحياة الشخصيّة، العائليّة والعمليّة من تدخلات السياسة. بالتدرّج ما لبثت الليبراليّة أن افترنت بالعقيدة التي تقول بوجوب تمتّع الأفراد بحريّة اتّباع ما يفضلونه من سائر الشؤون الدينيّة، الاقتصاديّة والسياسيّة. في معظم المسائل المؤثرة في الحياة اليوميّة في الحقيقة في حين أنّ بدائل مختلفة من الليبراليّة فسّرت هذه الغاية بأساليب متباينة، فإنّها كانت جميعاً موحّدة في الدفاع عن الدّولة الدستوريّة، الملكيّة الخاصّة واقتصاد السوق القائم على المنافسة بوصفها الآليات المركزيّة للتنسيق فيما بين مصالح الأفراد.
من المهمّ التأكيد أنَّ الأفراد كان يجري تصوّرهم في أقدم المذاهب الليبراليّة وأوسعها نفوذاً بوصفهم أحراراً ومتساوين وذوي حقوق ثابتة نزلت عليهم من السماء عند الولادة».
ويمكن تلخيص أهمّ أركان الليبراليّة بما يلي:
يُعتبر «منتسكيو« 1689 ـ 1755 م الفيلسوف الفرنسيّ الكبير، اوّل منظّر لمفهوم فصل السلطات والقانون الأساسيّ للحكومات،
ففي نظر منتسكيو فإنّ الأجهزة المختلفة في الحكومة في الأنظمة الديمقراطيّة وبعض أنواع الحكومات الأخرى، وهي جهاز التقنين، التنفيذ، القضاء، لا بدّ من الفصل فيما بينها على المستوى السياسي لإيجاد إشراف أكبر على عمل الحكومة.
ويعتقد منتسكيو أنّه لا يمكن الاعتماد على شخصيّة الحاكم وخصوصيّاته الذهنيّة والأخلاقيّة لحفظ حرّية الأفراد والفكر، بل إنّ الطريق لذلك منحصر في إيجاد التوازن والتعادل بين المصالح والقوى العاملة في الساحة السياسيّة والاجتماعيّة.
إنّ الحكومة البرلمانيّة والمقيّدة بالقانون، وكذلك حريّة المواطنين، بحاجة إلى وجود مجتمع مدني متنوّع على مستوى المنظّمات والأحزاب والمجاميع الفكريّة والفلسفيّه والدينيّة والثقافيّة والسياسيّة، ونفس وجود المجتمع المدني وقوّته يوجب تناثر وتشتت منابع القدرة في المجتمع.
وحضور المجاميع والمنظمات في المجتمع المدنيّ في السّاحة السياسيّة وميدان القدرة من خلال المنافسة الموجودة، يمنع تشكيل حكومة فرديّة ومستبدّة بتوسّط أحد هذه المجاميع ضدّ الآخرين.
يقول «جان لاك» الفيلسوف البريطانيّ: إنّ السياسيّين هم وحوش بالقوة، فلا يمتنعون من تسلّم القدرة وتسخيرها لمنافعهم الشخصيّة، إذاً فالطريق الوحيد لكبح جماحهم هو تقوية المنظّمات،
(36)والموانع العينيّة، والإشراف المستمرّ للشعب، وعلى هذا الأساس فإنّ السياسيّين يجب أن يكونوا تحت نظر الناس وانتخابهم، وإلّا فانّهم سيميلون نحو الفساد والإفساد.
تؤكّد الليبراليّة على تقدّم الحريّة على المساواة والعدالة الاجتماعيّة، يعني أنّ الحريّة هي الهدف الأصيل، والمساواة والعدالة وسيلة لتحقيق ذلك الهدف، وبعبارة اُخرى: لا يمكن سحق الحريات الأصّيلة أو تحديدها بحجّة إيجاد المساواة والعدالة الاجتماعيّة.
ترسم الليبراليّة دائماً حدود الدائرة العامّة والخاصّة في حياة الأفراد، وتعتبر أنّ الحياة الخاصّة والشخصيّة محترمة ومقدسّة، ويجب أن تكون مصونة من تدخّل القدرة السياسيّة الحاكمة.
بدت الطلائع الليبراليّة بالظهور في أوروبا في مرحلة ما بعد عصر الإصلاح الدينيّ ـ أي القرن السّابع عشر ـ حيث أدّت الحروب الدينيّة في تلك المرحلة الى إيجاد الأرضيّة اللازمة لتحديد قدرة الحكومة، وبالتالي فانّ أصحاب المناصب السياسيّة منعوا من تحميل عقائد دينيّة معينة على الناس، والتدخل في امورهم المذهبيّة والدينيّة.
(37)وعلى أساس نظريّة «جان لاك» فإنّ الحكّام إذا قرّروا إعمال قدرتهم بدون حقّ، فسيكونون في حالة حرب مع أفراد الشّعب، وعلى هذا الأساس فإنّ لأفراد الشعب عندما يواجهون نقض حقوقهم وحرياتهم، الحقّ في مقاومة الحكومة والانتفاضة ضدّها.
«ماركى دو كندورسة» ـ 1743 ـ 1794 م ـ الفيلسوف الفرنسيّ المعروف في عصر النهضة والريسانس كان يعتقد بأنّ الليبراليّة هي العامل الأساس لتضعيف أيّة قدرة، سواء كانت قدرة الدّولة أو الكنيسة أو العرف والتراث.
الملكيّة الخصوصيّة في نظر الليبراليّة إحدى الأدوات الأصليّة لحفظ وإدامة الحريّة السياسيّة، فالملكيّة الخصوصيّة أحد المنابع الأصليّة لاستقلال الأفراد ومقاومتهم في قبال قدرة الحكومة.
(38)
لا يخفى أنّه بسبب تغيير النظرة بالنسبة للفرد، الإنسان، المجتمع، الدّولة والاقتصاد، يمكن إيجاد أنظمة سياسيّة وفكريّة متنوّعة.
وقد رأينا أنّ الليبراليّة لا تطلق على معنى ومفهوم واحد، بل إنّ كلّ متفكّر يمكنه تفسيرها وتعريفها بالمسبوقات الذهنيّة والمعارف السّابقة، ولذا فنحن نشاهد اختلافاً في هذا المجال، وبالنظر إلى ذلك فإنّ النظريّة الديمقراطيّة الليبراليّة شهدت تحوّلات متنوّعة أيضاً.
يقسّم «مكفرسون» في كتاب «حياة الديمقراطيّة الليبراليّة» الديمقراطيّة الليبراليّة إلى ثلاثة أنواع: 1ـ الديمقراطيّة الدفاعيّة
2 ـ الديمقراطيّة التكامليّة 3 ـ الديمقراطيّة التعادليّة «أو ديمقراطيّة النخبة والتكثّر». ويقول في شرحها:
والمقصود بهذا النّظام هو تحديد القدرة الحاكمة دفاعاً عن المواطنين، كيما يتمكنوا في ظلّ هذه الحماية من نيل وتحصيل منافعهم، فهم أحرار في مشاركة المبادلات الاقتصاديّة، العمل والتجارة في السوق، تقسيم الثروات بصورة خصوصية.
وقد بلغت نظريّة الديمقراطيّة الليبراليّة الدفاعيّة كمالها المطلوب على يد «جرمي بنتام» 1863 ـ 1748 م و«جيمز ميل» 1836 ـ 1733 م.
يرى جرمي بنتام في هذا الصدد أنّه يتوقّع من الحكومة الديمقراطيّة أن تعمل على حماية المواطنين في مقابل استبداد القدرة السياسيّة، سواء كان الاستبداد بواسطة الملك أو النخبة من الأشراف والنبلاء أو من سائر المجاميع، والطريق الوحيد لذلك هو الانتخابات، القرعة، المنافسة بين الوكلاء السياسيين بالقوة، فصل السلطات، حريّة البيان والصحافة، وتشكيل الاجتماعات العامّة التي بإمكانها حفظ منافع المجتمع بصورة عامّة.
الديمقراطيّة الدفاعيّة وقعت في تقابل مع موضوع بديل: الموضوع الذي يمكن أن يعطينا مفهوماً جديداً من العلاقة والمناسبة بين المواطنين والحكومة، بحيث يأخذ بعين الاعتبار ظروف تكامل الفرد من الناحية الأخلاقيّة والاجتماعيّة من كلّ جهة...
جان استوارت ميل 1873 ـ 1806 م ذكر كلاماً وبياناً يعتبر أفضل بيان ممكن عن الفكر الديمقراطيّ التكامليّ. . . فالنموذج الذي يراه «ميل» يتبنّى سلسلة من المسائل الأخلاقيّة التي غفل عنها أصحاب نظريّة الديمقراطيّة الدفاعيّة أو وضعوها في الهامش.
إنّ ما يراه (مِل) في نموذجه السياسي وما يميّزه عن النموذج السابق، هو أنّ هذا النموذج يعطينا تصويراً اخلاقياً عن إمكان ارتقاء الإنسان والمجتمع الحرّ نحو المراتب التي يفتقدها المجتمع فعلا..
إنّ الرقيّ المتوقع في هذا النموذج يأخذ بعين الاعتبار التقدم
الحاصل في كيفيّات أفراد المجتمع، وكما يقول جان استوارت ميل: إنّ تقدّم المجتمع يكمن في التعقّل، الطهارة والفاعليّة.
والدليل الذي يورده ميل لهذا النظام الديمقراطيّ، هو أنّ هذا النظام يعمل على تطوير الحالة الاجتماعيّة أفضل من أيّ نظام سياسي آخر.
وهذا المعنى يلفت أنظارنا إلى الأسس التي يقوم عليها نموذج ميل للديمقراطيّة، فالأساس في هذا النموذج يقوم على تصوير خاصّ للإنسان يتفاوت مع النموذج السابق كثيراً، فالإنسان هو كائن له قابليّة على تطوير قواه وترشيد طاقاته وقابلياته.
فالإنسان يجب أن يتحرّك على مستوى تفعيل هذه الطاقات والقدرات وترشيدها، وهو أساساً لا يصرف ويتصرف (كما رأينا في النموذج الأول) وحسب بل هو كائن فاعل وله قابليات بالقوة، والمجتمع الجيّد هو المجتمع الذي يفسح المجال لأفراده على أساس أنّهم فاعلون ولهم حقوق، ويعمل على ترغيبهم للاستفادة من هذه الحقوق والطاقات.
وهذا النموذج استمرّ حتّى النصف الأوّل من القرن العشرين، وإلى أن جرى إبطاله بواسطة النموذج الثالث.
النموذج الثالث الذي ساد في العقود الوسطى من القرن العشرين في بلاد الغرب، حلّ محلّ النموذج الثاني الفاشل. . . وهذا النموذج يأخذ بعين الاعتبار جهة التعادل في الديمقراطيّة، بعنوان أنّها نظام وظيفته إيجاد التعادل بين العرض والطلب في الدائرة السياسيّة.
(41)المسبوقات الفكريّة والأسس المعرفيّة لهذا النموذج عبارة عن:
1 ـ إنّ الديمقراطيّة ما هي إلّا أداة ووسيلة من أجل انتخاب واختيار الحكومة، لا أنّها نوع من أنواع المجتمع، ولا مجموعة من الأهداف الأخلاقيّة.
2 ـ إنّ هذا المنهج يعتمد أساساً على المنافسة بين طرفين أو أكثر من السياسيين أو «النخبة»، التي تتكوّن من الأحزاب السياسيّة الداخلة ميدان المنافسة لكسب الآراء من أجل الوصول الى دفّة الحكم مدة معينة حتّى تحين الانتخابات الأخرى.
وهذا النموذج بدوره يواجه مطبّات وخللاً من جهات عديدة، وكما يقول مكفرسون: «إنّ عجز هذا النموذج على مستوى العمل اتّضح أكثر من السابق».
ومن أجل الاطّلاع الأوسع على مطبّات هذا النموذج يمكن مراجعة كتاب «بيان ونقد نظريّة الديمقراطيّة الليبراليّة» لمؤلّفه البروفسور آندرولوين.
الاشتراكيّة مأخذوة من مفهوم اشتراك أفراد المجتمع، ولها معان عديدة، ولكن التعريف المتعارف والسائد في الأوساط السياسيّة حديثاً هو: أنّ «الاشتراكيّة هي نظريّة وسياسة، تهدف إلى مالكيّة وإشراف المجتمع على وسائل التوليد، رأس المال، الأرض، الثروات الأخرى بشكل عام، وبالتالي إدارتها بما يكون فيها نفع للجميع».
وبعضهم يرى أنّ جذور الاشتراكيّة تمتدّ نحو أوّل نظريّة أخلاقيّة ودينيّة عملت على ترغيب الناس للتعاون الاجتماعيّ، كما يُنسب ذلك إلى افلاطون.
أمّا الاشتراكيّة الجديدة فهي في الواقع من نتاج الثورة الصناعيّة بشكل مباشر: «إنّ ظهور الاشتراكيّة كان على شكل ردّ فعل للظروف الاجتماعيّة والاقتصاديّة السائدة في أوروبا، وعلى أثر نموّ الرأسماليّة والإمبرياليّة الصناعيّة، حيث إنّ ولادة الأفكار الاشتراكيّة ترتبط بالدرجة الاُولى بفكرة إيجاد طبقة جديدة من العمال الذين كانوا يعيشون الفقر والتحقير والمحروميّة، التي تعتبر من سمات عصر النهضة الصناعيّة في أوروبا».
وقد استخدم هذا المعنى للاشتراكيّة أوّل مرة عام 1827 م من قبل(رابرت آون) في بريطانيا، وقد ورد هذا الاصطلاح في عام 1832م في الصحيفة الناطقة بلسان أتباع (سن سيمون) وبعد ذلك ساد استخدامه في فرنسا وبريطانيا وألمانيا وأمريكا.
ويرى الاشتراكيّون أنّ من الممكن التغلّب على أشكال التبعيض الاجتماعيّ والاقتصاديّ، من خلال الغاء الملكيّة الخصوصيّة واستبدال نوع من أنواع الملكيّة العامّة بها.
وبعد الحرب العالميّة الاُولى، وظهور بعض المنادين بالإصلاح في صفوف الماركسيين، وانكشاف عجز هذا النموذج الذي وضع جميع اهتماماته في سبيل تقسيم الثروة ولم يلتفت إلى عنصر القدرة السياسيّة، بحيث كانت النتيجة عملاً هي الاستبداد والدكتاتوريّة، فمن ذلك ذهب بعض الاشتراكيّين إلى
(43)مزج الديمقراطيّة ـ بمعنى التوزيع الصحيح للقدرة ـ والاشتراكيّة ـ بمعنى التوزيع الصحيح للثروة ـ.
لأنّهم يعتقدون أنّ الديمقراطيّة تعمل على زيادة الثروات الطائلة، أمّا الاشتراكيّة فتعمل على تقوية وترشيد القدرة المطلقة والاستبداد السياسيّ، وعلى هذا الأساس فإنّ السبيل إلى إصلاح المجتمع وتقدّمه هو العمل على إدغام وتلفيق الاشتراكيّة والديمقراطيّة.
وبشكل عامّ فإنّ السمة الأصليّة للديمقراطيّة الإشتراكيّة هي: الحكومة غير الطبقيّة، ضمان الحريّة لجميع الأفراد، إيجاد المساواة الاجتماعيّة والاقتصاديّة، مضافاً إلى وجود حقّ الرأي العامّ حيث يكون هو الضامن الأصلي لحقوق الأفراد ومنهم العمال.
إنّ أنصار الديمقراطيّة الاشتراكيّة أعلنوا أهدافهم في عام (1951م) بهذه الصورة:
«الاشتراكيّة تهدف إلى إحلال نظام بدل النظام الرأسماليّ، يكون فيه النفع العامّ مقدماً على النفع الخاصّ، والأهداف الأوّليّة للسياسة الاشتراكيّة هي عبارة عن القضاء على العطالة بصورة كاملة، الإنتاج الأكثر، رفع مستوى المعيشة، الأمن الاجتماعيّ، والتوزيع العادل للثروات والأرباح.
ومن أجل تحقق هذه الأهداف يجب وضع خطّة لكي يكون الإنتاج منظّماً بشكل نافع للجميع، ومثل هذا النظم يتنافى مع تمركّز القدرة الاقتصاديّة في أيدي فئة قليلة، ولازمها الإشراف الديمقراطيّ المؤثر في الإقتصاد، فعلى هذا الأساس فإنّ الديمقراطيّة الاشتراكيّة تتقاطع مع النظام الرأسمالي، وكذلك مع كلّ نوع من النظام الشامل
(44)والكلّي «توتاليتر» لأنّ كلا هذين النظامين يمنعان الإشراف العامّ على الإنتاج والتوزيع العادل للثروات.
ومن أجل التخطيط الاشتراكيّ فليس من الضروريّ تملّك الدولة لجميع وسائل الإنتاج، بل إنّ مثل هذا النظام يتلاءم مع الملكيّة الخصوصيّة في الموارد المهمّة من قبيل الزراعة، الصناعات اليدويّة، التجارة والصناعات المتوسّطة.
فالحكومة يجب أن تضع حداً للاستفادة غير المشروعة من القدرة للقسم الخاصّ، ومن جانب آخر فالحكومة يمكنها بل يجب عليها أن تمدّ يد العون إلى هذا القسم من أجل زيادة الإنتاج والرفاه في إطار البرنامج الاقتصاديّ».
وطبعاً فبعضهم يرى أنّ الديمقراطيّة الاشتراكيّة هي بنفسها نظريّة الديمقراطيّة الليبراليّة، ولكن مع بعض الإصلاحات الأخلاقيّة.
«ادوارت برنشتاين» 1850 ـ 1932 م الذي يعتبر من الإصلاحيين الكبار في النظام الماركسيّ، والصديق الحميم ل (انجلز) يقول: «إنّ الديمقراطيّة الاشتراكيّة ليست الوريث المشروع للّيبراليّة على مستوى الامتداد التاريخيّ وحسب، بل في خصوصياتها المعنويّة أيضاً». وهذا يعني أنّ الديمقراطيّة الاشتراكيّة لا تقوم بحذف الليبراليّة، بل إنّها توسّع دائرتها فحسب.
وكذلك يقول البروفسور اندرولوين: «أنا أدّعي أنّ نظريّة الديمقراطيّة الاشتراكيّة المعاصرة في النتيجة هي بنفسها نظريّة
الديمقراطيّة الليبراليّة المحوريّة، مع ارتباطها بالقيم في مجال التوزيع للثروات».
ويقول مكفرسون أيضاً في كتاب حياة الديمقراطيّة الليبراليّة بعد أن يذكر ثلاثة نماذج للديمقراطيّة: (الدفاعيّة، والتكامليّة، والتعادليّة) وبعد أن يذكر شواهد على ضعفها، يشير إلى نموذج رابع يسمّيه (ديمقراطيّة المشاركة) ويرى أنّ تحقّق هذا النموذج يستلزم أنّ المفروضات المبتنية على السوق تتنزّل في مورد ماهيّة الإنسان والمجتمع أو تطرح جانباً، ويجب الابتعاد عن الفكرة القائلة بأنّ الإنسان هو كائن استهلاكيّ، وينبغي التقليل من التفاوت الطبقيّ في الدائرة الاقتصاديّة والاجتماعيّة....
وهذه التحوّلات في النظر المنطقي لا تنفي صفّة الليبراليّة عن النموذج الرابع (ديمقراطيّة المشاركة) فما دام هناك ادراك قوي بالنسبة إلى القيم العليا والحقّ المساوي للنموّ والتطور، فإنّ النموذج الرابع هو الأفضل والمناسب للديمقراطيّة الليبراليّة.
وعلى أيّ حال فهذا النموذج الاشتراكيّ لم يتجاوز إلى الآن إطار النظريّة، ولم ينزل إلى أرض الواقع، ولا سيّما بعد انهيار الاشتراكيّة في العالم.
وهذا ما سنبحثه في الفصل القادم
لم يمض وقت طويل على دخول الديمقراطيّة الساحة السياسيّة الإسلاميّة، وذلك بعد ما غزيت البلاد الإسلاميّة من قبل الأوروبيّين غزواً ثقافياً وعسكرياً.
في تلك الفترة كانت البلاد الأوروبيّة تشهد أرقى أنواع التقدّم والرقيّ الحضاريّ، بعكس البلاد الإسلاميّة حيث مُنيت بأنواع التخلّف والانحطاط السياسيّ والثقافيّ.
ففي المجال السياسيّ ساد الاستبداد والدكتاتوريّة من قبل الحكام، وفي المجال الثقافيّ والدينيّ على الخصوص ساد التحجّر والانحطاط الفكريّ.
وهذا ما دعا دفع رجال الدين والعلماء إلى القيام لإعلاء كلمة الدين من طريق إصلاح فهم المسلمين له، وإعطاء رؤية مشرقة وتعبير صحيح للفهم الدينيّ يوافق التقدّم ويواكبه.
وبما أنّ من أهمّ الدواعي لنجاح أيّ مشروع إصلاحي صلاح الحكومة، اتّجهت الأنظار نحوها وبدأ المفكّرون بالتنظير والبحث والتنقيب، وكان عملهم على مرحلتين:
1 ـ رفض الاستبداد بشتى أنواعه. 2 ـ التنظير من أجل إقامة بديل للحكم الاستبداديّ.
ومن هؤلاء المنظّرين عبد الرحمن الكواكبيّ، فهو يشرح لنا بصورة واضحة هاتين المرحلتين، ويقول في تبيين المرحلة الاُولى:
(48)«وأشكال الحكومة المستبدّة كثيرة، ليس هذا البحث محلّ تفصيلها، ويكفي هنا الإشارة إلى أنّ صفّة الاستبداد كما تشمل الحكومة الحاكم الفرد المطلق الذي تولّى الحكم بالغلبة أو الوراثة، تشمل أيضاً الحاكم الفرد المقيّد المنتخب متى كان غير مسؤول، وتشمل حكومة الجمع ولو منتخباً... ويشمل أيضاً الحكومة الدستوريّة المفرقة فيها بالكلّية قوة التشريع عن قوة التنفيذ وعن القوة المراقبة، لأنّ الاستبداد لا يرتفع ما لم يكن هناك ارتباط في المسؤوليّة، حتّى يكون المنفّذون مسؤولين لدى المشرّعين، وهؤلاء مسؤولون لدى الاُمّة، تلك الاُمّة التي تعرف أنّها صاحبة الشأن كلّه، وتعرف أنْ تراقب وأن تتقاضى الحساب. إنّ الحكومة من أيّ نوع كانت لا تخرج عن وصف الاستبداد ما لم تكن تحت المراقبة الشديدة والاحتساب الذي لا تسامح فيه. . .».
أمّا بالنسبة للمرحلة الثانية فيشرح مبناه قائلاً:
«يجب قبل مقاومة الاستبداد تهيئة ماذا يستبدل بالإستبداد» ويقول في شرحه: «ومبنى قاعدة: إنّه يجب قبل مقاومة الاستبداد تهيئة ماذا يستبدل بالاستبداد، هو أنّ معرفة الغاية شرط طبيعيّ للإقدام على كلّ عمل، كما أنّ معرفة الغاية لا تفيد شيئاً إذا جهل الطريق الموصل إليها، والمعرفة الإجماليّة في هذا الباب لا تكفي مطلقاً، بل لا بدّ من تعيين المطلب والخطّة تعييناً واضحاً.. . والمراد أنّه من الضروريّ تقرير شكل الحكومة التي يراد ويمكن
(49)أن تُستبدَل بالاستبداد، وليس هذا بالأمر الهيّن الذي تكفيه فكرة ساعات أو فطنة آحاد...».
وهذا البديل الذي تحدّث عنه الكواكبيّ وغيره من المفكّرين، ليس إلّا حكماً اسلاميّاً من حيث المفهوم والمصداق، ولكن بدأت هناك مشكلة وهي القالب الذي ينصب فيه هذا المفهوم ويظهر على أرض الواقع.
فالحكم ـ بلا إشكال ـ لا بدّ من أن يكون اسلاميّاً من حيث المحتوى، يستمدّ قوانينه وشرعيّته منه، ولكنّ الكلام كلّ الكلام في كيفيّة شاكلة هذه الحكومة وصورتها وقالبها الذي تتلبّس به، فهل هذا القالب والإطار الذي يتأطّر به النظام السياسيّ للحكومة الإسلاميّة هو الاستبداد، أو المشروطة، أو الجمهوريّة، أو الديمقراطيّة ؟ !
قد يكون كلّ واحد من هذه القوالب أفضل من غيره في زمن معيّن، مثلاً كانت المشروطة في فترة معينة هي الخيار الوحيد والأفضل، ولذا دعمها الناس وبعض العلماء والمراجع، وما كان كتاب (تنبيه الاُمّة) للميرزا النائيني إلّا وليد تلك الفترة، ثمّ كانت الجمهوريّة كذلك حتّى إنّها كانت الشعار الأساسيّ في بداية الثورة الإيرانيّة إلى أن تحوّلت إلى شعار الديمقراطيّة في الآونة الأخيرة.
وعلى كلّ حال، إنّ دخول هذا الضيف الجديد في الأدبيّات السياسيّة الإسلاميّة سبّب ردود فعل كثيرة نفياً واثباتاً، وبدأت الكتب والمجلّات تنشر في التنظير له أو عليه، وللخروج من هذا الكمّ الهائل من التنظير بنتيجة معقولة وصحيحة رأينا جمع هذه
(50)النظريّات المختلفة وفرزها بصورة منظّمة يسهّل مراجعتها واتخاذ الرأي الصواب من بينها بالاعتماد على أهمّ المنظّرين للمصطلح في العالم الاسلاميّ، فكانت على ثلاثة أقسام:
1 ـ المخالفة المطلقة.
2 ـ الموافقة المطلقة.
3 ـ الموافقة المشروطة.
وهذا ما سنبيّنه في المباحث الآتية.
(51)
إنّ أصحاب هذا الرأي في الأقليّة، وهم يعتقدون أنّ قبول مصطلح الديمقراطيّة، أو القول بالديمقراطيّة الإسلاميّة، أو السعي في التوفيق بينهما، هو من الضعف والفشل أمام غزو الغرب الثقافيّ، فعلينا الرفض أوّلاً، وثانياً شرح وتبيين المشروع السياسيّ الإسلاميّ الأصيل.
فممّن ذهب إلى هذا الإتّجاه:
يُظْهِر سيد قطب مخالفته للديمقراطيّة قائلاً: «لم أستسغ حديث من يتحدّثون عن اشتراكيّة الإسلام وديمقراطيّة الإسلام، وما إلى ذلك من الخلط بين نظام من صنع الله سبحانه، وأنظمة من صنع البشر، تحمل طابع البشر وخصائص البشر من النقص والكمال، والخطأ والصواب، والضعف والقوة، والهوى والحقّ».
إنّ السبب الذي دعا سيد قطب لعدم رضاه بهذا المزج، هو اعتقاده بأنّ هذا العمل نابع من إحساس بالهزيمة أمام الغرب، فلذا يقول:
«بعض من يتحدّثون عن النظام الإسلاميّ ـ سواء النظام الإجتماعيّ، أم نظام الحكم وشكل الحكم ـ يجتهدون في أن
(52)يعقدوا الصلات والمشابهة بينه وبين أنواع النظم التي عرفتها البشريّة قديماً وحديثاً، قبل الإسلام وبعده، ويعتقد بعضهم أنّه يجد الإسلام سنداً قويّاً حين يعقد الصلة بينه وبين نظام آخر من النظم العالميّة القديمة أو الحديثة.
إنّ هذه المحاولة إن هي إلّا إحساس داخلي بالهزيمة أمام النظم البشريّة التي صاغها البشر لأنفسهم في معزل عن الله... الإسلام لا يحاول ولم يحاول أن يقلّد نظاماً من النظم أو أن يعقد بينه وبينها صلة أو مشابهة، بل اختار طريقة متفرداً فذاً، وقدّم للإنسانيّة علاجاً كاملاً لمشكلاتها جميعاً.
إنّ القاعدة التي يقوم عليها النظام الإسلاميّ تختلف عن القواعد التي تقوم عليها الأنظمة البشريّة جميعاً، إنّه يقوم على أساس أنّ الحاكميّة لله وحده، فهو الذي يشرّع وحده، وسائر الأنظمة تقوم على أساس أنّ الحاكميّة للإنسان، فهو الذي يشرع لنفسه، وهما قاعدتان لا تلتقيان. ومن ثمّ فالنظام الإسلاميّ لا يلتقي مع أيّ نظام، ولا يجوز وصفه بغير صفة الإسلام».
«حين تكون الحاكميّة العليا في مجتمع لله وحده ـ متمثلة في سيادة الشريعة الالهيّة ـ تكون هذه هي الصورة الوحيدة التي يتحرّر فيها البشر تحرّراً كاملاً وحقيقياً من العبوديّة للبشر، وتكون هذه هي الحضارة الإنسانيّة، لانّ حضارة الإنسان تقتضي قاعدة أساسيّة من التحرّر الحقيقيّ الكامل للإنسان، ومن الكرامة المطلقة لكلّ فرد في المجتمع، ولا حريّة في الحقيقة،
(53)ولا كرامة للإنسان. . . في مجتمع بعضه أرباب يشرّعون، وبعضه عبيد يطيعون».
ومن محسّنات هذا النظام أنّه: «كفيل بإقرار العلاقات بين الراعي والرعيّة على أسس من السلام والعدل والطمأنينة، ينهض عليها بناء السلام الاجتماعيّ سليماً راسخ الأركان، إنّ الراعي لا يصل إلى مكانه إلّا عن طريق واحد: رغبة الرعيّة المطلقة واختيارها الحرّ، ولا يستبقي بين الرعيّة مكانه ذاك إلّا عن طريق واحد: طاعة الله والعمل بشريعة الله».
فبعد هذا كلّه، يشرح سيد قطب نظام الحكم الإسلاميّ هكذا: «تقوم سياسة الحكم في الإسلام بعد التسليم بقاعدة الألوهيّة الواحدة والحاكميّة الواحدة، على أساس: العدل من الحكام، والطاعة من المحكومين، والشورى بين الحاكم والمحكوم.
(إِنَّ اللَّـهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ).
(وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ).
(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّـهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنكُمْ).
فالطاعة لوليّ الأمر مستمدّة من طاعة الله ورسوله، لأنّ وليّ الأمر
في الإسلام لا يطاع لذاته، وإنّما يُطاع لإذعانه هو لسلطان الله واعترافه له بالحاكميّة ثم لقيامه على شريعة الله ورسوله...
ويجب أن نفرّق بين قيام الحاكم بتنفيذ الشريعة الدينيّة، وبين استمداده السلطان من صفة دينية لشخصه، فليست للحاكم سلطة دينيّة يتلقاها مباشرة من السماء، كما كان لبعض الحكام في القديم في نوع الحكم المسمّى «ثيوقراطيّة».
إنّما هو يصبح حاكماً باختيار المسلمين الكامل وحريتهم المطلقة، لا يقيّدهم عهد من حاكم قبله، ولا وراثة كذلك في اُسرة، ثمّ يستمدّ سلطته بعد ذلك من قيامه بتنفيذ شريعة الله، دون أن يدّعي لنفسه حقّ التشريع ابتداء بسلطان ذاتيّ له، فإذا لم يرضه المسلمون لم تقم له ولاية، وإذا رضوه ثمّ ترك شريعة الله لم تكن له طاعة.
(وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ).
(وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ).
فالشورى أصل من اُصول الحياة في الإسلام، وهي أوسع مدى من دائرة الحكم، لأنّها قاعدة حياة الاُمّة المسلمة كما تدلّ الآية.
أمّا طريقة الشورى فلم يحدّد لها نظاماً خاصاً، وتطبيقها إذاً متروك للظروف والمقتضيات، فقد كان الرسول يستشير المسلمين فيما لم يرد فيه وحي، ويأخذ برأيهم فيما هم أعرف به من شؤون دنياهم، كمواقع الحرب وخططها.. . أمّا ما كان فيه وحي، فلا مجال للشورى بطبيعة الحال، فهو مقرّر من مقررات الدين».
«هذا النظام الإسلاميّ كفيل باستقامة الرعاة ورضى الرعيّة، وبإقرار السلام بينهما وتوطيده، لا بالعسف والجور، ولا بالكبت والإجبار، ولا بالقسوة والجبروت، ولا بالخوف والذلّ، ولكن بالرضى والقبول، والطاعة المنبعثة من أعماق الضمير، لا رياء ولا نفاقاً، ولا تظاهراً كذابا ً».
ثمّ إنّه يؤكد هذه الحريّة في الانتخاب، ونفي السلطة الدينيّة للحاكم قائلاً: «كان الأمر إذاً للشورى بين المسلمين، وللإقناع وللاقتناع بمن هو أحقّ الناس بالخلافة، ولئن كان الجدل يوم السقيفة قد انتهى إلى أن تكون الخلافة في المهاجرين، فما كان ذلك فرضاً اسلامياً، ولكنّه تواضع واتّفاق بين جماعة المسلمين، كان الأنصار يملكون ردّه ولا تثريب عليهم. ...
ولقد استخلف أبو بكر عمر ولكن هذا لم يكن إلزاماً منه للمسلمين، فلقد كانوا في حلٍّ من ردّ هذا الاستخلاف، وعمر لم يصبح خليفة بحكم استخلاف أبي بكر له، بل بمبايعة الناس إيّاه.
وكذلك عيّن عمر بعده ستّة للشورى على أن يختاروا منهم واحداً، وما كان المسلمون بملزمين بأن يختاروا واحداً من الستّة، وإنّما هم التزموا لأنّ الواقع كان يشهد بأنّ الستّة هم الأفضل...
فامّا البيعة لعليّ فقد ارتضاها قوم وأباها آخرون... هذا الاستعراض السريع يكشف لنا عن قاعدة الإسلام الأصّيلة في الحكم، وهي أنّ اختيار المسلمين المطلق هو المؤهّل الوحيد للحكم».
ثمّ إنّ سيد قطب يندّد بفعل الأمويّين حينما جعلوا الخلافة ملكاً عضوضاً في بني اميّة، ويعتقد أنّ هذا العمل من وحي الجاهليّة، فيقول:
«فلما جاء الأمويون، وصارت الخلافة الإسلاميّة ملكاً عضوضاً في بني اميّة، لم يكن ذلك من وحي الإسلام، إنّما كان من وحي الجاهليّة الذي أطفأ إشراقه الروح الإسلاميّ».
ثمّ يذكر مسألة أخذ البيعة ليزيد وخطبة معاوية في تهديد وجهاء مكّة، حيث قال لهم: «فّاقسم بالله لئن ردّ عليّ أحدكم كلمة في مقامي هذا لا ترجع إليه كلمة غيرها حتّى يسبقها السيف إلى رأسه». فيقول سيد قطب: «على هذا الأساس الذي لا يعترف به الإسلام البتّة قام ملك يزيد.
فمن هو يزيد؟ هو الذي يقول فيه عبدالله بن حنظلة: «والله ما خرجنا على يزيد حتّى خفنا أن نرمى بالحجارة من السماء، إنّ رجلاً ينكح الاُمهات والبنات والأخوات، ويشرب الخمر، ويدع الصلاة. . .« فإذا كانت هذه مقالة خصم ليزيد، فإنّ تصرفات يزيد العمليّة الواقعيّة فيما بعد، من قتل للحسين على ذلك النحو الشنيع، إلى حصار البيت ورميه. . . تشهد بأنّ خصوم يزيد لم يبالغوا كثيراً فيما قالوه».
يقسّم السّيد الطباطبائي إدراكات الإنسان إلى إدراكات حقيقيّة تحكي عن أمور خارجة عن الإنسان، وإدراكات اعتباريّة وهي
التي «لا تحكي عن أمور خارجيّة ثابتة في الخارج مستقلّة عنّا وعن أفهامنا.. . هي ممّا هيّأناه نحن، اُلهمناه من قبل إحساسات باطنيّة حصلت فينا من جهة اقتضاء قوانا الفعّالة وجهازاتنا العاملة للفعل والعمل. . .».
ومن جملة هذه الاعتبارات اعتبار الاستخدام، وهو أن يستخدم الإنسان كلّ ما يمكنه استخدامه في طريق كماله، ولذا يأخذ في التصرّف في المادة، والنبات، والحيوان، وكذلك بني نوعه «غير أنّ الإنسان لما وجد سائر الأفراد من نوعه وهم أمثاله، يريدون منه ما يريده منهم، صالحهم ورضي منهم أن ينتفعوا منه وزان ما ينتفع منهم، وهذا حكمه بوجوب اتّخاذ المدنية، والاجتماع التعاوني، ويلزمه الحكم بلزوم استقرار الاجتماع بنحو ينال كلّ ذي حقّ حقّه، ويتعادل النسب والروابط، وهو العدل الاجتماعيّ.
فهذا الحكم أعني حكمه بالاجتماع المدنيّ والعدل الاجتماعيّ إنّما هو حكم دعا إليه الاضطرار، ولولا الاضطرار المذكور لم يقض به الإنسان قط، وهذا معنى ما يقال «إنّ الإنسان مدنيّ بالطبع وإنّه يحكم بالعدل الإجتماعيّ. . .».
«ومن هنا يعلم أنّ قريحة الاستخدام في الإنسان بانضمامها إلى الاختلاف الضروريّ بين الأفراد من حيث الخلقة، ومنطقة الحياة، والعادات، والأخلاق المستندة إلى ذلك، وإنتاج ذلك للاختلاف الضروريّ من حيث القوّة والضعف، يؤدي إلى الاختلاف والانحراف عمّا يقتضيه الاجتماع الصالح من العدل الاجتماعيّ. . .
فكان بروز الإختلاف مؤدياً إلى الهرج والمرج، وداعياً إلى هلاك الإنسانيّة وفناء الفطرة وبطلان السعادة. . . وظهور هذا الاختلاف هو الذي استدعى التشريع، وهو جعل قوانين كليّة يوجب العمل بها ارتفاع الاختلاف، ونيلّ كل ذي حقّ حقّه، وتحميلها الناس».
ويقول أيضاً: «ولذلك شرّع الله سبحانه ما شرّعه من الشرائع والقوانين واضعاً ذلك على أساس التوحيد، والاعتقاد، والأخلاق، والأفعال، وبعبارة أخرى وضع التشريع مبني على أساس تعليم الناس وتعريفهم ما هو حقيقة أمرهم من مبدئهم الى معادهم، وأنّهم يجب أن يسلكوا في هذه الدنيا حياة تنفعهم في غد، ويعملوا في العاجل ما يعيشون به في الآجل. ...
قال تعالى: (فَبَعَثَ اللَّـهُ النَّبِيِّينَ مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ وَأَنزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِيمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ ۚ وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ) فقارن بعثة الأنبياء بالتبشير والإنذار بإنزال الكتاب المشتمل على الأحكام والشرائع الرافعة لاختلافهم».
وبعد هذه المقدّمة التمهيديّة لما يأتي السيد الطباطبائيّ إلى الإسلام وأمر الحكومة فيه يتساءل: «من الذي يتقلّد ولاية المجتمع في الإسلام وما سيرته ؟» ويجيب عنه:
«كان ولاية أمر المجتمع الإسلاميّ إلى رسول الله صلىاللهعليهوآله، وافتراض طاعته صلىاللهعليهوآله على الناس واتّباعه صريح القرآن الكريم».
أيضاً: «فهو أيضاً المتعيّن من عند الله للقيام على شأن الأمّة، وولاية أمورهم في الدنيا والآخرة، وللإمامة لهم ما دام حيّاً، لكنَّ الذي يجب أن لا يغفل عنه الباحث أنّ هذه الطريقة غير طريقة السلطة الملوكيّة التي تجعل مال الله فيئاً لصاحب العرش، وعباد الله أرقاء له، يفعل بهم ما يشاء، ويحكم فيهم ما يريد، وليست هي من الطرائق الاجتماعيّة التي وضعت على أساس التمتّع الماديّ من الديمقراطيّة وغيرها، فإنّ بينها وبين الإسلام فروقاً بيّنة مانعة من التشابه والتماثل».
ومن تلك الفوارق التي يذكرها السيد الطباطبائيّ كون تلك المجتمعات مبنيّة على أساس التمتّع الماديّ ممّا أدّى إلى الاستكبار الإنسانيّ الذي يجعل كلّ شيء تحت إرادته ولمصلحته، ويبيح له طريق الوصول إليه والتسلّط عليه بما يهواه ويشاءه.
ومنها ظهور الفساد في المجتمع مرة اُخرى بسبب اختلاف الطبقات في الثروة والجاه والمقام.
هذا ولكنّ السيد الطباطبائيّ في كتاب آخر يرى بعض التماثل بين المجتمع الإسلاميّ والديمقراطيّ من دون أن يريد عقد الصلة بينهما، فيقول بعد ما يقسّم الأحكام الإسلاميّة إلى أحكام ثابتة غير قابلة للتغيير، وأحكام متغيّرة:
«إنّ المجتمع الإسلاميّ من حيث احتوائه على القوانين الثابتة والمتغيّرة يشبه المجتمع الديمقراطيّ، فالمجتمع الديمقراطيّ أيضاً يحتوي على قسمين من القوانين: أحدهما بحكم الثابت وهو
(60)القانون الدستوريّ أو القانون الأساسيّ الذي لا يمكن تغييره حتّى من قبل المجلس الشورى الشيوخ، بل إنّ الشعب هو الذي يمكنه إبطال بعض موادّه أو تغييرها بطريق التصويت العامّ أو تأسيس مجلس المبعوثين.
والقسم الثاني يحتوي على القوانين الجزئيّة التي تصوّت في المجلس الشورى، وتكون بمنزلة تفسير موادّ القانون الأساسيّ، وهذا القسم هو الذي يخضع للتغيير.
وفي الوقت نفسه يجب أن لا يتصوّر بأنّ طريقة الحكم الإسلاميّ طريقة ديمقراطيّة أو اشتراكيّة. . . لانّ واضع القوانين الثابتة في الإسلام هو الله تعالى. . . أمّا القوانين الثابتة في سائر النظم الإجتماعيّة فهي وليدة المجتمع والشعب.
وكذلك القوانين المتغيّرة في سائر النظم تخضع لإرادة الأكثريّة سواء كانت حقاً أم باطلاً، ولكن تغيير القوانين المتغيرة في المجتمع الإسلاميّ ـ مع كونها ناتجة من الشورى ورأي الناس ـ تخضع للحقّ، لا لميل الأكثريّة وعواطفها.
إنّ المجتمع الإسلاميّ يجب أن يعمل بالحقّ وبما هو صلاح الإسلام والمسلمين سواء طابق رأي الأكثريّة ام خالفه».
تبيّن ممّا مضى أنّ السّيد الطباطبائيّ يذهب إلى انحصار الحكومة في النبيّ صلىاللهعليهوآله ومن بعده في الأئمة:، لكن بالنسبة إلى زمن الغيبة فيذهب سماحته إلى أنّ أمر الحكومة الإسلاميّة إلى المسلمين من غير إشكال، لكن بشروط.
(61)
قال: «هذا كلّه في حياة النبيّ صلىاللهعليهوآله، وأمّا بعده فالجمهور من المسلمين يرون أنّ انتخاب الخليفة الحاكم في المجتمع إلى المسلمين، والشيعة من المسلمين على أنّ الخليفة منصوص من جانب الله ورسوله، وهم اثنا عشر إماماً على التفصيل المودوع في كتب الكلام.
ولكن على أيّ حال، أمر الحكومة الإسلاميّة بعد النبي صلىاللهعليهوآله وبعد غيبة الإمام ـ كما في زماننا الحاضر ـ إلى المسلمين من غير إشكال، والذي يمكن أن يستفاد من الكتاب في ذلك أنّ عليهم تعيين الحاكم في المجتمع على سيرة رسول الله صلىاللهعليهوآله، وهي سنّة الإمامة دون الملوكيّة والإمبراطوريّة، والسير فيهم بحفاظة الأحكام من غير تغيير، والتولّي بالشور في غير الأحكام من حوادث الوقت والمحلّ. . . والدليل على ذلك كلّه جميع ما تقدّم من الآيات في ولاية النبيّ صلىاللهعليهوآله، مضافة إلى قوله تعالى: (لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة)».
إنّ الشهيد الصدر عند تقويمه للمذاهب الاجتماعيّة التي تسود الذهنيّة الإنسانيّة اليوم والتي يقوم بينها الصراع الفكريّ أو السياسيّ، يدمج النظام الديمقراطيّ مع الرأسماليّة ويبحث عنهما معاً فيقول:
«قد قامت الديمقراطيّة الرأسماليّة على الإيمان بالفرد إيماناً لا حدّ له، وبأنّ مصالحه الخاصّة بنفسها تكفل بصورة طبيعيّة مصلحة
(62)المجتمع في مختلف الميادين، وأنّ فكرة الدولة إنّما تستهدف حماية الأفراد ومصالحهم الخاصّة فلا يجوز أن تتعدّى حدود هذا الهدف في نشاطها ومجالات عملها».
ثم يبدأ الشهيد الصدر في تبيين الركائز الأساسيّة التي قامت الديمقراطيّة الرأسماليّة عليها ويقول:
«يتلخّص النظام الديمقراطيّ الرأسماليّ في إعلان الحريات الأربع: السياسيّة، والاقتصاديّة، والفكريّة والشخصيّة.
فالحرية السياسيّة تجعل لكلّ فرد كلاماً مسموعاً ورأياً محترماً في تقرير الحياة العامّة للأمة: وضع خططها، ورسم قوانينها، وتعيين السلطات القائمة لحمايتها. وذلك لأنّ النظام الاجتماعيّ للأمة والجهاز الحاكم فيها مسألة تتصّل اتصالاً مباشراً بحياة كلّ فرد من أفرادها، وتؤثّر تأثيراً حاسماً في سعادته أو شقائه فمن الطبيعيّ حينئذٍ أن يكون لكلّ فرد حقّ المشاركة في بناء النظام والحكم.
وإذا كانت المسألة الاجتماعيّة مسألة حياة أو موت، ومسألة سعادة أو شقاء للمواطنين الذين تسري عليهم القوانين والأنظمة العامة، فمن الطبيعيّ أيضاً أن لا يباح الاضطلاع بمسؤوليتها لفرد أو لمجموعة خاصّة من الأفراد مهما كانت الظروف، ما دام لم يوجد الفرد الذي يترفّع في نزاهة قصده ورجاحة عقله على الأهواء والأخطاء.
فلا بدّ إذاً من إعلان المساواة التامّة في الحقوق السياسيّة بين المواطنين كافّة لأنّهم يتساوون في تحمّل نتائج المسألة الاجتماعيِّة،
(63)والخضوع لمقتضيات السلطات التشريعيّة والتنفيذيّة، وعلى هذا الأساس قام حقّ التصويت ومبدأ الانتخاب العامّ الذي يضمن انبثقاق الجهاز الحاكم بكلّ سلطاته وشعبه عن أكثريّة المواطنين.
والحرية الاقتصاديّة ترتكز على الإيمان بالاقتصاد الحرّ، وتقرّر فتح جميع الأبواب وتهيئة كلّ الميادين أمام المواطن في المجال الاقتصاديّ، فيباح التملّك للاستهلاك وللإنتاج معاً، وتباح هذه الملكيّة الإنتاجيّة التي يتكوّن منها رأس المال من غير حدود تقييد وللجميع على حدّ سواء، فلكلّ فرد مطلق الحرية في إنتاج أيّ أسلوب وسلوك أيّ طريق لكسب الثروة وتضخيمها ومضاعفتها على ضوء مصالحه ومنافعه الشخصيّة...
والحرية الفكريّة تعني أن يعيش الناس أحراراً في عقائدهم وأفكارهم، يفكّرون حسب ما يتراءى لهم ويحلو لعقولهم، ويعتقدون ما يصل إليه اجتهادهم أو ما توحيه إليهم مشتهياتهم وأهواؤهم بدون عائق من السلطة والإعلان عن أفكارهم ومعتقداتهم، والدفاع عن وجهات نظرهم واجتهادهم.
والحرية الشخصيّة تعبّر عن تحرّر الإنسان في سلوكه الخاصّ من مختلف ألوان الضغط والتهديد، فهو يملك ارادته وتطويرها وفقاً لرغباته الخاصّة مهما نجم عن استعماله لسيطرته هذه على سلوكه الخاصّ من مضاعفات ونتائج، ما لم تصطدم بسيطرة الآخرين على سلوكهم، فالحدّ النهائيّ الذي تقف عنده الحرية الشخصيّة لكلّ فرد حرية الآخرين، فما لم يمسّها الفرد بسوء فلا جناح عليه أن يكيّف حياته باللون الذي يحلو له، ويتبع مختلف العادات والتقاليد
(64)والشعائر والطقوس التي يستذوقها، لانّ ذلك مسألة خاصّة تتصّل بكيانه وحاضره ومستقبله، ومادام يملك هذا الكيان فهو قادر على التصرف فيه كما يشاء.. . .
ويتخلّص من هذا العرض أنّ الخطّ الفكريّ العريض لهذا النظام هو: أنّ مصالح المجتمع بمصالح الأفراد، فالفرد هو القاعدة التي يجب ان يرتكز عليها النظام الإجتماعيّ، والدولة الصالحة هي الجهاز الذي يسخّر لخدمة الفرد وحسابه، والإدارة القويّة لحفظ مصالحه وحمايتها.
هذه هي الديمقراطيّة الرأسماليّة في ركائزها الأساسيّة، التي قامت من أجلها جملة من الثورات وجاهد في سبيلها كثير من الشعوب والاُمم. . . وقد أجريت عليها بعد ذلك عدة التعديلات، غير أنّها لم تمسّ جوهرها بالصميم، بل بقيت محتفظة بأهمّ ركائزها وأسسها».
وبعد هذا العرض الموجز يسجّل الشهيد الصدر عدّة نقاط على هذا النظام الاجتماعيّ، وهي التي تشكل الركيزة الأساسيّة لرفض هذا النظام عند السيد الشهيد والحكم عليه بالفشل والانهيار، وهذه النقاط كالتالي:
1 ـ إنّ هذا النظام الذي هو ماديّ بحت، وقد أخذ الإنسان منفصلا عن مبدئه وآخرته ومحدوداً بالجانب النفعيّ من حياته الماديّة، لم يبن على فلسفة ماديّة للحياة وعلى دراسة مفصّلة لها، فالحياة في الجوّ الاجتماعيّ لهذا النظام فصلت عن كلّ علاقة خارجة عن حدود المادة والمنفعة، ولكن لم يهيّأ لإقامة
(65)هذا النظام فهم فلسفيّ كامل لعملية الفصل هذه، وهذا هو التناقض والعجز.
إنّ المسألة الاجتماعيّة للحياة تتّصل بواقع الحياة، ولا تتبلور في شكل صحيح إلّا إذا أقيمت على قاعدة مركزية تشرح الحياة وواقعها وحدودها، والنظام الرأسمالي يفقد هذه القاعدة، فهو ينطوي على خداع وتضليل أو على عجلة وقلّة اناة، حين تجمد المسألة الواقعيّة للحياة وتدرس المسألة الاجتماعيّة منفصلة عنها، مع أنّ قوام الميزان الفكريّ للنظام بتحديد نظرته منذ البداية إلى واقع الحياة التي تموّن المجتمع بالمادة الاجتماعيّة، وهي العلاقات المتبادلة بين الناس، وطريقة فهمه لها واكتشاف أسرارها وقيمها.
2 ـ إنّ مسألة الأخلاق في هذا النظام أقصيت من الحساب ولم يلحظ لها وجود، وتبدّلت مفاهيمها ومقاييسها، واُعلنت المصلحة الشخصيّة كهدف أعلى، والحريات جميعاً كوسيلة لتحقيق تلك المصلحة، فنشأ عن ذلك أكثر ما ضج به العالم الحديث من محن وكوارث ومآسٍ ومصائب.
3 ـ تحكّم الأكثريّة في الأقليّة ومصالحها ومسائلها الحيويّة، فإنّ الحرية السياسيّة كانت تعني أنّ وضع النظام والقوانين وتمشيتها من حقّ الأكثريّة، ولنتصوّر أنّ الفئة التي تمثّل الأكثريّة في الاُمّة ملكت زمام الحكم والتشريع، وهي تحمل العقليّة الديمقراطيّة الرأسماليّة،
وهي عقليّة ماديّة خالصة في اتجاهها ونزعاتها وأهدافها وأهوائها، فماذا يكون مصير الفئة الاُخرى؟ أو ماذا يُنتظر للأقليّة من حياة في ظلّ قوانين تشرع لحساب الأكثريّة ولحفظ مصالحها؟ وهل يكون من الغريب حينئذٍ إذا شرعت الأكثريّة القوانين على ضوء مصالحها خاصّة وأهملت مصالح الأقليّة، واتجهت إلى تحقيق رغباتها اتجاهاً مجحفاً بحقوق الآخرين؟ فمن الذي يحفظ لهذه الاقلية كيانها الحيوي ويذبّ عن وجهها الظلم، ما دامت المصلحة الشخصيّة هي مسألة كلّ فرد، وما دامت الأكثريّة لا تعرف للقيم الروحيّة والمعنويّة مفهوماً في عقليتها الاجتماعيّة ؟
هذا إضافةً إلى ما أدّت إليه الحريّة الاقتصاديّة، وأجازته من مختلف أساليب الشراء وألوانه مهما كان فاحشاً، فتكون بالنتيجة هي المسيطرة على الموقف والمُمسكة بالزمام وتقهر الحريّة السياسيّة أمامها.
لأنّ الفئة الرأسماليّة بحكم مركزها الاقتصاديّ من المجتمع، وقدرتها على استعمال جميع وسائل الدعاية، وتمكنها من شراء الأنصار والاعوان، تهيمن على تقاليد الحكم في الاُمّة وتتسلّم السلطة لتسخيرها في مصالحها، ويصبح التشريع والنظام الاجتماعيّ خاضعاً لسيطرة رأس المال، بعد أن كان المفروض في المفاهيم الديمقراطيّة أنّه من حقّ الاُمّة جمعاء، وهكذا تعود الديمقراطيّة الرأسماليّة في نهاية المطاف حكماً تستأثر به الأقليّة، وسلطاناً يحمي به عدد من الأفراد كيانهم على حساب الآخرين بالعقليّة النفعيّة التي يستوحونها من الثقافة الديمقراطيّة الرأسماليّة.
(67)ثمّ إنّ هؤلاء السادة الذين وضع النظام الديمقراطيّ الرأسماليّ في أيديهم كلّ نفوذ وزوّدهم بكلّ قوة وطاقة، سوف يمدّون أنظارهم إلى الآفاق، ويشعرون من مصالحهم وأغراضهم أنّهم في حاجة إلى مناطق نفوذ جديدة، وذلك لوجود الموادّ الأوّليّة فيها، وللعثور على أسواق جديدة لبيع المنتجات الفائضة، فيكون هذا مبرراً منطقيّاً عندهم للاعتداء على البلاد الآمنة، وانتهاك كرامتها والسيطرة على مقدّراتها.
4 ـ إنّ السبب الحقيقيّ لفشل الديمقراطيّة الرأسماليّة في تحقيق سعادة الإنسان وتوفير كرامته، يكمن في التفسير الماديّ المحدود للحياة الذي شيّد عليه الغرب صرح الرأسماليّة الجبار، فإنّ كل فرد في المجتمع إذا آمن بأنّ ميدانه الوحيد في هذا الوجود العظيم هو حياته الماديّة الخاصة، وآمن أيضاً بحريّته في التصرّف بهذه الحياة واستثمارها، وأنّه لا يمكن أن يكسب من هذه الحياة غاية إلّا اللذة التي توفّرها له المادة، وأضاف هذه العقائد الماديّة إلى حبّ الذات الذي هو من صميم طبيعته، فسوف يسلك السبيل الذي سلكه الرأسماليّون، وينفّذ أساليبهم كاملة. . . ، فالخطر الحقيقيّ على الإنسانيّة يكمن كلّه في تلك المفاهيم الماديّة، وما ينبثق عنها من مقاييس للأهداف والأعمال.
وبعد هذه الملاحظات يحكم السيد الشهيد بفشل الديمقراطيّة الرأسماليّة وانهيارها ويقول:«إن الديمقراطيّة الرأسماليّة نظام محكوم عليه بالانهيار والفشل المحقّق في نظر الإسلام، ولكن
لا باعتبار ما يزعمه الاقتصاد الشيوعيّ من تناقضات رأس المال بطبيعته، وعوامل الفناء التي تحملها الملكيّة الخاصة في ذاتها، لانَّ الإسلام يختلف في طريقته المنطقيّة واقتصاده السياسيّ وفلسفته الاجتماعيّة عن مفاهيم هذا الزعم وطريقته الجدليّة، بل إنّ مردّ الفشل والوضع الفاجع الذي منيت به الديمقراطيّة الرأسماليّة في عقيدة الإسلام إلى مفاهيمها الماديّة الخالصة التي لا يمكن أن يسعد البشر بنظام يستوحي جوهره منها، ويستمدّ خطوطه العامّة من روحها وتوجيهها.
فلا بدّ إذاً من معين آخر غير المفاهيم الماديّة عن الكون، يستقي منه النظام الاجتماعيّ، ولا بد من وعي سياسيّ صحيح ينبثق عن مفاهيم حقيقيّة للحياة، ويتبنى القضية الإنسانيّة الكبرى، ويسعى إلى تحقيقها على قاعدة تلك المفاهيم، ويدرس مسائل العالم من هذه الزاوية، وعند اكتمال هذا الوعي السياسيّ في العالم واكتساحه لكلّ وعي سياسيّ آخر، وغزوه لكلّ مفهوم للحياة لا يندمج بقاعدته الرئيسيّة، يمكن أن يدخل العالم في حياة جديدة مشرقة بالنور عامرة بالسعادة.
إن هذا الوعي السياسيّ العميق هو رسالة الإسلام الحقيقيّ في العالم، وانّ هذه الرسالة المنقذة لهي رسالة الإسلام الخالدة التي استمدّت نظامها الإجتماعيّ، المختلف عن كلّ ما عرضناه من أنظمة، من قاعدة فكريّة جديدة للحياة والكون».
ولكن يلاحظ على هذا الاتجاه:
أولاً: إعطاء رؤية اُحاديّة وتفسير اُحاديّ للديمقراطيّة، ألا هي التي شهدها الغرب ومارسها ومزجها مع ثقافته الماديّة والالحاديّة، فهؤلاء زعموا أنّ ما حدث في الغرب من تمزّق والحاد وبعد عن الدين، إنّما جاء من الديمقراطيّة، ولم يتصوّروا إمكان إعطاء رؤية ثانية وتفسير ثان لها يمكن معها الجمع بين الاسلام أو الدين والديمقراطيّة، وذلك ربما يكون لشدّة الغزو الثقافيّ الذي واجهه العالم الإسلاميّ آنذاك وما اقترن به من نهب ثروات المدن الإسلاميّة واحتلال بعضها والإفساد فيها، ممّا أدّى الى تصادمات شديدة وحالة نفسيّة قويّة لكلّ ما جاء من الغرب بما يحمله من فساد وتحلّل ومسخ للهويّة الاسلاميّة، ومنه الديمقراطيّة حيث ولدت هناك وامتزجت بثقافة أمها الماديّة ووصلت الى البلدان الإسلاميّة بتلك الصورة.
فكان من الطبيعيّ الوقوف أمامها ورفضها رفضاً باتّاً، لأنّ الالتزام بهذا التفسير الأحاديّ للديمقراطيّة يعني التخلّي عن جميع القيم والمبادئ الإسلاميّة، وهذا ما لا يقبله أيّ مسلم ملتزم، ولكن لو ميّزنا بين أصل الديمقراطيّة كآلية وطريقة للعمل السياسيّ، وبين ما امتزجت به من ثقافة الغرب، لأمكننا التفاهم والوصول الى نتيجة أخرى، وهذا ما سنبيّنه في الفصل الخامس إن شاء الله تعالى.
ثانياً: إنّ جعل الديمقراطيّة وإدخالها في حكم الجاهليّة، حيث تعطي حقّ التشريع للناس دون الله تعالى، ينبع من تلك النظرة الأحاديّة ـ كما قلنا ـ حيث ترى أنّ تشريع الناس يتنافى مع التشريع الإلهيّ مطلقاً ويكون في عرضه، ولا يمكن إعطاء أيّ تفسير آخر غير هذا.
ولكن يمكننا الالتزام بالديمقراطيّة من جهة، وجعل تشريع
(70)الناس في طول الشريع الإلهي لا في عرضه من جهة ثانية، بمعنى أنّ الديمقراطيّة كمفهوم سياسيّ وطريقة للعمل السياسيّ تعطي حقّ التشريع والتقنين للناس، وبما أنّ الناس في البلدان الإسلاميّة مسلمون كلّهم، ويريدون الالتزام بالإسلام والحكم الالهيّ، يشرّعون لأنفسهم ما شرّعه الله تعالى لهم، وسيكون تشريعهم في طول تشريع الله تعالى، وهذا سيكون شرعيّاً من جهة وديمقراطيّاً من جهة ثانية وأما لو خالفوه، وكان في عرضه ومعارضاً له فإنّه سيكون باطلاً من وجهة نظر أيديولوجيّة وكلاميّة.
وهذا لا يخالف مبادئ الديمقراطيّة إطلاقاً، فإنّ الديمقراطيّة لا تنفي الالتزام بأيّ فكرة أو فلسفة أو أيديولوجيّة، كيف ونحن نرى أنّ العالم الغربيّ يلتزم بالديمقراطيّة مع التزامه التامّ بفلسفات مختلفة وأيديولوجيات متنوعة.
ثالثاً: أمّا ما يقال عن تناقضات الديمقراطيّة، وما تحمله في طيّاتها من فساد وتحلّل وخلاعة، وظلم للأقليّة، فانّ بعضها لا يختصّ بالديمقراطيّة بل يكون في سائر النظم أيضاً، إضافةُ إلى أنّ كثيراً منها نتيجة تلك الثقافة والأيديولوجيّة التي امتزجت معها الديمقراطيّة كالماديّة والرأسماليّة والليبراليّة.
(71)
وهؤلاء أيضاً يختلفون فيما بينهم نوعاً ما، وكلّ واحد منهم يعبّر عن رأيه ومعتقده بصورة مستقلّة، ولكنّ القاسم المشترك عند أكثرهم هو أنّ أمر الحكومة وتعيين الحاكم ـ سواء في زمن حضور المعصوم أو في غيبته ـ إلى الناس، وربما كانت بعض هذه الآراء متشابهة ومتقاربة، وإنّما أوردناها أمّا لكون الكاتب من المفكّرين المعروفين، أو لاحتواء بحثه على أسلوب يختلف عن غيره مع اتّحاد الفحوى.
ويبدو أنّ هذا الاتّجاه بدأ يفرض نفسه شيئاً فشيئاً على المفكّرين، وأصبح تياراً قويّاً بعد ما كان مغموراً.
وممّن ذهب إلى هذا الرأي:
إنّ الحكومة في منظار الأستاذ الدكتور الحائريّ ليست بمعنى الحاكميّة، بل مشتقة من الحكمة بمعنى تدبير الأمور، ولذا «إنّ الحكومة بمنزلة الوكيل للمواطنين، وليست شيئاً آخر وراء الوكالة، والوكالة بدورها عقد جائز».
الدكتور الحائريّ يرى أنّ هذه النظريّة تتضمّن الديمقراطيّة الحقيقيّة، ولذلك يذهب إلى نقد الديمقراطيات الموجودة وخصوصاً نظرية العقد الاجتماعيّ ويقول:
«إنّ الحكومة في نظري بعد نقد الرؤية الديمقراطيّة الموجودة، وأعتقد أنّها هي الديمقراطيّة الحقيقيّة، هي الحكومة القائمة على مفهوم الوكالة، وبشكل عامّ فإنّ الحكومة الإسلاميّة بهذا المعنى تتضمّن الديمقراطيّة الحقيقيّة».
ونحن هنا نسعى إلى بيان خلاصة نظره حول الحكومة والديمقراطيّة، قال:
«إنّ الحكومة والحكم جاءت بمعانٍ كثيرة، ولا يمكن ترجيح أحد المعاني على الآخر بدون قرائن حاليّة ومقاليّة، ولا يمكن أن نختار أحد هذه المعاني كما نحبّ ونجعله موضوعاً للبحث.. .
لأنّ السياسة وفنون إدارة الدولة من الفروع الأصليّة للحكمة العمليّة، ومن جهة اُخرى فإنّ الحكم والحكومة في الاصطلاح المنطقيّ بمعنى العلم التصديقيّ بحقائق عالم الوجود كما هو موجود، وعلى هذا يجب أن نطمئنّ أولاً على أنّ مصطلح الحكومة المستعمل في أمر السياسة، وإدارة الدولة، والذي يقال في سياسة المدن ناشئ عن التدبير والحكمة، وليس بمعنى الأمر والنهي مطلقاً وبمعان اُخرى، فكيف بمعنى الولاية والقيوميّة. . .
وإذا كانت الحال كذلك، وكانت الحكومة بمعنى الحكمة والمعرفة لا بمعنى الأمر والنهي وإعمال القدرة، إذاً فمن المعلوم أنّ
(73)الولاية والحاكميّة تخرج كلّيّاً عن دائرة الدلائل المطابقيّة والتضمّنيّة والإلتزاميّة لمفهوم الحكومة، ويكونان من قبيل لفظين ومفهومين متغايرين، من دون أن تكون مناسبة وضعيّة حتى مناسبة حقيقيّة أو مجازيّة بينهما».
الدكتور الحائريّ يرى أنّ سبب تشكيل الحكومة من قبل أفراد المجتمع تعود إلى الضرورات الطبيعيّة والتجريبيّة، ولا يحتاج إلى جعل ووضع:
«إنّ ما نفهمه من الحياة الطبيعيّة للإنسان هو أنّ كلّ واحد شخصيّ من جنس الإنسان ونوعه الطبيعيّ، يتمتّع بقوى وغرائز ـ كسائر الحيوانات ـ لانتخاب المكان الذي يعيش فيه، وعلى أساس هذا القانون الطبيعيّ الموجود في فطرة كلّ واحد من أفراد البشر من قبل الله تعالى، فإنّه في البداية يختار المحلّ المناسب لحياته.
وبما أنّ انتخاب هذا المكان المذكور هو انتخاب طبيعيّ من كلّ جهة، وكذلك ليس مسبوقاً بانتخاب شخص آخر، فإنّ المكان المنتخب المذكور يتعلّق به طبيعياً ويختصّ به، ويكون هو المالك الحقيقيّ له بلا معارض.
وهذا القانون يوضح لنا أنّ كلّ شخص حاز مكاناً مناسباً لمعيشته، من دون أن يكون ذلك المكان تحت تصرّف الآخرين وحيازتهم سابقاً، فإنّه من الطبيعيّ أن يكون مالكاً له، وهذا القانون هو قانون فطريّ من الأساس، حيث إنّ الحاجة الطبيعيّة للبدن الحيّ المتحرّك للإنسان، تتعلّق بمكانه الذي يعيش فيه، ويكون ذلك
(74)بشكل قانون طبيعيّ، وليس له أيّ ربط بالوضع والتقنين الاجتماعيّ والشرعيّ حتى بإرادة العقلاء.. . .
فالإنسان، كما هي الحال في سائر الحيوانات، عندما يختار الاستقرار في مكان طبيعيّ وخصوصيّ ومنحصر به، يُدرك بعد ذلك بغريزته أنّ هذا المكان الصغير إذا كان مغلقاً من كلّ جهة وغير قابل للنفوذ، فسيتحوّل هذا الكوخ إلى مقبرة، ولذا فإنّ ضرورة الحياة في هذه المرحلة أيضاً تتطلّب أن يكون لهذا البيت أو الكوخ المذكور نافذة إلى الفضاء الخارجي، لكي يُؤمَّن له ما يحتاج إليه من الطعام والشراب والإمكانات الاُخرى لحياته.
وفي هذه الأثناء يكون هناك بطبيعة الحال تعلّق وارتباط خاصّ بين المكان الصغير وبين الفضاء الكبير المفتوح، ويتضح هناك تفاوت بيّن بين المكان الأوّل والثاني، فالتعلّق بالمكان الأوّل كان بشكل منحصر وخاصّ جداً وانفراديّ، أمّا التعلّق بالمكان الثاني فهو بالرغم من كونه خصوصيّاً وشخصيّاً، ولكنّه خارج عن إطار الانحصار الفرديّ، ويتصف بالمالكيّة الشخصيّة المشاعة وغير الانحصاريّة.
وهذا الاختلاف والتفاوت في درجة التعلّق في دائرة المالكيّة، يظهر من التفاوت بين ضرورة الحياة في البيت وخارج البيت، وليس له أيّ ارتباط بالوضع أو التقنين أو الإرادة الجمعيّة حتّى إرادة العقلاء وإدراكهم.
وعلى هذا الأساس ولهذه الضرورات الطبيعيّة الفيسيولوجيّة
(75)نفسها، فإنّ الأشخاص الآخرين أيضاً سواء في مكان قريب أو بعيد، يختارون لهم مكاناً خصوصيّاً للسكن، وكلّ واحد منهم أيضاً له تعلّق خصوصيّ وانحصاريّ في دائرة المالكيّة بمكان شخصيّ وفرديّ صغير جداً، وذلك بسبب عامل الضرورة الطبيعيّة والفيسيولوجيّة، وله تعلّق آخر بالمكان الحرّ والمشترك في خارج بيته، وهو نوع من المالكيّة المشاعة وغير الانحصاريّة».
«إنّ التعلّق والاختصاص الذي يحصل عليه الإنسان كبقية الأفراد في المرحلة الاُولى من الحياة بالنسبة إلى المكان الطبيعيّ، وكذلك التعلّق والارتباط في المرحلة الثانية بالنسبة إلى المكان الواسع الذي يتردّد فيه، فكلاهما يرتبطان بنوع من المالكيّة الشخصيّة، ولكن أحدها «المالكيّة الشخصيّة الانحصاريّة» والآخر «المالكيّة الشخصيّة المشاعة».
وهنا يجب الالتفات إلى هذه النقطة، وهي أنّ حقّ المالكيّة بشكل عامّ ينتزع من هذا التعلّق واختصاص شيء بشيء آخر، بحيث يكون الشيء الآخر تحت حاكميّة الشيء الأوّل، ويجب أن تكون للأول ـ أي المالك ـ رابطة الحاكميّة والعلوّ على الشيء المملوك. . .
وعلى هذا الأساس فإنّ حقّ مالكيّة الإنسان بالنسبة إلى المكان الطبيعيّ الذي يعيش فيه، هو من الحقوق الطبيعيّة والتكوينيّة، ولا يمكن أن يكون قابلاً للجعلِ والوضع والتقنين، فعلى سبيل المثال فإنّ حقّ التعقّل والتفكّر الحرّ هو من الحقوق التي تنبع من القوة الفكريّة الطبيعيّة في الإنسان، وهي القوة التي تميّز ماهيّة الإنسان عن غيره من
(76)الحيوانات، فمثل هذا الحقّ ثابت في ذات كلّ فرد من الناس، ولا يتغيّر ولا يحتاج إلى وضع وتقنين من قبل المجامع القانونيّة. . . .
وكلا هذين النحوين من الملكيّة الخصوصيّة: الإنحصاريّة والمشاعة، بما أنّها كانت بمقتضى الدوافع الطبيعيّة الفيسيولوجيّة في الإنسان، فهي غير قابلة للوضع والتشريع، وبهذا السبب أيضاً أي بسبب عدم قبولها للوضع والتشريع، فهي غير قابلة للحذف والسلب القانونيّ.
وكلّ أنحاء إعمال القوة والقدرة ـ سواء من قبل الحكومة أو من قبل العوامل الأخرى ـ غير إعراض نفس المالك الأصلي والحقيقيّ عن ملكه الخصوصيّ، سيكون ظلماً وجوراً ومصادرة، أو سلباً لهذا الحقّ والملكيّة الطبيعيّة. فهذه من الحقوق الطبيعيّة التي تتعلّق بالإنسان ليس من جهة كونه إنساناً، بل من جهة كونه جسماً متحركاً حيّاً».
وعلى هذا فالإنسان مع تمتّعه بهذا الحقّ الطبيعيّ، وبمساعدة عقله العمليّ وقوّته الفكريّة، يصل إلى هذه النتيجة وهي:
«إنّه وجميع الأفراد الذين يعيشون مثله، يتمتّعون بالملكيّة المشاعة للأرض، وبمساعدة العقل العمليّ يعطون الوكالة والأجرة لشخص أو هيئة، لتصرف جميع وقتها وإمكاناتها للمحافظة على حياة الأفراد السلميّة في ما بينهم على هذه الأرض، وتبذل كلّ جهدها في هذا السبيل، وإذا لم تتّفق آراء المالكين المشاعين في بعض الأحيان على اختيار شخص معيّن، فالطريق الثاني والوحيد هو تحكيم الأكثريّة في الاقليّة. . .
(77)وجميع هذه القضايا تكون على أساس الاستقلال الكامل للفرديّة، والشخصيّة الحقيقيّة لأفراد الإنسان، حيث يكون العقل العمليّ في كلّ فرد هو الذي يهدي إلى هذا السبيل».
«فعلى هذا فانّ الحكومة ليست أكثر من وكالة ونيابة عن المالكين الحقيقيّين وهم المواطنون، ومعلوم أنّ عقد الوكالة والنيابة يكون دائماً في يد الموكلين واختيارهم من كلّ النواحي، لأنّ الوكالة كما يقول الفقهاء: هي عقد جائز في ماهيّتها وغير لازم، والموكل أو الموكلون يستطيعون في كلّ زمان يريدون فسخ هذه الوكالة من طرف واحد، والوكيل أيضاً يكون دائماً تحت نظر الموكل وإشرافه، وعليه أن يؤدّي الوظائف والمسؤوليّات في دائرة وكالته، وليس له حقّ التجاوز عن إطار وحدود هذه الوكالة والنيابة».
يلاحظ على ما ذكره الشيخ الحائريّ أمور:
1 ـ قوله: «إنّ مصطلح الحكومة المستعمل في أمر السياسة ناشئ عن التدبير والحكمة، وليس بمعنى الأمر والنهي مطلقاً» فلو سلّمنا بصِحّته لكنّ هذه الحكومة عند التطبيق على أرض الواقع ستحتاج إلى الأمر والنهي وإعمال الولاية، وإلّا فستكون فاشلة، فالأمر والنهي وإعمال الولاية من لوازم أيّ حكومة وبأيّ معنى فسّرت.
2 ـ لكون الحكومة من الضروريات والحقوق الطبيعيّة للإنسان، فإنّه لا يمكن أن تخضع لأيّ جعل ووضع، أول الكلام فكم من حقّ طبيعيّ وضرورة طبيعيّة خضعت للجعل والتشريع، أليس الدين ضرورة طبيعيّة للانسان مع خضوعه للجعل والتشريع ؟! نعم نحن لا ندعي لزوم الجعل والتشريع في جميع مفاصل الحكومة وجزئيّاتها المتغيّرة بتغيّر الزمان والمكان، بل نعتقد أنَّ هناك بعض الثوابت التي لا بد من مراعاتها واعتبارها وعدم مخالفتها عندما يترك الإنسان في دائرة الجزئيات والمتغيّرات.
3 ـ نحن لا نقصد بالحاكميّة الإلهيّة لزوم تدخّل الوحي في جميع شؤون الناس، وكيفيّة سلوكهم السياسيّ والاجتماعيّ حتّى كيفيّة العبور من الشارع والسياقة وما شاكل، فإنّ هذه أمورٌ ترك اختيارها للناس ـ كما قلنا ـ وإنّما نقصد بالحاكميّة الإلهيّة ما دلّت عليه الآية الكريمة من قوله تعالى: (لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ).
فإنّه تعالى أرسل الرسل بالبينات الدينيّة والدنيويّة، وأنزل معهم الكتاب والميزان إيضاحاً للطريق الصحيح، فالله إذاً هو الذي أرسلهم ونصبهم لهذين المنصبين أي الزعامة الدينيّة والسياسيّة من دون انفصال بينهما، ولم تدلّ الآية على أنّ الزعامة الدينيّة تكون بالنصّ والنصب، والسياسة بالاختيار والانتخاب، نعم على الناس تفعيل وتطبيق هذين المنصبين على أرض الواقع بالقبول والبيعة، وهذا مفاد قوله تعالى: (لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ).
ومقتضى قاعدة اللطف إنّما هو تهيئة الأسباب التي تقرّب العباد
(79)إلى مصالحهم الحقيقيّة وتبعدهم عمّا يضرهم، وهذا يتحقّق بنحو أكمل فيما لو اندمجت الزعامة الدينيّة والسياسيّة معاً، بخلاف ما لو انفصلتا.
يشير الدكتور سروش في أماكن متعدّدة من كتبه إلى الديمقراطيّة، ويبحث عنها في كلّ مقطع من مقاطعها، ونحن في هذا البحث نسعى للإشارة إلى آرائه.
يرى الدكتور سروش أنّ الحكومة لها معنى مستقلٌ عن الدين، وهي أمر غير دينيّ، كما هي الحال في الذهاب إلى المدرسة والأكل والشرب، التي هي اُمور غير دينيّة، لأنّ هذه الأمور تعتبر جزءاً وشأناً من الشؤون البشريّة، فالإنسان بمجرد كونه إنساناً يرتبط بمثل هذه الروابط.
فهذه الأمور تحديداً غير دينيّة، يعني أنّها متعلّقة ومرتبطة بالبشريّة، فلم يأت دين من حيث المجموع يقول: كلوا واشربوا أو لا تأكلوا ولا تشربوا، فَتدخُّل الدين في هذه الأمور قد يكون في دائرة تحديد السلوك البشري وحسب، بأن يقول: كلوا ولكن لا تأكلوا الشيء الفلاني، مثلاً كلوا ولكن لا تأكلوا بالباطل، فهذه الأمور غير الأمور التأسيسيّة. . .
فالدين لا يقوم بتأسيس الحكومة، والحكومة أمر موجود في جميع المجتمعات البشريّة، فهي أمر غير الصلاة مثلاً وتختلف
(80)عنها فالدين قد وضع وجعل الصلاة وأسّسها، ولكنّ الحكومة ليست لها هذه الحالة، ولذا لا يقال لو لم يأت الدين لم تتشكّل أيّ حكومة في العالم.
وببيان آخر فإنّ بحث الحكومة أساساً بحث خارج عن دائرة الفقه حتّى خارج عن دائرة الدين، ويجب الحصول على أحكامها وتكاليفها في ميادين غير دينيّة وغير فقهيّة. ولذا يجب علينا في البداية تنقيح قراءتنا عن الإنسان، ثمّ نتّجه نحو النظريات السياسيّة.
وبما أنّ الحكومة أمر خارج دائرة الدين، لذا فانّ الحكومات تنقسم إلى قسمين فحسب: إمّا ديمقراطيّة وإمّا غير ديمقراطيّة، والحكومة الدينيّة وغير الدينيّة تأتي بعد ذلك وبمرتبة ثانية، وعلى هذا الأساس فانّ النظام الديمقراطيّ في العصر الحاضر قطعاً أقرب إلى العدالة من الأنظمة غير الديمقراطيّة تحت أيّ عنوان.
والآن وقد عرفنا رأي الدكتور سروش بالنسبة إلى الحكومة ومعنى الحكومة الدينيّة، ننظر أيضاً إلى رأيه بالنسبة إلى الديمقراطيّة والدين، برغم أنّه تحدّث عن ذلك من زوايا مختلفة ومتعدّدة.
يعرّف الدكتور سروش الديمقراطيّة بقوله: الديمقراطيّة هي أسلوب لتحديد قدرة الحكّام، وعقلنة الحكومة في دائرة التدبير والسياسة، حتّى تصل الأخطاء الى الحدّ الأدنى، ويجري إصلاح
المفاسد وإدارة الأمور بالنصح والشورى والتعاون، فلا يحتاج بعدها إلى استخدام القوة والثورة، بل يُعزَل الحكام الفاسدون من دون التوسّل بأدوات القسوة والقوة.
وأمّا تفكيك القوى الثلاث، التعليم العموميّ الاجباريّ، تقوية الصحف والمجّلات ووسائل الإعلام وعدم انحصارها في يد الدولة، حريّة البيان والكلام والنقد، وجود أنواع كثيرة من الشورى في سطوح مختلفة، الأحزاب، الانتخابات العامّة، والبرلمان، تعتبر كلّ هذه مناهج لتحصيل وتأمين الديمقراطيّة.
الديمقراطيّة ترى أنّ إشراف الناس على عمل الحكّام، إنّما هو من حقوقهم الإنسانيّة الخارجة عن دائرة الدين، وتعتقد أيضاً انّ هذا الأشراف واجب وضروريّ لتصحيح عمل الحكّام.
إنّ الديمقراطيّة هي منهج سياسيّ لإدارة الأمور من أجل تقليل الأخطاء في دائرة المديريّة، وعزل الحكام من دون الحاجة إلى استخدام القوة، ومن أجل جذب الإصلاحات والتحوّلات والأفكار الجديدة بدون خوف من زعزعة النظام وبدون حاجة إلى الثورة، ومن أجل التوزيع الصحيح للقدرة على مستوى المجتمع بصورة عامّة، ومن أجل أن لا تكون القرارات متراكمة ومتجمّعة في نقطة واحدة، ومن أجل رعاية حقوق الأفراد، والتخلّص من الجزميّة في مقام كسب العلوم، وللاستفادة من آراء الآخرين.
يلاحظ على ما ذكره الدكتور سروش أمور:
1 ـ إنّ العمدة في رأيه فصل الدين عن السياسة، وجعل الحكومة أمراً غير ديني، وسنتكلّم عن هذا الأمر فيما بعد.
2 ـ يتّفق الدكتور سروش مع الشيخ الشبستريّ في جعل الديمقراطيّة وسيلة وآليّة للعمل السياسيّ لا أكثر، وإنّ التجربة الدينيّة هي المحور والأساس في التديّن فلا بد من فسح المجال أمامها وتغيير الأحكام والفتاوى لمصلحتها بالاجتهاد المستمرّ والجديد، وهذا هو الاجتهاد في مقابل النصّ المرفوض عقلاً وشرعاً، وحال من يدعو إليه حال المريض الذي يتلاعب بأوامر الطبيب الصحّيّة، فيزيد عليها وينقص بما يشاء بحجج واهية. والاجتهاد المقبول هو الذي يكون في طول النص لا في عرضه.
3 ـ إنه قال:«إنّ إحدى المقدمات اللازمة للحصول على حكومة دينيّة ديمقراطيّة جعل الفهم الديني سيالاً» ومفاد هذا الكلام أنّ أصول الديمقراطيّة ثابتة لا يتطرقها التغيير بخلاف الأحكام والفتاوى الدينيّة فإنّها متغيّرة وهذا غير صحيح فلماذا لا نعكس القضيّة ونقول: «إنّ أحد اللوازم للحصول على حكومة دينيّة ديمقراطيّة جعل الفهم الديمقراطيّ سيالاً وتغيير بعض مقوّماته لمصلحة الدين»؟!
4 ـ إنّ إفراغ الحكومة الدينيّة من أيّ محتوى، وجعلها مرتبطة بالوضع الخارجيّ للناس فإذا كانوا متدينين كانت الحكومة دينيّة وإلّا فلا، فغير صحيح فإنّ للحكومة الدينيّة ضوابط واُسساً مستقلّة عن تحقّقها الخارجيّ، فهي بمثابة القضيّة الحقيقيّة لا الخارجيّة،
وثانياً لا تلازم بين أن يكون المجتمع دينيّاً وأن تكون الحكومة دينيّة أيضاً، فربَّ مجتمعٍ متديّنٍ تحكمه حكومة غير دينيّة، فتديّن الشعب لا يجعل هذه الحكومة دينيّة ما لم تعمل بمقتضى دين الناس وتأخذ قوانينها من واقع الدين.
هذا ونحن أيضاً نعتقد بأنّ الحكومة الدينيّة غير مكلّفة لتجرّ الناس الى الجنّة بالسلاسل، وأنّها لا تجبر على التديّن ولا تعاقب على عدم التديّن، فكم من ملحدٍ غير متديّن يعيش في ظلّ الحكومة الدينيّة بحرية وأمان، نعم هذا لا يعني عدم وجود عقوبات دينيّة رادعة للمتمرّدين والمخالفين الذين يعيثون في الأرض فساداً.
5 ـ إنّ المؤلّف يرى تارة لزوم البحث عن الدين والديمقراطيّة في خارج دائرة الدين، ويذهب تارة أخرى الى خلافه ويقول: «إنّ البحث في باب الجمع بين الدين والديمقراطيّة يجب أن ينبع من جذور وجوهر الدين» أي داخل دائرة الدين، ثم يفسّر جوهر الدين بالتجربة الدينيّة المبنيّة على الفهم السيال للدين، والتي لا تكون عن إجبار وإكراه، فحينئذٍ أيّ فرق بين خارج دائرة الدين أو داخله، ولماذا هذا التمييز الذي ذكره ؟ ثم أيّ فرق بين هذا الدين وبين سائر النظم والقوانين البشريّة التي يضعها البشر بمعزل عن الوحي ؟ ولماذا هذا اللفّ والدوران، فليتركوا الدين رأساً ويتكلموا بما يشاءون.
يقول الدكتور الجابريّ: «الديمقراطيّة اليوم ليست موضوعاً للتاريخ، بل هي قبل ذلك وبعده ضرورة من ضرورات عصرنا،
(84)أعني أنّها مقوّم ضروريّ لإنسان هذا العصر، هذا الإنسان الذي لم يعد مجرّد فرد من رعيّة، بل هو مواطن يتحدّد كيانه بجملة من الحقوق هي الحقوق الديمقراطيّة التي في مقدّمتها الحق في اختيار الحاكمين ومراقبتهم وعزلهم، فضلا عن حقّ الحريّة، حرية التعبير، والاجتماع، وإنشاء الأحزاب، والنقابات، والجمعيّات، والحقّ في التعليم والعمل، والحقّ في المساواة مع تكافؤ الفرص السياسيّة والاقتصاديّة.
وإذاً فالمسألة الديمقراطيّة يجب أن ينطلق النظر إليها لا من إمكانية ممارستها في هذا المجتمع أو ذاك، بل من ضرورة إرساء أسسها، وإقرار آلياتها، والعمل بها بوصفها الإطار الضروريّ لتمكين أفراد المجتمع من ممارسة حقوق المواطنة من جهة، وتمكين الحاكمين من الشرعية الحقيقيّة التي تبرّر حكمهم من جهة اُخرى».
ثمّ يتساءل الدكتور الجابريّ: لماذا الديمقراطيّه ؟ ويجيب: إنّ طرح هذا السؤال يجب أن يستهدف أبعاد الديمقراطيّة ونتائجها لا مجرّد صياغة تعريف لها، ذلك انّه قد يتوهّم أنّ الهدف من الديمقراطيّة يتلخّص كلّه في تعريفها، وهو حكم الشعب نفسه بنفسه، أو في أضعف الأحوال: الحكم بارادة الشعب.
وقد يحدث أن نرى إرادة الشعب تشوّه وتزوّر أثناء الانتخابات، أو داخل المجالس النيابيّة نفسها، كما قد نرى هذه المجالس تقرّر قوانين تكبّل حريّة أفراد الشعب، أو تثقل كواهلهم بالضرائب، أو
(85)من شأنها أن تزيد الفقير فقراً والغني غنى، أو نراها تصادق على معاهدات ترهن سيادة الوطن أو تفرّط في حقّ من حقوقه.
قد يحدث هذا كلّه باسم الديمقراطيّة التي نتوهّم كما قلنا أنّ حقيقتها والهدف المقصود منها هو الحكم بإرادة الشعب، فتكون النتيجة المحتومة هي الكفر بالديمقراطيّة، ويصبح من الضروريّ صدّ الناس عنها وطرح شعارات بديلة.
فالمطلوب إذاً من الديمقراطيّة إحداث انقلاب في شتّى المجالات الفكريّة والاجتماعيّة، لا مجرّد الركون والرضى إلى تعريف الديمقراطيّة من دون نظر الى النتائج، يقول الجابريّ:
«إنّنا عندما نطالب بالديمقراطيّة في الوطن العربيّ، فانّما نطالب في الحقيقة بإحداث انقلاب تاريخيّ لم يشهد عالمنا، الفكريّ ولا السياسيّ ولا الاجتماعيّ ولا الاقتصاديّ له مثيلاً، وإذاً فلا بدّ من نفس طويل، ولا بد من عمل متواصل، ولا بدّ أيضاً من صبر أيوب.... فالديمقراطيّة في مجتمعاتنا العربيّة، ليست قضية سهلة، ليست انتقالاً من مرحلة إلى مرحلة، بل هي ميلاد جديد وبالتأكيد عسير».
من جملة هذا الانقلاب الذي يدعو إليه الدكتور الجابريّ، القول بالشراكة في الحكم، يقول: «لقد تميّز وضع الدولة في الوطن العربيّ، في الماضي كما في الحاضر، بنفي الشريك عن الحاكم، وهذا في حين أنّ الديمقراطيّة في جوهرها ليست شيئاً آخر غير المشاركة في الحكم.
إنّ الإيمان بوحدانيّة الإله هو حجر الأساس في عقيدتنا الدينيّة، وهذا ما يجب أن نحافظ عليه، ولكن مع الإيمان بأنّ كلّ شيء بعد الله متعدّد، ويجب أن يقوم على علّة التعدّد، وفي مقدّمة ذلك الحاكميّة البشريّة التي يجب أن نسلب عنها سلباً قاطعاً باتاً صفة الوحدانيّة.
وإذاً فما دمنا نحن العرب والمسلمين لا نؤمن بضرورة قيام الشريك في الحكم والسياسة، إيماناً بضرورة نفيه في ميدان الألوهيّة والربوبيّة، فإنّنا لا نستطيع أن نعطي للديمقراطيّة معنى، ولا لمضمونها أبعاداً فكريّة واجتماعيّة واضحة».
ويقول أيضاً: «لنسجّل ثانياً إذاً، أنّ من مظاهر الانقلاب التاريخيّ المطلوب من الديمقراطيّة إحداثه في الوطن العربي، انقلاب قوامه إحلال الولاء للفكرة وللاختيار الأيديولوجيّ الحزبيّ محلّ الولاء للشخص، حيّاً كان أو ميتاً، شيخاً لقبيلة كان أو رئيساً لطائفة، وإحلال التنظيم الحزبيّ المتحرّك محلّ التنظيم الطائفيّ والعشائريّ الجامد، كلّ ذلك وصولاً إلى تحقيق انتقال سليم للسلطة بمعناها الواسع. . .».
وبعد هذا فإنّ الجابريّ لا يرتضي بما يفعله «روّاد الفكر الفلسفيّ الإصلاحيّ» حيث زعموا أنّ الديمقراطيّة هي الشورى، إذاً هي ليست شيئاً جديداً على الاسلام بل هي من صميم أسسه ومقاصده.
يقول: «عندما بدأ العرب في الاحتكاك مع الغرب وفكره الليبراليّ،
وكان ذلك في القرن الماضي، عمد فريق منهم ـ وخصوصاً أولئك الذين أطلق عليهم فيما بعد اسم السلفيون ـ إلى البحث لكلّ مفهوم من المفاهيم الليبراليّة الاُروبيّة عمّا يوازنه أو يقاربه في الفكر العربيّ الإسلاميّ القديم.
وإذا كانوا قد وجدوا في كثير من الأحيان صعوبات عنيدة حالت دونهم ودون نجاح في عمليّة الموازنة والمقاربة تلك، فإنّهم لم يجدوا أيّة صعوبة، وعلى الأقلّ لم يشعروا بأيّ تردّد في المطابقة بين مفهوم الديمقراطيّة الاُروبيّ ومفهوم الشورى الإسلاميّ».
ويردّ عليهم بأنّ «الشورى هي أخذ الرأي من مأخذه، أي ممّن هو أهل لأن يؤخذ منه، وأخذ الرأي لا يعني مطلقاً وجوب الالتزام به تماماً، كما أنّ من يؤخذ منهم الرأي غير معينين ولا محصورين. وإذاً فالشورى ليست غير ملزمة للحاكم وحسب، بل إنّ أهلها غير مضبوطين أيضاً، وانّما يجمعهم تعبير (أهل الحلّ والعقد)، والمقصود بهم كلّ من له سلطة ما في المجتمع: علميّة أو اجتماعيّة أو اقتصاديّة أو دينيّة، ولكن دون تحديد لا للكمّ ولا للكيف ولا للجهة ولا للزمن.
هذا عن معنى الشورى كما يتحدّد في المرجعيّة اللغويّة، أمّا سياق الآيتين فهو لا يفيد الأمر بمعنى الوجوب، وهذا ما يتّضح من كلام المفسّرين. . .».
وعليه «تبقى مسألة الشورى في الإسلام من باب النصيحة، من
باب فضائل الحاكم، وليست من باب الفروض والواجبات وحسب، وإذاً فالشورى غير والديمقراطيّة غير».
وختاماً إنّ «الديمقراطيّة ما زالت تحتاج إلى تأسيس في الوعي العربيّ المعاصر، ما زالت في حاجة إلى جعلها تتحوّل داخل الوعي العربيّ، من قضية تحيط بها شكوك إلى قناعة لا تتزعزع، كقناعة العقل بالضروريات البديهيّة».
ملاحظات:
إنّ الجابريّ كغيره من الباحثين الجدد يُؤيّد الديمقراطيّة بشكل مطلق ويدعو لها، ويرى أنّها ضرورة من ضرورات عصرنا، وحقّ من حقوق إنسان هذا العصر، وإنّه لم يقنع منها بمجرّد التعريف ـ وهو الحكم بإرادة الشعب ـ بل يريد منها إحداث انقلاب تاريخيّ لم يشهده العالم العربيّ فهي إذاً لم تكن انتقالاً من مرحلة إلى مرحلة بل هي ميلاد جديد.
ولكنّ الأمر المهمّ الذي لم يتطرق إليه الجابريّ في بحثه، انّما هو كيفيّة الجمع بين الدين والديمقراطيّة وهل هناك تعارض بينهما أم لا؟ إضافةً الى أنّه ـ كغيره من المفكّرين العرب ـ لم يشهد ولم يجرّب في البلاد العربيّة حكماً ديمقراطيّاً متحقّقاً على أرض الواقع، فلذا بقيت أطروحاتهم على مستوى التنظير فقط، وذلك بخلاف ما شهده العالم الشيعيّ حيث جرّب الحكم الديمقراطيّ ومارسه فعلاً، ولم يقتصر على التنظير فقط.
إنّ الديمقراطيّة عند الدكتور حنفي هي: «الاعتراف باحتمال خطأ الذات، وبأنّها قد تتعلّم من الآخر، وقد يكون الآخر على صواب. تتضمّن الاعتراف بحقيقة مستقلّة عن الذهن يحاول الجميع الوصول إليها دون التضحية بالموضوع من أجل الذات، لا تعني الديمقراطيّة: حكم الشعب وحسب، بل تعني الاعتراف بوجود الآخر بجوار الأنا، وبأنّ الحوار بين الأنا والأنت هو الحياة».
يعتقد الدكتور حنفي: «إنّ قضية الحريّة والديمقراطيّة هي الشرط الأساسيّ لكلّ تحديث». ولكن حدثت أزمة عند العالم العربيّ حالت دون التحديث والتنوير ولا بد من معالجتها، يقول: «إنّ مجتمعاتنا الحاليّة ما زالت دون المجتمعات التي تقوم على الحريّة، وإنّ نظمنا الحاليّة أيضاً ما زالت دون النظم التي تقوم على الديمقراطيّة، ومن ثمّ فنحن دون التنوير، ولن نلحق بعصر التنوير إلّا بحلّ أزمة الحريّة والديمقراطيّة في وجداننا المعاصر».
يدعو الدكتور حنفي إلى معرفة جذور هذه الأزمة ومعالجتها، مع اعترافه بأنّ لها جذوراً تاريخيّة طويلة: «إنّ أزمة الحريّة والديمقراطيّة في وجداننا المعاصر ليست بنت اليوم، بل هي امتداد لوضع
حضاريّ واستمرار له منذ ما يقرب من ألف عام، منذ نهاية عصرنا الذهبيّ القديم في القرن الخامس الهجرىّ».
ويقول ايضاً: «إنّ أزمة الحريّة والديمقراطيّة هي أزمة تاريخنا في السنوات الألف الأخيرة، ومهمتنا اليوم في إيجاد البدائل لكلّ ما هو مطروح، ولكلّ ما هو أحادي الطرف، وفي الدخول في معارك التصوّرات وصراع القوالب الذهنيّة».
أمّا بالنسبة لجذور هذه الأزمة، فيذهب الدكتور حنفي إلى وجود نوعين من الجذور: «الأوّل جذور تراثيّة خالصة ورثناها من الاُصول الاُولى في القرآن والحديث والعلوم الدينيّة النقليّة والعقليّة، وهي العلوم التي تمدّنا بأبنيتنا الثقافيّة، وقوالبنا الذهنيّة، والتي تكون معظم بنائنا الفوقيّ.
والثاني بنية واقعيّة ساعدت على تغلغل هذه الجذور وتشعّبها، وكانت أرضها الخصبة التي ساعدت على نمائها، وهو طابع النظم الاجتماعيّة التي عشناها، والتي ابتعدت فيها جماهيرنا عن السّاحة منذ القضاء على الفرق الإسلاميّة الاُولى وتصفيتها، وظهور الطبقات الاجتماعيّة وتمايزها، واتساع البون بين من يملك ومن لا يملك، ثمّ ظهور الطبقات المتوسّطة التي تحكم السلطة من خلالها، والتي تمدّ السلطة بأجهزة ادارتها.. .».
ثمّ إنّ حسن حنفي يجعل هذه الجذور في خمس مجموعات
أساسيّة، نوردها هنا باختصار وتلخيص، يقول: ويمكن رصد هذه الجذور في خمس مجموعات أساسيّة هي:
وهي ما يسمّى في علوم القانون باسم الصوريّة، وما يعرف عادة باسم الجمود وضيق الأفق... هذه الحرفيّة تمنع الحوار حول المعنى والتوجّه إلى مضمون النصّ، فيتحوّل الحوار الفكريّ إلى لفظيّة، كما تغيب نقطة التلاقي في الواقع. . .
لا يمكن الحوار إلّا باحتمال انتقال اللفظة من الحقيقة إلى المجاز، ومن الظاهر الى المؤوّل، ومن المحكم إلى المتشابه، ومن المقيّد إلى المطلق، أي احتمال أحد أوجه الحقيقة، لا يحدث الحوار إلّا في منطق الاحتمال وفي تعدّد الحقائق، ويبدو أنّنا ألغينا الحريّة منذ البداية بالالتزام بالحقيقة المطلقة المسبقة المكتوبة بصياغة واحدة أبديّة. . . .
وقد ساعد ذلك على إنشاء وظيفة العالم، ثمّ إنشاء طبقة من العلماء بيدها حقائق العلم، فأرادت حفاظاً على هذه الميّزة احتكار العلم، فقامت بتكفير كلّ من خالفها، وباستئصال كلّ من عارضها أمّا مباشرة أو باستعداء الحكام.
تقرّب إليهم الحكّام للاعتماد عليهم في السيطرة على الشعوب نظراً لمكانتهم في النفوس، وأصبحت الطاعة العمياء للسلطة السياسيّة مرادفة لحرفيّة النصوص للسلطة الدينيّة، ثمّ نشأت مزايدات بين العلماء، كلّ منهم يريد إظهار سلطته الدينيّة أو تبرير
(92)سلطته السياسيّة كي يصبح كبير العلماء ورئيس هيئتهم. . . ومن ثمّ اتّحدت عقليّة السلطة السياسيّة مع السلطة الدينيّة، إذ اعتمد كلاهما على التنزيل، تنزيل الأمر من السلطة إلى الشعب، وتنزيل الوحي من الله إلى العالم دون حقّ الشعب في مراجعة قرارات السلطة، ودون حقّ العالم في مناقشة العلم اللدنّي. . . .
إنّ أزمة الحريّة والديمقراطيّة في وجداننا لَتنشأ من اضطراب الصلة في شعورنا بين اللفظ والمعنى والشيء، فضحّينا بالمعنى والشيء من أجل اللفظ، وبالتالي استحال الحوار.
لم يحدث ذلك في القرآن إذ: (لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ ۖ قَد تَّبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ)، وأيضاً: (فَمَن شَاءَ فَلْيُؤْمِن وَمَن شَاءَ فَلْيَكْفُرْ)، وايضاً: (كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ)، وأيضاً: (فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَّفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَـٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا)، وعشرات الآيات القرآنيّة الأخرى. ولكن حدث أن انتشر فيما بيننا العديد من الأحاديث الموجّهة لسلوكنا وذهننا، ونكثر من الاستشهاد بها في ماضينا وحاضرنا....
ويكفي أنْ نضرب المثل بحديث الفرقة الناجية، وأثره في أزمة الحريّة والديمقراطيّة في وجداننا القوميّ، وهو الحديث القائل:
«ستفترق أمّتي ثلاثاً وسبعين فرقة. . .»، وقد شكّ العلماء في صحّة هذا الحديث، وجواز الاستدلال به وعلى رأسهم ابن حزم، واكتفى بعضهم الآخر بتعدّد طرق روايته دون الشهود بصحّته. . .
ولكنّ الذي حدث هو أن استغلّ هذا الحديث وغيره من الناحية السياسيّة، وأصبحت الفرق الضالة هي كلّ أنواع المعارضة السياسيّة للسلطة القائمة، كما أصبحت الفرقة الناجية هي حزب الحكومة. .. كلّ من يجتهد بالرأي فقد ضلّ، وإنّ الحكومة دائماً على صواب، وإنّ كلّ مفكّري الاُمّة مغرضون، وإنّ الحكومة وحدها تسير على الطريق المستقيم...كيف يجري الحوار اذاً والسيف مُصلت على رقاب أصحاب الرأي والاجتهاد؟
لقد حدّدت الأشعريّة بعد انتصارها منذ القرن الخامس الهجري، وتحوّلها الى فكر رسميّ للدولة السنيّة، تصوّرنا للعالم. . . ويمكن تلخيص التصور الأشعريّ للعالم على أنّه تصوّر سلطويّ مركزيّ اطلاقيّ، أصبح تصوّرنا للعالم أساس نظمنا السياسيّة.
فالله مركز الكون وخالقه، يسيطر على كلّ شيء، له صفات فعّالة في الكون، قادر على ما لا يكون، وعالم بما يستحيل، لا يقف أمامه قانون طبيعيّ، ولا تردّه حرية إنسانيّة، لا يستطيع الإنسان أن يفعل إلّا إذا تدخّلت الإرادة الإلهيّة لحظة فعله وجعلته ممكناً وإلّا استحال الفعل.
فليس للإنسان إلّا أن يكسب ما هيّأه الله له، الهداية والضلال،
(94)والتوفيق والخذلان، والتأييد والخسران، كلّه من الله، والإنسان يعيش في عالم لا يحكمه قانون، ولا يراعى الأصلح، وليست به غاية... يتلّقى الإنسان العلم الالهيّ، ويظلّ عقله قاصراً على أن يستقلّ بنفسه، ومن ثمّ فهو في حاجة مستمرّة إلى عطاء من الوحي...
ومن هذا التصوّر المركزيّ للعالم جاءت فكرة الزعيم الأوحد، والمنقذ الأعظم، والرئيس المخلّص، ومبعوث العناية الالهيّة، والمعلّم والملّهم، يأمر فيطاع، يعبّر عن مصلحة الناس، يضمّ كلّ شيء، واستعار صفات الله المطلقة في العلم والقدرة والحياة. . . .
هذا التصوّر المركزيّ للعالم الذي يعطي القمّة كلّ شيء، ويسلب عن القاعدة كلّ شيء، كيف يجري فيه الحوار؟. . .لا يوجد حوار بين القمّة والقاعدة، بل يوجد أمر وتنفيذ، سمع وطاعة، رضوخ واستسلام، أو شكوى وأنين....
ولكنّ كلّ المجتمعات قد مرّت بهذه الفترة في تاريخها عندما كان تصوّرها للعالم سلطويّاً مركزيّاً اطلاقيّاً، ثمّ بدأ التحديث في الابنية الفوقيّة أوّلاً، وتحوّل التصوّر الرأسيّ إلى تصوّر أفقيّ، وتحوّلت العلاقة بين الأعلى والأدنى إلى العلاقة بين الأمام والخلف، وتحوّلت الحضارة الممركزة حول الله إلى حضارة ممركزة حول الإنسان، وتحوّل الآخر المطلق إلى الآخر النسبيّ وهو الإنسان، وبالتالي نشأت الديمقراطيّة بعد استواء الطرفين. . . إنّه لا أمل لحلّ أزمة الحريّة والديمقراطيّة في وجداننا إلّا إذا حدث هذا الانقلاب الثقافيّ في حياتنا العقلية. . . .
(95)كان عمل العقل في تراثنا الفلسفيّ القديم عملاً تبريريّاً خالصاً، أي إنّه يأخذ المعطيات وينظرها ويحيلها إلى معطيات مفهومة يمكن برهنتها، لم يقف العقل أمام المعطيات محايداً، أو ناقداً إيّاها، أو معارضاً لها، أو متسائلاً عن صحّتها... في هذه الوظيفة للعقل يستحيل الحوار، لأنّ المعطيات مقبولة سلفاً ولا توضع موضع النقد..
يظنّ الإنسان أنّه حرّ التفكير في حين أنّه لا يملك إلّا قبول المعطيات وتبريرها عقلاً....
كان هجوم الغزالي على العلوم العقليّة في القرن الخامس الهجريّ، وقضاؤه على الفلسفة، وعداؤه لكلّ اتّجاه حضاريّ عقلانيّ، وتنكّره لكلّ العلوم الإسلاميّة بما في ذلك علوم الكلام والفقه والحكمة وباستثناء علوم التصوّف، وهدمه لمنهج النظر، ودعوته لمنهج الذوق. .. كان ذلك كلّه بداية هدم العقل وهو أداة الحوار...
وقد غذّت السلطة السياسيّة كلّ التيارات اللاعقلانيّة في حياتنا، لأنّ العقل يناهض السلطة ويكشف اللاشرعيّة، ويطالب بالحقوق، وينادي بالحريّة، وبأنّه لا سلطان على الإنسان إلّا سلطان العقل، ولا حجّة عليه إلّا البرهان والدليل، فالإنسان لا يقبل إلّا سلطان العقل. ..
(96)إنّ سيادة العقل تجعل الحوار ممكناً بين القاهر والمقهور، وتعيد إلى الطرفين علاقة التساوي، وتقضي على علاقة التسلّط من طرف، وتبعيّة الطرف الآخر.
إنّ أزمة الحريّة والديمقراطيّة هي أزمة تاريخنا في السنوات الألف الأخيرة، ومهمّتنا اليوم في إيجاد البدائل لكلّ ما هو مطروح، ولكلّ ما هو أحاديّ الطرف، وفي الدخول في معارك التصوّرات وصراع القوالب الذهنيّة.
وإذا كنّا نحاور الأعداء، فالأولى أن نتحاور فيما بيننا، وأن يكون لكلّ منّا الحقّ في التعبير عن نفسه، وفي أن يستمع إلى رأى الآخر ليس مجرّد وهم أو خداع، فإن كنت موجوداً فالآخر موجود، وكلّا الطرفين متساويان، ليس علينا إلّا أن ننفذ إلى جذور الأزمة في قوالبنا الذهنيّة، وأن نعيد بناءها بحيث تتساوى الاطراف».
ويقول أيضاً في مكان آخر: «إنّ نقل مجتمعاتنا العربيّة من مرحلة التقليد والموروث والسلطة، إلى مرحلة الاجتهاد والتجديد وحريّة البحث، هو الشرط الأوّل لإحداث أيّ تغيير في النظم السياسيّة والاجتماعيّة، ولتحقيق ذلك يجب البحث عن الجذور التاريخيّة لأزمة الحريّة والديمقراطيّة في وجداننا المعاصر، ثمّ اقتلاعها من أساسها حتّى تتحوّل مجتمعاتنا، وتهتزّ أبنيتها تحت معاول النقد.
ونقد الموروث والمسلّمات والمقدّسات، هو البداية الحقيقيّة للتغيّر الاجتماعيّ، ولمّا كان النقد لا يجري إلّا بالعقل، كان استعمال العقل هو بداية تنشيط مجتمعاتنا وتحريكها.
(97)والعقل هو العقل الطبيعيّ المرتبط بالحسّ والمشاهدة والتجربة، وبه يجري تأكيد حريّة الإنسان واستقلال إرادته، ودوره في التاريخ، وسيادته للطبيعة ومساواته للآخرين، يمكننا حينئذٍ اجتثاث هذه الجذور التاريخيّة التي تكمن وراء أزمة الحريّة والديمقراطيّة وعلى رأسها سلطويّة التصوّر، وحرفيّة التفسير، وتكفير المعارضة، وتبرير المعطيات، وهدم العقل. بعدها تستطيع مجتمعاتنا أن تواجه مشاكلها الفعليّة، وتعيد الاختيار بين الأبنية السياسيّة والاجتماعيّة المختلفة طبقاً لمصالحها واحتياجاتها».
ويضيف أيضاً: «ولا حلّ لأزمة الحريّة والديمقراطيّة في عصرنا إلّا بالعودة الى العصر الليبراليّ، دفاعاً عن الحريّات العامّة، والتعدّدية الحزبيّة، والانتخابات الحرّة، وحقوق الإنسان، ولا فرق في ذلك بين الشرق والغرب، بين تراثنا وتراث الآخر، فالليبراليّة تراث إنسانيّ عامّ لكلّ الشعوب وفي كلّ الأزمان».
وختاماً: «ليست الديمقراطيّة.. بدعة غربيّة أو مذهباً مستورداً، أو نظاماً واحداً، بل هي روح الشريعة وأساس نظامها، ولا مشاحة في الألفاظ إذا كان اللفظ يونانياً فالمعنى إسلاميّ، وقد قبل القدماء ألفاظ اليونان ما دامت معانيها إسلاميّة يقبلها العقل وتتّفق مع الشرع، على المعنى يجتمع الإسلاميّون، واللفظ مقبول عند العلمانيّين، وحريّات الاُمّة تتحقّق بالمعنى واللفظ، فلم الخلاف الفقهيّ وضياع مصالح الناس؟!».
الدكتور حنفي كالجابري لا يريد الاقتصار على تعريف الديمقراطيّة، بل يريد الخوض في أعماق المسألة وحلّ المشكلة جذريّاً، ليتمكّن العالم العربيّ من تأسيس حكم ديمقراطيّ، فلذا لا يبحث عن كيفيّة ارتباط الدين بالديمقراطيّة وهل هناك تعارض بينهما أم لا؟ وربما يلوح من كلامه في خاتمة بحثه أنّ الخوض في هذه الأمور تضييع لمصالح الناس ولا فائدة فيها، بعد أن كانت الديمقراطيّة روح الشريعة وأساس نظامها، ولكنّ هذا الادّعاء لا يتجاوز حدّ الشعار، فهناك أمور وشبهات حقيقيّة تدعو الى حلّها ولا يمكن الاكتفاء بهذه الدعايات من دون الخوض في صلب البحث.
(99)
لا يختلف القسم الثالث عن القسم الأوّل كثيراً من حيث المباني والمرتكزات المعتمدة في البحث، سوى أنّ هذا القسم حاول إعطاء رؤية مرنة للإسلام تواكب التقدّم والحضارة، ولا تنفي ما توصّل إليه البشر من معطيات إيجابيّة، أي يمكن أن نقول إنّ هذا القسم إنّما هو إدامة للقسم الأوّل بعد تطوّره.
لذا نرى في هذا القسم محاولات مختلفة لدمج الإسلام والديمقراطيّة أو بعبارة أخرى أسلمة الديمقراطيّة بحيث يمكن أخذها والعمل بها، وذلك بعد ترك النزاع حول المصطلح، وبعد الغور في أعماقه وغربلة محتواه وأخذ الصحيح وترك الفاسد، ولذا نرى الالتزام بمصطلح الديمقراطيّة الاسلاميّة او الدينيّة لدى كثير من المفكّرين الاسلاميّين.
ولكنّ المحور الرئيسيّ لأرباب هذه الآراء برغم اختلافهم الكبير، يبتني على كون الحاكميّة لله تعالى، فهو المقنّن والمشرّع الوحيد للإنسان، ولا حكم إلّا حكمه، ولا ولاية إلّا ولايته ؛ لأنّه العالم بمصالحهم والقادر على توجيهها، وهو المالك الوحيد لهم، فله الحقّ في تعيين مصيرهم ورسم خطّة حياتهم بما يسعدهم في الدارين، فهذه الآراء مع وحدة المبنى مختلفة التعبير.
(100)أما الشيعة فبعد التسليم لنظريّة الحاكميّة الالهيّة وامتدادها إلى النبي صلىاللهعليهوآله وخلفائه الاثنى عشر، يختلفون في فترة ما بعد المعصوم أي فترة الغيبة، فبعضهم يرى امتداد هذه الولاية وجريانها حتّى في زمن الغيبة على يد الفقهاء والعلماء «نظرية ولاية الفقيه»، وبعضهم الآخر يرى تفويض هذا المنصب إلى الناس مؤقّتاً «نظريّة ولاية الاُمّة على نفسها».
وأمّا أهل السنة فهم لا يختلفون في كون هذه الولاية بعد الرسول تركت لاختيار الاُمّة فالأمر شورى بينهم، وهذا الامتداد الإلهيّ يجري على يد الأمّة، وتتبلور هذه النظريّة في قالب «خلافة الإنسان المؤمن» أو«الخلافة الإسلاميّة»، مع اتّفاقهم على تفوّق الإسلام أو الديمقراطيّة الاسلاميّة على الديمقراطيّة الغربيّة.
أمّا كيفيّة إجراء الديمقراطيّة واستعمالها في نظام كهذا، فإنّه يجري على أساس التقنين والتشريع الإلهيّ، والتطبيق والتنفيذ البشريّ، أي تكون سيادة الشعب وتدخّلهم في الأمور السياسيّة في ضوء التقنين الالهيّ والحاكميّة الالهيّة، فهي ديمقراطيّة محدّدة وليست مطلقة العنان، فالشعب يسلّم بحاكميّة الله تعالى، ويجعل سلطاته محدودة بحدود قانون الله وبرضاه ورغبته، والدولة تسير في طريق محدّد مرسوم ليس باستطاعتها تغييره أو الخروج عنه.
ولا بدّ من الإشارة هنا إلى أنّ علماء الشيعة ومفكّريهم وكذا أهل السنة عدا العلمانيّين منهم لا يرون أيّ دور للناس في إعطاء الشرعيّة للحاكم المعصوم، فإنّ شرعيّته تأتي من قبل الله تعالى وحده، نعم للناس دور تفعيل هذه الشرعيّة والإذعان لها والالتزام بها وبما جاء
(101)به لا أكثر، فلا مجال هنا للديمقراطيّة التي تكون بمعنى سيادة الشعب في اتخاذ القرار السياسيّ وحريتهم في انتخاب الحاكم وفي التشريع والتقنين، أمّا في فترة عدم وجود المعصوم أي بعد رحيل النبي صلىاللهعليهوآله عند أهل السنة، وبعد غيبة الامام الثاني عشر عليهالسلام عند الشيعة، فتأتي الأقوال التي أشرنا إليها سابقاً.
ولكن بناء على الرأي المختار من جعل الديمقراطيّة آليّة للعمل السياسيّ، فلا فرق بين زمن حضور المعصوم وعدمه ؛ لأنّها آليّة للعمل وليست نظرية فلسفية أو حقوقية جاءت لتحلّ محلّ فلسفة وأيديولوجيّة أخرى ليحصل التعارض بينهما، فهي بهذا المعنى تجتمع مع نظرية الإمامة أكثر من اجتماعها مع نظرية الشورى، حيث نرى تطبيقها عمليّاً في فترة حكومة أمير المؤمنين عليهالسلام وكيفية تسلّمه للسلطة وتعامله مع الناس ومع مخالفيه حيث لم يجبرهم على البيعة، ولم نر أيّ أثر لها في غيره من الخلفاء أتباع مدرسة الشورى.
وعلى كل حال، فمّمن ذهب إلى هذا الاتّجاه أي الموافقة المشروطة مع الديمقراطيّة:
من أجل التعرُّف الدقيق إلى رأي السيد الخمينيّ المتعلّق بالديمقراطيّة، يجب أن يكون لنا إلمام واسع بارائه السياسيّة والكلاميّة، ومع الدقّة في كلمات وتأليفات ومحاضراته طيلة أعوام النهضة والثورة، نصل إلى أنّ الفكر السياسيّ عنده في اقامة الحكومة الاسلاميّة ينقسم الى قسمين:
(102)الاوّل: كلاميّ، والثاني: سياسيّ، والغفلة عن هذا الأمر، والتحرّك لفهم نظريّته من جهة واحدة، يفضي إلى الوقوع في الاشتباه والخطأ في فهم مراده.
أما البعد الكلاميّ في بحث الحكومة الإسلاميّة التي ذكرها فإنّه يكمن في المشروعيّة الإلهيّة والدينيّة للحكومة، أمّا البعد السياسيّ فيكمن في المشروعيّة الشعبيّة، وحق تقرير المصير، وظهور القدرة السياسيّة من بين الجماهير.
إذاً فنحن في كلماته نواجه نوعين من المشروعيّة: الكلاميّة والسياسيّة، حيث نجد اهتماماً ملحوظاً من قبله لكلا هذين الأمرين.
يقول السيد الخميني في صدد جوابه عمّن سأله: «في أيّ صورة يكون فيها الفقيه الجامع للشرائط ولياً على المجتمع الإسلاميّ ؟» يقول في الجواب: «إنّ ولايته هي في جميع الصور، ولكنّ تولّي اُمور المسلمين وتشكيل الحكومة يرتبط بآراء أكثريّة المسلمين، حيث ذكر هذا الأمر في القانون الأساسيّ أيضاً، وفي صدر الإسلام وردّ التعبير عنه بالبيعة لوليّ المسلمين».
في هذا الكلام نجد الجمع بين هاتين المشروعيّتين، والتمييز بين الولاية وبين التولّي، فلذا نحن نقسّم آراء السيد الخميني هنا إلى قسمين كلّييّن:
1 ـ المشروعيّة الكلاميّة. 2 ـ المشروعيّة السياسيّة.
ونستعرض نظريّته في هذا المجال بالاستشهاد بكلماته وخطبه.
(103)الف: «إنّ من الأحكام العقليّة الواضحة، والتي لا يمكن لأحد إنكارها هي ضرورة وجود القانون والحكومة بين الناس، وإنّ العائلة البشريّة بحاجة الى تشكيلات ونظام وقانون وحكومة.
وإنّ ما يحكم به العقل الذي أعطاه الله للإنسان، هو أنّ تأسيس الحكومة بحيث يكون الناس ملزمين بإطاعتها ومتابعتها بحكم العقل، هي من صلاحيّات من يكون ضامناً لجميع شؤون الناس، وكلّ تصرّف يصدر منه تجاه الناس هو تصرّف في ماله وملكه، وهذا الذي يكون تصرّفه وولايته سارية في جميع شؤون الناس، ونافذة وصحيحة بحكم العقل، هو الله تعالى المالك لجميع الموجودات، وخالق الأرض والسماوات.
إذاً فكلّ حكم يقضي به الله تعالى في مملكته فهو نافذ، وكلّ تصرّف يصدر عنه هو تصرّف في ملكه، فلو أنّ الله تعالى أعطى الحكومة لأحد الأشخاص، وأنفذ حكمه بواسطة قول الأنبياء، وأوجب طاعته، فإنّ على جميع الناس أيضاً لزوم إطاعته».
«ليس لأحد حقٌ في الحكم على الآخرين سوى الله تعالى، وليس له الحقّ في تقنين القوانين أيضاً، بل إنّ الله تعالى يجب عليه بحكم العقل تشكيل الحكومة للناس، ووضع القانون لهم».
ب: بعد أن رأينا أنّ الحكومة هي من الله تعالى، فحينئذٍ هو الذي ينبغي له تعيين الحاكم، والله تعالى أيضاً عيّن الأنبياء والأئمة
حكّاماً على الناس، يقول السيد الخميني في هذا الصدد:
«إنّ الهدف من بعثة الأنبياء: بحكم العقل وضرورة الأديان، ليس هو بيان الأحكام فحسب، فليس الأمر مثلاً أنّ المسائل الشرعيّة والأحكام الدينيّة وصلت إلى الرسول الأكرم صلىاللهعليهوآله عن طريق الوحي، وأنّ النبي وأمير المؤمنين وسائر الأئمة: هم مبيّنون ومبلّغون لهذه الأحكام بتعيين من الله فحسب. . . ففي الحقيقة إنّ أهمّ وظيفة الأنبياء هو استقرار النظام الاجتماعيّ العادل عن طريق إجراء القوانين والأحكام».
«نحن نعتقد بالولاية، ونعتقد بأنّ النبيّ الأكرم يجب عليه تعيين الخليفة وقد عيّنه أيضاً، فهل تعيين الخليفة كان من أجل بيان الأحكام ؟ إنّ بيان الأحكام لا يحتاج إلى خليفة، فالنبي الأكرم نفسه قد بيّن الأحكام، ويمكنه كتابة جميع الأحكام في كتاب وإعطاؤه إلى الناس ليعملوا به، إنّ ما ينبغي عقلاً هو تعيين الخليفة للحكومة».
ويقول أيضاً: «إنّ الولاية الواردة في حديث الغدير هي بمعنى الحكومة لا بمعنى المقام المعنويّ. . . وما ورد في الروايات أيضاً من أنّه «بني الإسلام على خمس» ومنها الولاية، فهذه الولاية ليست الولاية الكلّية للإمام، وتلك الإمامة التي لا يُقبَل عمل بدونها إلّا بالاعتقاد بها لا تعني هذه الحكومة. . .
إنّ ما جعله الله تبارك وتعالى، وبتبع ذلك جعله أئمة الهدى: هو الحكومة. . . فعلى هذا فالحكومة التي جعلها الله تعالى لأمير المؤمنين سلام الله عليه، هذه الحكومة تعني السياسة، وتعني
اتّحادها مع السياسة. . . فما ورد تاكيده كثيراً من أمر الغدير.. . من أجل أنّ اقامة الولاية يعني وصول الحكومة إلى يد صاحب الحقّ، فتنحلّ بذلك جميع المسائل، وتنتهي جميع الانحرافات. . .
الولاية أساسها مسألة الحكومة. . . فعلى هذا الأساس «ما نودي بشيء مثل ما نودي بالولاية» من أجل هذه الحكومة، وما دُعي الناس لشيء مثل ما دعوا لهذا الأمر السياسيّ».
«إنّ الحروب والغزوات الكثيرة التي وقعت في عهد الرسول الأكرم صلىاللهعليهوآله، كلّها كانت من أجل هذا المعنى، وهو رفع الموانع من أمام هذا المقصد الإلهيّ، والمقصد الأعلى الذي يهدف إليه الرسول الأكرم صلىاللهعليهوآله، هو تحكيم الحكومة الإسلاميّة، حكومة الله، حكومة القرآن، وكلّ شيء كان من أجل ذلك».
ج: الحكومة هي من شؤون الله تعالى، وهو الذي عيّن الأنبياء والأئمة المعصومين للحكومة، والآن ونحن نعيش في زمان غيبة المعصوم، فكيف يكون أمر الحكومة ؟ هنا نستعرض أيضاً جواب الإمام الخميني على هذا السؤال، فإنّه يقول:
«إنّا نعلم علماً ضرورياً بأنّ النبي صلىاللهعليهوآله المبعوث بالنبوة الختميّة أكمل النبوّات وأتمّ الأديان، بعد عدم إهماله جميع ما يحتاج إليه البشر حتّى آداب النوم والطعام، وحتّى أرش الخدش، فلا يمكن أن يهمل هذا الأمر المهمّ الذي يكون من أهمّ ما تحتاج إليه الاُمّة ليلاً ونهاراً.
فلو أهمل ـ والعياذ بالله ـ مثل هذا الأمر المهمّ أي أمر السياسة والقضاء، لكان تشريعه ناقصاً، وكان مخالفاً لخطبته في حجّة الوداع، وكذا لو لم يعيّن تكليف الأمة في زمانها مع إخباره بالغيبة وتطاولها، كان نقصاً فاحشاً على ساحة التشريع والتقنين يجب تنزيهه عنه.
فالضرورة قاضية بأنّ الاُمّة بعد غيبة الإمام المهدي عليهالسلام في تلك الأزمنة المتطاولة لم تترك سدًى في أمر السياسة والقضاء، الذي هو من أهمّ ما يحتاجون إليه، خصوصاً مع تحريم الرجوع إلى سلاطين الجور وقضاتهم، وتسميته رجوعاً الى الطاغوت، وإنّ المأخوذ بحكمهم سحت ولو كان حقاً ثابتاً، وهذا واضح بضرورة العقل، ويدلّ عليه بعض الروايات».
الف: إنّ السيد الخميني عندما كان في النجف الأشرف وقبل مجيئه الى فرنسا، كان مشغولاً بالتنظير وتبيين المباني والأسس العقلية والشرعيّة للحكومة الاسلاميّة، وسعى سعياً بليغاً في ترسيخ جانبها الكلاميّ.
لكن بعد ما جاء إلى فرنسا، وبعد ما ظهرت بوارق النصر، تولّدت نظرية المشروعيّة السياسيّة للحكومة عنده، وبدأ بالتنظير والتبيين لهذا الجانب الهامّ أيضاً.
لقد ظهر الوجه الديمقراطيّ له في فرنسا، وكان أكثر كلامه وبيانه حول الحريّة، الديمقراطيّة الإسلاميّة، دور الناس في الحكومة،
(107)التصويت العامّ... وفي هذا دلالة واضحة على مواكبته لشرائط الزمان والمكان، ومعرفته بالأدبيات السياسيّة والعقلائيّة، حتّى إنّه كان يقول:
«الإسلام الذي جعل أكثر تأكيده للتفكير، ودعا الإنسان بالتحرّر من جميع الخرافات، والتحرّر من أسر القوى الارتجاعيّة المخالفة للإنسانيّة، كيف يمكن أن لا يتوافق مع الحضارة والتقدّم والأمور الجديدة المفيدة التي حصل عليها البشر بتجاربه ؟».
ب: إنّ السيد الخمينيّ هو الشخص الوحيد الذي تمكّن من طرح وإجراء وتطبيق الديمقراطيّة الإسلاميّة، لذا سعى في توضيح وتبيين هذا المصطلح، فقال مثلاً: «الديمقراطيّة الغربيّة فاسدة، وكذلك الدميقراطيّة الشرقيّة، الديمقراطيّة الإسلاميّة هي الصحيحة، ونحن ـ إن وُفّقنا فسنثبت للشرق والغرب أنَّ الديمقراطيّة الصحيحة هي التي عندنا لا التي عندهم».
وقال أيضاً: «الحكومة الإسلاميّة تعني الحكومة المبنيّة على العدل، والديمقراطيّة، والقوانين الإسلاميّة»، «الإسلام دين الترقّي والديمقراطيّة بمعنى الكلمة. . .».
«أمّا النظام الإسلاميّ، الجمهورية الإسلاميّة، فهو نظام يعتمد على آراء الناس، وعلى التصويت العامّ، وقانونه هو قانون الإسلام».
«إنّ حكومة الجمهورية الإسلاميّة التي ندعو لها، هي التي تقتدي بسيرة رسول الله صلىاللهعليهوآله وعليّ بن ابي طالب عليهالسلام، وتعتمد على آراء الناس، وأمّا شكل هذه الحكومة ستعيّن بالمراجعة إلى آراء الناس».
ج: إنّ المقوّم الأساسيّ للحكومات الديمقراطيّة، إنّما هو حضور الشعب في الساحة السياسيّة، ومدخليّة رأيه في تعيين مصيره، وهذا ما اكّده كثيراً طيلة حياته، وكان صادقاً ومعتقداً به، كان يقول: «لو تخلَّى الناس نخسر جميعاً».
ونحن في ختام هذه الجولة المختصرة في آراء السيد الخميني، نورد بعض كلماته حول أهميّة رأي الناس وحريّتهم في تعيين مصيرهم.
قال رحمه الله: «الحريّة هي الحقّ الأوّليّ للبشر، إنّ الحق الإبتدائيّ للبشر أن يكون حراً، أن يكون حرّاً في آرائه، حراً في أعماله، حراً في الدولة التي يعيش فيها».
«نحن نريد أن نرجع إلى رأي الناس. . . لأجل تشكيل الحكومة التي هم يريدونها، سواء أرادوا الجمهوريّة الإسلاميّة، أو أرادوا النظام الشاهنشاهيّ، فالاختيار لهم».
«.. .كلّ من يرد الإسلام يجب أن يريد الجمهوريّة الإسلاميّة، لكنّ جميع الناس أحرار في إبداء رأيهم، فليقولوا: نحن نريد النظام
الملكيّ، أو نريد رجوع محمد رضا البهلوي، أو نريد نظاماً غربياً، فهم أحرار».
«إنّ من الحقوق الأوّليّة للشعوب أن يكون تعيين مصيرها ونوع حكومتها بيدها، وبما أنّ أكثر من تسعين بالمائة من الشعب الإيرانيّ مسلم، فمن الطبيعيّ أن تُبنى هذه الحكومة طبقاً لموازين الشرع وقوانين الإسلام».
«إنّ آراء الناس تحكم هنا، إنّ الحكومة هنا بيد الناس. .. لا يجوز لنا التخلّف عن حكم الشعب، ولا يمكن ذلك».
«نحن لا نريد أن نجبر شعبنا، الإسلام لا يسمح لنا بالدكتاتوريّة، نحن تبع لرأي الشعب، كيفما صوّت الشعب فنحن نتّبعه، لا يحقّ لنا، إنّ الله تعالى لا يسمح لنا، إنّ رسول الله صلىاللهعليهوآله لا يسمح لنا أن نجبر الشعب على شيء...».
وقال مخاطباً أعضاء مجلس الخبراء: «.. الديمقراطيّة تعني اعتبار رأي الأكثريّة ـ ولاسيّما أكثرية كهذه ـ كلّما قالت الأكثريّة فرأيها معتبر ولو كان خلافاً أو بضررهم، إنّكم لستم أولياء الناس حتّى تقولوا هذا بضرركم فلا نعمله، أنتم وكلاء الناس ولستم بأوليائهم. .. عليكم العمل بما يرتبط بوكالتكم، واسلكوا الطريق الذي اختاره الشعب حتى لو اعتقدتم بأنّ هذا المسير ليس في مصلحة الشعب. . . الشعب صوّت وتصويته متّبع».
«... إنّي قلت سابقاً إنّ الشعب إذا أراد أن يقول: نحن نريد الدكتاتوريّة، كلّ الشعب قال: نحن نريد الدكتاتوريّة، فأيّ حقّ لكم أن تقولوا: لا».
إنّ المودودي من الدعاة المتقدّمين إلى اقامة الحكومة الإسلاميّة، وإنّ هذه الحكومة ينبغي أن تخضع لقانون الله تعالى لا قانون البشر، وهذا ما أدّى الى التباس الأمر عند بعضهم، فنسب المودودي إلى العداء الشديد للديمقراطيّة مستشهداً ببعض كلامه، ولذا قام الدكتور محمد عمارة في كتابه «الصحوة الإسلاميّة» بالدفاع عن المودودي، ونقل استشهادات من كلامه دفاعاً عن الديمقراطيّة، ونحن هنا بدورنا نتّبع منهجنا السائد في هذه الرسالة، ونقوم بتلخيص شموليّ لآراء المودودي لنصل إلى حقيقة رأيه، والله المستعان.
قال: «إنّ المسلمين لو أرادوا أن يعيشوا مسلمين حقيقةً، فلا بدّ لهم من أن يطيعوا الله في دقائق حياتهم وعظائمها، وأن يحكموا شريعته وقانونه في حياتهم الشخصيّة والجماعيّة. إذ الإسلام لا يقبل أبداً أن يعلن الإنسان إيمانه بالله ربّ العالمين، ثمّ يصرف اُمور حياته وشؤونها وفق قانون غير الهيّ. . . إنّ المطالبة بالحكومة الإسلاميّة والدستور الإسلاميّ تنبع من الشعور الأكيد بأنّ المسلم اذا لم يتبع قانون الله فإنّ ادّعاءه الإسلام ادّعاء باطل لا معنى له».
ثمّ يأتي بالأدلّة القرآنيّة على هذا المدعى قائلا:
«1 ـ يقرّ القرآن بأنّ الله تعالى هو مالك الملك، ومن ثمّ فهو صاحب الحقّ في الحكم بداهة، كما يقرّ بأنّ تنفيذ أوامر أحد غيره أو حكم أحد سواه في أرضه وعلى خلقه، إنّما هو باطل وكفران مبين، والصواب أن يحكم الحاكم بقانون الله، ويفصّل في الأمور بشريعة الخالق، بوصفه خليفة الله ونائباً عنه في أرضه. . . .
2 ـ وبناء على هذا سلب الإنسان حقّ التقنين لأنّه مخلوق ورعيّة وعبد محكوم، ومهمته تتركّز في اتّباع القانون الذي سنّه مالك الملك، وقد أباح الإسلام بالطبع مزاولة الإنسان الاستنباط والاجتهاد وتفريعاتهما الفقهيّة، لكنّه شرط ذلك بألّا يخرج عن اطار حدود الله.. . .
3 ـ إنّ الحكومة الصحيحة العادلة في أرض الله هي التي تتأسّس وتحكم بالقانون الذي بعثه الله على أيدي أنبيائه.
4 ـ إنّ كلّ ما يصدر من أعمال من قبل أيّة حكومة تقوم على أساس شرعة اُخرى غير شرعة الله، وقانونه الذي جاء به الأنبياء من لدن ربّ الكون وإلهه، باطل لا قيمة له ولا وزن. .. فإذا كان مالك الملك الحقيقيّ لم يخوّلها السلطان، فأنّى لها أن تكون حكومات شرعيّة ؟».
ويقول أيضاً: «فالخصائص الأوّلية للدولة الإسلاميّة ثلاث:
1 ـ ليس لفرد أو اُسرة أو طبقة أو حزب أو لسائر القاطنين في
الدولة نصيب من الحاكميّة، فإنّ الحاكم الحقيقيّ هو الله، والسلطة الحقيقيّة مختصّة بذاته وحده، والذين من دونه في هذه المعمورة إنّما هم رعايا في سلطانه العظيم.
2 ـ ليس لأحد من دون الله شيء من أمر التشريع، والمسلمون جميعاً، ولو كان بعضهم لبعض ظهيراً، لا يستطيعون أن يشرعوا قانوناً، ولا يقدرون أن يغيّروا شيئاً ممّا شرع الله لهم.
3 ـ إنّ الدولة الإسلاميّة لا يؤسّس بنيانها إلّا على ذلك القانون المشرّع الذي جاء به النبي من عند ربّه، مهما تغيّرت الظروف والأحوال، الحكومات التي بيدها زمام هذه الدولة لا تستحقّ طاعة الناس إلّا من حيث إنّها تحكم بما أنزل الله، وتنفّذ أمره تعالى في خلقه. ..».
وبعد هذا العرض يصل الأمر إلى تعيين الحاكم، وهنا يطرح المودودي نظريّة خلافة الإنسان المؤمن، فيقول:
«إنّ تصوّر الخلافة الذي جاء في القرآن الكريم، هو أنّ كلّ ما يناله الإنسان على وجه الأرض من طاقات وقدرات ليس إلّا هبة من الله تعالى. . . وعلى هذا فالإنسان هنا ليس هو السلطان المالك نفسه، وانّما هو خليفة المالك الأصليّ. . .».
ويقول في مواصفات هذا الخليفة: «إنّ من تُناط به هذه الخلافة الشرعيّة السليمة ليس فرداً أو اُسرة أو طبقة، وإنّما هو الجماعة ـ بجملة أفرادها ـ التي تؤمن بالمبادئ السالفة الذكر، وتقيم دولتها
على أساسها، والفاظ الآية (55) من سورة النور: (لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ) صريحة في توضيح هذا الأمر.
فكلّ فرد في جماعة المؤمنين شريك في الخلافة من وجهة نظر هذه الآية، وليس لواحد من البشر أو طبقة من الطبقات، أيّ حقّ في سلب المؤمنين سلطاتهم في الخلافة وتركيزها في يديه».
ثمّ إنّ المودودي لمّا يرى قرابة هذه النظريّة مع الثيوقراطيّة، ينبري لإزاحة الشبهة عندما يذكر خصائص الدولة الإسلاميّة، فيقول: «أن تكون الحاكميّة فيها ]أي في الدولة الإسلاميّة[ لله وحده إلى حدّ يتّفق والنظريّة الثيوقراطيّة (اللاهوتيّة)، إلّا أنّ سبيل الدولة في تنفيذ هذه النظريّة يختلف عن الثيوقراطيّة (اللاهوتيّة) المعروفة.
فبدلاً من اختصاص طبقة متميّزة من الكهنة أو الشيوخ وغيرهم بالخلافة عن الله، وتركيز كافّة سلطات الحلّ والعقد في يديها ـ كما هو المعهود عن السلطات اللاهوتيّة ـ نجد أنّ خلافة الله في الدولة الإسلاميّة من حظّ المؤمنين أجمعين (الذين عاهدوا الله عهداً واعياً صادراً عن إرادتهم على أن يخضعوا لحكمه ويذعنوا له) داخل حدود الدولة كلّها، وأنّ سلطات الحلّ والعقد النهائيّة في يديهم على نحو جماعيّ».
وعندما يريد أن يتحدّث عن الديمقراطيّة يقول: «إنّه لا يمكن لأيّ عاقل أن يعارض الديمقراطيّة، ولا يمكنه القول إنّه يجب أن يكون هناك حاكم ملكي أو أرستقراطيّ، أو ايّ نوع آخر من أنواع الحكم».
ويقول أيضاً: «إنّنا نعارض سيادة فرد أو أفراد أو طبقة سيادة مطلقة تستأثر بالسلطة، أكثر من معارضة المتحمّسين للديمقراطيّة الغربيّة، ونؤكّد المساواة في الحقوق، وتكافؤ الفرص أكثر من تأكيد أنصارها، ونحارب كلّ نظام يكبت الحريّات، فلا يبيح حريّة التعبير أو التجمع أو العمل، أو يضع العراقيل في سبيل الأفراد لاختلافهم في الجنس أو الطبقة أو أصل الولادة...
فإذا كانت الديمقراطيّة الغربيّة تعتبر هذه الأمور جوهرها وروحها، فإنّه لا خلاف بينها وبين ديمقراطيتنا الإسلاميّة. . . نحن نؤمن بحاكميّة الله تعالى، ونقيم نظام حكمنا على فكرة الاستخلاف أو النيابة، وهي نيابة ديمقراطيّة في جوهرها وروحها، يجري فيها انتخاب الخليفة أو الرئيس أو الأمير وفق رأي الجماهير وبإرادتهم الحرّة، كما يجري فيها انتخاب أهل الحلّ والعقد والشورى كذلك، وهم الذين لهم الحقّ المطلق في نقد تصرّفات الحكّام ومحاسبتهم».
نعم تفترق الدولة الإسلاميّة عن الديمقراطيّة، ويشير إليه المودودي قائلاً: «إنّ هناك فرقاً جوهريّاً بينها وبين الديمقراطيّة الغربيّة، هو أنّ فكرة الديمقراطيّة الغربيّة تقوم على مبادئ الحاكميّة الشعبيّة، أمّا في خلافة الإسلام الديمقراطيّة، فالشعب يسلّم بحاكميّة الله، ويجعل سلطاته محدودة بحدود قانون الله وبرضاه ورغبته».
«وهي» أى الدولة الإسلاميّة [تتّفق ومبادئ الديمقراطيّة في
ضرورة أن تتكوّن الحكومة أو تتغيّر أو تسير برأي الشعب، إلّا أنّ الشعب ليس مطلق العنان فيها بحيث يكون قانون الدولة ومبادئ حياتها، وتخطيط سياستها الداخليّة والخارجيّة، وكلّ طاقاتها ومصادرها تابعاً لهواه ومزاجه وتميل معه حيث يميل، وإنّما ينضبط هوى الشعب ويستقيم بقانون الله ورسوله. .. فتسير الدولة في طريق محدّد مرسوم ليس في استطاعة هيئتها التنفيذيّة أو التشريعيّة أو القضائيّة، حتّى في استطاعة الشعب بأكمله أن يغيّره، اللهم إلّا إذا قرّر الشعب نفسه نقض العهد والخروج عن دائرة الإيمان».
نعم إنّ المودوديّ كغيره من المفكّرين يتأسّف على زوال الدولة الإسلاميّة، ويقول تعريضاً بمعاوية الذي جعل الخلافة ملكاً عضوضاً: «باختصار، كلّ ما يميّز الحكومة الدنيويّة عن الحكومة الدينيّة بدأ وكأنّه داء عضال أنشب أظفاره في حكومة المسلمين بعد عام60هـ...».
يقول الأستاذ مصباح اليزدي في تعريف الديمقراطيّة: «انّ التعريف اللفظيّ للديمقراطيّة عبارة عن حكومة الناس أو حكومة الشعب، والمراد بذلك أنّ الناس لهم الحقّ في التدخّل في أمور الحكومة، سواء من جهة التشريع والتقنين أو تنفيذ القوانين، وسائر الشؤون السياسيّة للمجتمع، وليس لغيرهم الحقّ في وضع القوانين وتنفيذها أو التدخّل في ذلك».
وعلى هذا الأساس فإنّه يقسّم الديمقراطيّة إلى ثلاثة أقسام ويقول: «وعلى هذا فللديمقراطيّة ثلاثة معان:
1 ـ الديمقراطيّة بمعنى التدخّل المباشر للناس في أمر الحكومة، حيث جرى تطبيق مثل هذه الحكومة في مدّة قصيرة في إحدى مدن اليونان في الماضي وانقرضت بعد ذلك.
2 ـ تدخل الناس في أمر الحكومة بواسطة انتخاب الوكلاء والنواب، كما هو المعمول في الدول الحديثة حتّى في دولتنا هذه.
3 ـ المعنى الثالث للديمقراطيّة أن تكون جميع شؤون الحكومة سواء في التقنين أو التنفيذ منفصلة عن الدين، يعني أنّ شرط كون الحكومة ديمقراطيّة هو فصلها عن الدين».
القسم الأوّل كما أشار إليه قد انقرض من ساحة المجتمعات البشريّة، برغم أنّ بعض الدول تسعى لاحيائه، إذاً فمحلّ البحث هو القسم الثاني والثالث، ونبدأ من القسم الثالث.
يقول الأستاذ مصباح اليزدى في تعريف القسم الثالث: «في هذه الأيّام طرحت الديمقراطيّة بمعنى أخصّ، بحيث إنّ النظام السياسيّ لا يكون ديمقراطيّاً الّا إذا فصل عن الدين، فعندما يقال: إنّ الحكومة الفلانيّة ديمقراطيّة، أو إنَّ الدولة الفلانيّة تدار بشكل ديمقراطيّ، فالمقصود من ذلك أنّ الدين في هذا المجتمع ليس له أيّ تدخّل في إدارة المجتمع، والمنفّذين للقانون والمقننّين لا ينبغي لهم أن يسمحوا للدين بالتدخّل في شؤونهم.
وطبعاً فمثل هذا الأسلوب والمنهج الديمقراطيّ لا ينفي الدين أساساً، ولكنّه يمنعه من التدخّل في الأمور السياسيّة والإجتماعيّة، ولا يجيز لمنفّذي القانون أن يتحدّثوا عن الدين في مقام تنفيذ القانون، ولا يجوز أن يكون أيّ قانون وأيّ حكم صادر على أساس الأحكام والقيم الدينيّة، وفي الواقع فإنّ هذا النظام الديمقراطيّ يُبنَى على العلمانيّة، وفصل الدين عن السياسة والمسائل السياسيّة والاجتماعيّة تماماً».
«إنّ الديمقراطيّة الغربيّة وليدة تفكير فصل الدين عن السياسة، ولا يمكن أن تلتقي مع الإسلام أبداً، لأنّه كما تقدّم فإنّ الغرب في البداية افترض عدم تدخّل الدين في القضايا السياسيّة والحكوميّة، ثمّ اضطرّوا بعد ذلك إلى وضع حقّ الحكومة بيد الشعب حتّى لا يقعوا في وادي الدكتاتوريّة. . . .
ولكنَّ الإسلام ليس كالمسيحيّة أبداً، فلا شك في أنّ الإسلام يهتمّ بجميع أبعاد وجوانب الحياة البشريّة، والنصوص الدينيّة من القرآن، وسنّة النبي، وسيرة الأئمة المعصومين: مليئة بالتعاليم والأحكام الاجتماعيّة والسياسيّة والحكوميّة، فهل مثل هذا الإسلام يجيز لنا أن نكون عباداً لله في المسائل الفرديّة، ولكنّه في المسائل الاجتماعيّة نكون عباداً للناس ؟».
وبعد ذكر هذه المقدّمة يستفاد من كلامه أنّ الديمقراطيّة الغربيّة غير مقبولة بدليلين:
الدليل الأوّل: إنّ إدارة المجتمع تقتضي تصرّفات واسعة في حياة الأفراد... والحكومة يجب أن تأخذ بعين الاعتبار المصالح والمفساد الواقعيّة حين وضعها للقوانين وتنفيذها، وتطلب من الناس العمل على وفقها، فلو أنّ بعض الأفراد أو المجموعات لم يطيعوا القانون، فبإمكان الحكومة إجبارهم على الطاعة وإلزامهم بها، ولها الحقّ في معاقبتهم. . . فالكلام هنا في أنّ أكثريّة الناس من أين لهم الحقّ في الحكومة على جميع الناس ؟.
والخلاصة أنّه على ضوء الفكر الإلهيّ، فإنّ جميع أفراد البشر هم عبيد لله تعالى، وحقّ الحكومة منحصر بالله تعالى، فعلى هذا ليس لأيّ فرد من أفراد البشر حقّ الحكومة على أيّ فرد آخر.. . فحكومة بعض الأفراد على الآخرين بدون إذن من الله يعتبر غصباً وغير مشروع، وبدون إذن إلهيّ لا يمكن أن يكون لأحد الحقّ في القدرة السياسيّة والحكومة على الناس.
الدليل الثاني: إنّ وضع القانون في الأصل مختصّ بالله تعالى الذي أوجد جميع الناس وخلقهم، ورزقهم وأنعم عليهم من مواهبه ونعمه الماديّة والمعنويّة، ولا يكون لأيّ انسان الحقّ في وضع القانون للناس إلّا في الموارد التي لم يضع الله تعالى قانوناً فيها، وقد أذن له في وضع القانون.
إذاً فالسبب في رفض الديمقراطيّة هو أنّ الديمقراطيّة أوّلا:
تعطي حقّ الحكومة للناس، وثانياً: ترى أنّ حقّ التقنين من شؤون الناس أيضاً.
فالنتيجة لذلك أنّ الديمقراطيّة لو كان المراد بها شرعيّة كلّ قانون يضعه الناس واعتبار وجوب تنفيذه، فإنّ هذا المفهوم مخالف للدين قطعاً، لأنّه في نظر الدين أنّ حقّ الحاكميّة والتشريع مختصّ بالله تعالى: (إن الحكم إلّا لله)، فالله تعالى هو الذي يعلم جميع المصالح والمفاسد للإنسان والمجتمع، وله الحقّ في التشريع والتقنين للإنسان. . . .
فعلى هذا فلو كان المقصود بالديمقراطيّة وحكومة الشعب إعطاء القيمة والاعتبار لرأي الناس في مقابل رأي الله تعالى، فهذا المفهوم غير معتبر أبداً.. . فاحترام رأي الناس واعتباره في مقابل الحكم الإلهيّ هو في الحقيقة إعراض عن التوحيد، وقبول الشرك الجديد في العالم المعاصر، ويجب الوقوف أمام هذا الشرك الجديد.
إنّ أيادي الاستعمار في الدول الإسلاميّة، يهدفون إلى إدارة جميع الدول الإسلاميّة بهذا الشكل من الديمقراطيّة، يعني عدم السماح للدين بالتدخّل في أمور الدولة والحكومة سواء في جانب التقنين أو التنفيذ.
أما الديمقراطيّة المطلوبة والصحيحة في نظر الأستاذ مصباح، فهي القسم الثاني منها، حيث يقول: «إن المفهوم الثاني من
الديمقراطيّة مقبول بشروط. . . فمن جهة يجب رعاية واحترام القيم والأحكام الإسلاميّة، وأن لا يكون لأيّ مشرّع ومقنّن حقّ المخالفة مع القوانين القطعيّة للإسلام، وهذا هو الأصل في الاسلام، ولذلك فنحن نقبل الديمقراطيّة مع حفظها لهذا الأصل.
إنّ ما ينبغي توضيحه أكثر هو أنّ مسألة الديمقراطيّة في البعد التنفيذيّ، أو في الموارد التي لم يضع الإسلام لها قانوناً ثابتاً ودائمياً، فإنّ الإسلام أجاز لجهاز الحكومة المشروعة أن تضع القوانين في هذه الدائرة التي يعبّر عنها المرحوم الشهيد الصدر بمنطقة الفراغ، وتكون هذه القوانين في إطار مباني الإسلام وتعاليمه.
إنّ دور الشعب في البناء الحكوميّ من الناحية النظريّة والمشروعيّة، هو أنّ أفراد الشعب يعملون على التحقيق والبحث عن الشخص اللائق في تنفيذ القوانين أو تنفيذها، ثمّ يدلون برأيهم له، فرأي الناس هذا بمثابة الاقتراح على القائد الدينيّ، وفي الواقع هو نوع من العهد مع وليّ الفقيه، بأنّه إذا فوّض إليه أمر رئاسة الجمهوريّة فعليهم الإطاعة. . . فهذه هي نظرية الحكومة الإسلاميّة، ولا تتنافى مع المعنى الثاني للديمقراطيّة أبداً.
ويقول في مكان آخر: إنّ دور الناس في الحكومة قابل للبحث في جانبين: أحدهما في إعطاء المشروعيّة للحكومة الإسلاميّة، والآخر في عينيّة هذه الحكومة.
وقد اتفق جميع علماء الإسلام على أنّ مشروعيّة حكومة رسول الله o كانت من الله تعالى، يعني أنّ الله تعالى أعطاه حقّ الحكومة، وليس لرأي الناس ونظرهم أيّ دور لمشروعيّة هذه الحكومة، ولكن في دائرة تحقق حكومة النبي وتطبيقها، فإنّ رأي الناس وتأييدهم له الدور الأساس، يعني أنّ النبيّ الأكرم صلىاللهعليهوآله لم يعمل في توكيد حكومته للناس بالاستفادة من الجبر والقوّة، بل إنّ المسلمين بأنفسهم بايعوا النبي طواعيّة وقبلوا بحكومته كذلك.
وفي زمان الغيبة فإنّ مشروعيّة الحكومة هي من شؤون الله تعالى لا من قبل آراء الناس، ودور الناس في زمن الغيبة ينحصر في عينيّة الحكومة لا في مشروعيّتها.
وقد تقدّم أنّ الناس لا يعطون المشروعيّة لحكومة الفقيه، بل إنّ رأيهم ورضاهم يؤدّي إلى إيجاد مثل هذه الحكومة. . . فالناس يرجعون إلى الخبراء كما يرجع الحاكم إلى البيّنة، يعني أنّهم يختارون الخبراء في الدين كيما يأخذوا بكلامهم بعنوان الحجّة الشرعيّة، وبهذا التحليل تكون الانتخابات مُمهّدة للكشف عن القائد لأنّها تعطيه المشروعيّة.
ونحن نعتقد أنّ هذا النظام يجب أن يقوم على أساس الإرادة التشريعيّة الالهيّة، ورضى الله تعالى وإذنه في الأمور المختلفة.
فأيّ تحرّك باتّجاه وضع القانون، أو تنفيذه في حقّ الآخرين، أو تصرّف في الأراضي والغابات، والجبال والبراري، واستخراج المعادن من قبيل البترول، والغاز، والذهب، والنحاس، وأمثال
(122)ذلك، فمثل هذه الأعمال والتصرّفات يجب أن تكون صادرة بإذن ومجوّز، وفي التصوّر الإسلاميّ فالمجوّز لهذه التصرّفات هو اذاً الله تعالى. . . فحكم الله مطاع في جميع الموارد، أمّا رأي الناس فله اعتبار في ما لو لم يتعارض مع الدين، وعلى أساس هذه المباني فإنّ المشروعيّة الدينيّة هي المحور، ولها امتياز وأولويّة على المقبوليّة في نظر الناس.
ويرى الأستاذ أنّ الفائدة من الانتخابات برغم أنّها لا تؤثر في مستوى إعطاء المشروعيّة للنظام، يكمن في فائدتين:
1 ـ إنّها تبعث على مشاركة الناس في إيجاد الحكومة الدينيّة، وبالتالي تعمل على جذب حماية الناس، والتفافهم حول هذا النظام الذي أوجدوه بآرائهم.
2 ـ إنّ الإمام الراحل بتأكيده أهميّة دور الناس ومشاركتهم، في الحقيقة سلب السلاح من الخصوم، حيث انّ الأعداء كانوا يريدون إظهار النظام الإسلاميّ بثوب الاستبداد، وأنّه نظام فرديّ استبداديّ، ولكن عندما يقوم هذا النظام على آراء الشعب، وتكون آراء الناس فيه معتبرة، فإنّ الاعداء سوف لا يجدون منفذاً للطعن فيه.
وخلاصة الكلام إنّه إذا كان المقصود بالديمقراطيّة هي أنّ الناس في إطار الأحكام الالهيّة والقوانين الشرعيّة يقرّرون مصيرهم، فإنّ هذا التعبير غير مخالف للدين، فالميزان رأي الشعب ما دام لم يخرج
عن إطار القوانين الإلهيّة، ولم يخالف المباني الشرعيّة، ولكن في غير هذه الصورة فإنّ رأي الناس لا اعتبار له إطلاقاً.
إنّ الشيخ المطهريّ لم يدوّن آراءه الخاصّة بالأمور السياسيّة ولكن نستخلص من مجموع مؤلّفاته أنّ نظريته السياسيّة للدّولة تقوم على أساس «الجمهوريّة الإسلاميّة» مع إشراف «وليّ الفقيه» حيث يقول في شرح ذلك:
«إنَّ كلمة الجُمهوريّة تعيّن شكل الحكومة، وكلمة الإسلاميّة تعيّن محتواها، ونحن نعلم أنّ الحكومات في العالم سواء في الماضي أو الحاضر كانت لها أشكال مختلفة. . . وأحد هذه الحكومات هي الحكومة العامّة الشعبيّة، يعني الحكومة التي يكون فيها حقّ الانتخاب لجميع الناس. . . .
مُضافاً إلى أنَّ هذه الحكومة هي حكومة مؤقّتة، يعني أنّها تتبدّل في كلّ عدّة سنوات مرّة واحدة، أي إنّ الناس إذا أرادوا فبإمكانهم انتخاب الحاكم الفعليّ مرة ثانية، أو أحياناً للمرة الثالثة والرابعة إلى حيث يسمح لهم الدستور، وإذا لم يرغبوا في ذلك انتخبوا شخصاً آخر أفضل منه...وبهذا فالجمهوريّة الإسلاميّة تعني الحكومة التي تقوم في شكلها العامّ على أساس انتخاب عامّة الناس لرئيس الحكومة مدّة محدودة، ومحتواها يكون الإسلام».
وحول إشراف الفقيه يقول أيضاً: «إنّ ولاية الفقيه ليست بمعنى أنّ الفقيه يجب أن يكون على رأس الدولة، ويحكم هو على مستوى العمل، فإنّ دور الفقيه في إحدى الدول الإسلاميّة أي الدولة التي اختار فيها الناس الإسلام بعنوان عقيدة للأيديولوجيّة، والتزموا وتعهّدوا به، فإنّ دور الفقيه هو دور الأيديولوجيّة والعقيدة لا دور الحاكم، ووظيفة المنظّر للأيديولوجيّة هو الإشراف على الإجراء الصحيح والسليم لها، فالفقيه يشرف على صلاحية مجري القانون، والذي سيكون رئيساً للدولة، ويشرف على وظائفه وأعماله التي تكون ضمن الأيديولوجيّة الإسلاميّة.
لم يكن تصوّر الناس في الزمن السابق لعصر المشروطة ـ وكذلك تصوّر الناس في هذا العصر عن ولاية الفقيه بمعنى أنّ الفقهاء هم الحاكمون على الدولة، والذين يمسكون بزمام الأمور وإدارة الحكومة، بل إنّ تصوّر الناس على طول القرون والأعصار عن ولاية الفقيه، هو أنّ صلاحيّة أيّ حاكم من حيث قابليته وصلاحيته لإجراء القوانين الوطنيّة الإسلاميّة، يجب أن تكون مورد قبول وتأييد الفقيه في المجتمع الإسلاميّ، الذي يرتبط به الناس بدين الإسلام».
أمّا بخصوص الديمقراطيّة فإنّه يقول: «في الإسلام كما تعلمون هناك حرية فرديّة وديمقراطيّة، غاية الأمر مع فارق بين الفكر الإسلاميّ والفكر الغربيّ.
إذا قلنا إنّ ميول الإنسان ورغباته هي المنشأ والأساس للحرية والديمقراطيّة، فسوف نشاهد ما هو موجود في هذا الزمان في عهد الديمقراطيّة الغربيّة.
(125)وفي النقطة المقابلة لهذا النوع من الديمقراطيّة والحريّة، هو الديمقراطيّة الإسلاميّة، فالديمقراطيّة الإسلاميّة مبنيّة على أساس حرية الإنسان، ولكنّ هذه الحريّة لا تتلخّص في حريّة الشهوات، وطبعاً فالإسلام دين تهذيب النفس ومقاومة الشهوات، ولكن ليس بمعنى قتل الشهوات، بل أن يكون الدين هو الحاكم على الشهوات والمسلّط عليها.
ففي نظر الإسلام إنّ الحريّة والديمقراطيّة يجب أن تُبنى على أساس التكامل الإنسانيّ للإنسان، يعني انّ الحريّة هي حقّ الإنسان بما هو إنسان، الحقّ الناشئ من القابليّات الإنسانيّة للإنسان، لا الحقّ الناشىء من أهواء الأفراد ورغباتهم النفسيّة، فالديمقراطيّة في الإسلام تعني الإنسانيّة المتحرّرة، والحال أنّها في المصطلح الغربيّ بمعنى الحيونة المتحرّرة».
وفي النتيجة إنّ الجمهوريّةَ الإسلاميّةَ تحت إشراف الفقهاء لا تتنافى إطلاقاً مع الديمقراطيّة، لانّ اُصول الديمقراطيّة لا تستوجب مطلقاً أن لا يكون للمجتمع عقيدة وأيديولوجيّة حاكمة، فنحن نرى أنّ الأحزاب التي ترتبط عادة بأيديولوجيّة معيّنة، لا ترى أنّ هذا ينافي اُصول الديمقراطيّة، بل تعدّه من افتخاراتها.
وعندما نتحدّث عن الجمهوريّة الإسلاميّة، فبشكل طبيعيّ سيكون الحديث ضمناً عن الحرية وحقوق الأفراد والديمقراطيّة.
الشهيد المطهريّ يذكر في كتابه «جاذبة عليّ ودافعته» فصلاً
تحت عنوان ديمقراطيّة عليّ، يقول فيه:
«إنّ سلوك أمير المؤمنين مع الخوارج كان في منتهى درجة الديمقراطيّة والحريّة، فقد كان خليفة واولئك كانوا رعيته، فكان يستطيع أن يسلك معهم كلّ سلوك مُمكن، ولكنّه لم يأمر بسجنهم أو بضربهم بالسياط، حتّى إنّه لم يقطع راتبهم الشهريّ من بيت المال، وكان ينظر إليهم مثل بقية الأفراد...
وكان الخوارج يظهرون عقيدتهم في كلّ مكان بحريّة، وكان الإمام وأصحابه يواجهونهم ويناقشونهم في عقيدتهم بمنتهى الحريّة، وكان الطرفان يتحاوران بلغة الاستدلال، ونقض دليل الآخر بدليل مثله، ولعلّ هذا المقدار من الحريّة لم يكن له سابقة في العالم، بأن تسلك حكومة مع مخالفيها بهذه الدرجة من الديمقراطيّة».
وننهي حديثنا هذا عن كلام الأستاذ الشهيد بكلماته هذه حيث يقول: «في الأعصار الجديدة كما نعرف قامت نهضة في أوروبا ضدّ الدين، واتّسعت بشكل وبآخر إلى خارج العالم المسيحيّ، ولكن كان اتّجاه هذه النهضة إلى الجانب الماديّ، وعندما نبحث عن علل هذا الأمر وجذوره، نرى أنّ ذلك يعود إلى عدم قدرة المفاهيم الكنسيّة في استيعاب الحقوق السياسيّة للأفراد.
إنّ رجال الكنيسة وكذلك بعض الفلاسفة الأوروبيّين قرّروا نوعاً من الارتباط الوهميّ بين الاعتقاد بالله من جهة، وسلب الحقوق السياسيّة وتثبيت الحكومات الاستبداديّة من جهة اُخرى، وطبعاً افترضوا وجود نوع من الارتباط الإيجابيّ بين الديمقراطيّة وحكومة الشعب على الشعب، وبين إنكار وجود الله والإلحاد.
(127)فقد افترضوا أن نقبل بوجود الله ونعتقد به، ونقول إنّ حقّ الحكومة من شؤون الله تعالى، وقد فوّضه إلى أفراد معيّنين من دون أن يكون لهم امتياز على الآخرين، أو إلحاد وإنكار وجود الله ليكون لنا الحق في تقرير المصير.
ومن وجهة نظر سيكولوجيّة، فإنّ أحد موجبات الانحسار الدينيّ هو أنّ أولياء الدين تصوّروا وجود تضادّ بين الدين وبين أحد الحاجات الطبيعيّة للإنسان، وخاصّة بعد ظهور هذه الحاجة على مستوى الأفكار العامّة والرأي العامّ.
ففي الوقت الذي وصل فيه الاستبداد والدكتاتوريّة إلى أقصى غايتها في أوروبا، وكان الناس عطاشى لفكرة أنّ حق الحكومة من شؤون الناس، فإنّ الكنيسة أو أتباع الكنيسة، أو بالاعتماد على أفكار الكنيسة، طرحوا هذا الفكر بأنّ الناس ليس لهم في شأن الحكومة سوى التكليف لا الحقّ، وهذا بنفسه كان كافياً لقيام المتعطّشين للحريّة والديمقراطيّة ضدّ الكنيسة، بل ضدّ الدين وضدّ الله بشكل عامّ».
يرى مالك بن نبي أنّ العالم الإسلاميّ ورث مفهوم الديمقراطيّة ـ كسائر المفاهيم الغربيّة ـ نتيجة احتكاكه بثقافة الغرب وحضارته، والأمر المشكّل هو جعل هذه المفاهيم في ميزان الإسلام وتقويمها من وجهة نظر دينيّة:
«إنّ مشكلة الربط بين هذين المصطلحين هي في نظري المشكلة الأساسيّة في الموضوع، يجب أوّلاً أن نميّز بينهما، وأن نعطي لكليهما ما تستحقّ شخصيته من التعريف، حتّى يتبيّن في ضوء هذا التعريف أيّ قرابة توجد بين المصطلحين».
ومن هذا المنطلق يتساءل مالك بن نبي عن معنى الإسلام ومعنى الديمقراطيّة، مع اعترافه باحتواء الكلمتين على مضمون ثري يجب من الناحية العمليّة تبسيطه إلى أقصى ما يمكن حتى تتيسّر المقارنة بينهما.
فالديمقراطيّة بالمعنى اللغويّ هي سلطة الإنسان، والإسلام ـ كما ورد في الحديث ـ الإيمان بالله وحده، والقيام بالصلاة، وأداء الزكاة، والصيام.
فلو أردنا الاكتفاء بهذا التعريف البسيط أدّى ذلك إلى مناقضة بين الاصطلاحين، لأنّه: «أيّ وجه مقارنة بين مفهوم سياسي يفيد مجمله تقرير سلطة الإنسان في نظام اجتماعيّ معيّن، وبين مفهوم ميتافيزيقيّ يفيد مجمله تقرير خضوع الإنسان إلى سلطة الله في هذا النظام أو في غيره».
لكن مالك بن نبي لم يرتض بهذه المقارنة البسيطة، حيث اخذت الديمقراطيّة بالمعنى اللغوي اقتباساً من الثورة الفرنسيّة، ولذا يقول: «ولكن ينبغي لنا في الواقع أن نعيد الكرة في تحديد الديمقراطيّة، ونحدّدها دون ربطها مسبقاً بأيّ مفهوم آخر كالإسلام،
فننظر إليها من أعمّ وجوهها، أي في إطار عموميّاتها قبل أن نربط الموضوع بأيّ مقياس مسبق، ففي مثل هذا الاطار.. . يجب أن نعتبر الديمقراطيّة من ثلاثة وجوه:
1 ـ الديمقراطيّة كشعور نحو ال «أنا».
2 ـ الديمقراطيّة كشعور نحو الآخرين.
3 ـ الديمقراطيّة كمجموعة الشروط الاجتماعيّة السياسيّة اللازمة لتكوين وتنمية هذا الشعور في الفرد.
فهذه الوجوه الثلاثة تتضمّن فعلاً مقتضيات الديمقراطيّة الذاتيّة والموضوعيّة، أي كلّ الإستعدادات النفسيّة التي يقوم عليها الشعور الديمقراطيّ، والعدة التي يستند إليها النظام الديمقراطيّ في المجتمع، فلا يمكن أن تتحقّق الديمقراطيّة كواقع سياسي إن لم تكن شروطها متوافرة في بناء الشخصيّة، وفي العادات والتقاليد القائمة في البلد.
فهذه الاعتبارات. . . تدلّ خصوصاً على أنّ الشعور بالديمقراطيّة مقيّد بشروط معيّنة لا يتحقّق بدونها، وهذه الشروط ليست من وضع الطبيعة ولا من مقتضيات النظام الطبيعيّ، على خلاف ما كانت تتصوره الفلسفة الرومانتيكيّة في عهد جان جاك روسو، بل هي خلاصة ثقافة معيّنة، وتتويج لحركة الإنسانيّات، وتقدير جديد لقيمة الإنسان، تقديره لنفسه وتقديره للآخرين» .
ويقول في توضيح طبيعة هذا الشعور:«القانون العام بالنسبة
إلى طبيعة الشعور الديمقراطيّ، سواء في أوروبا أو في بلد آخر، هو أنّ هذا الشعور نتيجة لاطّراد اجتماعيّ معيّن، فهو بالمصطلح النفسيّ، الحدّ الوسط بين طرفين كلّ واحد منهما يمثّل نقيضاً بالنسبة للآخر، النقيض المعبّر عن نفسيّة وشعور العبد المسكين من ناحية، والنقيض الذي يعبّر عن نفسية المستعبد المستبد وشعوره من ناحية اُخرى.
فالانسان الحرّ أي الإنسان الجديد الذي تتمثل فيه قيم الديمقراطيّة والتزاماتها، هو الحدّ الإيجابيّ بين نافيتين، تنفي كلّ واحدة منهما هذه القيم وتلك الالتزامات: نافية العبوديّة، ونافية الاستعباد».
إذاً لا تكون الديمقراطيّة تلك المفاهيم السطحيّة المأخوذة من اشتقاق المفردة، بل «يجب أن نقدر كلّ مشروع يهدف إلى تأسيس ديمقراطيّة، على أنّه مشروع تثقيف في نطاق أمّة بكاملها، وعلى منهج شامل يشمل الجانب النفسيّ، والاخلاقيّ، والاجتماعيّ، والسياسيّ».
ومن هذا المنطلق يبدأ مالك بن نبي بالمقارنة بين الإسلام والديمقراطيّة ليصل إلى نتيجة تفوّق الإسلام على المنهج الديمقراطيّ الغربيّ، فيقول:«أمّا الإسلام، فإنّه يمنح قيمة تفوق كلّ قيمة سياسيّة أو اجتماعيّة، لأنّها القيمة التي يمنحها له الله في القرآن في قوله: (وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ) .
فهذا التكريم يكون أكثر من الحقوق أو الضمانات ـ الشرط الأساسيّ للتعبير اللازم في نفس الفرد، طبقاً للشعور الديمقراطيّ سواء بالنسبة للأنا أم بالنسبة للاخرين، والآية التي تنصّ على هذا التكريم تبدو كأنّها نزلت لتصدير دستور ديمقراطيّ يمتاز عن كلّ النماذج الاُخرى، دون أن تعبّر عنه نصوص قانونيّة محدودة.
فنظرة النموذج الإسلاميّ إلى الإنسان، هي نظرة إلى التكريم الذي وضعه الله فيه، أي نظرة إلى الجانب اللاهوتيّ فيه، بينما النماذج الاُخرى تمنحه النظرة إلى الجانب الناسوتيّ والجانب الاجتماعيّ، فالتقويم الإسلاميّ يضفي على الإنسان شيئاً من القداسة، ترفع قيمته فوق كلّ قيمة تعطيها له النماذج المدنيّة...
فالإنسان الذي يحمل بين جانبيه الشعور بتكريم الله له، يشعر بوزن هذا التكريم في تقديره لنفسه وفي تقديره للآخرين، لأنّ الدوافع والنزعات السلبيّة المنافيّة للشعور الديمقراطيّ تبدّدت في نفسه».
ويقول بالنسبة إلى نفي العبوديّة والاستعباد: «ثمّ إنّ الإسلام الذي وضع في نفسيّة المسلم هذا التوجيه العامّ، قد وضع عن طريقه ـ يميناً وشمالاً ـ حاجزين، كي لا يقع في هاوية العبوديّة أو هاوية الاستعباد.
وهذان الحاجزان مذكوران بالإشارة في آيتين، تذكر الواحدة الهاوية ذات اليمين، والاُخرى تذكر الهاوية ذات الشمال، فيقول عزوجل: (تِلْكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي
(132)الْأَرْضِ وَلَا فَسَادًا ۚ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ) فهذا الحاجز وضع بكلّ وضوح على حافة الاستعباد، حتّى لا يقع فيه المسلم.
أمّا الحاجز الآخر الذي يحفظه من هاوية العبوديّة، فهو مذكور في قوله عزوجل: ( إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ ظَالِمِي أَنفُسِهِمْ قَالُوا فِيمَ كُنتُمْ ۖ قَالُوا كُنَّا مُسْتَضْعَفِينَ فِي الْأَرْضِ ۚ قَالُوا أَلَمْ تَكُنْ أَرْضُ اللَّـهِ وَاسِعَةً فَتُهَاجِرُوا فِيهَا ۚ فَأُولَـٰئِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ ۖ وَسَاءَتْ مَصِيرًا ٩٧ إِلَّا الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ لَا يَسْتَطِيعُونَ حِيلَةً وَلَا يَهْتَدُونَ سَبِيلًا ٩٨ فَأُولَـٰئِكَ عَسَى اللَّـهُ أَن يَعْفُوَ عَنْهُمْ ۚ وَكَانَ اللَّـهُ عَفُوًّا غَفُورًا ٩٩ ) ومجمل القول، إنّ المسلم محفوظ من النزعات المنافية للشعور الديمقراطيّ، الموجودة أو المدسوسة في طينة البشر، بما وضع الله في نفسه من تكريم مقدّس، وما جعل عن يمينه وشماله من معالم ترشد طريقه حتّى لا يقع في وحل العبوديّة أو وحل الاستعباد».
ثمّ إنّ مالك بن نبي يعتقد أنّ الديمقراطيّة الإسلاميّة عاشت أربعين سنة ـ إلى انتهاء خلافة الخلفاء الراشدين ـ وفي هذه المدّة وضعت الاُصول والاسس للديمقراطيّة الإسلاميّة، مثل: حريّة العمل والرأي، تأمين الحريّات الفرديّة طبعاً إذا لم تضرّ بمصلحة المجتمع، عدم استبداد الحاكم بالرأي، توزيع الثروة بصورة صحيحة عبر
قانون الزكاة، قانون تحريم الربا وهكذا.. . فالإسلام يجمع بين الديمقراطيّة السياسيّة والديمقراطيّة الاجتماعيّة بنحو أتمّ.
يقول: «إنّ المبادئ التي قرّرها الإسلام في المجال السياسيّ والمجال الإجتماعيّ، ووضعها في أساس ما يمكن أن نطلق عليه (الديمقراطيّه الإسلاميّة) قد تحقّقت فعلاً في واقع المسلمين، وقد كان أثرها حقيقياً في سلوك الأفراد في أعمال الحكم».
ولكن حدث في العالم الإسلاميّ حادث منع المشروع الديمقراطيّ الإسلاميّ من أن يواصل سيره في التاريخ، وهو تسلّم معاوية للسلطة: «لا شك أنّ عهد معاوية مثلاً كان من الوجهة التي تهمّنا هنا عهد تقهقر الروح الديمقراطيّ الاسلاميّ».
وختاماً: «يمكن أن نستخلص من هذه الاعتبارات رأياً، فيما يخصّ مستقبل الديمقراطيّة في البلاد الإسلاميّة، فهذه البلاد تمرّ قطعاً بحالة إرهاص تبشّر بنهضة الروح الديمقراطيّة في هذه البلاد، حيث تجري تجارب ديمقراطيّة ملحوظة.
ولكنّ هذه المحاولات لا تنجح إلّا بقدر ما تضع في ضمير المسلم تقويماً جديداً للإنسان، أي بقدر ما تضع في ضميره قيمته وقيمة الآخرين، حتّى لا يقع في هاوية العبوديّة أو هاوية الاستعباد».
ويمكن تصوير الأقوال التي مرّ ذكرها كالتالي:
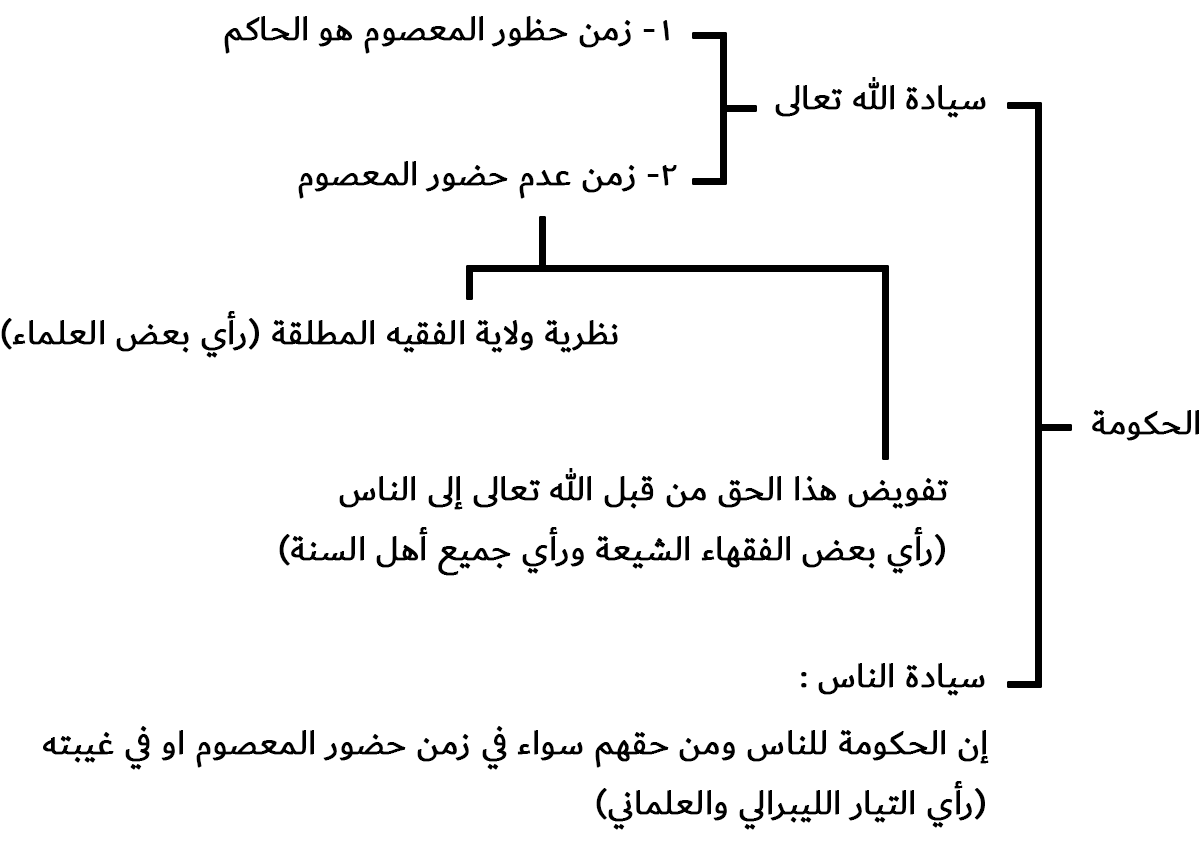
يمكن تقسيم الأقوال التي مرّت بالنسبة إلى الإسلام والديمقراطيّة، الى قسمين كلّييّن: القسم الأوّل يبحث عمّن يعتقد بأنّ أمر الحكومة وتعيين الحاكم من شؤون الله واختياراته، والقسم الثاني يبحث عمّن يعتقد بأنّ أمر الحكومة وتعيين الحاكم شأن من شؤون الناس وهم الذين ينتخبون شخصاً لتدبير أمورهم.
ونقول في توضيحه:
(136)إنّ أمر الحكومة وتعيين الحاكم تابع لله تعالى بدليلين:
أ: إنّ العقل يحكم بأنّ تأسيس الحكومة، بحيث ينبغي لجميع الناس متابعتها، لا يجوز إلّا لمن كان مالكاً لجميع أمور الناس، بحيث يعدّ ايّ تصرّف في أمورهم تصرفاً فيما هو له وملكه، وهذا لا يكون إلّا لله تعالى المالك لجميع الكائنات، فلذا لا تحقّ الحكومة لأحد غيره تعالى، وكلّ حكم بدون إذنه يكون غصباً وغير مشروع، فالله ـ بحكم العقل ـ لا بدّ من أن يعين الحاكم بنفسه.
ب: يُبنَى التوحيد الخالص على أنّ حقَّ التقنين لله تعالى وحده، ولا يحقّ لأحد غيره التقنين والتشريع.
إنّ فلسفة وجود الحكومة هي تقنين القوانين، ووضع الأحكام طبقاً لمصالح الناس ومفاسدهم الواقعيّة، ودعوة الناس إلى إجرائها والعمل بها، ومعاقبة المتخلفين عنها.
إنّ الله تعالى هو العالم الحقيقيّ بمصالح الناس والمجتمع الواقعية، وهو المالك لهم، فلذا لا يحقّ التقنين لأحد غيره، فلو كان معنى الديمقراطيّة نقل هذا الحقّ الى الناس، فهذا خروج عن التوحيد الخالص ودخول في الشرك.
مضافاً إلى أنّ قوله تعالى: (إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّـهِ) وقوله: (وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّـهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ) يؤيدان ذلك.
1 ـ 1: بعد ما علمنا أنّ المشرّع للحكومة والمقنن هو الله تعالى، فهو الذي أرسل الرسل لأجل هذا، وفي الحقيقة أنّ أهمّ وظائف الأنبياء تأسيس نظام عادل يجري القوانين والأحكام الإلهيّة في المجتمع، وبناء على اعتقاد الشيعة الإماميّة انتقلت هذه الوظيفة بعد النبي صلىاللهعليهوآله إلى الأئمة الاثني عشر عليهمالسلام :.
1 ـ 2 ـ 1: ذهب بعض فقهاء الشيعة إلى نظرية ولاية الفقيه المطلقة في زمن غيبة المعصوم، لأنّنا نعلم أنّ رسول الله صلىاللهعليهوآله هو خاتم الأنبياء، وأنّ دينه أتمّ الأديان وأكملها، بحيث ما ترك أيّ حاجة من حوائج الناس إلّا ذكرها، فلو لم يُعيّن أمر الحكومة في زمن الغيبة، كان ذلك نقصاً فاحشاً في ساحتي التشريع والتقنين.
فالعقل والنقل يحكمان بلزوم بقاء الحكومة الإسلاميّة، وبما أنّ الحكومة الإسلاميّة هي حكومة القانون الإلهيّ، يجب أن يتّصف الوليّ بصفة : 1 ـ العلم بالقانون. 2 ـ العدالة. فالشخص الوحيد الذي يستحقّ تولّي هذا الأمر هو الفقيه العادل.
1 ـ 2 ـ 2: إنّ أمر الحكومة بعد رحيل الرسول الأكرم صلىاللهعليهوآله ـ بناء على اعتقاد أهل السنة ـ وبعد غيبة الإمام الثاني عشر: ـ بناء على رأي بعض الفقهاء ـ مفوّض من قبل الله تعالى إلى الناس، وهم الذين يختارون شخصاً لتولّي أمر الحكومة.
لذا يقول العلّامة الطباطبائي: «ولكن على ايّ حال أمر الحكومة الإسلاميّة بعد النبيّ صلىاللهعليهوآله وبعد غيبة الإمام ـ كما في زماننا الحاضر ـ إلى المسلمين من غير إشكال. . .».
وقد بيّن أصحاب هذا القول معتقدهم بطريقين متقاربين:
ألف: نظرية خلافة الإنسان المؤمن:
إنّ الله تعالى هو المالك الحقيقيّ وهو الذي جعل الإنسان خليفته في الأرض، قال تعالى: (لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ)، وقال أيضاً: (إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً).
وتدلّ هذه الآية على خلافة الإنسان عن الله تعالى في إعمار الأرض، والإنسان تحمّل هذه المسؤوليّة باختياره: (إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ) فالإنسان يقوم بأداء هذه المهمّة في إطار الشريعة الالهيّة وأصل الشورى.
ب: ولاية الأمة على نفسها:
إنّ الولاية لله تعالى، وهو الذي جعل هذه الولاية في زمن الغيبة للشعب، ويدلّ عليه قوله تعالى: (وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ)، والشعب يستعمل هذه الولاية من طريق أصل الشورى، وفي دائرة القوانين الثابتة الالهيّة.
إنّ أصل الشورى شُرّع من قبل الله تعالى في آيتين محكمتين: (وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ)، (وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ)، كلمة
«الأمر» هنا بمعنى الأمور العامّة المرتبطة بالحكومة وسائر الشؤون الاجتماعيّة للناس.
بمعنى أنّ الحاكم يأخذ شرعيّته من الناس، وهم الذين ينتخبونه لتدبير الحكومة. وأهمّ الأقوال في هذا القسم أربعة:
الف: إنّ الحكومة من فروع الحكمة العملية، ومشتقة من التدبير والحكمة، ولم تكن بمعنى الأمر والولاية والقيوميّة.
هذه النظرية تعتمد على ركنين أساسيّين: 1 ـ الملكيّة الشخصيّة الإنحصاريّة. 2 ـ الملكيّة الشخصيّة المشاعة.
1 ـ الملكيّة الشخصيّة الانحصاريّة: إنّ القانون الطبيعيّ الذي فُطر الإنسان عليه يقتضي أن يختارّ كلّ شخص مكاناً لسكنه، وهذا المكان سيكون متعلقاً ومختّصاً به وهو المالك له، كما تدلّ عليه القاعدة المعروفة: «من سبق إلى مكان فهو أحقّ به»
وهذه القاعدة وإن كانت مستخرجة من الروايات، ولكنَّها في الحقيقة إرشاد الى ما تقتضيه حياة الإنسان الطبيعيّة والفطريّة النابعة من احتياج كلّ إنسان إلى مكان ليسكن فيه، ولا تخضع لأيّ جعل وتقنين اجتماعيّ أو شرعيّ أو عقلانيّ.
2 ـ الملكيّة الشخصيّة المشاعة: إنّ الإنسان يدرك بفطرته أنّه لو بقي في مكانه الانحصاريّ لا يتمكّن من إدامة الحياة، فلذا تحكم طبيعة الحياة بالخروج من هذا المكان الخاصّ إلى مكان أوسع لرفع حوائجه وبقائه حيّاً. فيحصل حينئذٍ ارتباط بين المكان الخاصّ والمكان الثاني غير الخاصّ به، وهذا الثاني مع كونه ملكاً شخصيّاً
لكنّه غير انحصاريّ بل أصبح مشاعاً بينه وبين الآخرين، وهذا أيضاً لا يخضع للوضع والتقنين بل ينتج من ضرورة الحياة الطبيعية. وبناء على هذا فالعقل العمليّ لهؤلاء يرشدهم إلى تعيين وإيكال شخص ينوبهم في تنظيم حياتهم الاجتماعيّة.
ويدلّ قولُه تعالى: (لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ) على أنّ وظيفة الأنبياء التعليم والإرشاد، أمّا القيام بالقسط والعدل وإجراء العدالة فموكول إلى الناس، وليست وظيفة الإجراء من شأن الأنبياء ومنزلتهم.
ب: للحكومة معنى مستقلّ عن الدين، وينبغي أن تبحث خارج دائرة الدين أنَّ للإنسان بمجرد كونه إنساناً ـ حقوقاً وتأسيس الحكومة من جملة هذه الحقوق. إنّ مفهوم الحكومة غير مفهوم الصلاة، إنّ الدين هو المؤسّس والواضع للصلاة، ولكنّ الحكومة ليست كذلك.
الحكومة الدينيّة منبعثة من المجتمع الديني، والحكومة اللادينية منبعثة من مجتمع لا ديني.
ج: إنّ الديمقراطيّة ضرورة من ضرورات عصرنا، وليس المطلوب منها مراعاة المعنى اللغويّ لها، إنّما المطلوب منها إحداث انقلاب في شتّى المجالات الفكريّة والاجتماعيّة، ومن جملة هذا الانقلاب القول بالشرك في الحكم، وإحلال الولاء للحزب محلّ الولاء للشخص وإحلال التنظيم الحزبي محلّ التنظيم الطائفيّ.
د: ليست الديمقراطيّة بدعة غربيّة، أو مذهباً مستورداً، أو نظاماً واحداً، بل هي روح الشريعة وأـساس نظامها، ولكن حصلت هناك أزمة لتحقّقها في وجداننا المعاصر، ولهذه الأزمة جذور يمكن فرزها في خمس مجموعات أساسية : 1 ـ حرفيّة التفسير. 2 ـ تكفير المعارضة. 3 ـ سلطويّة التصور. 4 ـ تبرير المعطيات. 5 ـ هدم العقل. ولأجل حلّ هذه الأزمة يجب من اقتلاع هذه الجذور من أساسها.
الذين اعتقدوا بأنّ أمر الحكومة وتعيين الحاكم إنّما هو لله تعالى أوّلاً وبالذات، لما واجهوا مسألة الديمقراطيّة انقسموا ـكما مرّـ إلى قسمين: قسم منهم خالفها مطلقاً، والقسم الثاني خالفها أيضاً ولكن وضع شروطاً لقبولها، من قبيل أنْ تكون في الجزئيات التي لا نصّ فيها، أو من قبيل تشخيص الموضوع المفوّض أمره إلى الناس، أو فيما لا يتقاطع مع النصوص الثابتة الدينيّة، أو جعلها بمثابة الشورى.
وعمدة الأدلّة في مخالفة هؤلاء، أنّ الديمقراطيّة تعطي حقّ السيادة وحقّ التشريع للشعب، وهذا ما لا يتوافق مع النظرة التوحيديّة الدينيّة حيث ترى اختصاص هذين الحقّين بالله تعالى.
والملاحظ على هؤلاء أنّهم أعطوا رؤية أحاديّة للديمقراطيّة وفسّروها بتفسير واحد، واعتقدوا أنّها ذات أيديولوجيّة ونظام يعتمد أساساً على فصل الدين عن السياسة، أو على نظرة ماديّة للعالم وللإنسان، فلذا لا يمكن التوافق بينها وبين الدين إلّا بتمحّل وعناء.
ولكن كما قلنا إنّ للديمقراطيّة معاني مختلفة، وكلٌّ حاول
(142)تفسيرها بما يتوافق مع أيديولوجيته ونظرته الكونيّة، فبالإمكان إعطاء تفسير لها يتوافق مع مبادئنا ونظرتنا الكونيّة للعالم وللإنسان، فالمفاهيم ليست حكراً على أحد.
وقد يقع أرباب هذا القسم في خطأ آخر، وهو الخلط بين الديمقراطيّة وبين ما امتزجت به من فلسفات ماديّة وإلحاديّة كالليبراليّة والماركسيّة أو غيرهما.
ولكن هذه الفلسفات والايديولوجيّات شيء والديمقراطيّة ـ حسب تفسيرنا شيء آخر، ولا يصحّ مزجهما وإعطاء حكم واحد لهما. فنحن لو فسّرنا الديمقراطيّة بأنَّها آليّة ووسيلة للعمل السياسيّ، وأفرغناها من محتواها الإلحاديّ الذي امتزجت به نتيجة الظروف والشرائط التي تولّدت فيها، أمكننا الأخذ بها ودمجها مع ثقافتنا الدينيّة، كما أشرنا إليه في الفصل الأول.
أمّا الذين ذهبوا إلى أنّ أمر الحكومة إنّما هو للناس خاصّة، فنظرتهم هذه تُبنَى على فصل الدين عن السياسة، والاعتقاد بأنّ أمر الحكومة وتعيين الحاكم من حقوق الناس الخاصّة، ولا يخضع لأيّ جعل شرعيّ.
والملاحظ عليهم أنّهم نظروا إلى أمر الحكومة وضرورة تأسيسها نظرة ماديّة بحتة، وأعطوها تفسيراً أحاديّاً أيضاً، فجعلوا مهمّة الدولة قضاء حوائج الناس الماديّة والآنيّة فقط، من قبيل تأمين الرفاه، السكن، الأمن، العمل وما شاكل.
ومن جهة اُخرى أعطوا للدين أيضاً تفسيراً خاصاً، وأحجموه في الجانب الآخرويّ والشخصيّ للإنسان وحده، ولذا خرجوا بهذه النتيجة وبالطبع خضعوا للديمقراطيّة بجميع أنواعها وتفاسيرها.
(143)ولكن إذا وسّعنا الدائرة، وتعدّينا هذه النظرة الأحاديّة للدين والدنيا، أمكننا مدّ جسور بينهما، وعقد الصلة بين الأرض والسماء، وهذا ما نتبنّاه في بحثنا هنا، ونحاول شرحه وإيضاح معالمه ضمن النقاط التالية:
1 ـ إنّ نظرتنا إلى العالم نظرة إلهيّة، تعتمد على اعتقاد وجود خالق ومدبّر للعالم، له الأمر والخلق، وهو المبدأ والمنتهى. هذه النظرة هي الأساس في جميع أعمالنا وأفكارنا واتجاهاتنا، فإذا كان كلّ انسان يعمل على شاكلته ـ كما قال تعالى : (قُلْ كُلٌّ يَعْمَلُ عَلَىٰ شَاكِلَتِهِ) ـ وهذه الشاكلة هي التي تحدّد مسير الإنسان ومنهجه في حياته، فشاكلتنا التي تحدّد مسيرنا ومنهجنا هي هذه النظرة الإلهية.
2 ـ نعتقد أنّ الإنسان خلق ليكون خليفة الله تعالى في أرضه، ولهذا الإنسان حوائج معنوية وحوائج مادية، وبإشباعهما معاً بصورة صحيحة يصل الإنسان الى أعلى المراتب.
ومن أهمّ هذه الحوائج نيل السعادة في الدارين، ولا يخفى أنّ الوصول إلى هذه السعادة صعب المنال، ويحتاج إلى برنامج واسع وشامل لجميع أبعاد الإنسان سواء المعنوية أو المادية، وسواء عرفها الإنسان وانتبه إليها او لم يعرفها.
ومن البديهيّ أن لا يتمكن أيّ شخص رسم هكذا برنامج شامل لنفسه أو لغيره، لأنّه فرع معرفته بجميع أبعاد وجود الإنسان وحوائجه، وما لم تشبع هذه الحوائج ولم تتحقّق بصورة صحيحة وواقعيّة، لن يصل الإنسان إلى السعادة.
(144)3 ـ نعتقد أنّ الدين والشرع الالهيّ هو القادر الوحيد على رسم هذا البرنامج الشامل، وهو المتكفّل لإيصال الإنسان إلى السعادة الكاملة، سعادة الدنيا والآخرة، فالله سبحانه وتعالى لمعرفته بجميع أبعاد وجود الإنسان وحوائجه: (أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ) له الحق في تعيين مصيره ورسم برنامجه السلوكيّ، وهذا ما تحقّق على يد الأنبياء.
4 ـ هذا البرنامج الإلهيّ لا يمكن أن يبقى ويستمرّ وينتشر ما لم يقترن بنظام سياسيّ يأخذ على عاتقه نشره والدفاع عنه وتبيين معالمه، فبقاء الدين رهن اقترانه بالنظام السياسيّ، ويؤيّده ما ورد عن الإمام أمير المؤمنين عليهالسلام حيث قال: «اللهم إنّك تعلم أنّه لم يكن الذي كان منّا منافسة في سلطان، ولا التماس شيء من فضول الحطام، ولكن لنردّ المعالم إلى دينك، ونُظهر الإصلاح في بلادك، فيأمن المظلومون من عبادك، وتُقام المعطّلة من حدودك».
وهذا يدلّ بوضوح على أنّ الحفاظ على معالم الدين وإقامة حدود الشريعة، لا يتأتّى إلّا بنظام سياسيّ شامل ومقتدر.
وطبعاً عندما نتكلّم عن الحكومة وضرورة تأسيسها، لا نقصد جانبها الماديّ والدنيويّ الذي يتكفّل بتأمين حوائج الناس الماديّة وحدها، فلو كانت حوائج الإنسان مقتصرة على الحوائج الماديّة وحدها، واقتصرنا على تأمين سعادته الدنيويّة، فهذا لا يحتاج إلى جعل الهيّ، بل هو متروك للناس شأنه شأن سائر ما يحتاجون إليه من الضروريّات الأوليّة كالأكل والنوم...
لكنّنا كما قلنا ننظر إلى الإنسان نظرة ثنائيّة، ونعتقد أنّ الإنسان كما يحتاج الى تأمين الجانب الماديّ في حياته، كذلك يحتاج إلى تأمين البُعد المعنويّ أيضاً وهو أهمّ وأخطر، وتأمين هذين البُعدين خارج عن قدرة الإنسان ويحتاج إلى برنامج إلهيّ كما قلنا، وهذا هو الذي دعانا للقول بلزوم الترابط بين الدين والسياسة، وبالتالي إلى تأسيس الحكومة الدينيّة.
5 ـ إنّ الآليات والوسائل التي يستعملها الإنسان لنيل ما يرومه لا تؤخذ من الدين، بل هي لتغيّرها وعدم ثبوتها تابعة للظروف والشرائط التي يعيشها الإنسان، فكلّ عصر يقتضي آليّة ووسيلة معينة، فالشريعة هي المتضمنة للثوابت الدينيّة، وأمّا الآليّات والوسائل فتعدّ من المتغيرات التابعة لشرائط الزمان والمكان.
يقول الشهيد المطهريّ: «ليس معنى القانون الإسلاميّ والقانون الدينيّ، أنّ الناس يرجعون إلى الكتاب والسنة لمعرفة حكم جميع جزئيّات حياتهم، وعلى سبيل المثال إنّ أوضاع المدن تتغيّر، والناس يستعملون وسائل جديدة للانتقال من مكان إلى مكان آخر، فيحتاجون إلى قوانين المرور لتنظيم أمر المواصلات، والّا فستحدث الفوضى، فهذه الأمور ممّا تركها الإسلام وفوّض أمرها إلى الناس».
ويشير في مكان آخر إلى أنّ التزاماتنا الدينيّة على نوعين: نوع منها له إطار مشخّص عيّن الإسلام جميع خصوصيّاته وشرائطه، وأراد منّا أداءه بنحو خاصّ. ونوع آخر منها أراد الإسلام منّا أداءه
(146)ولكن ترك الوسائل الموصلة إليه لنا، وهذه الوسائل والسبل تختلف باختلاف الزمان والمكان.
وعلى سبيل المثال قد فرض علينا الدفاع عن حوزة الدين، ولكن من دون تعيين الوسائل والآليّات التي تستعمل لحفظه، بمعنى أنّها متروكة لتشخيصنا وانتخاب الأحسن منها حسب الشرائط والظروف المحيطة بنا، وكذلك بالنسبة الى آليّات قيادة الناس وهدايتهم، فالإسلام لم يرسم لنا آليّات معينة مائة بالمائة بجميع أجزائها ومقدّماتها ومقارناتها وموانعها، لانّ هذه الوسائل والآليّات متغيّرة وغير قابلة للتعيين، فآليّات قيادة الناس ليست أمراً تعبديّاً كالصلاة مثلاً.
ولذا نرى أنّ العلامّة الطباطبائيّ يقول بالنسبة إلى كيفيّة الحكومة: «إنّ الشريعة تتضمّن الثوابت الدينيّة فقط، أمّا كيفية الحكومة ]أي آليّات عملها[ فقابلة للتغيير والتبديل حسب التقدّم الحضاريّ الطارئ على المجتمع».
6 ـ الديمقراطيّة في أحد تفاسيرها ـ كما مرّ ـ ما هي إلّا آليّة للعمل السياسيّ، وليست نوعاً من أنواع المجتمع، ولا مجموعة من الأهداف الأخلاقيّة والايديولوجيّة، وهدفها بلورة رأي الناس وإيضاحه كما هم عليه لا أكثر، فهي كما قلنا: «آلة قانونيّة تعصم مراعاتها المجتمع من الوقوع في متاهات الاستبداد والدكتاتوريّة».
هذه الآليّات والوسائل لا تعطي أيديولوجيّة ونظرة كونيّة، ولا تنفي أيضاً أيّ أيديولوجيّة ونظرة كونيّة عن المجتمع اللهمّ إلّا النظرة الاستبداديّة.
فالديمقراطيّة كالكأس يمكن أن يُشرَب بها الماء الحلال، ويمكن أن يُشرَب بها الخمر الحرام، فالكأس وضع للشرب لا أكثر، وهذا الإنسان هو الذي يُلبسها ثوب الحلّية أو الحرمة بحسب استعماله لها.
وفي هذا يقول الشيخ المطهريّ: «إنّ أصول الديمقراطيّة لا تقتضي نفي الأيديولوجيّة عن المجتمع أبداً، نحن نرى الأحزاب عادة لا تأبى الانتساب إلى أيديولوجيّة معيّنة، بل تفتخر بهذا الانتساب فضلاً عن أن تراه مغايراً للاُصول الديمقراطيّة، إذاً لا مانع من أن نكون متدينيين وديمقراطيين في الوقت نفسه».
فبالإمكان إذاً تأسيس حكومة تقوم في شكلها وقالبها على أساس الديمقراطيّة وانتخاب الناس لرئيس الحكومة، ويكون محتواها دينيّاً وإسلاميّاً، فلا تضادَّ ولا تعارض بين الدين وبين الديمقراطيّة بهذا المعنى، وليس لنا طريق آخر للجمع بين الدين والديمقراطيّة سوى هذا الطريق، أي اتخاذ الديمقراطيّة كوسيلة وآليّة للعمل السياسيّ في هذا الزمان، أما سائر الطرق فتشكو من تعارضات معرفيّة تؤدّي الى نفي الدين وانحساره عن العمل السياسيّ، أو نفي الديمقراطيّة.
وبناءً على هذا التفسير لا فرق بين زمن حضور المعصوم أو غيبته، ولا فرق بين الفكر الإماميّ والفكر السنيّ، بعد ما عرفت أنّها آليّة للعمل السياسيّ لا أكثر، نعم إلّا أن يصدر من قبل المعصوم تصريح بنفيها.
هذا، ولكن لو اعتقدنا أنّ الدين يتدخّل حتى في رسم الآليّات والوسائل التي يسلكها الإنسان لنيل مآربه وحوائجه تدخّلاً تاماً،
(148)وقلنا إنَّ للإسلام طريقة حكم وآليّات خاصّة فريدة تختلف عن سائر الطرق والآليّات، فهنا لا يمكننا الجمع بين الدين والديمقراطيّة وبين أيّ نظام آخر، ولا نتمكّن من استعمال مُصطلح «الديمقراطيّة الدينيّة» للتنافر الحاصل بينهما.
هذا هو رأينا المختار، وما نعتقده ونلتزم به من إمكانيّة الجمع بين الدين والديمقراطيّة بالمعنى الذي ذكرناه، وبالتالي تأسيس حكومة دينيّة ديمقراطيّة.
نعم تبقى هنا عدّة تساؤلات تجول في الذهن، وتبقى كعقبة أمام قبول هذا التفسير والجمع، كان لزاماً علينا الإشارة إلى أهمّها والإجابة عنها.
فمن تلك الإشكالات القول إنّ الديمقراطيّة تعني الخضوع أمامَ رأي الأكثريّة، والأكثريّة لا تكون مع الحقّ غالباً، بل ورد ذمّها في العديد من الآيات القرآنيّة، من قبيل قوله تعالى: (وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُم ۚ مِّنْهُمُ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ).
(وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنجِيلَ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِم مِّن رَّبِّهِمْ لَأَكَلُوا مِن فَوْقِهِمْ وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِم ۚ مِّنْهُمْ أُمَّةٌ مُّقْتَصِدَةٌ ۖ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ سَاءَ مَا يَعْمَلُونَ).
(فَإِن تَوَلَّوْا فَاعْلَمْ أَنَّمَا يُرِيدُ اللَّـهُ أَن يُصِيبَهُم بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ ۗ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ).
ونقول في الجواب:
أولا: إنّ القرآن الكريم عندما يذمّ الأكثريّة لا يريد إعطاء رؤية فلسفيّة وحقوقيّة لهذه اللفظة، بمعنى أنّ الأكثريّة تساوي الباطل دائماً، ولو تدبّرنا الآيات الواردة في ذمّ الأكثريّة ـسواء التي ذكرناها أم التي لم نذكرها ورأينا صدرها وذيلها لرأينا أنّ الذمّ متوجّه لمن ترك الحقَّ وجعله وراء ظهره، وهم كانوا يشكلون الأكثرية انذاك فورد الذمّ بهذه الصيغة.
وعلى سبيل المثال الآية الاُولى والثانية تدلّان على أنّ أهل الكتاب لو آمنوا وأقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم، لكانوا أكثريّة مؤمنة ولورد المدح بحقّهم، ولكن بما أنَّهم رفضوا صاروا أكثريّة مذمومة، وكذا الحال في أيّ مجتمع آخر.
والشاهد على كلامنا ما ورد من مدح الكثرة في آيات اُخرى، من قبيل قوله تعالى: (وَكَأَيِّن مِّن نَّبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ فَمَا وَهَنُوا لِمَا أَصَابَهُمْ).
وقوله تعالى: (أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّـهَ يَسْجُدُ لَهُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَالنُّجُومُ وَالْجِبَالُ وَالشَّجَرُ وَالدَّوَابُّ وَكَثِيرٌ مِّنَ النَّاسِ ۖ وَكَثِيرٌ حَقَّ عَلَيْهِ الْعَذَابُ) حيث تساوت النسبة.
يقول الميرزا النائينيّ في الردّ على من جعل الأخذ بالأكثريّة من البدع: إنّ من لوازم الشورى الثابتة بنصّ القرآن الأخذ بالترجيحات عند التعارض، والأكثريّة عند الدوران من أقوى المرجّحات النوعيّة، والأخذ بالطرف الأكثر أرجح عقلًا من الأخذ بالشاذّ، وعموم التعليل
الوارد في مقبولة عمر بن حنظلة يشعر إلى هذا.
ولفظ المقبولة: (..ويترك الشاذّ الذي ليس بمشهور عند أصحابك، فإنّ المجمع عليه لا ريب فيه) ويؤيّده ما ورد عن زرارة عن الإمام الباقر عليهالسلام عند تعارض الأحاديث: «خذ بما اشتهر بين أصحابك ودع الشاذّ النادر».
وهذا ربّما هو السبب في العمل بالشهرة الفتوائيّة، فالشهرة وإن لم تعيّن الصواب والحقّ في الأمر نفسه، فإنّ الحقّ حقّ سواء وافقته الأكثريّة أم خالفته، فالمعتبر هو الكيف لا الكمّ، ولكن عندما يتساوى الكيف يرجع إلى الجانب الكميّ من باب أنّه عنصر موجب لتصاعد الجانب الكيفيّ.
قال المظفّر: «من المعروف عن المحقّقين من علمائنا أنّهم لا يجرأون على مخالفة المشهور، إلّا مع دليل قويّ ومستند جليّ يصرفهم عن المشهور، بل ما زالوا يحرصون على موافقة المشهور وتحصيل دليل يوافقه، ولو كان الدالّ على غيره أولى بالأخذ وأقوى في نفسه، وما ذلك من جهة التقليد للأكثر ولا من جهة قولهم بحجيّة الشهرة، وإنّما منشأ ذلك إكبار المشهور من آراء العلماء سيّما إذا كانوا من أهل التحقيق والنظر.
وهذه طريقة جارية في سائر الفنون، فإنّ مخالفة أكثر المحقّقين في كلّ صناعة لا تسهل إلّا مع حجّة واضحة وباعث قويّ، لانّ المنصف قد يشكّ في صحّة رأيه مقابل المشهور، فيجوّز على نفسه الخطأ ويخشى أن يكون رأيه عن جهل مركّب، ولا سيّما إذا كان قول
المشهور هو الموافق للاحتياط».
وثانياً: كما قال العلّامة الطباطبائيّ: «إنّ رأي الأكثريّة يتبع دائماً نوع الثقافة والفكر والتربية التي نشأت عليها الأكثريّة، وهذا الأمر بعد إشباعه بالبحوث الإجتماعيّة والنفسيّة وصل إلى حدّ البداهة، فالأجواء التي يُنشِئها الإسلام من معرفة الله والتقوى الدينيّة، لا يمكن معها إخضاع الأكثريّة عقلهم السليم للأهواء والميول، فيكون حينئذٍ رأي الأكثريّة دائماً موافقاً للحقّ.
ولا تختصّ هذه الخاصّة بالمجتمع الإسلاميّ، ففي أيّ مجتمع آخر مُنحطّ أو متقدّم ـ لا يمكن أن يتكوّن الرأيّ العام من دون أن يتأثّر بالتربية الأخلاقيّة والعادات والثقافة العامّة في المجتمع».
فتلخّص أنّ الأكثريّة في نفسها لا تدلّ على مدح ولا على ذمّ، فلا بد في تقويمها من مراجعة المحتوى الذي اختلطت به، فاذا كان حسناً كانت حسناً واذا كان سيئاً كانت سيئة.
ومن الإشكالات أيضاً مسألة تهميش دور الأقليّة، فنقول: إنّ هذه المشكلة قائمة وموجودة وأثارت جدليّات كثيرة، ولكنّها أوّلاً لا تمسّ أصل النظريّة من إمكانية الجمع بين الدين والديمقراطيّة، وثانياً بالإمكان رسم خطط وبرامج تفسح المجال للأقليّة بإبداء رأيها عبر الصحف والمجلات ووسائل الإعلام، وتقف أمام استبداد الأكثريّة.
ومنها أيضاً احتمال مصادرة الآراء والأصوات من قبل أصحاب الثروة والقدرة الذين بيدهم وسائل الإعلام. فنقول: هذا أيضاً من المشاكل الحقيقيّة، ولكنّه لا يمسّ أساس النظريّة، ويمكن وضع
حلول للصدّ عن هذا الأمر، من قبيل تشديد الرقابة، وفسح المجال لإشراف الناس وتفعيل دورهم، وإعطائهم صلاحيّات كافية، وغير ذلك.
ومنها أنّ الدين يعطي حقّ التشريع والتقنين لله تعالى، والديمقراطيّة تعطيه للإنسان، فكيف يمكن الجمع بينهما؟
الجواب: أولاً كما قلنا مراراً إنّ تفسيرنا للديمقراطيّة ليس تفسيراً ايديولوجيّاً، بل جعلناها آلة ووسيلة للعمل السياسيّ، يمكن أن تجتمع مع التقنين الإلهيّ.
وثانياً قلنا إنّ رأي الأكثريّة يتبع دائماً نوع الثقافة والفكر والتربية التي نشأت عليها الأكثريّة، فالأجواء التي يُنشئها الإسلام من معرفة الله والتقوى الدينيّة لا يمكن معها إخضاع الأكثريّة عقلهم السليم للأهواء والميول، إلّا بعوامل خارجيّة اُخرى من تهديد وتطميع وتمويه للحقيقة.
وثالثاً هذه الأكثريّة المؤمنة لما تريد أن تعمل بالدين وتصغي إلى أوامر الله تعالى، ولمّا تريد التشريع والتقنين لنفسها سترجع إلى القوانين الالهيّة، وتستنبط برنامجها العملي منه بدل رجوعها إلى الحقوق الوضعيّة أو الطبيعيّة والماديّة، وبهذا يجري التقنين والتشريع وفقاً للاُصول الدينيّة والديمقراطيّة.
ومنها وهو أهمّها أنّ هذه الأكثريّة لو انحرفت يوماً ما، وأرادت التحرّر من الإلزامات الدينيّة، فما هو الحلّ ؟ هل نلتزم بمبادئ الديمقراطيّة وندع الأمور لهم، ونتنازل عن مبادئنا؟ أم نقف بوجههم ونمنعهم من ذلك ولو باستعمال العنف ؟
(153)الجواب: في الحقيقة أنّ هذا من أهمّ إشكالات المتديّنين على الديمقراطيّة والباعث القويّ لنفيها، وأعتقد شخصيّاً انّ الأمر تابع للمباني الفكريّة والثقافيّة التي نعتقد بها ونستلهمها من واقع الدين.
فلو توصّلنا في فهمنا الدينيّ إلى أنّ للحكومة الدينيّة إجبار الناس وإكراههم بشتّى الوسائل على الالتزام الدينيّ وعدم التخلّي عنه، فهذا ما لا يمكن جمعه مع الديمقراطيّة، وبالتالي يجُرّنا إلى رفضها وإلغاء مصطلح «الديمقراطيّة الدينيّة» نهائياً.
ولكن لو قلنا إنّ الدين لا يسمح بإجبار الناس على الإلتزام الدينيّ، حتّى لو فرضنا انحرافهم عن جادّة الحقّ فمقتضى العدل والدين والعقل عدم إجبارهم على شيء، فإنّ الإجبار ينتج عكس المطلوب، ويبقي الشعب محجوراً عليه غير قادر على انتخاب الأحسن بعد خوض التجارب والنقد والتمحيص.
يقول الشهيد المطهريّ: «إنّنا لو أردنا رقيّ الإنسان نحو الكمال، فلا بدّ أن ندعه حرّاً في أعماله وانتخابه وإن أخطأ في بداية أمره، فلو سلبنا حريّات الشعب بحجّة عدم رشده وبلوغه وأجبرناه على شيء، فسيبقى هذا الشعب غير رشيد الى الأبد، إنّ رشده في إعطائه الحريّة ولو أخطأ فيها مائة مرة. . . .
إنّ الإسلام الذي رفض التقليد، وقال إنّي لا أقبل منكم اعتناق أصول الدين إلّا إذا كان عن وعي وإدراك حرّ، فدين كهذا هل يمكن أن يجبر الناس على اعتناق الإسلام ؟ ! إنّ ما فعله الإسلام هو رفض العقائد الخرافيّة التي لا تمتّ الى العقل والفكر بصلة، بل كبّلت
(154)العقل وقيّدته بقيودها، فجاء الإسلام ورفع هذه القيود ليفكر الإنسان بحريّته وينتخب».
فلو كانت نظرتنا الدينيّة وفهمنا الدينيّ مبنيّاً على هذه الأسس والمباني، فبالإمكان الأخذ بالديمقراطيّة والجمع بينها وبين الدين، وبطبيعة الحال لو تحقّق هذا الأمر ورفض الناس القيم الدينيّة، فلن يكون هذا المجتمع مجتمعاً دينيّاً بل سيكون مجتمعاً علمانيّاً أو إلحاديّاً، ويبقى على عاتق علماء الدين والبقيّة الباقية من المؤمنين استغلال الديمقراطيّة، والشروع مرة ثانية بالتبليغ والإرشاد، عسى أن يفتح الله لهم من جديد.
ولا بأس هنا وفي ختام هذا البحث بالإشارة إلى ما ذكره الأستاذ مصباح اليزديّ في جوابه لمن سأله عن احتمال رجوع الناس عن النظام الإسلامي، حيث قال:
«إنّ احتمال عدم مقبولية النظام الإسلاميّ من قبل الناس يمكن تصويره بصورتين:
الأول: أن لا يقبل الناس من البداية بالحكومة الدينيّة اطلاقاً، ففي هذه الحالة وبرغم وجود الإمام المعصوم أو الفقيه الواجد للشرائط، لا تتحقّق الحكومة الدينيّة، لأنّ شرط تحقّقها قبول الناس. . . .
الثاني: أن تكون حاكميّة الحاكم الشرعيّ متحقّقة فعلاً، ولكن بعد برهة يرفضه جمع من الناس ويبدأون بمخالفته، هذا الفرض له حالتان:
الحالة الاُولى: أن يكون المخالفون هم الاقليّة، وغرضهم الثورة على الحكومة الشرعيّة التي أرادها الأكثريّة، فهنا لا
(155)شك في أنّ الحاكم الشرعيّ يجب عليه مقابلة هؤلاء، وإلزامهم بالانقياد للحكومة الشرعيّة، كما فعل أمير المؤمنين عليهالسلام مع أصحاب الجمل وصفين والنهروان، لأنّه لا ينبغي للحاكم الشرعيّ أن يفسح المجال لمن يريد الثورة على الحكومة الحقّة المؤيّدة من قبل أكثريّة الناس.
الحالة الثانية: أن تقوم الأكثريّة الساحقة بمخالفة الحكومة الشرعيّة ويرفضوها، فهنا يبقى الحاكم حاكماً شرعاً، ولكن مع عدم وجود المقبوليّة لا يتمكّن من أعمال حاكميّته المشروعة، كما حصل للإمام الحسن عليهالسلام في صلحه مع معاوية، حيث لم يكن حاكماً فعلاً لعدم إقبال الناس».
فتلخّص ممّا ذكرنا أنّنا مع إعطاء تفسير معيّن للدين، ومدى إمكانية إجباره الناس على التديّن، وإعطاء تفسير خاصّ للديمقراطيّة وجعلها بمثابة وسيلة وآليّة للعمل السياسيّ، يمكننا الأخذ بالديمقراطيّة والجمع بينها وبين الدين، ورفع شعار «الديمقراطيّة الدينية» وإلّا فلا.
هذا آخر ما أردنا إيراده هنا، وما توصّلنا إليه من إمكانيّة الجمع بين الدين والديمقراطيّة، وآخر دعوانا أن الحمد لله ربّ العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وآله الطيبين الطاهرين.
(156)
ـ آئين شهريارى وديندارى: عبدالكريم سروش ـ مؤسسه فرهنگى صراط ـ ط الاولى عام 1379 ش، طهران.
ـ آفاق فلسفه: گفتگوهائى با مهدى حائرى يزدى ـ انتشارات فرزان، ط الاولى عام 1371 ش، طهران.
ـ الإسلام والمدنية الحديثة: ابو الأعلى المودودي ـ طبع في القاهرة عام 1401 هـ.
ـ اُصول الفقه: محمد رضا المظفر، دار الكتب العلمية، قم.
ـ اصول الكافى: محمد بن يعقوب الكليني ـ دارالكتب الإسلامية قم ـ الطبعة السادسة عام 1375 ش.
ـ امامت ورهبرى: مرتضى مطهرى ـ منشورات صدرا، طبع عام 1368 ش، طهران.
ـ امدادهاى غيبى: مرتضى مطهرى ـ منشورات صدرا، طبع عام 1368 ش، طهران.
ـ انديشههاى ماركسيستى: حسين بشيريه ـ منشورات ني، ط الثانية عام 1378 ش، طهران.
ـ بحار الأنوار : محمد باقر المجلسيّ، الطبعة الثانية 1403، مؤسسة الوفاء، بيروت.
ـ بيست گفتار : مرتضى مطهرى ـ منشورات صدرا، طبع عام 1368 ش، طهران.
ـ پرسشها وپاسخها : محمد تقى مصباح اليزديّ ـ مؤسسة آموزشى امام خميني، ط العاشرة عام 1379 ش، قم.
ـ پيرامون انقلاب اسلامى : مرتضى مطهرى ـ منشورات صدرا، ط الرابعة عشرة عام 1368 ش، طهران.
ـ پيرامون جمهورى اسلامى : مرتضى مطهرى ـ منشورات صدرا، طبع عام 1378ش، طهران.
ـ تاريخ فلسفه سياسى : بهاء الدين پازارگاد ـ الطبعة الرابعة، 1359 ش، طهران.
ـ تاريخ فلسفه سياسى غرب : عبدالرحمن عالم ـ منشورات الوزارة الخارجية، ط الاولى عام 1362 ش، طهران.
ـ تاريخ ملل شرق ويونان : آلبرماله وزوال ايزاک ـ انتشارات علمى، ط الاولى عام 1362
ش، طهران.
ـ تحرير الوسيلة : الإمام الخمينيّ ـ مؤسسة تنظيم ونشر آثار الإمام الخميني ـ الطبعة الأولى عام 1421 ه، قم.
ـ تفسير الميزان : العلامة الطباطبائيّ ـ الطبعة الثالثة عام 1394 هـ مؤسسة الاعلمى للمطبوعات، بيروت.
ـ تنبيه الاُمّة وتنزيه الملة : الشيخ محمد حسين النائيني، الطبعة التاسعة عام 1378 ش، منشورات شركت سهامى انتشار، طهران.
ـ جاذبه ودافعه على عليهالسلام: مرتضى مطهريّ ـ منشورات صدرا عام 1379 ش، طهران.
ـ حق وباطل : مرتضى مطهرى ـ منشورات صدرا عام 1379 ش، طهران.
ـ حقوق وسياست در قرآن : محمد تقى مصباح اليزدي ـ مؤسسه آموزشى امام خمينيّ، ط الثانية عام 1379 ش، قم.
ـ الحكومة الإسلاميّة : ابو الأعلى المودودي ـ دار المختار الإسلاميّ القاهرة ـ الطبعة الأولى عام 1367 هـ.
ـ الخطاب الإسلاميّ المعاصر محاورات فكريّة : اعداد جودت سعيد، وحيد تاجا ـ دارفصلت، الطبعة الاُولى عام 1420 هـ.
ـ الخطاب العربي المعاصر : محمد عابد الجابريّ ـ مركز دراسات الوحدة العربيّة، الطبعة الخامسة عام 1994 م، بيروت.
ـ الخلافة والملک : أبو الأعلى المودودي ـ دار القلم الكويت ـ الطبعة الاُولى عام 1398 هـ.
ـ دانشنامه سياسى : داريوش آشورى ـ منشورات مرواريد ـ ط السادسة عام 1379 ش، طهران.
ـ درسهاى دموكراسى براى همه : حسين بشيريه ـ منشورات مؤسسه پژوهشى نگاه معاصر، ط الاولى عام 1380 ش، طهران.
ـ دموكراسى : آنتونى آربلاستر ـ منشورات آشيان ـ ط الاولى عام 1379 ش، طهران.
ـ ده گفتار : مرتضى مطهرى ـ منشورات صدرا، طبع عام 1379 ش، طهران.
ـ الديمقراطيّة وحقوق الإنسان : محمد عابد الجابريّ ـ مركز دراسات الوحدة العربيّة الطبعة الثانية عام 1997 م، بيروت.
ـ الدين والثورة في مصر : حسن حنفي ـ مكتبة مدبولي، مصر.
ـ زندگى وزمانه دموكراسى ليبرال : كرافورد برومكفرسون ـ منشورات ني، ط الاولى عام 1376 ش، طهران.
ـ السلام العالمي والإسلام : سيد قطب ـ دار الشروق مصر طبع عام 1415 هـ.
ـ سياست : ارسطو، منشورات شركت سهامى كتابهاى جيبى عام 1358 ش، طهران.
ـ سياست نامه : عبدالكريم سروش ـ مؤسسه فرهنگى صراط ـ ط الثالثة عام 1379 ش، طهران.
ـ سير آزادى در اروپا : هارولد جى لاسكى ـ منشورات شركت سهامى كتابهاى جيبى ـ ط الثانية عام 1353 ش، طهران.
ـ سيرى در نهج البلاغه : مرتضى مطهرى ـ مركز مطبوعاتى دارالتبليغ ـ سال 1354 ش.
ـ صحيفه امام (مجموعه گفتهها وپيامهاى امام خمينى 1) : مؤسسه تنظيم ونشر آثار الامام الخميني، ط الاولى عام 1378 ش، قم.
ـ طبايع الإستبداد ومصارع الإستعباد : عبدالرحمن الكواكبي ـ دار الشروق العربي بيروت، الطبعة الاُولى عام 1416 هـ
ـ طرح ونقد نظريه ليبرال دموكراسى : اندرو لوين، منشورات سمت عام 1380 ش، طهران.
ـ العدالة الإجتماعية في الإسلام : سيد قطب ـ دارالشروق مصر عام 1415ه .
ـ العرب والعولمة : اعداد اسامة امين الخولي.
ـ فربهتر از ايدئولوژى : عبدالكريم سروش ـ موسسه فرهنگى صراط ـ ط السادسة عام 1378 ش، طهران.
ـ الفقيه والدولة، الفكر السياسي الشيعي : فؤاد إبراهيم ـ دارالكنوز الأدبية بيروت ـ الطبعة الاُولى عام 1998 م.
ـ في الثقافة السياسية : حسن حنفي ـ دارعلاء الدين ـ الطبعة الأولى عام 1998 م.
ـ القضايا الكبرى : مالک بن نبي ـ دارالفكر المعاصر بيروت ـ طبع عام 1420 هـ.
ـ الكامل في التاريخ : عزالدين عليّ بن ابي كرم (ابن الأثير) ـ دار صادر بيروت طبع عام 1399 هـ.
ـ كتاب البيع : الإمام الخمينيّ ـ مؤسسة تنظيم ونشر آثار الإمام قم ـ الطبعة الأولى عام 1379 ش.
ـ كتاب الرسائل : الإمام الخمينيّ ـ مطبعة اسماعيليان قم ـ عام 1385 ه.
ـ كشف الأسرار : امام خميني، بدون ناشر.
ـ مدارا ومديريت : عبدالكريم سروش، منشورات مؤسسه فرهنگى صراط ـ ط السادسة عام 1376 ش، طهران.
ـ نماذج الديمقراطية، ديفيد هلد، معهد الدراسات الاستراتيجية، بغداد عام 2006م.
ـ مسألة شناخت : مرتضى مطهرى ـ منشورات صدرا عام 1379، طهران.
ـ المسلمون والصراع السياسي الراهن : ابو الأعلى المودوديّ ـ طبع في القاهرة عام 1401 هـ.
ـ معالم في الطريق : سيد قطب ـ دار الشروق مصر، الطبعة السابعة عشر عام 1413 هـ. .
ـ نظام حقوق زن در اسلام : مرتضى مطهرى ـ منشورات صدرا عام 1379 ش، طهران.
ـ نظريه سياسى اسلام : محمد تقى مصباح اليزدي، منشورات مؤسسه آموزشى امام خميني، ط الثانية عام 1378 ش، قم.
ـ نظريّة الإسلام السياسيّة : أبو الأعلى المودودي ـ طبعة بيروت عام 1389 (ضمن مجموعة: نظرية الإسلام وهديه في السياسة والقانون).
ـ نهج البلاغة : جمع الشريف الرضي، دار الهجرة.
ـ ولايت فقيه : الامام الخميني ـ مؤسسه تنظيم ونشر آثار امام ـ ط العاشرة عام 1379 ش، قم.
ـ هموم الفكر والوطن : حسن حنفي ـ دار قباء ـ عام 1998 م، القاهرة.
ـ يادداشتهاى استاد مطهرى : نشر صدرا ـ ط الاولى عام 1379ش طهران.